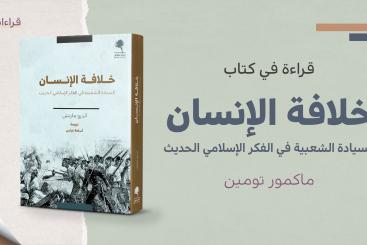عن ما بعد الحداثة: البراديغم والتحقُّق

الاستحالة والتحقُّق
قد يقودنا الحديث عن الحداثة – اليومَ – إلى الحديث عن ما بعد الحداثة وإشكاليتها الكبرى؛ إذ يصعب الإمساك بمعنى هذا المفهوم "الفلسفي" والهلامي… فهل هو نزعة فنية فقط، أم بلغ مبلغ الظاهرة الاجتماعية واكتسح الاقتصاد والسياسة؟ هل تغلغل في الإنسانية، كما فعلت الحداثة؟ هل من فرق بين الأولى (ما بعد الحداثة) والثانية (الحداثة)، فرق قد يقود إلى تجاوز وقطيعة مبرمة – لربما؟ بعيدًا عن كل هذا، فما يمكننا التأكيد عليه كون أن ما-بعد الحداثة قد أنشأت جذورها في الأدب (بيكيت، كامو، ميللر، كافكا…)، كما قد استوعبت الفنَّ وضمَّته إليها منذ سنوات الخمسينيات من القرن المنصرم. "فالمصطلح الآن أصبح مميزًا لنزعات في الفيلم، المسرح، الرقص، الموسيقى، الفنّ، والعمارة؛ في الأدب والنقد؛ في الفلسفة، اللاهوت، التحليل النفسيّ، والتاريخانية؛ في علوم جديدة، تقنيات، نظم وأنماط الحياة الثقافية المتنوّعة"(1).
فإن تضاربت التواريخ في تحقيب الحداثة، فالمفكِّر الأمريكي البرجماتي ريتشارد روتري يلحق الحداثة بفكر ديكارت (القرنان السادس عشر والسابع عشر)، والمفكِّر الألماني يورغن هابرماس يربطها بعصر الأنوار (القرن الثامن عشر)، ويذهب باحثون إلى التأريخ لظهورها في القرن التاسع عشر! مما يجعل تحديدَ تاريخ فعليٍّ لمنعطف الحداثة يبدو شائكًا وصعبًا، وهو ما يدل على صعوبة تحديد مفهومها أيضًا، وذلك رجوعًا لما يربطه تحديد المفهوم بالحقبة التي ينتمي إليها.
ومن الجهة نفسها، يقع الأمر على دلالة مفهوم ما بعد الحداثة، فيكون هذا المفهوم غامضًا ومضطربًا بسبب استناده إلى مفهوم الحداثة وانبنائه عليها. وهكذا يجري إطلاق مفهوم ما بعد الحداثة على أمورٍ متناقضة إلى الحدِّ الذي يصير معه فاقدًا لمعنًى محدَّد. تقول كارول نيكولسون بهذا الصدد: "إذا أخذنا بعين الاعتبار التعدُّد والتنوع الذي يطبع حركة ما بعد الحداثة، يظهر أنه من الحماقة بمكان حصر دلالة هذه الحركة في تعريفٍ دقيق". ويقول دافيد هارفي: "من المؤكَّد أن الجميع يختلف فيما يقصد باللفظ (ما بعد الحداثة)، ما عدا احتمال أن يكون المقصود بها كونها تجسيدًا لردِّ فعلٍ ضد الحداثة أو انزياح عنها. وطالما استغلق علينا معنى الحداثة والتبس، فإذا رد الفعل هذا المعروف باسم ما بعد الحداثة يظلُّ هو الآخر مستغلقًا بكيفية مضاعفة"(2).
إذن، يُعَدُّ مفهوم "ما-بعد الحداثة" من أكثر المفاهيم التباسًا وتعقيدًا، بل ولقِصر زمن ظهوره يصعب علينا إدراكه مليًّا والإحاطة به بشكل كليٍّ؛ فبعكس الحداثة التي استكملت من العمر قرونًا عدَّة، فهذا المفهوم لم يُكمل بعد قرنَه الأول؛ ولهذا يستحيل علينا ضبطه. "فيظلّ أصله ملتبسًا، مع (العلم) أن فيديريكو دي أونيس قد استعملَ كلمة Postmodernismo ضمن مختاراته للشعر النسائي الإسباني والهسباني Hispanoamericana، المنشور في مدريد 1934؛ واستعاده دادلي فيتس من جديد في مختاراته للشعر الأمريكي/اللاتيني المعاصر عام 1942. قصد كلاهما الإشارة إلى تفاعل ثانويٍّ مع الحداثة الكامنة فعليًّا ضمنها، بالعودة إلى بواكير القرن العشرين. كما ظهرَ المصطلح في "دراسة التاريخ" لأرنولد توينبي حين أصدر د. س. سومرفيل جزأه الأول مختصرًا في عام 1947.
صمّمَت ما بعد الحداثة منعطفًا تاريخيًّا جديدًا في الحضارة الغربية، (…) أثناء الخمسينيات، كان تشارلز أولسون يتحدَّث غالبًا عن ما بعد الحداثة بتعريفٍ ساحق أكثرَ منه مصقولًا"(3). وقد شاع هذا المصطلح وساد منذ سنوات الخمسينيات على رغم استحالات تحديد مصدره بشكل محدَّد رغم حداثته، وإن كنَّا نجد جون واتكنز تشابمان John W. Chapman قد استخدم مصطلح "أسلوب الرسم ما بعد الحداثي" عام 1870، وهو يتحدَّث عما نسميه اليوم بما بعد الانطباعية.
البراديغم والمعنى
تُعَدُّ فترة الثلث الأول من القرن الماضي فترةً حاسمة في التاريخ البشري، معرفيًّا وجغرافيًّا وأيديولوجيًّا وعلميًّا كما فنيًّا. تلك الفترة كان لها فعل رسم معالم الاتجاهات الفنية على امتداد القرن والقارات.
وهي الحقبة التي شهدت انفجارًا كونيًّا في دائرة المعارف الفنية، وسيلًا عارمًا من التيارات والنزاعات والمدارس الفنية لم يعرفها تاريخ الفن العالمي من قبل. وقد استطاعت هذه الحقبة أن تنسج بطانةً حضارية توليفية بين فنون الشرق والغرب، مترعةً بصخب روح العصر ورعب الحضارة الصناعية واقتصاد السوق وفن السوق، مستندةً إلى جيلٍ من الفنانين متنوعٍ وعالمي، مكتنزٍ بتطلعات جمالية جريئة وغريبة عن المألوف والموروث، وقادرة على "التفكيك" وثقافية "النفي" والتحليل والتركيب والتجريد. ورغم اختلاف العناوين والشعارات والتسميات، فإن الفن الجديد(4) Art Nouveau أو الأفنغارد (الطلائعية) « Avant-gardes » أو الحداثة « Modernisme » مع ما استولدته من « Isme » – بات اليوم جزءًا من تاريخنا المعاصر، حتى إننا نطلق عليه مرحلة "الكلاسيكية" من الحداثة، بعد ظهور مصطلح ما بعد الحداثة(5) Postmodernisme .
كل ما لا يدخل تحت طائلة النظام الشمولي؛ أي لا يعبر بلغة واحدة عن شيء واحد في اللحظة التاريخية…، فهو لا يفيد، ويعتبر منتهي الصلاحية أو سابقًا لأوانه.
قد يكون عبد الله العروي أبرز الأسماء الفكرية العربية الرافضة لمفهوم ما بعد الحداثة؛ إذ لا يتردَّد في رفضها وإنكار استعمالها. حيث يقول في أحد حواراته: "لقد كثر الكلام لدى بعض المثقفين أو أنصافهم عن مجتمع ما بعد الحداثة! أي مجتمع ما بعد الحداثة بالنسبة للمغرب؟ نعرف مجتمع ما قبل الحداثة، ولم نرَ مجتمع الحداثة بعدُ". غير أن رؤيته هذه من جهة، كما يقول د. موليم العروسي (كطرف مقابل)، إن تبدو صائبة إلا أنها مكرّسة لنظرة سياسية شمولية. إذ يرى أن كل ما لا يدخل تحت طائلة النظام الشمولي؛ أي لا يعبر بلغة واحدة عن شيء واحد في اللحظة التاريخية…، فهو لا يفيد، ويعتبر منتهي الصلاحية أو سابقًا لأوانه(6).
وهذه النظرة إن انتقل بها من مستواها البحثي الذي جاء به في كتابه "الأيديولوجية العربية المعاصرة" إلى مستوى الفن، فإنها تبدو ساذجةً. فالعروي يرثي لحال مؤرخي المستقبل؛ لأنه لن يجد في متاحفنا الفنية ما يفيده في دراساته التاريخية. وعندما يتساءل عن شكل لباس أجدادنا، وعن طبيعة الدار البيضاء ومحيطها في القرن العشرين، فإن الرسم سيبقى صامتًا؛ والسبب أن المغاربة انتقلوا مباشرةً من فنِّ الأرابيسك إلى الرسم التجريدي، حسب قوله.
يبدو العروي "ساذجًا" – على حدِّ تعبير موليم العروسي – من خلال هذا الموقف. هل يظن فعلًا أنه لا علاقة للرسم بالإبداع؟ هل يظن أن دور الرسم هو الإخبار والإعلام والتوثيق؟ ما علاقة الرسم بالإبداع إذن؟ هل هو إبداع أم مجرَّد صنعة؟ صحيح أننا لا نتوفر على رسم كلاسيكيٍّ مغربي، لكننا لا نتوفر كذلك على شعر جاهليٍّ مغربي، فهل يعني هذا أن ندير ظهورنا إلى ما يسميه – قدحًا – الشعر الحر حتى نتفرغ لنظم قصائد على طريقة امرئ القيس(7)؟ ألا يقود هذا الموقف إلى سياسة الاتباع لا الإبداع؟ ألا نكون بالتالي مجبرين على خلق تاريخ وهميٍّ لمسايرة الحداثة الأوروبية التي ستكون قد تجاوزتنا إلى ما فوق – لا ما بعد – الحداثة وأصنافها؟ فلماذا لا يمارس العروي طرقَ تأريخه مثل الأقدمين؟ وإن كان مع القطع والتجاوز، فلماذا يرى اتباع الطرق الكلاسيكية في الرسم والتأريخ؟ أسئلة وأخرى تقودنا للتناقض في رؤية عبد الله العروي، هذه. رؤية تتناقض مع ما جاء يتبنَّاه من تجاوزٍ وقطعٍ مع الماضي وموروثاته. فبهذا يمكننا أن نتجاوز نظرة العروي عن الحداثة وما بعد الحداثة – على الأقل على المستوى التشكيلي.
وإن تمخَّض عن الحداثة في القرن العشرين عدَّة تيارات فنية يمكن أن نحصرها في: الانطباعية – التعبيرية – التكعيبية بمراحلها الثلاث (وباقي التيارات التي رافقتها) – الصفائية – التصوير الماورائي – الدادئية – الحركة التعبيرية الألمانية – المستقبليون – الطليعيون الروس – اتجاهات الفن التجريدي – البناءون – السريالية – التجريدية…إلخ؛ فإنَّ أيَّ حديثٍ عن فن ما بعد الحداثة، هو بالضرورة حديثٌ عن الفن المعاصر. وإذا كانت الحداثة الكلاسيكية تتميَّز بعقلانية أداتية صارمة، وبنزعة تقنية وبقدراتٍ لا متناهية على السيطرة على الطبيعة والإنسان، فإن ما بعد الحداثة تحاول تقديم صورةٍ أكثر إنسانية عن الحداثة، بحيث تدمج في منظورها الذات البشرية الفاعلة والمعاني الغائبة والأبعاد الجمالية، محاولة الحدَّ من بعض مظاهر أداتيتها.
ولم تأتِ ما بعد الحداثة وتتولَّد لكون الحداثة قد استوفت شروطَ أفولها، وإنما لوفرة الزخم الإبداعي ودفق التجدُّد لدى جيل الرواد – على المستوى الغربي – في الثلث الأول من القرن الماضي، الذي افتتح عصرًا فنيًّا مختلفًا عما سبقه: متبدلًا، وأثيريًّا، ومتحرِّرًا من كل شروط المجتمع والتاريخ(8). إن ما بعد الحداثة بهذا المعنى هي التغيير في الحداثة نفسها، أي هي حداثة الحداثة؛ إذ لم تقف هذه الأخيرة عند لحظةٍ تاريخية ما لتبدأ الأخرى، بل هما متصاحبتان في اللحظة والآن.
إن ما بعد الحداثة – في سياقنا – هي منعطف جذريٌّ من منعطفات الحداثة أو من مساقاتها التاريخية.
بهذا يمكننا القول إن مفهوم ما بعد الحداثة لا يشي – بأي حالٍ من الأحوال – بالقطيعة المبرمة مع الحداثة، ولا ينطوي على أيِّ ادعاء لتجاوز أفق الحداثة وآفاقها، وإلا وقعنا في أحابيل ما يدعوه المفكِّر محمد سبيلا "بالامتساخ التاريخي وعمى الألوان"(9). إن ما بعد الحداثة – في سياقنا – هي منعطف جذريٌّ من منعطفات الحداثة أو من مساقاتها التاريخية. إنها تشير إلى لبوسٍ آخر للحداثة، أو دورٍ مغاير من أدوارها.
إنها أفق بعديٌّ من آفاق تطور الوعي الحداثي، ومراجعته لثوابته، وتشكيكه في مطلقاته وأقانيمه. فالحداثة وما بعد الحداثة ليستا وضعين متواجهين متنابذين، بل يندرجان معًا في سيرورةٍ واحدة هي سيرورة التحديث على حدِّ قول فانسان ديكومب. إن ما بعد الحداثة هي حداثة الحداثة، أو هي الحداثة وقد تخلَّصت من رؤيتها الطوباوية ومنزعها البرميثيوسي البطولي ومحكياتها الكبرى. إنها حداثةٌ بعدية تمضي شَطْرَ تشذيب خطابها التقدُّمي والقطائعي، وتحاول أن تنقع جسمها الغضَّ بمياه مختلفة، من خرائط وتجارب ومشارب وأزمنة مختلفة. يقول "فانسان ديكومب": "لقد كان الإنسان الحداثي يعتقد – بعمق – بأن للتاريخ معنًى، من ثمة كان بمقدوره أن يتشبَّع ويدافع عن قضايا بعينها وأن يلتزم داخل تنظيم سياسيٍّ. أما الإنسان ما بعد الحداثي فهو نفسه هذا الشخص الحداثي، وقد تغلَّب فيه الحسُّ النقدي على آخر ما تبقَّى من سذاجته"(10).
بينما يعتبر الفيلسوف الفرنسي جان فرنسوا ليوتار أن الأيديولوجيات الكبرى التي سيطرت علينا طيلة القرنين الماضيين كالليبرالية والاشتراكية والماركسية التي كانت من نتاج الحداثة وعصر التنوير، لم تستطع أن تحقِّق وعودها للبشر بالسعادة عــــلى هــذه الأرض؛ ولذلك فهو يدعوها بالحكايات الكبرى الطـــوبــــاوية، أو الأســــاطـير الكـبرى الـــتي أوهمتـــنا بفكرة التـــقدُّم، وقالت لنا إن الإنسان سائر لا محالة نحو الأفضل باستمرار، إذا ما اتبع المنهج العقلاني وتخلَّى عن الخرافات، وانتزع من رأسه العقلية الغيبية التي سيطرت على العقول إبَّان العصور الوسطى في الغرب الأوروبي.
وفي اعتقاد ليوتار أن مقولة التقدُّم قد سقطت بعد مرور العالم بتجربة الفاشية والنازية والمحرقة اليهودية، ولم يعد في الإمكان أن نضع ثقتنا في أيديولوجيا التقدُّم والتنوير والحداثة؛ لأنها ليست يقينيات علمية، وإنما مجرَّد طوباويات تحرِّك الجماهير، وتوهمها بالتحرير والخلاص، ولكن بلا جدوى. ويستطرد ليوتار قائلًا إنه يجب على إنسان ما بعد الحداثة العيشُ من دون حكاياتٍ أو سردياتٍ كبرى، ويجب عليه أن يرفض كلَّ صور الكلية والشمولية التي حكمت الفكر الغربي، وفرضت عليه نوعًا من الإرهاب والإقصاء، والتي جعلت منه سجينَ أفكارها الباطلة، كما يجب عليه أن يتخلَّص من الإيمان بوجود حقيقة واحدة، والتخلُّص من فكرة الثورة لبلوغ الحرية والسعادة. وعلى إنسان ما بعد الحداثة أن يقتنع بهيمنة التقنيات والعلوم على وجوده، وأن يتكيَّف مع هذه الهيمنة من دون القدرة – مع ذلك – على الوثوق بها فيما يتعلَّق براحته(11).
وفي جانبٍ آخر، "فإن الحداثة بناء تاريخيٌّ، حصل تدريجيًّا، وتبلور في مظاهر شتَّى حاول المفكرون والمؤرخون، كما يخبرنا السوسيولوجي عبد الله حمودي، مسحها بعد التحوّل التاريخي نفسه، بحيث نتفادى تصورها في شكل برنامج مثاليٍّ وُضع أولًا ثم قام الناس بتطبيقه في مكانٍ وزمانٍ معيَّنين"(12). فإن كانت الحداثة بصفتها واقعًا وبناءً تاريخيًّا، فإنها على سلبياتها "جاءت نظريات "ما بعد الحداثة" لتُعيد النظر في تلك الثنائيات وفي التراث والتقليد ما قبل التعقيل"(13).
التمييز الذي جاءت به ما بعد الحداثة هو غياب القواعد، والتشكيك في كلِّ ما تلقيناه من معارف وعلوم.
وبجانبه "يوضِّح ليوتار لمتابعيه في نقد الحداثة، أن إنسان ما بعد الحداثة ينكر على نفسه عزاء الأشكال الجيدة، فهو يعمل من أجل ذوقٍ يتيح المشاركة الجماعية في الحنين إلى ما يمكن بلوغه، وهذا الشعور سيكون الشعور السامي الحقيقي، فهو يبحث في تقديماتٍ جديدة ليس من أجل الاستمتاع بها، بل من أجل نقل حسٍّ أقوى. وبهذا يصبح الفنان والكاتب كالفيلسوف؛ إذ إن النصَّ الذي يكتبه الكاتب، والعمل الذي ينتجه الفنان غير محكومٍ بقواعد راسخة ومعطاة سلفًا، فهما يعملان من دون قواعد حتى يصوغا قواعدَ جديدة، ويعملان بعيدًا عن مرجعياتٍ وسردياتٍ أظهر الواقع بطلانها. إن التمييز الذي جاءت به ما بعد الحداثة – على ما يرى ليوتار – هو غياب القواعد، والتشكيك في كلِّ ما تلقيناه من معارف وعلوم.
تدفع دعوة ليوتار إنسان ما بعد الحداثة إلى القطع مع الأيديولوجيات، والتيارات الفكرية القائمة على الشرعية التاريخية، تدفعه إلى رفض كل أشكال وصور الكلية والشمولية، وتدعوه إلى الأخذ بفكر الاختلاف والتعدُّد، ورفض القواعد الثابتة، فلا وجود لخطاب موحَّد، بل تعدُّد في أنواع الخطاب، وأن لكل خطابٍ قواعد ومعايير، ومناهج خاصة، وبذلك يرفض ليوتار الأفكار المتعلِّقة بإمكان قيام نظرية عامة شاملة تكون مرجعًا أساسيًّا للمعرفة. فهو يقول: "القصة الصغيرة لا تزال الطريقة الجوهرية التي تمثّل بها المعرفة"، وهو يقصد أن هذه القصة الصغيرة ليست تلك الحكايات الكبرى التي تبنَّتها فلسفة الحداثة التي تكوِّن الإطار الأمثل للتاريخ الكوني الشامل الذي تحدَّث عنه هيغل، بل إنها الحكاية التي ترتبط بتاريخٍ معيَّن؛ لأن لا وجود لتاريخ كونيٍّ كليٍّ وعام، بل هناك تواريخ عدَّة.
ومن ناحية أخرى، ترفض حركة ما بعد الحداثة النظرية الحديثة، في زعمها إمكانية أن تسيطر نظريةٌ واحدة على مجمل علمٍ أو تخصيصٍ بأسره، والزعم بأن بعض النظريات الاجتماعية والسياسية يمكن أن تطبق مقولاتها في أي سياقٍ مهما اختلفت الثقافات أو اللحظات التاريخية – وهمٌ باطل لا يقوم على أساس.
وتريد حركة ما بعد الحداثة أن تقلِّص دور النظرية وتستبدل بها حركة الحياة اليومية، والتركيز على ديناميات التفاعل في المجتمعات المحلية، تلاقيًا لعملية التعميمات الجارفة التي تلجأ إليها النظريات، مما يؤدِّي – عمليًّا – إلى تغييب الفروق النوعية، وإلغاء كل صور التعدُّدية الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ويأتي في فنون الما بعد الحداثية أن العمل الفني رغم أنه لا يمثِّل أيَّ روابط مع العالم العادي ordinaire – إما عبر الأشياء التافهة، وإما عبر المحيط الطبيعي أو العمراني – فهو يميل إلى إدماج مجاله الوجودي في السياق الذي يوجد فيه منشأ أو مقترح للعموم(14). كما تلخِّص ذلك ناديا والرافون Nadia Walravens: "الأثر œuvre لا يمكن اختصاره في الشيء المعروض – لوحة مثبتة على الجدار أو منحوتة موضوعة على الأرض. فالعمل /الأثر اليوم يكشف عن حضور أشياء تنفتح على الفضاء والزمن، مكونات جوهرية للعمل. سياق الحضور يظهر إذن جوهريًّا"(15). هذا السياق يمكن أن يكون زمنيًّا أو – في الغالب – مكانيًّا، كما اجتماعيًّا.
كما أنه لا يعتبر الوعي البصري ما بعد الحداثي وعيًا مضادًّا للحداثة، ولا يعلن القطيعة معها، بل هو وعيٌ نقديٌّ يسائل طوباوية الحداثة ومنزعها الطليعي، ويعمل على تنسيبها والاشتباه في دوغمائيتها. وبدل استراتيجية الثنائيات المتنائية (تقليد/حداثة، حرفي/فنان، خام/ثقافي، اللوحة/النصب…) التي اتكأ عليها البروتوكول الحداثي، قام الوعي البصري ما بعد الحداثي على أواليتين مفصليتين هما: المفارقة التاريخية Anachronisme والمفارقة البراديغمية، مما جعله يصالح بين أزمنة وبراديغمات جمالية متباعدة. وضد المنزع الطليعي عانق الفردانية الموغلة في الذاتية، وعوض جماليات التجريب ويوتوبيا المغايرة تحصَّن الوعي ما بعد الحداثي بإستيتيقا التكرار والاستعادة والالتفاف الملتوي على التجارب الفنية السابقة، فيما يشبه الترتيق والترميق bricolage، لا المحاكاة والاستنساخ الحرفي.
وفي السياق ذاته عمل الوعي البصري ما بعد الحداثي في المغرب على مساءلة التركة الحداثية برمتها، ووضع مرجعياتها وفتوحاتها ومختبراتها التجريدية موضع اشتباه. مما ترتب عنه خلخلة نظرة المتلقي لشخصية الفنان ولأثره الإبداعي وغائياته ولبروتوكول التلقي ومواثيقه المرجعية. وهكذا انمحت الحدود التي كرستها الحداثة الجمالية بين الأجناس والأساليب والسجلات الجمالية، وغدا الوعي الإستيتيقي ما بعد الحداثي أكثر نزوعًا إلى "المحافظة" و"التهجين" بدل جدل المجاوزة ووازع الصفائية الإبداعية الخالصة Purisme، وأسلسَ في المصالحة بين أشد الأساليب والتعبيرات تباعدًا وتنابذًا، والتوليف بين أزمنة أكسيولوجية متنائية(16).
***
إن ما بعد الحداثة هي ذلك البحث عن اللامتوقع واستجابة للمتخيل داخل قالب متجدِّد ومغاير ومتغيِّر بشكل مستمر، قالب التجريب، معتمدة على الرؤية التشكيكية والعدمية، كما على التناص (إعادة صياغة الأعمال المبكِّرة والترابط بين النصوص الأدبية – كما يحدِّد ذلك دافيد كارتر) والبحث عن المستحيل، وتجاوز المسلَّمات عبر نقدها للحداثة عينها والإنهاء مع الرؤية المركزية التي ظلَّت لصيقةً بالحداثة. وهي كذلك ليست – كما يتوهَّم البعض – قطيعةً مع الحداثة بقدر ما هي إعادة محاورتها ومناقشتها وتمحيصها.
و نشير هنا إلى أمثلة من مدارس الفن المعاصر "فنون ما بعد الحداثة" التي نهل منها الفن التشكيلي المغربي ليؤسِّس لمعاصرته (ما بعد حداثته):
– البوب آرت – فن التجهيز (التنصيب/ أنستلايشن) – الحدوثة – فن جاهز الصنع – فن البيئة أو فن الأرض – الفن الإقليلي – الفن المفاهيمي – فنون الميديا – فن الأداء (برفورمانس) – الفن الفقير أو المتقشِّف – فن الجسد…
الهوامش
(1) إيهاب حسن، منعطف ما بعد الحداثة، ترجمة محمد عيد إبراهيم، كتاب الهلال، 2016، ص 6.
(2) محمد الشيخ وياسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر، دار الطليعة، 1996، ص 10.
(3) إيهاب حسن، منعطف ما بعد الحداثة ، ص 122.
(4) Groy. C. the Great Experiment : Russian Art. 1863-1922. London, 1962.
(5) زينات بيطار، غواية الصورة، ص 84
(6) موليم العروسي، الحداثة في فكر عبد الله العروي، عن كتاب: عبد الله العروي، الحداثة وأسئلة التاريخ. (كتاب جماعي)، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء، 2007، ص119.
(7) نفسه، ص 120.
(8) زينات بيطار، غواية الصورة، ص 84.
(9) محمد سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال، 2000، ص50.
(10) محمد الشيكر، الفن في أفق ما بعد الحداثة ، ص 5.
(11) موريس أبوناضر، جريدة الحياة، عدد الأربعاء، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015 .
(12) عبد الله حمودي، الحداثة والهوية، ص 16.
(13) نفسه ص 19.
(14) Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain Structures d’une révolution artistique, éd. Gallimard, 2014 p 119.
(15) Nadia Walravens, l’œuvre d’art en droit d’auteur : Forme et originalité des œuvres d’art contemporain, éd. Economica, 2005, p 85.
(16) محمد شيكر، كاطلوغ 50 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب، ص 30-31.