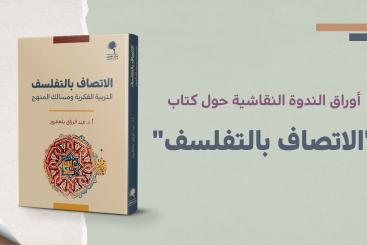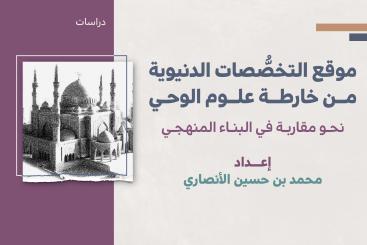نحو منهجية علمية إسلامية: توطين العلم في ثقافتنا

يندرج كتاب يُمنى طريف الخولي، ضمن سياق مجموعة من الاجتهادات النظرية الرامية إلى استقصاء سبُلٍ وطرائقَ قمينة بإخراج الثقافة العربية من وهدة التخلف والتقليد؛ وذلك من خلال التركيز على المكانة الجوهرية التي يتبوؤها الفكر العلمي في كلِّ تطور حضاري. لذا يمكن القول: إن هذا الكتاب ليس بِدْعًا داخلَ الثقافة العربية الإسلامية؛ إذ سبقته اجتهادات نظرية أخرى تتوخى الهدف ذاته.
لكن ما يُميز هذا العمل قياسًا إلى تلك الاجتهادات، هو أن المؤلفة قد يَمَّمَتْ وجهها شَطْرَ بُعدٍ قلَّما يُلتفت إليه، والمقصود هنا البعد المنهجي الذي ترى فيه الكاتبة حَجَرَ الأساس الذي يجب أن يَسْنِدَ كل بحث يهدف إلى إرساء أسس نهضةٍ حضاريةٍ منشودة. لكن، لا يجب أن يَحْمِلَنَا هذا على الاعتقاد بأن الكتاب يهدف إلى اعتماد منهج، أو مناهج معينة، قصد مقاربة النصوص التراثية.
كما لا يمكن النظر إلى هذا العمل كمجرَّد تساؤل إبستمولوجي حول المناهج وما تُثيره من إشكالاتٍ ذات طابع فلسفي؛ بقدر ما تسعى المؤلفة إلى استثمار المكتسبات المنهجية التي حققها الدرس الإبستمولوجي المعاصر، وكذا الاستفادة من الخصائص والمميزات المنهجية التي طبعت الحضارة العربية الإسلامية قَصْدَ الوصول إلى "نموذج إرشادي إسلامي"[1]، يكفُل لنا توطين العلم داخل ثقافتنا.
وتبقى هذه العملية، في نظر الكاتبة، هي أولى الأولويات وكُبْرَى التحديات؛ إذ تقول منذ الأسطر الأولى: إن عملية "توطين العلم وتبيئة البحث العلمي في حضارتنا هدفُ الأهداف الذي لا يختلف عليه اثنان"[2].

يمنى طريف الخولي
سنقدم فيما يلي عرضًا لأهم الأفكار والرؤى التي عملت الكاتبة على استشكالها والاستدلال عليها، وسنتبع نفسَ التقسيم الهندسي الذي وضعته المؤلفة لكتابها، حيث وَزَّعَت أفكارها على أربع فصول كبرى، وجاءت هذه الفصول معنونةً على الشكل التالي: الفصل الأول: ما قبل المنهج وما حوله: مقدمات راسمة. الفصل الثاني: العلم والمنهج. الفصل الثالث: التأصيل المنهجي: علم أصول الفقه معاصرًا. الفصل الرابع: النموذج الإرشادي الإسلامي نحو المستقبل. أما فيما يخص خاتمة الكتاب فقد ضمَّنتها المؤلفة أهمَّ الخلاصات التي انطوى عليها هذا العمل.
عملت الباحثة في توطئة الكتاب على رسم الخطوط العامة التي ستتولي الفصول التالية تفصيلَ القول فيها، مشيرةً إلى ضرورة تضافر "الجهود الفلسفية والعقلية والفكرية والعقائدية" في سبيل إيجاد الأمة العربية الإسلامية لقدمٍ راسخةٍ داخل ميدان "العلم والبحث العلمي"؛ باعتباره أهمَّ وأسمى "الفعاليات الإنسانية".
لئن وفر لنا علم المناهج وفلسفة العلوم مكتسباتٍ منهجيةً ثمينةً، فإن استيعابنا واستفادتنا من هذه المكتسبات حق الاستفادة لن يكون إلا من خلال استثمار الخصائص المنهجية الكامنة داخل ثقافتنا.
وللوصول إلى هذا المرام –توطين العلم في ثقافتنا- لا بد من "نموذج إرشادي إسلامي" يستثمر المقومات الحضارية للهوية العربية الإسلامية وخصوصياتها الثقافية والقيمية… أو بعبارة أخرى: إنه "لا توطين للحركة العلمية ولا تأصيل لها في ثقافتنا؛ إلا إذا كان لدينا أصول للمنهجية العلمية كامنة في خصوصيتنا الثقافية، لنقوم بتطويرها في طريقنا لاستيعاب الآليات المنهجية المعاصرة، في إطار نموذج علمي إرشادي إسلامي متجه صوب المستقبل"[3]. ولئن وفر لنا علم المناهج وفلسفة العلوم مكتسباتٍ منهجيةً ثمينةً، فإن استيعابنا واستفادتنا من هذه المكتسبات حق الاستفادة لن يكون إلا من خلال استثمار الخصائص المنهجية الكامنة داخل ثقافتنا.
خصصت المؤلفة الفصل الأول للحديث عن بعض التحولات الجوهرية التي شهدتها فلسفة العلوم المعاصرة؛ إذ ذهب بعض فلاسفة العلم المعاصرين إلى أن المعرفة العلمية "ظاهرة من الظواهر الإنسانية"، التي لا يمكنها أن تنشأ في فراغٍ تامٍّ، بل لابد لها من إطار حضاري يحتضنها ويسهم في نموها وتطورها. وبالتالي، فليس في مُستطاع هذه المعرفة أن تبقى بمنأى عن التأثر والتأثير في باقي المكونات القيمية والثقافية والمؤسساتية… وقد عمل هؤلاء من خلال أطروحتهم تلك على مجابهة بعض التصورات الوضعانية التي ساهمت بشكل كبير في تجريد "ظاهرة العلم من أي أبعادٍ حضارية أو ثقافية أو اجتماعية أو قيمية"[4].
وكان من نتائج هذا التجريد أن أصبح العقل العلمي متعاليًا عن الزمان والمكان، وأضحى معه "العلم الغربي" هو العلم الوحيد والنموذج الأوحد الذي يجب أن تقاس عليه باقي الإسهامات المعرفية، فغدَا العلمُ هو الحضارة الغربية والغرب هو الحضارة العلمية[5]. ولا يخفى ما نتج عن هذا التصور من هيمنة فكرية مثلت "النزعة المركزية الغربية" أبرز صورها، وصارت معه الحضارة الغربية هي المعيارَ والمحكَّ الذي يُقاس عليه تقدم أو تخلف باقي الحضارات، فما وافق هذا النموذج فُرِضَ وحُفِظَ، وما خالفه رُفِضَ ولُفِظَ!
سيعرف هذا التصور العلموي الوضعي هجومًا وانتقادات من داخل الثقافة الغربية نفسها، كانتقادات كارل بوبر (Karl Popper) الذي سيرى أنه لا يمكننا اختزال فلسفة العلم في مجرد تحليلات منطقية، بقدر ما يجب النظر إليها باعتبارها "فلسفة الفعالية الحية والهَمّ المعرفي للإنسان".

بنية الثورات العلمية
كما سيمثل صدور كتاب توماس كون (Thomas Kuhn) "بنية الثورات العلمية" منعطفًا نوعيًّا داخل فلسفة العلوم، حيث قدَّم فيه مفهوم "الباراديم" (النموذج القياسي الإرشادي بتعبير المؤلِّفة)، الذي تخطَّت أهميتُه الإجرائية ووظيفتُه المعرفية حقلَ فلسفة العلوم وتاريخها؛ إذ سيستثمره العديدُ من الباحثين في مجالات علمية مختلفة. وكان من النتائج الإيجابية والحاسمة لعمل كُون أن "حدث أخيرًا تآخي العلم مع الظواهر الحضارية الأخرى، لأنه مثلها لا يُفهَم إلا في ضوء تطوره عبر التاريخ"[6].
أشارت الباحثة أيضًا إلى بعض الفلاسفة الآخرين كفيرابند (Paul Feyerabend)، الذي يَرى أن العلم لا يُمكن أن يتطور وينمو إلا داخل "الأنظمة المعرفية الأخرى"، داعيًا إلى عدم اتخاذ العلم "ذريعة" لفرض النموذج الحضاري الغربي وتهميش الثقافات الأخرى. لم يعد يُنظر للعلم من لَدُنِ العديد من الباحثين كظاهرةٍ مستقلة بنفسها عن باقي المكونات الثقافية، بل صار غيرَ منفصل عن تاريخه وعن الأنساق الحضارية والقيمية التي يتطور وينمو داخلها، أو في عملية تفاعل معها.
وكان من نتائج هذا التصور ظهور مجموعة من المباحث العلمية التي تُولي هذه الأبعادَ أهميةً خاصة، فظهر ما عُرف بسوسيولوجيا العلوم وسيكولوجيتها، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي في علاقته بظاهرة "العلم"… أما فيما يخصُّ النتائج التي أسفرت عنها هذه التصورات غير الوضعانية داخل الفلسفة عامة، وفلسفة العلوم خاصة، فتمثلت في التخلِّي عن "النزعة الأُسسية" (Foundationalism)، التي تؤمن بضرورة تأسيس مبادئ أولية يقينية تشكل أساسًا للمعرفة بصفة عامة، لصالح "نظرة بنائية اجتماعية" (social constructivism) تعزو للقيم الاجتماعية والثقافية داخل المعرفة العلمية أهميةً بالغة، وبالتالي فهي "تؤكد تعدديةَ الأنساق المعرفية، وقيمة التعدُّدية الثقافية (multiculturalism) ودورها في الممارسة العلمية"[7]. وغدت المعرفة مع هذا التصور معرفة نسبوية relativism.
لابد من إرساء قواعد "منهجية إسلامية" تمثل نظرة شاملة تستوعب كل المناحي المعرفية والقيمية للأمة العربية الإسلامية.
لكن، لا يعني هذا أن المعرفة صارت تنحو صوبَ ضرب من العدمية والفوضوية؛ إذ لا تتوخى هذه النظرة التفريطَ في شرط "الموضوعية" بقدر ما تبتغي تقديرَ هذه "الموضوعية" حقَّ قدرها، وذلك من خلال التأكيد على "أن الموضوعية الحقيقية تقتضي أن نأخذ بعين الاعتبار العواملَ التاريخية والمجتمعية والحضارية والتعددية الثقافية"[8]. يُعد هذا التصور الآخذ بفكرة التعدُّدية مكسبًا مهمًّا بالنسبة للثقافة العربية الإسلامية؛ ذلك أنه يوفر لها فرصةً ثمينة يمكن أن تستثمرها في سبيل الإسهام الفعَّال في الحضارة الإنسانية المعاصرة، عن طريق تأسيس نموذج إرشادي إسلامي يستمدُّ أصولَه المنهجية من داخل الثقافة العربية الإسلامية. أو بتعبير آخر، لابد من إرساء قواعد "منهجية إسلامية" تمثل نظرة شاملة تستوعب كل المناحي المعرفية والقيمية للأمة العربية الإسلامية.
وغني عن البيان أن المنهجية تُعبِّر –في نظر المؤلفة- عن معنى أوسع وأعمق من "مجرد مناهج معينة"، حيث ينحصر دور الأخيرة في الوسائل والإجراءات التي يقتفيها الباحث قصد الوصول إلى نتائج معينة انطلاقًا من مقدمات محددة، أما المنهجية "فتضم المناهج نفسها وتتجاوزها إلى نموذج إرشادي شامل يمثل القيم والمحددات والمنطلقات الموجهة لثقافة أو حضارة ما"[9]. تتميز طبيعة المناهج بنوعٍ من الاستقرار والثبات باعتبارها أصولًا وقواعد منطقية، بينما تتميز "المنهجية" بطابع التطور والتصحيح والتجديد. بالتالي، فهي عبارة عن اجتهادات مرهونة بالظروف والشروط التاريخية.
من هنا، يصير من حق الأمة العربية الإسلامية أن تجتهد في اجتراح "منهجيتها" الخاصة التي تمثلها حقَّ تمثيل. تقول الباحثة موضحة طبيعة هذه المنهجية: إنه لن "يتأتى نقل هذا عن الغرب، ولن يكون معطى جاهزًا في التراث يُراد فرضه على الواقع، يمكن أن تكون أصولُه مستوحاةً من الوحي ومستلهمةً من التراث في عملية اجتهادية، هي ككلِّ اجتهاد إنساني ليست معصومةً من الخطأ، ومعرّض دائمًا للتصويب والتعديل والتطوير. إنه اجتهاد يفتح الباب لاجتهاد متواصل في تفعيل الفكر وتوطين البحث العلمي"[10].
ولا يقوم هذا الاجتهاد على أساس رؤية – أو قراءة – أحادية تفاضلية تولي أهميةً قصوى "لكتاب الطبيعة" وإقصاء ما عداه، وإنما تتوخى المنهجية الإسلامية قراءة "تكاملية" تنضح من معين الكتاب المسطور، أي الوحي، والكتاب المنظور، أي الطبيعة. وطالما أنه لا إمكان لقيام حضارةٍ أو عمرانٍ، مَعْرفةٍ أو قِيَمٍ، دون وجود تصور عام يمثل دعامة وأساسًا، تستند إليه رؤيةُ تلك الحضارة للكون وللحياة وللإنسان، فإن قراءةَ الكتاب المسطور، في سياق الحضارة العربية الإسلامية، تغدو هي الأرضيةَ التي تنبني عليها مجمل التصورات الشاملة التي تؤطر عمليةَ قراءة الكتاب المنظور؛ من خلال ما توفِّرُه من تقاليد وقيم خاصة بالهوية العربية الإسلامية. كما تسهم مسألة التأطير تلك في عصمة عملية القراءة من أي منزلقات غير أخلاقية.
يشكل مفهوم "التوحيد" نواةً تنتظم حولها المنظومة القيمية الإسلامية.
تُجمِل الباحثة الخصائصَ الأساسية للهُوِيّة العربية الإسلامية في أربع مفاهيم أساسية: مفهوم مركزي، هو مفهوم "التوحيد"، تنتظم حوله باقي المفاهيم. ولا يمثل هذا المفهوم مجرَّد مبدأ ميتافيزيقي يوفر شرطًا من شروط اقتحام عالم الطبيعة؛ حيث إنه يُضفي نوعًا من النظام على الكون، بل يُعَبِّرُ أيضًا عن مبدأ قيمي يُصْبِغُ على البحث العلمي مجموعةً من المعايير والضوابط الأخلاقية. ويشكل مفهوم "التوحيد" نواةً تنتظم حولها المنظومة القيمية الإسلامية، التي تتجسد بدورها في ثلاث مفاهيم، هي: مفهوم "الاستخلاف"، ومفهوم "التزكية"، ومفهوم "العمران".
يُعَبِّر مفهوم الاستخلاف عن المكانة المتميزة التي يتبوؤها الإنسان قياسيًّا إلى باقي الكائنات نظرًا لما يتميز به من "عقلٍ" ونشاط معرفي. بالتالي فهو وحده الحَقِيقُ بـ"الاستخلاف" في الأرض. وبما أنه وحده "المُسْتَخْلَفُ" فهو الوحيد الذي أُنِيطَتْ به مهمة إعمار الأرض، أي وظيفة "العمران". ويكون عمران الأرض من خلال توظيف جُلِّ الطاقات المعنوية والمادية في سبيل خدمة حياة البشر، والارتقاء بها والمساهمة في ازدهار الحضارة الإنسانية، أو لنَقُل باختصار: العملُ على "تزكيتها؛ من حيث إن التزكية هي التطهير والترقية والتنمية، للنفس وللواقع وللعلاقات الاجتماعية، وهذا هدف العمران ووسيلته. ولا يعدو أن يكون تطويرًا للهدف المجمع عليه من كل الأطراف، شرقية وغربية، إسلامية وغير إسلامية، أي التنمية"[11].
وبالاستناد إلى هذه الركائز التي توفرها الثقافة العربية الإسلامية، واستثمار مكتسبات الدرس المنهجي (الميثودولوجي) المعاصر، يمكن بناء نموذج إرشادي إسلامي. لكن، لا يمكن إرساء تصور واضح وشامل "لمنهجية إسلامية"، دون توضيحٍ وتحديدٍ للدَّلالات التي ينطوي عليه مفهوم "المنهج العلمي"، وقد خصَّصت المؤلفة الفصل المُعنون بـ"العلم والمنهج" لهذا الغرض.
بعد أن عَرَّجَتِ الكاتبة على بعض تعريفات مفردة "العِلم"، وكذا التطرُّق إلى أهم خصائصه التي حصرتها في أربع: الوصف، والتفسير، والتنبؤ، والسيطرة – نراها تتجه صوب تقديم بعض التعاريف اللغوية لمفردة "المنهج" في اللغة العربية. لتنتقل بعد ذلك إلى التأكيد على الأهمية البالغة، التي حظي بها الجانب المنهجي داخلَ التراث العربي الإسلامي. ويكفي دلالةً على ذلك أن مجموعة من المتون العلمية قد ضَمَّت مُفردة "المنهج" كمكون أساسي ضمن عناوينها، ككتاب "مناهج الأدلة في عقائد الملة" لابن رشد، وكتاب ابن تيمية "منهج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية"…
كما يقدم لنا علم أصول الفقه، الذي يقع وسطًا بين العلوم العقلية والعلوم النقلية، مثالًا لا غُبار عليه للمكانة الجليلة التي حظي بها الجانب المنهجي داخل ثقافتنا. ولم يشكل هذا الجانب مُعطًى عرضيًّا من إسهامات علماء الإسلام، بل إنه "لا مبالغة في القول: إن أهم إنجازات تراثنا تأتّت في مجال المنهج والدراسات المنهجية"[12].
أخذت المؤلفة بعد ذلك في الحديث عن علم مناهج البحث (Methodology)، والمكانة الأساسية التي يتبوؤها في أي نموذج قياسي إرشادي علمي. وتتبدى فائدته في مستويين اثنين على الأقل: أ- فائدته للعلوم التي تتوخى دراسة الكون في جُلِّ جوانبه وتمظهراته، سواء كانت ظواهرَ طبيعية أو إنسانية. ب- تنعكس أهميته كذلك على "البنية الحضارية"؛ من حيث إنه يعبر عن "بلورة لأساليب التفكير المثمرة السديدة، ولوسيلة فعالة امتلكها الإنسان لمواجهة الواقع والوقائع"[13].
كما أشارت الباحثة إلى أن جوهر "الميثودولوجيا" يقوم على نوع من التقابل والتقاطع، أو الافتراق والالتقاء، بين منهجين: منهج صوري يَطبع علم المنطق والرياضيات ولا يلتفت للواقع. ومنهج تجريبيي يُمثل منهج العلوم "الإخبارية"، أي العلوم الفيزيائية والكيميائية… لكن، لا يعني هذا أن البحث العلمي ينبني على أحد هذين المنهجين دون الآخر، بل إنه عبارة عن عملية تفاعلية بين آليات منطقية رياضية مع معطيات واقعية، أي مع وقائع معينة.
انتقلت المؤلفة للحديث عن العلائق والروابط التي جمعت المنهج التجريبي بالحداثة الأوروبية، مُؤكدةً أنه لا يمكن النظر إلى "التجريبية" داخل الحداثة الأوربية كمجرَّد آلية أو منهجية للبحث المعرفي، بل إنها مَثَّلَتْ إيديولوجيا طبعت جُلَّ العصر الحديث، وعبَّرَت (التجريبية) عن روحه وقيمه وعن الآفاق التي كان يستشرفها. لذا فلا غَرْوَ أن نجد من الفلاسفة مَن حاول آنذاك البحث عن نهج يوافق الروح الجديدة ويستجيب لمتطلبات ذلك العصر[14].
نرى بعد ذلك المؤلِفةَ تعود بالتاريخ إلى الخلف؛ في محاولة منها لرصد وتَتَبُّع أهم الخصائص والمراحل التاريخية التي مرَّ منها سؤال "المنهج". فنجدها تبتدئ بالحضارات القديمة، كالحضارة البابلية والحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية، منتقلةً بعد ذلك إلى الحضارة العربية الإسلامية، ومشيرةً إلى العديد من الإنجازات العلمية التي خلفتها هذه الحضارة. ويأتي في مقدمة إسهاماتها تأسيسُ علم الجبر الذي مثل -في رأي المؤلفة- تأسيسًا لنموذج إرشادي ثوري في مجال المعرفة؛ حيث يمكن اعتباره فاتحةً لـ"ميلاد عقلانية علمية جديدة جبرية وتجريبية… [و] أتاح نشأةَ إستراتيجيات ذهنية جديدة أدت للعقلانية الجديدة، التي كانت مقدمةً شرطية لما سمّي بعقلانية العلم الحديث"[15].
لكن، رغم وجود هذا الوعي المنهجي الرفيع داخل تراثنا وما رافقه من اجتراحٍ لآليات منهجية وإسهامات معرفية قيّمة، فإنه لا يمكننا –ولا يفيدنا- مجردُ العودة إلى تلك الإجراءات قصدَ تطويرها أو تفعيلها. بل إن المطلوب شيءٌ أعمق وأشمل من هذه العملية بكثير، فالأمر يتعلق هنا بالبحث عمَّا إذا كانت الثقافة العربية الإسلامية قد توفرت على "روح منهجية" أم لا. وترى الكاتبة أن الجواب عن هذا السؤال "بالإيجاب شرطٌ ضروري لأي محاولة لتوطين المنهجية العلمية.. لتشييد نموذج إرشادي علمي إسلامي مستقبلي"[16]. فهل شهدت الحضارةُ العربية الإسلامية "روحًا منهجية" من هذا القبيل؟ وأين تجلى ذلك بالضبط؟ تجيب المؤلفة: أن علم أصول الفقه هو العِلم الذي عبَّر عن هذه الروح خيرَ تعبير. لذا فقد خَصَّصَت الفصل الثالث من كتابها لإبراز الخصائص المنهجية التي طبعت هذا العِلم.
يشكل علم أصول الفقه عِمَاد عملية توطين المنهجية العلمية وتأسيس "النموذج الإرشادي الإسلامي"؛ إذ مثل اجتهاداتٍ منهجيةً ناضجة تمحورت حول الوحي؛ وذلك قصد الوصول إلى القواعد العامة التي تُسْتَنْبَطُ بها الأحكامُ الشرعية ودلائلُ هذه الأحكام. كما جَسَّد هذا العِلم، إلى جانب علم أصول الدين، الخصائصَ النظرية والمنهجية للعقلية الإسلامية؛ حيث كانا استجابةً لمجموعة من الظروف والمتطلبات التي وجدت الحضارة الإسلامية نفسها آنذاك تجاهها.
وعملت الكاتبة على "استخلاص الجواهر المنهجية" لهذا العِلم، من داخل ذلك الكمِّ الكبير من الأمور والقضايا الجزئية والتفصيلية الخاصة بمجموعة من المسائل الفقهية، كما عملِت أيضًا على تحرير وتخليص هذه "المنهجيات" من بعض ما عَلِقَ بها "من الجدليات والخلافات والمناظرات بينهم [الفقهاء] في الأصول وفي الفروع، فلا يبقى إلا المنهجيات بالمفهوم الشامل للمنهاج والمنهجية التي تبدو لنا عند الله وعند الناس خيرًا وأبقى"[17].
إن القرآن والسنة هما الثَّقلان: المصدران الأعظمان لعلم أصول الفقه.
بعد حديث المؤلفة عن البدايات الأولى لعلم أصول الفقه داخل الحضارة العربية الإسلامية والروابط التي جمعته بالمنطق، انتقلت إلى استجلاء الخصائص المتعلقة بالمصادر المنهجية الأصولية، وهي القرآن والسنة، والإجماع والقياس. ولئن كان الأصل الأول يمثل "المدار والمركز"، فالسنة عبارة عن تفسير وشرح لهذا المركز، تقول المؤلفة عن هذين الأصلين: إن "القرآن والسنة هما الثَّقلان: المصدران الأعظمان لعلم أصول الفقه"[18]. أما المصدر الثالث، الإجماع، فالمقصود به "اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة واتفاق المجتهدين" على مسألة معينة غير قطعية؛ لأنه لا إجماع في القطعي الذي يجد "أسسه في النص أو في بداهة العقل وشهادة الواقع".
أَوْلَت الدكتورة للمصدر الرابع، الاجتهاد والقياس، عنايةً وحيزًا أكبر من باقي الأصول، حيث ترى فيه "صلب ميدان الآليات المنهجية المنوط بها الفعالية المستدامة، في القراءتين معًا"[19]، أي قراءة الكتاب المسطور والكتاب المنظور. وتطرقت بعد ذلك إلى أركان القياس (الأصل والفرع والعلة، وحكم الأصل)، ولم تُفَصِّل كثيرًا في هذه الأركان بقدر ما اتجهت صوب تفصيل القول في ركن "العلّة"؛ نظرًا لأهميته الميثودولجية. ويكفي دلالة على أهميته القصوى "أن الأصوليين… سمّوا الحكمة من التشريع المعين: علّة التشريع، مصدّقين على أن التعليل دائمًا تعقّل"[20].
عملت المؤلفة بعد ذلك على رصد طرائق الاستدلال التي يتبعها الأصوليون وصولًا إلى العلة؛ (طرق الاستدلال على العلة والوصول إليها)، وهذه المسالك هي: الطرد والانعكاس والسبر والتقسيم والمناسبة. كما قدَّمت شرحًا لهذه المسالك مع العمل على إعطاء ما يُشاكلها ويماثلها من آليات المنهج العلمي التجريبي. كما أشارت إلى ما يَطْبَع "القياس الأصولي" من مرونة وارتباط بالواقع، عكس القياس الأرسطي الذي هو منطق ثنائي القيمة وذو طبيعة صورية محضة. وبذلك يمكن القول: إن علم أصول الفقه قد نشأ "كعقلية منهجية استنباطية، لكنه تميز أيضًا بشكل من أشكال التعامل الحي مع الواقع، فحمل بذورًا تجريبية تفتقت عن شجيرات ودوحات منهجية تلاقى في ظلالها عمادَا الميثودولوجيا العلمية: الاستنباط، والتجريب"[21].
كما ترى الكاتبة أن أصول الفقه ما فتئ يقدم لنا درسًا مهمًّا في كيفية الاستفادة من المكتسبات العلمية والمنهجية ودمجها في ثقافتنا؛ خدمة لنموذج إرشادي إسلامي يعبر عن روح الأمة العربية الإسلامية، حيث استطاع هذا العلم الأصيل أن يستثمر العدة المنطقية الوافدة من الثقافة اليونانية ليعمل على سبك وتقوية عدته المنهجية، مُقدِّما لنا بذلك كيفية مشخصة لعملية الجمع بين "الموروث والوافد". وإذا كان الأمر كذلك، "فلماذا لا يتكرر هذا بشكل جديد، فتجمع على أسسه المنهجية محصلات الإيجابيات الوافدة من التطورات المعاصرة في الميثودولجيا العلمية، وتشغيلها في إطار نموذج إرشادي إسلامي ينبع من عالمنا ويمثل روح حضارتنا؟"[22]. وخصائص هذا النموذج الإرشادي الإسلامي هو مدار حديث المؤلفة في الفصل الأخير (الرابع) من هذا الكتاب.
سبق أن ألمحنا إلى أن الباحثة تُرجع مهمة هذا النموذج الإرشادي إلى علم أصول الفقه؛ نظرًا لما تَميَّز به من غنًى منهجيٍّ، لكنها شدَّدت في الآن نفسه على أنه لا ينبغي النظرُ إلى هذا العلم في حدِّ ذاته كنموذج إرشادي؛ بل إن المطلوب هو "استغلال المنهجية الماثلة فيه كتأصيل لنموذج إرشادي علمي إسلامي، وتفعيله داخل منطلقات الروح المنهجية لهذا النموذج"[23].
ورغم المكانة الأساسية التي يحتلُّها علم أصول الفقه في عملية التأسيس تلك، إلا إنه ليس المُعْتَمَدَ الوحيد؛ حيث تؤكد المؤلفة على الأهمية التي يضطلع بها علم الكلام داخلَ هذه العملية، داعيةً في الآن نفسه إلى ضرورة "تكاثف" هذين العِلْمين؛ ذلك أن "أصول الدين باشتباكه مع العقائد والتصورات، يتَّصل بتصور حدود حلبة عالم العلم، بأنطولوجيا العلم وإبستمولوجيته، فيشتبك بفلسفة الطبيعة، مقابلَ اشتباك أصول الفقه بفلسفة المنهج أو الميثودولوجيا"[24].
عملت المؤلفة على دفع بعض الاعتراضات التي يمكن أن تقول بتباينٍ بَيْن مجالَي علم الكلام وفلسفة الطبيعة؛ مُعتبِرةً أنه رغم أن الطبيعيات لم تكن من المشكلات الأساسية لعلم الكلام، إلا إن هذا لا يعني أنها كانت منقطعةَ الصلة به؛ ذلك أنه (علم الكلام) أولاها اهتمامًا في ما يُسمى بمبحث "اللطائف"، أي الطبيعيات، ويهتم هذا المبحث بالكونِ الفيزيقي من جسمٍ وحركةٍ وزمانٍ ومكانٍ… لكن استثمار هذا المبحث (الطبيعيات/اللطائف) لا يعني استرجاعَ تلك الإشكاليات أو طرائق وسبل مقارباتها، فهذا أمرٌ غير معقول، بل لابد من إحداث "قطع معرفي" مع علم الكلام الذي نظر إلى الطبيعة كمشكلة أنطولوجية، والنظر إليها بدلَ ذلك باعتبارها مشكلةً إبستمولوجية. أي إنه يجب علينا تحويل الطبيعة إلى موضوعٍ للبحث والدراسة، وبذلك تتمحور المهمةُ الجديدة لعلم الكلام في "تنضيد العقائد الدافعة إلى قراءة كتاب الطبيعة"[25].
أما فيما يتعلق بخصائص هذا النموذج الإرشادي الإسلامي فتحصرها المؤلفةُ في ثلاث دعائم أساسية: الوحي، والعقل، والطبيعة. إذ يُحدِّد "الوحي القرآني" معالمَ منهجية معينة؛ من خلال حثه على النظر العقلي في الكون والإنسان، أي استثمار العقل الإنساني في فهم وتدبر الطبيعة. كما حددت العناصر الفاعلة لهذا النموذج في ثلاث عناصر: "الرصد العلمي العالمي والنظريات المعمول بها في المجال المعني"، و"التفكير وآلياته وإجراءات البحث وخطواته"، و"قيم الممارسة العلمية أو السلوك العلمي".
وتعزو المؤلفة إلى العنصر الثالث قيمةً خاصة؛ حيث ترى فيه تجسيدًا للخصوصية الحضارية الإسلامية؛ إذ تعتبر أن من الخصائص المميِّزة للنموذج الإسلامي إعطاءَ أسبقية وأهمية كبرى للجانب القيمي الأخلاقي. لكن، هل تعني الدعوة إلى نموذج إرشادي إسلامي نوعًا من القطيعة مع الآخر/الغرب والتقوقع على الذات؟
ترد الكاتبة بكل حزم ووضوح أنه لا يمكن مطلقًا أن يكون "دعوة للانعزال أو الانغلاق المستحيلين، فضلاً عن أن يكونا مجديين، بل هو دعوة لتوطين العلم وللتمكن المنهجي من أجل الرعاية المعمقة لفاعليات البحث العلمي ونمائها في أجواء أليفة غير مغتربة، ثم استدامة وتجويد الحصائل المعرفية"[26].
أشارت المؤلفة لبعض المحاولات الجادة التي تشترك مع هذا الكتاب في نفس الغاية. وتتميز المشاريع الفكرية التي أومأت إليها الباحثة بكونها تنتمي لحقول معرفية مختلفة، من فلسفة وأصول فقه وعلوم اجتماعية وتاريخ وعلاقات دولية وعلوم سياسية… كما قامت أيضًا بعرض بعض هذه الاجتهادات بشيءٍ من التفصيل، وترى فيها تميزًا من حيث جدَّتها وجدِّيتها، كمشروع "التراث والتجديد" لحسن حنفي، ومجهودات عبد الوهاب المسيري الرامية إلى تشخيص "الأخطاء والخطورات الكامنة في التسليم بالنموذج الغربي، الذي لن ينفصل عن المنزع الاستعماري والإمبريالي"[27]. إضافة إلى الأعمال العلمية الرصينة لمؤرخ العلوم رشدي راشد، التي تهدف إلى توطين العلم والبحث العلمي بناء على استثمار المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تاريخ العلوم العربية.
كما لم يفتها الإشارةُ إلى الكتابات التي تندرج ضمنَ ما عُرف بـ"أسلمة المعرفة"، معتبرةً أنها تتَّسم بـ"طابع دَعوي وعظي قيمي، وفي أسوئها طابعٌ تعصبي انفعالي. وقد تتراجع الأصول المنهجية المثمرة حقًّا، وتبلغ أحيانًا حدًّا من التسطيح والانفعالية يثيران الدهشة والأسف"[28].
تطرَّقت الباحثة بعد ذلك إلى "مشروع المنهجية الإسلامية" الذي تبناه المعهد العالمي للفكر الإسلامي منذ سنة 1977. مُشيرةً إلى التقارب الكبير بين هذا المشروع وبين "النموذج الإرشادي العلمي الإسلامي". وأشارت كذلك إلى بعض الدراسات التي انشغلت بـ"المنهجية الإسلامية" داخل العلوم الإنسانية، كمحاولة الدكتور عماد الدين خليل في مجال التاريخ، والدكتور علي ليلة في العلوم الاجتماعية.
أما في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فقد أكدت على مكانة وأهمية المدرسة التي أُسست بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقد ركزت هذه المدرسة جهودها على "تأسيس علم سياسي وفق نموذج إرشادي إسلامي".
ويمكن القول إجمالًا: إن جل مجهودات هذه المدرسة تتمحور حول مفهوم مركزي هو "المنظور الحضاري الإسلامي".
وبعد حديثِ المؤلفة عن إحدى الباحثات البارزات داخل هذه المدرسة، وهي الدكتورة نادية مصطفى، خَصَّصَتْ ما تبقى من هذا الفصل للحديث – بنوع من التفصيل- عن الدكتورة منى أبو الفضل، التي رأت فيها تتويجًا لـ"مدرسة المنظور الحضاري الإسلامي"؛ حيث عملت الدكتورة منى أبو الفضل على اجتراح منهجية إسلامية يَنطلق فيها الباحث من منطلقات حقله التخصصي من جهة، ومن ثقافته الإسلامية وفق "رؤية إسلامية سوية تمثل قاعدة معرفية"[29] من جهةٍ أخرى.
أما عن خاتمة الكتاب فقد عملت فيها المؤلفة على استخلاص الخطوط العريضة التي تضمَّنها هذا العمل؛ مُجْمِلَةً إياها في اثني عشر نقطة. ويصعب الحديث هنا عن مضامين هذه الخلاصات نظرًا لما يطبعها هي نفسها من تركيز واختصار، لذا يُستحسن أن تُؤخذ من مظانّها.
الهوامش
[1] – تستعمل المؤلفة عبارة "النموذج الإرشادي" كمقابل للكلمة الإنجليزية Paradigm.
[2] – يُمنى طريف الخولي، نحو منهجية علمية إسلامية: توطين العلم في ثقافتنا، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 2017 .ص 15.
[3] – نفسه، ص 18.
[4] – نفسه، ص 27.
[5] – نفسه، ص27.
[6] – نفسه، ص 29.
[7] – نفسه، ص 33.
[8] – نفسه، ص 36.
[9] – نفسه، ص 44-45.
[10] – نفسه، ص 46.
[11] – نفسه، ص 61.
[12] – نفسه، 87.
[13] – نفسه، ص 93.
[14] – نفسه، 101-102.
[15] – نفسه، 121.
[16] – نفسه، ص 129.
[17] – نفسه، ص 137.
[18] – نفسه، 150.
[19] – نفسه، ص 153.
[20] – نفسه، ص 160.
[21] – نفسه، ص 175.
[22] – نفسه، ص 182-183.
[23] – نفسه، ص 190.
[24] – نفسه، ص 191.
[25] – نفسه، ص 195.
[26] – نفسه، ص 205.
[27] – نفسه، ص 211.
[28] – نفسه، ص 213.
[29] – نفسه، ص 229.