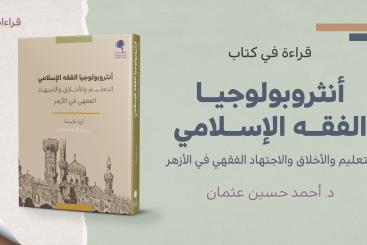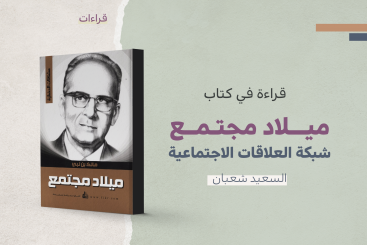-نعم ما زلت أؤمن بدور المثقف العضوي!- حوار مع المفكر الهندي بارثا تشاترجي

بارثا تشاترجي Partha Chatterjee: هو أستاذ الأنثروبولوجيا ودراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في جامعة كولومبيا، وأستاذ العلوم السياسية في مركز دراسات العلوم الاجتماعية في كلكتا بالهند. وهو منظِّر ومؤرخ سياسيٌّ حصل على الدكتوراه من جامعة روتشستر، ودرَّس في كلية الرئاسة بكلكتا. يقسم وقته بين جامعة كولومبيا ومركز دراسات العلوم الاجتماعية في كلكتا، حيث شغل منصب مدير المركز في الفترة من عام 1997 إلى عام 2007. من أهم مؤلفاته: "الأمة وشظاياها" و"الفكر القومي والعالم الاستعماري" و"أنا الشعب". وقد طلبنا إليه إجراء حوار معه بمناسبة قُرب صدور الترجمة العربية لكتابه "أنا الشعب" عن مركز نهوض للدراسات والبحوث، فأبدى ترحيبه، وكان لنا معه هذا الحوار.
١. يسعدنا أن نرحِّب بك في مركز نهوض للدراسات والبحوث. لا أدري ما إذا كانت هذه هي المقابلة الأولى التي تجريها معك جهة ثقافية عربية أم لا. لكن دعني أسألك في البداية عن علاقتك بالعالم العربي أو صورته الذهنية لديك؟ وربما يحيلنا هذا السؤال البسيط إلى سؤالٍ أكثر تعقيدًا مفاده: هل تتعامل دراسات ما بعد الاستعمار مع الدول التي خضعت للاستعمار بمنهجية واحدة؟ أعني أن تلك الدول تمتلك بعض السمات المشتركة الأساسية، ومن ثَمَّ يمكن القول إن هناك أوجه تشابه بين الهند -على سبيل المثال- وبعض دول العالم العربي التي خاضت التجربة الاستعمارية.
تشاترجي: أظن أنني أجريتُ بعض المقابلات في وقتٍ سابقٍ مع بعض الصحف والمجلات العربية، وإن كانت الذاكرة لا تسعفني في تذكُّر متى حدث ذلك على وجه التحديد. لقد زرتُ العديد من الدول العربية: لبنان، ومصر (عدَّة مرات)، والجزائر، والمغرب. وبالطبع سافرتُ أكثر من مرة عبر المطارات الإماراتية. وكان لديَّ -على مرِّ السنين- كثيرٌ من الأصدقاء والطلَّاب والزملاء الذين يعيشون في الدول العربية أو يأتون منها. ومن نافلة القول أن الروابط التاريخية والثقافية بين الهند والعالم العربي روابطُ عميقة جدًّا، من اللغة إلى الطعام إلى الموسيقى إلى السينما إلى الممارسات اليومية العادية، مع أن كثيرًا من الناس لا يدركون حتى القواسم المشتركة بين المنطقتَيْن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التجربة المشتركة التي عاشتها تلك الدول تحت الحكم الاستعماري الأوروبي هي سببٌ آخر يجعلنا كثيرًا ما نرى سماتٍ مشتركةً في العمارة والقانون وأشكال الحكومة، وما إلى ذلك. وعندما أسافر إلى الريف البنغالي، كثيرًا ما أقابل أشخاصًا يقولون إن قريبًا أو جارًا لهم "ذهب إلى الجزيرة العربية" أو "عاد من الجزيرة العربية"، وهذا يعني عادةً الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، حيث يذهب آلاف الأشخاص من الهند وباكستان وبنجلاديش للعمل.
٢. من بين اهتماماتك العديدة وكتاباتك القيِّمة، دعني أركِّز تركيزًا خاصًّا على مسألة الشعبوية populism، التي اتخذتها موضوعًا رئيسًا لكتابك الأخير "أنا الشعب"، الذي ستظهر ترجمته العربية قريبًا عن مركز نهوض للدراسات والبحوث. فاسمح لي أن ينتقل حوارنا من البسيط إلى المركَّب، ودعني أسألك: ما الشعب؟ ومَن يتحدَّث باسمه؟ وكيف تُحدَّد الهوية الشعبوية؟
تشاترجي: إن سؤال "ما الشعب؟" وكذا سؤال "من يتحدَّث باسمه؟" ليسا من الأسئلة البسيطة على الإطلاق. فهما من أصعب الأسئلة في الفلسفة السياسية. وبما أنك طلبت إليَّ أن أبدأ بمقترحاتٍ بسيطة، فدعني أقُل: إن الشعب -بالمعنى الاصطلاحي الذي نستخدمه اليوم- يتوافق مع فكرة حديثة للغاية، أي فكرة سيادة الشعب. بالطبع هناك معنًى نستعمله عندما نتحدَّث مثلًا عن الشعب العربي أو الشعب الهندي قبل ألف عام، لكن فكرة الشعب هذه لم تكن تحمل في دلالتها أيَّ إشارة إلى تشكيل سيادة الدولة. فقد نشأت هذه الفكرة في أواخر القرن الثامن عشر في فرنسا ومستعمرات المستوطنين الأوروبيين في أمريكا، حيث منح الشعب نفسَه -بعد الثورات ضد الدولة الملكيَّة- دستور دولة جديدة. هذه هي الفكرة السياسية الجديدة عن الشعب التي بدأت تنتشر في أوروبا في القرن التاسع عشر، وفي البلدان المُستعمَرة في آسيا وأفريقيا إبَّان القرن العشرين. وبصفة عامَّة، ظلَّت مسألة تعريف الشعب في وضعيَّة معيَّنة -سواء من خلال لغة مشتركة أو دين أو عِرق- مسألةً خلافيةً. ولكنَّ فكرة أن الشعب هو الأساس الشرعي الوحيد لسيادة الدولة اكتسبت صفةً عالميةً بحلول النصف الثاني من القرن العشرين.
إلَّا أن هذا ظلَّ مبدأ شكليًّا. إذ لا يعني ذلك -في الواقع- أن الشعب حكم نفسَه بنفسِه على نحوٍ مباشر. فعلى الرغم من وجود بعض النقاشات حول الديمقراطية المباشرة، حيث يُتخذ كلُّ قرارٍ حكوميٍّ بعد التشاور العام مع الشعب، فقد كان من الواضح استحالة تنفيذ الإجراءات الحكومية العملية بهذه الطريقة، خاصةً في الدول التي تضمُّ ملايين من المواطنين. ثمَّ توصل الفلاسفة الليبراليون في أوروبا إلى حلٍّ: سيختار الناس ممثليهم الذين سيضعون القوانين ويضعون السياسات نيابةً عنهم لفترة محدَّدة من الزمن، وبعد ذلك سينتخب الناس مجموعةً جديدةً من الممثلين لهم. وغالبًا ما يُنظر إلى هذا الشكل من الديمقراطية التمثيلية -حيث تتنافس الأحزاب السياسية المنظَّمة في انتخاباتٍ مفتوحةٍ لكسبِ أصوات الشعب- على أنه التعبيرُ الأكثر شرعيةً عن سيادة الشعب. لكن من المهم أن نلاحظ أنه في العديد من دول العالم التي لا تتبع الديمقراطية الليبرالية بوصفها أساسًا ينظِّم علاقة الحاكم بالمحكوم، فإن أولئك الذين في السلطة، سواء كانوا دكتاتوريين عسكريين أو قادة لأنظمة الحزب الواحد، يدَّعون -مع ذلك- أنهم يمثلون الشعب ويحكمون من خلاله. وهم يقرون أيضًا بضرورة أن تُستَمدَّ شرعيتهم من اعتراف الشعب صاحب السيادة بهم على نحوٍ ظاهرٍ ومُعلَن.
القائد الشعبوي الناجح قادرٌ على ربط العديد من المجموعات المختلفة الساخطة التي تعاني من مظالم مختلفة في تشكيلٍ واحدٍ يُسمَّى "الشعب"، الذي يُفترض أن جميع مكوناته ضحايا للنخبة الحاكمة الظالمة.
يتمسَّك القادة الشعبويون بهذا الإقرار عبر إجراء انتخاباتٍ دوريَّة والفوز بها. قد لا تكون هذه الانتخابات نزيهةً، وقد لا يُسمح للمعارضة بالعمل بحرية، لكن يجب على القائد الشعبوي أن يُثبت أنه نال أصوات الأغلبية بوصفه ممثلًا للشعب. وبهذا المعنى، فإن القادة الشعبويين اليومَ ليسوا مثل دكتاتوريي القرن العشرين الذين استغنوا استغناءً كاملًا عن الانتخابات. وهنا يصبح السؤال الجوهري هو: هل ثمة طريقة مميزة يمكن أن يبني من خلالها الزعيم الشعبوي أغلبيةً، وتكون هذه الطريقة مختلفةً عن تلك المستخدمة في الديمقراطيات الليبرالية؟ الجواب: نعم. لقد شرحتُ هذا بإسهابٍ في كتابي. وباختصار، فإن القائد الشعبوي الناجح قادرٌ على ربط العديد من المجموعات المختلفة الساخطة التي تعاني من مظالم مختلفة في تشكيلٍ واحدٍ يُسمَّى "الشعب"، الذي يُفترض أن جميع مكوناته ضحايا للنخبة الحاكمة الظالمة. إذن، هناك أُمَّة منقسمة إلى: شعب (الأغلبية) من ناحية، وعدوّه (النخبة الحاكمة) من ناحية أخرى. والقائد الشعبوي الناجح قادرٌ على إبراز هذا الانقسام من خلال الخطابة وسَرْد القصص واستعراض الصور التي تخلق هويةً عاطفيةً قويةً بينه وبين الشعب. خُذ أيَّ قائدٍ شعبويٍّ من الذين تراهم اليومَ وستجد هذا النمط حاضرًا لديه.
٣. عندما تُناقش الشعبوية في وسائل الإعلام، وهي مسألة باتت جليَّة في وقتنا الراهن، عادةً ما تُقدم دون تفسير، كما لو أن الجميع يمكنه تعريفها بالفعل؛ ما دام يُسمح لهم -على الأقل- بالاستشهاد بكل بساطة بالتطورات التي يُفترض أن تفسرها الشعبوية: بريكست، وترامب، صعود فيكتور أوربان في المجر وجايير بولسونارو في البرازيل. وغالبًا ما تبدو الشعبوية وكأنها قادمةٌ من عوالم أفلام الرعب: فيروس غريب تسلَّل بطريقة أو بأخرى عبر حصون الديمقراطية وعتباتها، وهو يعمل الآن على تسميم الحياة السياسية عبر خلق صفوفٍ جديدةٍ من الناخبين الشعبويين بيننا (من الواضح أن معظم ما يقال عن الشعبوية يفترض أن الجمهور غير متعاطفٍ معها!). فكيف يمكن أن يكون جذب الناس العاديين أمرًا سيئًا؟
تشاترجي: أولئك الذين يزعمون أن الحكومة التمثيلية الليبرالية يجب أن تكون معيار الديمقراطية ينظرون إلى الشعبوية بوصفها انحرافًا عن الديمقراطية. ولهذا يمكنك أن تلاحظ الإدانة الشاملة والسهلة لجميع أنواع القادة والحركات الشعبية عبر نَعْتهم بالشعبوية. ولكن ما لا يعترف به هؤلاء المهاجمون هو أن هناك أزمةً عميقةً في الديمقراطية الليبرالية المعاصرة هي التي خلقت الظروف للتعبير عن المطالب الشعبية من خلال التوجهات الشعبوية.
لقد نتجت هذه الأزمة أولًا: بسبب السلطة الهائلة التي تمارسها الشركات الكبرى -وخاصةً المؤسسات المالية- على الحكومات والأحزاب السياسية الرئيسة.
وثانيًا: نتيجة الاعتماد الكبير على الخبراء في صنع السياسات، الأمر الذي يعني خروج مهامَّ جوهرية من مهام الحكم عن سيطرة الممثلين المنتخبين.
وثالثًا: من خلال التقارب الكبير في السياسات بين الأحزاب السياسية الرئيسة، الأمر الذي لم يتح خياراتٍ كبيرةً أمام الناخبين.
وأخيرًا: اللامبالاة واسعة النطاق تجاه الناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت.
لقد كانت أزمة الديمقراطية الليبرالية واضحةً بالفعل في التسعينيات. إلَّا أنني مقتنعٌ بأن الأزمة المالية في 2008-2009 كانت نقطة تحوُّل ظهرت بعدها مجموعةٌ واسعةٌ من الحركات الشعبية التي نظَّمها قادة ومجموعاتٌ غير معروفة حول العديد من القضايا المتنوِّعة. لقد كان ذلك بمثابة أرضيَّة للسخط الشعبي والاضطراب التي بنى عليها القادة الشعبويون سردياتهم اليوم، لإثبات مدى ارتباطهم بالناس. ومن المستحيل تقسيم هؤلاء القادة والحركات الشعبوية إلى مجموعاتٍ واضحةٍ مثل اليمين أو اليسار من حيثُ سياساتهم؛ لأنهم لا يندرجون ضمن الأنماط التقليدية للسياسات الحزبية في القرن العشرين. ولكن لا يمكن إنكار أنهم يعبِّرون عن سخطٍ شعبيٍّ معيَّن لا يمكن تمثيلُه من قِبَل الأحزاب والقادة التقليديين.
٤. قبل أن تصبح الشعبوية موضوعًا لفتنة وسائل الإعلام، وقبل أن تصبح تفسيرًا من كلمة واحدة لأشياء عديدة، كان يدرسها مجموعة صغيرة من الأكاديميين لمعرفة ما هي بالضبط، وما الدروس التي تحملها للسياسة الديمقراطية. فهل محاولتك امتداد لمحاولاتٍ أخرى سابقة؟
تشاترجي: نعم، لقد حاولتُ في كتابي بذلَ قصارى جهدي لتحديد معايير دقيقة ودالَّة، يمكن من خلالها تمييز الحركات والأنظمة الشعبوية. وعلى وجه التحديد، استخدمت إرنستو لاكلاو، الذي أعتقد أنه حلَّل بعناية كبيرة التقنيات البلاغية التي يشكِّل الشعبويون من خلالها -من مجموعاتٍ متباينة وغير متجانسة- كيانًا يُدعى "الشعب". وتتحقَّق هذه العمليات البلاغية عبر علاماتٍ وتمثيلاتٍ ورواياتٍ لإنتاج المشاعر الجماعية التي تؤلِّف بين المجموعات السكانية في عاطفة مشتركة توحّدهم؛ مضمونها أنهم جزءٌ من شعبٍ مهضوم حقّه. ولكن لم تأخذ النظرية السياسية الليبرالية -التي كانت غارقةً في التصورات المُجردة والحجج العقلانية- دورَ تلك العواطف على محمل الجدّ. وهذا -في رأيي- هو أحد الأسباب الرئيسة للاستخدام العشوائي لمصطلح "الشعبوية" اليوم.
٥. هل تُعَدُّ الشعبوية والدعوات القومية العنصرية منتجاتٍ طبيعيةً للنيوليبرالية في الوقت الحاضر؟ وكيف يمكن معالجة صعود الشعبوية في أجزاء مختلفة من العالم؟
تشاترجي: لن أقول إنها نتاجاتٌ "طبيعية" للنيوليبرالية. ثمَّ إنَّ الشعبوية لا ترتبط دائمًا بالقومية العنصرية. فقد وُجِدت القومية العنصرية من دون الشعبوية، كما أن الشعبوية ليست بالضرورة عنصريةً. والأهمُّ من ذلك أن الشعبوية -كما نراها في أوروبا وأمريكا- قد مرَّت في وقتنا الراهن بمساراتٍ مختلفةٍ عن المسارات التي مرَّت بها في آسيا أو أفريقيا. ففي الغرب، هيأت أزمة الديمقراطية الليبرالية في مرحلة النيوليبرالية الظروفَ لظهور الشعبوية. أما في بلدٍ مثل الهند، فقد ظهرت الشعبوية داخل السياسة الانتخابية في وقتٍ سابقٍ بكثير؛ من السبعينيات. وهذا أحد الفروق الرئيسة التي حاولت أن أوضحها في كتابي. فبعض السمات -مثل تقسيم المجتمع إلى محرومين في مقابل نخبة تتمتَّع بالامتيازات كافَّة، وتوزيع المنافع على المؤيدين لتأمين أصواتهم، وبروز الزعماء الذين يُعامَلون كما لو كانوا أصحابَ سيادةٍ مطلقةٍ يُتاح لهم استخدام السلطة التعسُّفية لتحقيق العدالة للشعب- أعلنت عن نفسِها في السياسة الانتخابية في الهند منذ عدَّة عقود. وقد تحوَّلت بمرور الوقت -رغم أنها قد لا تكون ضروريةً- إلى مكوناتٍ معتادة في التنافس الانتخابي. والآن بعد ظهور تلك السمات فجأةً في قائدٍ مثل ترامب، بدأ المراقبون والمُحللون الغربيون يخوضون ويكافحون لتفسير هذا الأمر!
٦. وفقًا لشانتال موف وإرنستو لاكلاو، فإن الرابط الأصلي الوحيد بين الحركات الشعبوية اليمينية واليسارية يتمثَّل في أن كلتيهما تتبنَّى الحقيقة الأساسية نفسَها حول الديمقراطية، وهي أنَّ هناك تنافسًا دائم التحوُّل حول كيفية تعريف الـ"نحن" الافتراضية للسياسة وإعادة تعريفها، حيث لا يمكن ضمان وجود تعريفٍ واحدٍ مستقرّ. وهما يحاجّان بأن الهدف لا يجب أن يكون إجماعًا هادئًا، بل "تعدُّدية خلافية": حالة يتمُّ فيها قبول المعارضة واختلاف الآراء كقاعدة، يحتفظ الناس على أساسها بالقدرة على المعارضة بشدَّة دون أن يشيطن بعضهم بعضًا، أو الانحدار نحو الحرب. فهل تتفق مع هذا الرأي؟
تشاترجي: أرى أن تحليل لاكلاو الدلالي لكيفية ظهور زعيم أو حركة شعبية عبر تعبئة الدالِّ الفارغ أو العائم المسمَّى "الشعب" هو تحليل مفيدٌ للغاية، على الرغم من تعديلي هذا التحليل قليلًا. ومع ذلك، لا أجد حجَّة "التعدُّدية الخلافية" مقنعةً بدرجةٍ كبيرةٍ. إذ يبدو أنَّ لاكلاو يعتقد أن الحركة الشعبوية -بعد وصولها إلى السلطة- تتحوَّل بالضرورة إلى ما يُسميه المنطق التفاضلي المتمثل في تلبية المطالب لمجموعاتٍ مُستهدفة محدَّدة بشكل مستقل، ومن ثَمَّ تتضاءل جاذبيتها الشعبية. وقد قدَّم مثالًا على ذلك ما حدث مع البيرونية() وبعض حركات التحرير في أفريقيا.
من الممكن أن أفهم لماذا يمكن للشعبوية اليسارية أن تجلب منافعَ مهمَّة للفقراء والمُهمَّشين، ولكن لا أتفق معها في قدرتهم على إحداث تحوُّل في بنية السلطة.
وأعتقد أنه لم ينجح في ملاحظة قدرة الأنظمة الشعبوية على تغيير محتوى الدالَّة التي تُدعى "الشعب" للتعامل مع الأوضاع الانتخابية المتغيرة، وإن ظلَّت في الوقت ذاته محتفظةً بالصورة الشعبوية نفسِها. فقد تمكَّنت بعض الأحزاب الشعبوية في الهند -على سبيل المثال- من القيام بذلك على مدى عدَّة عقود، سواء في الوقت الذي كانت فيه داخل السلطة أو خارجها أو حتى مع تغيُّر القيادة. ليس ذلك فحسب، بل يمكننا أن نلاحظ بسهولة أن حزبًا شعبويًّا ما يجابه تحديًا من حزبٍ شعبويٍّ آخر، بحيث يظهر مع الوقت نظامٌ انتخابيٌّ قائمٌ على شعبوياتٍ متنافسة. وأعتقد أن لاكلاو وموف قد قلَّلا من إمكانية وجود ديمقراطية انتخابية في ظلِّ وجود انقساماتٍ شديدة الاستقطاب. فقد لا تكون النتائج مقبولة دائمًا، ولكن يجب أن يكون هناك منطقٌ ديمقراطيٌّ ما. وفي الآونة الأخيرة، عدَّلت موف حُجَّتَها حول "التعدُّدية الخلافية" للدفاع عن الشعبوية اليسارية. ومن الممكن أن أفهم لماذا يمكن للشعبوية اليسارية -دعنا نقُل تحت حكم شافيز أو لولا أو موراليس على سبيل المثال- أن تجلب منافعَ مهمَّة للفقراء والمُهمَّشين، ولكن لا أتفق معها في قدرتهم على إحداث تحوُّل في بنية السلطة. فلا تزال الشعبوية -حتى عندما تكون مدفوعةً بأيديولوجيا يسارية- مُلزَمةً ضمن الحدود التكتيكية بالفوز في الانتخابات والحفاظ على مصادر الإيرادات لتوزيع المنافع. ولهذا السبب رأينا الخسارة الأخيرة في شعبية هذه الأنظمة وانهيارها بعد ذلك.
٧. اصطبغت المناقشة الحالية حول الشعبوية في الغرب بخطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة الشعبوية التي ظهرت في أوروبا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، مثل حزب الحرية النمساوي وحزب الشعب الدنماركي والجبهة الوطنية الفرنسية. وما عرفه معظم الناس عن هذه الأحزاب -في البداية- هو نزعاتهم العنصرية والعرقية الصريحة. فقد كان خطاب هذه الأحزاب يؤكِّد على وجود مواطنين "أصليين"، ويدافع عن "النقاء" القومي والإثني، ويشيطن المهاجرين والأقليات في المقابل. وقد غازل العديد من قادة أحزابهم فكرة معاداة السامية، وتزامنت انتصاراتهم الانتخابية مع عودة العنف اليميني المتطرف في أوروبا، مثل هجوم عام 1991م على العمَّال المهاجرين وطالبي اللجوء في مدينة هويرزفيردا في شرق ألمانيا. فهل يعني هذا أن الشعبوية هي في الأساس أيديولوجيا أم أنها سياسة؟ وهل الشعبوية مرتبطة بالأحزاب اليمينية فقط؟
تشاترجي: ظهرت الأحزاب اليمينية التي ذكرتها في الثمانينيات والتسعينيات بشكلٍ رئيسٍ للتعبير عن مظالم القطاعات التي شعرت بأنها مستبعدةٌ من النمو الناتج عن الوحدة الأوروبية والاقتصاد المعولم. لكن هذه الأحزاب كانت هامشيةً في السياسة الانتخابية، ومثَّلت آراء سياسية متطرفة. وقد تغيَّرت الظروف مع العقد الأول من الألفية الجديدة، خاصةً بعد الأزمة المالية 2008-2009. فقد كان النمو مهددًا، كما شعرت قطاعاتٌ كبيرةٌ من الناس بالتفاوت الطبقي على نحوٍ أكثر حدةً بكثيرٍ من ذي قبل. هذه هي الأرضية التي بدأت الحركات الشعبوية بالظهور منها خارج نطاق الأحزاب السياسية الرئيسة. فلم يكن جميعهم من اليمينيين والعنصريين والمعادين للمهاجرين. فقد كان هناك سيريزا Syriza وبوديموس Podemos في أوروبا، وحركات "احتلوا" Occupy movements في الولايات المتحدة.
هل الشعبوية أيديولوجيا أم سياسة؟ أعتقد أنك تشير إلى ادعاء لاكلاو أن الشعبوية هي العلَّة الأصيلة للسياسة نفسِها، وهو ادعاء لا أقبله. فعلى العكس، وصفتُ الشعبوية في كتابي بأنها تمتلك بُعْدًا حوكميًّا وأيديولوجيًّا. فقد يكون المحتوى المحدَّد لهذه الشعبوية مختلفًا. ومن ثَمَّ قد يكون لكلِّ نظامٍ شعبويٍّ قائمةٌ خاصَّة به (ومتغيِّرة) للمنافع الحكومية التي يجب منحها لـ "الشعب"، تمامًا كما يمكن أن يكون له تحديده الثقافي الخاص لمن ينتمي إلى "الشعب" ولمن هو "العدو". إلَّا أن ما هو مشترك بينها هو الأسلوب الخطابي أو العلاماتي (السيميوطيقي) المميز لتشكيل شعبٍ من مجموعاتٍ غير متجانسة.
٨. يتفق بعض المتخصِّصين الآن على أن الشعبوية طريقة أيديولوجية للنظر إلى السياسة بوصفها ميدانًا للصراع بين "الشعب" و"النُّخب". ويخلق هذا التعريف المزيد من الأسئلة: هل "الشعب" كما تعرِّفه الشعبوية محدَّد بطبيعته بطريقة تشكِّل خطرًا على التعايش التعدُّدي؟ أو -إذا حاولنا أن نقلِّل من هذا الخطر- هل "الشعب" مفهوم ضروريٌّ ولكنه قابل للتطويع المستمر، أي إنه جزءٌ من ممارسة السياسة؟
تشاترجي: أعتقد أنني قدَّمت في إجاباتي السابقة بالفعل إشاراتٍ إلى هذا. فالمضمون الذي يتمُّ إدراجه داخل فئة "الشعب" أو "النخبة" يختلف من حركةٍ إلى أخرى أو من نظامٍ شعبويٍّ إلى آخر، بل إنه يتغيَّر داخل الحركة الشعبوية نفسها -كما تُظهر بعض الأحزاب الهندية- من وقتٍ إلى آخر. لكن الشعبوية ليست الطريقة الوحيدة لممارسة السياسة. فقد كانت هناك ولا تزال حركات وأحزاب وسياسات غير شعبوية. ومن الصعب الإجابة عن ما إذا كانت الشعبوية تهدِّد التعايش التعدُّدي بالضرورة أم لا. إذ يبدو أن معظم نماذج الحركات الشعبوية في الغرب تناصر الهويات الثقافية الحصرية وترفض التعدُّدية. ولكن مرة أخرى، لا يتوافق بوديموس في إسبانيا أو سريزا في اليونان أو حركة النجوم الخمسة [في إيطاليا] مع هذا التوجُّه.
وفي الهند، يدَّعي مودي Modi من حزب بهاراتيا جاناتا BJP تمثيل الأمة الهندوسية، ويشيطن المسلمين في المقابل؛ لكن لديك أيضًا قادة وحركات شعبوية أخرى -في المقابل- تعرّف "الشعب" بأنه الذي يحوي بداخله هوياتٍ دينية وثقافية مختلفة، وتعرّف "العدو" بأنه الذي يحاول تقسيم الناس على أساس الدين. وإذا نظر المرء إلى السياسة الهندية، فقد يجادل بأن الجانب الحكومي من الشعبوية -المتمثل في توزيع المنافع على الشعب- هو شكل عالميٌّ في السياسة الانتخابية بصفة عامَّة لدرجة أنه لم يعُد علامة دالَّة على الشعبوية دون غيرها، ومن ثَمَّ فلا يمكن استخدامه في تمييز الشعبوية عن أيِّ شيء آخر. ولكن فيما يتعلَّق بالجانب الأيديولوجي، هناك أنواع مختلفة من الشعبوية، تمامًا كما يمكن أن تكون هناك أحزابٌ وحركاتٌ غير شعبوية على الإطلاق؛ لأنها لا تسعى إلى تمييز الحدود بين الشعب وعدوِّه.
٩. سوف يلاحظ قارئ كتابيك "الفكر القومي والعالم الاستعماري" و"أنا الشعب" تشاؤمًا سياسيًّا قويًّا، وخاصةً في الجزء الختامي. وعلى الرغم من محاولتك معالجة هذا الأمر بفكرة "تفاؤل العقل" في كتابك الأخير، فإن الروح التشاؤمية تظلُّ هي الغالبة، فهل يعني هذا أنك فقدت إيمانك بدور المثقف في مواجهة بؤس العالم؛ المثقف العضوي على وجه التحديد؟ وإذا كنت ما زلت مؤمنًا به فما هي أدواته؟ وكيف يصمد أمام الآلة الوحشية للشعبوية؟
تشاترجي: لم أفكر قطُّ في أن تحليلي للقومية كان متشائمًا، وفوجئت حقًّا عندما قيل لي إن تحليلي للشعبوية متشائمٌ أيضًا. أفكِّر الآن في هذا وأدرك أنه عندما أحاول تقديم تحليلٍ نقديٍّ لظاهرة سياسية، أحرص على الحفاظ على مسافةٍ ما من تلك الظاهرة. وهذا يعني أنني أحاول ألَّا أجعل تحليلي وموقفي من السياسة جزءًا من تلك السياسة. وذلك لا يعني أن طريقة التحليل النقدي هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها مقاربة السياسي. لقد انخرطت في السياسة، وما زلت أفعل ذلك بعدَّة طرق، بصفتي ناشطًا ومنظمًا ومواطنًا، ولا أشعر في هذه الأدوار بأنني بحاجة إلى تحديد مسافة تفصلني عن المجال السياسي المباشر.
المطلوب هو الإبداع والابتكار، لا في الأفكار فقط، ولكن في طرق الاقتراب من الناس أيضًا.
نعم، إنني أؤمن بدور المثقفين العضويين الذين يضعون الأساس للتحوُّل الاجتماعي والسياسي. وأعلم أنه من الصعب الحفاظ على هذا الاعتقاد في هذه الفترة التاريخية التي نعيشها، عندما يبدو أن اليسار لديه القليل من الإجابات الإبداعية لمشكلات اليوم، باستثناء الأمل في ألَّا تتعرَّض البنى القائمة للمزيد من الضرر. وفي الواقع، يبدو أن الأحزاب والقادة اليمينيين لديهم أفكارٌ أكثر راديكاليةً بكثير وشجاعةٌ أكبر بكثيرٍ لتنفيذها. أعتقد أننا ننسى -في كثيرٍ من الأحيان- أن مثقفي اليمين -سواء كانوا اقتصاديين نيوليبراليين أو معلِّقين محافظين أو أيديولوجيين دينيين- قد عملوا بصبرٍ وفعاليةٍ لعقودٍ عديدةٍ داخل المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الثقافية لتشكيل آراء وممارسات الناس الذين يتقبلون الآن تلك الأفكار اليمينية بأريحية كاملة. ولا يوجد سبب يمنع اليساريين من فعل الشيء نفسه الآن، خاصةً مع ملاحظة أن الوضع الراهن يعيش أزمةً عميقةً لا تخفى على الناظر. والمطلوب هو الإبداع والابتكار، لا في الأفكار فقط، ولكن في طرق الاقتراب من الناس أيضًا. وأعتقد أنه من الأهمية بمكانٍ أن نستخدم وسائل التكنولوجيا الرقمية الجديدة في وسائل التواصل استخدامًا إبداعيًّا. لقد فكَّرنا -خاصةً أبناء جيلي- في المثقفين العضويين بوصفهم أشخاصًا تحيط بهم الكتب من كل جانب، ويكتبون المقالات في الصحف، ويلقون المحاضرات العامَّة. إلَّا أن المثقفين العضويين من الجيل التالي يجب عليهم أن يقاربوا مهمتهم مقاربةً مختلفةً تمامًا.
١٠. ربما سيشعر قارئ كتابك "الفكر القومي والعالم الاستعماري" بأنك من دعاة الحتمية التاريخية، فهل هذا صحيح؟
تشاترجي: لا، بل أنا على العكس تمامًا. وفي الواقع، إن أحد الأسباب الرئيسة لإعجابي المتواصل بأنطونيو غرامشي هو رغبته -وهو الماركسي- في أن يأخذ تفرُّد الحدث السياسي بجديَّة باعتباره متميزًا في موقعه ضمن بنية أُنتجت تاريخيًّا. فمن الممكن أن يكشف تحليل البنى عن ديناميكية ضمنية أو يفسّر ذلك بنزعة تاريخية ثاوية خلفه. ولكن الفعل السياسي لإنتاج حدثٍ سياسيٍّ حاسمٍ يمكن أن يغيّر هذه البنى ويفتح مساراتٍ جديدةً من التطور التاريخي لم يكن من الممكن توقُّعها. ولهذا السبب شعرتُ دائمًا أنه من الواجب علينا أن نزاوج بين التحليل النظري للمفاهيم السياسية ودراسة الأحداث التاريخية بمساعدة المواد الأرشيفية، وبين التناول الإثنوغرافي للممارسات المعاصرة.
١١. ومع ذلك، نجد في كتابك "الأمة وشظاياها" تحليلًا قويًّا للممارسات السياسية اليومية التي قد تتعارض مع فكرة القانون الكُليّ أو الوحدة المفاهيمية الشاملة.
تشاترجي: هناك فرق مثير للاهتمام بين الكتابَيْن. ففي أوائل الثمانينيات، تأثرت تأثرًا قويًّا بالماركسية البنيوية وخطَّطت لكتابة تاريخٍ من ثلاثة أجزاء عن التحوُّل الذي حدث في البنغال في العقود الأخيرة من الحكم الاستعماري البريطاني. وكتبت الجزء الأول بالفعل عن الاقتصاد الزراعي. وكنت أخطط أن يكون الثاني عن السياسة، وهو ما عملت لأجله على تحليل العديد من الأعمال الأرشيفية. ولكن من أجل تأطير تحليلي البنيوي، كنتُ بحاجة إلى تقديم وصفٍ لأيديولوجيا السياسة القومية. وقد أفضى بي ذلك إلى الفكر القومي والعالم الاستعماري، الذي انتهى به المطاف ليكون تاريخًا فكريًّا لثلاثة مفكرين مرجعيين. وقد أظهر لي هذا التمرين حدود التاريخ الفكري بوصفه نافذةً للتاريخ الفعلي للأحداث السياسية؛ لأنه لم يتجاهل أصواتَ الناس العاديين الذين شاركوا في السياسة الجماهيرية وأفكارَهم فحسب، بل لأنه لم يقدِّم رؤى حول تطوُّر الأحداث التاريخية أيضًا. وهذا هو السبب في أن كتاب "الأمة وشظاياها" مختلفٌ للغاية، فإنه ليس مرتبطًا بالعالم المفاهيمي للتاريخ الفكري.
١٢. تذكر حالة الاستثناء في كتاباتك المختلفة، وهي الحالة التي تغفل فيها الحكومات بعضَ الانتهاكات القانونية التي يرتكبها بعض الأفراد داخل المجتمع. وهي تتلاعب بهذا الوضع من أجل تحقيق غاياتٍ سياسية، ولكن هل ينطبق هذا الشكل من الاستثناء أيضًا على الديمقراطيات الغربية، أم أنه مقتصرٌ على مجتمعات ما بعد الاستعمار فقط؟
تشاترجي: على الرغم من إنكار وجودها، فإن أشكال ما أسميه المجتمع السياسي -حيث يتمُّ التفاوض على الاستثناءات- موجودةٌ في الديمقراطيات الغربية أيضًا. فكِّر في كيفية حكم السكان المهاجرين وإدارتهم في هذه البلدان. فهم في الغالب ليسوا مواطنين، وقد لا يكون لديهم وضع قانوني شرعي، ويعيشون في مجتمعاتٍ منعزلة، ولا يندمجون في الثقافة القومية مثلما فعل المهاجرون الأوائل. ومع ذلك، لا يتعرضون للطرد من البلاد؛ لأنهم غالبًا ما يقومون بعملٍ ضروريٍّ منخفض الأَجْر لا يمكن للمواطنين الأصليين القيام به؛ لذا فهم محكومون على أساس كونهم سكانًا استثنائيين وليسوا مواطنين كاملي المواطنة. ويحدث التفاوض حول احتياجاتهم والتزاماتهم من خلال ممثلي المجتمع. ومثل هذه القطاعات في العديد من البلدان الغربية صغيرة ومتناثرة، لكنها ليست ضئيلةً في المجمل. أما الشكل الأكثر وضوحًا من هذه الحالات فهو موجود في دول الخليج بطبيعة الحال، حيث تتكوَّن غالبية السكَّان العاملين -الذين يُحكمَون على أنهم سكان استثنائيون- من غير المواطنين الأصليين.
١٣. بالإضافة إلى غرامشي وفوكو وليفي شتراوس، دعني أسألك عن التأثيرات الفكرية الأخرى التي شكَّلت عمل دراسات التابع Subaltern Studies على العموم، وعملك على الخصوص.
تشاترجي: كان هناك ما يقرب من اثني عشر عضوًا في مجموعة دراسات التابع، وقد استمدَّ كلٌّ منهم مقاربته من مصادر فكرية مختلفة. وكان معظم الأعضاء الأوائل من المؤرخين الممارسين الذين تأثَّروا تأثُّرًا شديدًا بالمؤرخين الماركسيين البريطانيين مثل كريستوفر هيل Christopher Hill وإي بي طومسون E. P. Thompson، وكذلك بمؤرخي مدرسة أناليس Annales مثل إيمانويل لو روي لادوري Emmanuel Le Roy Ladurie. وقد انجذب آخرون إلى التوجُّهات الهرمنيوطيقية لهايدغر. وفي وقتٍ لاحقٍ، جاء تأثير فلاسفة ما بعد الحداثة مثل دريدا Derrida ودولوز Deleuze، والنقاشات التي دارت داخل الحركة النسوية. وقد انجذب بعضنا أيضًا انجذابًا قويًّا إلى أفكار غاندي عن اللاعنف. أما أنا فقد تغلَّبت على إغواء النظرية البنيوية، وكافحتُ من أجل إيجاد علاقة تربط التشابكات السياسية لغرامشي بالقوى التاريخية وتحليلات فوكو للسلطة الحديثة. وقبل هذا، منذ أن كنت يافعًا، احتفظت دائمًا باهتمامٍ دائمٍ بماركس. وهناك أيضًا مجموعة كاملة من الأعمال الأدبية والفلسفية البنغالية التي ترعرعت معها، وهي جزء رئيس من عالمي الفكري. وهذا جانب غير واضحٍ لأولئك الذين قرؤوا كتاباتي الإنجليزية.
١٤. كان مفهوم غرامشي عن حرب المواقع war of positions حاضرًا بقوة في عملك، فما مدى جدارته على أرض الواقع؟ ودعني أذكر مثالًا متشككًا: في أعقاب "الثورة" المصرية عام 2011م، حدث تبادل في المواقع بين الحكم العسكري الذي استمرَّ في الحكم ستة عقود، وبين الإخوان المسلمين الذين سعوا إلى الوصول للحكم طوال هذه المدَّة أيضًا، حيث جاء الإخوان المسلمون إلى السلطة، ثم أُطيح بهم بعد عامٍ واحدٍ من قِبل النظام نفسه! أَلَا يعني هذا أن النصر في حرب المواقع سيكون حليفًا دائمًا للطرف الأقوى والأكثر نفوذًا داخل السلطة؟ أليس هذا معناه أن الأنظمة الراسخة هي التي ستخرج منتصرةً دائمًا ولو بعد حين؟
تشاترجي: إن حرب المواقع -مثل حرب المناورة- مفهوم استراتيجيٌّ للحرب. ويمكن أن تؤدي حرب المناورة إلى ثورة، كالتي حدثت في مصر عام 1952م، والتي أنشأت نظامًا استمرَّ لعقود. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي حرب المواقع إلى وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، ليتمَّ إسقاطهم في غضون عام! وهذا لا يعني أن حرب المناورة كانت ناجحةً دائمًا؛ لأن هناك العديد من الحالات في التاريخ التي فشل فيها الاستيلاء الثوري على السلطة. ولا يعني ذلك أيضًا أن حرب المواقع لم تنجح أبدًا. فقد حدَّد غرامشي نفسه حركة غاندي في الهند بوصفها مناورةً جزئيةً. وأعتقد أنه كان على صواب، وعلى الرغم من أنه لم يعش ليرى ما آلت إليه، فإن حركة غاندي قد أفضت في النهاية إلى ظهور دولة قومية جديدة لديها دستور ديمقراطي، ومع ذلك حافظت على العديد من المؤسسات الرئيسة للدولة الاستعمارية. وأعتقد أنه على عكس الاعتقاد السائد بين الشيوعيين في زمن غرامشي بأن أزمة الرأسمالية الحتمية ستخلق الظروف لحرب مناورة سريعة تؤدي إلى تغييرٍ ثوريٍّ للسلطة، فإن تحوُّل المجتمع الرأسمالي يمكن أن يكون بطيئًا وجزئيًّا فقط من خلال تغييراتٍ مُضنية في المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويمكن أن تتسارع الوتيرة في بعض الأحيان نتيجة الأحداث التاريخية، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة مع حركة الحقوق المدنية أو حرب فيتنام أو -على ما أظن- حركة حياة السود مهمَّة Black Lives Matter الحاليَّة. لكن المؤسسات البرجوازية في الغرب لديها من المرونة ما يحول دون تبدُّلها تبدلًا كاملًا عبر "هجوم مفاجئ".
إلَّا أن الوضع يختلف في بقاعٍ أخرى من العالم. فعلى الرغم من أن رأس المال قد يكون مهيمنًا في كل مكانٍ تقريبًا، فإنه لا يمتلك بالضرورة وجودًا مؤسسيًّا قويًّا في قلب كل مجتمع. إن إمكانيات المناورة الاستراتيجية قائمة بالفعل. وفي الواقع، نرى الانقلابات والاستيلاء على السلطة من وقتٍ لآخر. لكن هذا التغيير يمكن أن يسير في اتجاه تقدُّمي أو رجعي على السواء. وعلى عكس الوضع الذي كان قائمًا في القرن العشرين، لا أعتقد أن ثمة حركةً ديمقراطيةً ذات شعبيةٍ قويةٍ يمكن أن تعتمد كليًّا على حرب المناورة. ويجب أن تكون الاستراتيجية الرئيسة -كما وصفها غرامشي- هي استراتيجية حرب الخنادق داخل شبكة المؤسسات الاجتماعية، والحركة البطيئة التدريجية نحو أُفقٍ من الأهداف السياسية القابلة للإنجاز، التي تَعِد بمزيدٍ من المساواة وبمزيدٍ من الحقوق القيِّمة والحياة الكريمة.