سوسيولوجيا الإسلام: الـمعرفة والسُّلطة والـمدنيَّة
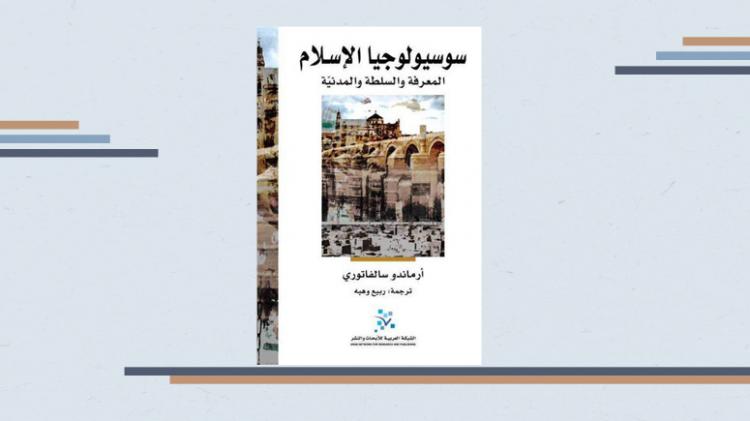
عندما أصدر برايان أس ترنر (Bryan S. Turner) كتابه الرَّائد: "فيبر والإسلام"، في سبعينيات القرن الـماضي، إضافة إلى تعليقاته القيمة على ثلاثية مارشال هودجسون (Marshall Hodgoson) البارزة: "مُغامرة الإسلام" (The Venture of Islam)، لم يكن يتصور أنه وضع بذلك أسس التَّعامل مع موضوع سوسيولوجيا الإسلام، الذي تعاظم الاهتمام به من بعد في تسعينيات القرن الـماضي؛ خاصة لدى مؤلِّف هذا الكتاب؛ الباحث الإيطالي أرماندو سالفاتوري، والذي يعدُّ بمثابة الـجزء الأول من مشروع طويل الأمد، كتمهيد لما يتبعه لاحقًا من إصدار جزأين لاحقين. وكان سالفاتوري قد أنجز أطروحته للدكتوراه، والتي بدأها عام 1991 إلى أن نشرها في كتاب بعنوان: "الإسلام والـخطاب السياسي في الـحداثة"، عام 1997.

مغامرة الإسلام
والـحال أنَّ الدِّراسات الـمُتعلقة بهذا الـموضوع، غربيًّا، كانت لا تزال هشَّة مُعتمدة على إسهامات مُتفرِّقة وجهود تعاون مُتقطِّعة في الأوساط الأكاديمية إبَّان حقبة التسعينيات من القرن العشرين. وكانت حولية "سوسيولوجيا الإسلام"، التي انتشرت فيما بين عامي 1988 و 2008، وأطلقها جورج شتاوت، بمثابة وسيلة لربط السِّياق السوسيولوجي لدراسة الإسلام مع برنامج البحث الرئيس، الذي حاول علم الاجتماع عن طريقه نزعَ صفة التبعية الرّعوية عنه؛ وذلك بالفكاك من قبضة الافتراضات الغربية الرائجة بين أوساط الـمستشرقين بصفة خاصة.
على أنَّ الـمُنعطف الرئيس تمثَّل في عقد "الـجمعية السوسيولوجية الألمانية" مؤتمرًا دوليًّا حول: "سوسيولوجيا الإسلام: تأمُّلات، ومُراجعة، وإعادة توجيه"، في يونيو/ حزيران 2015، حيث استعرض فيه برايان ترنر حصادَ أربعين سنة من التطور الذي اعترى هذا الـمجال. وبدا واضحًا آنذاك أنَّ اعتماد سوسيولوجيا ممكنة للإسلام قد أصبح مطلبًا مُلِحًّا؛ خاصة وأنَّ هذا الـحقل الدِّراسيَّ نشأ في سبعينيات القرن الـماضي بالتوازي مع نقد الاستشراق، وتلقّى دفعة كبيرة بعد أحداث الـحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، جنبًا إلى جنب، مع مُحاولات أكاديمية أخرى تتعامل والإسلام من زاوية الـحداثة.
سوسيولوجيا الإسلام في سياق تاريخي
في هذا الكتاب، أو بالأحرى الـجزء التمهيدي من مشروع سالفاتوري، يتتبَّع الـمؤلف روابط الدين والـمدنية، ويتبنَّى منظورًا يجمع بين كلٍّ من التَّاريخيِّ والنظريِّ والـمقارن، في الوقت الذي يتمتَّع بتشابُكات رئيسة تأخذ بحدود الـمُقارنة الكلاسيكية إلى الأمام.
وتبعًا لذلك؛ يتوجَّه الكتاب أساسًا إلى النوع نفسه من الـجمهور، والنّقاشات الـموضوعية التي أدَّت إلى وجوده. ولهذا تضع الـمقدِّمة/الـجزء الأول موضوع "سوسيولوجيا الإسلام" في سياقه التَّاريخي والتَّخصُّصي، فيما من الـمُقرَّر أن يضطلع الـجزءان التاليان إلى حقبة الفترات الوسطى (Middle Periods)؛ وتحديدًا أواسط القرن العاشر إلى أواسط القرن الـخامس عشر الـميلادي/ أواسط القرن الرابع إلى أواسط القرن التاسع الـهجري، ثمَّ حقبة العصر الـحديث وأواخر الـمرحلة الكولونيالية.
من جهة أخرى، يتحرَّك الكتاب على جبهتين أساسيتين تحكُمان بنيته الدَّاخلية، ومن ثمَّ سياقاته الـمنهجية. تتمثَّل الـجبهة الأولى في مواجهة الـمركزية الغربية القائمة على استثنائية الغرب من جهة، ومعياريته في أية مقارنة تاريخية من جهة أخرى. وفي هذا السِّياق يُمثِّل ماكس فيبر (Max Weber)، الـمُنطلق الرئيس لنقد هذا الإطار الـمرجعي.
التحدّي الـمبدئي الذي طرحته دراسة الإسلام أمام التَّصنيفات السُّوسيولوجية الـمُتصلِّبة، بما في ذلك الـحداثة، قد مكَّنت تيارًا واسعًا من التخصُّصات الأكاديمية لدراسة مُقارنة الأديان والثقافات والـحضارات.
فالغرب، بحسب الـمركزية الغربية، يمتاز ببنيته الـمؤسساتية وعقلانيته، اللتين تُفسَّران ضمن نسق تاريخي غائي يُرسِّخ فكرةَ امتياز الغرب عن الآخرين، ومن ثمَّ؛ فإنَّ كلَّ محاولة لفهم الإسلام تنطلقُ في الأساس من تصوُّر الغرب عن نفسه، وعليه تُصبح الأسئلة من نوع: لماذا لم ينجح الإسلامُ في التّلاؤم مع الـحداثة أو الدِّيمقراطية أو العلمانية؟ هي الغالبة على أية مُقاربة غربية للإسلام؛ الأمر ما يرفضه سالفاتوري بطبيعة الـحال، ساعيًا في الـمقابل من ذلك- وهنا ينتقل إلى الـجبهة الثانية – إلى تقديم "سوسيولوجيا للإسلام" مُستقلَّة ومتحرِّرة من الإرث الأكاديمي الغربيِّ بكلِّ ما يحمله من الفرضيات الـمُتضمّنة للمركزية الغربية. والـحال أنَّ التحدّي الـمبدئي الذي طرحته دراسة الإسلام أمام التَّصنيفات السُّوسيولوجية الـمُتصلِّبة، بما في ذلك الـحداثة، قد مكَّنت تيارًا واسعًا من التخصُّصات الأكاديمية لدراسة مُقارنة الأديان والثقافات والـحضارات. وفي هذا السِّياق رتَّبوا الإسلامَ بوصفه نموذجًا مُضادًّا للحداثة الغربية التي روّضت سُلطة التقاليد الدِّينية وكيَّفتْها.
حدث ذلك قبل صعود علم الاجتماع الذي لم ير النُّور كتخصُّص معرفيٍّ إلا فيما بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، غير أنه ورث الرُّؤية الـمُنحازة ضدَّ الإسلام؛ نظرًا لاعتماده – بحُكم أنَّه تخصُّص معرفي جديد – على نتائج وأفكار التخصُّصات اللغوية والنَّصية والتاريخية. وهذا ما ظهر جليًّا بصفة خاصة في الـحالة الألمانية، التي شهدت أيضًا دورًا مُتواصلًا للفلاسفة في رسْم خريطة العلاقات العالمية بين التّقاليد الثقافية والدِّينية.
لكن على الرُّغم من ذلك؛ فإنَّ الفكرة القائلة بعدم مُلائمة الإسلام والـحداثة لم يكن مقدّرًا لها أن تصمد بمجرد أن تولَّى علمُ الاجتماع زمامَ الأمور. غير أنَّ تطبيع الإسلام الكامل وتطويعه ضمن ما هو "معياريٌّ سوسيولوجيًّا" لم يفلح كذلك. فقد أصرَّ الإسلام أن يظلَّ قوة قادرة دائمًا على زعْزعة طموحات علم الاجتماع التي لم يتخلَّ عنها قط في تفسير عوامل التّحوُّلات الاجتماعية وعوائقها والتماسُك الاجتماعيِّ على الـمستوى العالَمي.
والـحال أنَّ محاولات إدخال تنوع الإسلام في الـمسائل والنماذج السوسيولوجية تتحوّل بدورها إلى وسيلة نافذة في تجديد الطموحات العالمية التي لم تُنجز قط، فقد وُلد علمُ اجتماع الإسلام عبر الطريقة ذاتها التي ربط بها ترْنر دراسةَ الإسلام التَّاريخية بالـمسائل الـمتقاطعة الرئيسة التي ورثها مؤسِّسو علم الاجتماع وتركوها من دون حلٍّ.
إنَّ تفكيك التَّصنيفات الغربية تفكيكًا جذريًّا غالبًا ما يقودُنا مباشرة إلى إلغاء مركزية السُّلطة مع ما يرتبط بها من إنتاج الـمعرفة، من دون التَّشكيك فيما إذا كان مثل هذا التفكيك يتحدَّى فعليًّا مفاهيم الـمعرفة والسُّلطة نفسها، أو الإفصاح عن مُعادلة الـمعرفة- السُّلطة في رؤيتها من منظور الـهيمنة الغربية.
بالنظر إلى التَّقاليد الثقافية والدِّينية، ينبغي أن نفكِّر مليًّا في الآليات التي تُحصِّن مُمارسيها من رؤية السُّلطة كنهايةٍ لفعلٍ اجتماعيٍّ في حدِّ ذاته.
ولا شكَّ في أنَّ من ميزات هذا الكتاب، أنّه لا يتعامل مع "سوسيولوجيا الإسلام" بوصفه دينًا محدَّدًا؛ وإنَّما يسعى إلى استكشاف طريقة تفاعُل كلٍّ من الـمعرفة والسلطة في تشكيل التّقاليد الإسلامية وتحوُّلاتها عبر أنماط النّزعة الاجتماعية والآداب، والـمدنية التي تتجمَّع في أشكالٍ مؤسَّساتية يغلبُ عليها طابع الـمُرونة. وبهذه الطَّريقة يمكننا أن نستكشف أنماطَ بناء العالَم الاجتماعيِّ الثقافيِّ بوصفها إحدى السِّمات الرئيسة التي لا يمكن إنكارُها لأي شيء نُسمّيه دينًا. وتبعًا لذلك؛ ينظر مؤلِّف الكتاب إلى "الـمدنية" بوصفها مُحرِّكًا لمعادلة الـمعرفة – السُّلطة في الإسلام. فبالنظر إلى التَّقاليد الثقافية والدِّينية، ينبغي أن نفكِّر مليًّا في الآليات التي تُحصِّن مُمارسيها من رؤية السُّلطة كنهايةٍ لفعلٍ اجتماعيٍّ في حدِّ ذاته؛ وذلك عبر مجموعةٍ من التحوُّلات والاستيعاب، وبالتالي؛ فإنَّ النظر إلى الـمدنية على أنها مُحصِّلة رئيسة من محصِّلات معادلة الـمعرفة – السُّلطة، هي مسألة أساسية في سياق الـحديث عن "سوسيولوجيا الإسلام".
فالتّفاعُل بين هذه العناصر الثلاثة: (الـمعرفة، السُّلطة، الـمدنية) لا يعكسُ تمييزًا مبدئيًّا بين ما هو دينيٌّ وما هو اجتماعي فحسب، بقدر ما يكون الدِّين ليس عبارة عن مجرد مجموعة من الـمؤسَّسات الـمُحدَّدة؛ بل يشكِّلُ أساسًا مصفوفةً ما وراءَ مُؤسَّساتية.
سوسيولوجيا الطُّرُقية الصُّوفية
في إطار حديثه عن تجلِّيات الـمدنية في السِّياق الإسلاميِّ، يؤكِّد الـمؤلِّف حقيقة أنَّ الإسلام حقَّق النُّضج لتركيبةٍ طويلة الـمدى، من الـمساواة والكونية الكامنتيْن في الـحضارة الإيرانية السَّامية، فضلًا عن مدى تثمين الإسلام أيضًا لمكوّنات التُّراث الإغريقيِّ والـهلينيِّ، الرئيسة. فنموذج الإسلام/ العالَم الإسلامي الـمرِن عند هودجسون، ليس نموذجًا ثنائيًّا يُضاهي دينًا مُتصلِّبًا مع حضارة مُتخندقة على الذات؛ بل هو بالأحْرى توليفة من تقاليد ثقافية ودينية متعدِّدة، نشأت داخل حدود الـحضارات القديمة؛ بل وتجاوزتها.
وبشكل عام، ترتبط فكرة الـمدنية بين الـمعرفة والسُّلطة، وتُوازِن بينهما، واضعةً الـمقدرةَ الابتكارية والتبلورَ الـمؤسَّسيَّ بعضها مقابل بعض. ففي مسار ما بعد الـحادي عشر من سبتمبر/أيلول، في العالم ذي الأغلبية الـمسلمة، وصولًا إلى الرَّبيع العربيِّ؛ فإنَّ مدى احتمال تيسير أفكار الـمدنية وممارستها في التحوُّلات الدِّيمقراطية، أصبح موضوعًا لإعادة التقييم.
حاول كثيرٌ من العلماء الغربيين، منذ القرن التاسع عشر، قَصْرَ الصُّوفية على أنَّها مُكوِّن غريبٌ في/عن الإسلام؛ بل والتكهُّن حتَّى من دون تقديم دليل مُتراكمٍ على أنَّ أصلها من مصادر خارج الإسلام!
فلكي نفهم جيدًا التأثيرات الـمُتباينة لمجرد التمدُّد الذي طرأ على مفهوم الـمجتمع الـمدني في ثوبه الـجديد في عالم الـمسلمين منذ التسعينيات، من الأهمية بمكان أن نكون على إلمامٍ بما هو حادثٌ من تقابُلٍ بين ضعْف النظرية وقوّتها على نقل تطوُّر استثنائيٍّ في أجزاء من العالَم الـمسيحيِّ الغربيِّ، على امتداد الـحقبة التي سُمِّيت تقليديًّا بحقبة التنوير. ففي الـحالة الإسلامية على وجه التحديد تعدُّ الأخوّة الصُّوفية (الطَّريقة) بمثابة مصفُوفةٍ تقليديةٍ مهمَّة للرابط التضامُني، الذي يُيسِّرُ التعاوُن والتَّرقي الرُّوحاني، فضلًا عن التشْبيك الاجتماعيِّ الـمُتماسك. كما أنَّ الطَّريقة تُجسِّد- بحسب الـمؤلِّف – مصفوفةً ما وراءَ مؤسَّساتية من منظورات تاريخية، حيث حاول كثيرٌ من العلماء الغربيين، منذ القرن التاسع عشر، قَصْرَ الصُّوفية على أنَّها مُكوِّن غريبٌ في/عن الإسلام؛ بل والتكهُّن حتَّى من دون تقديم دليل مُتراكمٍ على أنَّ أصلها من مصادر خارج الإسلام!
أمَّا اليوم؛ فإنَّ ثمة إجماعًا أكاديميًّا على أنَّ الـجذور البعيدة للصُّوفية قديمة قِدَم الإسلام ذاته. فقد ازدهرت التقوى الصُّوفية التي بزغتْ تدريجيًّا أولًا في أثناء الـخلافة الكبرى، والتي امتدتْ إلى أواسط القرن العاشر الـميلادي/ الرابع الـهجري، حيث كانت تجلِّيات التقوى الأولى موجَّهةً إلى الـحقيقة الباطنة التي يُمكننا مُطابقتها مع الصُّوفية.
هكذا، وبفضل القوَّة التي مثّلتها أهمية الصُّوفية الصَّاعدة كتخصُّص معرفيٍّ يُشدِّد على الـحقيقة الباطنية، جاءت الشَّريعة لتمثِّل هي أيضًا -وفي الـمقابل- الأبعادَ الـخارجية لقانون الإسلام الدِّينيِّ الأخلاقيِّ. وما حدث بعد ذلك هو أنَّ الشَّريعة تطابقتْ مع البُعد الأكثر منهجيةً للمعيارية الإسلامية، فيما أصبح التحوُّل إلى الباطن الذي روَّج له الصُّوفية – مفهومَ الـحقيقة بوصفه الـمقابل الباطني للشَّريعة – يُشكِّل جزءًا لا يتجزَّأ من العملية الأوسع، وطويلة الـمدى، التي ظهرتْ عبرها الشَّريعةُ كمفهومٍ إسلاميٍّ رئيس.
تاريخيًّا، ازدهرت الصُّوفية القائمة على الطَّريقة في الفترات الوسْطى، عبر مناطق واسعة من الـمعمورة الإسلامية؛ وصُولًا إلى جنوب آسيا ثمَّ جنوبها الشَّرقيِّ، وهنا عمِلت الصُّوفية بوصْفها القوَّة الـمُوجِّهة الرَّئيسة لنشر الإسلام إلى جانب التّجارة. ولا شك في أنَّ الصوفية الـمُتمأسسة غالبًا ما أُدْرِكَتْ بوصفها السُّلطة البديلة من قِبَل التَّراتبيات التي ترأستْ إنتاجَ الـمعرفة الـمعيارية والقانوينة ونشرها؛ تلك التي تأسَّستْ رأسًا على التعليم الـمدرسيِّ.
وفي الواقع، لا تحيلُ الـمعرفة، أو السُّلطة، إلى جماعاتٍ أو مؤسَّسات- وإنْ تداخلتا معهما بأشكال كبيرة- بقدر ما تبدوان مفاهيمَ ناظِمة للتَّراكيب الاجتماعية. فالـمعرفة يُعبَّر عنها من خلال الأخويات الصُّوفية وجماعات الفُقهاء. وتبعًا لذلك؛ لعب الوقفُ دورًا حاسمًا في تحقيق وضمان الاستقلال الـخاصِّ بالـمعرفة في الـحقبة اللاحقة على الـخلافة الكبرى، والتي كانت حاسمة في تشكيل عالم الإسلام.
فبالإضافة إلى الدَّور الـمركزيِّ الذي اضطلعتْ به الطُّرق الصُّوفية في نشر الإسلام، لعبت الصُّوفية دورًا أكثر خطورة في نقل الـمعرفة وتشكيل لغةٍ أخلاقية عامَّة ومُشتركة للجميع، أسَّستْ قيم الانتماء إلى عالم الإسلام. وبدورها سمحت هذه اللغة للأفراد الـمُنتمينَ إلى الـجماعات الصُّوفية/الـمُريدين، بالتّعاقُد وإقامة الصفقات والالتزام بها، فشكَّلت بهذا الإطار الـمرجعي الـمُشترك الذي يفهم الأفرادُ أنفسَهم من خلاله، ويملكون بفضله قيمًا مُشتركة يستندون إليها في علائقهم مع بعضهم البعض.
كما امتلكت الطُّرق الصُّوفية أيضًا قدراتٍ عسكريةً مهمَّة وأخويات سمحتْ لها بتكوين قوَّة عسكرية مُوازية لتلك التي امتلكها أهل السُّلطة (السّيف)، يُضاف إلى هذا، وجود قادة كاريزميين (أي بنية شبه مؤسَّساتية). كلُّ هذا سمح بضمان وحفظ استقلال الـمعرفة وحامليها الاجتماعيين تجاه السُّلطة الزَّمنية. بهذا المعنى، لا يمكن اختزال الصُّوفية إلى مجرد مسار روحانيٍّ؛ مثلما فعل أغلب الـمستشرقين الأوربيين، فقد سيطر الـمُتصوفة على التوتُّر القائم بين مُستويات الالتزام الإيمانيِّ الرُّوحانيِّ منها والعمليِّ، وهدَّءوا من روْعِه عبر بناء أشْكالٍ ترابُطيةٍ مُلائمة في شكل التنظيمات الأخوية.
ونتيجة لذلك؛ بلغت قدرة الصُّوفيين على البناء وتقديم السُّلطة الاجتماعية ذروتها في الـمراحل الـحرجة تاريخيًّا، عندما أدَّت الطُّرق الصُّوفية دورًا رئيسًا في التوسُّع الإسلامي، مختصرة بذلك ذلك الزَّخمَ التَّشبيكيَّ وما يكمن وراءه من قوَّة خاملةٍ تتمثَّل في التنظيم الاجتماعيِّ الذاتيِّ، الذي خدمتهُ جيدًا ممارساتُ الشَّريعة.
أضف إلى ذلك أيضًا، ما وراء التصوُّف من انتشار التنظيمات الأخوية ممثَّلةً في النِّقابات الـحرفية والعُمَّالية، وما رافق ذلك من انتشار نمط أو تشكيلات "الفتوَّة" التي انسجمتْ وتعايشتْ مع الطَّريقة الصُّوفية، بوصفها تعبيرًا عن جوهر رمزيٍّ لسُلطة الـخلافة التي كانت تتهاوى فعليًّا.
المدنية: العمران الخلدوني من منظور التاريخ والاجتماع
شكَّل إسلام القرون الوسطى تتويجًا أنثروبولوجيًّا لمأزق التّواصل الـجوهريِّ فيما يتعلَّق بالصِّلة الـمحورية الثلاثية بين الأنا والآخر والله. ففي تلك الـمرحلة الـحرجة من التاريخ الإسلاميِّ ظهرت الأمَّة الإسلامية كمُجتمع من الشَّبكات التي تُغذِّيها دوائرُ تواصُل مُشتركة في الـمركز.
وفي الوقت نفسه كانت فكرة الـمدنية، التي من الـمفترض تشريعُها وفق الشُّروط الإسلامية، قد انهارتْ وتحوَّلت إلى مُضاربات أصولية حول قضايا النِّظام العام. وكثيرًا ما أسهم هذا التوجُّه في خلق رؤية عن الـحياة الإنسانية تتميّز بانفتاح غير مُعتادٍ على الطاقات الإنسانية من جمال وحبٍّ ومعرفة؛ سواء الـحب كمعرفة أو الـمعرفة كحب.
وضمن هذا السِّياق، يعدُّ ابن خلدون نمطًا لعالِم الاجتماع النَّموذجيِّ، حيث يعكسُ بوصْفه عالِـمًا بأفضل صورةٍ ممكنةٍ ديناميات العصْر في صورتها الـمُحْتضرة، وذلك عبر مُضاهاة الدِّينامية مع عدم الاستقرار. وفد اشتُهر بخاصة بسبب ما صاغه من قوانين جوهريةٍ عن السُّلطة والعصبية والفرق بين مجتمعات الـحضر والبداوة. فقد أشار ابن خلدون بأهمية بالغة إلى أنَّ الـمدنية، التي تقوم أساسًا على الـحضر، ويُسمِّيها العُمْران، تتميَّز ببُعدٍ مزدوجٍ متأصِّلٍ فيها، بحيث يتقاطعُ مع جميع الدَّوائر الأخرى.

ابن خلدون
وتبعًا لذلك ترتقي الـمدنية – وفقًا لتعريف ابن خلدون – إلى شكلٍ للحياة يقومُ على التَّحسين والتَّثقيف والآداب/الإتيكيت. وكما هو معلوم؛ فإنَّ ابن خلدون رأى في التماسُك القبليِّ- الـمُسمَّى عصبيةً- عاملَ التماسُك الرَّئيس اجتماعيًّا، والقوَّةَ السِّياسية التي أصبحت فعَّالة؛ خصوصًا كعامل للتغيير في الفترات غير الرُّوتينية من التحوُّلات التي تقع عادةً عندما تتعرَّضُ سلامةُ أنظمة الـحُكم إلى تحدِّيات خارجية أو داخلية أو الاثنين معًا. وكما لاحظ سالفاتوري؛ فإنَّ العصبية هنا لا تمثِّل مجرد مُحرِّكٍ للدائرة الأساس، وأحد مقوِّمات الـمدنية عن بُعْدٍ، بل إنها تمثِّل أيضًا بديلًا سوسيولوجيًّا مُقنِعًا عن الكاريزما، وفي الوقت نفسه، تكشفُ العصبيةُ عن هشاشة مفهوم الـمجتمع الـمدني، القائم على تركيبة من الـمصلحة والوجدان في شكل تعاطُفٍ إنسانيٍّ مُعتدل.
أخيرًا يتحدث الكتاب عن واقع الـمدنية في العصور الـحديثة، وعن ديناميات البلاط والنُّخب البازِغة، وعن تعقُّد عملية التحضُّر في الأزمنة الـحديثة والـمعاصرة، مُنتهيًّا في الأخير إلى تقرير أنَّ تموضُع الإسلام الغريب تاريخيًّا وحضاريًّا في مقابل الـحداثة الـمتمركزة على الغرب يظلُّ من حقائق التاريخ الفكريِّ، وموضوعًا لأشكال تمثيلٍ مختلَّة التوازُن ضمن طيفٍ واسعٍ وأجيالٍ مُتعاقبة، جنحتْ إلى تبخيس الإسلام وحرمانه من شخصيته الـمتفرِّدة.
وحقيقةً فإنَّ الإسلام يُواصل ظهورًا غريبَ الأطوار فيما يتعلَّق بمحور عملية التحضُّر العالمية، بحيث لا يمكن أن نستدلَّ عليها منطقيًّا من خلال خصائص ناقلات الإسلام ومصْفُوفاتِه في عملية التحضُّر؛ بل من خلال صعود الغرب وتوسُّعِه الكولونيالي، والذي أزاحَ مركزيةَ الإسلام جانبًا في شطْر الكُرَة الأرضية الشَّرقي.
ومن ثمَّ، يطرحُ سالفاتوري خارطةَ طريقٍ من أجل الـخروج من هذه الـمُعضلة التاريخية، تبدأُ بالتَّشكيك في خطابات الـهيمنة الغربية، التي تفرضُ نماذجَ مُقنَّنة وثنائيةَ التَّقسيم؛ من قبيل: التَّقليدية والتَّقدُّمية، الـحداثة والـمدنية؛ كما لو أنَّ هناك – على الرغم من جميع التَّنافسات الكولونيالية والإمبريالية – رسالةَ تَحَضُّرٍ غربيةٍ مُتجانِسَةٍ، بمقدورها أن تحْتضنَ العالَم كلَّه، وأن تُواجِهَ جمودًا لا شكلَ له من ثقافاتِ ما قبل الـحداثة!





