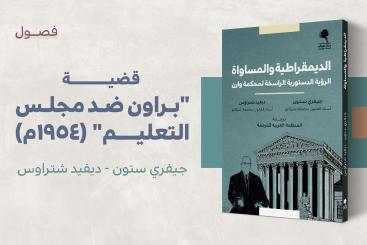تفسير القوانين: النص والسياق والتفسير المقاصدي

تُعَدُّ الكتابة في مجال تفسير القوانين من أدق الكتابات؛ ذلك لأنها لا تتوقف على الجانب النظري وحسب، بل تلتصق التصاقًا وثيقًا بمجال التطبيق، وتنزيل الأحكام على دنيا الناس، بما يقوم به القضاء في ساحات المحاكم ورجال القانون في الشروح والتعليقات، وكلّما تسلح القائمون على هذا العمل –في المجال التطبيقي– بقواعد تفسير منضبطة، استطاعوا أن يرتقوا بالنظام القانوني إلى الدرجات العلا، واستطاعوا أن يحققوا الهدف الأسمى من إقامة أي نظام قانوني ألا وهو العدالة، وحتى يكون القارئ على وعي بأهمية الكتاب؛ فلا بُدَّ قبل قراءته أن يُلِّم بالآتي:
أ- المراد بتفسير القوانين وعلاقته بالمنظومة القانونية
يُقصد بتفسير النصوص «توضيح ما أُبهِم من ألفاظ التشريع، وتكميل ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه، والتوفيق بين أجزائه المتناقضة»[1]. وإذا كان تعريف تفسير القانون قد اقتصر على عناصر محددة -كما في التعريف السابق- فإن الواقع الذي يقوم به القضاة غير ذلك، وأوسع من المحيط الذي ارتضاه علماء أصول القانون؛ لأنه جهد عقلي وعلمي مدروس، يُقصَد به تحديد معنى القاعدة القانونية ومداها، لجعل القوانين صالحة للتطبيق العملي على الحالات الخاصة، وعليه فكل جهد يُبذل في هذا المجال ضمن القواعد الأصولية، واللغوية، والمنطقية، والغاية الاجتماعية للقاعدة يُعتبر تفسيرًا. يتضح من ذلك أن تفسير القوانين يأتي في المنظومة القانونية بعد عملية التشريع؛ ليكون همزة الوصل بين خطاب المشرع والواقع المعايش.
ب- أنواع التفسير وأهمها
ينقسم التفسير بناء على الجهة التي يصدر عنها، ومدى قوة الإلزام التي يحققها إلى الآتي:
التفسيـر الفقهـي: وهو يُعبر عن الجهد الذي يبذله شراح القانون والفقهاء في تفسير القواعد التشريعية، وأحكام القضاء والتعليق عليها وانتقادها. ويستعين الفقهاء في تفسيرهم بقواعد المنطق السليم، دون النظر إلى النتائج العملية التي يؤدي إليها تطبيق التشريع على الحالات الواقعية، ولذلك فهو يغلب عليه الطابع النظري، ومن حصيلة جهد الشراح تتكون مجموعة من الاتجاهات الفقهية التي تكون خير معين للقاضي في تكوين آرائه، وخير معين للمشرِّع في تعديل القواعد التشريعية وتطويرها.
التفسير التشريعي: ويصدر هذا النوع من التفسير من المشرِّع نفسه، حين يرى ضرورة لذلك، فإذا اختلفت المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرِّع، وصدرت الأحكام متضاربة، ومتناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرِّع إلى إصدار قانون يفسر به القانون السابق، كما قد يصدر التفسير في الوقت نفسه الذي يصدر فيه التشريع، ويصدر القانون التفسيري من السلطة التي أصدرت القانون المراد تفسيره، وبصدوره يلتزم القاضي بالتفسير التشريعي، فيتقيد به عند تطبيق التشريع السابق.
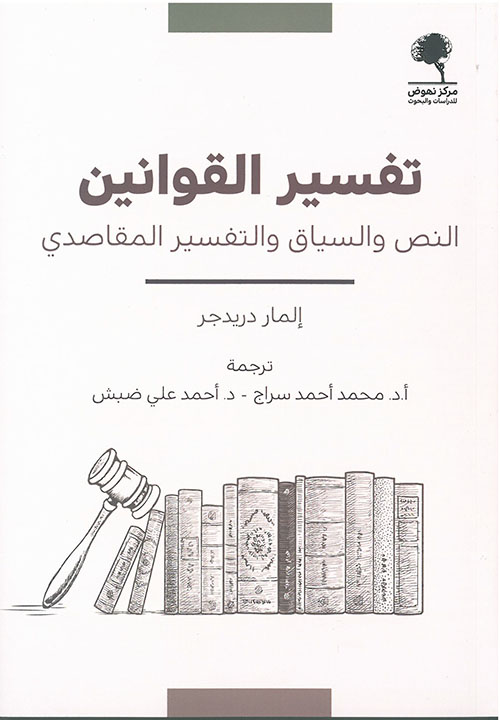
التفسير القضائي: وهو ما يقوم به القضاة تجاه تفسير النصوص الغامضة، أو الناقصة، أو المتناقضة إذا لم يوجد تفسير تشريعي لها، و القاضي ملزم بتفسير النص؛ ليتيسر عليه تطبيقه، و لكن لا يقوم القاضي بالتفسير إلا بمناسبة واقعة معروضة عليه، وليس للتفسير القضائي قوة إلزامية، فهو مُلزِم لأطراف النزاع الذي صدر التفسير بصددهم، وغير ملزم للمحاكم الأخرى، فما استقر عليه القضاء من تفسير معين لا يُعَدُّ ملزمًا، ويمكن العدول عنه، والأخذ بتفسير آخر في قضية مماثلة.
ويُعَدُّ هذا النوع الأخير أهم الأنواع؛ لأنه يحول النص من جماد إلى كائن حي ينمو ويترعرع داخل المجتمع، ويقوم بوظيفته من إرساء العدالة، ويمكن من خلال توارد التفسيرات القضائية على قضية ما، بشكل ما، أن تكون حافزًا للمشرِّع بأن يجعله وسيلة لتطوير تشريعه، وقد استعان العلامة «السنهوري» إبان تعديله للقوانين المدنية بأحكام القضاة، فحوَّلها من مجرد حكم غير ملزم إلى حكم ملزم. فنقل مبادئ قانونية لم يكن لها تشريع خاص، وكان القضاء يطبق في تفسيرها مبادئ العدالة والقانون الطبيعي، ومن ذلك الملكية الأدبية، والفنية، والصناعية التي لم يكن لها حيز في التقنين المدني القديم[2].
ج- أهمية حقل تفسير القوانين
لعل أهمية حقل التفسير تنبع أولًا من الأسباب التي دعت إليه، وهي بصورة إجمالية: غموض النص، وتعارض النصوص مع بعضها، ونقصها أوعجزها عن مسايرة الحياة أحيانًا. ويمكن بسط الأهمية في النقاط الآتية:
- يُعتبر تفسير النصوص أداة فعّالة لتقريب القانون إلى الواقع، ونقله من صورة مجردة إلى صورة ملموسة.
- يعمل التفسير على تكييف القانون مع الحاجات المستجدة، والقضايا المُلحة في ساحات القضاء، وتبرز هذه الأهمية بشكل جلي عندما تبتعد المسافة بين القاعدة القانونية، والوقائع الطارئة، أوعندما تستجد حاجات ومصالح جديدة لم تكن معروضة أو متصورة عند سن التشريع، فيلجأ القاضي إلى روح القانون وغايته.
- يعمل حقل تفسير القانون على استكمال وظيفة المشرِّع الذي لا يمكن أن تُحيط نصوصه بكل الوقائع؛ فيضع صيغًا مرنة فضفاضة ملقيًا بمهمة تفسيرها على القاضي، مثل التعسف في استعمال الحق، ومخالفة الآداب العامة، ومنع الغرر، والغبن، والاستغلال، كل هذه قضايا عامة، والقاضي هو من يثبتها في الوقائع المعروضة أمامه أو ينفيها من خلال استقراء الواقع والاستعانة بفلسفة المجتمع ومعتقداته.
- إن هناك تياريْن متعارضيْن نلمحهما دائمًا عند صناعة القوانين، الأول: التيار الداخلي الذي يفرض الثبات والاستقرار، ويعتقد دائمًا أن النص قد حوى كل شيء، والثاني: التيار الخارجي الذي يسعى دومًا نحو التطوير نتيجة للضغوط الخارجية، والتغيرات الاجتماعية، وتأتي مناهج تفسير النصوص لتوازن بين التياريْن، فتحافظ على النص وأُطره، وتضع قواعد منضبطة لتفسيره بما يُحقِّق مقاصد المجتمع دون ترك مجال لأهواء القضاة، أو فرض سياج سميك بين النص والواقع.
النصوص ليست كلها قطعية الدلالة، كما أنها ليست تفصيلية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تعلقها بأعراف تغيرت عبر الأزمنة.
هذا عن فائدة التفسير بصورة عامة في كافة النظم القانونية، فإذا خصصنا الحديث عن الشريعة، فسنجد أن هناك أهمية كبيرة لذلك الحقل؛ فالنصوص ليست كلها قطعية الدلالة، كما أنها ليست تفصيلية بصورة كبيرة، بالإضافة إلى تعلقها بأعراف تغيرت عبر الأزمنة، فكان لا بُدَّ من وسيلة فعّالة لبيان معاني النصوص الشرعية، ودلالتها على الأحكام للعمل بها، وهذه هي مهمة التفسير وذروة سنامه، وإذا كانت عملية التفسير قديمًا تتم بصورة ميسرة اعتمادًا على السليقة العربية، فقد تغير الزمان واحتجنا إلى ضبط هذه العملية لتصبح تخصصًا له أهله ومنهجه.
د- الخطوات العامة في عملية التفسير
لا شك في أن عملية التفسير مجهدة ومتشعبة، لكننا يمكن أن نضعها في مراحل ثلاث لا بُدَّ أن يَعْبُر عليها المفسر دون الخوض في التفصيلات وهي:
- النظر الجزئي للمفردات.
- النظر الكلي للتركيب والسياق، والسياقات المشابهة.
- استقراء مقاصد وأهداف وغايات المشرِّع.
د. تفسير القوانين بين أصول الفقه وأصول القوانين
إذا كان الغرض من أصول الفقه في مبحث دلالات الألفاظ والمقاصد –خاصة– هو الكشف عن مقصود الشارع، فهذه هي الوظيفة الأساسية –أيضًا- للقاضي مع اختلاف طبيعة الكلام المنظور فيه، فلما كان الأصوليون يتعاملون مع نصوص إلهية ذات مستوى أعلى من طاقة البشر، نتج عن ذلك تدقيقات كثيرة تتناسب مع هذا المقام قلّما التفت إليها الأصوليون في مجال القانون.
لقد تمكّن علماء أصول القانون -بناء على النقطة السابقة- من وضع ضوابط للتفسير، لكنها لا يمكن أن تُضاهي -بناء على رؤية موضوعية زاهدة في التعصب- مباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه، التي قسمت اللفظ من حيث الوضوح والخفاء إلى مباحث فريدة، ووضحت السبل لرفع التعارض والغموض، فالعقل الأصولي والفقهي أدرك أن التشريع ليس مجرد نصوص، بل هو دلالات ومعانٍ تؤخذ بطرق متعددة منها: عبارة النص وإشارته، ومفهوم الموافقة والمخالفة، كما يؤخذ من لوازم النص العقلية، فالنص الدال على المعنى الملزم دال على المعنى اللازم عقلًا[3].
الشريعة فتتميز بثبات مصالحها وخلود مقاصدها وقيمها التي لم تتدابر -ولو للحظة- مع الفطرة السليمة.
لقد تنوعت وتشعبت مناهج تفسير النصوص في أصول القانون بين المدارس التي تهتم بالغاية وتهمل النص، وبين المدارس التي تعتقد أن النص حوى كل شيء، ولا يجوز الخروج عنه، لكن منظومة أصول الفقه منذ بواكيرها الأولى أعملت التفسير اللفظي، والمنطقي، والمقاصدي لتفسير النص. إذا كان من المفترض أن يتفهم القاضي مقاصد المشرع وأهدافه، حتى يقوم بعملية التفسير بصورة سليمة؛ فإن ثبات هذه الأهداف بصورة ما ضروري لتيسير مهمة القاضي، وفي الغالب لا تتفق القوانين على أهداف ثابتة، فهي تتأرجح بين المذهب الفردي والجماعي، بل المقاصد قد تتغير في النظام الواحد وفق ميول كل نظام سياسي تمكن من حيازة السلطة، أما الشريعة فتتميز بثبات مصالحها وخلود مقاصدها وقيمها التي لم تتدابر -ولو للحظة- مع الفطرة السليمة، الأمر الذي يجعل التفسير في حقل أصول الفقه أكثر إنتاجًا لمظاهر العدالة[4].
هـ - أصالة أصول الفقه في التوفيق بين النص والواقع
يُقرِّر علماء فلسفة القانون أن هناك مشكلة تواجه كل النظم القانونية، وهي مشكلة الموازنة بين اعتبارات الثبات والتغير، وتبلغ هذه المشكلة مداها عندما يحدث التباعد بين النص القانوني الثابت والواقع الاجتماعي المتغير، نتيجة لحدوث تغيرات اجتماعية متلاحقة في العلاقات الاجتماعية السائدة في مجتمع من المجتمعات، وعندما تكون سرعة تغير العلاقات الاجتماعية أكبر من قدرة المشرِّع على تنظيمها تنظيمًا قانونيًّا يتميز بطبيعته بقدر من الثبات، حينئذ ينزع الفكر القانوني إلى التخلي عن الشكلية في المعالجة القانونية وعن الالتزام الحرفي بالمفهوم المباشر للنص، ويتجه إلى الغائية في فهم القانون وتطبيقه سواء بالبحث عن الغايات الاجتماعية التي كان للمشرع أن يتوخاها في هذه المرحلة، أو بالالتجاء إلى حيلة المثاليات القانونية، ولكن القانون في الوصول إلى هذه النظرية تخبط كثيرًا في سيره، وتمسك في أحايين كثيرة بحرفية نصوصه وبسيادته، ضاربًا بالواقع المتغير عُرض الحائط وفق كل نظام سياسي يتحكم فيه، أو فلسفة تفرض نفسها على الواقع.
إن هذه المشكلة تلحق أي نظام قانوني مهما كان مصدره إذا ظل فقهاؤه وقضاته مكتوفي الأيدي، يتابعون سير المجتمع إلى الأمام ولا يحرِّكون المياه الراكدة في النصوص، ويُشيد علماء فلسفة القانون بالدور المبكر الذي قام به علماء المسلمين في حل هذه المشكلة، فأصبح من الثابت في بحوثهم أن علماء المسلمين من الأوائل الذين تنبهوا إلى مشكلة العلاقة بين النص القانوني الثابت، والواقع الاجتماعي المتغير، تلك المشكلة التي شغلت الفكر القانوني منذ أقدم العصور، ولقد تم ذلك في الفكر الفقهي باصطناع منهج المصلحة، وبالعدول بالمسألة عن نظائرها إلى حكم آخر نقيض لسبب يقتضي هذا العدول، وهو ما يسمى بالاستحسان.
يتبين لنا من خلال تقدير علماء القانون للاستحسان أنه ينبغي علينا إبراز الحديث عن المنهج الإسلامي في التوفيق بين اعتبارات الشريعة الإسلامية، والواقع الاجتماعي المتغير وصولًا إلى أنسب الحلول التشريعية التي تناسب مصالح الجماعة، وهذا الأمر منطقي ومترتب بالضرورة على كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. إن إبراز مثل هذه النظريات الفقهية وطرحها بصورة بارزة في الساحة العلمية أولى بكثير من مناقشات جزئيات الفقه؛ لأنها تُبرز قدرة هذا النظام الفقهي على فك كثير من الإشكاليات في منهجيات النظم الوضعية[5].
إن القوانين التي كانت تنتمي إلى أصل أجنبي أصبحت الآن عربية، ويجب أن تُفسَّر وفق قواعد التفسير التي نمت وترعرعت في ظل بيان اللغة العربية.
وخلاصة النظر في مناهج التفسير بين النظر الأصولي والقانوني، أن المسلمين لم يهملوا الغاية الاجتماعية للنص الشرعي، بل كانوا أكثر اجتهادًا وسعيًا لتحقيق مقاصد الشارع وحكمة التشريع وروحه، وإذا كانت مدارس التفسير القانونية متصارعة حول أي الطرق التي ينبغي سلوكها، فإن الفقه الإسلامي غني بمعايير واضحة يتزود بها القاضي، ويراعيها عند تفسير نص من النصوص الشرعية، بل وصل إلى مرحلة «جني» وهي أقوى مدارس تفسير النصوص، التي يُطلَق عليها مدرسة البحث العلمي الحر، ويقارنها علماء أصول القانون عادة بمدرسة «أبي حنيفة»؛ لكنني أرى أن مدرسة جني خرجت من النقيض إلى النقيض، فأهملت النص أو جارت عليه، أما سُبل الاستنباط، واستنطاق النص، وتحقيق العدالة عند علماء الإسلام فقد جمعت بين مراعاة النص والمقصد والمصلحة. ولعل القانون المدني اليمني يُعتبر الوحيد بين التقنينات العربية الذي نص في مادته الثالثة على أنه:
"يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي"، وهي حقيقة أحسن المشرِّع في الجهر بها، فأصول القوانين لا تحتوي على المادة الكافية من أدوات التفسير التي تمكِّن القاضي من عملية الاجتهاد بصورة منضبطة. إن القوانين التي كانت تنتمي إلى أصل أجنبي أصبحت الآن عربية، ويجب أن تُفسَّر وفق قواعد التفسير التي نمت وترعرعت في ظل بيان اللغة العربية.
ز- أمثلة على تصحيح التفسيرات الخاطئة
فلو نظرنا إلى تفسير مبدأ الشريعة الإسلامية القائل: «بألا تركة إلا بعد سداد الديون» ومبدأ القانون الفرنسي الذي يقضي «بأن تنتقل إلى الورثة ديون المورِّث كما تنتقل حقوقه»، وهو يقضي -أي القضاء عادة- باتباع الشريعة، ولكنه -مع ذلك- لا يسير في هذا المبدأ حتى النهاية، بل يحمي حق الغير الذي تعامل مع الوارث بحسن نية قبل سداد ديون التركة، فقد قضت محكمة الإسكندرية الأهلية (31 ديسمبر-سنة 1896م) بأنه إذا كانت التركة مدينة وباع أحد الورثة ما خصه من الميراث قبل وفاء الدين وتبينت سلامة نية المشتري، وعدم تواطئه مع البائع للإضرار بحق الدائن؛ فيكون البيع نافذًا، وادعاء فساده بأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاء الدين منقوض بأن ملكية أموال المتوفى تنتقل إلى ورثته في حال موته، فيكون هذا الوارث قد باع ما هو ملكه، وبأن معنى كون الميراث لا يكون إلا بعد وفاء المدين، هو أن الوارث يجب عليه دفع الدين على قدر قيمة ما ورثه ولا يلزم بزيادة، لا أن أموال المتوفى تبقى بدون مالك حتى تمام دفع الدين، وقضت محكمة الاستئناف الأهلية (9 ديسمبر سنة 1912م، مجموعة عمر 14، ص42) بأن الوارث لا يملك شرعًا ما يتركه مورّثه وقت الوفاء، والقول بألا تركة إلا بعد سداد الديون لا يُقصَد به أن التركة تبقى معلقة لا مالك لها حتى ندفع ديون المورّث كلها، وإنما معناه أن الوارث ملزم بدفع ديون مورّثه بنسبة ما أخذه من التركة، فلذلك ليس لدائني المورّث أن يطلبوا إلغاء البيع الحاصل من الورثة لشيء من أموال التركة، بناء على أن البيع قد حصل قبل سداد ديون المورّث، وأن الورثة قد باعوا حينئذ شيئًا لا يملكونه، بل الطريقة الوحيدة للطعن في هذا البيع هي رفع دعوى إبطال التصرفات الصادرة من المدين إذا توافرت شروط هذه الدعوى.
ويُثبت السنهوري -بعد رصد هذا الاضطراب- أن القضاء المصري غير مطرد في هذه المسألة، فهناك أحكام كثيرة تحمي دائن التركة وتُفضّله على المشتري من الوارث، وخير سبيل يراه السنهوري للتنسيق بين القضاء والشريعة أن تنظم طريقة لتصفية التركة على مثال تصفية أموال المفلس، حتى تحفظ حقوق دائني المورّث، ولا يضار حسن النية الذي يتعامل مع الوارث[6].
عود على بدء فإن هذا الكتاب -الذي صنّفه (إلمار دريدجر)– يأتي محاولًا الربط بين قواعد التفسير وتطبيقاتها العملية في ساحات المحاكم، واستطاع مؤلفه أن يربط بين دلالات الألفاظ، والسياق، والمقصد في بوتقة واحدة، يكون الغرض منها الوصول لطريقة لفهم النص شاملة جامعة لا يجور فيها النص على المقصد أو العكس.
ولا يقل الدور الذي قام به المترجمان الفاضلان، الدكتور: محمد أحمد سراج، والدكتور: أحمد ضبش– عن الدور الذي قام به المؤلف، ولعل أول مظهر من مظاهر هذا الجهد الرائع هو اختيار الكتاب في حد ذاته، ثم تأتي مشاق الترجمة والتقابل اللغوي، والتعليقات التي أوضحت النص وزادته جلاء وبروزًا.
وعلى الرغم من سعادتي بهذا الكتاب، فكنت آمل في أن يتم استخلاص القواعد من جسم القضايا، حتى نضع قواعد مسلسلة للقارئ في نهاية الكتاب، تمكنه من استجلاء القواعد التفسيرية التي أقرَّها المؤلف، والتي لا تختلف إلا في النزر اليسير منها عن قواعد أصول الفقه الإسلامي. لذا ستكون قراءتي لهذا الكتاب جُهدًا يسيرًا يضاف إلى جهود المترجميْن الجليليْن.
فالكتاب في مجمله -بالإضافة إلى مقدمة المترجميْن- يتناول عدة محاور على النحو الآتي:
أولًا: أهمية العناية بجانب تفسير النصوص
لقد أوضح الكتاب مع مقدمة المترجميْن إلى أهمية مجال التفسير، ويمكن أن نُجملها في الآتي:
إن الحاجة ماسة لوضع قواعد ميسرة في تفسير النصوص؛ ذلك لأن النظم القانونية العربية قد استغنت بمباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه عن ضبط قواعد التفسير في قوانين جامعة بلغة حديثة واضحة، لتيسّر الربط بين النظر والعمل، وإذا كان الأصوليون قد حددوا القواعد الفنية اللازمة لتفسير النصوص، والتعريف بالسياق، وتلك الخاصة بالمقاصد، فإن الهيكل العام الذي وضعوا فيه تلك القواعد مختلط وفيه استطرادات، وتصنيفات، وأسس لا تتعلق بتفسير النصوص، مثل التقسيمات المعقدة لأوجه الخفاء التي دفع الخلاف فيها بين الأحناف والمتكلمين إلى العناية بإثباتها، دون بذل جهد -ولو قليل- لبيان ما يُزيل غموضها، وقل مثل ذلك في العناية بأوجه الوضوح التي كان من المناسب العناية بتقديم أسباب الوضوح فيها بدلًا من العكوف على تصنيفاتها، وتعريفات أقسامها.
إن قواعد تفسير النصوص التشريعية، وفهم مقاصدها، وسياقاتها السياسية، والاجتماعية، والقانونية، والعمل المستمر على تطوير هذه القواعد، والإفادة من المنجزات الحديثة في علوم اللغة والاجتماع، والقانون هو عصب التفكير الشرعي والقانوني، الذي يؤدي ضعفه إلى بطء تدفق الدماء في شرايين العملية القانونية بأسرها، وإن قانونًا سيئًا مع تطبيق معايير راقية في التفسير السليم يأخذ القانون في الاتجاه الصحيح، على العكس من التفسير الفاسد الذي يضعفه.
التفرقة بين التفكير الأصولي والقانوني: التفكير الأصولي أسرف في الجانب النظري، وقد دارت فيه معارك عالية الجودة على المستوى النظري فيما يتعلق بالماهية. والواجب الآن التخفيف من هذا الجانب النظري والعمل على ربطه بالجانب القانوني والقضائي، حتى نمد ساحات المحاكم بقواعده منضطبة تُيسّر وظيفة القاضي في فهم النص وإقامة موازين العدالة.
ثانيًا: الأسس المعرفية والمنهجية في تفسير القوانين
لقد استطاع الكاتب -ومعه بلا شك جهود المترجمين- أن يضع المنهجية العامة في تفسير النصوص مع التنبيه على بعض الجزئيات التي تُعَدُّ منطلقًا مهمًّا للقيام بعملية التفسير في النقاط التالية:
- إن التفسير عملية لغوية في الأساس، وتفتقر إلى الإلمام بقواعد اللغة، وأساليبها في التعبير والبيان عن مراد المتكلم، وأول واجبات من يتصدى لتفسير النصوص التشريعية، أن يكون ملمًّا بالمعاني المعجمية، والمعرفية للكلمات، وبالقواعد البلاغية المؤثرة في تحديد المعنى المقصود لها.
- إن المنهج الذي نأمل أن يكون محكمًا، هو المنهج الذي لا يتجاوز حدود اللغة، أو التفسير النصي المعدل، بضم السياقات المتنوعة التي صدر فيها النص، إلى جانب التفسير المقاصدي، بحيث يبدأ المفسر من النص، وينتهي بالمقصود في ضميمة واحدة .
- إن التفسيرات الآلية التي تقف عند حدود المعاني اللغوية للكلمات هي تفسيرات تهزم أعدل القوانين، وتأخذها إلى مدارك الفشل، وهو ما ينطبق كذلك على الوقوف عند دلالات الألفاظ، وقد أمكن تلافي كثير من عيوب هذا المنهج بإضافة عنصر السياق مع تقدم الدراسات اللغوية وتطورها، فاشتمل المنهج النصي بذلك على تحديد المعنى المألوف للكلمات في العرف اللغوي، فضلًا عن البحث في السياقات القانونية، والسياسية والاجتماعية التي وردت عنها.
- يجب أن يؤخذ تفسير القانون من المعنى المجرد لكلمات القانون، ولا نستطيع انتشال ما يحتمل أن يكون نية المشرّع، وليس لنا أن نقدِّم العون فيما يتعلق بصياغة المشرّع المعيبة للقانون، ولا نستطيع من خلال التفسير أن نُضيف، أو نُعدّل أو نصلح، العيوب التي تُرِكت هناك[7].
- إذا صدر من البرلمان تقنين وتبيّن أنه معيب فمن حق المشرّع أن يُصححه أو يلغيه، ولكن ما دام موجودًا كالقانون؛ فإن المحاكم ملزمة بتنفيذه. فليس من اختصاص المحكمة أن تسير وراء افتراض أن المشرّع قد وقع في خطأ، فأظن أن الواجب على محكمة القانون -مهما كانت الحقيقة الواقعة- أن تسير وراء افتراض أن المشرّع شخص مثالي لا يقع في خطأ.
ثالثًا: منهجية فهم كلمات المشرّع
تمكّن المؤلف في هذا المحور من وضع منهجية قويمة حين ننظر إلى كلمات المشرّع؛ استجلاءً لمعناها المراد في النقاط التالية:
- إن الكلمة داخل التشريع لا تُقرَأ مجردة عن السياق، فالمعجم يعطي تعريفات كثيرة للكلمة، فهي لا تُفيد معنى إلا حين تُقرَأ مقرونة بغيرها من الكلمات.
- إذا كان معنى الكلمات عندما تُقرَأ في سياق القانون بكامله واضحًا، في مقابل معناها المعتاد والنحوي؛ فإن الواجب أن تُحمل على هذا المعنى المعتاد؛ لأن هذه الكلمات تفصح في سياقها القانوني بأفضل وجه عن قصد المشرّع.
توضيح:
إن أول ما يجب فعله في تفسير كلمات داخل مادة من القانون الذي صدر عن البرلمان –فيما قد نخاطر بالتفكير فيه– هو ألا نأخذ هذه الكلمات في المطلق -كما يقال- لإعطائها ما قد يطلق عليه أحيانًا "المعنى الطبيعي" أو المعتاد الذي يلزم استخلاصه على نحو مستقل تمامًا عن السياق، لخلع نوع من المعنى الذي يبدو لها مما قد يجب تبديله، أو تحويره، وإنما تجدر قراءة التشريع بكامله؛ لنتعرف إلى المعنى المراد داخل السياق، فالتقنين الأصل فيه التناسق مع سلسلة القوانين المتعلقة بالموضوع ذاته[8].
- حيثما يختار المشرّع كلمات فنية اصطلاحية؛ كي تفيد معناها، فإن المفترض بوجه العموم أنه يستخدمها في هذه المعاني الفنية.
توضيح:
إذا كان القانون قد اتجه إلى تناول أمور تؤثر في كل أحد بوجه العموم، فسوف تُحمل كلماته المستخدمة مما يتعلق بهذه الأمور على معانيها العامة والمعتادة في اللغة، وإذا كان القانون قد صدر متعلقًا بتجارة خاصة أو عمل أو معاملة، وكانت الكلمات المستخدمة تُفيد معنى خاصًّا لدى كل شخص على دراية بهذه التجارة، أو العمل، أو المعاملة، فإن هذا المعنى الخاص هو الذي يجب الحمل عليه، ولو اختلف عن المعنى العام، أو المعتاد للكلمات.
- الكلمات الدالة على الذكور تشمل الإناث والمؤسسات.
- الألفاظ في صيغة الجمع تشمل المفرد، وفي صيغة المفرد تشمل الجمع.
- إذا فسّر لفظ فإن اشتقاقاته الأخرى وتصرفاته تأخذ معانٍ مناسبة.
رابعًا: التعامل مع النصوص وقت خفاء المدلول
أوضحت البنود السابقة أنه يجب قراءة البنود الجزئية المنطبقة على القضية المعينة محل النظر بمعناها النحوي والمعتاد، على ضوء نية البرلمان المتجسدة في القانون بمجمله، وغرض القانون وخطته، وهذا هو المنتهى إذا كانت هذه جميعها واضحة جلية، وفي اتساق مع المقصود، والغرض، والخطة، والكيان العام للقانون. فإذا كانت الكلمات خفية وغير واضحة فلا بُدَّ من اتباع الآتي:
- إذا كانت الكلمات غامضة وخفية، فإن المعنى الأفضل الذي تُحمَل عليه هو الذي يتفق مع مقصود البرلمان وغرض القانون وخطته، إذا كانت الكلمات قابلة للحمل على هذا المعنى.
- إذا قام عدم الاتساق في داخل القانون، أو بينه وبين غيره الوارد في الموضوع نفسه، فإن الكلمات تُحمَل على معنى أنقص من المعنى النحوي، وأنقص من المعنى المعتاد، إذا كانت قابلة للحمل على هذا المعنى، وذلك بصرف النظر عمّا إذا كانت هذه الكلمات واضحة وجلية عندما تُقرَأ بمعناها النحوي المعتاد.
- إذا لم يكن من الممكن رفع الخفاء، والغموض، والتناقض على نحو موضوعي بالرجوع إلى مقصود البرلمان، وخلاصة القانون وخطته؛ فإن المعنى الأقرب إلى العقل هو الذي يجري اختياره.
خامسًا: منهجية معرفة قصد المشرّع
من المفترض أن مقاصد الشارع لا تتباين ولا تتعارض وترتبط بالثقافة، ومدى الحماية التي يسبغها المشرّع على المصالح الفردية، والاجتماعية، وإن معاني الكلمات تتحدد وفق الهدف المقصود من التشريع، وقد يتضح ذلك بإدراك أن التشريع يُحدد هدفه أولًا، والمقصود السياسي، أو الاجتماعي المتعلق بدفع المفاسد وإثبات المصالح، ثم يُحدِّد الوسائل الدالة على هذا الهدف في المضامين والألفاظ والأحكام الدالة عليها مما تتكفل به عمليات الصياغة والتفسير، ومعرفة قصد المشرّع يُحقّق لنا أمريْن: فهم القانون على وجه جيد مما يستتبع أن تكون أداة جادة لرفع أي خفاء يعترض بنوده وكلماته، والثاني: إسباغ التناسق والتناغم على سياقاتها المختلفة ومواضعها المتباينة. وهناك طرق للتعرف إلى قصد المشرّع قد وضحها المؤلف، وهي:
- النظر إلى النية بأنواعها المختلفة:
النية الصريحة: وهي تلك التي عُبّر عنها بكلمات في التشريع.
النية المتضمنة: وهي التي تُفهَم على نحو مشروع من كلمات التشريع.
النية المعلنة: وهي تلك التي يقول البرلمان باحتمال أو وجوب أو نفي أن تكون مقصود له.
النية المفترضة: وهي تلك التي تُلحقها المحاكم بالبرلمان عند عدم وجود ما يناقضها[9].
والنية التي تبذل المحاكم جهدًا في استخلاصها لها عدة وسائل:
- أن تُقرَأ الكلمة في سياقها، والمقصود بالسياق هنا: السياق الأعم، الذي لا يشمل -فحسب- مجرد سائر البنود الصادرة في القانون نفسه، وإنما يشمل كذلك ديباجته، والوضع الراهن للقانون، والقوانين الأخرى متماثلة الموضوع، والأضرار التي يمكن استخلاصها من هذا كله، ومن الوسائل الصحيحة الأخرى التي كانت علاجًا لهذه الأضرار.
- اختبار الخلفية التشريعية وإثباتها بوجه التحديد إذا لم تكن من مقتضيات المعرفة العامة؛ بغية تحديد الخلل في العدالة الذي يمكن أن يكون هو المقصود بالعلاج.
- النظر العام إلى الهيكل العام للقانون، مما له صلة بالموضوع للغرض نفسه.
- النظر الخاص إلى العنوان المطول للقانون لتفسيره (مع المقدمة إن وجدت) بما يُشير إلى المقاصد العامة من التشريع.
- تتبع الكلمات الفعلية التي تُفسر القانون على ضوء القواعد المستقرة للتفسير.
- اختبار بنود القانون الأخرى في محل النظر، أو القوانين الأخرى المتماثلة الموضوع؛ للاستفادة من إلقاء الضوء على الكلمات المعينة المطروحة للتفسير.
- النظر إلى الظروف التي صدر فيها القانون (الخلفية الاجتماعية).
- النظر إلى السياق الواقعي المتعلق بالضرر المقصود رفعه.
- العناية بعلامات الترقيم؛ لأنها جزء من نص القانون المسنون، ولا يمكن إغفال ملاحظتها عند قراءة النص؛ ذلك أن العلامات الصحيحة هذه مما يقود ذهن القارئ إلى التفسير النحوي الذي قصده محررو القانون.
سادسًا: قواعد الترجيح بين التفسيرات المستنبطة
يوضح الكتاب أن التشريع لا يوافق على ضرر، ولا يسعى إلا إلى تحقيق المصالح العامة والمشتركة بين الناس، ويجب أن تفترض المحاكم قصد القانون إلى وجود ما أسماه المؤلف «النوايا الثابتة أو المفترضة» المتعلقة بالحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية، مثل: العدل، والكرامة، وغيرها من المثل العليا، وعندما تكون هناك قراءتان محتملتان أو أكثر في أحوال الغموض؛ فإن هذا ما يسوغ لنا أن نأخذ بالتفسير الذي يبعد عن المشقة أو يحقّق المصلحة، وهذه هي المنطلقات الأولى في الترجيح حين تتعدد التفسيرات، ومن القواعد المقررة المعينة للترجيح ما يلي:
- إذا كان هناك تفسيران أحدهما قد يضر بالمال، والآخر يحفظ المال، فلا بُدَّ من ترجيح الثاني؛ ولهذا يُفضّل رأي الشافعية في ضمان المنافع.
- العمل بالتفسير المتشدد الأضيق في مجالات التشريع الضريبي والجنائي مقابل الأخذ بالتفسير المرن والأوسع في التعويضات، ولذا فإن الأخذ بالشك لمصلحة المتهم وبالعقوبة الأخف، ليس كرمًا من المحكمة، وإنما هو أمر مقصود للشارع.
- العمل بالتفسير الأوْفَق في الحفاظ على صحة الناس وسلامتهم، ولذا فالأوفق ألا يتمسك القانون بوجوب إثبات القصد الجنائي في الجرائم المتعلقة بالأدوية المغشوشة، والأغذية الضارة وسائر الأمور المؤثرة .
- تفضيل التفسير الموافق للمعقول بناء على افتراض معقولية المشرّع.
- إذا كان هناك تفسيران معقولان من الوجهة النحوية لكلمات القانون؛ فإن للمحكمة أن تتبنى التفسير الأوفق للعدل، والأقرب للعقل بدل الآخر الذي لا يوافق هذه الأشياء.
- التشريعات التي تنتقص من حقوق المواطن سواء في شخصه أو ماله هي تشريعات لا بُدَّ أن تخضع لنوع من التفسير الضيق.
- إذا كان هناك تفسير معقول يستبعد العقوبة في أية قضية خاصة؛ فإن علينا أن نتبع هذا التفسير، وإذا كان هناك تفسيران معقولان فإن علينا أن نتخذ التفسير الأخف.
سابعًا: قضايا العموم والخصوص
قد يجابه المفسر للقوانين كلمات تحتمل العموم والخصوص، والمنهج الذي سار عليه المؤلف لفك هذا الإشكال هو ما يلي:
- إذا كانت الألفاظ تفيد معنيين أحدهما عام مطلق واسع، والآخر خاص مقيد، فالواجب حينئذ هو تحديد المعنى المراد في سياق معين، فإذا حدد السياق المعنى، كانت الكلمات واضحة جلية، ووجب حملها على هذا المعنى مهما كانت النتائج[10] .
- إذا كانت الألفاظ تحمل معنى عامًّا والآخر ضيقًا، وجب اللجوء للمعنى الضيق، إذا كان المعنى الأوسع لا يتسق مع نية المشرّع على ما يستخلص من القانون، أو بعبارة أخرى إذا كان المعنى الأوسع سيؤدي إلى الانقطاع عن المقصود.
- حيث يوجد في القانون نفسه حكم تشريعي خاص وآخر عام، لو حمل على معناه الشامل جميعه ألغي الأول، فالواجب أن يقضي بإعمال النص الخاص على أن يجري إعمال النص العام في الأجزاء الأخرى الباقية التي يمكن أن ينطبق عليها».
- تطبق قاعدة حمل العام على المشترك الجامع إذا كانت الأشياء الخاصة التي تسبق الكلمات العامة يمكن وضعها في إطار فئة مشتركة.
ثامنًا: قواعد النسخ
قد يجد المفسر تعارضًا بين التشريعات المتلاحقة، وقد يترتب على التشريع السابق حقوق لا يسمح بها اللاحق؛ ولكل ذلك فإن الكتاب يضع هذه الضوابط التي تفك إشكال هذا التعارض، وهي:
- إذا كان التعارض بين تشريعيْن عاميْن كليهما أو خاصين كليهما؛ فإن اللَّاحق سيلغي السابق، وأما إذا كان التعارض بين تشريعيْن خاص وآخر عام، فالمعتبر أن الأول يُخصّص الثاني، أو أن الخاص مقدّم على العام، أو أن الخاص استثناء من العام.
- عندما يتضمن أحد التشريعات الأحدث بنودًا من تشريع آخر قديم بطريق الإحالة، ويجري إلغاء التشريع الأقدم بعد ذلك، فإن هذه البنود ستظل قيد العمل ما دامت تُشكِّل جزءًا من التشريع الأحدث، وعندما يتضمن أحد التشريعات مادة واحدة من مواد تشريع آخر، فالواجب أن تُفسر هذه المادة بالمعنى الذي كان لها في التشريع الأصلي بغية التحقق من معناها بالرغم من عدم وجود الأخذ بسائر المواد في القانون الأحدث «غير أنه لا تصح الإشارة إلى أي شرط أو استثناء لم يذكر في هذا القانون».
- لا تؤخذ الكلمات العامة للتشريع على محمل يناقض النظام السابق للقانون إلا إذا لم يكن هناك معنى أو مفهوم يمكن أن تُحمل هذه الكلمات عليه بما يتفق مع مقصود حفظ النظام القائم دون المساس به.
- يحق للتشريع أن يُعدِّل مبدأ القانون العرفي، لكن إذا كان من الواضح أن قصد المشرِّع من إصدار التشريع هو إلغاء القانون العرفي وتغييره، فيجب إمضاء ذلك وتغليب بنود التشريع وأحكامه.
- لا يلغى القانون بمجرد عدم التطبيق أو بإهماله وهجره.
- التشريع المُعدّل يجب أن يُفسر على أنه جزء من التشريع الذي تم تعديله، ما دام متوافقًا مع فحواه.
إذا أُلغِي التشريع كله أو بعضه، فهذا الإلغاء لا يعني:
- إعادة تشريع أو أي تصرف لم يكن نافذًا، أو موجودًا في الوقت الذي ينفذ فيه الإلغاء.
- المساس بما سبق من تنفيذ لذلك التشريع المُلغى أو أي تصرف تم من قبل بناءً على التشريع المُلغى.
- المساس بأي حق أو امتياز مكتسب، بناءً على التشريع المُلغى، أو أي التزام أو مسؤولية مترتبة على ذلك التشريع المُلغى.
- المساس بأي جريمة ارتكبت بالمخالفة لأحكام التشريع المُلغى، أو أي جزاء أو مصادرة، أو عقوبة مرتبة على ذلك التشريع المُلغى.
- المساس بأي تحقيق أو دعوى قضائية أو تعويض يتعلق بأي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية أو جزاء أو مصادرة أو عقوبة مما ذكر.
كل حق مكتسب بالتشريع المُلغى لا يُمَس ومن ذلك:
- كل شخص قائم بعمل بموجب التشريع السابق يظل قائمًا بهذا العمل كأنه معين بموجب التشريع الجديد.
- كل سند أو ضمان أخذه شخص معين بموجب التشريع السابق يظل في حيز التنفيذ، وكل صك أو ورقة، أو نموذج، أو شيء أنشئ أو استُعِمل بموجب التشريع السابق يظل مستعملًا كما كان قبل الإلغاء ما دام متسقًا مع التشريع الجديد.
- كل إجراء يتخذ بموجب التشريع السابق يُدرَج مباشرة تحت سلطة التشريع الجديد وبما يتماشى معه ما دام يمكننا فعل ذلك بشكل متسق مع التشريع الجديد.
- إذا خُفِّفت عقوبة، أو جزاء، أو خُفِّضت مصادرة بموجب التشريع الجديد، فإن العقوبة أو الجزاء تُخفَّف ،والمصادرة تخفَّض بالتبعية إذا فُرضِت أو أخذت حكمًا نهائيًّا بعد الإلغاء.
- جميع الاتفاقات الناشئة بموجب التشريع السابق تظل قيد التنفيذ، وتُعتَبر كأنها ناشئة بموجب التشريع الجديد، ما لم تكن غير متسقة مع التشريع الجديد، حتى يُلْغَى أو يحل غيرها محلها.
تاسعًا: ضوابط الخروج عن المعاني المعتادة للكلمات
قد يجد المفسر نفسه مضطرًا للخروج عن المعنى المعتاد للكلمة لدواع كثيرة، وهو ما يسمى في أصول الفقه بالتأويل، وقد وضَّح المصنف أن مجرد الظن بأن البرلمان خامره مقصود معين، ولو كان طبيعيًّا لم يتجسد في كلمات استخدمها بتفسيرها تفسيرا نصيًّا، لن يكون سببًا كافيًا للخروج عن هذا التفسير النصي[11].
يجب تفسير القانون بما يُبعده قدر الإمكان عن الاضطراب وعدم الاتساق بين معطياته المختلفة.
وإنما يتم الخروج إذا وجد المفسر ما يلي:
- إذا كان هناك شذوذ تام أو إذا كان هناك جزء من الألفاظ واضح المعنى، وجزء شاذ تمامًا أو غريب، فإن للمحكمة أن تُقرِّر أن المعنى المعتاد أو الطبيعي لهذه الألفاظ ليس هو المعنى الحقيقي المراد.
- أو شيء من التناقض أو الاضطراب أو غياب المنطق بين كلمات التشريع.
- أو عدم الاتساق مع المقاصد المعلنة للمؤلف، وهي تلك التي تُستَخرج من الوثيقة كلها بعد قراءتها.
- إذا كان هناك خروج عن معنى العدالة.
والسبل التي يتبعها المفسر ما يلي:
يجب تفسير القانون بما يُبعده قدر الإمكان عن الاضطراب وعدم الاتساق بين معطياته المختلفة، والقيد على القاعدة الذهبية في هذا هو بوضوح:
- إذا نشأ من قراءة كلمات التشريع في معناها النحوي والمعتاد عدم اتساق فلا بُدَّ من عمل شيء يحدث عند التجانس. وذلك بطريق التقييد، أو تعديل التركيب النحوي، أو بطريق تحوير الكلمات أو بطريق حذف الكلمات أو بطريقة الاستثناء أو تضييق النطاق[12] «يمكن أن يُعدَّل المعنى، أو يمتد إلى غيره، أو يُلغَى للبعد عن نتائج معينة دون تجاوز ذلك».
- إذا كانت لغة التشريع غامضة ومحتملة لمعنييْن يتفق أحدهما مع معنى العدل والخير، في حين يؤدي الآخر إلى نتائج مبالغ فيها، فإن على محكمة القانون أن تتجه إلى تبني المعنى الأول، ورفض الأخير حتى لو كان هو المعنى الأقرب إلى المعنى الظاهر للكلمات المستعملة.
- العموم في الكلمات قد يُحدَّد بالقيود الصريحة أو الضمنية التي توجبها سياسة القانون، وبالأخص فيما لو كان التفسير الذي سيطلق النص إلى منتهاه سيؤدي إلى التناقض أو عدم التناسق في محتويات النص.
- السياق الموضوعي هو القانون الذي سنّه المشرّع، كما أن السياق اللفظي هو الكلمات، والتركيب النحوي المستخدم في التعبير عن القانون، ومن الضروري على الدوام أن نقرأ كلمات أي بند معين على ضوء السياق الموضوعي بسبب أنه إذا كان هناك تعارض بينهما، فإن السياق الموضوعي هو الذي يلزم تغليبه على السياق اللفظي ضرورة.
عاشرًا: محل الأثر القانوني وقواعد عامة
- إن النص القانوني يسري على المستقبل، ولا يسري على الماضي بأثر رجعي إلا إذا وجد نص بخلاف ذلك.
- لاتمس أحكام القانون الشخصي حقوق أي شخص آخر إلا إذا ذكر ذلك فيها أو أُشير إليها.
- تُعَدُّ كل التشريعات جابرة للضرر، وتُمنح التفسير والتأويل العادل الواسع والحر، الذي يؤكد أفضل تحقيق لمقاصدها.
- يُعَدُّ القانون ناطقًا دائمًا، ويجب تطبيق كل ما يعبر عنه بصيغة المضارع على الظروف التي تطرأ، بحيث يمكن إعطاء الأثر للتشريع، ولكل جزء فيه وفقًا لروحه ومقصده من ورائه ومعناه الحقيقي.
أظن بهذا الترتيب الذي سبق يكون الكتاب قد أنجز دوره المطلوب، وأوضح في عبارات جامعة جزءًا كبيرًا من المنهج الذي لا بُدَّ أن يضعه المُفسر نصب عينيه.
الهوامش
[1] انظر: أصول القانون، لعبد الرزاق السنهوري، وأحمد حشمت، ص163.
[2] حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، ط2، 1402، 1981م، والملكية الأدبية، للصدة، طبعة معهد الدراسات العربية.
[3] النظريات الفقهية للدريني، ص13.
[4] التقاء الشرائع وتقارب القوانين، للدكتور محمد فايز، ص113.
[5] انظر: الشريعة والمصلحة الاجتماعية، مقارنة بين تاريخ الفكر القانوني والفقه الإسلامي، د. محمد نور فرحات، المجلة الجنائية القومية، العدد 19، مارس 1976م.
[6] انظر: مقالات السنهوري (1/118). والشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، للدكتور صوفي أبو طالب، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عام 1995م.
[7] مشكلة أصحاب القراءة المستنيرة للنصوص أنهم لا يفرقون بين النظام وبين تنزيله على الدنيا، فكثيرًا ما يهرعون إلى النص وينتقدونه، بل ويمتد الأمر ببعضهم إلى حد القول بحذفه، فالنظام ثابت لا يتغير، وهذه قاعدة عند كل النظم، وإنما نوفق بين النص والواقع من خلال أدوات مستوحاة من النظام ذاته. إن وظيفتنا هي تفسير القانون وليس تغييره، وكذلك في تعاملنا مع النص المقدس.
[8] بصورة عامة عند تحديد معنى كلمة معينة من قانون معين صادر عن البرلمان لا بُدَّ من اعتبار نقطتَين: الدليل الخارجي المستمد من الظروف الخارجية مثل القانون السابق، والقضايا المحكوم فيها، الدليل الداخلي المستمد من القانون نفسه.
[9] ولعل النية المفترضة تكلم عنها الأصوليون فيما يعرف بالمناسب المرسل.
[10] لا شك أن قضايا العام والخاص، المطلق والمقيد لها مساحة أكبر من ذلك في أصول الفقه، الذي يجب أن نعتني به هو مد حقل تفسير القانون بهذه القواعد أو بعبارة أخرى تعميق هذا الجانب لدى القانونيين مع مراعاة أن يكون لتلك القواعد بُعد تطبيقي مثمر. فلا نختذلها في هذه النقاط الضامرة ولا نتوسع فيها بصورة نظرية فلسفية.
[11] وهذا ما أشار إليه الأصوليون من أن المصالح المعتبرة تتقيد بالنصوص.
[12] وأظن دلالة الاقتضاء وما شابهها تدور في هذا الفلك من البحث عن معنى مقبول.