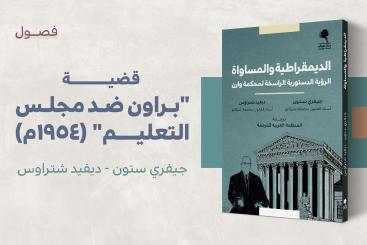القيود التعاقدية على الحرية الفردية للعمل في القضاء الإنجليزي

تندرج هذه الدراسة التي بين أيدينا تحت الدراسات المقارنة، التي تُعَدُّ من الحقول العلمية المهمة التي بدأت تظهر مع انعقاد أوَّل مؤتمر للقانون المقارن عام 1900م، وقد برز الأستاذان «إدوارد لامبير» و«ريمون سالي» بوصفهما أهمَّ المدافعين عن القانون المقارن، وأبرز الداعين إلى جعله علمًا قائمًا بذاته في الموضوع والمنهج والغاية. والقانون المقارن اصطلاحًا: هو»العلم الذي يتناول بالدراسة المقارنة بين نظامَيْن قانونيَّيْن أو أكثر بصدد موضوع أو مشكلة معينة بهدف استخلاص أوجه التشابه والاختلاف بينهما، أو بقصد إبراز المفاهيم والأفكار وأساليب الصياغة القانونية والوقوف على العوامل والمؤثرات التي جعلت لكل شريعة طابعها المميز وسماتها الخاصة»[1].
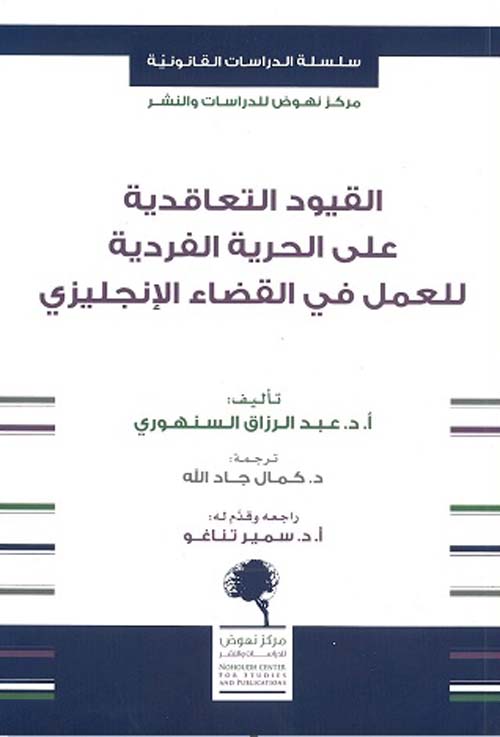
أما الموضوع: فهو القوانين المختلفة زمانًا ومكانًا، وأما المنهج: فهو الطريقة المقارنة، وأما الغاية: فهي البحث والتأمل في القوانين لتوحيدها أو استخلاص العناصر المهمة منها لترقية النظم المحلية وإسعاف القاضي بأقوى الحلول التي تُحقِّق العدالة.
ولقد توالت مؤتمرات القانون المقارن، ففي مؤتمر لاهاي عام 1937م أُدْرِجت الشريعة بوصفها مصدرًا من مصادر القانون المقارن، وبهذا تصير مصادر القانون المقارن أربعة: القوانين الفرنسية والألمانية والإنجليزية والشريعة الإسلامية.
في مؤتمر القانون المقارن المنعقد بلاهاي عام 1938م، دُعي مندوبون من الأزهر تكلموا فيه عن موضوعات قانونية منها بحث «المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في الإسلام» لمحمود شلتوت، وعن نفي كل علاقة مزعومة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية، وقد سجل المؤتمر هذا القرار المهم: اعتبار الشريعة مصدرًا من مصادر التشريع، وأنها حية قابلة للتطور، وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذًا من غيره.
وفي المؤتمر الدولي للقانون بواشنطن عام 1945م، الذي كان غرضه وضع مشروع القانون النظامي لمحكمة العدل الدولية، نصت المادة (9) على أنه: «عند انتخاب أعضاء المحكمة يجب أن يُرَاعى فيها أنهم يُمثِّلون مختلف الديانات الكبرى والنظم القانونية الأساسية في العالم فضلًا عمَّا يلزم من توافر الشروط والكفايات المقررة»، وتقدَّم المبعوثون المصريون -وعلى رأسهم وزير العدل المصري الأستاذ محمد حافظ رمضان- واستندوا إلى قرارات المؤتمرات الدولية السابقة التي قررت أن الشريعة تُمثِّل مدنية الإسلام، سواء من حيث ماضيها المجيد أو حاضرها المزدهر، وأنها ضرب من ضروب الديانات الكبرى، وختم تقريرهم بقولهم: «ومن جهة أخرى فإن الشريعة الإسلامية التي يخضع لها قسم مهم من سكان الأرض هي نظام قانوني قائم بذاته له مصادره، وطلبوا -بناء على هذا- أن يُخْتار قاض يُمثِّل الشريعة الإسلامية في محكمة العدل الدولية، وقد سبق أن نوَّهت بهذا المعنى حكومات الدول الإسلامية بالشرق الأوسط في الخطابات التي أرسلتها إلى السكرتير العام لعصبة الأمم في سبتمبر 1939م، وكانت نتيجة ذلك أن قبل المبدأ واحتفظ للأمة الإسلامية بعضو يُمثِّلها في المحكمة الدولية وهو الدكتور عبد الحميد بدوي»[2].
وتُعَدُّ الرسالة التي أنجزها العلامة القانوني عبد الرزاق السنهوري من الدراسات المهمة في مجال هذا الحقل الجديد وصدى قويًّا له، خاصة أنه من أبرز الطلبة لدى «لامبير» أحد مؤسسي هذا الفن، وقد اختار السنهوري مقارنته بين نظامَيْن من أهم النظم في عالم القوانين وهما: النظام الفرنسي والإنجليزي.
وهي من جانب آخر تُثير كثيرًا من التساؤلات العميقة، لعل أبرزها لماذا اختار السنهوري القضاء الإنجليزي بالتحديد ليقارنه بالقانون الفرنسي وفي قلب فرنسا؟ وهل هذه الدراسة كان لها مردود على تعديلات القانون المدني المصري، ثم التعديلات القانونية الأخرى في المنطقة؟ أو هل لنا أن نتساءل بصورة أكثر وضوحًا، هل لهذه الدراسة علاقة بالنزعة الاستقلالية لدى السنهوري ورغبته في التخلّص من القانون الفرنسي من خلال إظهار قصوره في بعض الجوانب ليُحرجَه في عقر داره، وتكون تلك البحوث الموضوعية أدلة دامغة على ضرورة التخلص منه أو على الأقل تعديله فيما يتعلق بقوانيننا المدنية التي يُهيمن عليها؟ سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات في جزئية (أبرز القضايا التي يُثيرها الكتاب).
عود على بدء أقول: إن الكتاب الصادر عن مركز نهوض أصله رسالة دكتوراه ناقشها السنهوري عام 1925م في فرنسا، وهي دراسة يحاول فيها السنهوري أن يجد حلًّا لقضية تتنازعها العديد من الفلسفات، وهي إيجاد التوازن بين الحرية الفردية في العمل والقيود التعاقدية التي يفرضها صاحب العمل عليه بُغية تفادي المنافسة، وهي قضية اجتماعية تكشف عن الصراع الدائر في فلسفة القانون بين مصلحة الفرد ومصلحة رأس المال.
وعلى الرغم من أن قضية التعارض بين القيود التعاقدية وحرية العمل هي الأساس في الدراسة، فإن الكتاب في الصورة التي أخرجها مركز نهوض يُعَدُّ ثلاث دراسات في كتاب واحد، الأولى: عن السنهوري ومشروعه النهضوي، والثانية: عن فكرة المعيارية ودورها في تطوير القوانين، والثالثة: معالجة التعارض بين القيود التعاقدية وحرية العمل، ويمكننا أن نضع مخططًا مجملًا لهذه الدراسة يُبيّن أهميتها ويعقبه تفصيل لأهم ما أُثِير فيها، وجلاء ما وضح ظاهره وخفي غرضه وأثره في حركة التقنين المحلية والعالمية.
المخطط الإجمالي للكتاب وأهميته
أولًا: المشروع النهضوي للسنهوري
في الجزء الأول دراسة كاملة عن أهم شخصية تاريخية في مجال القانون الحديث لها أثر في كافة الأصعدة الإصلاحية، ألا وهو السنهوري الذي ولد في الإسكندرية عام 1895م، واستطاعت هذه المقدمة العميقة أن تُبْرِز عدة نقاط أساسية أبرزها:
تجسيد معنى العِصامية في حياة رجل استطاع أن ينهض بقضايا ينوء بها العصبة أولو القوة.
توضيح الجوانب الإصلاحية التي اهتم بها السنهوري وهي تتمثَّل في عدة نقاط:
-
النهوض بالشريعة وجعلها صالحة للتقنين.
-
النهوض بالوضع الاقتصادي والمالي.
-
النهوض بحالة المرأة الاجتماعية والتعليم.
-
الاهتمام باللغة العربية وتطوير دراستها.
-
الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتقريب الفروق بينها، ومساندة الفلاح في قوانين الإصلاح الزراعي.
إنها تكشف لنا كيف يُمكن أن يربط الرجل الإصلاحي بين أهدافه وأعماله الأكاديمية، فرسالته عن «الخلافة» تكشف عن هدفه للوحدة القانونية التي أرادها للوطن العربي، ورسالته عن «القيود» تكشف عن أهدافه لإصلاح الوضع الاجتماعي للعمال، وعن منهجه الذي سيسير عليه في قضية التوازن بين البند القانوني وحرية القاضي المتمثِّلة في تطبيق المعايير المرنة.
إنها تُبْرِز إسهامه بقسط كبير جدًّا في تحرير القوانين العربية من الشرائع اللَّاتينية التي كانت جاثمة على رئة مجتمعاتنا العربية، فغيَّرت هويتها الثقافية بصورة عامة وهويتها القانونية بصورة خاصة، لكن السنهوري استطاع أن يصنع قانونًا عربيًّا خالصًا، وحاول أن يجعل معظم آرائه ذات صبغة إسلامية -حسب الحدود المتاحة على الصعيد السياسي- ومن يقرأ القانون المدني العراقي يُدرك أن السنهوري أراد أن يجعل الفقه الإسلامي هو الرابط الأساسي لكافة القوانين العربية[3].
القانون ليس كلمة المشرِّع يقول فيه كُن فيكون، لكنه كائن حي ينشأ ويترعرع حتى يبلغ أشده، وليس هو خلق الساعة ولا وحي الإرادة.
إن ما فعله السنهوري ليس نتاج تعصب لثقافة ما، ولكن السنهوري متأثر بعلم اجتماع القانون[4] الذي يُرشدنا -كما يوضح- إلى أن القانون هو نبت البيئة، وغرس الأجيال المتعاقبة يتطور من مرحلة إلى مرحلة، ويتخطى أعناق القرون تُسلّمه الآباء للأبناء والأبناء للأحفاد، وهو في كل مرحلة ينضج ويصطبغ بلونها، فهو عصارة الحضارة وظاهرة اجتماعية تتكيف وفقًا لمقتضيات البيئة، وينبع من خصائص كل مجتمع[5]. فهو ليس كلمة المشرِّع يقول فيه كُن فيكون، لكنه كائن حي ينشأ ويترعرع حتى يبلغ أشده، وليس هو خلق الساعة ولا وحي الإرادة، فإذا أُريد وضع قانون لبلد ما فلا بُدَّ أن يكون متصل الحلقات بالماضي وتُراثه بالقدر الذي ينبغي أن يتطلع فيه إلى المستقبل، بل القانون لا يُشرّع إلا وفقًا لحاجة الشعوب ووفقًا لواقع الحال، ولا شك أن الشريعة هي تُراث هذا المجتمع الذي يجب أن تعود إليه مؤسسات صناعة القوانين[6].
ثانيًا: المعيار القانوني
تتناول الدراسة في جزئها الثاني الحديث عن المعيار القانوني الذي وصل إليه القانون الإنجليزي في آخر مراحل تطوره -وسنُشير إليه بصورة جلية للقارئ بعد قليل- وهي دراسة توضح الفرق بين القاعدة القانونية والمعيار، والدور الذي يقوم به كل منهما والمجال الذي يُطبَّق فيه، وأثر العناية بالمعيار في تطوير القضاء وتحقيق سبل العدالة، كما استطاع أن يُدافع في دراسته عن فكرة المعيار تجاه كل الانتقادات التي وُجِّهت إليه.
والدليل على أهمية هذه الدراسة أن العلامة (موريس هوريو) أحد علماء القانون المقارن كتب عنها تعليقًا في أهم مجلات القانون المدني، وذكر في الفصل الثالث أن تَفرقة السنهوري بين المعيار والقاعدة يمكن أن تؤثر في نظام القانون الوضعي كله، وقد اتخذها أساسًا لنظريته الشهيرة، بل وأصبحت هذه الدراسات ضمن الكتابات الأولى الجادة في حقل القانون المقارن التي أشاد بكاتبها مؤسس هذا الفن العلَّامة لامبير.
ثالثًا: الموازنة بين حرية القيود التعاقدية وحرية العمل
إن الجزء الثالث من هذه الدراسة يُعَدُّ عصب الكتاب، الذي يُعَدُّ صورة تطبيقية للإصلاح التشريعي في فكر السنهوري، وصورة تطبيقية لفكرة المعيار التي استطاع من خلالها أن يجد توازنًا بين حرية الشروط التعاقدية وحرية العمل -كما سنُبيِّن لاحقًا- فمن استجلب عاملًا ضعيف الخبرة في مصنع ما، واستطاع أن يُثْقِل من مهاراته، هل له أن يشترط عليه ألَّا يُمارس هذه المهنة لمدة كذا في مكان كذا؟ نحن هنا بين شقَّيْن أحدهما: حرية الشروط التعاقدية، والآخر: حرية العمل وإرساء مبدأ التنافس، وقد استطاع السنهوري أن يأخذ بأيدنا خطوة بخطوة بداية من التطورات الأولى للقضية وصولًا إلى قمة طورها، ليحلّها عن طريقة معيار المعقولية -كما سيتضح- ولم يقف السنهوري عند هذا الحد، بل أقام مقارنة منهجية تطبيقية بين القانون الفرنسي والقضاء الإنجليزي في صورة موضوعية، يُبيِّن فيها كيف عُولِجَت القضية في النظامَيْن، وهو في رحلته من قضية المعيار حتى المقارنة بين النظامَيْن يضرب العديد من الأمثلة التطبيقية من القضايا الحيَّة ويُحلِّلها.

د. عبد الرزاق السنهوري
وكما هو ظاهر فإن السنهوري استخدم المنهج التاريخي في تتبع المشكلة، والمنهج التحليلي عند النظر في عمل القضاء، كما جمع بين التنظير التجريدي للنظرية مع المنهج التطبيقي، ليكشف عن قدرتها على حل هذه الإشكالية بين حرية العقود وحرية العمل.
وإن كان لي نقد للكتاب الذي بين أيدينا، فهو أنه من المفترض أن يكون بعنوان «الصياغة المرنة ودورها في تطوير القانون وعمل القضاء» وأن يجعل قضية القيود التعاقدية وحرية العمل نموذجًا تطبيقيًّا لما يمكن أن تُحدِثه النظرية الحديثة من نجاح في فض كثير من الإشكالات الاجتماعية في العلاقات المدنية.
أبرز القضايا التي يُثيرها الكتاب
يُمكننا بعد الوصف الإجمالي للكتاب أن نُفصِّل في بعض القضايا المهمة بصورة أكبر وضوحًا حتى يكون قارئ الكتاب على بينة من أمرها:
المعيار القانوني ودوره في تطوير القضاء
لا بُدَّ ونحن نطالع هذا الكتاب أن نعرف أن هناك تيارَيْن بارزَيْن في الصياغة القانونية، الأول: تيار الصياغة القانونية المجردة، وهي التي تعتمد على التقنين بحيث يواجه كل الحالات بقاعدة واحدة صارمة، والثاني: تيار آخر من شأنه أن يضع معايير مرنة تجعل القاضي يتمكن من مواجهة كل قضية على حدة، ويندرج تحت التيار الأول القوانين اللَّاتينة خاصة الفرنسي منها، ويندرج تحت التيار الثاني القوانين الأنجلوسكسونية خاصة القضاء الإنجليزي.
أ-توضيح معنى المعيار والقاعدة
يُعرَّف المعيار بأنه: توجه عام وخط عريض للسلوك، فهو يُرشد القاضي في تطبيق القانون، ويجعله يفهم روح النظام القانوني ومقصده، تاركًا له حرية التصرف والسلطة التقديرية حتى يستطيع تنزيل القانون على الوقائع الموجودة.
أما القاعدة فإنها: تضع حلًّا تفصيليًّا في كل حالة، ويمكن من خلال مجموعة من القواعد أن نُكوّن ما يُسمَّى بالمبدأ الذي يقوم بتجميع عدد من القواعد التي تجمعها فكرة واحدة مشتركة[7].
ب- الفرق بين عمل المعيار والقاعدة القانونية
إن القاعدة تتم من خلال مجموعة من المقدمات والنتائج المنطقية، فنحصل على عمل ضخم يبدو منطقيًّا وبراقًا، لكنه في الحقيقة بعيد عن التأثير الخارجي وعن فكرة العدالة والإنصاف والفائدة الاجتماعية، فهي تنطبق بطريقة آلية على كل الحالات التي تدخل فيها، أما المعيار فهو الطريقة الجديدة التي نحاول من خلالها تحقيق عملية التأقلم فلا نُعالج المرضى كلهم بدواء واحد.
إن القاعدة تُعطِي حلًّا ثابتًا لفرض معين، أما المعيار فليس فيه هذا التحديد أو الجمود، فهو فقط طريق طويل للسلوك ومعيار عام يسترشد به القاضي، ففرق بين أن نقول: إن سن الرشد يتم بالوصول إلى عمر كذا، وبين وضعه تحت قدرته على التصرف وتولي أمور ذاته بصورة سليمة رشيدة لا طيش فيها.
إن عمل القاضي تحت تأثير القاعدة القانونية يتمركز حول التحقق من الشروط المحددة، ويقتصر دوره حينئذ على تطبيق القاعدة بطريقة ميكانيكية، أما عند تطبيق المعيار فإن عليه أن يمارس سلطة تقديرية ويتحلَّى بحاسة الخبير، وهو هنا لا يقوم بعمل آلي أعمى، بل يقوم بعمل عقلي بارع، وهو لا يُعطي الحل الثابت نفسه في جميع الأحوال، ولكنه يُعطي حلولًا مختلفة مع خصوصية الوقائع المعروضة عليه، أي إن المنطق الخالص هو الذي يحكم تطبيق القاعدة، أما الإحساس والخبرة فيحتلان مكان القاعدة عند تطبيق المعيار.
ج- مجال كلّ من المعيار والقاعدة
لكل من القاعدة والمعيار مجال محدَّد، فالمعيار يكون في المجالات التي تحتاج إلى التأقلم والتطور أكثر من الحاجة إلى الأمان والاستقرار، مثل مجالات النشاط الاقتصادي والعلاقة بين الطبقات الاجتماعية، أو بين رأس المال والعمل، أما القاعدة فتظهر في تعريف الجريمة وفي القانون الجنائي والشكليات والمواعيد في قانون المرافعات والحقوق العينية وأحكام الأسرة في القانون المدني .
د- أهمية العناية بقضية المعيار وتطبيقاتها في القانون المدني المصري
إن الاهتمام بالمعيار يُغيِِّر الفكرة التي كانت سائدة بأن أهم شيء في القانون الخاص هو الاستقرار، الذي يمكن التضحية بأي شيء آخر في سبيله، لكن اتضح أن هذا مجرد خيال فلا يوجد استقرار مع قانون ثابت لا يُجاري متقلَّبات الحياة، فالمواكبة والتقارُب بين القانون والحياة أهم من تحقيق الاستقرار.
تمكن السنهوري من تحقيق المعادلة بين فلسفتَيْن متنازعتَيْن في النظام القانوني وهما: الحاجة إلى الثبات والاستقرار، والحاجة إلى المرونة والتأقلم.
وإذا كان السنهوري أورد اعتراضًا بأن إطلاق يدَ القاضي في تطبيق المعايير قد يؤدي إلى التحكم الذاتي، وتطبيق مذهبه الشخصي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع تنحية دور محكمة النقض في هذا الدور مما يؤدي إلى أقصى درجات الخطر، فإنه من ناحية أخرى يؤكد أن القاعدة وحدها لا تؤدي إلى الاستقرار، ولهذا لجأ السنهوري إلى ما يُسمى بالاستقرار النسبي، وهو الذي يعتمد فيه على المعايير العامة داخل القاعدة القانونية ذاتها، فهو هنا يؤلف بين منهجَيْن: الجمع بين القاعدة القانونية والمعيار فيما يسميه «الصياغة المرنة»، وهذه من أفكاره المهمة التي كانت لها شأن في تطوير الصياغة القانونية في العصر الحديث، بحيث يترك مساحة للقاضي يتدخل فيها وينفذ منها إلى العدالة، وبهذا يتمكن السنهوري من تحقيق المعادلة بين فلسفتَيْن متنازعتَيْن في النظام القانوني وهما: الحاجة إلى الثبات والاستقرار، والحاجة إلى المرونة والتأقلم.
الأمثلة التطبيقية عن الموازنة بين القاعدة والمعيار في فكر السنهوري
كنت أود في الحقيقة أن يذكر السنهوري أمثلة على إحداث التوازن بين القاعدة والمعيار؛ لأنه يُؤسِّس نظرية لم يُسْبَق إليها بهذه الطريقة، وهو أنه يجمع بين النظام اللَّاتيني بقواعده الصارمة غالبًا، والنظام الإنجليزي بمرونته المفرطة في بوتقة واحدة، ولعل العذر أنه لم يكن أنجز القانون المدني المصري، فالرسالة كانت وقت تحصيله العلمي خارج البلاد، لكنني مع البحث والتنقيب توصلت إلى بعض المواد التي جمعت بين القاعدة والمعيار في آن واحد، وأنا هنا لا أدعي أن السنهوري سار على الوتيرة نفسها في معظم القانون المدني، ولكنه طرق الباب على الأقل وطبَّق كثيرًا من أهداف هذه الفكرة على المستويَيْن النظري والتطبيقي.
فعلي المستوى النظري: فرَّق بين الصياغة الجامدة والمرنة في كتاباته الأصولية، فالصياغة الجامدة تتصف بأنها تُحدِّد المخاطب بالقاعدة القانونية، أو تُحدِّد الواقعة التي يكون بشأنها الخطاب، أو تُحدِّد أثر هذه الواقعة القانونية بوصف منضبط لا يترك فرصة للتقدير، ولا يدع مجالًا لاختلاف وجهات النظر[8].
وعلى المستوى التطبيقي على الصياغة المرنة -التي تجمع بين القاعدة والمعيار- نجد أن التقنين الجديد أورد في القواعد العامة أنه إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، فالغلط الذي يُخوّل طلب إبطال العقد هو الغلط الجوهري، ولكن متى يُعَدُّ الغلط جوهريًّا؟ فهذا متروك للقاضي يُقدِّره وفقًا للظروف، وما ذكره من أمثلة هو للاسترشاد فقط، وكل هذا حسب المعيار الذي وُضِع في صدر المادة (121): «من أن الغلط يكون جوهريًّا إذا بلغ حدًّا من الجسامة حيث يمتنع معه التعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط»[9].
كما نجد ذلك في تقدير التعويض المستحق للشخص المضرور. وذلك في حالة الدفاع الشرعي، فمن جاوز في هذا الدفاع القدر الضروري أصبح ملزمًا بتعويض تُراعى فيه مقتضيات العدالة (م166). وفي حالة الضرورة، فمن سبَّب ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر لا يكون ملزمًا إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبًا (م168). وفي تحديد طريقة التعويض، فيُعين القاضي هذه الطريقة تبعًا للظروف.
كل هذه مواد تكشف عن المذهب المرن الجديد للسنهوري، وهي توضِّح من زاوية أخرى الدور الذي تقوم به المقارنة بين الشرائع في تطوير القانون الوطني، فليس الغرض أن ننقل نموذجًا متطورًا، ولكن الغرض أن نَخرج من النظر الكلي للنظم الحديثة بقانون أو نظريات أو صياغة من شأنها إحداث الترقية الذاتية لمجتمعاتنا بما تقبله أصولها وفلسفاتها.
التوازن بين حرية القيود التعاقدية وحرية العمل
تُعَدُّ هذه القضية التي عالجها السنهوري تطبيقًا عمليًّا لما يمكن أن يقوم به المعيار في حل العديد من القضايا بصورة تُحقِّق العدالة الاجتماعية، وكي نتمكن من إبراز الدور الفعال في حلها، علينا أن نصوغها بصورة أكثر تركيزًا، وأن نُجرّدها بصورة نظرية من هيكل القضايا التي فتَّت تماسكها -وإن كان لها دور في شخصنتها- على النحو الآتي:
تصور المسألة: هناك رب عمل يوظِّف عاملًا في خدمته، وبافتراض أن هذا العامل يمكن أن يُصبح منافسًا في المستقبل، يضمن رب العمل بندًا يحظر على هذا العامل أن ينافسه فيما بعد.
إشكالية المسألة: هذه المسألة تكشف عن التعارض بين مبدأَيْن، الأول: حرية التعاقد التي تُخوّل للمرء أن يفرض ما يشاء من القيود التعاقدية التي في صالحه. والثاني: مبدأ حرية العمل التي هي صفة لصيقة بشخصية العامل، وهي غالبًا مصدر رزقه وبفقدها أو شلّها يصبح عالة على المجتمع، ويُحرَم المجتمع ذاته عضوًا نشطًا يُسهم في إحداث منافسة شريفة تمنع الاحتكار العام.
الفلسفة التي ينمّ عنها هذا التعارض
في الحقيقة نحن في هذا الكتاب لسنا أمام مبدأَيْن عابرَيْن على هامش التعاملات، لكننا أمام حل لإشكالية صراع بين مذهبَيْن كبيرَيْن في الحياة الغربية، إنه الصراع الدائم بين مصلحة الفرد ومصلحة المشروع، أو بصورة أدق الصراع بين العامل ورأس المال.
دور القضاء الإنجليزي في معالجة القضية
تمكَّن السنهوري من خلال رصده الدقيق للقضية أن يُبْرِز مراحل تطور القضاء الإنجليزي في حل هذه المشكلة، وهو هنا يُشير إلى صورة القانون الناضج الذي تغلُب فيه عناصر البقاء بصورة حية على عناصر الاستقرار، وعن الاستماتة الفكرية لدى قضاته في إيجاد مجتمع متوازن يُحقِّق العدالة أكثر من تحقيق العدل، لقد مرَّ الفقه الإنجليزي تجاه هذه القضية بالمراحل التالية:
في البداية كان القضاء الإنجليزي يعدّ كل قيد على حرية العمل غير قانوني، ولم يكن الصراع بين رأس المال والعمل ملموسًا، وكان يكفي لحسم الصراع قاعدة ثابتة ومحدَّدة هي حسم الانتصار لحرية العمل فلا تُفرض قيود عليها.
ومع تقدم الحياة وتشابكها وبداية الصراع اضطر القضاء الإنجليزي أن يُخفِّف من غلواء القاعدة السابقة حين سلَّم إلى حد ما بصحة القيود الجزئية، لكنه مع ذلك كان بإزاء قواعد صارمة لا تُمكِّنه من إجراء العدالة بصورة واضحة.
قد يستعين القضاء بعناصر خارجية للوصول إلى أكبر صور العدالة.
صورة الحل العادل: بما أن النظام العام يقضي بحرية التعاقد وحرية العمل، وبما أن القانون علم يهدف إلى المصالحة بين الأفكار المتعارضة، فلا بُدَّ أن نتخذ حلًّا وسطًا يتجسد في التضحية بجزء من حرية كلّ منهما، بهدف تعايش الحريتَيْن على هذه الأرضية من النظام العام، ولقد استطاع القانون الإنجليزي في مراحله الأخيرة من عدم الاعتراف بالقواعد المحددة التي تشل حركته، بل تمكَّن من تبني توجهٍ عامٍّ يكمن في معيار «المعقولية» الذي استطاع التوافق مع الظروف الاقتصادية المتنوعة، فكون القيد جزئيًّا أو عامًّا، صالحًا أو غير صالح، أمر يتوقف على معقولية القيد من خلال دارسة دقيقة لكل حالة والنظر إلى الواقع، وعدم النظر إلى كل المهن بفروعها المختلفة من صناعية وتجارية نظرة واحدة، أو مواجهة ظروفها إذا كانت مختلفة بحكم واحد، فالمشروع الذي له طبيعة عامة وزبائن منتشرون بطول البلاد أو العالم كله، يحتاج بالتأكيد إلى حماية أكثر اتساعًا مما يتطلبه مشروع محلي، وقد يستعين القضاء بعناصر خارجية للوصول إلى أكبر صور العدالة، وقد نفذ هذا التوجه إلى عدد من الأمور، وحلَّل بدقة العلاقات والمواقف الاقتصادية، ليحمي من بين المصالح الكثيرة المتصارعة المصالحَ المعقولة، وبفضل مرونة المعيار حدث توازن أكثر انضباطًا وتناغمًا وملائمة للحقائق الاقتصادية، وذلك بين مبدأ حرية القيود التعاقدية وحرية العمل.
مقارنة بين القانون الفرنسي والإنجليزي في التعامل مع قضية العقود
هذه هي القضية الثالثة التي عالجها الكتاب، ومن يقرأ الكتاب سيجد نفسه أمام مقارنة بين عائلتَيْن كبيرتَيْن دون أن يدري سبب هذا الخلاف في التعامل؛ لذا علينا أن نضع تصورًا عامًّا لطبيعة كلا النظامَيْن ثم نذكر طريقة كل منهما في المعالجة.
أ- تصور عام عن النظام الفرنسي والإنجليزي
إن القوانين الفرنسية تُعَدُّ الوريث للقانون الروماني القديم الذي طُوِّر بشكل ملحوظ على مستوى الصياغة أو المضمون، وقد لعب الفقهاء والقضاة دورًا غير قليل في تطويرها مما ساعد على نشرها، واستجابتها لمقتضيات حياة الشعوب، كما أن ازدهار حركة التقنين كانت وراء انتشارها بصورة كبيرة، وتمتاز هذه الشريعة بتعدُّد مصادرها، مثل التشريع واللوائح والعرف والعادات والقضاء والفقه.
وهو قانون يعتمد على التقنين والمنطقية في ترتيبه، والاعتماد على نظرية الالتزام في التقسيمات الكبرى له، كما يعتمد على نظام قضائي متدرج، وهو يغلب عليه المحافظة على الاستقرار أكثر من تحقيق المواكبة، ويحاول قضاته من وقت لآخر تحقيق روح العدالة من خلال المقاربة بين النص والواقع.
ولقد استوحت كثير من الدول في أغلب القارات هذا النظام القانوني المعاصر في إنشاء وتطوير نظمها ومواكبة احتياجاتها ومقتضياتها المحلية، ومن هذه الشريعة برزت نظم قانونية في العديد من الدول مثل: ألمانيا، وأسبانيا وفرنسا وإيطاليا[10]، وهذه القوانين على الاختلاف بينها في النزعة لكنها تتَّحد في التقسيمات والاصطلاحات القانونية.
وتجدُر الإشارة إلى أن القانون المدني المصري تأثر بصورة كبيرة بالقانون الفرنسي أحد أفراد عائلة القانون الروماني.
أما الشريعة الأنجلوسكسونية أو نظام القانون العام: فهو نظام قانوني مطبَّق في إنجلترا، ثم امتد ليُطبَّق في الدول التي تأثرت بنظمها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا، ويطلق على الأنظمة القانونية التي تأثرت بالنهج القانوني نظام الشريعة العامة أوالقانون العام (common law).
وتُعَدُّ من أبرز خصائص هذا النظام:
القِدم والاستمرارية: حيث يُلاحظ أن القانون في دول أوروبا قاطبة تقريبًا ينفصل عن الماضي بثورة أو بإعلان الاستقلال أو التقنين، إلا أن القانون في إنجلترا يعود بجذوره إلى القرن السادس الميلادي، والقانون الإنجليزي بهذه الخصوصية فريد من نوعه، فقواعده قديمة لا يمكن أن تفقد قوتها بمرور السنين، لدرجة أن هناك قضية فُصِل فيها سنة 1946م استنادًا إلى سابقة صادرة سنة 1381م.
عدم التقنين: فالقانون الإنجليزي قانون غير مقنَّن، في حين أن قوانين القارة الأوروبية لها تقنيناتها المعروفة، وهذا القول يجب ألَّا يؤخذ على إطلاقه، إذ نلاحظ أن بعض القوانين الفرنسية -وهي مهد التقنين- غير مقننة كالقانون الإداري، في حين أن بعض موضوعات القانون الإنجليزي مقننة كقانون السرقة مثلًا[11]، وهو يعتمد بصورة كبيرة على الطابع القضائي فأحكام السوابق القضائية تعتبر precedent بوصفها مصدرًا أساسيًّا ورسميًّا لمبادئه ونظرياته.
غلبة الطابع الإجرائي: من بين الملامح المهمة للشريعة العامة في القرون الوسطى غلبة الطابع الإجرائي على قواعدها، والتأكيد على أن التدبير القضائي هو الذي يخلق الحق وليس العكس، وبذلك فالشريعة العامة تبدأ من الإجراء لتصل إلى الحق.
وجود هيئة المحلِّفين: وهم مجموعة من المواطنين يدعون للمشاركة في مجلس القضاء مع رجاله، بعد حلفهم اليمين لسماع الدعوى وإصدار قرارهم في وقائعها، ليقوم القاضي بتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع، وقد سُمّوا بهذا الاسم بسبب تحليفهم قبل مباشرة مهمتهم. ويتخذ المحلِّفون صورتَيْن أساسيتَيْن: هيئة المحلفين الكبرى، وهيئة المحلفين الصغرى، والكبرى: مجموعة أشخاص تتكون من ثلاثة وعشرين شخصًا، يدعون من وقت إلى آخر بواسطة المحكمة للتحرّي عن الجرائم، فهي التي تقرِّر ما إذا كانت هناك أسباب محتملة للاعتقاد بأن شخصًا ما قد ارتكب جريمة معينة، وتُسمَّى بهيئة محلِّفي الاتهام، فهي تقوم بدور المدعي في توجيه قرار الاتهام. وأما الصغرى وتُسمَّى بهيئة محلِّفي المحاكمة، فهي عادة تتكون من اثنَي عشر شخصًا يُدعون للإسهام مع القضاة في سماع الدعوى والبتّ في وقائعها بإصدار قرار يُحدِّد مسؤولية الفاعل فيما إذا كان مذنبًا أم غير مذنب[12].
القضاء الموحَّد: فلا يوجد فيها قضاء متخصِّص في المنازعات الإدارية إلى جانب القضاء العادي، وذلك على أساس أن القضاء العادي بتكوينه واختصاصاته يُحقِّق ضمانًا أكبر للأفراد، إذ لا سلطان للإدارة عليه، وهو لا يخضع إلا لحكم القانون[13].
ب- تعامل النظامَيْن مع الموازنة بين مبدأ حرية العمل وحرية القيود التعاقدية
وضَّح السنهوري أن النظام الإنجليزي بدأ جامدًا مضطربًا، لكنه بتخلّصه من التقنين تمكَّن من تفعيل فكرة المعيار بصورة أكثر حيوية، أما القانون الفرنسي فقد اتفق مع القانون الإنجليزي في بدايته حيث وجد نفسه بين مبدأَيْن متناقضَيْن: حرية العمل التي كرَّستها المادة (7)، وحرية القيود التعاقدية التي كرَّستها المادة (1134).
وجاء القانون الإنجليزي في مرحلة ثانية ليقبل بعض البنود الجزئية بشروط، وهذه أيضًا توصَّل إليها القانون الفرنسي لكنها كانت أكثر صرامة، فقد كان يقبل كل الشروط الجزئية دون وضع ضوابط كما فعل القانون الإنجليزي الذي مكنته الشروط من إيجاد مرونة في القضية، لكن القانون الفرنسي توقف عند هذا الحد، في حين واصل القضاء الإنجليزي تطوره ليصل إلى فكرة المعيار ويُغرِّد وحده بعيدًا عن قيود القواعد.
ويُشير السنهوري إلى أن القانون الفرنسي استطاع بفضل قُضاته أن يُطوّع النظام -الذي يبدو صارمًا- لمتطلبات الحياة، ولم يطبق القاعدة في صرامتها إلا حين يتوافق المنطق مع الوقائع الاقتصادية في القضية المطروحة، ولم يشذ عن ذلك سوى القيود المعقولة، وعندما تؤدي القاعدة إلى نتائج غير معقولة أو سيئة اقتصاديًّا، فهنا لا يتردد القضاء في تطويعها، وكان يسترشد بحجة أو بأخرى، دون التصريح بذلك (معيار المعقولية)، مع ادعائه بأنه يُطبِّق القاعدة، وهو في ذلك يقترب من القضاء الإنجليزي بصورة غير مباشرة، حيث يعمل المعيار في الواقع دون الإقرار صراحة بنطاق النظرية.
إن المعيار المعقول في القانون الإنجليزي واجب التنفيذ، أما في القضاء الفرنسي فمحتمل التنفيذ.
وعلى الرغم من أن ما توصل إليه القضاء الفرنسي حقَّق ما وصل إليه القضاء الإنجليزي، فإن القضية تبقى في القضاء الفرنسي مُقلِقة وخاضعة لتقديرات القاضي، وربما لجأ العامل إلى التنفيذ الطوعي للبند المتعسف تجنبًا لصراع قضائي قد لا يمتلك فيه كل قاض المهارة اللازمة لإخضاع النص لقيم العدالة، أي إن المعيار المعقول في القانون الإنجليزي واجب التنفيذ، أما في القضاء الفرنسي فمحتمل التنفيذ، وإذا كان القانون المكتوب يُفسَّر بأمانة ووفقًا لإرادة المشرع فلا يُمكنه بمجرد التفسير أن يتوافق مع المواقف المختلفة التي عليه تنظيمها، فليس على المفسر عبء معالجة هذا الخطأ، بل تقع على المشرِّع نفسه مسؤولية صياغة القانون بشكل يسمح بإعطاء من يُطبّقه المرونة اللازمة لتوفيق النص مع المواقف المختلفة.
العلاقة بين نقد القانون الفرنسي والاستقلال التشريعي
نستطيع بعد توضيح أهم جوانب الكتاب أن نجيب عن التساؤل المُثار في المقدمة، وهو العلاقة بين نقد القانون الفرنسي والاستقلال التشريعي.
لقد كتب السنهوري عند عودته من بعثاته الخارجية مقالته الشهيرة «تنقيح القانون المصري». وفي هذه المقالة تمكَّن السنهوري من رصد أوجه النقد الموجه للقانون الفرنسي، ولا يسمح المقام ببسطها الآن، لكن ما فعله لا يدع مجالًا للشك في أنه أراد أن يُحدِث الاستقلال القانوني والقضائي للقوانين العربية، وأن يعود مرة أخرى للقضاء المصري بخلفايته الفقهية التي ترعرعت على أرضه، وكان لزامًا عليه لكي يُحْدِث هذه النقلة أن يُقنع العقول الموضوعية بأسباب دامغة توضح قصور القانون الفرنسي، وهذا ما ظهر مع مرور الزمن في كتاباته إبان صياغة القانون المدني العراقي، وفي كتابه الرائع «مصادر الحق» الذي واصل فيه نقضه للقانون الفرنسي، ليس من خلال مقارنته بالفقه الإسلامي وحسب، بل من خلال موازنته بالنظم الحديثة مثل القانون الألماني وغيره، وهو بذلك يُحرج القانون الفرنسي ويُعِيد الثقةَ للفقه الإسلامي، وفي دراسته هذه عن «القيود التعاقدية» نراه يُحرج القانون الفرنسي في عُقْر داره، وقد حوى الكتاب كثيرًا من عبارات الانتقاص الموضوعية لهذا النظام كعبارات (الجمود والعقم واللَّامبالاة)، ويقول في كتابه «نظرية العقد» علينا أولًا أن نُمصِّر الفقه ونجعله فقهًا مصريًّا خالصًا، نرى فيه طابع قوميتنا ونُحس أثر عقليتنا، ففقهنا حتى اليوم ما يزال -هو أيضًا- يحتله الأجنبي والاحتلال هنا فرنسي، وهو احتلال ليس بأخف وطأ ولا أقل عنتًا من أي أحتلال آخر، ما يزال الفقه المصري يتلمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد، لا يكاد يتزحزح عن أُفقه، أو ينحرف عن مسراه، فهو ظلّه اللَّاصق وتابعه الأمين، فإذا قُدِّر لنا أن نستقل بفقهنا وأن نُفرّغه في جو مصري يَشبّ فيه على قدم مصرية، وينمو بمقومات ذاتية، بقي علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرة العالمية، ونؤدي قسطًا مما تفرضه علينا الإنسانية ضريبة في تقدم الفقه العالمي أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون المقارن»[14].
الأمر الذي يظهر هدفه من البداية، ورغبته في حشد كل الأدلة على ضعفه ونقصه وتناقضه -كما يُردِّد كثيرًا- ولعل من أقوى الأدلة التي حاز عليها نيله درجة الدكتوراه في هذا الموضوع من فرنسا ذاتها التي أقرَّ فقهاؤها بضعف القانون الفرنسي، وقوة القانون الإنجليزي في هذه القضية.
إن الذين اتَّهموا السنهوري بأنه أدخل القوانين الغربية، وأخَّر الشريعة هم في الحقيقة غير مقدِّرين لمشروع السنهوري الكبير الذي قسَّمه إلى ثلاث مراحل، فبدأ بمرحلة أولى يستفيد منها بكل النظم، ثم يُقارن بينها وبين الشريعة ليطورها ثم يستمد من هذا المشروع قانونًا عربيًّا موحدًا مستمدًا من شريعة وفقه متطورَيْن قادرَيْن على قيادة المدنية الحديثة، وفي الوقت ذاته تتمكن من مغالبة قوانين غربية تدعي التطور والحداثة، فكل من هاجم السنهوري ومدرسته نظروا إلى الجزء الأول من المشروع واعتقدوا أنه المشروع كله، وهو في الحقيقة لبنة أولى يعقبها بنيان قائم على الشريعة في الأساس أو تمهيدًا لها من البداية.
إن الدراسات المقارنة تُسجل حقيقة لم يغفل عنها السنهوري وهي أنه طالما تمتَّعت النظم باستقلالها السياسي وبكتابات قانونية متطورة فإنها تُثْبت وجودها دون أن يكون هناك سبب للاعتقاد بأنها ستتقدم ضرورة في اتجاه النظم التي استفادت منها، وتشكَّلت من خلالها، فالمخاوف من اتجاه القانون المصري نحو الفقه الأجنبي مُنتفٍ[15].
وحتى لا يكون الكلام نظريًّا محضًا، ولكي نُبرهن على أن السنهوري أراد إحراج المشرِّع الفرنسي بالقوانين الغربية وإدهاش العالم القانوني بأن الشريعة تُضاهي ما توصَّلوا إليه بل تزيد، فلننظر إلى ما فعله في نظرية مسوؤلية عديم التمييز، فلقد سار مشروعه في هذه القضية على ثلاث خطوات:
الأولى: بيَّن أن القوانين تطورت تطورًا كبيرًا عمّا كانت عليه القوانين اللَّاتينية التي قالت بعدم مسؤولية عديم التمييز والمجنون معتمدة على المعيار النفسي في القضية.
الثانية: أثبت أن القوانين الحديثة كلها تقول بالمسؤولية عليهما من منطلق عقلي سديد مفاده: أن الروابط المدنية غير الروابط الجنائية، وإذا كان مفهوم ألَّا يعاقب شخص إلا إذا توافرت عنده الإرادة؛ لأن هذه الإرادة هي التي تُبرِّر المسؤولية الجنائية فليس بمفهوم أن شخصًا يتسبَّب في إلحاق ضرر بمال شخص آخر ولا يُعوض عن الضرر بدعوى أن الإرادة تنقصه، فالروابط المدنية إنما توجد بين مال ومال، لا بين شخص وشخص، فالمنطق يقضي بوجوب التعويض متى وُجِدَ الضرر وأن تُبنى المسؤولية على فكرة السببية لا فكرة الخطأ، وقد أسند هذا الكلام للقانون السويسري والجرماني والإيطالي والسوفيتي والبولوني وغيرها من القوانين الحديثة.
الثالثة: أثبت أن الشريعة الإسلامية أبعد مدى وأشد توغلًا من هذا كله حتى قالوا: إن طفلًا يوم ولد لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه الضمان[16]، ثم يُخبر السنهوري الجميع أن الشريعة الإسلامية قادرة حتى في حالتها الراهنة أن تَمد العالم بفكر قانوني جيد..[17] فأين إذن إهمال الشريعة في مشروع السنهوري وهو بين الفَينة والفينة وبين نظرية وأخرى يُظهِر تَفرُّد الشريعة أمام العالم؟
وختامًا، إن القراءة في الكتب وتحليلها لا تقف فقط على الوصف، بل لا بُدَّ أن نُخرِج من الكتب ما نكمل به تطور بحوثنا في المجال نفسه الذي تعالجه هذه الكتب، والذي يُمكن أن يَخرج به القارئ من هذا الكتاب خاصة المشتغلين بالقانون وتقنين الفقه ما يلي:
الإفادة من فكرة المعيار في تطوير القوانين
وهو هدف السنهوري الذي أشار إليه في أكثر من موضع فالمشرِّع وهو يقنِّن لا يهدف من وراء عمله الإحاطة بكل شيء، فينبغي هجر القواعد الجامدة إلى المعايير المرنة ما أمكن، حتى يترك للقاضي المجال عند التطبيق لوضع الحلول المناسبة لظروف كل واقعة، ولا يحبس القانون في نصوص جامدة تحول دون التطور، إذ القانون كالكائن الحي لا بُدَّ من ترك المجال له كي يتطور بتطور الحياة المتغيرة[18].
فالمشرِّع مهما كان بعيد النظر، فهو عاجز عن أن يتصور -عند وضع التشريع- كل أمر ليضع حكمًا له، بل هو عاجز عن أن يضع للأمور التي يعرفها أحكامًا صالحة لكل زمان ومكان، والمشرِّع الحكيم هو الذي يترك مجالًا واسعًا لتطور القانون، فلا يقضي عليه بالجمود بحصره في قوالب محدودة من الألفاظ والأحكام، والطريق السليم هو أن يترك المسائل التفصيلية للفقه والقضاء، بل إنه يجب أن يترك كثيرًا من المسائل الرئيسة دون أن يتخذ منها موقفًا معينًا ما دام تطورها لم يستقر عند غاية، وما دامت الحاجة العملية لا تقتضي ذلك.
ضرورة الإفادة من الشريعة الإسلامية في تطوير القوانين المدنية
فمعيار التعسف في استعمال الحق، قد مكَّن القوانين الحديثة بصورة عامة والقوانين المدنية العربية من التعامل مع مقتضيات الحياة، ولا بُدَّ لنا من استكمال هذا التفاعل، فما يزال القانون المصري بحاجة إلى قواعد أكثر مرونة كما هو الحال في قضية الاستغلال، فقد اقتصر القانون في تحديد نطاق الاستغلال على عنصرَيْن فقط هما: الطيش البيِّن، والهوى الجامح، في حين أن هذَيْن العنصرَيْن لا يتحققان كثيرًا في الحياة العامة، والأكثر وقوعًا هو الحاجة وعدم الخبرة، فكان على المشرِّع أن يُضيفَ هذَيْن الأمرَيْن خاصة وأن كل التشريعات الحديثة قد تداركتها في تشريعاتها، ومن هذه القوانين الألماني والسويسري والمشروع الفرنسي الإيطالي[19]. وكانت الشريعة الإسلامية قبل كل هذه القوانين تُطبِّق مقتضيات العدالة فهي المقام الأول في التشريع، فقد عالج الفقهاء مسائل الاستغلال من خلال الغُبْن مع التغرير أو الغُبْن المجرد أو الضرورة أو حالات السفه والعته والصغر، باعتبار أن الغُبْن في الفقه الإسلامي يقوم على اعتبارات موضوعية أقرب إلى المرونة باتخاذ العرف والعادة والخبرة أساسًا للتقدير، ومن ثَمَّ سهل تطبيقه، واقترب من الحياة العملية ليُحقِّق الاستقرار، فكل علاقة تستغل ضعف الطرف الآخر تجعل العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال، ولم تقتصر فقط على الطيش والهوى الجامح كما في القانون المدني الحالي.
كثيرًا ما يرجع القانونيون إلى مجموعة الأحكام القضائية التي تُكمل نصوص القانون وشروحه، وما يقابل هذه الكتب في التفكير الفقهي هي كتب الأقضية.
بِناءً على النقطة السابقة ينبغي الإفادة من كتب الأقضية في الفقه الإسلامي لاستخراج معايير مرنة تُسْعفنا في المواكبة، فقد اتضح أن القوانين التي تعتمد على القضاة وعملهم وسوابقهم أكثر استجابة للواقع، فكتب الأقضية تؤرخ لوقائع حدثت منذ عهد الرسول، وتكمن أهمية هذه الكتب في أنها تبصرنا بما يجب مراعاته في الواقع[20] وكيفية تفسير القانون، وتُمثل هذه النوعية من الكتب أهمية كبيرة عند القانونيين بل هناك مناهج -كالقانون الإنجليزي- تعتبر الأقضية السابقة هي القانون في حد ذاته، وهناك مناهج أخرى يلعب فيها القضاء دورًا بارزًا في تفسير القوانين[21]، وكثيرًا ما يرجع القانونيون إلى مجموعة الأحكام القضائية التي تُكمل نصوص القانون وشروحه، وما يقابل هذه الكتب في التفكير الفقهي هي كتب الأقضية.
إن كتب القضاء في الإسلام تُشكِّل حقلًا خصبًا لمواكبة الواقع؛ لأنها تعني الفقه التطبيقي العملي، وفي ظني أن البلاد العربية كانت أقرب إلى النظام الإنجليزي من الفرنسي، ففي حين يهرع رجل القانون الفرنسي إلى البنود التي بدورها قد تُكبِّل عمل القاضي، فإن القانون الإنجليزي يُعطي مساحة للقضاء أوسع يتحرك فيها طالما أن وجهته العدل، فالقضاء عندهم أو ما يُطلق عليه القانون العمومي هو المنبع الجوهري للقواعد والحلول القانونية، وهذا ما استمر عليه الفقه الإسلامي فترة من الزمن إلى أن أصبح القاضي مقيدًا بمذهب معين، ثم بالراجح في المذهب، ثم بالبنود القانونية المختارة من المذاهب.
وقد حاولت كثيرًا البحث عن سبب ثقة الإنجليز في القضاء، فتبيَّن لي من خلال دراسات علوم القانون المقارن أن هذا يرجع إلى عوامل تاريخية جعلت الإنجليز يعتقدون أن القانون العمومي هو مستودع الحرية والعدل، وأن القانون المسنون هو العجلة التي يمتطيها الاستبداد والتحكم، فالقانون العمومي هو الحصن الحصين للحريات هناك من الاستيلاء عليها وصبغتها بصبغة خاصة[22].
وتزداد القناعة بهذا النظام حين نعلم أنه إبان قانون نابليون ظن فقهاء مدرسة الشرح على المتون أن كل الحلول المحتملة واردة في المجموعة المسنونة، فسادت بذلك روح وضعية وهيمنت على الثقافة القانونية حتى تبيَّن ضعف هذا التصور وسرى الهِرم إلى مفاصل القانون الفرنسي، فآمنوا يومئذ بأن القانون ليس هو المستودع الوحيد للحلول الشرعية لما يجدُّ من النوازل والأحداث، فالتفتوا إلى دراسة الاجتهاد القضائي لا بوصفه -في هذه اللحظة- ذا مهمة تفسيرية ولكن بوصفه قادرًا على الاستنباط والخلق، فأصبح القضاء من خلف ستار عند هؤلاء منبعًا مهمًّا من منابع تطور القضاء الفرنسي، وفي ذلك يقول رينيه: «إن استمرار الفقه الفرنسي على الانطواء على نفسه سيهدم مملكة الفقه الفرنسي»[23]؛ لأن هذا هجر للمنهج العلمي الذي سارت عليه الجامعات في دراسات القانون الروماني، كما أدى اعتزاز فقهاء البلاد التي أنجزت تقنيناتها إلى إذكاء روح الوطنية في نطاق القانون على عكس الروح التي كرَّستها مدرسة القانون الطبيعي في الدعوة إلى قانون عالمي موحد.
الاهتمام بالمقارنة وتطويرها
في الكتاب دراسة جادة بين عائلتَيْن تُثير فينا ضرورة النظر لكل ما أنتجه العقل الغربي لتطوير القوانين العربية في المنطقة، ولا تخفى أهمية القانون الموازن في حركة التشريع حيث لُوحظ أن أسوأ القوانين صياغة وحلولًا هي تلك القوانين التي شرَّعتها سلطة تجاهلت الإفادة من الحلول الواردة في أمثال تلك القوانين في البلاد الأجنبية، ولم تفد من خبرات الدول الأخرى في هذا المضمار، والواقع أن معظم حركة التشريع في أوروبا وغيرها تمت منذ القرن التاسع عشر في ظل القانون الموازن، حيث أصبح من المألوف أن يستعير المشرِّع الوطني من القوانين الأجنبية ما يحتاج إليه من حلول وقواعد قانونية.
والسنهوري في الحقيقة من خلال مقارنته مكَّننا من أن نستشف العديد من منهجيات المقارنة، ومنها:
-
التتبُّع التاريخي للظاهرة وتطورها، لنفيد منها في الخطط التي نستعين بها في ترقية القوانين، وتفادي الأخطاء التي وقع فيها السابقون.
-
الوقوف على الخلفيات الفلسفية حول القضية المُثارة، تيسيرًا للوصول إلى العلة التي هي مدار الحكم، وهذا ما فعله السنهوري حين رد المسألة لقضية الطبقية.
-
أن تكون المقارنة في منهج المعالجة مع التطبيق على الجزئيات لذا اختار السنهوري المقارنة بين المعيار والقاعدة، وجعل (القيود التعاقدية) تطبيقًا لها.
-
ألَّا نقارن القانون وهو معزول في مدوَّنات التشريع نفهمه بفهم ألفاظه، بل هو حركة دائبة يتَّسع بها النصّ ويضيق، ولا يحضر ولا يغيب إلَّا بعلّة، والنص القانوني كما يقول «سالي»: «إذا أُخِذَ القانون بألفاظه فهو هيكلٌ عظمي مجرَّد عن معنى الحياة»، ويقول «كابيتان»: كم يخطئ مَنْ يتصور أنه محيطٌ علمًا بالقانون المدني! فإن نصوص القوانين المسطورة ليس مصيرها كلًّا سواء، فمنها ما يَبْلى ولا تُصبح له أهمية عملية، فلا يبقى له سوى القيمة النظرية، ومنها ما يتحوَّر طبقًا لمقتضيات الحياة العملية. وفضلًا عن ذلك فإن النصوص التشريعية في أمة مهما كانت كاملة لا تُمثِّل إلَّا جزءًا من قانون تلك الأمة، فهناك أحكام القضاء وما تُطبِّقه من مبادئ، كما أن الكثير من القواعد التي وضعتها الأعراف تبقى بجانب القوانين المسطورة معمولًا بها، ولو أنها لم تُدوَّن… إذن فالذي يجب معرفته هو القانون الحي، وهو القانون كما يعمل به الناس، وكما تُطبِّقه المحاكم، وهو ما أطلقت عليه في دراساتي «القانون في حالة حركة، وليس في حالة سكون». وهذا ما فعله السنهوري حين عالج القضية من خلال ما يُطبّقه القضاء ولم يكتف فقط عند بنود القانون الفرنسي.
أظن بذلك تكتمل العناصر الأساسية ونحن بصدد القراءة التحليلة للكتاب، وهي: أهميته، ومجمل محتواه، وأخذ عين القارئ لأهم القضايا التي قد تمر عليه مرور الكرام دون إدراك قيمتها، ثم في النهاية الإضاءات التي يضعها لنا الكتاب كي نكمل تطورنا.
الهوامش
[1] د. محمد حسين منصور، «القانون المقارن مفهوم وطبيعة وأصول وأساليب»، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2010م)، ص28. د. محمد أحمد سراج، مقدمة كتاب «ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون»، (الإسكندرية: دار المطبوعات، ط2، 2105م)، ص هـ.
[2] محمد صادق فهمي، مقال «الحق والعروبة»، ص245. وانظر: د. فايز حسين، «فلسفة النظم القانونية وتطورها»، ص53.
[3] انظر: السنهوري، «القانون العربي الموحد»، ومن «مجلة الأحكام العدلية للقانون المدني العراقي» العدد الخاص في مجلة القانون والاقتصاد.
[4] علم اجتماع القانون: هو العلم الذي يدرس نشأة القاعدة القانونية وأسباب تطورها، كما يدرس الآثار الاجتماعية التي تنتج عن تطبيق قاعدة قانونية ما في المجتمع، فهو الذي يُقدِّم التفسير العلمي للقانون، وهو يُمهِّد للتوصل إلى أكثر الصيغ القانونية ملاءمة للمجتمع، كما أنه يكشف عن الأسباب العلمية التي تَكْمن وراء الظواهر القانونية، ويُسْهِم في ترشيد السياسة التشريعية من ناحية واتجاه القضاء من ناحية أخرى، انظر: د. سمير نعيم أحمد، «علم الاجتماع القانوني»، (مكتبة سعيد رأفت، الطبعة الأولى)، ص15.
[5] انظر: شفيق شحاته، «الاتجاهات التشريعية في قوانين البلاد العربية»، ص5. ليون، «الأوراق الشخصية للسنهوري»، (8/9/1932م). د. محمد عمارة، «إسلاميات السنهوري»، (1/195).
[6] انظر: «القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية»، (2/195)، ط دار الكتاب العربي. وكلمة محمد نجيب حسني رئيس جامعة القاهرة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس، ضمن مقالات السنهوري إحياء لذكراه، ص29.
[7] حسن كيرة، «أصول القانون»، ص18.
[8] انظر: السنهوري، «أصول القانون». مصطفى محمد الجمال، «تجديد النظرة العامة للقانون»، ص173. عبد القادر الشيخلي، «فن الصياغة الفقهية تشريعًا وفقهًا وقضاء»، ص23.
[9] انظر: القانون المدني مادة (121)، ومصادر الحق (2/106) وما بعدها.
[10] انظر: لترمانيني، «القانون المقارن»، ص112. محمد حسين، «القانون المقارن»، ص197 وما بعدها.
[11] انظر: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، ص15.
[12] انظر: د. محمد إبراهيم زيد، «نظام المحلِّفين في الولايات المتحدة»، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، يوليو 1971م.
[13] انظر: صوفي أبو طالب، «تاريخ النظم القانونية والاجتماعية»، ص11 وما بعدها. البندراوي، «أصول القانون المقارن». شفيق شحاته، «القانون المقارن»، ص6.
[14] «مقدمة نظرية العقد»، 1934م. وانظر أيضًا من هذه العبارات ما ذكره في كتابه «القيود التعاقدية على الحرية الفردية»، ص (117، 119، 124).
[15] انظر: كتاب أكسفورد (1\ 716).
[16] انظر: غانم بن محمد البغدادي الحنفي، «مجمع الضمانات»، دار الكتاب الإسلامي، ص165. ومجلة الأحكام العدلية المادة (916).
[17] انظر: مقالتَيّ السنهوري، «من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي»، و»حركة التقنين المدني في العصور الحديثة»، العدد الخاص، ص323. ومشروع تنقيح القانون المدني، (1\173). طارق البشري، «الوضع القانوني بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»، مقال بمجلة الأزهر، شوال 2011م، ص1617.
[18] انظر: محمد جمال عطية، «أهداف القانون بين النظرية والتطبيق»، ص195. رمضان أبو السعود، همام محمد محمود، «المبادئ الأساسية في القانون»، ص16.
[19] تنص المادة (138) من القانون الألماني على أنه: «يعتبر باطلًا بنوع خاص كل تصرف قانوني يستغل فيه الشخص حاجة الغير أو طيشه أو عدم خبرته ليحصل لنفسه أو لغيره في نظير شيء يؤديه على منافع مادية تزيد قيمة هذا الشيء بحيث يتبيَّن من الظروف أن هناك اختلالًا فادحًا في التعادل بين قيمة تلك المنافع وقيمة هذا الشيء».
[20] انظر: د. سراج أحمد سراج، «الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق»، ص211.
[21] انظر: د. عباس مبروك الغزيري، «دور القضاء في تفسير القانون».
[22] صلاح الدين الناهي، «النظرية العامة في القانون الموازن وعلم الخلاف»، (بغداد: مطبعة أسعد، 1968م)، ص164.
[23] السابق، ص180.