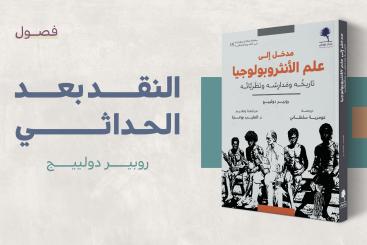أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر
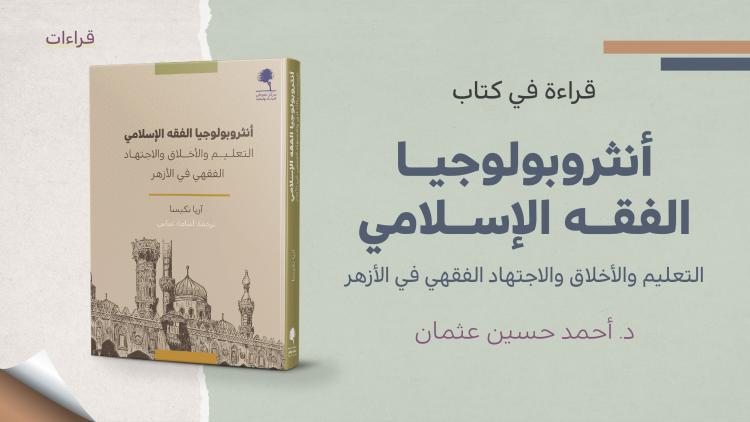
مقدمة
لقد كثرت الدراسات الاستشراقية حول الشرق وأفكاره، ويُقصَد بالاستشراق: ذلك الاتجاه الفكري الذي يصدر من الغرب ويُعنى بقضايا الإسلام والمسلمين من شريعة وسُنَّة وعقيدة وتاريخ، وغيرها من العلوم الإسلامية الأخرى(۱).
وقد حاولت كثير من الدراسات البحثَ عن دوافع الاستشراق، فتوصلت إلى أن هناك دوافعَ دينية وسياسية وتجارية واستعمارية وحضارية، دون تفصيل فيها، ولعل من بين هذه الدوافع التي لها علاقة بدراستنا: الدوافع العلمية والثقافية؛ حيث كانت نظرة الغرب إلى الحضارة الإسلامية نظرةَ إكبار وإجلال؛ لأن المسلمين كانوا أساتذة العلم في العالم قرونًا عديدةً، فدرسوا التراث الإسلامي بدافع حبّ المعرفة والاطلاع، وهؤلاء -الذين حرَّكتهم المعرفة- كانوا أقلَّ من غيرهم خطأً في فهم الإسلام، وهم مع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون من الزلل والاستنتاجات البعيدة عن الحق، وذلك راجع إما لجهلهم بأساليب اللغة العربية، وإما لأنهم يُسقطون نظرياتٍ مسبقةً لديهم على المجتمعات الإسلامية(۲).
ومن خلال هذه الفئة الضئيلة نشأ الجانب المضيء في الدراسات الاستشراقية، حيث كانت معظم الكتابات العربية تتجه بشدَّة نحو نقد الاستشراق ودراساته، بل ووضعها كلها في سلَّة واحدة: سلة الاستعماريين والمُشوِّهين لتراثنا، وغير ذلك من المصطلحات التي يعرفها الدارسون، لكن بعد فترة زمنية وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، ظهر هذا الفصيل من المستشرقين الباحثين عن الحقيقة لذاتها، فقدَّموا خدماتٍ جليلةً للتراث الإسلامي، الأمر الذي أعقبه ظهور تيار من علماء الشرق حاول تبنّي وجهة نظرٍ مغايرة عن الاستشراق مفادها: عدم الحكم العام، وتمسكوا بشواهد من أعمال المستشرقين النافعة، ومنها:
* اهتمام الدراسات الاستشراقية بالتأليف المعجمي لمعظم العلوم الإسلامية، ومن ذلك "دائرة المعارف الإسلامية" التي تُرجمت للعربية، وأُجريت حولها عملية نقد شاملة.
* اهتمامهم بالمخطوطات وإحياؤها وتحقيقها، كما فعل المستشرق دي سلان ماك غوكان، الذي وضع فهرس المخطوطات الشرقية، وكتحقيق وليم مارسيه لكتاب "التقريب والتيسير" للنووي.
* إصلاح حقيقة الإسلام في عيون الغرب، كما فعل توماس أرنولد في كتابه "الدعوة إلى الإسلام".

آريا نكيسا
ولعل كتاب "أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي" لآريا نكيسا -وهو أستاذ مساعد للدراسات الإسلامية والأنثروبولوجيا في جامعة واشنطن سانت لويس، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد- واحدٌ من الدراسات التي يُطلق عليها "مرحلة ما بعد الاستشراق" التي تهدف إلى المعرفة الخالصة، والتي ستضاف -بلا شكّ- إلى الجانب المضيء للاستشراق، وإن كان لا يخلو من نقد. حيث يحاول نكيسا دائمًا في دراساته الأنثروبولوجية التركيزَ على المناطق التي ينتشر فيها الإسلام بصورة مكثَّفة، وتعتمد على منهجيات كلاسيكية في تلقي العلم، مثل مصر وإندونيسيا وماليزيا، كما يركِّز نكيسا على الكيفية التي يمكن أن تقدِّم بها الأُطر النظرية المتنوعة تأملاتٍ جديدةً في دراسة الإسلام والمجتمعات الإسلامية.
وسوف أحاول من خلال قراءتي لهذه الدراسة أن أقف على هدفه منها مع بيان مجمل محتواها، ثم الوقوف أمام أبزر القضايا التي تناولها، ثم محاولة مناقشته في القضايا التي أرى أنها محلُّ نقد، ثم أخيرًا تلمُّس ما تثيره هذه الدراسة فينا من بحثٍ وتطويرٍ لعددٍ من النقاط الخاصة بمجتمعاتنا وتراثنا.
أولًا: الهدف الإجمالي للكتاب ومنهجه وأهميته
۱. الهدف من الكتاب: يقدِّم الكتاب منظورًا مركبًا للنظر في التلقي العقلي والسلوكي للأحكام الشرعية، خاصةً داخل المؤسسات المنوط بها دراسة التراث الإسلامي، فالمؤلف يريد أن يقدِّم فهمًا عميقًا للفقه وأحكامه من خلال الممارسات والنصوص المكتوبة والمرويَّة؛ لأن الأُطر النظرية وحدها -من وجهة نظره- لا يمكن أن تكشف عن ماهية التراث الإسلامي، وعن تعميق النظر في عملية التلقي والتلقين للعلوم الإسلامية، كما أنه يريد أن يبيِّن أننا من خلال الممارسة والتلقي لا نتوصل إلى فهم الحكم الشرعي الجزئي فقط، ولكن من خلال مجمل الممارسات نصل إلى مقصود الشارع، أي ما يُعرف بنظرية المقاصد التي وضع أُطرها الشاطبي. كما أنه حاول أن يفسِّر من خلال نظريتَي الهرمنيوطيقا والممارسة كيف تترسخ الأخلاق في النفوس، الأمر الذي جعله يقف كثيرًا أمام التصوف، والعلاقة بين الشيخ والمريدين، وكيف يمكن من خلال تكرار الفعل تغييرُ السلوك بل والعقل أيضًا. وفي صعيد آخر، يحاول الكاتب أن ينقض بعض الدراسات الاستشراقية التي تصوّر الدرس الفقهي قبل الحداثة حالةً جامدةً وخاليةً من التفاعل مع مستجدات الواقع.
۲. عيّنة الدراسة التطبيقية: لا يكتفي الكاتب بالوقوف عند الجانب النظري، بل اختار الأزهر ليطبّق نظريته عليه، ويعني الأزهر عنده: الجامعة، والحلقات التقليدية، وما تولَّد عنها من فروع مثل: دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي.
۳. الفترة الزمنية التي يدرسها الكتاب: ركَّز الكاتب دراسته على فترتَيْن: فترة ما قبل الحداثة، وهي عنده من القرن الحادي عشر حتى عصر الحداثة، وفترة الحداثة إلى اللحظة التي خرج فيها الكتاب.
٤. منهج المؤلف: هناك طريقتان في مثل هذه الدراسات: إما النظر في النصوص المكتوبة أو المرويَّة كما هو الحال في نظرية الهرمنيوطيقا، وإما النظر في الأفعال والممارسات والتطبيق كما هو الحال في نظرية الممارسة. أما الطريقة التي ارتضاها الكاتب، فهي التي تجمع بين النصوص والممارسات من خلال الدراسة الميدانية. ولم يكتفِ الكاتب بالمشاهدة وتدوين الملاحظات على مَن يقوم بتدريس التراث أو دراسته، بل قام هو نفسه بالممارسة والصحبة، فجلس في الحلقات، ودخل القاعات، وصاحب الطلبة والمشايخ والدكاترة فتراتٍ لا بأس بها؛ فقام بملاحظة الظاهرة، ثم وصفها وصفًا دقيقًا وصل لدرجة ذكر الزيّ وطريقة الجلوس، ثم تحليل كيف يرى المعلمون والمتعلمون العمليةَ التعليمية. والملاحظ أيضًا أن المؤلف قد اعتمد على المنهج المقارن حين وازن بين طريقة نقل التراث وفهمه في الأزهر ومؤسساته في فترة الحداثة وما قبلها.
ثانيًا: المخطط العام للكتاب وقضاياه
قسم الكاتب دراسته إلى أربعة أقسام:
تناول في القسم الأول الحديثَ عن نظريتَي الهرمنيوطيقا والممارسة في تحليل التقاليد الثقافية والقانونية، مع التركيز على بيئة الأزهر وتقديم سردٍ تاريخيٍّ للتعليم في مصر الحديثة. حيث تؤكِّد نظرية الهرمنيوطيقا أن الأفعال تكشف عن العقل والمقصد، أما نظرية الممارسة فتؤكِّد أن الفعل المتكرر قد يغيّر العقل، وهذا ما تفعله كثير من مؤسسات السلطة حين تفرض ممارسةً ما لتغيير العقول. ففرض الصلاة وتكرارها يغرس الإيمان مثلًا، أو بصورة أخرى دور الفعل في نقل الحكم الشرعي واستنباط مقاصده؛ فعندما يغضُّ الشيخ بصره، فإن الطلاب يستنبطون أن النظر إلى المرأة حرام أو مكروه مثلًا، ويتوسعون في الفهم حتى يصلوا إلى مقصد حفظ الأنساب.
ثم حاول الكاتب أن يجمع الأشياء التي نستدلُّ بها على مقصود الشارع أو الحكم الشرعي، وقد حصرها في القرآن والسُّنة وأقوال الصحابة وأفعال العلماء المعاصرين. ولنا هنا وقفة سنناقشها في الجزء النقدي. لكن ما يلفت النظر أنه أقرَّ أن النصَّ وحده مجردًا لا يمكن أن نستدلَّ به على الحكم الشرعي مباشرة، بل لا بدَّ من النظر إلى قول الفقهاء والممارسات التي دارت حوله، فهم لا يقطعون يَدَ الطفل ولا المجنون، مع أن النصَّ عامٌّ.
فحين يكسر النبي ﷺ الأصنام نعلم أن الله تعالى يأمر بالوحدانية. وقد قدَّم المؤلف في هذه الجزئية تحليلًا رائعًا لكون أفعال التابعين والصحابة موصلةً للحكم الشرعي، فقد بلَّغ الرسول ﷺ الجيل الأول الذي شاهد ما يفعله الرسول ﷺ فنقل بعضًا من أحكام الشريعة فعلا لا قولًا، وهي قضايا معروفة في أصول الفقه باسم قول الصحابي.
وعلى ضوء ذلك يقرِّر الكاتب أنه لا يمكن فهم الإسلام من خلال نظرية الهرمنيوطيقا وحدها ولا الممارسة وحدها، بل من خلال الجمع بينهما، ويرى أن الكفاءة في فهم الحكم وتنفيذه بل في فهم التراث تعتمد على التعلُّم عن طريق النصوص، والتعلُّم عن طريق المشاهدة، والتعلُّم عن طريق الممارسة.
أما الجزء الثاني في هذا القسم، فقد تناول فيه الأثر الذي أحدثه الغزو الأوروبي للمجتمعات الشرقية وما استتبعه من تغييرٍ للتقاليد الأصلية القديمة للتعليم الديني، وهذه قضية سنفصل فيها في جزئية أهم القضايا المثارة في الكتاب. لكن المهم أنه استطاع أن يفسِّر أسباب كثيرٍ من الاضطرابات التي نراها الآن داخل المؤسسة، وتبنّي فصيل من أفرادها بعضًا من الآراء الشاذة، وكيف أصبح الأزهر يحوي تيارين متعارضين: التيار التقليدي والتيار المستنير، ثم ما لبث أن تحوَّل إلى تيار سلفي وتيار وسطي، وداخل التيار الوسطي يوجد العديد من الدرجات، وكيف ألقت هذه النزاعات بظلالها على رسالة الأزهر الأساسية.
ثم تناول مواقف الحكومات المتباينة من الأزهر، فنظام يقرّبه، وآخر يستخدمه، وثالث يهمّشه ويعتبر قوته تهديدًا لقوته. ثم تطرق إلى قضية اجتماعية، وهي وجود أنظمة مختلفة للتعليم في مصر، وأثر إعلاء التعليم العام على الأزهر ومريديه من تضييقٍ في الوظائف والشعور بالدونية، وإنكار الانتماء إليه، كما سنبيِّن في جزئية القضايا المهمة.
كشف الكاتب عن الوضع الحقيقي للأزهر من طرق تدريسه، ومخططات تغييره، ومعارك استبعاده سياسيًّا، والتيارات البارزة داخله، ثم أثر كل ذلك في رجاله اجتماعيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا.
ولعل الكتاب حين تطرق إلى مدرسة دار العلوم قد ألمح إلى قضية الهضم الثقافي دون أن يشير إلى ذلك، فقد أُسِّست دار العلوم لتكون سلاحًا يُضرَب به الأزهر، وكثير من الأزهريين يعتقدون ذلك حتى الآن، لكنها ما لبثت أن أصبحت إحدى القلاع التي تدافع عن الهوية العربية الإسلامية، وتمكَّنت من الإفادة من النسق الغربي دون أن يجور ذلك على الثوابت والمسلَّمات. وقد أجاد الكاتب بصورة ملحوظة في هذه الجزئية، حيث كشف عن الوضع الحقيقي للأزهر من طرق تدريسه، ومخططات تغييره، ومعارك استبعاده سياسيًّا، والتيارات البارزة داخله، ثم أثر كل ذلك في رجاله اجتماعيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا.
أما القسم الثاني فجاء بعنوان "التعليم الإسلامي التقليدي والفقه"، فتناول المفاهيم الأساسية عن الشريعة والسُّنة، والأخلاق ومكانها في الفقه الإسلامي والتعليم الديني، فالأخلاق لها دور كبير في دراسة التدين الإسلامي، بل إن الأخلاق تمثِّل النطاق المركزي للشريعة وعلومها كما بيَّن وائل حلاق وطه عبد الرحمن، وقد رجع المؤلف إلى كثيرٍ من النصوص التي تحتوي ذلك. كما قدَّم المؤلف في هذه الجزئية نقدًا للدراسات الاستشراقية التي تجد معارضةً بين الفقه والتصوف من خلال ذكر رجال كالغزالي والنووي الذين جمعوا بين الحسنيَيْن. لكن ما أراده الكاتب هنا هو أن يبيِّن أن السلوك الأخلاقي في الإسلام يُفسَّر من خلال بُعْدين: النصوص والممارسة التي شكَّلت القلوب، وهذا تطبيق عمليٌّ للجمع بين نظريتي التأويل والممارسة عنده.
واستطرادًا من الكاتب أجرى مقارنةً بين الشريعة والقانون، ففي حين تدور الأحكام في القانون بين الواجب والمُحرَّم، نجد أن الشريعة فوق ذلك تقسم الحكم إلى المستحب والمكروه، مما يعني أن الشريعة تحثُّ على المكارم حتى داخل سياقها القانوني، ومن ثَمَّ يرى الكاتب أنه لا يمكن اختزالُ الشريعة في الأحكام فقط، بل هي أفعال وسلوك، بل العمل بالأحكام ضمن أُسس غرس الأخلاق.
لقد استطاع الكاتب أن يربط بتسلسلٍ بين أحكام الشريعة والأخلاق وتجنُّب المحرمات، فالأخلاق تستلزم العمل بأحكام الشريعة عن طريق الممارسة، وبهذه الممارسة يُتولَّد لدى المرء شيء من محبَّة الطاعة، وهذه المحبَّة ستعوِّده تركَ الأفعال التي تتعارض مع الشريعة، كالقمار والزنا، وهذا ربط جيد من الكاتب، ويعبّر عنه علماء التصوف بشكل أو بآخر.
ثم تطرق الكاتب إلى عددٍ من القضايا التي يطبّق فيها نظريتَيْه، منها:
۱. مفهوم الصُّحبة في التربية الإسلامية: فالصحبة في التعلُّم هي الطريقة الأولى في نقل التراث الإسلامي، بدايةً من الصحابة؛ لأنهم صحبوا النبي ﷺ، ثم التابعين؛ لأنهم تبعوا الصحابة، ثم أصحاب المذاهب وتلاميذهم، وعن طريق الملازمة والصحبة اكتسب الأشخاص العلمَ، ولعل تفاوت الرعيل الأول في درجة العلم راجعٌ إلى اختلاف فترة المصاحبة بينهم، ومشاهدة الشريعة وهي تُمارس، ومن خلال الممارسة يكتسب المرء كثيرًا من تصحيح الأحكام، كما أمر الرسول ﷺ أحدهم بإعادة الصلاة أكثر من مرة، وتصحيح طريقة الذكر، وغير ذلك. وهنا يشير الكاتب إلى الفارق بين منظومة التعليم التقليدية التي ترى أن هذا العلم دين، فلا يكتمل بدون الإخلاص والخلق المستقيم والقدوة الحسنة للمعلّم، وبين المنظومة الحديثة التي تقتصر على الجانب العقلي في العملية التعليمية وتغفل عن الجوانب الأخرى التي تحمي العلم من أن يُستغل فيما لم يوضع له، أو يوظَّف لغير ما يُرجى منه.
وما يلفت نظرنا هنا هو أن المؤلف توصل إلى أن العلم بالفقه صَنعة ومَلَكة تتكون من الممارسة؛ لذا عدَّ الأشخاص المنقطعين عن الشيوخ والصحبة والممارسة والمشاهدة غيرَ مكتسبين للصنعة الفقهية والملكة بالقدر الكافي، مما قد يتسبَّب عنه قصور في الفهم، وفي استخلاص الحكم، وإدراك التصور الأكمل لمقاصد الأحكام، واستدلَّ الكاتب على ذلك بالشاطبي حين ربط بين التخلي عن عملية الصحبة والممارسة وظهور شواذ الآراء الفقهية.
يقول الشاطبي في شروط المتعلم الذي سيصير متصدرًا: يجب "أن يَكُونَ مِمَّنْ رَبَّاهُ الشُّيُوخُ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ؛ لِأَخْذِهِ عَنْهُمْ، وَمُلَازَمَتِهِ لَهُمْ؛ فَهُوَ الْجَدِيرُ بِأَنْ يَتَّصِفَ بِمَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَهَكَذَا كَانَ شَأْنُ السَّلَفِ الصَّالِحِ. فَأَوَّلُ ذَلِكَ مُلَازَمَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْذُهُمْ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَاعْتِمَادُهُمْ عَلَى مَا يَرِدُ مِنْهُ، كَائِنًا مَا كَانَ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ صَدَرَ؛ فَهُمْ فَهِمُوا مَغْزَى مَا أَرَادَ بِهِ أَوَّلًا حَتَّى عَلِمُوا وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا يُعارض، وَالْحِكْمَةُ الَّتِي لَا يَنْكَسِرُ قَانُونُهَا، وَلَا يَحُومُ النَّقْصُ حَوْلَ حِمَى كَمَالِهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْمُلَازَمَةِ، وَشِدَّةِ الْمُثَابَرَةِ... وحَسْبُكَ مِنْ صِحَّةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّكَ لَا تَجِدُ عَالِمًا اشْتَهَرَ فِي النَّاسِ الْأَخْذُ عَنْهُ إِلَّا وَلَهُ قُدْوَةٌ وَاشْتُهِرَ فِي قَرْنِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَقَلَّمَا وُجِدَتْ فِرْقَةٌ زَائِغَةٌ، وَلَا أَحَدٌ مُخَالِفٌ لِلسَّنَةِ إِلَّا وَهُوَ مُفَارِقٌ لِهَذَا الْوَصْفِ، وَبِهَذَا الْوَجْهِ وَقَعَ التَّشْنِيعُ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ، وَأَنَّهُ لَمْ يُلَازِمِ الْأَخْذَ عَنِ الشُّيُوخِ، وَلَا تَأَدَّبَ بِآدَابِهِمْ، وَبِضِدِّ ذَلِكَ كَانَ الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ... فَلَمَّا تُرِكَ هَذَا الْوَصْفُ؛ رَفَعَتِ الْبِدَعُ رُءُوسَهَا لِأَنَّ تَرْكَ الِاقْتِدَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَمْرٍ حَدَثَ عِنْدَ التَّارِكِ، أَصْلُهُ اتِّبَاعُ الْهَوَى"(۳).
۲. السَّنَد ومكانته في التعليم الإسلامي: السند هو سلسلة الرواة الذين تناقلوا الخبر، وهي الآلية الموثوق بها عند المسلمين في نقل جميع الكتب العلمية، فنقل الكتب بالسند يساعد في المحافظة على أصالة النص من التحريف. ويحاول الكاتب ربطَ فكرة السند بعملية الممارسة؛ لأن الطالب الذي ينقل الكتاب بسنده عن شيخه لا بدَّ أن يكون صاحب شيخه وفهم الكتاب عنه بالممارسة، لذا فالسند لا ينقل لنا النصَّ فحسب، بل ينقل لنا أيضًا الفهم الصحيح حوله الذي تناقلته الأجيال بالتواتر.
إن عملية الحفظ لا تطغى بأي وجه على عملية التفكير، بل على العكس تمامًا تجعل الصور مستحضرةً في ذهن الطالب؛ فيتمكَّن -بعدما صار الفقه من مَلَكاته- من إجراء عملية الاستنباط والتخريج، واستجلاء المقاصد الكبرى.
٣. كيفية استعمال النصوص المكتوبة في التعليم الإسلامي التقليدي: وُضِعَت النصوص المكتوبة المستخدَمة في التعليم التقليدي على نحوٍ يعزز ممارسة الصحبة، فلم يكن يقرؤها الطالب بصورة مستقلة، بل يقرؤها سطرًا سطرًا على شيخه، ويبرز الكاتب دهشته حين ينقل لنا أن التعليم التقليدي كان يتيح للطالب حفظَ كتب ومطولات كبيرة ومتون تصل إلى الألف بيت على مشايخه، في حين يبدي أَسَفه حين يذكر أن الطالب الأزهري في الجامعة الآن لا يحيط علمًا بأصغر المتون. إن عملية الحفظ لا تطغى بأي وجه على عملية التفكير، بل على العكس تمامًا تجعل الصور مستحضرةً في ذهن الطالب؛ فيتمكَّن -بعدما صار الفقه من مَلَكاته- من إجراء عملية الاستنباط والتخريج، واستجلاء المقاصد الكبرى. ثم ختم الكاتب فكرته بقضية الإجازة التي هي تعبيرٌ عن كثرة المصاحبة والملازمة والممارسة.
أما أخطر أقسام الكتاب -كما سأبيِّن لاحقًا- فهو القسم الثالث، حيث تكلم عن نظرة جديدة لدراسة الفقه الإسلامي، وقد ركَّز فيه المؤلف على ما يلي:
۱. البنية الفقهية من خلال نظرية أصول الفقه وتطورها على يد الشاطبي: لقد عمل الكاتب على إظهار المخطَّط الكلي في كيفية فهم النص واستنباط الحكم في الفكر الفقهي الإسلامي، فتطرَّق إلى معقولية نظرية المقاصد، ومعقولية العقوبة بناءً على سُمو المقصد، لكنه استخدم كلمة "غير عقلانية" في كلامه ليعبِّر عن وسيلة تحقيق المقصد، فالغرض من عقوبة الخمر حفظ العقل، لكن لماذا اختار الله تعالى ثمانين جلدةً لا أقل أو أكثر؟ هذا أمر تعبديّ، لا عقلانيّ عند الكاتب. ثم تطرق إلى الوسائل التي تلائم بين التراث والمعاصرة أو بين الفقه والواقع، وهي: القياس والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان، مما يعني أن منظومة أصول الفقه لم تقف عاجزةً عن الحداثة والمواكبة.
۲. الاجتهاد والتقليد: تعرَّض الكاتب لقضية التقليد، فبيَّن أن سببه هو الاعتقاد بأن الأجيال السابقة تحفظ من الأحاديث ما لا نعرفه، وأن العلم ليس المكتوب فقط، بل هناك علم يُنقَل عن طريق الممارسة، ثم فرَّع على ذلك أسباب الاعتماد على الإجماع، وهي قضية سنناقشها في الجزء النقدي.
وأما القسم الرابع فجاء بعنوان "الإصلاح الحديث"، وقد تناول فيه:
۱. جهود إصلاح الأزهر من خلال تنظيم الزمان والمكان في الجامعات، وعدد المحاضرات، وعدد الطلاب، والمعدَّل الزمني المقيد لإنجاز العملية التعليمية بدلًا من الوقت المفتوح، والجنوح للتخصُّص بدلًا من الموسوعية. ولكن هناك سلبيات ظهرت مع هذه الإصلاحات منها: ضعف التمكُّن، وتحوُّل المدرّس إلى رجل أكاديمي لا يمارس الأخلاق، وإن كان يمارس العلم. ويشير الكاتب إلى أن هناك موقفَيْن تجاه هذه الإصلاحات: فتيار يرى أنه هجوم غربي، وتيار يرى أنه إصلاح ضروري.
۲. الممارسات الجديدة التي ظهرت عقب الإصلاح في فهم النصوص وقراءة الكتب، مثل ظهور الطباعة والكتاب المنسَّق. ويرى الكاتب أنها أثَّرت في عملية المصاحبة والممارسة، حيث تراجع دور الشيخ، لتحل محلَّه القراءة الحرة، وظهرت الدراسة الموضوعية بديلًا عن الدراسة النصيَّة، ويعني بالنصيَّة أن يقرأ الطالب مع الشيخ كلمة كلمة، ويعني بالموضوعية أن العملية التعليمية تقع على عاتق الطالب، ودور الشيخ أن يعلِّق ويصحِّح ويوجِّه، فغابت طريقة المتون والحواشي، وظهرت النظريات الفقهية. ويرى الكاتب أنه بضعف مفهوم الممارسة والصحبة، أصبحت الأحكام -بل التراث برمَّته- لا تُنقَل بصورة صحيحة غالبًا.
ج- التيارات التي ظهرت في الأزهر: يختم الكاتب دراسته الأنثروبولوجية بأن الأزهر انقسم إلى تيارين: تيار سلفي يعمل بالظواهر، وتيار وسطي يدعو إلى توسعة الفهم وإفساح مزيدٍ من المجال للقياس والعرف والاستحسان والمصالح لفهم الحكم الشرعي. لكن لا بدَّ من الإشارة إلى أن السلفية والوسطية ليسا فصيلًا واحدًا، فهم ينقسمون إلى تيارات كثيرة من الناحية السياسية، ومن الناحية المنهجية، فهناك التيار الوسطي المستنير الذي يُعَدُّ محصلة نهائية لجهود إصلاح الأزهر، وهؤلاء يمقتون التراث، ويشيعون أن الأقدمين أخطؤوا في فهم التراث والنصوص، وأنهم اخترعوا الإجماع وعظَّموا ما لا يُعظَّم، وفرضوا عليه من القدسية ما لا يقبله، مثل تقديس روايات البخاري ومسلم والتسليم بصحتها دائمًا، ويوجد منهم فصيل داخل الأزهر وخارجه، وأن القوانين المعمول بها كلها شرعية، ويؤكِّد الكاتب أن التيار الوسطي التقليدي لم يعجز قطُّ عن سدِّ الفجوة بين النص والواقع المتغير، في حين يحاول التيار التغريبي إغفال هذا الدور والتأكيد على وصفهم بالرجعية، ويؤكِّد الكاتب أن الصراع لا يزال مستمرًّا بين التيارين حتى الآن.
ثالثًا: أهمية الكتاب

الجامع الأزهر
يُعَدُّ الكتاب -في مجمله- دراسة فلسفية اجتماعية فقهية عن التراث الإسلامي، متمثلًا في دور الأزهر تجاهه، وإذا أردنا التفصيل في أهميته نقول:
۱. إنه يقدِّم صورة جادة عن تاريخ أكبر مؤسسة إسلامية، بحيث يرصد كل مراحل التحولات التي تمت فيها وأثَّرت في بنيتها، سواء من الداخل أو الخارج.
۲. يُعَدُّ الكتاب من الدراسات الغربية التي تعيد دور الفقه وأصوله في بناء عقلية سليمة قادرة على التفاعل مع المجتمع والتأثير فيه.
۳. كشف لنا عن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمتعلّمين والمعلّمين داخل بنية الأزهر وما تولد عنها من آثار سلبية نتيجة تردي الأوضاع المحيطة بهم.
٤. إنه من الدراسات القليلة التي أحدثت تفاعلًا بين علم الاجتماع وعلم الفقه وكيف أثَّر كلاهما في الآخر سلبًا وإيجابًا.
٥. إن الكاتب في دراسته يقدِّم نقدًا لاذعًا لكثير من الدراسات الاستشراقية التي حطَّت من الدور الريادي للتراث الإسلامي؛ لذا فهو يصحِّح كثيرًا من المفاهيم التي تصل إلى حدِّ المسلَّمات في الدراسات الغربية السابقة من خلال تقديم منهجية جديدة لفهم التراث الإسلامي.
٦. استطاع الكتاب الجمعَ المعطيات السوسيولوجية والأنثروبولوجية المتعلِّقة بالمضمون المعرفي الإسلامي بعدما كانت متناثرة.
۷. يمكننا من خلال التأمُّل في هذا الكتاب أن نستشفَّ من فحواه سبلًا عديدة لتطوير الدراسة داخل الأزهر.
رابعًا: أبرز القضايا التي يثيرها الكتاب
قد تكون القضايا التي أودُّ الوقوف عندها قضايا ليست من الأساسيات المعرفية التي أراد الكاتب الكشف عنها، لكن الكاتب وضع يده على نقاط هو لا يدري أهميتها بالنسبة إلينا، ومنها:
۱. تطور مناهج المستشرقين في دراسة التراث الإسلامي:
لعل أهم القضايا المثارة هنا هي أن الدراسات الاستشراقية كانت تعتمد في دراستها على النصوص الدينية أو الممارسات الميدانية، وفي الحقيقة كلا المنهجَيْن لا يمكن أن يصيب كبد الحقيقة إذا طُبّق على التراث الإسلامي معزولًا عن الآخر؛ لذا فقد طبَّق الكاتب نظريتَي الهرمنيوطيقا والممارسة للوصول إلى فهم أعمق للتراث الإسلامي، فالفقه حين نلاحظه في النصوص، يختلف عن الفقه الممارَس، أي: الفقه في ساحات الإفتاء والقضاء، والكاتب نفسه كان يعتقد أن الفقه في قضية ما ثابت في موقفه، لكنه حين سأل أحد العلماء وجد مرونةً في التعامل تتلاءم مع الظروف وتحقِّق العدالة، فالسارق تُقطَع يده، والطلاق يقطع رابطة الإرث بين الزوج والزوجة، لكن لا يتم القطع في وقت المجاعة أو الضرورة، والطلاق في مرض الموت بقصد المنع من الإرث لا يمنع من التوارث.
۲. نقد كثير من النظريات الاستشراقية:
ومما لفت نظري في هذه الدراسة أنها جمعت كمًّا كبيرًا جدًّا من نقد الخطاب الاستشراقي السابق عليها، فإذا كنا نعاني سوءَ فهم للتراث، أو تعمُّد مجانبة الصواب في تصوره وما يستتبع ذلك من أصوات داخلية تتلقف تلك التصورات، وتنادي بها كمحاولة لهدم وزعزعة أسس نظرياته في بناء المجتمعات، بداية من طه حسين ودندنته بأفكار مرجليوث وغيرها، فالجدير بنا أن نجمع نقد الخطاب الاستشراقي بعضه إلى بعض كأحد المضادات الفكرية التي تحمي تراثنا من النيل منه. ومن أمثلة هذا النقد الذي ملأ الكاتب به دراسته:
أ- النقد الموجَّه لنظرية الممارسة أو نظرية الهرمنيوطيقا معزولة كل واحدة عن الأخرى في فهم التراث(٤).
لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال أن نزن الآراء التي تشكَّلت في أعراف قديمة بميزان عصرنا الحالي، وهذه منهجية للنقد غير سديدة، فإن اجتزاء فترة زمنية وبَترها عن قطار التطور حتى عصرنا الحاضر هو منهج تصيّد الخطأ.
ب- تعميم التصورات الإسلامية: حيث تميل بعض الدراسات الاستشراقية إلى تعميم التصورات حول التراث الإسلامي مع عدم التفرقة بين الفترات الزمنية المختلفة للتاريخ الفقهي، فهناك فترة التكوين، والفترة الكلاسيكية، وفترة ما بعد الكلاسيكية، وإذا كنا لا نتفق مع هذا التقسيم، لكننا نتفق مع جوهر الفكرة، فقد يصل مستشرق ما إلى نصٍّ أو ممارسة ما، ثم يبني عليها تصورًا كبيرًا عن الإسلام ويقوم بالتعتيم على بقية التصورات التي قد تكون أقوى، أو يركِّز على رأي في فترة تاريخية ثم يجعله ممثلًا عن التراث كله، وقد أثبت الكتاب أن هناك فصيلًا من المستشرقين يرفض هذا المنهج الذي يظلم التراث الإسلامي والبحث العلمي النزيه معًا، فكثيرًا ما تُتهم الآراء الفقهية بالجمود دون أدنى تأمُّل لتاريخ الفتوى أو الحكم أو البُعْد الحضاري، فلا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال أن نزن الآراء التي تشكَّلت في أعراف قديمة بميزان عصرنا الحالي، وهذه منهجية للنقد غير سديدة، فإن اجتزاء فترة زمنية وبَترها عن قطار التطور حتى عصرنا الحاضر هو منهج تصيّد الخطأ، الذي لا بدَّ أن تتبرأ منه الصروح العلمية والمنابر الثقافية، حفاظًا على حُرمة العلم ومناهجه، فلا بدَّ من محاكمة الفكرة في أحدث صورها المستقرة لا في طور ظهورها وتقلُّباتها، فقد شاع في الدراسات الفقهية أن الفقه لا يقول بضمان المنافع دون أدنى تأمُّل لتاريخ هذا التصور، ودون مبالاة بمتابعة تطور هذه الفكرة فيما بعد(٥).
ج- تقسيم التراث إلى حقبتَيْن ساكنة ومتحركة: يشير الكاتب إلى أن الكتابات التاريخية الاستشراقية تقسم التراث إلى حقبة ما قبل العصر الحديث وحقبة العصر الحديث، ويوافقهم الكاتب في هذا التقسيم، لكنه ينزعج من تصويرهم حقبة ما قبل العصر الحديث في الدراسات الاستشراقية السابقة بأنها ساكنة وهامدة تمامًا وخالية من روح التجديد والمواكبة، ويؤكِّد الكاتب أن الكتابات الأكاديمية قريبة العهد أصبحت تشدِّد على دينامية المجتمعات الإسلامية قبل العصر الحديث، وأصبحت شديدة الحساسية للأخطار التي تمثّلها التعميمات التاريخية الفضفاضة، بل أثبتت أن التراث الإسلامي في حالة تغيُّر مستمر، وهو موقف الكاتب الذي جزم به، ودافع عنه من خلال كثيرٍ من التحركات الميدانية والقراءات النصيَّة(٦).
د- التعارض بين التصوف والفقه: لقد افترضت الأجيال السابقة من المستشرقين وجودَ معارضة أساسية بين الفقه والتصوف، لكن الدراسات الحديثة رفضت هذا القول، فأكثر علماء المسلمين تبنوا تصورًا من التصوف يلتزم بقوة بتعاليم الفقه الإسلامي، ويقرِّر الكاتب أن أيَّ محاولة لتحليل الفقه الإسلامي أو التصوف بمعزلٍ عن الآخر سوف تقودنا إلى نتائج جزئية ومُحرّفة، فالواجب تحليل الفقه والتصوف معًا، وأن نضمَّ معهما الحقول المعرفية الأخرى، كالتفسير والحديث وعلم الكلام. وكنت أود من الكاتب رصدَ أوجه الفكر الناقص في المعالجة الاستشراقية التي تفصل الفقه عن التصوف، لكنه لم يفعل.
هـ- توقف الاجتهاد: ينزعج الكاتب انزعاجًا شديدًا من ادعاء بعض المستشرقين أن الاجتهاد توقف منذ القرن العاشر الميلادي، وعلى رأس هؤلاء جوزيف شاخت، الأمر الذي يستنبط منه أن التراث الإسلامي أصبح عاجزًا على التوفيق بين أحكام الشريعة والظروف الاجتماعية المتغيرة، وأصبح بناءً عقليًّا فكريًّا مفصولًا عن الواقع الاجتماعي، ويؤكد الكاتب أن الدراسات الحديثة والموضوعية توصلت إلى غير ذلك تمامًا، فالدراسات الفقهية دائمًا تلاحق الواقع، وتتلاءم معه، وتبدي تصورها الاجتماعي حوله، بل أثبت أن وجهة نظر شاخت قائمةٌ على تصوُّر مُسبَق متحيِّز يدَّعي أن العقل العربي المسلم يفتقر إلى ما يتمتع به العقل الأوروبي من نزعة الإبداع.
و- ظاهرة التقليد في التراث الفقهي: يرى الكاتب أن التيار الاستشراقي القديم عندما اعتمد على أن العلم بأحكام الشريعة يعتمد على النصوص المكتوبة، لم يستطع أن يفسر قضية التقليد في التراث الفقهي، لتساوي السابق واللاحق في تحصيل العلم عن طريق قراءته، وإذا تساووا في الطريق، فلماذا يصرون على التقليد، الأمر الذي جعلهم يرجعون التقليد إلى عوامل سياسية أو تاريخية أو إلى أسباب سلوكية، كعدم الرغبة في الجدّ والعناء، وذهب البعض إلى أن ذلك راجع إلى ضمان الاستقرار والضبط القانوني. ويرى الكاتب أن كل هذه الأراء خاطئة لعدَّة أسباب:
أولًا: فالإذعان ليس مطلقًا، وليس مع كل الأشخاص، وليس بدرجة واحدة في كل العصور، بدليل وجود منظومة هرمية في أصول الفقه تبدأ من العاميّ حتى المجتهد المطلق، ولكل درجة سماتها.
ثانيًا: أن هذا تجاهل للفقه ذاته الممتلئ بالاعتراضات والردود داخل المذهب الفقهي الواحد.
ثالثًا: أن ما يذهبون إليه ينمُّ على عدم فهم لطبيعة العلم، حيث اعتقدوا أنه في الكتب دون أن يدركوا ممارسته، وأن هناك علمًا في الصدور لم يدوَّن، وأن الأفهام كلها ليست على درجة متساوية لا في الفهم، أو الاستنباط، أو التطبيق؛ لذا وُجِدَ المجتهد، والمقلِّد، والعامي(۷).
ويتجاوز الكاتب هذه النقطة ليظهر أسفه عندما يقرر أن التيار الاستشراقي الذي ربط التقليد بالعوامل السياسية، هو ذلك التيار الذي ربط تطور الفقه أيضًا بالمصالح السياسية التي دفعته للتخلي عن المعنى الحرفي لخدمة فكرة أو شخص ما! وفي الحقيقة، هذا الربط القاصر هو ما جعلهم لا يفهمون ولا يتصورون أحكام الشريعة على أنها بناء معقَّد، ونظام متسق من المقاصد والعلوم، وأنها نظام يتَّسم بدرجة من القدرة على التطور استجابةً للظروف المتغيرة، ولا إلى الطرق التي حاولوا بها رفع كفاءة الحكم الفقهي وطرق نقله وتعلُّمه.
۳- منطقية أصول الفقه:
من محاسن هذه الدراسة -التي أشار إليها الباحث من خلال تعرُّضه للممارسة والقراءة- حديثُه المتفرق عن أصول الفقه، أو كما أطلق عليها البنية الفكرية، والذي جاء كنوع من التحليل لهذه البنية والاستدلال المنطقي عليها كواحدة من أدوات التفكير الصحيحة التي أبدعها التراث الإسلامي في فهم النصوص وتطوير الأحكام، ومن ذلك:
۱. الممارسة وقول وفعل الصحابة أو عمل أهل المدينة:
يحتوي أصول الفقه على مسألة قول الصحابي وفعله، ويحتوي الفقه المالكي على قضية عمل أهل المدينة، ولم يشر الكاتب إلى هذه المصطلحات، ولم يشر حتى إلى وجودها في أصول الفقه، لكنه تناولها في معرض أن العلم لا يوجد فقط في النصوص، بل قد يتم تناقله من خلال الممارسة، فقد بلَّغ الله تعالى أحكامه إلى الرسول ﷺ، والرسول بلَّغ الشريعة ومارسها أمام الجيل الأول؛ فأصبح الجيل الأول أعلمَ المسلمين بمقاصد الشرع وأحكامه، وعلى ضوء هذا تلقى العلماء أحكام الشريعة بطرق أخرى غير النصوص المكتوبة، ودلَّل الكاتب على وجهة نظره بوجود مجموعة واسعة من المسائل الفقهية التي لم ترد في النصوص. فنظرية الممارسة يمكن توظيفها في الاستدلال على حجية فعل الصحابي وقوله إلى آخر المصطلحات المعروفة(۸).
۲. معقولية بناء فكرة المقاصد في التراث الفقهي:
يُعَدُّ فهم مقاصد الشريعة أداةً من أدوات المقاربة بين النص والواقع؛ بحيث إننا ليس في حاجة دائمًا إلى الدليل الجزئي الخاص، وقد توصل الكاتب إلى منطقية هذه الأداة من خلال حديثه عن أن الأفعال والآثار والنصوص دليلٌ على مقاصد الشارع أو ما أطلق عليه في سياقات أخرى عنده "نظرية التخطيط والعقلانية الغائية"، وهي تعتمد على أن مجموع معتقدات الفرد ورغباته تشكِّل مقاصده، وفي السياق الإسلامي يجب النظر في مجموع النصوص معًا، والجمع بينها في صورة شاملة متسقة لنظام الشريعة الكُليّ، وهذه إحدى النظريات التي ذكرها الكاتب لإدراك ما في العقول، فإننا نفسر العلامات الفردية للحصول على فهم شامل. فعندما يجزم المسلمون بأن الله تعالى يريد من المكلفين حفظ الأنساب، فإنهم لا ينظرون إلى دليل واحد فقط، بل ينظرون إلى الأحكام المختلفة من تحريم الزنا، وتحريم تعدُّد الأزواج، وتحريم الخلوة بالمرأة، فابجتماع تلك النصوص نصل إلى المقصد العام.
ويفرق الكاتب بين الغاية العقلانية -أي التي تحقِّق مصالح المجتمع- وبين الوسائل التي قد تكون غير مفهومة دون القدح في بنيتها، فالرجل الذي يريد أن يؤدب ابنه ليستقيم، يسعى إلى تحقيق غاية معقولة، لكن لو تساءلنا لماذا اختار خمس ضربات لا ست ضربات -مثلًا- فهذا أمر غير معقول؛ لأن اختيار أي رقم سيتوجه إليه السؤال بلماذا؟ وهذا ما توصل إليه علماء المسلمين حين ذكروا القسم التعبُّدي، أي غير المعلَّل والمفسر، كعدد الركعات، واختيار شهر رمضان، لكن المسلمين يقرون بوجود حكمة لا نعرفها، ولو فتشنا في التراث الإسلامي سنجد اجتهاداتٍ في توضيح الهدف من الوسائل التي تبدو غير مُعلَّلة. والمهم في ذلك أن المقصد العام إذا كان يهدف إلى تحقيق المصالح، والوسائل المختارة تؤدي إلى ذلك، فلا يلزم المجادلة فيها (أي الوسائل).
وهذا ما توصل إليه علماء الأصول. فالأصل الشرعي كالنص الشرعي. يقول الشاطبي: «العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان: أحدهما الصيغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني استقراء مواقع المعاني حتى يحصل في الذهن أمر كلي عام، فيجري في الذهن مجرى العموم المستفاد من الصيغ. ومثل ذلك قاعدة رفع الحرج في الدين نستفيدها من نوازل متعدِّدة خاصة، مختلفة الجهات، متفقة في أصل رفع الحرج».ويقول: «إذا ذُكِرَ العموم في أصول الفقه فالمراد العموم المعنوي، كانت له صيغة أم لا»، ويقول: «والأصل الكلي إذا كان قطعيًّا قد يساوي الأصل المعين، وقد يُربي عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه. وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك؛ لأن معناه تقديم الاستدلال المرسل على القياس»(۹).
ومن هذا العموم المعنوي كان الاستدلال بمعنى مقطوع به من النص كمثل الاستدلال بالنص، وأقوى من الاستدلال بمعنى نص واحد الاستدلالُ بمعنى أو فحوى مجموعة نصوص. والأصول الكلية تمتاز عن الفروع بأن الفروع تستند إلى آحاد الأدلة، أما الكليات فتتضافر في إنتاجها جملة نصوص.
إن الكاتب هنا يشيد بالدور الذي يمكن أن يقدِّمه الفقه الإسلامي بصورة أكثر من القياس على المعنى المستفاد من الوقائع، إنه يقدِّم لنا صورةً آخاذةً تفوق فكرة العودة للسوابق القضائية عند الإنجليز، وتفوق فكرة الاعتماد على النص في مدرسة الشرح على المتون، وهي نظرية لاتينية. إن المنهج الذي ضبطه الشاطبي في "الموافقات" منهج عقليٌّ بحت يضخُّ عناصر التجديد في الفقه، ويفسح مجالًا متسعًا للقاضي من خلاله يرسي قواعد العدل.
٣. البنية الفكرية لأصول الفقه لمواجهة الوقائع:
كما قلت، فإن الكاتب يشيد بالدور الذي قام به الفقهاء في مواجهة المستجدات، وهو منهج يتسق مع الفكر، فالفقهاء يستخدمون أربعة طرق؛ الأول: الاعتماد على ظاهر النص، والثاني: القياس الذي يتضمَّن توسيع الحكم عن طريق النظر، والثالث: الاستصلاح الذي يتضمَّن ترك حكم ما، وربما إصلاحه في ضوء الظروف الجديدة، والرابع: الاستحسان الذي يتضمَّن وضع استثناء مقيد للحكم، في ضوء ظروف معيَّنة أو جديدة، وقد ضرب الكاتب أمثلةً على تنفيذ هذا المخطط الذي يستخدمه الفقهاء بصورة هندسية للموازنة بين النص والمستجدات.
وما ذكره الكاتب يؤكده دائمًا القانونيون، يقول السنهوري: "ثم ننتقل إلى مرحلة التبويب والترتيب والتنسيق والتحليل والتركيب في الفقه الإسلامي، فتقف على الصناعة الفقهية في أروع مظاهرها وفي أدق صورها، ثم يقول لك هؤلاء الفقهاء في كثيرٍ من التواضع: إن هذا هو الإجماع أو القياس أو الاستحسان أو الاستصحاب، أو ما شئت من المصادر التي ابتدعوها، وأن الأصل في كل هذا يرجع إلى الكتاب والسُّنة، والواقع من الأمر أنهم صنعوا فقهًا خالصًا هو صفحة خالدة في سجل الفقه العربي... ففقه هذه الشريعة كثوبٍ راعى الشارع في صُنعه جسم مَن يلبسه وكان صغيرًا، ولحظ في صنعه نموّ هذا الجسم في المستقبل، فبسط في القماش بحيث يمكن توسيع الثوب مع نمو الجسم، وذلك من خلال الأدوات الدافعة لحركة تطوير الفقه الإسلامي"(۱۰).
٤- أثر الغزو الأوروبي في مؤسسة الأزهر والتراث عامة:
من القضايا ذات الأهمية في هذا الكتاب أنه تلمَّس عن قرب السببَ في ضعف المؤسسة الدينية في مصر، وقد أرجع هذا الضعف إلى عدَّة أسباب داخلية وخارجية، لكن الذي استرعى انتباهي بصورة أكثر أنه وضَّح الأسباب التي جعلت كثيرًا من أبناء هذه المؤسسة يحيدون عن منهج الأزهر، بل عن أُسس الفكر الفقهي ذاته، واستطاع أن يحيطنا علمًا بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، مدللًا عليها ببحث ميداني، ومن هذه الأسباب:
۱. إنشاء مؤسسات تعليمية ذات اتجاه علماني: ففي عام ۱۹۰۸م، أُسست أول جامعة حديثة، وأريد لها أن تكون مؤسسة علمانية تزاحم الأزهر في التغذية الثقافية؛ بحيث لا يتفرد بالمسرح الثقافي، وحتى يخرج جيل من أبناء البلد يشكِّك في منهجه ووظيفته. وفي السياق ذاته، أُنشئت مدارس وطنية وأهلية يتمتَّع أبناؤها بالرعاية التامَّة والزي الحديث والتأهيل للوظائف، مما أدى إلى تراجع عدد المنتسبين إلى الأزهر لصالح هذه المؤسسات الحديثة.
۲. العمل على عدم الاستقلال المالي للأزهر: كانت المؤسسة الدينية تُموَّل عن طريق الأوقاف، الأمر الذي جعلها بعيدةً عن الضغوط السياسية والاجتماعية، وجعلها مستقلةً ومتفرغةً للقيام بمهمتها، لكن منذ عهد محمد علي أصبحت مؤسسة حكومية تُموَّل من داخل الحكومة، وبدأت الدولة تتحكَّم في جميع برامج التحديث، وتملي عليها ما تشاء من السياسات والقرارات، وتغري أبناءها بالمناصب كلما كانوا أكثر خضوعًا.
۳. الاستغناء عن خريجي الأزهر في وظائف الدولة: كانت الدولة في حاجة إلى مهارات اللغة والفقه للجهاز الإداري لديها، ولأن الأزهر لم تكن قد لانت قناته بعدُ، فقد أسَّست الدولة مدرستي دار العلوم والقضاء الشرعي، كنوع من إثبات قدرتها عن استغنائها لهذه المؤسسة، ولكن استطاعت مدرستا القضاء الشرعي ودار العلوم -للمفارقة- أن تكونا آليةً جيدةً في الحفاظ على التراث، الأمر الذي جعلهما امتدادًا حقيقيًّا للأزهر خارج مؤسساته.
٤. التخفيف من المناهج الدينية داخل المؤسسة: في عام ۱۸۷۲م، حصل تحديث للأزهر من حيث الامتحانات الموحَّدة، ونقل الدراسة إلى المباني المجاورة بدل الحلقات، وإنشاء مجموعة كاملة من الكليات غير الدينية مع تخفيف الدراسة الدينية، وأصبحت إدارة الأزهر يتولاها أفراد ذوو خلفية تعليمية غربية. وفي كل هذه الأجواء، قلَّ العمل بالممارسة، وتلاشت إجازة الشيوخ، لتصبح الدولة هي المانحة للشهادات بصرف النظر عن أحقيَّة الأشخاص.
٥. إفساح المجال لحركات النقد للتعليم التقليدي: لقد أُفسح المجال لمدرسة محمد عبده لتنتقد التعليم التقليدي، الأمر الذي تطور ليصبح نقدًا للتراث الإسلامي ذاته، ففي العقود التي تلت محمد عبده أصبح يروج لإصلاح الأزهر السياسيون المصريون الليبراليون، والاشتراكيون، وسلطات الاستعمار البريطاني، وعلماء الدين ذوو العقلية الليبرالية، مع العلم أن المؤلف لم يستطع أن يحدِّد موقفه من مدرسة محمد عبده ونواياها من الإصلاح، لكن المؤكَّد أنه جرى تقويض مرجعية المذاهب الأربعة لصالح دعوات الاجتهاد والاستنارة ونبذ إجماعات الأمة.
بدأ التيار الليبرالي يصور للنظام السياسي الحالي أن وجود الإسلاميين في المشهد السياسي أو الثقافي يشكِّل إضعافًا للدولة ومؤسساتها العسكرية، فاتخذ النظام موقفًا معاديًا للأزهر ومشيخته، وحاول تقويض صلاحياته ومحاربته من خلال كثير من الحداثيين بداعي حرية الفكر.
٦. العلاقة بين المؤسسة الدينية والدولة: حاولت كثير من الدراسات أن تفهم العلاقة التي تربط المؤسسة الدينية بالنظام السياسي أو الحكومة، وهي في الغالب تلجأ للتعميم، لكن الكاتب حاول أن يكشف تفاوتًا ملحوظًا في العلاقة بينهما حسب الفلسفة التي يتبنَّاها كل فصيل سياسي. فقد عمل نظام مبارك على الموازنة بين الأمور؛ بحيث تكون جميع المؤسسات التعليمية مُلزَمة بتبنّي التيار الوسطي، وكان النظام يتسامح مع التيار التقليدي على الهامش، في حين حظر السلفية تمامًا، كما احتفظ نظام مبارك بالمناصب العليا لأصحاب الرؤى الليبرالية أو لأصحاب عدم التوجُّه من الأساس، المهم ألا يكونوا معارضين للدولة. أما بعد نظام مبارك وصعود التيار الإسلامي إلى السياسة بقوة، بل وتقلُّد المناصب الحساسة، فقد بدأ التيار الليبرالي يصور للنظام السياسي الحالي أن وجود الإسلاميين في المشهد السياسي أو الثقافي يشكِّل إضعافًا للدولة ومؤسساتها العسكرية، فاتخذ النظام موقفًا معاديًا للأزهر ومشيخته، وحاول تقويض صلاحياته ومحاربته من خلال كثير من الحداثيين بداعي حرية الفكر، مما أدى إلى تراجع دور الأزهر وفقًا للمساحة الضيقة المتاحة له، بل أدى استخدام التيار الليبرالي في مواجهة الأزهر إلى التشكيك في فكره لدى الطبقات غير المثقفة.
۷. تردّي الأوضاع المعيشية: حيث تراجع مستوى الإنفاق على التعليم الديني لصالح المدارس الحديثة، وأصبح علماء الدين يواجهون فقرًا شديدًا، وأصبح هؤلاء محرومين من التعيين في السلك الحكومي، الأمر الذي شكَّل ضغطًا لإجراء مزيد من الإصلاح، وأصبح فصيل كبير من الأزهر لا يرى أنه سيعيش حياة كريمة إلَّا إذا تحلَّى بكمٍّ أكبر من الأفكار الليبرالية، وقد نتج عن ذلك عدَّة أشياء، منها:
* زهد شريحة كبيرة من المصريين في إلحاق أبنائهم بالأزهر باستثناء الريف، فقد لوحظ أنه أكثر تعلُّقًا بالتعليم الأزهري.
* الابتعاد عن الالتحاق بالكليات الدينية داخل الأزهر، والتطلُّع للالتحاق بكلية التجارة أو الهندسة أو الطب.
* أصبح يتخرج في الكليات الدينية طلبة أجبرهم المجموع الدراسي -في الغالب- على الالتحاق بها؛ فنتج عن ذلك الضعف العلمي، وعدم الإخلاص للتراث، والتخلي عن صحيح الدين؛ إرضاءً لسلطة أو رغبةً في نيل منصب.
* الشعور بالدونية في المجتمع، فكثير من أبناء المؤسسة من خريجي الشريعة والقانون أو أصول الدين -مثلًا- لا يجدون وظيفة تناسب تخصُّصهم؛ لأن الدولة حصرتها في الأوقاف التي بدورها لا تعيّن ذوي الكفاءة العلمية بل الأمنية، حتى إن الكاتب أجرى مزيدًا من اللقاءات لأناس يعملون في حراسة المنازل، وكلهم يبدون أسفهم لدخولهم تلك الكليات، بل الأغرب أنهم يخفون هويتهم التعليمية حتى لا يتعرضوا للسخرية.
كل ذلك ساعد على ضعف المؤسسة الدينية، كما يفسِّر لنا الدور المضاد الذي يقوم به بعض أبنائها الذين يفعلون ذلك، هروبًا من السفينة الغارقة.
خامسًا: النقد الموجَّه للكتاب
إذا كان الكتاب قد حوى كثيرًا من الأفكار الجادة، وأثار كثيرًا من الموضوعات التي تحتاج إلى كثيرٍ من التأمل، فإنه لا يخلو من بعض مواطن الزلل، وقد جمعتها في النقاط التالية:
۱. حينما أعلن الكاتب عن منهجه، قسم تاريخ الأزهر إلى مرحلة التعليم التقليدي ومرحلة ما بعد دخول الحداثة، ويقول: "وأشير إلى أنه لا يزال من الممكن الوقوف على العديد من ممارسات التعليم الإسلامي التقليدي في القاهرة الآن، وفي تحليلي لهذه الممارسات أستشهد بالنصوص والكتابات لما قبل العصر الحديث...والانتباه إلى النصوص القديمة هو أن علماء الدين المعاصرين يرجعون إليها...وتعود لفترة العصور الوسطى...فعند تناول التعليم الأساسي المعاصر لا مناص من الإشارات المطولة إلى تلك الكتب القروسطية". أقول: هذه من إحدى مسلَّمات المستشرقين، فإنهم يتعاملون مع التراث الإسلامي باعتباره نصًّا تاريخيًّا أنجز مهتمه ورحل، ويحاولون أن يقسموا التاريخ الفقهي إلى فترات منقطعة لا صلة بينها، والأمر في الحقيقة غير ذلك، فالفقه ليس تراثًا بالمعنى الاسشتراقي، بل إن كتبه لا تزال مرجعًا أساسيًّا للباحثين لا كما يصور أنهم يرجعون إليها عرضًا؛ فلذلك يضطر الكاتب هو الآخر أن يرجع إليها. كما أن مصطلح القرون الوسطى له مدلول عندهم، أي إنه عصر ظلام وجمود إلى ما شابه.
۲. يعتقد الكاتب أن أفضل طريقة لتصور العلم بأحكام الشريعة هو تصويرها بأنها علم بالصفات النفسية الإلهية، وأن المسلمين يساوون بين أحكام الشريعة ومقاصدها. وفي الحقيقة كان على المؤلف أن يرجع إلى منظومة أصول الفقه، صحيح أنه توصل إلى أن الحكم الشرعي هو تعبيرٌ عن إرادة الله تعالى، وهذا لا يبتعد عن تعريف الأصوليين بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، لكنهم لا يجعلون الحكم مساويًا للمقصد، كما أنهم يفرقون بين العلة والسبب، والحكم والمقصد، ولعل معظم الدراسات الاستشراقية تقع في هذا المنزلق لعدم قدرتها على تصور منظومة أصول الفقه التي تحتاج إلى الإلمام باللغة وعلم الكلام والمنطق، وغير ذلك من الآلات التي لا تتوفر لديهم بصور كافية.
۳. لقد جعل الكاتب الطاعة الانقيادية المشاهدة لعلماء المسلمين المعاصرين من الأشياء التي يُتوصَّل بها إلى الحكم الشرعي، وفي الحقيقة هناك اضطراب في هذه الجزئية، ففعل العلماء ليس دليلًا في ذاته، ولا يعتقد الطالب أنه دليل، بل كثيرًا ما تجري نقاشات نقدية حول تصرُّف العالم الفلاني، وأقصى ما يمكن قوله هو أن مصاحبة الشيخ تورث حالةً من الانضباط السلوكي، ولا تكشف عن الحكم الشرعي إلَّا من باب تطبيقه والثقة في أن عالم الدين غالبًا لا يخالف الشرع.
٤. حاول الكاتب أن يبيِّن أهمية نظرية الممارسة في الكشف عن الحكم الشرعي، وهي نظرية جيدة في البداية، لكنه في جانبٍ من جوانب التحليل أسقط النظرية بإطارها السياسي على الأزهر، فاعتبر أن الكشف عن الحكم الشرعي من خلال الممارسة راجعٌ بوضوحٍ إلى سلطة الأزهر الذي يُعَدُّ من مؤسسات الدولة، فهو يدعو إلى العمل بأحكام الشريعة، ويوصي بذلك، ويستعمل سلطته في التصويب، وفي الحقيقة فات الكاتب أن الأزهر كان جهة مستقلة، والأحكام التي ذكرها -كغض البصر، وتحريم الخمر- يدرسها الأزهر قبل أن يصبح سلطة تابعة للدولة، وهذا من التقصير في دراسته، التي أفقدتها كثرة تشعبها كثيرًا من الدقَّة، فكان عليه أن يبيِّن الأحكام وتطورها عبر تاريخ الأزهر من الاستقلال إلى التبعية، وعلى ضوء هذا ستتكشف له الأحكام المسيَّسة التي يمارس فيها الأزهر سلطته لا وظيفته الرسمية.
٥. تحدَّث الكاتب في الجزء الأول من الدراسة عن نسبيَّة التحليل الثقافي، ومفاده أن تصور المسلمين للمقاصد الإلهية التي أطلق عليها الكاتب "العقل الإلهي" يستند إلى ما يؤمنون به إيمانًا ذاتيًّا أنه آثار أفعال الله تعالى، كما يؤمنون إيمانًا ذاتيًّا بأن أفعال النبي ﷺ هي آثار لتلك المقاصد، لكن ليس من المهم أن تكون هذه المعتقدات الذاتية صادقة أم لا. ثم يقول إن الجماعات الاجتماعية المعيَّنة تتعامل مع التقليد أو التراث المعيَّن عن طريق معتقداتها الذاتية.
وفي الحقيقة تصوُّر الكاتب فيه اضطراب: فالأمر الأول أنه افترض ذاتية التفسير في فهم الخطاب أو النص، أي إن النص يُفهَم بحسب تراكمات المعرفة عند كل جماعة، ولا يشترط أن يكون هذا الفهم صوابًا، وهذا صدى لنظرية "موت المؤلف" عند الحداثيين، فعندهم أن النص انفصل عن قائله، وأصبح ملكًا للسامع يحمله ويفهمه على أي وجه يروق له، والأمر ليس كذلك، فالتراث الإسلامي يمتلك منظومة كبيرة من آليات فهم النص وقواعد التفسير التي تحميه من الذاتية في التفسير، والعبث في التأويل، والنسبية في الفهم.
والأمر الثاني أننا إذا أردنا أن نخفِّف من هذا الفهم لكلام المؤلف، ونحمله على مقصد آخر مفاده أن النص والفعل حمَّال أوجه، مما ينشأ عنه نسبيَّة في التفسير بين المذاهب، فإننا يجب أن ننوّه بقضية مهمَّة تقع في دلالات الألفاظ، وهي أن الأصوليين قسموا الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء إلى النص والظاهر والمشترك والمحكم إلى غير ذلك مما هو معروف، فكونه يجعل الألفاظ وما يستنبط منها من أحكام أمرًا نسبيًّا، فهذا ما لا يقبله نظام التفكير الفقهي.
٦. في القسم الثالث وعند الحديث عن تجديد الفقه، وخاصةً في جزئية التراجع عن الأحكام، خلط الكاتب بين النسخ، والتدرج في الحكم، وتغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، وجعلها كلها محصورةً في قضية التراجع عن المقصد، فإذا علمنا أن المقصد عنده يساوي الحكم، أدركنا أن التخبُّط في فهم النظام الإسلامي بلغ مداه. يقول الكاتب: "قد يلغي الله تعالى حكمًا شرعيًّا؛ لأن الظروف الجديدة تجعل كلفة تحقيقه زائدة، فالأصل تحريم لمس الرجل للمرأة الأجنبية أو النظر، لكن الفقهاء أجازوه من أجل العلاج مثلًا"، فأين في هذا المثال إلغاء الحكم؟ بل أين إلغاء المقصد؟ إن القضية هنا مجرَّد استثناء لتحقيق مقصد آخر، هو الحفاظ على النَّفْس مع وجود الحكم الأول كما هو، وحتى لا يحدث خلل في المنظومة وُضِعَتْ قاعدة "الضرورة تُقدَّر بقدرها"، أي إن اللمس لن يكون عامًّا، ولن يكون بلا ضوابط. وحتى لا نجور على الكاتب، فإن الفكرة التي يريدها جيدة لكن التعبير عنها فيه لَبْس، ففرق بين تغيُّر الوسائل وتغيُّر الحكم والتراجع عن المقاصد، فالمقاصد لا تتغيَّر، والأحكام والوسائل قد تتغيَّر بناءً على تغيُّر الظروف، فرباط الخيل في إعداد القوة والعدول عنه إلى ما هو أقوى كالطائرات ليس تراجعًا عن الحكم أو المقصد، بل هو البحث عن أعلى وسيلة لتحقيق المقصد.
۷. تطرق الكاتب إلى قضية الإجماع واعتبرها نوعًا من أنواع التقليد، ولم يتطرق للكتابات المعاصرة عند رجال القانون حول الإجماع، فوجود الإجماع من وجهة نظر رجال القانون كان أمرًا ضروريًّا، خاصةً أن القرآن والسُّنة -وهما المصدران الأولان للشريعة- قد أخذا صورةً نهائيةً في فترةٍ قصيرةٍ انتهت بخاتم الأنبياء، في حين أن الشريعة تحتاج إلى تطور مستمر، مما يستلزم عنصرًا ثالثًا يُدخل عنصر المرونة والتطور في الأحكام، وهذا المصدر هو الإجماع، فالإجماع يمكن أن يُعَدَّ -بحقٍّ- المصدر المباشر للتشريع، وهو الذي يمكنه التطور الدائم مع تغيُّر الظروف رغم تبعيته الظاهرة لهذين المصدرين، أو على حدِّ تعبير الدكتور صوفي أبو طالب: "الإجماع هو المجال الحقيقي في صدر الإسلام لإعمال العقل والرأي في المسائل التي لم يرد فيها حكم لا في الكتاب ولا في السُّنة، ومن هنا كان الإجماع على رأس الأدلة العقلية، لكن علماء الأصول اعتبروه من الأدلة النقلية"(۱۱).
إن اهتمام الفقهاء بأن يكون للإجماع سَنَدٌ مُستَمَدٌّ من مصادر الشريعة الأخرى يمكن أن يُفهَم منه أن دور الإجماع هو أن يكون المصدر المباشر للتشريع والتقنين أو صياغة الأحكام المستمدَّة من الكتاب والسُّنة أو الاجتهاد، ووضعها في الصورة المناسبة للجيل الذي يعاصره؛ ولذلك اعتقد بعض المستشرقين(۱۲) أنه يمكن أن يصبح هو المصدر المباشر الرئيس للفقه.
وفائدة الإجماع الكبرى أنه يعطي الأحكام التي تُستَمَدُّ من الاجتهاد صفةً أكثر إلزاميةً إذا أجمع المجتهدون في عصر معيَّن، وذلك في المسائل المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصٌّ، وهو أداة أيضًا لإقرار الأحكام التي تُستَمَدُّ من توافق ضمني استقرَّ بمضي الزمن في صورة عرف(۱۳). والمقصود من هذا أن الإجماع يجعل الاجتهاد المُجمَع عليه كالنص، وهذا له أثر في الواقع، بحيث يصبح ما توصل إليه ليس مجرَّد رأي، بل هو تشريع يحسب للشريعة وتطورها ويلزم الحاكم وأمته.
يقول السنهوري في واحد من مقالاته تأكيدًا لهذا الملمح: "القائمون بدراسة هذا الفقه عليهم أن يجتهدوا في استنباط أحكام تلائم العصر، وفقًا لأصول الصناعة الفقهية، ومتى أجمعت كثرتهم على رأي أصبح هذا الرأي جزءًا أصيلًا من الشريعة الإسلامية يستمدُّ وجوده من الإجماع، ونكون بذلك قد جدَّدنا في أحكام الشريعة دون أن نخلَّ بأصولها أو ننحرف عن مصادرها"(۱٤). وكان يمكن للدراسة الغربية أن تنكر طريقة تكوينه دون الغضِّ من أهميته، وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى النقطة التي توقف عندها الإجماع، وكيف يمكن أن يتطور(۱٥).
فالإجماع في مرحلته الأولى أعطى للعادات مكانًا بين المصادر القانونية، فكان مالك يأخذ بإجماع أهل المدينة(۱٦)، أي عاداتهم، واستخدمه الفقهاء في مرحلته الثانية ليجعلوا من اتفاق الصحابة على رأي قانونًا مُلزِمًا، واستخدموه في مرحلة ثالثة لصناعة قانون مُلزِم من اتفاق الأجيال الأخرى من المجتهدين من غير الصحابة(۱۷). ففي المرحلة الأولى كان يصدر من غير قصدٍ من خلال عادات ألِفها الناس فصارت مُلزِمة، أما في المرحلتين الأُخريين فهو يصدر عن شعور وإن لم يصدر عن اتفاق مقصود، فلو أردنا تطوير الإجماع فعلينا أن نبحث عن طرقٍ لتنظيم الاتفاق المقصود.
أما خريطة استكمال تطوير هذا المصدر، فتقوم على خطوتَيْن:
الأولى: تنظيم الأداة العلمية للإجماع بطرق المداولة في مجلس الشورى، بحيث يوجد جهاز منظَّم عمليًّا يقوم باختيار الفقهاء الصالحين للمشاركة في الإجماع، وضبط مداولاتهم، وإثبات الأحكام الناتجة عنها في صورة رسمية موثوق بها.
والثانية: اتخاذ الإجماع أساسًا للنظام النيابي في الحكم الإسلامي، وهذه فكرة ليست غريبةً عن الفقه، فالإجماع يشمل جميع الأحكام التي يحتاج إليها المجتمع الإسلامي، ووضع هذه الأحكام يستلزم علمًا بمصادر الشريعة وأحكامها، وبمعرفة أحوال الناس وحاجاتهم أيضًا؛ ولذلك وجب أن يضمَّ المجمع نوعَيْن من المجتهدين: رجال الدين ورجال العمل المختصين بمعرفة نواحي الحياة الاجتماعية المعقَّدة من زراعة وصناعة وغيرها، ويمكن أن يُعَدَّ هؤلاء من أهل الذكر الذين أُمرنا أن نستشيرهم، فهم مجتهدون من نوع خاص، فإذا وُجِدت مجالس تضمُّ هؤلاء وهؤلاء، فإننا نتمكَّن من استنباط أحكام شرعية ملائمة لحاجات الناس في النواحي كافَّة(۱۸).
ثم علينا بعد ذلك أن نحرِّر هذا الإجماع ونحميه من أي ضغط أو رهبة أو قرارات مُملاة، ثم بعد ذلك نعطي نتائج الإجماع صلاحيةَ التطبيق، وإلزامه دون أي عائق، ثم نقبل إلغاءها بعد ذلك بإجماع آخر مماثل إذا استجدت وجهات نظرٍ أخرى في المسألة ما دمنا ندور في الحالات كافَّة مع قوة الدليل الشرعي، وتحقيق مصالح الناس المعتبرة في الشرع(۱۹). تلك هي النظرات التي فات الكاتب أن يسجِّلها عند التعامل مع أدوات تطوير الفقه في مرحلة الحداثة.
النقاط التي نحتاج إليها بعد قراءة هذا الكتاب
وختامًا، فإن هذه الدراسة التي جمعت قضايا شتَّى ترشدنا إلى الآتي:
۱. تسليط الضوء بصورة كبيرة على الكتابات الاستشراقية ذات الأداء الموضوعي، والتي ستقودها موضوعيتها إلى إنصاف التراث الإسلامي.
۲. جمع انتقادات الدراسات الاستشراقية بعضها إلى بعض لمدافعة التيارات التي تتعامل مع ما قرروه بنوعٍ من التسليم. فإن كثرة القراءة والاعتناء بكتب المستشرقين -وإن كان بعضها نافعًا- دون الرسوخ والامتلاء من أصول علوم الإسلام ومعرفة طرائق أهل العلم فيها وكيفية بنائها، مُفْضٍ إلى تعظيم أعمال هؤلاء ثم تحكيم ما يقولون فيها فيما أسَّسه أهل العلم وأصَّلوه وتتابعوا عليه؛ فيكون الإغراب والشذوذ شأنَ كل مَن لم يتربَّ على كتب أهل العلم.
۳. إذا كانت هناك جهود مستميتة لإخماد جذوة المؤسسات الدينية، بدايةً من قطع التمويل عنها، فإن هذا يدعونا إلى إحداث عمل مضاد من إجل إصلاح التعليم الأزهري، ولتكن البداية بإعادة مفهوم الأوقاف إليه، وإن كان بصورة غير رسمية.
٤. العمل على مدِّ يد العون بين المؤسسات الاجتماعية والدولة لإحداث الإصلاح الشامل، فمن الواضح أن علماء الاجتماع يعملون في الإطار النظري، ولا يُسمعون إلَّا أنفسهم، في حين أن دراسةً مثل هذه كشفت مزيدًا من الأسباب التي أدت إلى تردّي الوضع الثقافي والاقتصادي.
٥. تركيز الضوء على الكتابات التي تُعنى بإظهار البنية الفكرية في الإسلام لمواكبة الواقع، فقد بيَّن الكاتب أن ضعف النصوص عن ملاحقة الواقع معضلةٌ تلحق أي نظام قانوني مهما كان مصدره إذا ظلَّ فقهاؤه وقضاته مكتوفي الأيدي يتابعون سير المجتمع إلى الأمام، ولا يحركون المياه الراكدة في النصوص، لكن الكاتب في دراسته هذه أشاد بالدور المبكِّر الذي قام به علماء المسلمين في حلِّ هذه المشكلة، فأصبح من الثابت أن علماء المسلمين من الأوائل الذين تنبهوا إلى مشكلة العلاقة بين النص القانوني الثابت، والواقع الاجتماعي المتغيّر، تلك المشكلة التي شغلت الفكر القانوني منذ أقدم العصور، ولقد تمَّ ذلك في الفكر الفقهي باصطناع منهج المصلحة، وبالعدول بالمسألة عن نظائرها إلى حكمٍ آخر نقيض، لسبب يقتضي هذا العدول، وهو ما يُسمَّى بالاستحسان. ويتبيَّن لنا من خلال تقدير الدراسات القانونية للاستحسان وغيره أنه ينبغي علينا إبراز الحديث عن المنهج الإسلامي في التوفيق بين اعتبارات الشريعة الإسلامية والواقع الاجتماعي المتغيّر، وصولًا إلى أنسب الحلول التشريعية التي تناسب مصالح الجماعة، وهذا الأمر منطقيٌّ ومترتِّب بالضرورة على كون الشريعة صالحةً لكل زمان ومكان. إن إبراز مثل هذه النظريات الفقهية وطرحها بصورةٍ بارزةٍ في الساحة العلمية أَوْلَى بكثيرٍ من مناقشة جزئيات الفقه؛ لأنها تُبرز قدرة هذا النظام الفقهي على حلِّ كثيرٍ من الإشكاليات في منهجيات النُّظُم الوضعية.
الهوامش
(۱) انظر كتاب "الاستشراق: تعريفه - مدارسه - آثاره" للدكتور محمد فاروق النبهان.
(۲) انظر كتاب "المتنبي" و"رسالة في الطريق إلى ثقافتنا" للأستاذ محمود شاكر.
(۳) انظر: الشاطبي، الموافقات (۱/۱٤۰ وما بعدها) (طبعة مشهور آل سلمان).
(٤) انظر هذا النقد الموسع للنظريتين من ص۲۳ حتى نهاية الفصل.
(۹) انظر: الشاطبي، الموافقات (٤/۷٥).
(۱۰) انظر: عبد الرزاق السنهوري، القانون المدني العربي الموحد، مجلة القانون والاقتصاد العدد الخاص، ص٤۸٥.
(۱۱) صوفي أبو طالب، تطبيق الشريعة الإسلامية، ص۱۳۲. وانظر كتاب "تجديد الفكر الاجتهادي" لجمال الدين عطية.
(۱۲) نقل الدكتور توفيق الشاوي في تعليقه على كتاب "الخلافة" للسنهوري قولَ المستشرق سنوك هرخرونيه: "لقد أصبح الإجماع في العصور الحالية هو الأساس العلمي للتشريع، وأصبح القرآن والسُّنة تاريخيَّيْن، أما هذا المصدر فله أهمية علمية كبرى، فإن أحكام الفقه جميعها يمكن أن تُنسب إليه، مهما يكن مصدرها الأول، وهي تستمدُّ صفتها الإلزامية وصياغتها وقابليتها للتطبيق من الإجماع"، ونقل عن لامبير قوله: "إن الإجماع بعد عدَّة قرون قد يصبح له الصدارة في التعبير عن المصدرين التاريخيَّيْن: الكتاب والسُّنة؛ لأن القائمين بالتطبيق قد يستغنون بالرجوع إليه عن البحث فيهما". انظر: فقه الخلافة، للسنهوري، (هامش ٤۳، ص۷۲). مع تحفُّظنا الشديد على قولهما إن القرآن والسُّنة مصدران تاريخيان.
(۱۳) انظر: عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة، ص٦۲؛ شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، ص۸۷ وما بعدها.
(۱٤) انظر: عبد الرزاق السنهوري، القانون العربي، ضمن مقالات السنهوري، سنة ۱۹٥۳م.
(۱٦) انظر تفصيلًا في هذه القضية: محمد المدني، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، دار البحوث للدراسات الإسلامية.
(۱۷) يقول إجناتس جولدتسيهر: "لا يكفي أن يُترك الإجماع حرًّا متروكًا للإحساس الغريزي للجماعة"، انظر: العقيدة والشريعة في الإسلام، ص٦۳. وانظر: عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة، ص٦۰؛ تنقيح القانون المدني المصري، مقالات السنهوري، ص۱۷٥.
(۱۸) انظر: عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة، ص٦۰.
(۱۹) انظر: محمد البلتاجي، مناهج التشريع الإسلامي، ص٥۷۸. وانظر توسعًا في قضية حماية الإجماع من الضغوط السياسية: توفيق الشاوي، فقه الشورى، ص۱۷۹؛ المستشار عبد الحليم الجندي، اقتراح بإنشاء مجمع للتشريع الإسلامي، مجلة إدارة قضايا.