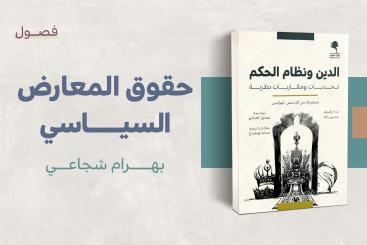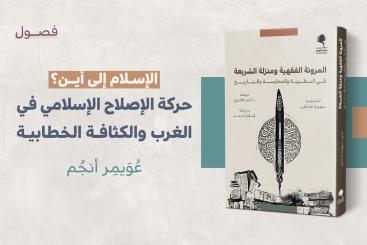قراءة في كتاب "الإسلام والسياسة في العصر الوسيط"

تناول مفكرو العصر الوسيط الإشكالية السياسية من مداخل متباينة. فتقليد الآداب السلطانية اعتبر السياسة كما مُورست إفرازًا لا محيد عنه للأهواء الإنسانية، والسياسة من هذا المنظور هي مجال لتدبير هذه الأهواء وكبحها لتنظيم المجتمع الإنساني. بينما تأطرت نظرة الفقهاء معياريًّا بالنصوص الدينية، لكن إكراهات الواقع كثيرًا ما حتَّمت الانزياح في الحالات الاستثنائية عن المقاصد الدينية. أما الفلسفة السياسية فنظرت إلى المجال السياسي على ضوء العلوم الطبيعية الوسيطية، وحاول الفلاسفة المسلمون أن يجعلوا من "المدينة" كيانًا يحاكي نظام العالم. وبين النظرة المعيارية للفقهاء والمقاربة المثالية للفلاسفة، كانت الواقعية الخلدونية التي جاءت في لحظة تراجع الحضارة الإسلامية وبزوغ فجر النهضة الأوربية، فقدَّمت تصورًا اجتماعيًّا لتطور الدولة وأفولها. وقد شكَّلت هذه الرؤى الأربع (الآداب السلطانية، والسياسة الشرعية، والفلسفة السياسية، والنظرية الخلدونية) المادة الأساسية التي حاول الباحث مكرم عباس تحليل بُناها في كتابه "الإسلام والسياسة في العصر الوسيط".
ينطلق الباحث مكرم عباس في قراءته للتراث السياسي الذي تكوَّن من داخل الفكر الإسلامي من التفاعل مع مجمل النظريات التي أنتجتها السرديات الغربية، سواء من داخل الاستشراق أو علم الاجتماع السياسي. وقد قدَّم هذا الأخير، خاصةً مع عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، تصنيفات لطبيعة الممارسة السياسية، حيث ميَّز بين الفعل السياسي في الغرب الحديث القائم على استقلالية القانون وعلمانيته وعقلنة البيروقراطية، ما جعله ينتزع شرعية سياسية حديثة، وبين شرعيات أخرى تقليدية محتكمة لرسوخ العرف أو كاريزماتية تعتقد في الفرد المخلِّص. فبخصوص الإسلام نظر فيبر إليه بوصفه كنيسة غير مرئية؛ إذ ثمة حسب قراءته تداخل صميميٌّ بين المكونين الديني والسياسي. ويرى الباحث في مقدمته أن هذا التنظير من ماكس فيبر قد وجَّه مجمل الدراسات اللاحقة عن السياسة والدين في الفكر الإسلامي، ويذكر مجموعةً من الأسماء، مثل: آن لامبتون، ولويس غارديه، وفون غرونباوم، وبرتراند بادي، وباتريشا كرون. ويخلص الباحث في حكمٍ مجملٍ إلى أن خصوصية التاريخ الأوروبي قد تحكَّمت بشكل كبير في قراءة تجربة التاريخ السياسي الإسلامي، فهي لا تفصل بين الذات والموضوع، بل تسقط ذاتها على الموضوع المدروس، يقول: "المشكلة التي تطرحها هذه الدراسات تتمثَّل في إسقاط شبكات تحليل جاهزة على ثقافة الإسلام. ثم السعي بعد ذلك إلى التحقُّق منها وإثباتها"[1].
ومن هنا يبدو أن الغاية من تأليف الكتاب هي إعادة النظر في مجمل هذه الأحكام، وما دامت الدراسات الاستشراقية كانت مُوجَّهةً بأفكار مُستقاة من المجال التداولي الغربي، فإن الباحث سيتوجَّه رأسًا إلى قراءة داخلية محايثة. إنه سينظر في الأدبيات التي تشكَّلت من داخل الفكر السياسي الإسلامي، وقد صنَّفها الباحث إلى ثلاثة أقسام: الآداب السلطانية، والسياسة الشرعية، والفلسفة السياسية. حيث يضفي على القسم الأول طابعًا تاريخيًّا، وعلى الثاني ملمحًا قانونيًّا، بينما يصنِّف الفلسفة السياسية في القول العلمي.
الآداب السلطانية
فإن الباحث يلمح إلى ما عرفته الدولة الإسلامية عبر تاريخها من اهتزازات مستمرة فرضت عليها أن تنحو منحًى استبداديًّا. وإذا كان الباحث يركز على الفتن الداخلية، فإنه يغفل عن عنصر آخر أساسي عن الدولة الإسلامية في العصر الوسيط، ويتعلق الأمر بالتهديد الخارجي المستمر، سواء الأجنبي المسيحي أو الصراع المذهبي داخل الإسلام
يبدأ الباحث بالآداب السلطانية، وينظر بدايةً في ماهية الكتابة السلطانية في السياسة. ويخلص بالفعل إلى أن هذا الصنف لا يشغله البحث في سؤال الشرعية؛ لأن الإشكالية السياسية لا تحتاج إلى أية شرعية خارج ماهية الإنسان. فما يفرض وجود النظام السياسي أو الدولة على النحو الذي تتحدَّث عنه الآداب السلطانية هو الإنسان والأهواء التي تُحرِّكه. ولا يمكن الوصول إلى بناء اجتماع إنساني إلا إذا عُلِّقت هذه الأهواء الإنسانية واختزلت في شخص واحد هو السلطان. لهذا فالاستبداد مكون طبيعي وأساسي في الدولة السلطانية؛ لأنه إذا ارتفع وقع من الرعية. ومع ذلك، نلاحظ أن الباحث يتعالى عن محاكمة هذه المنظومة بمعايير النُّظُم السياسية الحديثة، وهذا حين يعرج على بعض مواقف المفكر محمد عابد الجابري وتلميذه كمال عبد اللطيف، فهذا التيار الفكري يحمِّل مسؤولية النزعة الاستبدادية التي سادت في التاريخ الإسلامي لأدبيات الآداب السلطانية، بينما ينظر الباحث إلى جانب آخر، ففي آخر المطاف في هذه الأدبيات: "وظيفة السياسي الأولى هي مكافحة الفوضى والتنازع الفطريَّيْن في الطبيعة"[2]. وبالفعل، فإن الباحث يلمح إلى ما عرفته الدولة الإسلامية عبر تاريخها من اهتزازات مستمرة فرضت عليها أن تنحو منحًى استبداديًّا. وإذا كان الباحث يركز على الفتن الداخلية، فإنه يغفل عن عنصر آخر أساسي عن الدولة الإسلامية في العصر الوسيط، ويتعلق الأمر بالتهديد الخارجي المستمر، سواء الأجنبي المسيحي أو الصراع المذهبي داخل الإسلام، وهو تهديد بات معه تقوية الجبهة الداخلية من أجل مواجهة التحديات الخارجية يرجح على كل مقصد سياسي آخر.
ويتوغل الباحث في هذا الصنف من الكتابة السياسية من أجل إبراز جوانب تخفِّف من الأحكام الصادرة بحقِّه. ونجده بالفعل يعثر على جوانب مضيئة فيها، ومنها فكرة المرآة التي تحضر باستمرار في هذه الكتابة[3]. إن هذا الخطاب ذو نزوع وعظي، وكثيرًا ما تحضر المرآة بوصفها رمزًا يحيل على البطانة الصالحة التي تعكس للسلطان حقيقة تصرفاته وأفعاله. وبالمثل، فإن هذا الخطاب يحضُّ على المشورة بوصفها أسلوبًا ضروريًّا لصناعة القرار السياسي. وهنا يفتح الباحث القوس ليجلي مسألة أساسية: فورود مفهوم الطغيان في هذه الأدبيات لا يعني ما يتبادر إلى الإذهان من مطلق الحكم الفردي. إن للطغيان داخل هذه المنظومة دلالة خاصة، فهو يعني القرار الذي يتخذه السلطان دون العودة إلى بطانته ومستشاريه. وبمجرد أن يستشير معاونيه فهو خارج الحكم الطغياني في هذا الخطاب السياسي، فالطغيان ينتهي في تلك اللحظة التي يستمع فيها السلطان لمستشاريه، وتمنح هذه الأدبيات السياسية للسلطان كامل الحق في التصرف في هذه المشورات دون تقديم أي توضيحاتٍ ونسبتها إلى نفسه. ويثير الباحث الانتباه إلى أن هذا الأمر كان يسري على الشرق والغرب على حدٍّ سواء، وثمة رواية أسطورية يوردها فرانسيس بيكون، فالإله جوبيتير تزوج من ميتس، وهذه الكلمة الأخيرة تعني مشورة، فلما حبلت لم ينتظر أن تضع مولودها بل ابتلعها هي كاملة، وهذا يوضِّح ما كان يبديه الحاكم في العصر الوسيط من احتواء آراء مستشاريه وتبنِّيها باعتبارها تنتمي إليه دون أن ينسبها إلى أحد[4].
يناقش الباحث مسألة العلمنة في التاريخ الإسلامي، فيرفض أن تكون العلمنة -كما ذهب ماكس فيبر وغيره- نتاجًا غربيًّا وإفرازًا للإصلاح الديني مع البروتستانتية. ينتقي الباحث بعض معاني العلمنة، ومنها الاحتفاء بالحياة الدنيا أو "الدنيوة"، فيوفَّق في استحضار مجموعة من النصوص التي تؤاخي بين الدنيا والآخرة ولا تنظر إلى الأولى بانتقاص أو اشمئزاز كما كان الشأن في الفكر الديني الغربي بالعصر الوسيط. ويمكن الحديث هنا عن دين يتوجه إلى الحياة ويتفهم كل رغبات الإنسان ولا يجعلها محلَّ اتهام.
المعنى الآخر للعلمنة هو ما اعتبره كارل شميث علمنة لمفاهيم اللاهوت السياسي، أي البحث عن مقابلات دنيوية للمفاهيم التي تنتمي للاهوت. فكما يقول الباحث: "ظاهرة النقل في تقليد الإسلام أقل وضوحًا بكثير مما هو في الغرب"[5]. لكن بعملية تأويلية لبعض المبادئ الفقهية توصل الباحث إلى نماذج يمكن رفعها إلى مرتبة التسييس العلماني. ففي البدء كان هناك تماهٍ بين وظيفة الإمامة في الصلاة ومقام الإمامة السياسية، ثم شيئًا فشيئًا جرى التخلي عن الوظيفة الدينية وتهميشها. يلاحظ كذلك أن الفكر السياسي في الإسلام استمدَّ بعض تنظيراته من أدلَّة ذات طابع عقدي. حاول الفكر الإسلامي دائمًا التأسيس لضرورة الإمام الواحد بالقياس على آية قرآنية كريمة؛ إذ كما أن تعدُّد الآلهة يؤذِن بفساد الوجود لداعي التنافس بين الآلهة، فكذلك تعدُّد الأئمَّة حقيق بأن يؤدي إلى اضطراب في الدولة.
السياسة الشرعية
يتناول الباحث المقاربة الفقهية للسياسة في فصل بعنوان "الشريعة والسياسة"، وذلك بعد انتهائه من عرض منظور الآداب السلطانية؛ ولهذا فإن التمايز بين المقاربتين الفقهية والسلطانية ثابت. وأول ما يرصده الباحث من ملاحظات حول "السياسة الشرعية" هو تأخر ظهور التأليف فيها بالمقارنة مع أبواب الفقه الأخرى؛ فقد خصَّ الفقهاء كل المعاملات الاجتماعية والاقتصادية فضلًا عن الأحوال الشخصية والعبادات بأبواب معروفة في كتب الفقه، بيْد أن التأليف في الفقه السياسي -على حدِّ قول الباحث- "ظل غائبًا عن هذا الفقه"[6]. ويحاول الباحث أن يبحث عن مسوغات لهذا التأخر فيجده في خصوصية البحث المبكر في قضايا السياسة. فمن المعلوم أن المسلمين تجادلوا، وأحيانًا بشكل حاد، في قضايا التاريخ السياسي الإسلامي، وبالخصوص الفتنة الكبرى والصراعات بين الصحابة، وهكذا فبدل أن يذهب اهتمام الباحثين إلى التنظير بدءًا للممارسة السياسية، نجد أن ما قامت به المذاهب المختلفة هو إعادة قراءة التاريخ السياسي على النحو الذي يبرئ أو يدين هذا الطرف أو ذاك. ولا بدَّ أن نسجل هنا أن هذا الجدل أثير في سياقات كلامية وفقهية. ومن هنا يحقُّ لنا أن نستنتج أن التاريخ ألقى بثقله على وعي الفقهاء والمتكلمين ولجم مَلَكاتهم التنظيرية لصياغة فقه سياسي إسلامي. ويبدو أن الفقهاء قد تورعوا بالفعل عن الكتابة في الفقه السياسي بالنظر إلى أن فترة الخلافة، التي تُعَدُّ التجربة الأولى للممارسة السياسية، والفترة المثالية كذلك، قد شهدت أحداثًا لم يكن من الممكن الخوض فيها، فضًلا عن استنباط أحكام فقهية سياسية منها.
وهكذا فقد تأخر ظهور كتابات في الفقه السياسي الإسلامي أو السياسة الشرعية إلى حدود القرن الحادي عشر الميلادي. ويورد الباحث سببين رئيسين لظهور هذه الكتابة: الأول هو ضعف الخلافة العباسية وصوريتها بعد وصول البويهيين الشيعة إلى الحكم واشتداد شوكتهم ابتداءً من عام 945م. أما الثاني فهو نضج الكلام الأشعري، والواقع أن الفقه السياسي الإسلامي كما يذهب بعض الباحثين كان تفريغًا فقهيًّا للجدل الكلامي حول قضايا السياسة والتاريخ السياسي[7]. ولهذا يمكن القول إنه مع نضج علم الكلام الأشعري امتلك الفقيه ما يكفي من جرأة ومن ثقة بسبب الحجج الكلامية للخوض في قضايا عويصة ظلت إلى ذلك الحين من المسكوت عنها عند الفقيه.
يبدو السؤال الأول الذي يطرحه الفقيه هو مشروعية السلطة والإمامة: هل هي ضرورية أم لا؟ ويحتكم الباحث إلى كتابات الإمام الجويني في كتابه "غياث الأمم" للإجابة عن هذا السؤال. فعكس الكيسانية القائلين بعدم ضرورة السلطة السياسية، وهي حالة تتحقَّق في نظرهم عند بلوغ المجتمع لحالة من النضج الأخلاقي، فإن الفقيه على العكس من ذلك يرى وجوب تنصيب الإمام. غير أن أهل السُّنة -خلافًا للشيعة- يصنفون الأحكام المتصلة بالسياسة في الفروع وأنها ليست من أصول الدين، ومن هنا فالأحكام المتصلة بالسياسة لا تطالها ثنائية الإيمان والكفر مثل كل أصول الدين، أي العقائد الإيمانية. ومن المؤكَّد أن هذا الخلاف السُّني الشيعي قد ألقى بظلاله على المرجعية العليا لاختيار الحاكم، فقد كان منسجمًا مع موقف الشيعة من قدسية قضية الإمامة أن ينظر إليها كمسألة لا تخضع لاجتهاد، وإنما هي بالتعيين والنص، بينما هي عند عموم أهل السُّنة خاضعة للاجتهاد بالاختيار وعبر آلية الشورى أو ولاية العهد، لكن هذه الأخيرة لم يُضفِ عليها الفقه السياسي السُّني أية قدسية؛ إذ عادة ما يكون اختيار ولي العهد إما مقننًا بعرف في الدولة أو يتم بعد مداولات ومشاورات.

يثير الباحث قضية الاستثناء في التشريع السياسي الإسلامي. إنه من المعلوم أن التاريخ السياسي في الإسلام شهد حضورًا قويًّا للعنف في المشهد السياسي، وفي غالب الأحايين كانت لغة القوة هي التي تحسم في الخلافات، ومن هنا يطرح الباحث موقف الفقهاء من حالات الاستثناء التي يتجاوز فيها الفاعل السياسي الحدود التي خطَّتها الشريعة وقنَّنها الفقه السياسي. يعود الباحث دائمًا إلى كتاب "غياث الأمم" للإمام الجويني، فبعض فصول الكتاب في الأصل خُصِّصت لافتراض الإشكالات التي يجري فيها خرق قواعد الشريعة والتنظير لها، وهو تنظير لا يخرج في الغالب عن التبرير. من هذه القضايا اشتراط القرشية، فالجويني في الواقع لا يقرُّ بهذا الشرط رأسًا، وذلك تبعًا لموقف المتكلمين المشكِّك في أخبار الآحاد وعدم تحقيقها لقطعية الثبوت؛ ولهذا فهو لا يجد حرجًا في ردِّ هذا الحديث ونسف حجيته.
وبالنظر إلى العرض الذي يقدمه الباحث في الاستثناءات المتعلقة بالإمامة، مثل إمامة المفضول مع وجود الفاضل أو إمامة الفاسق، يمكن أن نستنتج أن الفقه السياسي تنازل عن الشروط المتعلقة بالعدالة الفردية للإمام مقابل توفُّر الكفاءة السياسية والأهلية لصيانة مصالح البلاد والعباد. فاقتراف الإمام للمحظورات ولو كانت من الكبائر لا يجيز بأي حالٍ الخروج عليه ما دام يراعي المصالح المتعلقة بالرعية. لكن من الواضح كذلك أن الفقه السياسي الإسلامي افتقد للقدرة على الحسم حتى في الحالات التي يتخلَّى فيها الإمام عن مسؤوليته في الدفاع عن حياض الأُمَّة؛ إذ جعل الأمر مفتوحًا، وأدلى برأي فقهي خالٍ من أي فعل سياسي أو توجيه للخروج من المأزق. إن الجويني بعد أن يعدِّد في عبارة طويلة من كتابه "غياث الأمم" الموبقات السياسية التي يمكن أن يرتكبها الحاكم من قبيل "تعطيل الحقوق والحدود" و"تعطيل الثغور"، وحين ننتظر الرد المناسب من الفقيه، نجد أن كل ما يدلي به هو قوله: "فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم"، ويعلق الباحث على هذا الأمر فيقول: "إن الوقع الساخر لهذه العبارة يشهد على اضطراب فقيه مناهض للثورة"[8]. ولا بدَّ أن الفكرة التي توجه هذا الفقه السياسي المحافظ المتوجس من أي قيامٍ في وجه السلطة هي الموازنة بين المفاسد التي يمكن أن تترتب عن قيام حرب أهلية نتيجة الخروج على الحاكم، وبين الصبر على الظلم. إن الفقيه حين يوازن بينهما يلفي أن الصبر على الاستبداد السياسي يرجح على ما ستفتحه الثورات من نيران فوضى لن تخمد والدخول في دهاليز مظلمة وحالكة لا يعرف أحدٌ أين ستنتهي. إن هذا الأفق المجهول هو الذي يخشاه الفقيه، فيُفضل الرزوح تحت الغطرسة الظالمة للحاكم على المراهنة على ثورة باحتمالات مفتوحة.
يخلص الباحث إلى مجموعة من الخلاصات من قراءته في طبيعة مقاربة الفقه السياسي للحالات الاستثنائية، التي تكاد في الواقع تشكل القاعدة بدل أن تكون الاستثناء. ومن أهمها النظر إلى هذه الأحكام الفقهية على أنها آراء أكثر منها أحكامًا تستند إلى مستند من الشريعة، أو تقف على أرض صلبة من معيار شرعي أخلاقي. ومن هذا المنظور يصدر الباحث حكمًا يميز فيه بين الشريعة والفقه، بين النظرية والممارسة، بحيث إن الأولى هي الأُسس والمبادئ الأخلاقية مثل الأمانة والعدل وغيرها من القِيَم الإسلامية التي يفترض أن تنظم الحياة السياسية، بينما كان الفقه هو الآراء التي تعبّد الطريق لقبول حالات الاستثناء. ولعل تناول الفقه السياسي لمفهوم قرآني محوري مثل "البغي" يؤكِّد هذا الأمر ويوضِّحه. إن الواضح من السياق القرآني أن الباغي هو الظالم الخارج على جماعة المسلمين، لكن بشيء من التحوير ستزاح "جماعة المسلمين" ليصير البغي هو مطلق الخروج على السلطة السياسية. إن المثال في هذا الخطاب الفقهي الذي يجب أن يُحفَظ ليس هو القيمة الأخلاقية العليا، وإنما السلطة بغضِّ النظر عن طبيعتها ومدى توافقها مع النموذج المستوحى من القيم. يجمل الباحث نقاشه حول هذه النقطة فيقول: "إن العدل والبغي يحددان وفق طاعة السلطة الحاكمة وعصيانها"[9].
على أن الباحث يثير بعض المسائل التي لا يتوسع فيها بما يكفي، ومنها مناقشته للمرجعية الحديثية التي يستلهم منها الفقيه آراءه. إن هذه النصوص في الواقع تنتمي إلى الشريعة لا إلى الفقه كما رأينا في تمييزه السابق. والباحث لا يثير نقاشًا حول السياق الذي ظهرت فيه هذه النصوص الحديثية على النحو الذي يسمح له بحفظ ذلك التمايز بين الشريعة والفقه. إن بعض النصوص -بتعبيره- ترسخ نوعًا من السلبية إزاء الفتن السياسية التي يعرفها المجتمع الإسلامي، فهي تدعو -كما يحلِّل الباحث- إلى الانسحاب ككل لا إلى التفاعل الإيجابي الأخلاقي معه وتحمل المسؤولية التي يفرضها الانتماء إلى جماعة المسلمين، ومن ضمن هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذًا فليعذ به" (صحيح البخاري، الحديث رقم 7081). ولهذا يرى الباحث أن هذه النصوص الحديثية التي لم تُقرأ قراءة تلائمها مع شرطها التاريخي الأول من أجل تنزيل سليم على النوازل التي يجابهها المجتمع الإسلامي قد أسهمت فيما يعتبره: "إضعافًا لهذا الفقه الذي لم يتمكَّن من التحرُّر نهائيًّا من اللاهوت"[10]. إننا نعرف من تجربة الصحابة رضي الله عنهم أن كثيرًا منهم لم يكن ينسحب حين تثار قلاقل سياسية، ومنهم مقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الإمام علي بن أبي طالب وبنيه وأحفاده، وهذا يعني أن مثل هذه الأحاديث تحتاج لقراءة جديدة، بدل أن تؤخذ على ظاهرها وتصدر على ضوئها أحكام تقضي بأنها تكرس السلبية أو تضعف الفقه السياسي، وإلا فإن الباحث في الواقع يعيد نفس القراءة الاستشراقية التي انتقدها في مقدمة كتابه، وميزتها التسرع في ازدراء الموروث المنتمي إلى الآخر والحكم عليه بالدونية.
يكتب الباحث مكرم عباس في هذه النقلة من عقد الإمامة إلى عقد الشوكة فيقول: "ننتقل من عقد الإمامة إلى انعقاد الشوكة، أي من حقيقة قيام عقد الإمامة على إرادة متعاقدين، إلى حقيقة قيامها على قوة تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع"
إن هذا التمايز بين الشريعة والفقه له وجه آخر في خطاب الفقه السياسي الإسلامي، وهو ذلك الاعتقاد في تعاقب نظامين متعارضين في التاريخ الإسلامي: الخلافة الراشدة، والملك الذي ابتدأ مع الأمويين. يناقش الباحث التغيير الحاصل بتحول الخلافة إلى الملك؛ فنلاحظ أنه يستعيد التحليل الذي قدَّمه محمد عابد الجابري. فالباحث يرى أن جوهر هذا التحول هو انفصال العلماء عن الأمراء[11]. وهو في الواقع قول لا يستقيم مع المنهجية التي اتبعها في كتابه هذا والقائمة على تحليل النصوص التراثية وبيان حدودها على ضوء مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة. إذ إن هذا التفسير التبسيطي لا يفعل أكثر من استدعاء مقولة للفقيه المغربي المالكي ابن العربي الذي يتحدث عن "انفصال العلماء عن الأمراء" دون أي تصرف منه ودون حتى الإحالة على قولة ابن العربي[12]. على أنه يهمل الشطر الثاني من المقولة، وهو لا يقل أهمية، بل إنه في الواقع يُعبّر عن صميم التغير الحاصل في المجتمع الإسلامي، فابن العربي يتحدَّث عن "انفصال الجند عن الرعية". لقد توقف الجابري مع مقولة ابن العربي وعبَّر عنها باللغة السوسيولوجية الحديثة، فتحدَّث عن ظهور المجال السياسي في الوقت الذي لم يكن المجتمع الإسلامي الأول في عهد الخلافة يمارس سياسة بالتمييز بين السلطة السياسية والسلطة العلمية، أو بين الشخصية المدنية و العسكرية، نقرأ في كتاب "العقل السياسي العربي": "إذا نحن أردنا أن نعبّر عن مضمون هذا التحول بتوظيف المصطلح السياسي السوسيولوجي، قلنا: إنه انتقال من دولة بدون مجال سياسي إلى دولة انبثق فيها مجال خاص تمارس فيه السياسة كسياسة"[13].
كانت فكرة الإجماع -إلى حد ما- هي الفكرة التي أسَّست الوعي السياسي في فترة الخلافة. فالخليفة كان يحظى بإجماع المسلمين وقبولهم. لكن الذي جرى في الملك العضوض هو انقلاب على مستوى الشرعي. فلم تعُد فكرة الإجماع من المفكَّر فيه في مجتمع تتجاذبه النوازع القَبَلية المتباينة، والمحتكم إلى شرعية القوة لا إلى شرعية الحق. لقد حدث ما يسميه الباحث "ذبول الفقه"[14]، فالسلطة السياسية تطلب، بل تلحُّ على أن يكون للفقيه سلطة تشريعية في كل قضايا الفرد والمجتمع، لكنها تودُّ أن تنفلت من أية رقابة، وتتعالى على أية سلطة فقهية تحدد لها مساراتها. ومن هنا ذَوت فكرة الإجماع لصالح "الشوكة"، و"عقد الشوكة" الوهمي ينعقد بشخص واحد إن كان مطاعًا مسموع الكلمة كثير الأتباع، وبعبارة الجويني: "إن بايع رجل واحد مرموق كثير الأتباع والأشياع، مطاع في قومه، وكانت منعته تفيد ما أشرنا إليه، انعقدت الإمامة"[15].
إن كتاب مكرم عباس هو كتاب عن الفكر السياسي في العصر الوسيط، ولن نعدو الصواب لو قلنا إن الفكر السياسي الحديث الذي أحدث قطيعة مع العصر الوسيط إنما انطلق من الافتراق مع القوة كمصدر للشرعية. ويمكن أن نجد هذا النقد لشرعية القوة في كتابين مؤسسين في الفكر الغربي الحديث: كتاب "العقد الاجتماعي" لجون جاك روسو، وكتاب "في الحكم المدني" لجون لوك، فجون جاك روسو يخصص فصلًا في كتابه المشار إليه لتفنيد سلطة الأقوى فيقول: "إن أعمال أصحاب السطوة والبطش مهما كانت شاملة ليست معيار الحق"[16]، وهي الفكرة نفسها التي يفصل فيها جون لوك مميزًا بين مختلف أصناف الغلبة الداخلية والخارجية[17].
وإذا عدنا إلى المجال التداولي الإسلامي، نجد أن قطاعًا واسعًا من الفكر الإسلامي، وخصوصًا المتأثر بعلم الكلام، لم يكتفِ بالتخلي عن فكرة الإجماع لتأسيس السلطة السياسية المشروعة، بل إنه كذلك عمل على سحب البساط من تحت ما يؤسس لفكرة الإجماع في حدِّ ذاتها. ومن هنا فالجويني بوصفه فقيهًا ومتكلمًا رأى ألَّا حجية في الأحاديث النبوية التي تثني على إجماع الأُمَّة من قبيل: "لا تجمتع أمتي على ضلالة"، وعدَّها أحاديث آحاد لا يمكن الوثوق بثبوتها. والواقع أن الجويني يقع في تناقضٍ صارخٍ حين يرفض حديث حجية الإجماع عقليًّا لأنه آحاد، وفي المقابل يبرر فقهيًّا الشوكة كمصدر للشرعية، رغم أن هذه الشرعية ليس وراءها غير شخص واحد. يكتب الباحث مكرم عباس في هذه النقلة من عقد الإمامة إلى عقد الشوكة فيقول: "ننتقل من عقد الإمامة إلى انعقاد الشوكة، أي من حقيقة قيام عقد الإمامة على إرادة متعاقدين، إلى حقيقة قيامها على قوة تفرض نفسها بحكم الأمر الواقع"[18].

الفلسفة السياسية
إذا انتقلنا إلى الخطاب الفلسفي، فإن الباحث مكرم عباس يرى أن منطلقات وغايات خطابهم السياسي مختلف تمامًا عن الآداب السلطانية والسياسة الشرعية. إن الخطاب الفلسفي حول السياسة ينطلق من منطلقات علمية، وهو يستلهم نتائج علمَي الفلك والأحياء من أجل بناء منظومة سياسية. وهكذا فالنظرية السياسية الفلسفية حول المدينة هي التي تحاكي نظام الكون وتحاول أن تتبع نظامه الخاص. أما الغاية القصوى فهي بلوغ الكمالات الإنسانية التي خُلق الإنسان لأجلها. وهذه الفكرة الأخيرة هي التي تبرر بالذات ضرورة الاجتماع الإنساني ومن ثَمَّ تأسيس الدولة.
ونلحظ أنه في الكوسمولوجيا السياسية للفارابي تحضر أفكار ما ورائية كثيرة، بل إن منظومته كلها قائمة على محاكاة تصور ميتافيزيقي للعالم، بعيد عن أن يكون علميًّا، لكن لا يبدي المؤلف تلك النبرة النقدية في مقاربة هذه النظرية السياسية كما هو الشأن مع السياسة الشرعية. فالفارابي يرفع الرئيس الأول لمدينته الفاضلة المتخيلة إلى صنو النبي القادر على الاستيحاء مما يسميه عقلًا فعَّالًا عن طريق الفيض الإلهي، ومن غريب تصورات الفارابي أنه يعد الفيلسوف والنبي معًا ممَّن يُوحى إليهما، لكن بينما وحي الفيلسوف تام يجعل منه فيلسوفًا حكيمًا، بينما ما يوحى إلى النبي مجرد تخيلات ومجازات. وهي نظرية لا تختلف من حيث تأسيسها لنزعة استبدادية عن الآراء الفقهية. فإذا كان الاستبداد هو الحكم الفردي، فإن الفارابي لا يتوانى عن القول بأن رئيس المدينة يدبر وحده ولا يشاركه أحد في تدبيره فضلًا عن أن يدبر له، يقول: "الرئيس الذي هو في تلك الرتبة يدبر كل ما دونه ولا يمكن أن يدبره آخر أصلًا، ويرؤس كل ما دونه"[19]. ومن التعقيبات النادرة للباحث في كتابه، حين يناقش التصور الوسيطي للنشاط النظري بوصفه أرقى نشاط، وهو الذي يليق بالفيلسوف المفارق للمادة، فإنه يصدر حكمًا بأن هذا التصور ينظر إلى الشعب الذي يقوم بأعمال تنتمي إلى أعمال الحِس نظرة ازدرائية، يقول: "إنها فكرة لا شكَّ في أنها تعزز النظر إلى الشعب باعتباره جسمًا أدنى وكتلة مضطربة ومادة غير منضبطة"[20].
مع فيلسوف قرطبة أبي الوليد ابن رشد، يتناول الباحث وجهًا آخر من أوجه المقاربة الفلسفية للإشكالية السياسية، وهي تلك المتعلقة باللاهوت الديني. لقد دافع ابن رشد في مؤلفاته عن تصورين للدين: تصور للعامَّة وآخر للخاصَّة. فالعامَّة تتقبَّل الدين كما هو دون أن تثير الآيات المتشابهات إشكالًا في اعتقاداتها، بينما للخاصَّة -وهم علماء الكلام بالخصوص- تأويلات شتَّى لبعض القضايا الدينية، وهذه التأويلات تتعارض من مذهب كلامي إلى آخر، وقد رأى ابن رشد أن تعارض هذه التأويلات قد شوَّش على العامَّة وأفسد المجتمع الإسلامي ومزقه كل ممزق. يجمل الباحث مكرم عباس النقد الرشدي لعلم الكلام الإسلامي في علاقته بوضعية المجتمع الإسلامي فيقول: "يتهم ابن رشد علم الكلام بأنه سبب الخلافات السياسية والحروب وتمزق الجسد الاجتماعي، ويتم التنديد به باعتباره ممارسة إقصائية وغير متسامحة تقود باسم المعرفة العميقة بالنص القرآني إلى استبعاد الخصم اللاهوتي والسياسي؛ بل وتقيم الاستبعاد السياسي والاجتماعي على أساس التكفير"[21]. وهكذا فما تقود إليه أطروحة ابن رشد في نقده لعلم الكلام هو إقرار تعدُّدية إيمانية بالفصل بين الإيمان وبين التأويل اللاهوتي للعقائد الإيمانية من جهة، ثم تحلي السلطة السياسية بنوعٍ من الحياد السياسي. ويرى الباحث مكرم عباس أن هذه الأفكار هي نفسها التي حاول إيمانويل كانط استعادتها في كتابه "الدين في حدود مجرد العقل".

النظرية الخلدونية
يخصُّ الباحث نظرية ابن خلدون في الدولة بفصل خاص. ولهذا التخصيص ما يبرِّره بالفعل؛ فمقاربة ابن خلدون للدولة تختلف عن المقاربة السابقة، وإن كان يستفيد منها ويضمِّن نتفًا منها نظريته. إن ابن خلدون لا يهتم كثيرًا بسؤال الشرعية والمشروعية، ولا بالمدينة الفاضلة المثالية. إنه على العكس من ذلك ينحو منحًى تاريخيًّا اجتماعيًّا في مقاربته، فيرصد كيف تتشكَّل الدول في التاريخ الإسلامي بتحليل واقعي.
يثير الباحث السياق التاريخي الذي عاش فيه ابن خلدون. إنه عصر اتَّسم بظهور إرهاصات تحوُّل شامل؛ ففي الوقت الذي كانت تتبرعم نهضة أوروبية ناشئة، استطاع ابن خلدون بحسِّه التاريخيِّ أن يستشعر حركيتها، فعلى المستوى العربي الإسلامي كان هناك تراجع تام عبَّر عنه ابن خلدون بقوله: "وكأنما نادى لسان الكون بالخمول فبادر بالإجابة". من جهة كيانات سياسية تنحلّ، وطاعون يفتك بمحاسن العمران...إلخ. ولعل هذا السياق التاريخي الذي عاشه ابن خلدون هو الذي دعاه لقراءة المنظومة السياسية والاجتماعية للمجتمعات المغربية والعربية قراءة واقعية، والإمساك بخيوط هذه المنظومة فيما يشبه إمساك المؤرخ السوسيولوجي المتطلع بدينامية مجتمعه.
ينطلق ابن خلدون في بناء نظريته السياسية من اللبنة الأولى: الإنسان. ويبدو أن ملاحظةً أثارت انتباه الباحث بخصوص تصور ابن خلدون للإنسان؛ إذ يرصد تناقضًا في تمثل ابن خلدون بين الخيرية والنزعة الشريرة. وفي الحقيقة ليس ثمة تناقض، فابن خلدون يستلهم أفكارًا دينية مبثوثة في القرآن والحديث عن الأصل الخيِّر للإنسان، لكن إهمال هذا الجانب الفطري في الإنسان يتسبَّب في تحوُّل يحدث في طبيعته، أو بعبارة ابن خلدون: "الشر أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده ولم يهذبه الاقتداء بالدين".
والسياسة في نظر ابن خلدون تتفرع عن هذا التصور. إنها إفراز لتلك الجدلية القائمة بين الخير والشر، بين العقل من جهة، والدوافع الإنسانية التي تحتاج إلى كبح جماحها من جهة أخرى. غير أن ابن خلدون لا يكتفي بالانطلاق من طبيعة الإنسان، وهذا ما يضفي على نظريته طابعًا سوسيولوجيًّا. إن ابن خلدون يقرِّر أن العمران صنفان: عمران بدوي وعمران حضري. وبخصوص قيام الدولة وتأسيسها، يحتلُّ مفهوم العصبية مكانة مركزية في نظريته. فالعماد الذي تقوم عليه الدولة هو العصبية، أي تلك اللحمة القَبَلية التي تدفع بقبيلة ذات طابع بدوي للمطالبة بالملك وإخضاع العصبيات الأخرى. والسبب في أن العصبيات القبلية البدوية هي التي تندفع لتأسيس كيانات سياسية يرجع إلى الرابطة القوية بين أفرادها بسبب عدم الاختلاط بالأجناس الأخرى، وكذلك إلى اعتياد ظروف الحياة الصعبة والقاسية أو بعبارة ابن خلدون "شظف العيش" الذي يجعلهم أشداء قادرين على التغلُّب على الآخرين. يشرح الباحث هذه النظرية الخلدونية فيقول: "تتغذى القوة السياسية في البداية، وهي بالضرورة من أصل بدوي أو رعوي وناتجة بشكل جوهري عن حضارة الصحراء أو البادية، على القيم الحربية ونقاء الأصول لكي تغزو في مرحلة ثانية إقليمًا حضريًّا تحكمه سلالة متهالكة بعيدة بالفعل عن أصولها الحربية"[22].
والفكرة التي تفسِّر نشوء الدولة هي نفسها التي يفسِّر من خلالها ابن خلدون ذبولها وانهيارها. إنها العصبية كذلك. فالعصبية التي كانت في البدء نقية الأصول تستبدل العمران الحضري بالعمران البدوي، وبهذا تفقد لحمتها بتقريبها لعصبيات أخرى، وكذلك تتخلَّى عن خلق التوحش الذي كان مُعينًا لها على التغلُّب وتشكيل الدولة، فتظهر أجيال رخوة اعتادت رغد الحياة والطبع المتحضر، فتتناسى الأصول الأولى المؤسسة للدولة. لهذا فكل دولة تمرُّ بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، ثم يأتي جيل مخضرم تبلغ معه الدولة قمَّتها، فهي تحتفظ بأمجاد المؤسسين وبعض طباعهم وفي الوقت نفسه تتوسع الدولة وتبلغ أعلى مجدها، لكن مع الجيل الثالث تذبل الدولة وتهرم بسبب "انقلاب خلق التوحش ونسيان عوائد البداوة التي كان بها الملك من شدة البأس" كما يقول ابن خلدون. ويلاحظ الباحث أن ابن خلدون يقيم تماثلًا بين الكيان السياسي والكائن الإنساني، فهما معًا يمران بالمراحل نفسها، بل إن ابن خلدون يستعمل مفاهيم متعلِّقة بالأعمار الإنسانية لوصف مراحل الدولة، فالمرحلة الأخيرة يعتبرها مرحلة الهرم ويصف ما يعتورها من قلاقل وفتن تمهد لسقوطها بالمرض.
يخصِّص الباحث فصلًا لتناول علاقة الدين بالسياسة. من المعلوم أن ابن خلدون في تصنيفه للأنظمة السياسية اعتبر النظام السياسي الذي يدمج المصالح الدنيوية بالمآل الأخروي أفضل نظام سياسي، وهو يفضِّله على النظام السياسي المتوسل بالسياسة العقلية من أجل تحقيق السعادة والعدالة على الأرض. وهذا في الواقع هو المضمون الوحيد لعلاقة الدين بالسياسة في فكر ابن خلدون؛ ولهذا لا يفتأ الباحث ينبِّه على أن الدين والسياسة في المجتمع العربي الإسلامي لم يتجسدا في مؤسسات تمثلهما، فالدين عند ابن خلدون قيم أخلاقية بالأساس، ويبدو هذا الملمح في كتابته بالخصوص حين يتحدَّث عن العِرق العربي فيقول: "إذا كان الدين بالنبوءة أو الولاية، كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم"[23]، وعلى هذا الأساس يرفض الباحث أي إسقاط لتجربة العلاقة بين المؤسسة المدنية ومؤسسة الكنيسة الدينية على التجربة الإسلامية. يقول مكرم عباس: "إنه من الضروري الإشارة إلى أن جدلية السياسي والديني لا تشير مطلقًا إلى وجود علاقة بين سلطتين تمثلهما مؤسستان قد تتعارضان"[24].
في ختام هذه القراءة، لا بدَّ من التأكيد على أن الشمولية التي أرادها الباحث مكرم عباس في تناوله لمختلف المقاربات للإشكالية السياسية كانت لتكون أكثر خصوبةً لو أن الباحث انفتح على تصورات أخرى أهملها في كتابه هذا، ومن أهمها المقاربة الكلامية. ويبدو أن الباحث اكتفى في استحضاره لعلم الكلام على النقد الرشدي كما رأينا في هذه المقالة. بينما الواقع أن المذاهب الكلامية كانت لها تصوراتٌ خصبة للإشكالية السياسية، وأسهمت إسهامًا كبيرًا في ابتكار مقولات، وهذا ما يمكن أن نجده عند فرق كلامية مثل القدرية والمعتزلة والخوارج والشيعة. وقد وسم أحد الباحثين الرؤى السياسية لبعض الفرق المعارضة في التاريخ الإسلامي بـ"الحركة التنويرية" إدراكًا منه لأهميتها النظرية والتاريخية. وقد رأى أن تأثيرها لم يكن حبيس قراءات نظرية، بل أسهمت عمليًّا في خلق دينامية سياسية، يقول عابد الجابري عن الحركات الكلامية مثل القدرية والمعتزلة: "إذا كان لكل ثورة كبرى أنتلجنسيا خاصة بها، أي مفكرون متنورون يحملون مشروعها ويبشرون به، فإنه يمكن القول بدون تردُّد إن رجال حركة التنوير هذه هم الممهدون الحقيقيون للثورة العباسية"[25].
- الهوامش
-
[1] مكرم عباس، الإسلام والسياسة في العصر الوسيط، ترجمة: محمد الحاج سالم (الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2020م)، ص14.
[2] نفسه، ص30.
[3] قد يكون في إشارتنا إلى الحضور المستمر لفكرة ما من الآداب السلطانية توضيح لمسألة بديهية في هذه الكتابة، وذلك أن الدارسين الذين أنجزوا أبحاثًا مستقلة عن الأدبيات السلطانية لاحظوا وجود ما سمّوه بالتناص في مجمل المؤلفات، ويقصدون بذلك ظاهرة التكرار والاستنساخ، انظر مثلًا:
عز الدين العلام، الآداب السلطانية (الكويت: عالم المعرفة، 2006م)، ص76.
[4] مكرم عباس، الإسلام والسياسة، م. س، ص63.
[5] نفسه، ص70.
[6] نفسه، ص88.
[7] "عنصر الجدة في عمل الماوردي يرجع إلى كونه انتزع الكلام في الإمامة من كتب المتكلمين". محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010م).
[8] مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص102.
[9] نفسه، ص110.
[10] نفسه، ص113.
[11] نفسه، ص117.
[12] يقول ابن العربي: "كان الأمراء قبل هذا اليوم، وفي صدر الإسلام، هم العلماء، والرعية هم الجند، فاطرد النظام، وكان العوام القواد فريقًا والأمراء فريقًا آخر. ثم فصل الله الأمر بحكمته البالغة وقضائه السابق، فصار العلماء فريقًا والأمراء آخر، وصارت الرعية صنفًا وصار الجند آخر، فتعارضت الأمور". ذكره ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق وتعليق: علي سامي النشار (بغداد: منشورات وزارة الإعلام، 1977م)، ج1، ص391. ونلاحظ أن الباحث يستعيد هذا المعنى بتوظيف المصطلحات نفسها، عندما يختزل الفرق بين الخلافة والملك في: "الانفصال الحاصل بين علماء الدين والأمراء بعد أن كانت السلطتان متحدتين في عهد الخلفاء الراشدين". مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص117.
[13] محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، م.س، ص234.
[14] مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص120.
[15] الجويني، غياث الأمم، ص55.
[16] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, (Paris : Flammarion, 1992), p. 30.
[17] John Locke, Two treatsies of civil government, (Baldwin Printer : London, 1824), p. 247.
[18] مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص124.
[19] ذكره مكرم عباس، الإسلام والسياسة، ص147.
[20] نفسه، ص147.
[21] نفسه، ص163.
[22] نفسه، ص178.
[23] نفسه، ص192.
[24] نفسه، ص188.
[25] الجابري، العقل السياسي العربي، م. س، ص328.