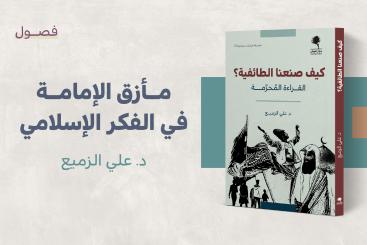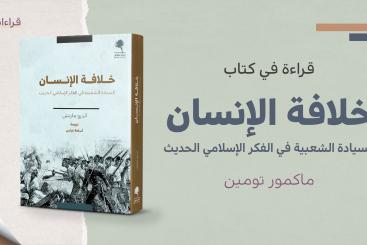عن الروح العلمية في الفكر الإسلامي: السببية أنموذجًا

لا ينفصل التحديث عن الحداثة، واستهلاك منتجات العلم الذي نشأ في مناخ حداثي، من تقنيات ومخترعات حديثة، لا يعني الانخراطَ في مشروع الحداثة إسهامًا وإضافة ببعد كوني.
إن الفرق بين التحديث والحداثة يمكن مقارنته بتشبيه لأحدِ الباحثين بين "الأواني" و"المعاني"(1)؛ "الأواني" هي المنتجات المادية التي نتوصل إليها من خلال توظيف منهج علمي معين، وهذا الأخير هو بالذات ما أطلق عليه هذا الباحث "معاني"، ومن لم يتشبع بروح المعاني التي فتحت فتوحًا علمية وأثبتت نجاعتها فإنه سيظل بلا شك عالةً على الآخرين في استهلاكه للأواني، من غير أن يرتفع إلى درجة الإبداع وبصم المشروع الحداثي بمساهمات علمية تضيف لبنة جديدة إلى هذا الصرح.
من غير شك أن العلم بمعناه الدقيق هو أحد أهم مقومات النهضة والتقدم في العصر الحديث، وقد شغل هذا السؤال منذ بداية عصر النهضة العربية تفكير النخب الإصلاحية، وبحثت عن جينيالوجيا التأخر العلمي في العالم العربي، وقد تنوعت الإجابات التي قدمت لهذا الهم المعرفي، بين من يرد ذلك إلى "إسلام الحديث"(2)، باعتبارها منظومةً تضخمت بشكل كبير حتى سيطرت على العقل العربي الإسلامي وحالت دون تحرره، بينما يرى أحد المفكرين من خلال مقاربة إبستمولوجية، أن الفكر الإسلامي توزعته ثلاث أنظمة معرفية: بيانية، وعرفانية، وبرهانية.
كان النظام المعرفي الأول ينصب حول نص ديني، وموضوع كهذا كما يرى هذا المفكر لا يسمح بالتوجه إلى الطبيعة، وبالتالي ظل هذا النظام المعرفي بحكم منهجه البياني بعيدًا عن الإطلال على هذه القارة المعرفية العلمية، أما النظام المعرفي العرفاني فهو اللاعقل نفسه، إنها منظومة مجافية للعقل وتقوم على دمج نسق ديني بمسحة سحرية في العلم، وبالتالي فلم يكن ينتظر أن يتطور هذا النظام المعرفي إلى فكر علمي بالمعنى الحديث للعلم.
لعل الفكر الأوروبي الذي قرأ تاريخ تطور العلم وتموجاته وانتقالاته عبر الحضارات، وترك مسافة من الداء المزمن لفكرة المركزية الغربية، قد اعترف بمديونية الغرب للثقافة العربية.
أما النظام المعرفي البرهاني، فقد استطاع بتمثله لمفاهيم من المنظومة الأرسطية وخاصة القياس، ودمجها بمناهج من النظام البياني مثل "السبر والتقسيم" من إبداع المنهج العلمي الحديث، يقول المفكر معلقًا على نص طويل للعالم الفيزيائي العربي ابن الهيثم يصف فيه خطوات المنهج العلمي "استئناف النظر في المبادئ والمقدمات، الاستقراء، التصفح، تمييز خواص الجزئيات، السير بالتدريج في البحث والمقاييس مع انتقاد المقدمات والتحفظ في النتائج وطلب الحق وتجنب التعصب للآراء...تلك هي الأسس التي قام عليها العلم الحديث في أوربا بعد أن لم تجد قابلة لها في التجربة الحضارية العربية"(3)، ولعل الفكر الأوروبي الذي قرأ تاريخ تطور العلم وتموجاته وانتقالاته عبر الحضارات، وترك مسافة من الداء المزمن لفكرة المركزية الغربية، قد اعترف بمديونية الغرب للثقافة العربية، سواء على مستوى ظهور مفهوم المثقف(4) الذي سيحرك الراكد ويقدم بديلًا لرجل الدين واهتمامته الدينية المحضة، أو على صعيد الاعتراف بأسبقية العالم الإسلامي إلى اكتشاف المنهج التجريبي. يقول بريفولت: "لم يكن روجر بيكون أكثرَ من أحد الحواريين أو الرسل الذين نقلوا العلم الإسلامي ومنهجه إلى أوربا المسيحية"(5).
ثمة حتمًا عوامل موضوعية فكرية كانت وراء تعثر مسيرة العرب العلمية، ويمكن أن نرجع ذلك إلى ما أشرنا إليه في مستهل هذا المقال من مفارقة "التحديث" و"الحداثة"، فقد كان في العالم العربي دائمًا تيارات- لها السيطرة الفكرية عمومًا- تتبنى أقاويل فكرية لا تتفق مع البراديغم الفكري المنتج للعلم، وقبل أن نولي وجهنا إلى الماضي لنقف على هذه الأنساق الفكرية. لنلقِ نظرة سريعة على بعض هذه الآراء ومعاكستها للروح العلمية.
إن الفكر العلمي الآن تجريبي، لقد أشار باشلار إلى أن الفلسفةَ يجب أن تكون تابعةً للمختبر، بمعنى آخر لابد أن تكون الحقيقةُ الفلسفية العلمية قادمةً من المختبرات التي تتوسل بالاختبار التجريبي، مستعينة في ذلك بأحدث الوسائل التقنية، أما المتفلسف العربي الذي يجر معه إرثًا عرفانيًّا يجعله ينفر من كل الوسائط المعرفية والعلمية ويرتاح إلى المعرفة الدينية التي تُلقَى في القلب مباشرة، فإنه يرفض ويطرح جانبًا هذا التوسل بالأدوات العلمية، مفضلًا عليها المجردات التي تستخلص دون وسائط.
يقول أحدهم في عبارة تشي باستمرارية العقل المستقيل في التأثير على الثقافة العربية المعاصرة: "إن العلم الحاصل بالعقل المجرد ليس مستفادًا بصورة مباشرة كما لو كان ينقدح في ذهن الإنسان لأول مرة، وإنما هو مستفاد من اصطناع لوسائط ووسائط الوسائط ووسائط أخرى فوقها، حتى يتهيأ له ضبط الظواهر وصفًا وتجريبًا ومراقبةً وتنبؤًا"(6).
يمكن أن نلاحظ في الإبستمولوجيا المعاصرة كذلك: أن تطور الفكر العلمي يقوم على مبادئ النسبية، فالنظريات العلمية تقطع مع بعضها، لهذا رأى بعض الفلاسفة الأوربيين أن التطور يتحقق بقطائع Ruptures، وأن كل نظرية علمية لا تكون كذلك إلا حين تكون قابلةً للدحض Réfutable(7) ،ومن نافل القول أن هذه الرؤية النسبية التي تُريد أن تترك منافذَ لهبوب نسائم التجديد، وتقدم مسوغًا نظريًّا لأيديولوجيا التقدم تستبطن غنى العالم الذي يستوجب فكرًا مركبًا حتى يكون بمكنته السير المتواصل نحو فهمه وتجويد ملكة الفهم هذه. يقول إدغار موران: "إن الكون أكثر غنى مما يمكن أن نتصوره بنيات دماغنا؛ مهما كانت درجة نموه(8).
إن النظريات العلمية كما يكشف عنها هذا التاريخ ليس بعضها واصلًا لبعض، وإنما على الحقيقة بعضها قاطع عن بعض؛ بحيث تقوم بينها علاقة تباين وتعاند لا علاقات تكامل وتساند.
أما المتفلسف العربي المولع بالثبات، والمثقل بهوس تناغم الأنساق المعرفية، ولو على حساب عدم نجاعتها، فإنه يرى في هذه الحركية التاريخية التي تنمُّ عن حيوية الفكر مع التجرد وإعمال ملكة النقد الحاملة على التجاوز، يرى فيها فوضوية، وهي سمة ملازمة للعقل المجرد الذي ينتهي به المطاف إلى انقلاب أهدافه إلى ضدها، وفي الحقيقة هذا القول يذهل عن ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج مبهرة وفتوح علمية كبيرة من جراء هذه الحركية الفكرية والمستجدات المنهجية التي تغني الفكر العلمي.يقول طه عبد الرحمن واصفًا القطائع الإبستمولوجية، بعبارة فيلسوف العلم باشلار، التي يخضع لها تاريخ العلم: "إن النظريات العلمية كما يكشف عنها هذا التاريخ ليس بعضها واصلًا لبعض، وإنما على الحقيقة بعضها قاطع عن بعض؛ بحيث تقوم بينها علاقة تباين وتعاند لا علاقات تكامل وتساند (...) وأن كلًّا منها ما أن يتخذ له طريقًا في الإجابة على بعض الأسئلة، حتى يقع في أسئلة أخرى قد تكون أعوص منها، فتأخذ الأسئلة في التزايد والانتشار في كل اتجاه قد يؤدي إلى الخبط"(9).
تحيلنا هذه المفارقات على حقيقة تحدث عنها أحد المفكرين، وهي أنه بينما تطغى الشعارات الإصلاحية في الفكر العربي، يلاحظ في المقابل غلبة مذاهب إيديولوجية تحمل في أحشائها بذور التخلف، فلسفات تلغي العقل وتعلي من شأن اللاعقل، وأحيانًا من خلال استحضار نماذج من الفكر الأوربي نفسه ناقدة للحداثة(10)، وهكذا بينما يحتفظ بمظاهر اللاعقل التي ورثها عن موروثه، يضيف لاعقل آخر طارئ على الثقافة الغربية.
يقول المفكر: "إن الخطاب الفلسفي في الفكر العربي الحديث والمعاصر الذي لم يتردد هو الآخر في إعلان انتمائه إلى الإشكالية العامة للنهضة بقي مناهضًا لنفسه، لطموحاته ومبررات وجوده. لقد كان ولا يزال يبحث عن أصالة فلسفة الماضي في القطاع اللاعقلاني في تراثنا الفكري وعن فلسفة عربية معاصرة في القطاع اللاعقلاني في الفكر الأوربي"(11).
علم الكلام و إنكار السببية في الماضي
قبل أن يكون العلم منتجًا ماديًّا فهو يحمل كذلك بين طياته روحَ المنهج الذي أدى إليه، ولعل من أهم أسس هذه الروح العلمية هو السببية، فهذه النزعة الباحثة عن أسباب الأشياء هي فضول فطري في الإنسان، كما أن معرفة شيء ما هو مرتبط كبير الارتباط بمعرفة سببه، فالكثير من المكتشفات التقنية في مختلف فروع الحياة من طب ووسائل تواصل واتصال وغيرها كان دافعها الأول هو اكتشافات السببية.
إننا حين نعرف مثلًا كيف يعمل عضو ما داخل جسم الإنسان والأسباب التي تتحكم في عمله، يمكن لنا أن نستبق مرضًا ما فنبادر إلى شفائه بتوفير أسباب تمام عمله، فلو أن الطب الحديث لم يعلم على سبيل المثال أن الأنسولين هو المسؤول عن تنظيم جزيئات السكر في جسم الإنسان، لما توصل إلى إنتاج هذه المادة ليقدمها لمرضى السكري، لهذا يمكن القول مع الأستاذ فؤاد زكريا في كتابه "التفكير العلمي": إن "معرفة أسباب الظواهر هي التي تمكننا من أن نتحكم فيها على نحو أفضل، ونصل إلى نتائج عملية أنجح بكثير من تلك التي نصل إليها بالخبرة والممارسة (...) فالمعرفة العلمية الحقيقية مرتبطة بالبحث عن أسباب الظواهر"(12).
لا علم إذًا دون معرفة الأسباب، والتحكم في الطبيعة، وهو لب مشروع الحداثة، يفترض البدء باكتشاف القوانين التي تنبني عليها هذه الظواهر الطبيعية، فيمكن إذًا أن نقول- ابتداءً: إن إنكار قانون السببية في الفكر الإسلامي، هو أحد عوامل تعثر الفكر العلمي في العالم العربي الإسلامي، لنوضح كيف تأدى الفكر الإسلامي إلى إنكار مبدأ السببية.
تنتمي النظرة التي شكلها الفكر الإسلامي في الماضي عن العالم إلى مباحث علم الكلام. لقد ابتدأ هذا المبحث من الناحية التاريخية داخلَ حقل اهتمام سياسي، فكان يناقش بخطاب ديني فوقي قضايا سياسية، لكن سيحدث أن يتناسى اللاحقون هذه الجذورَ السياسية فيتناولون مقولاتهم بالتحليل والدرس، مع تطويرها شيئًا فشيئًا لتتحول إلى منظومة متكاملة تطال كذلك رؤية الإنسان المسلم إلى العالم، وليس فقط الماورائيات(13).
ويقسم هذا العلم إلى مبحثين؛ جليل الكلام ودقيق الكلام، وتحت هذا الصنف الثاني تندرج رؤية الفكر الإسلامي إلى العالم، لكنها عمومًا ليست نظرةً متحررة من "جليل الكلام"، بل إنها ترتبط دائمًا بالله تعالى، وفي هذه الإشكالية بالذات، أعني مسألة السببية، كانت الخلفيات الدينية هي التي وجهت النظر فيها.
لكي نفهم الجذور الدينية الكلامية لنفي السببية في الفكر الإسلامي، ينبغي أن نعود إلى البناء الاستدلالي الذي أدى بالمتكلمين لهذا الرأي الذي لا يؤسس لنظرة علمية صارمة. تبتدئ الفكرة مع نظرية "الجوهر الفرد" أو "الجزء الذي لا يتجزأ" أو بالعبارة المعاصرة "الذرة"، لقد قال معظم المتكلمين لغايات تيولوجية بحتة بهذا الجوهر الفرد، وأصل المفهوم لم يكن إسلاميًّا بحتًا، بل مأخوذًا من فلسفات يونانية وهندية.
يقول أحد المستشرقين عن "الاكتشافات" الأولى لهذا المفهوم: "فأما بعض الفلاسفة اليونان فقد ذهبوا إلى أن الجسم يتألف من أجزاء صغيرة لا تنقسم، وحاولوا تعيين خصائصها، ومنهم ديمقريط"(14).
أمَّا لِـمَ قال المتكلمون بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ- فلم يكن في الواقع لدوافع علمية بحتة، أي فضول علمي لفهم الكون، بقدر ما أملته اعتبارات دينية، فالذين قالوا بالجوهر الفرد أرادوا من ذلك إثبات شيئين؛ أولًا أن كل ما في الكون قابل لأن ينقسم إلى قسمة لا تقبل الانقسام، وبالتالي فالعالم متناهٍ، ومنه إحصاء الله تعالى لكل ما في الكون، مصداقًا للآية الكريمة: {وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا} (الجن: 28)، وبالتالي فمضمون الفكرة تبقى دينية، وغير فلسفية أو علمية.
وهذا ما يشير إليه الخياط في حديثه عن مذهب أبي هذيل العلاف كأحد أوائل القائلين بالجوهر الفرد، يقول الخياط: "اعلم أن القول الذي كان أبو الهذيل يناظر فيه، هو أن للأشياء المحدثات كلًّا وجميعًا وغايةً ينتهي إليه في العلم بها والقدرة عليها، وذلك لمخالفة القديم للمحدثات. فلما كان القديم عنده ليس بذي غاية ولا نهاية ولا تجري عليه بعض ولا كل، وجب أن يكون المحدث ذا غاية ونهاية وأن له كلًّا وجميعًا"(15).
والذي يقصده الخياط من هذه القولة أن المتكلم أراد أن يميز بين الله والعالم، فالله ذو الوجود اللامتناهي لابد أن يكون غير العالم، وبالتالي وجب أن يكون هذا الأخير متناهيًا، ومتشكلًا من ذرات لا تقبل الانقسام، وإلا فلو كانت قابلةً للانقسام إلى ما لانهاية، فإنها ستشترك مع الله في هذا اللاتناهي. إنه بعبارة وجيزة ما عبر عنه الخياط بقوله: "مخالفة القديم للمحدثات".
ولمذاهب المتكلمين في الجوهر الفرد الذي هو أصغر قسمة في العالم التي لا تقبل القسمة إلى ما هو أصغر منها علاقة كذلك بجليل الكلام، ونعني بذلك الأدلة العلمية لإثبات حدوث العالم، وبالتالي إثبات إحدى أهم العقائد الإسلامية وهي خلق العالم وعدم أزليته، وأما تفصيل ذلك: فقد رأى المتكلمون أن لكل جوهر عرضًا، ومن تعريفهم للعرض أنه لا يبقى زمانين، فهي تتغير باستمرار.
"وبما أن الجواهر لا تنفكُّ من الأعراض فهي لا تسبقها في الوجود؛ إذ لا يتصور وجود جوهر بدون أعراض، وبالتالي فهي حادثة مثلها، وإذن فالأحداث حادثة، وبما أن العالم كله مؤلف من أجسام فهو حادث كذلك"(16).
وأما تتمة هذا "الدليل" الذي رآه أبو الوليد ابن رشد غير برهاني بالدلالة الأرسطية للبرهان في كتابه "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"(17)، فهو أن ما دام العالم حادث، والمحدث لا يكون من تلقاء ذاته، بل لابد له من محدِث، فذلك دليلٌ على وجود خالق هو الذي أحدث هذا العالم، وهو الله سبحانه وتعالى.
ومن هنا فهذا الدليل ينطلق من القسمة الأصغر للكون، ومنها إلى إثبات حدوث العالم، ومن هذه إلى إثبات وجود الله، وهذه السلسة تبين الوشائج القائمة بين دقيق الكلام، أو الرؤية الطبيعية الإسلامية، وبين جليل الكلام.
لو انتقلنا الآن إلى صفات هذه الجواهر المفردة اتضحت لنا الرؤية أكثر حول جذور إنكار السببية، واقتربنا من فهم هذه الإشكالية، إنه حسب المتكلمين كل جسم يتشكل من عدد من الجواهر المفردة، وهذه الأخيرة موحدة ومتشابهة جميع الأجسام ولا فرق بينها ولا اختلاف، ولكن الأهم والأساسي أنها غير ملتصقة فيما بينها، فليس بينهما احتكاك، وإنما هذه الأجزاء التي لا تتجزأ متجاورة فقط، وهي كذلك توجد في خلاء، وإذا قيل على سبيل التجاوز: "تداخل الجواهر واختلاطها، فالمعنى تجاورها"(18).
وعلى هذا الأساس، فما دامت هذه الجواهر المفردة متشابهةً فهي لا يمكن أن تؤثر في بعضها البعض، لأن التأثير يكون بين أشياء بمميزات مختلفة. ومن هنا نفهم سرَّ إنكارهم للطبائع؛ أعني طبائع الأشياء، فالجسم لا يحمل في ذاته أي طبع، وذلك أن المتكلم منطلقًا من تشابه الجواهر المفردة يتساءل عن ماهية استمداد كل جسم، على ما بين مكوناته من تشابه، لطبعه.
وهكذا فالطبائع غير حقيقية، وهذا مذهب يشترك فيه عموم المتكلمين، أشاعرة ومعتزلة على حد سواء. يقول أحد من حفظ لنا مذهب الاعتزال القاضي عبد الجبار عن الشيخين الجبائيين المعتزليين: "وعندهما أن القول بالطبع لا يعقل وهو باطل". ولا يخفى الأصل اللاهوتي لإنكار الطبع، إنه ببساطة ترك مكان للبديل الآخر وهو إثبات الخلق الإلهي المستمر، وهما فعلًا مقترنان، فإذا نفينا طبع الأشياء، ولاحظنا أن لكل شيء في الواقع صفة تخصه، كان ذلك دليلًا على أن الله هو الذي يخلق صفة الجسم أو الشيء، من لون أو رائحة أو تأثير... إلخ.
يشرح ابن ميمون ذلك فيقول: "والذي دعاهم إلى هذا الرأي- الخلق الإلهي للأعراض- هو أن لا يقال بأن ثمة طبيعة بوجه، وأن هذا الجسم تقتضي طبيعته من الأعراض الكذا والكذا، بل يريدون أن يقولوا: أن الله تعالى خلق هذه الأعراض الآن دون وساطة طبيعية، دون شيء آخر"(19).
وبالإضافة إلى نفي الطبائع التي تتفرع عن إثبات تشابه الجواهر المفردة، فإن انفصال هذه الأخيرة عن بعضها البعض يعني أنه لا تأثير متبادل بينها، وبالتالي فلا شيء يكون سببًا في شيء آخر؛ لأن الاتصال بين هذه الأشياء منعدم، بالنظر إلى أن هذه الجواهر المفردة التي تشكلها توجد في خلاء، متجاورة لا متلاصقة.
إن ما نراه سببية هو مجرد اقتران، أي أنه جرت العادة حين نرى تأثيرًا لشيء في آخر، أن تتدخل الإرادة الإلهية لخلق الشيء، لا أن في شيء ما طبعًا هو الذي يخلق ويؤثر.
وهكذا فما دامت هذه الجواهر متشابهة، والتأثير إنما يكون بين مختلفات متنافرات، وكذلك أنها غير متصلة ملتصقة، فإن النتيجة أن يكون مبدأ السببية في الفكر الإسلامي مجرد وهم من أوهام الذهن.وقد كانت هذه إحدى المسائل التي انتقدها الإمام أبو حامد الغزالي على الفلاسفة، فهو يرى أن لا علاقة ضرورية بين السبب والمسبب، وإن ما نراه سببيةً هو مجرد عادة، والقول في المقابل بالاقتران، وإذا أردنا أن نشرح هذه النظرية الأشعرية فسنقول: إن ما نراه سببية هو مجرد اقتران، أي أنه جرت العادة حين نرى تأثيرًا لشيء في آخر، أن تتدخل الإرادة الإلهية لخلق الشيء، لا أن في شيء ما طبعًا هو الذي يخلق ويؤثر.
إن ظاهرة ما "تحدث عند.." لا "تحدث بـ.."، تحدث بقدرة وإرادة إلهيتين عندما يقترن شيء بشيء، لا أن يحدث شيء بشيء آخر، فطبائع الأشياء منتفيةٌ في الفكر الكلامي الأشعري. يقول أبو حامد في نص شهير من كتابه "تهافت الفلاسفة" شارحًا هذه النظرية الكلامية: "الاقتران بين ما يعتقد عادة سببًا، وبين ما يعتقد مسببًا، ليس ضروريًّا عندنا، بل كل شيئين، ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما، متضمنًا لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمنًا لنفي الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر، مثلا الشرب والري، والشبع والأكل، والاحتراق ولقاء النار، والنور وطلوع الشمس..."(20).
نخلص من هذا العرض أن القول بالجواهر المفردة، التي أدت بالمتكلمين إلى نفي السببية والقول بنظرية الاقتران، كانت خلفها اعتبارات دينية. إن علم الكلام كما يقول ابن خلدون في مقدمته: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة"(21).
من هنا فلم تكن لتتسم الرؤية، التي ستتشكل من داخل مبحث له هذه الأغراض الإيمانية، بما يفترض في العلم من موضوعية وتجرد في التفسير، وإنما سيكون موجهًا دائمًا بالهم الكلامي الذي يروم إثبات عقيدة لا بلورة رؤية علمية واكتشاف قوانين الطبيعة التي تتوج دائمًا بتطبيقات عملية وتقنية.
وهذا يدعونا مرةً أخرى للتذكير بضرورة الفصل بين الفلسفة الإيمانية والإبستمولوجيا أو "فلسفة العلم"، إن العلم له مبادئه المنفصلة عن الإيمان، وهو يتطور دائمًا من داخله، تتطعم فلسفته بجديد الكشوف العلمية ويغني منهجياته، وحين نبحث في العلم بتوجه مسبق؛ هو إثبات العقيدة، فإننا لن نتجاوز سقف ما وصلت إليه البحوث في ما يسمى "الإعجاز العلمي"، فهذا الأخير في الحقيقة لا يعدو أن يكون وجهًا آخر لما سُمّي في الماضي "علم الكلام"، ليس غايته أن ينتج علمًا بقدر ما هو توظيف نتائج البحوث العلمية لإثبات صحة العقيدة(22).
إن هذا الغرض الإيماني محمود في ذاته، لكن لا يجب أن يكون على حساب الروح العلمية.
الهوامش
(1) "ما فتئ الباحثون الاجتماعيون والأنثربولوجيون والمفكرون في شؤون المجتمعات العربية يلاحظون أنه لئن تأثث فضاء العالم العربي بمختلف الآلات التقنية الحديثة والأحدث، فإن الذهنية الحداثية لا زالت لم تتمكن بعد من نفوس سكان هذه البلاد".
محمد الشيخ: ما معنى أن يكون المرء حداثيًّا؟ (الدار البيضاء : منشورات الزمن، 2006). ص: 8.
(2) جورج طرابيشي، من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. (بيروت : دار الساقي، 2011).
(3) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009)، ص 350.
(4) Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, (Paris : Seuil, 2014)
(5) أورد القولة الفيلسوف الشاعر الهندي محمد إقبال؛ انظر: محمد إقبال، تجديد التفكير الديني في الإسلام. ترجمة: عباس محمود، (بيروت : منشورات الجمل، 2015). ص. 180.
(6) طه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، (بيروت : المركز الثقافي العربي، 2006)، ص: 47.
(7) يقول أحدهم: "إن النظريات العلمية لا تكون صادقة، حسب كارل بوبر، إلا إذا تمكنا من تحديد موطن خطئها؛ لأن كل نظرية لابد وأن تتضمن جانبًا من الخطأ (...). إن هذه الخاصية التطورية للمعرفة العلمية، والتي مثلت أحيانًا ثورات وطفرات، عبر عنها غاستون باشلار بالنفي والتجاوز، هي التي دفعت بكارل بوبر إلى التشكيك في القيمة العلمية للنظريات، وبالتالي الإقلاع عن الفلسفة الوثوقية التي تؤمن بإطلاقية الحقيقة من أجل تبني إبستمولوجيا نقدية وإبطالية منفتحة واستنباطية".
يوسف تيبس، التصورات العلمية للعالم: قضايا واتجاهات في فلسفة العلم المعاصرة. (بيروت: دار الروافد الثقافية، 2014)، ص 118.
(8) Edgar Morin , Introduction à la pensée complexe, (Paris, ESF Editeur, 1990), p. 94.
(عنوان الكتاب بالعربية : مدخل إلى الفكر المركب).
(9) طه عبد الرحمن، العمل الديني... مرجع سابق، ص 46.
(10) نشير هنا إلى الاحتفاء والاهتمام من قبل التيارات الإسلامية بأعمال زيغمونت باومان الناقدة لبعض الظواهر السائلة في الفكر الحداثي الغربي، ومن المفارقة أن ينتقد العربي ما هو سائل ومتحرك ومتغير في الآخر، بينما يعيش على وقع الركود الثقافي والاجتماعي في مجاله!
(11) عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية. (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 1994)، ص. 197.
(12) فؤاد زكريا، التفكير العلمي. (الكويت : عالم المعرفة، 1978). ص 31.
(13) "تحول المعتزلي من قاض يفكر في شؤون الخلق إلى متكلم في صفات الله ثم تحول هذا بدوره إلى فيلسوف يبحث في الماورائيات". عبد الله العروي، السنة والإصلاح. (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2010)، ص 139.
(14) س. بنيس، مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، ترجمة : محمد عبر الهادي أبو ريدة، (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، 1946).
(15) أبو الحسين الخياط، الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد، ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم، تحقيق ألبير نادر (بيروت : المطبعة الكاثوليكية، 1957)، ص 16.
(16) محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 2013)، ص: 180-181.
(17) يقول ابن رشد: "وطريقتهم (الأشاعرة) التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ- وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد- طريقة معتاصة، تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل، فضلًا عن الجمهور، ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري سبحانه". ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007)، ص: 103.
(18) عابد الجابري، بنية العقل العربي... مرجع سابق، ص 182.
(19) موسى بن ميمون، دلالة الحائرين، تحقيق حسن أتاي. (تركيا: جامعة أنقرة، 1974)، ص 205.
(20) الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، (القاهرة : دار المعارف، (د.ت))، ص 239
(21) عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي، (القاهرة: دار نهضة مصر، (د.ت)). ج3، ص 1069.
(22) عن بعض الانتقادات التي وجهت لمنهج بحوث "الإعجاز العلمي"، ينظر: طه عبد الرحمن، سؤال العمل : بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم. (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2012)، ص: 135-137.