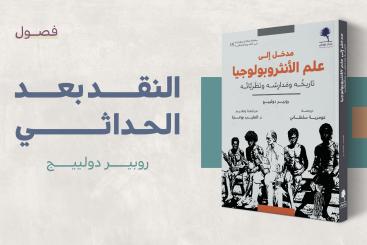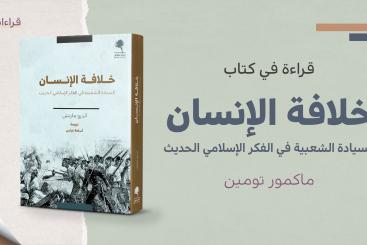ماذا يمكن للماضي الإسلامي أن يخبرنا عن الحداثة العلمانية؟ قراءة نقدية لكل من وائل حلاق وحسين عجرمة

تُعَدُّ طريقةُ نقل القوانين الأجنبية من الغرب إلى العالم الإسلامي، من قِبَل النخبة الحداثية المحلية والقيادات الاستعمارية، بمثابة السمة المميزة والرئيسة للعملية الحثيثة والمركَّزة لتحديث الدولة في الشرق الأوسط. وقد جرت هذه الطريقةُ -تقريبًا- في جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة، من المغرب حتى إندونيسيا، منذ أن بدأت في خمسينيات القرن التاسع عشر واستمرت مع القرن العشرين.
وبقي قانونُ الأسرة، في معظم هذه الدول، ضمنَ اختصاص المحاكم الدينية التقليدية، التي كثيرًا ما تنوَّعت حسب كل طائفة دينية. ومع انتقال هذه القوانين الأوروبية إلى العالم الإسلامي -سواء بتبنِّيها طوعًا من قِبَل الدول الإسلامية أو بفرضها جبرًا من قِبَل المستعمر- أسهمت الدولُ الإسلامية في تقنين بعض الأحكام الفقهية التقليدية في مجالات ومواضيع معيَّنة، وبالأخص مسائل الأسرة والأحوال الشخصية، وبعض فروع القانون المدني. وأبرزُ دليل على هذا الأمر هو مجلةُ الأحكام العدلية العثمانية، التي شملت أحكامَ القانون المدني الإسلامي، وأصبحت ساريةَ النفاذ عام 1877م. وفي حالات أخرى، كالجزائر والهند والسودان، كان المستعمرُ الإنجليزي والفرنسي والأوروبي هو المحرض والداعي إلى تقنين الأحكام الفقهية الإسلامية، كي يمكن تطبيقها في محاكم الدولة.
ولم يكن تقنينُ أحكام الشريعة بالأمر اليسير، باعتبار أنَّ الفقهَ الإسلامي ظلَّ ثمرةَ اجتهادات قضائية وفقهية، ضمن مجموعة من المبادئ تطوَّرت عبر القرون في صورة مطولات فقهية، تتعاقبُ عليها الأجيالُ بالحواشي والتعليقات. وأحدثَ اعتمادُ الدولة السيادية في تشريعاتها القومية على نظام قانوني موحَّد -حتى ولو كان مستمدًّا من أحكام الفقه الإسلامي- نقلةً ثوريةً لكلٍّ من الجانبين النظري والعملي للشريعة الإسلامية.
وهذا هو السياق التاريخي لرغبة العديد من المسلمين في تطبيق الشريعة الإسلامية، أو تأسيس دولة إسلامية في العصر الحديث. وبينما يعتقدُ كثيرٌ من المسلمين أنَّ تطبيقَ الشريعة الإسلامية يعني استعادةَ المجتمعات المسلمة لكرامتها وأصالتها ومكانتها، فإنَّ عددًا قليلًا للغاية ارتابَ في الدولة الحديثة -من حيثُ طبيعتها وممارساتها- أنْ تكونَ أداةً لتحقيق هذا الهدف. ووفقًا لكثيرٍ من الإسلاميين والمفكرين، فإنَّ مزيدًا من المشروعية القانونية يعني تعزيزَ الجوهر الإسلامي لقوانين الدولة وتشريعاتها. وحتى ظهور الكيان، الذي أَطلقَ على نفسه مسمى الدولة الإسلامية، أو دولة الخلافة الإسلامية، لم يتصوَّر أحدٌ أنَّ تطبيقَ الشريعة يعني عودةً لمرحلة ما قبل التقنينات، حينما كانت المحاكمُ لها اختصاص على معظم مناحي المجتمع، مستندةً إلى التراث المعرفي والعملي الذي تطوَّر عبر القرون في المدارس الدينية التقليدية.
ويُعَدُّ هذا المخيالُ المازجُ للسياسي مع القانوني مؤطرًا لأطروحة وائل حلاق المهمة "الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي" (مطبوعات جامعة كولومبيا، نيويورك 2013م). حيث سعى حلاق إلى نقد الفكرة، التي تشاركها المسلمون وغير المسلمين، بأنَّ الدولةَ الحديثةَ يمكنُ أن تكونَ إسلاميةً إذا طبَّقت الأحكامَ الفقهيةَ الإسلاميةَ بالقدر الكافي. وكما هو واضحٌ من عنوان الكتاب، وتقريبًا في كل صفحة من صفحاته، فإنَّ أطروحةَ حلاق تقومُ على أنَّه يستحيلُ -من الناحية العملية- أنْ تسيرَ الدولةُ الإسلامية وفقًا للشروط السياسية والاجتماعية الحداثية، ومن الناحية النظرية والمفاهيمية، فهو طرحٌ هادمٌ لذاته. وببساطة، فرؤية حلاق كالتالي:
- الدولةُ الإسلامية لا يمكنُ إلَّا أنْ تكونَ محكمةً للشريعة الإسلامية.
- حاكميةُ الشريعة تعني الحكمَ غير الرسمي للفقهاء، وفقًا لنظرياتهم المعرفية، وأصولهم الفقهية، ومذاهبهم التقليدية المقيدة بالسيادة التشريعية لله.
- تتميزُ الدولةُ الحديثةُ بأنَّها تصدرُ التشريعات القانونية من منطلق سيادتها المطلقة.
- وعليه، فأيُّ تصور لدولة إسلامية حديثة يكونُ طرحًا مناقضًا لذاته.
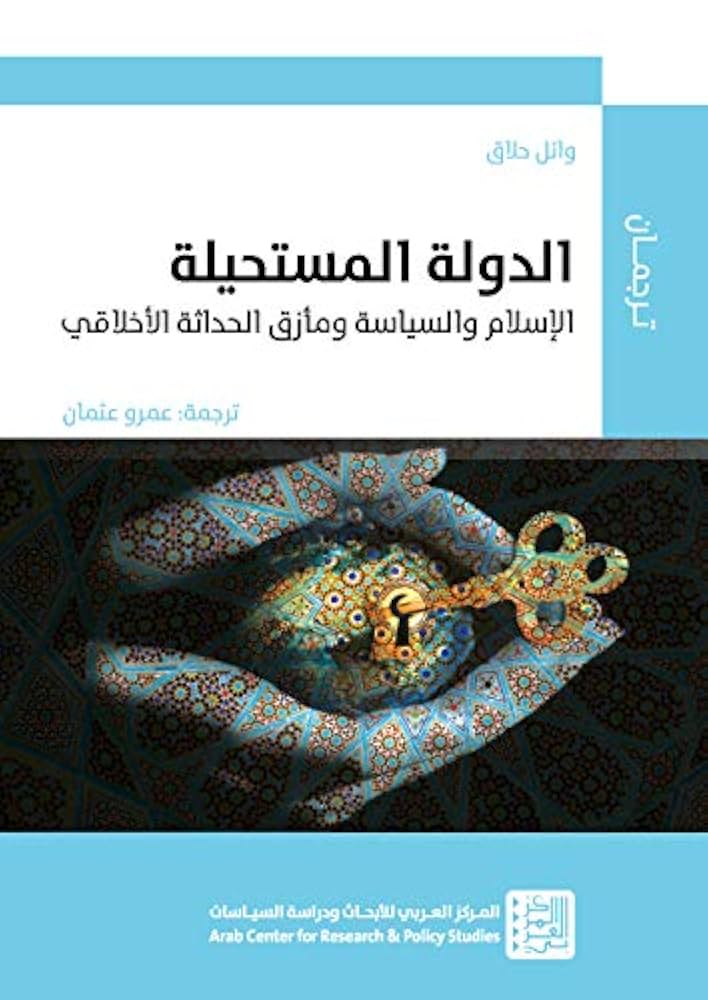
يكرّس وائل حلاق جزءًا كبيرًا من كتابه لبرهنة المقدمتين الثانية والثالثة. ويرى حلاق أنَّ التعريفَ المُحكَم للقانون الإسلامي هو ما كان عليه فقهاءُ المسلمين وعلماؤهم من ممارسات ونظريات معرفية تقليدية حتى القرن التاسع عشر. وبالمثل، فإنَّ الدولةَ الحديثة والحداثة لهما كذلك بعض السمات الجوهرية والأساسية. فدعائم النموذج الفلسفي التنويري التي تقومُ على رؤيته الميكانيكية للطبيعة والكون، وفصله للواقع عن القيم، واعتقاده باستقلالية الذات، وتوجُّهه الأداتي نحو الطبيعة، كل ذلك من شأنه أنْ يقضي على أي إمكانية للانسجام والتلاقي ما بين القانون والأخلاق والحوكمة والضمير الإنساني. وبالنظر في كتب جمهورية أفلاطون الأولى والأخيرة، والعديد من أدبيات التراث الإسلامي، يؤكِّد حلاق على أنَّ صميمَ السؤال الأخلاقي "يعكسُ مأزقًا جوهريًّا للحداثة، وهو سؤالٌ لم يُطرَح في الكثير من الأدبيات الإسلامية التقليدية، بمختلف مدارسها الماقبل حداثية، ولم يكن أيضًا مطروحًا في باقي الثقافات الأخرى غير الإسلامية في مجتمعات ما قبل الحداثة" (ص112). ويستند القانون الحديث -في أنحاء العالم كافَّة- إلى إرادة الدولة التحكُّمية وغير الأخلاقية فقط. إنَّ حالةَ الجمع ما بين الفقدان العام للأخلاق مع سلطة الدولة في الرقابة والمعاقبة والتنظيم، من شأنها أنْ ترسمَ صورةً لتجربة الحداثة المختلفة في العدمية والاغتراب. ويذكِّرنا هذا الموقف بألسدير ماكنتاير ]فيلسوف الأخلاق والفلسفة[ غير المتفائل بالحداثة.
وبالتأكيد، فإنَّ وائل حلاق يلفت الانتباهَ إلى إشكالية حقيقية، فبعد الانتهاء من قراءة كتاب حلاق، وبشكل غير واعٍ، لا يمكنُ التفكير في عبارات مثل "دولة إسلامية" أو "تطبيق الشريعة". وهو محقٌّ في مقولته بأنَّ "الدولةَ الحديثةَ، باعتبارها نموذجًا للحكم، تطوَّرت في أوروبا، وترسَّخت بطريقة غير طبيعية في باقي أرجاء العالم" (ص156). تبدو أيضًا حجةُ حلاق مقنعةً، في ملاحظته مدى إشكالية مؤسسات الدولة الحديثة بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية، وكيف أنَّ كثيرًا من الإسلاميين السياسيين غفل عن اعتبار الدولة مشكلةً بالنسبة إلى الإسلام. وفيما يبدو، فإنَّ وائل حلاق يقفُ وحيدًا محاججًا بأنَّ الإسلامَ يمتلكُ من المصادر والإمكانيات لمقاومة السلطات التأديبية والتنظيمية للدولة الحديثة ونقدها، بدلًا من اتخاذها وسيلةً لتحقيق مقاصد إسلامية.
ولو ظلَّ الكتابُ على هذا المنحى الكاشف لتشابك الإسلام مع الدولة الحديثة، بوصفه إشكالية يجبُ أنْ تُفهمَ بكل تجلياتها ومظاهرها وتشعباتها، لكان إضافةً غير كافية للدراسات المعاصرة. ومع الأسف، فإنَّ المنطقَ الجدلي للكتاب طغى على غاياته العلمية، فرؤيةُ حلاق للماضي الإسلامي أسطوريةٌ ونمطيةٌ، أكثر منها تأريخية، والأمر نفسُه في رؤيته للحداثة الغربية. بالتأكيد، كثيرٌ منها صحيحٌ وبالغ الأهمية، لكن تركيزه على لا أخلاقية الدولة لم يتركْ مساحةً لاستكشاف بديل أخلاقي وقانوني وسياسي في الحداثة، بما فيها ممارسات الحوكمة التي لا تنفرد الدولة بإنتاجها.
ويمكنُ تلخيصُ محاججة حلاق بعدم التوافق الجوهري بين الإسلام والحداثة، في نقطتين أساسيتين: الأولى أنَّ اكتسابَ القانون الوضعي لصلاحيته من إرادة الدولة السيادية يتنافى تمامًا مع الشريعة الإسلامية. والثانيةُ أنَّ التقنيات التنظيمية والعقابية للدولة الحديثة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، فهي سياساتٌ لم تُمارَس في التاريخ الإسلامي، ولا ينبغي أنْ تقومَ بها الحكوماتُ المسلمة. ويمكنُ أنْ نناقشَ هاتين الفرضيتين، اللتين يراهما حلاق بديهيتين علميتين، على النحو التالي:
أولًا: دعوى حلاق بأنَّ الحاكمَ -في إسلام ما قبل الحداثة- لم يتمتَّع بإرادة مستقلة لتشريع قوانين. ورغم صحَّة هذه الدعوى، فإنها تبيسطٌ مختزلٌ للحقيقة، فقد ميَّز التراث الإسلامي -بشقيه النظري والعملي- بين حقلين مختلفين: حقل السياسة الشرعية، وحقل الفقه الإسلامي الذي استأثرَ به رجالُ الدين. ومع ذلك، هناك العديد من المساحات العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المحكومة بنصٍّ شرعيٍّ محدَّد، التي خُوِّل للحكومة الإسلامية أنْ تقومَ على أمرها، في إطار أخلاقي واسع، طالما أنَّ سياستها لهذه المجالات تهدفُ إلى تحقيق الصالح العام والرفاهية المجتمعية. كما تبنَّت الكثيرُ من السلالات الإسلامية الحاكمة بعض المذاهب الفقهية واعتمدتها قانونًا رسميًّا للدولة، وألزمت محاكمَها الشرعية في بعض الأحيان ببعض الآراء الفقهية، دون آراء أخرى متعددة، لتكونَ مرجعيتها في القضاء. وقبل بداية الحقبة الكولونيالية بفترة طويلة، وفي إطار السياسة الشرعية التي تركها رجالُ الفقه للحكَّام، أصدرَ العثمانيون الكثيرَ من القوانين الرسمية، التي أُصِّلت شرعيتُها على أساس إرادة السلطان، كما ذهب فقهاءُ الدولة العثمانية. وبينما تجاهلَ كتابُ "الدولة المستحيلة" هذا البُعْدَ من السياسة الشرعية في فترة ما قبل الحداثة، فإن وائل حلاق نفسه تناولَها بطرح وخبرة واسعة في العديد من كتبه المبكرة[1].
فلو سلَّم بعضُ المسلمين المعاصرين بأنَّ الدولةَ الحديثة موجودةٌ وباقيةٌ، وسعوا إلى طرح مجموعة من المعايير التي يمكنُ من خلالها نعتُ هذه الدولة بالإسلامية؛ فما الطائل من وراء طرح منطقي سيناوي يدَّعي استحالة هذا الأمر؟
ولا يدحضُ هذا التراثُ الدستوري للماضي الإسلامي ما قبل الحداثي نظريةَ وائل حلاق، بل يجعلُها أكثرَ تعقيدًا. إنَّ ثنائي السياسة والفقه يرسخُ لفكرة أنَّ الحكمَ الإسلامي اعتمدَ كليةً على حكم الشريعة، كما يطرحُ الكثيرَ من الأسئلة السياسية المعقَّدة، حول كيفية وضع حدٍّ فاصلٍ ما بين المساحات التي تتمكَّن من خلالها السلطاتُ العامةُ أن تحكمَ وتتصرفَ، وتشرعَ، وتفرضَ نفوذها، في إطار إباحة واسعة من قِبَل رجال الدين والفقه الإسلامي، والمساحات الأخرى التي يتمكَّن فيها أهلُ الفقه الإسلامي من تطبيق الشريعة بحرية مطلقة، ودون أي تدخلٍ من السلطة. ويمكنُ لحلاق أنْ يجيبَ قائلًا بأنَّ الحكامَ لم يتملكوا سلطةَ السياسة الشرعية، بل غالبًا ما كانوا مقيدين بالقواعد والأحكام النمطية لرجال الدين. يمكنُ أنْ نقبلَ هذا الطرحَ على المستوى التنظيري المثالي، ولكن مؤرخي الفقه الإسلامي قد أشاروا -بطريقة تفصيلية بالغة- إلى أنَّه في ظل أنظمة حاكمة مختلفة، كعصر المماليك والعثمانيين، راعى أهلُ الفقه ورجالُ الدين رغبات حكَّامهم وامتيازاتهم وسلطاتهم وليس العكس[2].
وبعيدًا عن الموروثات التاريخية، ما هو وجه الإفادة في القول بأنَّ جميعَ المحاولات والجهود الحداثية لتقديم طرح أو تشريع ضمن مسائل السياسات العامة تتعارضُ مفاهيميًّا وجوهريًّا مع المعنى الكلاسيكي لمفهوم الشريعة؟ ومن المؤكد أنَّ كثيرًا من العلماء والفقهاء والمفكرين والشيوخ المسلمين لا يقولون بهذا الأمر، رغم وعيهم بالقطيعة التي خلقتها الحداثة، ويعتقد كثيرٌ منهم بأنَّ المسلمين ملتزمون في كل زمان ومكان بأن يضبطوا حياتهم ومجتمعاتهم وفقًا للمقاصد العليا والأولويات المهمة للدين الإسلامي، مع إدراك للتغيرات التاريخية، التي يتعيَّن عليهم الاشتباك معها بطريقة جدلية. ولماذا لا نُسلِّم -من وجهة نظر معرفية- بأنَّ الفقهَ الإسلامي الحداثي مزيجٌ غير مرتَّب من نصوص تراثية، وأحكام صادرة عن مجامع فقهية، ومجالس تشريعية، ومحاكم شرعية، وقضاء مدني، وهئيات دينية مستقلة؟ وبالمثل، فلو سلَّم بعضُ المسلمين المعاصرين بأنَّ الدولةَ الحديثة موجودةٌ وباقيةٌ، وسعوا إلى طرح مجموعة من المعايير التي يمكنُ من خلالها نعتُ هذه الدولة بالإسلامية؛ فما الطائل من وراء طرح منطقي سيناوي يدَّعي استحالة هذا الأمر؟
يزعمُ حلاق أنَّ أي جهود حداثية محكوم عليها بالفشل؛ لأنَّها لن تتمكَّن من إعادة فرض الهيمنة الأخلاقية لشريعة ما قبل الحداثة، التي نسجت الفردَ والأسرةَ والمجتمعَ والسوقَ والسلطةَ بطريقة متناغمة ومتسقة. وهنا تبدو رؤيةُ حلاق ذاتها أكثرَ حداثةً مقارنةً مع النموذج الإسلامي ما قبل الحداثي، فلم يجتهد العديدُ من فقهاء ما قبل الحداثة في إطار "اجتماعي"، ومن ثَمَّ لم يروا أنَّ مجالات الحياة المتنوعة يعتمدُ بعضها على بعض، لضمان فاعليتها وتناغمها. كما يبدو أنَّ ما يتخيله حلاق من سماتٍ يصف بها مثالية نظام ما قبل الحداثة، فيما يتعلق بالمساواة والعدالة الاجتماعية والخصوصية وسيادة القانون، هو انعكاسٌ لأنظمة حداثة ما بعد الأنوار أكثر منها إسلام ما قبل الحداثة. وبعد كل ذلك، يحاول حلاق أن يقنعَ معاصريه في الغرب بأنَّ المجتمعَ الإسلامي ما قبل الحداثي كان نموذجًا فائقًا لمجتمع "بالغ التنظيم" (ix).
ثم ماذا عن محاججة حلاق بأنَّ الدولةَ الحديثة تمارسُ باستمرار سلطاتٍ لا تبيحُ الأخلاقُ الإسلامية لأي سلطة دينية أو علمانية القيامَ بها؟ وهذا القولُ منطقيٌّ من الناحية النظرية، فمن الذي يدافعُ عن السلطة التعسفية للدولة غير الأخلاقية، وهي تُشكّل رعاياها وفقًا لرغباتها، مسلحةً بشبحها العقابي والرقابي؟ لكن إذا نظرنا إلى بعض المجالات حيث تمارسُ الدولةُ الحديثةُ سلطتها -أعني النطاق الواسع للسلطة الحيوية- فإنَّ الأمورَ ستبدو إلى حد ما أكثر ضبابيةً.
لنأخذَ على سبيل المثال جمهوريةَ إيران الإسلامية، باعتبارها الدولة الأكثر وضوحًا في دعواها بأنَّها "إسلامية" و"دولة". من المهم أن ننوِّه إلى أنَّ كتابَ "الدولة المستحيلة" لم يذكر بالاسم أيَّ دولة أو مجتمع مسلم حديث. إنَّ تجربة إيران ما بعد الثورة في أسلمة القانون تنطوي على العديد من الدروس التي تؤكِّد وجاهة نظرية حلاق. فقد كان من الصعوبة بمكان -في كثير من الفروع القانونية- أن تُصاغَ الأحكامُ والقواعدُ القانونية وفقًا لأحكام الشريعة، وفي حالة صياغة قوانين مستندة إلى الشريعة، كان الالتزامُ بها أمرًا مكلفًا للغاية[3]. فإيران نموذجٌ مثاليٌّ لخيبة أمل المشروع الأيديولوجي، الرافع لشعار تطبيق الشريعة بوصفه حلًّا لجميع أوجه القصور في شرعية الدولة. لكن قامت الجمهوريةُ الإسلامية أيضًا بالعديد من الأمور، تحت مسمى السياسة العامة، التي يشخصها حلاق بأنَّها إحدى وظائف سلطة الدولة الحديثة، فإيران ما بعد الثورة لديها أحد أنجح أنظمة الصحة العامة -بما فيها تنظيم الأسرة- مقارنةً بدول الشرق الأوسط. واحتاج تطوير هذه السياسات وتنفيذها إلى انخراط جميع أركان السلطتين الدينية والعلمانية، مثل الفتاوى الدينية للعلماء، وتشريعات أجهزة الدولة الرسمية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتشريعات المتعلقة بالرفاهية المجتمعية والمصلحة العامة، وتقنيات الضبط والتنظيم البيروقراطي، وخطاب سياسي حيوي حول صحة المجتمع وسلامته....إلخ[4]؟
كيف يمكنُ لوجهة نظر حلاق أن تساعدَنا في دراسة السلطة الحيوية، وسياسات الشريعة حول الصحة العامة في إيران ما بعد الثورة؟ هل سيحاجج بأنَّ كلَّ ما يَنتجُ عن مؤسسات السلطة الإيرانية، من مخرجات متوافقة شكليًّا مع الشريعة، ملوثٌ لاقترانه بسلطة الدولة؟ لكن ماذا عن الفتاوى الفقهية والأحكام الدينية الصادرة عن الحوزات العلمية المستقلة عن الدولة؟ هل سيحاجج أيضًا بأنَّ الدولةَ تمارسُ سلطةً لم تسمح بها الشريعةُ التقليديةُ على الإطلاق؟ حسنًا، معنى هذا: إمَّا أنَّ الدولةَ تتصرفُ على أساس تحقيق الرفاهية المجتمعية (المصلحة) وهو أصلٌ شرعيٌّ، وإمَّا أنَّ الشريعةَ تُحرّمُ على الدولة أن يكونَ لها دورٌ في هذه المجالات الحياتية. ويبدو أنَّ الخيارَ الأخيرَ -في ظاهره- أمرٌ غير قابل للتصديق، وكذلك فرضيةٌ عجيبةٌ أمام المسلمين المتطلعين إلى أن يكونَ لهم دورٌ في مجالات كالصحة العامة. هل سيحاججُ حلاق بأنَّ الشريعةَ تسمحُ للسلطات العامة بالعملِ في مجال الصحة العامة، بشرط عدم الاستعانة ببعض تقنيات الدول الحديثة أو عدم القيام بأشياء أخرى؟ حسنًا، ما طبيعة هذه الأشياء؟ وكيف نعلمها؟ لا يمكن الاقتناع بأنَّ مجردَ القول بأنَّ بعضَ أو جميعَ ممارسات الدولة الحديثة غير إسلامية أمرٌ له فائدةٌ أو أهميةٌ على الصعيد المعرفي.
أنتقلُ سريعًا إلى "النموذجية" التي وسمَ بها حلاقُ الماضي المسلم. ورغم أهمية هذا الوصف في بعض الجوانب، فإنه يكتنفُه -هو الآخر- بعضُ الشكوك. فيحاججُ حلاق بأنَّه على مدار اثني عشر قرنًا، وفي كل ربوع العالم الإسلامي، اتسمت مجتمعاتُ ما قبل الحداثة بأنَّها مجتمعاتٌ عضويةٌ نموذجيةٌ منظمةٌ ومستقلةٌ عن الدولة (التي لم تكن موجودة أصلًا)، وفي تناغمٍ مع القواعد الأخلاقية الكونية، التي جسَّدتها القوانينُ الاجتماعية للشريعة.
وأقلُّ ما يمكنُ قوله هنا هو أنه ربما يرغب القارئ المتحمس في المزيد من المراجع للدراسات الاجتماعية التاريخية لدراسة هذا الماضي الإسلامي الماقبل استعماري، بجانب ما قدَّمه حلاق من مراجع فقهية نصية. وواضحٌ أنَّ هذه السرديةَ شبهَ الأسطورية للماضي الإسلامي النموذجي لا تعطي اعتبارًا حقيقيًّا لأي صراع أو خصام أو نزاع أو بدائل خفية، من أجل دراسة ممارسة السلطة في إسلام ما قبل الحداثة. فهو عالم بلا تاريخ، حيث يتمتَّع المسلمون الأتقياء بحالة من الانسجام التام مع مجتمعهم المثالي، وأي حيادٍ عن هذا التصور هو نقصٌ بشريٌّ، ولا يعني بالضرورة صراعًا أو خلافًا أخلاقيًّا أو روحيًّا واقعيًّا.
هل مثل هذا النقد للحداثة في صالح المسلمين؟ إذا كان ثمنُ نقد كلٍّ من استبدادية الدولة الحديثة، وسطحية بعض الدعوات الإسلاموية الحديثة بتطبيق الشريعة، هو تشييد نموذج إسلامي يلزمُ أن يكونَ -مهما كانت التكلفة- مغايرًا لما نعتقدُ أنَّ الحداثةَ الغربيةَ تمثلُه، فهل الأمر يستحقُّ كلَّ ذلك؟ إن التصدي للشعور بالانتصار الراضي عن التفوق الأخلاقي للحداثة الغربية لا ينبغي أن يتمثَّل في صياغة نماذج استشراقية جديدة سطحية وعاكسة لما كان عليه العالم الإسلامي قبل نابليون.
فحلاق يفترضُ فقط أنَّ مجردَ بُعْد المسلمين عن شريعة ما قبل الحداثة هو عينُ الاغتراب والانعزال عن الشريعة. لكن ماذا لو رأى أهلُ المجتمعات المسلمة في الوقت المعاصر خلافَ ذلك؟
وعلى أي حال، فما الذي يمنعُ استعادة السلطة اللامتنازع عليها والمحكِّمة للشريعة داخل الحداثة؟ بينما يستهلُّ حلاق افتراضَهُ بقوله: "إن فرضيةَ أنَّ معظم المسلمين المعاصرين يودّون عودة الشريعة بشكل أو بآخر، هو أمرٌ يدركهُ أيُّ شخص لديه معرفة عابرة بالشؤون الدولية"، وأنَّ التناقضَ يكمنُ -فقط- في رغبتهم في استعادتها في إطار الدولة الحديثة (x)، ومن المهم أيضًا دراسةُ الفكرة القائلة بأنَّ المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة -شأنها شأن المجتمعات الحديثة الأخرى- تواجهُ التحدي الأساسي نفسَه المتمثِّل في التعدُّدية.
وربما يصحُّ القولُ بأنَّ "الشريعةَ تظلُّ عند الغالبية العظمى لمسلمي اليوم مصدرًا للسلطتين الأخلاقية والدينية" (x)، لكن تتباين مواقفُ المسلمين تباينًا شديدًا حول مضمون هذا القول ومفهومه، ومَن يرغبون في أنْ يكونَ متحدثًا باسم الشريعة. ويعتقد كثيرون أنَّ هذا النوعَ من التعدُّدية هو مأساة في حدِّ ذاته، وفقط هم المسلمون الذين يتعيَّن عليهم مواجهته بسبب الاستعمار. ولا يقول حلاق بهذه الفرضية؛ لأنَّه لا يتناولُ مطلقًا حقيقةَ التعدُّدية، وتنافسية الرؤى الأخلاقية السياسية. ولو أنَّه محقٌّ باستحالة الدولة الإسلامية، فمن المرجَّح أن يكونَ ذلك راجعًا إلى مزيج ما بين التعدُّدية الأخلاقية للمجتمعات المسلمة من جانب، وعدم ملاءمة أو انفكاك القواعد القانونية الإسلامية (وليس المبادئ) الماقبل حداثية عن العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما توحي تجربةُ إيران ما بعد الثورة، من جانب آخر. ويرى حلاق أنَّ السلطات الرقابية والعقابية والتنظيمية للدولة الحديثة، المرتكزة على الفكر التنويري للعقلانية الذرائعية، والتمييز بين ما هو كائن/وما يجب أن يكون، هو ما يمنعُ المجالَ العامَ من أنْ يكونَ مرتكزًا على أسس أخلاقية. وعلى الرغم من أنَّ وائل حلاق سعى في كتابه إلى استكشاف "المأزق الأخلاقي للحداثة"، فإنَّه لا يقرُّ بالأحوال المختلفة للجدل الأخلاقي في الحداثة، فحلاق لا يأخذُ على محمل الجد التمييزَ ما بين الأخلاقية التي تعني ما ندين به للآخرين على مستوى الحقوق والعدالة، والأخلاقية بمعنى تربية النفس؛ ولذا لا يطرحُ إمكانيةَ أنْ تهدفَ أيُّ مشاريع حداثية سياسية وقانونية إلى أخلاقية بالمعنى الأول، بينما يقرُّ بمشاريع أخلاقية متعددة على المعنى الثاني. وليس هناك تصورٌ بأنَّ ثمةَ اختلافًا منطقيًّا واردًا داخل الحداثة حول الأخلاقيات، سواء بالنسبة إلى المسلمين أو إلى مَن يعيشون في الدول المسلمة. فحلاق يفترضُ فقط أنَّ مجردَ بُعْد المسلمين عن شريعة ما قبل الحداثة هو عينُ الاغتراب والانعزال عن الشريعة. لكن ماذا لو رأى أهلُ المجتمعات المسلمة في الوقت المعاصر خلافَ ذلك؟
وكذلك كانت الدراسةُ النقديةُ لتطبيق القواعد القانونية الإسلامية في الدول الحديثة محورًا رئيسًا لأطروحة حسين عجرمة الممتعة "مساءلة العلمانية: الإسلامُ والسيادةُ وحكمُ القانون في مصر الحديثة" (مطبوعات جامعة شيكاجو، شيكاجو 2012م). يستندُ جانبٌ من دراسة عجرمة على قراءات نصيَّة لبعض التجارب الحديثة للقانون الإسلامي في مصر، ويستند جانبٌ آخر على العمل الميداني الإثنوغرافي في محاكم الأسرة المصرية، ومجالس الفتوى بالأزهر. ومن ثَمَّ فهي تتمَّةٌ ممتازةٌ لدراسة وائل حلاق عن "الدولة المستحيلة". لكن تختلفُ دراسةُ عجرمة في أمرين رئيسين: أولهما عدم وجود أجنده موضوعية صريحة، سواء فيما يتعلق بمعنى القانون الإسلامي، أو سلطات الدولة الحديثة. ثانيًا: بينما يتخذُ حلاق الحداثةَ إطارًا تاريخيًّا وتحليليًّا بشكل عام، فإنَّ عجرمة مهتمٌّ بالسلطة العلمانية باعتبارها المشكلة الأساسية في دراسة كيفية عمل القانون الإسلامي في العالم الحديث.

وبحيوية بالغة، يتناولُ الكتابُ عددًا من القضايا ومواضع الجدال الأخلاقي والقانوني في مصر الحديثة. فيبدأ أولًا بتحليل ودراسة القضية الشهيرة، لأستاذ العلوم العربية والإسلامية بجامعة القاهرة، نصر حامد أبو زيد، الذي فرَّقت المحكمةُ بينه وبين زوجته على أساس أنَّه صار مرتدًّا عن الإسلام، بسبب كتاباته الأكاديمية حول القرآن. وفي الفصل الأول من الكتاب، يلقي عجرمة الضوءَ على مسألة كيف لدولة علمانية مثل مصر أن تفرضَ نصًّا قانونيًّا مستندًا إلى أحكام الفقه الإسلامي التقليدي (الحسبة)، ينصُّ على أنَّ جميعَ المسلمين ملتزمون بحماية الأخلاق الدينية تجاه بعضهم بعضًا. وبدايةً من الفصل الثاني حتى الفصل الخامس، يُقدِّم الكتابُ عملَ عجرمة الميداني في محاكم الأحوال الشخصية، ومجالس الفتوى بالأزهر، لدراسة عملية ممارسة وإنتاج كل من أحكام المحاكم الرسمية والفتاوى الدينية الاستشارية غير الإلزامية. وتستندُ هذه الفصول، بالغةُ الأهمية، إلى المواد الإثنوغرافية، لطرح أسئلة حول العلانية والسرية، والنظام العام، والأسرة، والشك، والسلطة، وسيادة القانون، والتقاليد، والإصلاح القانوني، والإصلاح (الجبري) للنفس. وفي الختام، يحللُ عجرمة لغةَ العدالة، التي وظَّفها المحامون الإسلاميون في إطار حالة الطوارئ المصرية، ليحاججَ بأنَّ التدينَ المسيسَ الموظفَ من قِبَل هؤلاء المحامين ليس بديلًا عن العلمانية، بقدر ما هو تعبيرٌ عن الخيارات التي تمكَّنت منها سلطةُ الدولة المصرية على الدين.
وفصولُ الكتاب ثريةٌ جدًّا بالعمل الميداني الإثنوغرافي القيِّم، وبالتحليل المخضرم للأرضية القانونية المعقَّدة في مصر، وسيستفيد من هذا الكتاب -الذي آملُ أن يُقرأ على نطاق واسع- كلُّ دارس للفقه الإسلامي، والعلمانية، وعلم اجتماع دول ما بعد الاستعمار الحديثة. وأخصُّ بالذكر نقاشات عجرمة المقنعة للغاية في المناهج المختلفة التي يُتعامل بها مع الدين باعتباره مأزقًا للنظام العام، ومن ثَمَّ موقعًا ثابتًا لتوسيع السلطة السيادية للدولة، وكذلك محاججته بأنَّ أكثرَ مواقع مقاومة السلطة العلمانية نجاحًا هي -للمفارقة- ممارساتُ الشريعة المتحررةُ، التي تتجنبُ الدولةَ من خلال عدم التعامل معها (ص25).
ويهدفُ الكتابُ إلى دراسة العلمانية، ليس باعتبارها نموذجًا معياريًّا، أو مجموعةً من المعتقدات، أو نظامًا دستوريًّا، وإنما بوصفها شكلًا مختلفًا من السلطة، بأسئلته ومفارقاته الخاصة. ويهدفُ مشروعُ عجرمة إلى طرح هذا السؤال: كيف تعززُ العلمانيةُ وتقوضُ المفاهيمَ والحساسيات والافتراضات والسلوكيات لدى العلماني، الذي تعتمدُ عليه وتستندُ إليه؟ وكجزء من السلطة، كيف تمارسُ العلمانيةُ وظيفتَها؟ وما تأثيرها في سلوكيات المعرفة وتوجهاتها وطرقها التي تُشكِّل سبلَ حياتنا؟ لاحظ أنَّ عجرمةَ لا يشيرُ إلى أشياء من قبيل: "خطاب العلمانية"، "العلمانية بوصفها أفقًا أيديولوجيًّا"، "العلمانية بوصفها مجموعة من القيود الدستورية والقانونية". وهناك إضفاء طابع مادي متكرر للعلمانية، وسُلطة العلماني في مواضع مختلفة من الكتاب. وغالبًا ما يصورُ عجرمة السلطةَ العلمانيةَ لا بوصفها نظامًا يطبقه أفراد أو مؤسسات، ولا بوصفها علاقة فوكوية، بل بوصفها فاعلًا يؤثِّر بذاته مباشرةً في العالم.
وفي بعض الأحيان، تجدُ عبارات عجرمة المتوالية بانتظامٍ حول كيفية دراسة العلمانية أكثر إقناعًا. فيؤكِّد سؤالُه البحثي على الحجاج الوارد في الكثير من الأعمال الحديثة عن العلمانية في حقلي الأنثروبولوجيا والنظرية الاجتماعية، بأنَّ العلمانيةَ لا تعني مجردَ الفصل بين الدين والسياسة، بقدر ما تعني "تشكيلَ الدين كمادة للإدارة والتدخل المستمر، وتشكيل الحياة الدينية، والشعور العام لملاءمة الافتراضات المسبقة، والاحتياجات الآنية لحكم ليبرالي" (ص20). أو بأنَّ العلمانيةَ هي "مجموعةٌ من أساليب السلطة وهياكلها، التي دائمًا ما ينشأ بموجبها سؤال -له سمتٌ مميزٌ- حول كيفية الفصل ما بين الدين والسياسة" (ص27).
وهذا "السمتُ المميزُ" أمر بالغ الأهمية، حيث ينوهُ عجرمة -بشكل صحيح- بأنَّ الحدَّ الفاصلَ ما بين المقدَّس والعلماني يظهر في العديد من الأيديولوجيات والأنظمة السياسية (بما فيها العصور الوسطى الإسلامية). لكن يتعيَّن علينا أن نتحدَّث عن العلمانية عندما تناط هذه الحدود الفاصلة برهانات ومصالح كبيرة، و"يُنظر إلى الإجابات عنها على أنَّ لها عواقبَ لا مفرَّ منها بشأن كيفية تحديد الحريات الأساسية، وتعريف الذوات ودوافعها، وكيفية عيش أساليب الحياة" (ص27). فالعلمانية هي "الاشتباكُ المستمر والمتعمقُ في سؤال الدين والسياسة، بغرض تحديد الحقوق والحريات الليبرالية الأساسية وضمانتها" (ص29).
ورغم منطقية القول، فإنه يظلُّ مثيرًا لبعض التساؤلات، مثل: هل الإدارةُ العلمانيةُ للدين في عهد نظام مبارك، ويوغسلافيا الاشتراكية، والجمهورية الخامسة في فرنسا، وأمريكا القرن الحادي والعشرين، جميعها جزءٌ من نفس مشروع "الحكم الليبرالي"؟ يستشكلُ هذا الأمر بشدة في الكتاب، خصوصًا أنَّ أثرى أجزاء كتابه هي التي يبحث فيها كيف تمكِّن العقلانيةُ العلمانيةُ الدولةَ من بسط سيادتها، دون حتى التظاهر بحماية القيم الليبرالية، فيما تصفُ الدولةُ ممارساتها بأنَّها لحماية الإسلام بوصفه جزءًا من نظامها العام. ويمكنُ تفادي هذا الاستشكال بتعريف العلمانية بأنَّها "الاشتباكُ المستمرُ والمتعمقُ في سؤال الدين والسياسة، بغرض تحديد وضمانة مصالح سلطة الدولة واستقرارها". وبهذا أيضًا يمكننا تفادي التعميم المتمثل في الاضطرار إلى الإجابة عن سؤال: لماذا توظفُ السلطة العلمانية للسيطرة على الدين في مصر، ولكن ليس في إيران أو المملكة العربية السعودية، في حين أنَّ الافتراضَ المسبق للطبيعة "العلمانية" للدولة المصرية هو بالضبط ما يريد عجرمة أن يناقشه، أو يشككَ فيه.
وبهذا التأطير يضعُ عجرمة كتابَهُ تحت شعار: "كل شيء يبدو مسمارًا لكل مَن يحمل مطرقة". فإذا كان العلمانيون الليبراليون الملتزمون يميلون إلى رؤية المتدينين على أنَّهم هم الذين يثيرون الاضطرابات في المجال العام، ويتعدّون على حقوق الآخرين وحرياتهم، فإنَّ وجهةَ نظر عجرمة هي أنَّ هذه الحوادث لا تنشأ إلا بوصفها صراعات حول الدين، بسبب مشكلة الآلية، التي ترسمُ بها السلطةُ العلمانية الحدودَ بين السياسة والدين. فلا يكفي القولُ -عند عجرمة- بأنَّ العلمانيةَ هي إحدى الآليات الخاصة لتسييس الدين، لا فصل الدين عن السياسة، بل "العلمانيةُ هي ما تجعلُ من الدين موضوعًا للسياسة"، وبموجب العلمانية "يصبح ممكنًا الطعنُ في سلطة ادعاءٍ دينيٍّ بالقول بأنَّه صادرٌ عن دوافع سياسية" (ص33). وهي وجهةُ نظر بالغة الطموح إذا اقتصرت على كشف التسييس العلماني المميز للدين والمزاعم الدينية، دون أن تذهب إلى الدعوى، التي يمكنُ دحضُها بسهولة، بأنَّ العلمانية فقط هي ما تمكِّن من ذلك. فهل يظن عجرمة أنَّ الطعنَ في صدق الادعاءات الدينية في السياسة غيرُ شائع داخل الخطاب غير العلماني؟
ومن الأمثلة البارزة على قصور فرضية عجرمة قراءتُهُ لقضية نصر حامد أبو زيد، وممارسة الحسبة في الفقه الإسلامي. فحتى وقت قضية أبو زيد، كان من غرائب القانون المصري إمكانيةُ أن يرفعَ الأفرادُ العاديون دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بدعوى انتهاك الأخلاق الدينية (تغيَّر القانون بعد قضية أبو زيد، ليكونَ هذا الحقُّ قاصرًا على الدولة). ويبرزُ هذا الأمر بُعدًا عميقًا حول المفاهيم الإسلامية للسلطة والسيادة. ففي حين أنَّ السيادةَ العظمى لله، فإنَّ إنفاذ تلك السيادة -"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"- يُنظر إليه على أنَّه مسؤوليةُ المجتمع المسلم كليةً، والمسلم الملتزم منفردًا، فثمة شعبوية راديكالية في المخيلة الثيوقراطية الإسلامية.
ورغم أنَّ لفظَ الظلم ذُكِرَ في القرآن سبع مرات، وأنَّ مشتقات الكلمة وردت فيما لا يقل عن 315 موضعًا، فإنَّ عجرمة لا يُفصّل القولَ فيما يمكن أنْ يجعل من الأمر مفهومًا إسلاميًّا خالصًا. ويتسرعُ كثيرًا في وصف بعض المواقف بأنَّها "مفارقات"، إلَّا أنَّ القراءةَ المتأنيةَ تقولُ بأنَّه يعني شيئًا آخر: "المأساة" أو "المعضلة" أو حتى "التحدي".
وبدلًا من رؤية الحسبة على أنها سمة ذات أصل ديني داخل النظام القانوني المعقَّد في مصر، وتتموضعُ بصعوبة مع جوانب أخرى من هذا النظام، يريدُ عجرمة أنْ يرصدَ كيف أنَّ عملَ الحسبة داخل النظام القانوني للدولة هو دليلٌ على منطق "السلطة العلمانية" في مصر. فتشريحُ عمل الحسبة في النظام القانوني المصري يُخبرنا الكثيرَ عن خصوصيات هذا النظام القانوني الخاص. وإسهام عجرمة في ذلك إسهام كبير.
ولكن يحاول عجرمة أن يتجاوزَ خلاصةَ أنَّ التقاضي بشأن الحسبة في مصر الحديثة يُنتج أشكالًا جديدة وغريبة من صناعة القوانين، وهذا مثالٌ جليٌّ لما أقوله بأنَّ عجرمة يبالغُ في هذا الأمر، لإثبات وجهة نظره حول "السلطة العلمانية". فيرى عجرمة أنَّ "الحسبة في الشروح التقليدية للشريعة الإسلامية كانت ضربًا من النظر والعمل المرتبطين بتقويم النفس" (ص20)، عملًا بُغي به "بثّ الخشية والأمالي الراشدة... ضبط أخلاقي مُقوّم للنفس المسلمة" (ص64). وعلى النقيض، أضحت محاكمُ مصر الحديثة معنيةً بصيانة المصالح الحامية والمبررة للنظام العام" (ص20). ويشدِّد عجرمة (بقوة وبتفصيل بالغ) على هذه الثنائية، محاججًا بأنَّه يجبُ علينا فهمُ التقاضي في أمور الحسبة، ليس على أنَّه سمةٌ "دينيةٌ" للقانون المصري، بل هو بالأساس عملٌ للسلطة العلمانية، تستمدُّ منه استمراريتها. وذلك لأن عجرمة يرى أنَّ أيَّ حكم باسم النظام العام سمةٌ عقلانيةٌ علمانيةٌ للسلطة السيادية.
وهي قراءةٌ انتقائيةٌ للأسف ومندفعةٌ للغاية لطرق استخدامات الحسبة في الفقه الإسلامي الكلاسيكي، وتعتمدُ على مصدرين فقط، كما أَّنها تتجاهلُ التناولَ الفقهي الرئيس في التراث الإسلامي. ولهذا تخلطُ رؤيةُ عجرمة ما بين أخلاقيات الحسبة التي يمارسها الفرد، وبين الظروف التي يُطلب فيها من كل المجتمع المسلم أنْ يأمرَ بالمعروف وينهى عن المنكر. صحيحٌ أنَّ التناولَ التراثي للحسبة ركَّز على الشروط، والبواعث، والأحكام الأخلاقية اللازمة لكل مسلم أخذَ على عاتقه فرض الأخلاق العامة، لكن لا يتعارض هذا -على الإطلاق- مع اعتبار أنَّ النظامَ العامَ من ضمن مسوغات فرض هذه الأخلاق، خاصةً عندما تمارسه المحاكمُ أو المحتسبُ أو غيرهم من المسؤولين العموميين. هذا، ويؤكدُ الفقهاءُ المسلمون الكلاسيكيون البارزون ممَّن صنَّفوا في الحسبة -ولم يرجع عجرمة إلى واحد منهم- على أنَّ "الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر" هو المبدأ التأسيسي الجامع بين كل السلطات السياسية في الإسلام، من أول الخلافة حتى المحتسب. ولا تتفقُ مصنفاتُهم مع الثنائيات التي يطرحُها عجرمة، من حيث عنايتهم بالتخلُّق الديني (الأنفس المسلمة القويمة)، والنظام العام، والمصلحة العامة (لا أعني مفهومَ المصلحة الفقهي، عجرمة، ص66)، والمصالح الجماعية، والتنفيذ القضائي -إذا لزم الأمر- لكل ذلك، وفقًا للإجراءات الصحيحة. إنَّ سرديةَ عجرمة لحشد وتجنيد واستخدام بعض من مسوغات النظام العام داخل المحاكم المصرية من قبل بعض المسؤولين، هي رؤيةٌ بالغة الأهمية والثراء، في حد ذاتها، لكن دون حاجة إلى المبالغة في السمات الأخلاقية لأدبيات الحسبة في شريعة ما قبل الحداثة، للمحاججة بأنَّ السلطةَ العلمانية -متذرعةً بالنظام العام- مسؤولةٌ كلية عن ابتداع المحاكمات الأخلاقية الإسلامية.
ومن الأمثلة الأخرى المحيرة عند عجرمة حديثُه عن مفهوم الظلم باعتباره "مفهومًا غير إسلامي" (ص212) لكي يحاججَ بأنَّ الدولةَ العلمانية تنتجُ لغةَ السيادة القانونية، التي يصعبُ التمييزُ فيها بين القاعدة والاستثناء. ورغم أنَّ لفظَ الظلم ذُكِرَ في القرآن سبع مرات، وأنَّ مشتقات الكلمة وردت فيما لا يقل عن 315 موضعًا، فإنَّ عجرمة لا يُفصّل القولَ فيما يمكن أنْ يجعل من الأمر مفهومًا إسلاميًّا خالصًا. ويتسرعُ كثيرًا في وصف بعض المواقف بأنَّها "مفارقات"، إلَّا أنَّ القراءةَ المتأنيةَ تقولُ بأنَّه يعني شيئًا آخر: "المأساة" أو "المعضلة" أو حتى "التحدي".
وعليه، فكتابُ عجرمة تشوبهُ أحيانًا حالةُ الانتقال ما بين الإثنوغرافية الضيقة والادعاءات النقدية الواسعة، وهذا ناتج عن القراءة السطحية والمخلة، وغير المعززة بأدلة وافية لبعض أدبيات فقه ما قبل الحداثة. لكن ما أودُّ أنْ أؤكدَ عليه هو أنَّ كتابَ عجرمة احتوى نقاشات مهمة وثاقبة لكيفية تقديم المحاكم المصرية لخطابات متشابكة ومتشعبة عن الإخلاص، والأصالة، والثقة، وتهديدات النظام العام، خاصةً عندما تتعاملُ مع مسائل يُفترضُ أنَّها دينية. ورغم أنَّني لا أتفقُ مع جميع استنتاجاته وتفسيراته، فإنَّه ينبغي الاقتداء بنهج هذا الكتاب في إطلاق العنان لأسئلة بحثية إبداعية، والانتقال بمهارة بين الفقه الإسلامي، سواء باعتباره تقليدًا عقديًّا نصيًّا أو لغةً حيةً للعدالة، والأخلاق، والتواصل الاجتماعي.
***
إن قراءة هذين الكتابين معًا أمر مفيد للغاية، فكلاهما يُسهم إسهامًا كبيرًا في الحقل المعرفي حول حقيقة أنَّ سلطات الدولة الحديثة ليست مجرد مصدر محايد يمكنُ استخدامه لتحقيق غايات أيديولوجية مختلفة، وكلاهما ينبهُ بوضوح (إن كان ثمة حاجة إلى ذلك) إلى التكاليف التي تتكبدُها الأنظمةُ السياسيةُ غيرُ الديمقراطية في توسيع المعاني القانونية المشروعة والمقبولة محليًّا، وإنماء آمال 2011 الضائعة. أرجو أن يُقرأ الكتابان، أولًا لثرائهما المعرفي، وثانيًا لمزيد من الاجتهاد حول الكيفية التي ينبغي (أو لا ينبغي) بها الاعتماد على التراث لنقد الممارسات الراهنة. فهل نستطيع دراسةَ تأثيرات السلطة، والتأملَ في الخسارة التاريخية دون نصوص أسطورية أو تصورات انتقائية عن الماضي؟
- الهوامش
-
[1] Wael B. Hallaq, Shariʿa: Theory, Practice, Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 200–21.
[2] Kristin Stilt, Islamic Law in Action: Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk Egypt (Oxford: Oxford University Press, 2012); and Colin Imber, Ebu’s-suʻud: The Islamic Legal Tradition (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997).
[3] Asghar Schirazi, The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic (London: I.B. Tauris, 1998).
[4] Homa Hoodfar and Samad Assadpour, “The Politics of Population Policy in the Islamic Republic of Iran,” Studies in Family Planning 31, no. 1 (2000): 19–34.