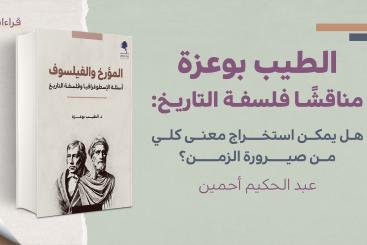في مديح المحققين العرب

ملخص
يستعرض نيل جرين في مقالته "في مدح المحققين العرب" دور المحققين العرب وأهميتهم في مجال النشر والأدب. كما يتناول القدرات الفريدة التي تمتع بها المحقق العربي وثقافته العالية ولغته الصحيحة والمؤثرة. وهو ما يعتبر الركيزة الأساسية في ترويج التراث الإسلامي وتسليط الضوء على القضايا الثقافية والاجتماعية المهمة في المنطقة. وهو ما عثرنا عليه في هذه القراءة التي بين أيدينا لكتاب "إعادة اكتشاف التراث الإسلامي: كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالَمنا الفكري؟"، الذي كان -بحق- سفرًا في التاريخ الفكري، تجاوز فيه مؤلفه ما سبقه من كتابات، والذي تصلح فصوله الثمانية -بما تحمله من موضوعات- أن يكون كل منها بحثًا مستقلًّا؛ كونه يتميز بنظرته الفاحصة ووضوحه وأصالته، ليكون لكل مهتمٍّ بالشرق الأوسط في العصور الوسطى أسبابٌ كافيةٌ يمتدح بها المُحقِّقين العرب.
مقدمة المترجم[1]
من حُسن حظنا نحن القُرَّاء ألا تطول المدَّة بين صدورِ الكتاب وصدورِ ترجمته، وهو ما حدث مع كتاب أحمد الشمسي: "إعادة اكتشاف التراث الإسلامي: كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالَمنا الفكري؟"؛ إذ لم يكن الفاصل الزمني بين الطبعتَيْن إلا عامين تقريبًا. واعتبار ذلك من حسن الحظِّ بسبب ما فيه من وصل جموع القُرَّاء والمهتمين بآخر ما يُكتب في حقولٍ معرفية ما تكفّ مياهها عن الجريان من ناحية، ولما فيه من إعادة توطين الكتاب في بيئة ليست بالجديدة في حالة كتابنا هذا؛ فهو ابنُ هذه اللغة العربية وهذا التراث الذي يدور حوله البحث، وما ينشأ عن العودة من استبصاراتٍ جديدةٍ تكشفها القراءات من خلفياتٍ متعدِّدة من ناحية أخرى. ثم يكون من حسن حظِّ الكتاب والقارئ على حدٍّ سواء ألا يُترك مقطوعًا بعد صدوره وقراءته، ولكن تدور حوله المراجعات والنقاشات، فتارة تستدرك على ما فيه من نقص، وتارة تكشف ما فيه من خبايا، وهو ما عثرنا عليه في قراءة نيل جرين التي بين أيدينا لكتاب "إعادة اكتشاف التراث".
ونيل جرين[2] هو أستاذ كرسيّ ابن خلدون للتاريخ العالمي في جامعة كاليفورنيا، يهتمُّ بوضع التاريخ الإسلامي والتاريخ العالمي في سياق واحد، فسبق أن ألَّف كتابًا بعنون "الإسلام العالمي: مقدمة قصيرة جدًّا"، وتُرجم له كتاب "الصوفية: نشأتها وتاريخها"، وهو متخصِّص في دراسة الصوفية والإسلام في منطقة الهند والمحيط الهندي. ويقدم في الوقت نفسِه بودكاست "غرفة أكبر" يستضيف فيه أكاديميين وخبراء للحديث عن الإسلام من زوايا وخبايا ليست مطروقة، وله مراجعات عدَّة للكتب التي يرى فيها جدَّة وطرافة، ومنها مراجعته لكتاب أحمد الشمسي التي عنونها "في مديح المحققين العرب".
ولا شكَّ أن فصول الكتاب الثمانية بما تطرقه من موضوعات تصلح كلٌّ منها أن تكون بحثًا مستقلًّا، بدايةً من لغز اندثار المخطوطات، فبدايات الطباعة وظهور المحققين، وليس انتهاءً بالسجالات حول نقد النصوص، لكن المراجعة التي بين أيدينا سلَّطت الضوء على ما يفتح بعض الأُفق في قراءة الكتاب، كتركيزها على وضع الكتاب في سياق حقل دراسة تاريخ الكتاب الإسلامي، وكيف يمثِّل هذا الكتاب نموذجًا لنضجِ الحقل وتجاوزه المقولات التعميمية السابقة عليه إلى فضاء أرحب من التنقيب التاريخي المثير. ومن ثَمَّ يقارن نيل جرين منهج أحمد الشمسي وما يرمي إليه في كتابنا هذا بعَلَمين كبيرين: إليزالبيث آيزنشتاين في مجال دراسة الطباعة، وإدوارد سعيد في مجال دراسة الاستشراق، ليكشف عن موقفٍ نظريٍّ واعٍ من مقولات العلاقة بين الوسيلة والرسالة/ الخطاب والأداة.
ومن هنا يركِّز جرين على أحد أهم ما اشتمل عليه كتاب الشمسي، وهو انشغاله "بالتوثيق الدقيق لتعقيدات الاشتباك مع أوروبا؛ إذ لم يسفر هذا الاشتباك عن فقدان الكتب التدريجي فحسب، بل وفَّر نماذجَ للحلول كذلك"، وذلك بفضل "الجيل الجديد من مُحبّي الكتب" والمحققين الذين لم يكونوا مجرَّد رد فعل على الاستعمار أو متلقين سلبيين للاستشراق، بل كانوا فاعلين لهم أهداف وضعوها نصب أعينهم، كان أهمها تحصيل أدوات إعادة اكتشاف تراثهم، وإعادة صلتهم بإرثهم. ولا شكَّ أن السُّبل تفرقت بهم في إدراك هذه الغاية، لكن ما نستطيع استخلاصه من تحقيق الشمسي ومراجعة جرين هو ضرورة استعادة نوع الأهلية والفاعلية لجيلٍ من المحققين والمنشغلين بالتراث، وبثّ نوعٍ من الحركية في فهم تاريخ الكتاب العربي وثقافته، ثم قيام نوعٍ من الصلة بما تراكم من معرفة داخل هذا الحقل، معرفة لا يقتصر تأثيرها في حدود المهتمين بالتراث الإسلامي، بل قد تكون ضروريةً في كل قراءة لثقافتنا بعد الطباعة والتحقيق.
نأمل بترجمة هذه المراجعة أن نمدَّ القارئ بسياقٍ لأفكار الكتاب، واستبصاراتٍ تثير الأسئلة في ذهنه، وتدفعنا جميعًا إلى مدِّ عمر القراءة بمزيدٍ من المناقشة والبحث، والله من وراء القصد.
النَّصُّ المُترجَم
منذ إطلاق علَّامة نظرية الاتصال الكندي مارشال مالكوهان عبارته الشهيرة "الوسيط هو الرسالة" عام 1964م، تبارى المؤرخون في الإجابة عن سؤال: كيف تعيد التقنية تشكيلَ الأفكار؟ بل كيف يصل بها الحدّ لتغيّر الثقافة برمّتها؟ وليس ما نواجه مع الوسائط الرقمية عن ذلك ببعيد. فقد رأت إليزالبيث آيزنشتاين في كتابها "الطباعة محركةً للتغيير"[3] أن ثورة الوسائط بدأت باختراع جوتنبيرج الذي فتح الباب للتحولات الكبرى؛ كعصر التنوير، وازدهار العلوم، والإصلاح البروتستانتي. لكن ماذا عن بقية مناطق العالم خارج حدود أوروبا التي دخلت الطباعة بعضها قبل أوروبا، وبعضها الآخر بعدها؟
ما لبثت أن أصبحت تقاليد الطباعة المحلية في هذه المناطق، كالصين وكوريا واليابان، محلَّ العديد من الدراسات بعد مقولة مالكوهان ودراسة آيزنشتاين المدققة؛ لِما لهذه التقاليد من سبقٍ على أوروبا. وبذلك وسّع حقل تاريخ الكتاب نطاقَهُ منذ ثمانينيات القرن العشرين خارج حدود أوروبا، موجهًا أنظاره إلى الوسائط الأخرى من ألواحٍ طينيَّة ومخطوطات ولفائف. وفي هذه الأثناء، كان المهتمون بالشرق الأوسط يشهدون نقلةً نوعيةً غيّرت نظرتنا إلى الكتاب، أو إلى النصوص على أقل تقدير، كانت هذه النقلة هي إصدار إدوارد سعيد كتابه "الاستشراق" عام 1978م، أي قبل صدور كتاب آيزنشتاين بعام واحد. حيث لفت سعيد الانتباهَ إلى الأبعاد السياسية والخطابية للمعرفة، أو قُل علاقة المعرفة والسلطة كما حدَّدها ميشيل فوكو، بدل التركيز على جوانبها التقنية والمادية. ولعل تأثير أفكار سعيد هو في حدّ ذاته حجّة مضادة لادعاء مالكوهان أولوية الوسيط على الرسالة. لكن في الوقت الذي تصدّر فيه أتباع سعيد المشهد في العديد من دراسات الشرق الأوسط، كان جيل متريّث من الباحثين يطّلع على المخطوطات الفارسية وآثار الطباعة الحجرية الملاوية وبواكير الطباعة العربية، مؤسِّسين حقلًا علميًّا قليل الشهرة عن تاريخ الكتاب الإسلامي. إلى أن نضج هذا الحقل بإصدار أحمد الشمسي دراسته المهمَّة عن تأثير الطباعة في اللغة العربية بعنوان "إعادة اكتشاف التراث الإسلامي: كيف غيّرت ثقافة الطباعة والتحقيق عالَمنا الفكري؟"، ليتجاوز ظلال مالكوهان وسعيد وآيزنشتاين جميعًا.
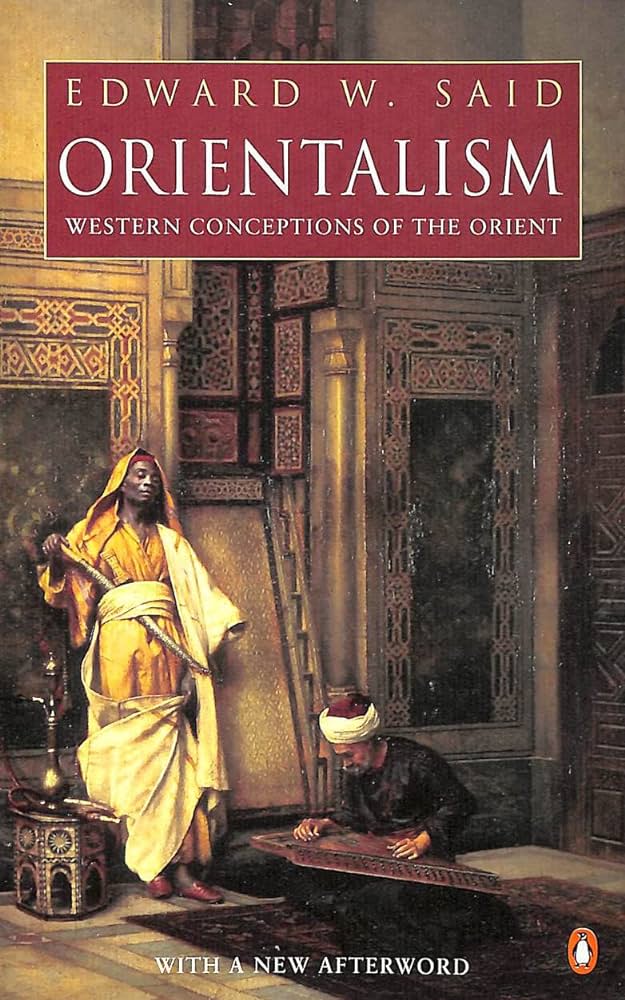
دخلت الطباعة عالم الشرق الأوسط على يد المسيحيين العرب في القرن الثامن عشر، لكن مجتمعاته لم تعتمدها إلا في أوائل القرن التاسع عشر. والمفارقة هنا أن الطباعة العربية قد تطوَّرت داخل أوروبا قبل ذلك بوقتٍ كبير، وكانت مصر أُولى محطاتها عن طريق جيش نابليون الذي جلب معه خطًّا عربيًّا نَهَبه من الفاتيكان، التي مرَّ عليها أثناء توجُّهه جنوبًا إلى البحر المتوسط. وبعدما استعادت مصر استقلالها سريعًا، تأسَّست أول مطبعة مصرية في القاهرة ليبدأ الفصل الصعب في قصة صعود المدينة لتكون مركز النشر العربي الإسلامي. لكن هذه الجملة الأخيرة -التي تجمع بين المهام الميكانيكية المميزة لإعادة طباعة النصوص وتوفير نسخٍ صحيحة يقرؤها الجمهور- تخفي بين ثناياها تطوراتٍ معقَّدة سعى الشمسي إلى الكشف عنها، من قبيل العثور على مخطوطات المؤلِّفين المسلمين النادرة، أو ضمان خروج النصّ المضبوط من المطبعة، أو القيام بمجموعة دقيقة من المهام التحريرية. كلُّ ذلك أضاف قيمةً ثقافيةً إلى الكتاب المطبوع لم تكن في الكتاب المخطوط.
وأولى المشاكل الكبرى التي رصدها الشمسي هي أوضح ما واجه قُرَّاء العربية قبل قرنين من الزمان، ولمَّا حلتها التحولات الكبيرة التي يكشفها كتاب الشمسي صارت منسيَّة. ولذلك بدأ الشمسي كَشْفَهُ بالسؤال: لماذا لم تكن المخطوطات العربية متوافرةً قبيل إدخال الطباعة في القرن التاسع عشر؟ وقاده هذا السؤال إلى مجموعة لازمة من الأسئلة: مَن الذين استطاعوا تخطي العقبات الفيلولوجية والتنظيمية والمالية حتى يعيدوا اكتشاف هذه النصوص؟ وكيف فعل ذلك هؤلاء المحررون الرائدون المنسيون وجامعو المخطوطات النهمون؟ وما الذي حَفَزهم لخوض غمار تحديات طباعة نصوص القرون الوسطى في فترةٍ نظنُّ أنها فترةُ الانبهار بالحداثة؟
من بين هذه الأسئلة، دعونا نبدأ بأول مشكلة تعرَّض لها الشمسي في كتابه. وهي أنه رغم كتابة مئات آلاف الأعمال بالعربية في الفترة بين العام الأول الهجري (622م) وسنة 1819م، سنة تأسيس مطبعة بولاق في القاهرة، وهي أول مطبعة إسلامية، فقد كانت نسخ هذه الأعمال إمَّا مفقودة وإمَّا نادرة إذا عُلم بوجودها أصلًا، بسبب تعاقب الحروب والحرائق وتقلُّبات الطقس والحشرات والرقابة عليها. ويشير الشمسي إلى أنه حتى اليوم يصعب الوصول ما يقارب 600 ألف مخطوطة عربية بقيت من فترة القرون الوسطى، فما بالك بما كان عليه الحال قبل قرنين من الزمان حين بدأت القصة التي يرويها مع ميلاد الطباعة في العالم الإسلامي؟ لا شكَّ أن التحديات كانت عظيمة، فلم تكن المكتبات المنظّمة والفهارس الموثّقة وأدوات البحث الببليوغرافي منتشرةً في ذلك الوقت؛ إذ جاءت مع دخول الطباعة.
طرق التعلم الإسلامية - الطريقة الشفاهية والمدرسية والباطنية- الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر لا حاجة فيها إلى اقتناء المخطوطات. وهو ما أدى بالتبعية إلى الاستغناء عن تعدد نسخ المخطوط الذي قد تنحصر نسخه في وسط تلاميذ المعلم. وأدى ذلك إلى تأثير تراكمي على مر الزمن (كان تأثيرًا تناقصيًا في واقع الأمر).
ولم يكن عاملُ الزمن وحده الذي أسفر عن ندرة المخطوطات؛ إذ ثمة عاملان آخران: اندثار المكتبات التقليدية في العالم العربي، ونَهم المستشرقين الأوروبيين. يرى الشمسي أن جانبًا لا بأس به من أزمة المكتبات العربية كان بسبب الغزو الإمبريالي العثماني لسوريا ومصر عامي 1516 و1517م. إذ لم يكتفِ العثمانيون بتتابع القوافل الملأى بغنائم المخطوطات إلى عاصمتهم (وقد استقرت هناك في مكتبات إسطنبول حتى يومنا هذا)، بل أحلوا التركية والفارسية محلَّ العربية في لغة الدواوين، "فتقلَّص الدعم المؤسسي للمعرفة العربية الإسلامية".
أما العامل الثاني وهو الاستشراق، فقد أدى إلى "ابتلاعٍ آخر للكتب"، وابتلعتها هذه المرة مدنُ لندن وميونيخ وليدن في هولندا بسبب الوَلَع الأوروبي بالعربية. وأدى النهب دَوْرَهُ هذه المرة كذلك في شكل سرقاتٍ منظَّمة للمكتبات خطَّط لها مستشرقون بعينهم "بعقلية نبَّاشي القبور" ونفذها وكلاؤهم المحليون في مصر. ومع ذلك، ضَمن الثراء النسبي للمستشرقين وعلاقاتهم الوثيقة مع مكتبات الدول الغنيَّة أن "أغلب المخطوطات التي تدفقت من الشرق الأوسط إلى أوروبا في هذه الفترة قد باعها أصحابها عن طيب خاطر (وإن لم يبيعوها دائمًا بشكل قانونيّ)".
لكن تفسير الشمسي لقلة المخطوطات العربية المتاحة للقُرَّاء المسلمين في القرن التاسع عشر ليس اقتصاديًّا وسياسيًّا فقط، فله أسبابٌ ثقافيةٌ كذلك قادتها الطبيعة المتغيرة للمعرفة الإسلامية. إذ يرى أن طرق التعلُّم الإسلامية (الشفاهية والمدرسية والباطنية) الممتدَّة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر لا حاجة فيها إلى اقتناء المخطوطات. وهو ما أدى بالتبعية إلى الاستغناء عن تعدُّد نسخ المخطوط الذي قد تنحصر نُسخه في وسط تلاميذ المعلم. مما أدى إلى تأثيرٍ تراكميٍّ على مر الزمن (كان تأثيرًا تناقصيًّا في واقع الأمر).
أضف إلى ذلك أن طرق التدريس والتعلُّم بشكل عام لم تكن تركِّز على النصوص الأصلية لعلامات القرون الوسطى كالأشعري والغزالي، بل كانت التعليقات والشروح والحواشي هي طريق دراسة أعمالهم لا ما كتبوه بأنفسهم. كما يعتقد الشمسي أن صعود "الباطنية" -لا سيما أفكار ابن عربي الصوفي الأندلسي- قوَّض مكانة وسلطان التعلُّم عن طريق الكتب، فزهّد في إنفاق الوقت في البحث عن الكتب ونسخ قديمها.
ومن ثَمَّ لم تحدث "إعادة اكتشاف" كتابات الأشعري والغزالي وغيرهما من مؤلِّفي القرون الوسطى واعتبار أعمالهم "أصولًا" إلا في منتصف القرن التاسع عشر من خلال إعادة التنظيم الفكرية التي أتاحتها -وإن لم تحدِّدها سلفًا- الطباعة. وبذلك رسم الشمسي مشهدَ حرمان مصر من مخطوطاتها في البداية، وبدل أن يتبع حتمية مالكوهان، انتقل إلى وصفٍ تفصيليٍّ للقرارات التي اتخذها أفرادٌ عرب من موظفين ومُدرِّسين ومُحرِّرين ومُحبِّين للكتب، وبفضلها استطاعت الإمكانات الجديدة للطباعة تغيير تقاليدهم الفكرية.
نعرف أن التاريخ المبكِّر للطباعة العربية مُوثَّقٌ الآن، لكن إسهام الشمسي يكمُن في دراسة التحولات النصيَّة المختبئة التي رافقت مكابس الحديد والحروف النحاسية. فهو يُفرِّق تفرقةً مهمةً بين دور المُصحِّح ودور المُحقِّق، ويُظهر أن المهام الأساسية للمُصحِّحين سبق ظهورها بنحو قرنٍ من الزمان نشأةَ تدخل المحققين في النصوص، وهؤلاء المحققون هم مَن ابتكروا علامات الترقيم المعيارية والفقرات والهوامش والمراجع. لكن هذا لم يدفع الشمسي إلى تفسيرٍ تجريديّ نظريّ لتحديد شكل النصِّ للمعنى، كما اعتدنا بعد صكّ ما بعد البنيوية حتمية خطابية من مقولة مالكوهان تقول: "شكل النصّ هو الرسالة"، وإنما ظل في كتاب "إعادة اكتشاف التراث الإسلامي" وفيًّا للأفراد الذين اختلفت أغراضهم واهتماماتهم وأسفارهم وممارستهم، التي شكَّلت ثقافة الكتاب العربي الجديدة التي أتاحت المخطوطات المفقودة لجمهور واسع من قُرَّاء الكتب المطبوعة.
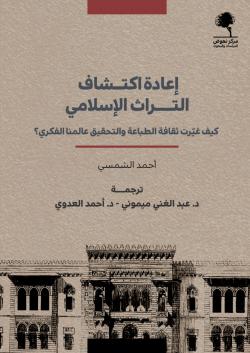
وأحد هؤلاء كان نصر الهوريني، المُصحِّح بالمطبعة الأميرية الذي تولَّى مهمة البحث عن مخطوطات مقدمة ابن خلدون، ومع أن ابن خلدون وقتها كان في طريقه ليصبح أشهر المؤرخين العرب على الإطلاق -وكان من أسباب ذلك اهتمام المستشرقين الفرنسيين به الذين أطلقوا عليه "مونتسكيو الشرق"- كانت مقدمته ودرَّة إنتاجه نادرةَ الوجود في مصر؛ فَجُلّ نسخها حين بدأ الهوريني بحثَهُ كانت في مكتبات إسطنبول العثمانية، بما في ذلك أقدم نسخها، وهي النسخة المصرية التي خطَّها ابن خلدون بيده. أما بقية النسخ فقد استطاع جامعو الكتب الأوروبيون الاستحواذ عليها. ومن هنا يبيِّن الشمسي مجاهدةَ الهوريني في رحلته للعثور على نسخٍ تمكِّنه من إخراج قراءة دقيقة؛ إذ يمكن لتحريف النقط في مخطوطة عربية مكتوبة على عجلٍ أن يبدل المعنى تمامًا؛ ولذلك على المُحقِّق المقارنة بين عدَّة مخطوطات حتى يُخرج نسخةً دقيقةً يدفع بها إلى المطبعة. ولسوء الحظ لم يعثر الهوريني إلا على مخطوطتين للمقدمة، لكن ذلك لم يعجزه، وقد أتاح إخراجُهُ هذا السفر عن المطبعة الأميرية عام 1857م لجمهور القُرَّاء العرب الواسع قراءةَ ابن خلدون بعد أربعة قرون ونصف القرن من وفاته.
يروي لنا الشمسي كذلك قصة الجيل الجديد من مُحبّي الكتب الذين خلقوا الطلب على الكتب المطبوعة، وأسَّسوا جمعية المعارف المصرية عام 1868م، التي انضمَّت إليها نخبة جديدة من موظفي الدولة المتعلِّمين في المدارس الحديثة بدل الانضمام إلى "العلماء" التقليديين الذين هيمنوا على التعليم العربي قرونًا.
وكان أحمد تيمور أحد هؤلاء، وهو الذي جعل من موضة جمع المخطوطات النادرة سياسةً حكومية، ومن ثَمَّ أوفده الخديوي إسماعيل في رحلة رسمية إلى المكتبات الأوروبية. واستطاع خلالها نَسْخَ المخطوطات العربية لديهم، ما سهّل صدور نسخٍ دقيقة مطبوعة في القاهرة.
وهنا يبدو الشمسي يخالف إدوارد سعيد كما خالف مالكوهان من قبل. فهو مشغول بالتوثيق الدقيق لتعقيدات الاشتباك مع أوروبا؛ إذ لم يُسفر هذا الاشتباك عن فقدان الكتب التدريجي فحسب، بل وفَّر نماذجَ للحلول. وأول هذه الحلول كان إنشاء أولى المكتبات الحديثة في الشرق الأوسط، "وهي المؤسسة التي استلهمت المكتبات البحثية الأوروبية وكانت دائمًا مقتفية آثارها". وأحد أهم العلامات هنا هو رفاعة الطهطاوي، وكان إمامًا لأول بعثة من الطلاب العرب الذين أُرسلوا للدراسة في باريس في عشرينيات القرن التاسع عشر. وبعد عودته إلى القاهرة أدى دورًا كبيرًا في إصلاح التعليم المصري، وكان للكتب المطبوعة مكانة مركزية فيه. وقد أسفرت جهود الطهطاوي وأتباعه عن افتتاح دار الكتب عام 1870م في القاهرة لتكون أولَ مكتبة وطنية في الشرق الأوسط، وبعدما كانت المكتبة الوطنية الفرنسية نموذجها أصبحت هي نموذج بقية المكتبات الحديثة في البلاد العربية.
ومع بداية القرن العشرين، شجَّع الحاذقون بالكتب المطبوعة ظهور طائفة المُحقِّقين بدل المُصحِّحين. وهنا أيضًا كان لأوروبا ما تقوم به؛ لأن الاشتباك الإيجابي مع الاستشراق في مجال الأدوات المنهجية أوسع من عمل المكتبات. وهنا يبرز أحمد زكي باشا الذي أتاح له عمله مترجمًا للغة الفرنسية في الحكومة المصرية (وقد تعلم لاحقًا الإنجليزية والإسبانية والإيطالية) الوصولَ إلى كتابات المستشرقين ومؤتمراتهم. وكان "ولعًا بكتابات الباحثين المستشرقين وسعى إلى وصلِ عمله بأعمالهم". وقد جاب المكتبات الأوروبية، ثم استكشف مكتبات إسطنبول وذلك في مهمات رسمية، واستطاع كتابة تقريرٍ في غاية الأهمية عن حالة المكتبات العثمانية في العقد الأخير من الإمبراطورية.
ولمَّا رأى أحمد زكي صعوبة الوصول إلى المخطوطات النادرة وهي ترزح وراء أقفال المكتبات العثمانية -صعوبة لم يسلم منها باحثون مُموَّلون ومُسلَّحون بالخطابات الرسمية- صمَّم على إتاحة هذه الأعمال مطبوعةً. وحتى يقوم بذلك استدعى الأساليب والمناهج التي طوَّرها الأوروبيون في طباعة الكتب العربية، ومنها مقدمات المُحرِّرين، ووصف المخطوطات، وعلامات الترقيم المعيارية، واستخدام الهوامش لتنبيه القُرَّاء إلى القراءات المختلفة للمخطوطات المتعدِّدة. ويلخِّص الشمسي ثورة التحقيق التي أحدثها أحمد زكي معتبرًا أنها تشكَّلت "بوعيٍ دقيقٍ بمؤسسات جمع الكتب والإنتاج… وألفة كتابات المستشرقين والمخطوطات العربية في أوروبا وفي العالم الإسلامي، وطموح لإخراج أعمال مرجعية تكون عماد دراسات الشرق وتاريخه، ورغبة أكيدة في جمع المستشرقين والباحثين المسلمين على مائدة الحوار".
ولم يتضح حينها الفارق الذي أحدثه أحمد زكي عن الجيل الذي سبقه من "المصححين" بسبب التطورات المتلاحقة في ثقافة الكتاب العربي، على الأقل لم يستطع ذلك قُراء النصوص التي أتاحها، فقد بلغت ابتكاراته من الجدَّة أنه لم يكن ثمة مرادفٌ عربيٌّ لدوره. لكن بحلول عام 1911م بدأت تظهر كلمة "مُحقِّق" مع اسمه المكتوب على صفحة عنوان الكتاب (وهذه الصفحة نفسها ابتكار آخر).
ورغم التقارب بين اللفظين: "المُحقِّق" و"المُحرِّر"، فقد كان اختيار اللفظ مدروسًا؛ لأن المسؤولية التي وقعت على عاتق أحمد زكي ورفاقه لم تقتصر على تصحيح الجُمل من الأخطاء، بل كانت مهمة إبستيمولوجية لضمان فهم العرب المُحدَثين المعنى الدقيق الذي قَصَده أسلافهم في القرون الوسطى. وأتاحت أساليب أحمد زكي في التحقيق واستطاعت الكشف عن حقائق عظيمة بإزاحة قرونٍ من أخطاء النسَّاخ التي أخفت تعاليم مُفكِّري التراث الإسلامي.
كانت هذه الاهتمامات محلَّ تركيز الشمسي في الفصول الأخيرة، التي يصف فيها "إدراك المصلحين الإسلاميين قوة الطباعة وتوظيفها لخدمة غاياتهم المتمثِّلة في التغيير الاجتماعي الثقافي الضارب بجذوره في نفس الثقافة والمجتمع". وهنا يسوق أمثلةً لشخصيات مؤثرة، منها محمد عبده -مارتن لوثر المسلمين إن جاز الوصف- الذي رأى أن إحياء النصوص العربية ونشر التراث الإسلامي هما أداتا الإصلاح الديني. وهذا الإصلاح الذي رجاه عبده وتلاميذه لم يقتصر على تنقية الإسلام بإزاحة قرونٍ من الخرافات والدروشة الصوفية، بل شمل التوفيق بينه وبين العلوم الحديثة.
"الفيلولوجيا لم تكن ببساطة أداة نقدية للتعامل مع النصوص، بل كانت حارسًا يحدد أي النصوص يظهر للعالم؟ وما الشكل الذي يتخذه هذا الظهور؟ وما درجة الأصالة -التاريخية والنصية- التي يمثلها؟"
جعل كلُّ ذلك من القاهرة عاصمةَ النشر في العالم العربي، وتخطَّت التأثيرات حدود مصر، ولم تكن أقلها مؤسسات تلميذ محمد عبده السوري رشيد رضا الذي صدّرت مجلته المنار أفكارهما الإصلاحية. وبحلول عام 1920م، أُطلق على حركتهم "السلفية". ولمَّا أحال اللفظ إلى السلف، وهم الأتقياء الأنقياء في صدر الإسلام وعصوره الأولى، وكانت الفجوة الممتدَّة بينهم تتجاوز الألف عام، كانت أفضل الوسائل للاتصال بهم هي استعادة النصوص التراثية التي سجَّلت كلماتهم. وكان ابن تيمية من بين المؤلِّفين المُهمَلين الذي وجدوا اليومَ قُرَّاء بفضل الطباعة، وهو الذي يُعَدُّ أشدَّ نقَّاد الصوفية في القرون الوسطي، فوجد له جمهورًا متحمسًا في السعودية جارة مصر والدولة الوليدة بعد نهاية حكم العثمانيين.
وهنا نجد نقطة تلاقٍ بين الشمسي وتفسير إليزابيث آيزنشتاين المشهور عن تأثير الطباعة في أوروبا، وهي إشارته إلى التشابه بين "الإصلاح" الإسلامي وسلفه المسيحي. لكن الشمسي يفضِّل التماسَّ مع موضوعات كتابه بدل تعميم دعوى آيزنشتاين. ولذلك عندما وصل إلى نقطة تغري الباحث الغرَّ إلى الانتقال إلى "الصورة الكبيرة"، اختار تخصيص الفصل الأخير للنقد والفيلولوجيا. ولم ينقص هذا الموضوع الحيوية في معالجته، فقد وصف فيه الصعود المثير للدراسة المتخصِّصة للغة وسط الاضطرابات السياسية في عشرينيات القرن العشرين التي شهدت حكم فرنسا وبريطانيا لمناطق شاسعة من الإمبراطورية العثمانية المتهافتة، وانتشار الحركات القومية الجديدة في الشرق الوسط برمَّته. وبيَّن الشمسي -باستعراضه الأقطاب المشتعلة "للنقاشات الحامية"- أن "الفيلولوجيا لم تكن ببساطة أداة نقدية للتعامل مع النصوص، بل كانت حارسًا يحدِّد أي النصوص يظهر للعالم؟ وما الشكل الذي يتخذه هذا الظهور؟ وما درجة الأصالة -التاريخية والنصية- التي يمثلها؟".
ويختتم الشمسي بتذكرينا بالشغل الفكري والأخلاقي الروحي الشاغل لأبطال قصته، وهو الحاجة إلى التحقيق. وهذه الحاجة إلى المعرفة الموثَّقة المبنيَّة على النصوص الدقيقة هي التي أدت إلى ظهور المحققين العرب ومهنتهم المميزة.
***
قد لا يكون الصوفية أشرار مترصدين بل ضحايا مثل غيرهم لأوجه التراجع التي اعترت الكتب ورصدها الشمسي.
لا شكَّ أن كتابًا زاخرًا بالأفكار كهذا الكتاب عرضةٌ لمساءلة المتخصِّصين أطروحاته، ومنها ادعاؤه أن تعاليم الصوفية -لا سيما ابن عربي- أدت إلى "نزعة مضادة للكتابة"، فقد لا يكون ادعاءً مغاليًا فحسب، بل غير مُقنِع كذلك. فقد كان ابن عربي غزير الإنتاج لا يكفّ عن تسويد الصفحات كل يوم طوال حياته. وخلال القرون التي أظهر فيها الشمسي تناقصَ إنتاج الكتب، كان من الصوفية مَن يكتبون أعمالًا مطوَّلة. لكن إذا كان بعض الصوفية أنفسهم بكتابتهم هذه النصوص لم يستجيبوا لنصيحة الابتعاد عن الكتب والانكفاء على تلقي الدروس النورانيَّة، فإن هذا لم يؤدِّ حتمًا إلى انتشار كتاباتهم واستنساخها. وبذلك قد لا يكون الصوفية أشرارًا مترصدين، بل ضحايا مثل غيرهم لأوجه التراجع التي اعترت الكتب، والتي رصدها الشمسي.
وربما تكون الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع اقتصاديةً أكثر منها باطنيةً أو ميتافيزيقيةً، نتيجة تكلفة الورق وتوافره، لا سيما أنه كان يُنتَج محليًّا بدل استيراده من مصانع الورق المزدهرة في إيطاليا عصر النهضة. لكن يبقى التفضيل بين هذه الاحتمالات مهمَّة المؤرخين. أما قيمة مقاربة الشمسي وأصالته فتكمُن في محاولته الكشف عن الأسباب الفكرية للتحولات التاريخية في الشرق الأوسط بدل الاعتماد على المقاربات الاقتصادية والسياسية الرائجة.
كما أن لغة الشمسي واضحةٌ جليةٌ رغم تناوله مسائل دقيقة ومتخصِّصة. كما دبج كتابه سِيرًا حيَّة، فكانت بمثابة سِير للكتب من خلال مَن أعادوا اكتشاف مخطوطاتها النادرة -"التراث الإسلامي" المفقود- ثم أتاحوها للجمهور الواسع في طبعات مُحقَّقة مُصحَّحة. وعندما روى هذه السِّيَر حرص على بعث روحٍ من الإثارة الفكرية وروح المغامرة في أبطال قصصه دون أن يقع مرة واحدة في تنميطٍ مُمِلّ.
ثم أضاف قراره بإدراج صور هؤلاء الرجال المجهولين لفتةً إنسانيةً لهذه القصص عن "تصرفاتهم في اختيار الأعمال التراثية وتحقيقها ونشرها وتوزيعها حتى تتوافق مع ما اعتبروه واجب الوقت المُلحّ". وهذا يسلط الضوء في النهاية على اهتمامه الأساسي بدور هؤلاء الأفراد الذي طالما كان مقيدًا بحتمية مالكوهان التقنية، وأغلال إدوارد سعيد عن الخطاب. ولذلك "رغم أن هيمنة الأوروبيين السياسية والثقافية كانت قابعة دائمًا في حياة المحققين الذين تناولهم الكتاب ونشاطاتهم، فلا يمكن اختزال سيرهم في مجرد رد فعلٍ على الكولونيالية أو التلقي السلبي للاستشراق. بل كانوا يستكشفون إرثهم الفكري لغاياتهم الخاصة، حدث ذلك مرةً بالحوار مع المعرفة الغربية، ومرةً بالتعلُّم منها، ومرةً بالتعارض معها".
وقد أحيت هذه القرارات التي اتخذها المحققون العرب المجهولون كثيرًا من الأعمال المفقودة التي انتشرت بفضل الطباعة، ليعتبرها الباحثون المسلمون وغير المسلمين على حدٍّ سواء "التراث الإسلامي".
لقد كتب أحمد الشمسي سفرًا في التاريخ الفكري، وجدَّد به أُسس حقله الدراسي مثل كل عملٍ رائدٍ. فخلال 30 عامًا مضت، أسَّس باحثون يعملون في مختلف المناطق في الشرق الأوسط وإفريقيا وصولًا إلى الهند وإندونيسيا حقلَ تاريخ الكتاب الإسلامي حتى أثمر هذا الحقل ثمرتَهُ التي طال انتظارها بكتاب "إعادة اكتشاف التراث الإسلامي" ونظرته الفاحصة ووضوحه وأصالته، ليكون لكل مهتمٍّ بالشرق الأوسط في العصور الوسطى أسبابٌ كافيةٌ يمتدح بها المُحقِّقين العرب.
- الهوامش
-
[1] نُشرت هذه المراجعة على موقع لوس أنجلوس ريفيو أوف بوكس (Los Angles review of Books)، بعنوان (In Praise of the Arab Editor)، على الرابط.
[2] نيل جرين (Nile Green): أستاذ كرسيّ ابن خلدون للتاريخ العالمي في جامعة كاليفورنيا، ومؤلِّف كتاب "الإسلام العالمي: مقدمة قصيرة جدًّا".
[3] Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. 1980.