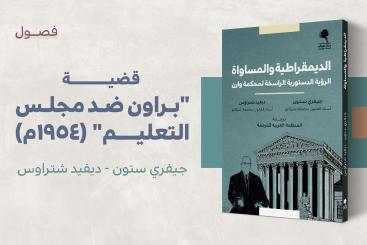دراسة تحليلية: أخطاء القضاة.. دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي و القوانين الوضعية

الكتاب الذي نُقدِّم له اليوم عُرِّب أو تُرِجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية للمرة الأولى منذ نيف ومئة سنة، وعلى وجه التحديد في عام 1333هـ الموافق 1914م، وذكر القائمون على ترجمته أنها كانت بناء على توصية من جانب المستر إيموس ناظر مدرسة الحقوق الخديوية منذ كان مستشارًا بمحكمة الاستئناف الأهلية تعميمًا لنفعه بعد أن استشار مؤلفه، ورأوا أن هذا الكتاب جدير بأن تتناوله أيدي من يهمهم شأن القضاء من قضاة ومحامين وخبراء ومتقاضين من الناطقين بالضاد. وأشاروا إلى أن مؤلف الكتاب تحرى في تدوين فصوله المعززة بالشواهد والاستنتاجات الرجيحة انتقاد عيوب إذا كانت فاشية في بلد كفرنسا عرفت بأنها مبعث العلوم القضائية، فهي في بلد كمصر لم يتجاوز نظامه القضائي -وقت ترجمة الكتاب- أربعة عقود أكثر فشوًّا وأشد ضررًا بالمتقاضين.
موضوع الكتاب
تناول الكتاب موضوعًا بالغ الأهمية لا تبلى جدته رغم قدمه، وهو أسباب أخطاء القضاء؛ فما زالت وجوه الخطأ التي عرض لها هذا الكتاب وبيَّن أسبابها وآثارها قائمة حتى اليوم على حالها بنفس تلك الأسباب وهذه الآثار، وربما بشكل أوضح، وكأنما صدر الكتاب بالأمس القريب ولم يصدر منذ أكثر من قرن من الزمان. بل إن إنعام النظر في الأخطاء التي بسطها يُلقي في روع القارئ أن الخطأ القضائي هو من لوازم القضاء في كل مجتمع وفي كل زمن. وكما أن المرض عرَض لا يسلم منه إنسان، فكذلك الخطأ عوار لا يسلم منه القضاء، أيّ قضاء.
والسبب معلوم، وهو أن القضاء اجتهاد بشري، وهو في جوهره بحث عن الحقيقة من وجه، وإمضاء للعدالة من وجه، وكلا المطلبين عسير؛ فالقاضي مهما خلصت نواياه، ومهما بذل أقصى الجهد في عمله، فهو غير معصوم من الخطأ، بل هو عرضة له، إذ ليس في الناس من يسلم من الخطأ. وهذه القضية لا تحتمل المكابرة؛ لأن المنازعة فيها تعني ادعاء الكمال وهو مالم يزعمه أحد. ولهذا فالخطأ وارد على كل قاض بوصفه إنسانًا ولو كان نبيًّا مرسلًا؛ فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار".
وفي القرآن مثال عملي لورود الخطأ حتى على الأنبياء حين يقضون. قال تعالى في سورة الأنبياء: "وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلًّا آتينا حكمًا وعلمًا [الآيتان 78و79].وتذكر كتب التفسير أن سليمان عليه السلام راجع أباه في حكمه واقترح عليه حكمًا آخر رآه أصوب فأمضاه، وقال له: وُفقت يا بني، لا يقطع الله فهمك (أحكام القرآن للقرطبى. طبعة دار الشعب ص4348). وثَمَّ واقعة أخرى روتها كتب الحديث؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب الذئب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى (الجامع الصحيح لمسلم)، وانكشف بذلك خطأ ما قضى به نبي الله داود.
ولما كان القضاء موضوعًا إنساني الطابع فقد شغلت به الشرائع الوضعية، وعنيت بوضع الضوابط والضمانات التي تحول دون وقوع القضاة في الخطأ، كما عنيت بعلاج أو تدارك ما يقع منهم رغم ذلك من خطأ. ويلفت النظر أن الشرائع بوجه عام تتشابه مواقفها وإن تباينت في بعض التفاصيل. وعلة التشابه والتباين مفهومة؛ فليس بين الناس من يقرّ الخطأ أو يرضى باختلال ميزان العدل؛ لأن العدل مركوز في الفطرة، وهو إلى ذلك ضرورة اجتماعية لا تستقيم بدونها حياة الناس، ومن هنا كان التشابه. لكن عقول الناس تتفاوت في استنباط الحلول وابتداع الوسائل، وهذا سر التباين.
يهدف الطعن إلى تدارك ما شاب الحكم من خطأ، وذلك بتصحيحه على نحو يجعله متفقًا مع حقيقة الواقع ومطابقًا للقانون، وهذه هي وظيفة العلاج أو التصحيح.
ووسائل الشرائع الوضعية في توقي الخطأ القضائي وعلاجه عديدة، وليس من شأننا ونحن نقدم لهذا الكتاب أن نستقصي كل هذه الوسائل، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى واحدة من أهم تلك الوسائل، وهي تقرير حق الخصوم في الطعن فيما يصدر ضدهم من أحكام، فتقرير هذا الحق ينطوي على تسليم المشرع بأن الخطأ القضائي ليس أمرًا شاذًّا، بل إن شيوعه أمر ملحوظ. وهذا الحق يؤدي وظيفة مزدوجة، فهو بمجرد تقريره وبغض النظر عن ممارسته كفيل بحمل القضاة على بذل مزيد من العناية فيما يفصلون فيه من دعاوى حذرًا من أن تُلغى أحكامهم أو تُعدَّل عند الطعن فيها. فتقرير حق الطعن -من هذا الوجه- عاصم من الوقوع في الخطأ إلى حد كبير، وتلك هي الوظيفة الواقية لهذا الحق. أما الوظيفة الأخرى فتبدو عندما يباشر صاحب الشأن حقه بالفعل. وفي هذه الحالة يهدف الطعن إلى تدارك ما شاب الحكم من خطأ، وذلك بتصحيحه على نحو يجعله متفقًا مع حقيقة الواقع ومطابقًا للقانون، وهذه هي وظيفة العلاج أو التصحيح.
وطرق الطعن في الأحكام في التشريعات المعاصرة -بوجه عام- هي المعارضة والاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. ولكل طريق من هذه الطرق علة وأحكام خاصة، وبعضها محل جدل، فمن الفقهاء من يغلو في نقده ويشتد في التحامل عليه، ومنهم من يتحمس للدفاع عنه والإبقاء عليه. ويجري التشريع الوضعي بوجه عام على تقييد حق الطعن بأسباب معينة وبقيد زمني محدد، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحتين كلتاهما جديرة بالرعاية. أما الأولى فهي تحقيق العدالة، وأما الأخرى فهي استقرار الحقوق والمراكز القانونية، فقد قدَّر المشرِّع من جهة أن فتح باب الطعن في الأحكام من شأنه تحقيق العدالة، وقدَّر من جهة أخرى أن إغلاق هذا الباب بعد فترة معلومة لازم لكي تستقر الحقوق وتتأكد جدية الأحكام، وإلا تأبدت الخصومات واستحال على القضاء أن ينهض بمهمته ويؤدي رسالته.
ولما كان القضاء بحثًا عن الحقيقة وإمضاء للعدل، فقد رفع الإسلام من شأنه، وذكر الرسول أن عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة، وبين فضل القاضي فجعله أحد سبعة يُظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وقال: المقسطون عند الله على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. غير أنه نفـّر مع ذلك من الحرص على تولي القضاء ونهى عن طلبه فقال: من جُعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقال: ستطلبون الإمارة وتكون حسرة وندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وُكل إليه وخيف عليه الهلاك، ومن لم يسأله وامتـُحن (أى اُبتلي) به وهو كاره له خائف على نفسه فيه أعانه الله عليه. وعن عائشة ڤ أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط.
وصنف رسول الله القضاة فجعلهم ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة؛ فقاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض قضى بجهل فهو في النار، وقاض عرف الحق فجار فهو في النار. ثم هدَّأ ﷺ من روْع القضاة فقال: إذا حكم الحاكم -يعني القاضي- فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
مفهوم الخطأ القضائي عند المؤلف
وزع المؤلف موضوع كتابه على ثمانية أبواب، عرض في أولها لبيان مفهوم الخطأ القضائي، وعُني بإيراد المفهوم الفلسفي للخطأ والصواب بوجه عام، ثم حاول تعريف الخطأ القضائي وخلص إلى أنه يقع كلما قـُضي بعقوبة على بريء أو على شخص غير مسؤول، وكذلك كلما عوّل القاضي في حكمه على وقائع غير صحيحة لتطبيق المبادئ التي نص عليها القانون. ثم تحفظ بأنه كان الأصل أن القضاء خطأ ببراءة مجرم يدخل كذلك في تعريف الخطأ القضائي؛ لأن الحكم ببراءته يخدش وجه الحقيقة ويعبر عن فكرة لا تتفق مع الموضوع الذي قامت عليه، إلا أنه مع ذلك أخرج هذا الخطأ من نطاق الخطأ القضائي الذي خصص له كتابه. وعلل ذلك بأنه إذا كان الحكم ببراءة المجرم هو من عوامل الخلل الاجتماعي لما يترتب عليه من عودته إلى العبث بالمال أو النفس، إلا أن هذا الخلل أقل أهمية في كل حال مما يُحدثه الحكم بالعقوبة على بريء أو على شخص غير مسؤول جنائيًّا. ويرى المؤلف أن واجب الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الجريمة، فإن وقعت فإن عدم الاهتداء إلى الجناة أكثر ضررًا من تبرئة ساحة المجرمين، بل هو تشجيع على الفساد وخطر يتهدد النظام الاجتماعي.
واكتفى المؤلف في تحديد مفهوم الخطأ القضائي بما نقلناه عنه، ثم عمد في الأبواب السبعة التالية إلى استقصاء أسباب هذا الخطأ. ونرى أن حرصه على استقصاء هذه الأسباب أدى به إلى عدم الوقوف موقف المتأني أمام فكرة الخطأ القضائي ذاته. وربما كان لطبيعة عمله كمحام -أمام محكمة استئناف باريس- دخل كبير في ذلك، فقد نظر إلى أخطاء القضاء بعين المحامي رغم ما بذله من جهد لالتزام جانب الإنصاف. وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي رأى أنها تُفضي -من وجهة نظره- إلى وقوع أخطاء القضاء، فإنه يكاد يردها في المقام الأول إلى أول هذه الأسباب، وهو القاضي نفسه. وقد أفصح المؤلف عن ذلك صراحة في خاتمة الكتاب تحت عنوان «النتيجة» فقد استهلها بطرح السؤال التالي: ما الذي ينبغي أن يستنتجه القارئ من هذا البحث؟ ونفي الادعاء بأنه حل معضلة الخطأ القضائي بإزالة أثر الغلطات القضائية وتمكين قواعد العدل، ثم أضاف: غير أن هذا لا يمنعنا من القول بأنه يتلخص في أمر واحد، وهو ضرورة استجماع القضاة لعناصر علم حديث، وهو علم الأحوال النفسية -يقصد علم النفس القضائي- من حيث ارتباطه بالقضاء. ودعا الخلف من الباحثين والناقدين إلى التوسع في هذا العلم بما يجعله كفيلًا بتحقيق الغاية المقصودة منه. وحاصل هذا الرأي أن المؤلف يرى أن الحل يكمن في تأهيل القضاة وإلزامهم بالتزود بطائفة من العلوم والمعارف تحدُّ من وقوعهم فيما يقعون فيه من أخطاء.
ولا شك أن للمؤلف خبرة عريضة وعميقة بعمل القضاء، فهو على دراية دقيقة بالدعوى الجنائية منذ نشأتها، بل حتى قبل أن تنشأ، أي وهي في مرحلة الاستدلال. ثم هو أكثر دراية بها وهي في مرحلة التحقيق الابتدائي والمحاكمة، بل حتى بعد انقضائها بالحكم البات ثم عودتها من جديد في حالة الطعن بطلب إعادة النظر. وحرص المؤلف طوال هذه المراحل على بيان مدى معاناة المتهم هو ومن يتولى الدفاع عنه. وكل ما ذكره في هذا الشأن صحيح. ولا أخفي أنه كان جديدًا بالنسبة لي على المستوى الشخصي، بل وغريبًا كل الغرابة أن تكون معاناة المتهم ومحاميه على النحو الذي بسطه المؤلف في بلد كفرنسا بالذات ومنذ أكثر من قرن من الزمان.
وربما كانت تجربة المؤلف كمحام هي التي حملته على العناية بتسليط الضوء على أسباب أخطاء القضاء أكثر من عنايته بتحديد فكرة الخطأ القضائي ذاته مع أنه موضوع هذا الكتاب. والمعلوم أن خطأ القضاء من حيث محله نوعان، فقد يكون خطأ في تحصيل وقائع الدعوى، أو في تأويل القانون وتطبيقه، أو في الأمرين معًا. فالمعروف أن عمل القاضي له طبيعة مزدوجة، فهو يبحث أولًا عن حقيقة الواقعة المتنازع فيها، ثم يُنزل بعد ذلك حكم القانون عليها، وخطؤه وارد في الحالين. وهذا التحليل ليس جديدًا، بل هو من البديهيات المسلَّـمات. وقد أشار إليه فقهاء الشريعة الإسلامية من قرون، فقد اشترطوا فيمن يتولى القضاء شروطًا، منها العلم بالأحكام الشرعية والفطنة.
ويذكر ابن القيم أن إياسًا، وهو من مشاهير القضاة، لما وُلي القضاء بالبصرة طار صيته في الآفاق حتى جاءه الناس يطلبون منه أن يعلمهم القضاء، فكان يجيبهم: إن القضاء لا يُعلَّم، إنما القضاء فهم، ولكن قولوا: علـمنا العلم (الطرق الحكمية ص40). وشرط الفهم -بالنسبة للقاضي- بالغ الأهمية، فليس القضاء مجرد بيان للحكم الشرعي، وإنما هو حكم شرعي مطبق على واقعة حال. فإذا قصر ذكاء القاضي عن فهم الواقعة أو النازلة، فلا جدوى من إحاطته علمًا بالحكم الشرعي، لأنه ينزله عندئذ غير منزله ويضعه في غير موضعه. وهذا ما عناه عمر بن الخطاب حين كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه المشهور: الفهمَ الفهمَ فيما أُدلي إليك. ويقول ابن القيم في بيان ذلك: إن القاضي إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات وكليات الأحكام أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكوّن فيه اعتمادًا على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله (الطرق الحكمية ص5). ويقول أيضًا إن القاضي لا يتمكن من الحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يُحيط به علمًا، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع (إعلام الموقعين ص77-78).
(أ) وقد اقتصر المؤلف في الكتاب الذي نُقدِّم له على أحد نوعي الخطأ القضائي، وهو الخطأ في تحصيل الواقع، ربما لأنه الأكثر شيوعًا من جهة، وأنه الأشد خطرًا من جهة أخرى، ذلك بأن المفترض في القاضي -بحكم تخصصه القانوني وانقطاعه للعمل القضائي وتمرسه به- أنه على دراية كافية بأحكام القانون وذو خبرة بتطبيقه على وقائع الأحوال، فضلًا عن أن رقابة محكمة النقض على ما يصدر من أحكام -وهي رقابة قانونية- كفيلة بجبر ما قد يقع فيها من خطأ في القانون. ولهذا فالمفروض أن الأخطاء القانونية في أحكام القضاء هي -من الناحية العملية- محدودة من حيث العدد والأهمية. أما «الواقع» فأمره مشكل؛ لأن موضوع الدعوى الجنائية ليس هو الواقع «القائم»، بل الواقع «الذي كان».
يُحكى أن الملك هنري الرابع بعد أن استمع في مجلسه إلى مناجزة خطابية بين محاميين كبيرين فكر مليًّا ثم قال: يا إلهي، كلاهما على حق! ويُروى أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعنّى عليهما فإن كلا منهما يريدني عن ديني.
ولكي ينزل القاضي حكم القانون على موضوع الدعوى تنزيلًا صحيحًا فعليه أن يسترجع الماضي، أى يستعيده. وقد تكون وقائع هذا الماضي قريبة العهد لم يمض عليها غير أسابيع أو شهور، وقد يطول عليها الأمد فتكون قد حدثت من سنوات. واستعادة الماضي على حقيقته ليس بالأمر اليسير، سواء كان هذا الماضي بعيدًا أو قريبًا؛ لأن هذا يقتضي إزاحة الحجُب عن واقع أدبر وتولى وطويت صفحته، ولا يقل الماضي في كثير من الأحيان خفاء وغموضًا عن المستقبل، لا سيما أن القاضي لم يشهده، بل يجب ألا يكون من شهوده، وإلا امتنع عليه قانونًا نظر الدعوى والفصل فيها. واستعادة الماضي تغدو أشد عسرًا حين يكون القاضي ملزمًا إذا جنح إلى القضاء بالإدانة بأن يَبين من حكمه أن الواقعة ثبتت لديه على سبيل الجزم واليقين، لا من باب غلبة الظن أو على سبيل الترجيح، وإلا كان حكمه عرضة للإلغاء من جانب محكمة النقض. ومما يزيد الأمر عسرًا أن تكون عمدة القاضي في استعادة ذلك الماضي هي ما يقدمه إليه خصوم متشاكسون ينفي بعضهم ما يدعيه البعض، ويقدم كل منهم للقاضي إثباتًا لصحة دعواه ما ينقض أدلة خصمه ويبطل دعواه. ولهذا يُحكى أن الملك هنري الرابع بعد أن استمع في مجلسه إلى مناجزة خطابية بين محاميين كبيرين فكر مليًّا ثم قال: يا إلهي، كلاهما على حق! ويُروى أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعنّى عليهما فإن كلا منهما يريدني عن ديني.
ولما كان الخطأ في الحكم واردًا على كل قاض، فقد جرت سنة معظم فقهاء الشريعة الذين كتبوا في القضاء على استهلال الموضوع بالتساؤل عما إذا كان من المستحب الدخول فيه أو تركه والتنزه عنه، واختلف الرأي في ذلك. غير أن الثابت أنه تولاه قوم صالحون وأبى الدخول فيه قوم صالحون. وقد عُرض القضاء على بعض كبار الأئمة فاعتذروا وآثروا ألا يلوه، وامتُحن بعضهم امتحانًا شديدًا ونُكـّل به لهذا السبب. وتروي كتب الفقه وتراجم القضاة في هذا المقام طرائف، منها أن أحد الفقهاء الورعين طـُلب للقضاء فتجانّ وتحامق وركب قصبة وتبعه الصبيان، وأن آخر أُرسل إليه ليتولى القضاء فكحّل عينيه وجزّ لحيته، فلما دخل على الوالي صاح: هذا مجنون، أخرجوه! وقال بعض الصالحين: إذا ولي الرجل القضاء، فليجعل للقضاء يومًا وللبكاء يومًا. ورُوي أن أحد الصالحين ولي القضاء فهجره بعض خُلصائه، ثم اضطـُر أحدهم إلى الدخول عليه في شهادة، فلما أدّاها ضرب على كتفه وقال: يا إسماعيل، علـم أجلسك هذا المجلس كان الجهل خيرًا منه؛ فوضع القاضي رداءه على وجهه وبكى حتى بلَّه. وقال أحد الصالحين: ما وليت القضاء حتى حلَّت لي الميتة. وقيل لأحد الصالحين: لو وليت قضاء المسلمين كان لك بذلك أجر، قال: يا أيوب، السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح!
ويمكن تقسيم الخطأ القضائي كذلك من حيث مدى مسئولية القاضي عنه إلى خطأ شخصى أو ذاتى وخطأ موضوعى. فأما الأول فنقصد به الخطأ الذي يُسأل القاضي عنه، وهو الانحراف بحكمه عن القضاء الواجب، وأما الثانى فنقصد به عدم إصابته الحق أو الحقيقة أيا كان السبب. والخطأ الثانى أكثر سعة من الأول، فهو يتسع له دائما ويتسع عنه أحيانا. ذلك أن تجنب الخطأ الأول مقدور عليه من جانب القاضي، إذ لا يخلو وقوعه فيه أن يكون على وجه العمد أو التقصير، ومن ثم كان هذا الخطأ موجبًا للذم أو للوم. أما الخطأ الثاني فقد يخلو من العذر أو يقترن به. وإذا خلا من العذر تطابق الخطآن، وإذا اقترن به افترقا. وعند التطابق يكون القاضي جديرًا باللوم والمؤاخذة، ولا يكون كذلك عند الافتراق، وإن كان الخطأ في الحالين قادحًا في عدالة الحكم، وواجبًا دفعه قبل أن يقع ورفعه إذا وقع.
(ب) والتفرقة بين نوعي الخطأ دقيقة، لكنها لازمة. وقد غفل عنها مؤلف الكتاب الذي نُقدِّم له، إذ يبين من معالجته لموضوعه أنه يكاد يحمّل القضاة تبعة كل ما يقع في أحكامهم من أخطاء. غير أن الإنصاف مع ذلك يقتضي الاعتراف بأن مؤلف الكتاب لا ينفرد وحده بما ذهب إليه؛ لأن جمهور الفقهاء، بل والعامة أيضًا ينسبون كل خطأ في الحكم إلى القاضي الذي أصدره، معذورًا كان أو غير معذور.
وجدير بالذكر أن فقهاء الشريعة عرضوا لهذه المسألة بمناسبة تناولهم للحديث النبوي الذي أشرنا إليه والذي استهله ﷺ بقوله: إنما أنا بشر مثلكم؛ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى تنزيه الرسول عن الخطأ في قضائه، استنادًا إلى ما اتفق عليه الأصوليون من أنه لا يُقَر على خطأ. وردَّ البعض على ذلك بأنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ لأن مرادهم: فيما حكم فيه باجتهاده، أما إذا حكم بما يخالف ظاهره باطنه فإنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا. فإذا كانا شاهدي زور ونحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما، أما الحاكم (أي القاضي) فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد (شرح الزرقاني على موطأ مالك حـ3، ص385).
وهذا الدفاع مقبول على شرط الفقيه الذي أبداه؛ فهو يصرف صحة الحكم القضائي إلى مطابقته لأصول الإثبات، وليس هذا ما نقصد إليه، فهذا هو العدل الشكلي. وإذا كان هذا العدل مطلوبًا فلأنه يؤدي غالبًا إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. غير أن هذا لا يطـّرد في كل حال، ولهذا فنحن لا نعتبر الخطأ هنا مقابلًا لصحة الحكم، بل نعتبره مقابلًا للصواب. وليس بمستبعد أن يكون الحكم صحيحًا في شكله لكنه غير مصيب في قضائه. وقد اتفق الفقهاء على أن مثل هذا الحكم إن كان يصح قضاءً فإنه لايصح ديانة؛ لأنه لم يُحقق جوهر العدل. وهذا ما عناه الرسول حين حذر في الحديث من قضى له على خصمه من أن ينفذ الحكم ويأخذ ما قضى له به.
وقد افترض ﷺ إمكان وقوع هذا النوع من الخطأ منه، أي إمكان تحرّيه هو نفسه الواقع دون إصابة حقيقته. ألا تراه يقول: إنما أنا بشر مثلكم!، ويقول: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار. فكيف يكون الحكم صوابًا وهو ينهى المحكوم له عن تنفيذه! والحق أن عصمة الرسول لا تشمل كل ما يصدر عنه من قول أو فعل، بل تنحصر فيما يبلغ عن ربه، سواء كان تكليفًا أو مجرد خبر. وفيما خلا ذلك فهو -كما صرح- بشر مثلنا يُصيب ويُخطئ، وليس في هذا ما يُنقص من قدره، بل هو ما يستقيم مع بشريته. وحول هذا الحديث يقول شيخنا محمد أبو زهرة: "إن القضاء ليس تشريعًا، ولكنه تطبيق للمبادئ المقررة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وفرقٌ بين التطبيق والتشريع، فالنبي في التطبيق يعمل عمل البشر من الاستماع للبينات، وفي الشريعة المطبقة يتلقى من السماء ويُبلغ أهل الأرض، وفرق ما بين الأمرين عظيم". (تاريخ المذاهب الفقهية ص11).
على أن إمكان ورود الخطأ على القاضي- ولو كان نبيًّا- في تحري حقيقة الواقع الذي يبني عليه قضاؤه لا يعني بالضرورة أنه مخطئ فيه، وإن كان ذلك لا ينفي أن الحكم نفسه خاطئ، بمعنى أنه مجانب للعدل لابتنائه على ما يخالف حقيقة الواقع. ويحدث ذلك حين يكون القاضي ملزمًا باتباع طرق إثبات معينة في تحري هذا الواقع، ومأمورًا بالأخذ بها وإعمال مقتضاها عند وجودها مستوفية شروطها، وذلك ببناء الحكم عليها. ويقع ذلك أيضًا إذا كان القانون يُخوِّل القاضي سلطة الحكم في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بناء على الأدلة التي تطرح أمامه في الجلسة، وهو ما تنص عليه معظم التشريعات المعاصرة. فإذا تبين بعد ذلك أن أدلة الثبوت التي بنى الحكم عليها كانت غير صحيحة، بأن ثبت أن الشهود قد شهدوا زورًا، أو أن الدليل الكتابي الذي عوَّل عليه القاضي كان مزورًا، أو أن الشخص الذي ادُّعي قتله ظهر بعد الحكم حيَّا، فإن الحكم بالإدانة يكون مخطئًا، أما القاضي الذي أصدره فلا ينسب إليه خطأ بالمرة؛ لأنه استفرغ الجهد وبذل ما في طوقه لإدراك الحقيقة وإن لم يصبها. وهنا ينتفي التطابق بين خطأ الحكم وخطأ القاضي، إذ لا يلزم من ثبوت الأول ثبوت الثاني.
ولا يختلف الأمر في رأينا لو أن خطأ القاضي لم ينصب على حقيقة الواقع، بل انصب على الحكم الواجب تنزيله على هذا الواقع بفرض صحة الواقع، وذلك بشرطين: أحدهما ألا يكون القاضي في هذه الحالة نبيًّا موحى إليه، أو مبلغًا عن ربه، والثاني: أن يكون الحكم الذي طبقه القاضي في محل الاجتهاد والقاضي من أهله، سواء وافقه في رأيه المجتهدون الآخرون أو خالفوه، وذلك عملًا برأي المصوّبة الذين قالوا إن كل صورة لا نص فيها ليس لها حكم معين عند الله، بل ذلك تابع لظن المجتهد.
ولا يقتصر ما ذكرناه على اجتهاد القاضي في الأحكام الشرعية، بل ينصرف كذلك إلى اجتهاد القاضي المعاصر في تأويل نصوص القوانين الوضعية وتطبيقها. فقد يجتهد القاضي في تأويل بعض هذه النصوص ملتزمًا في ذلك أصول التفسير المتعارف عليها، ويبني حكمه في الواقعة التي فصل فيها على مقتضى هذا التأويل، ثم يُطعن في حكمه بطريق النقض فتختلف محكمة النقض معه وتؤول النص على وجه آخر ثم تنقض حكمه. وفي هذه الحالة يكون حكمه معيبًا لخطئه في تأويل القانون، لكن من أصدر هذا الحكم لا يكون -في رأينا- مخطئًا، بل يظل مصيبًا، وإن جاز القول بأن تأويل النقض أصوب. آية ذلك أن محكمة النقض نفسها قد يستقر قضاؤها زمنًا على تأويل بعض النصوص على وجه معين، وتجري محاكم الموضوع على مذهبها فتطبق النص على هذا الوجه، ثم يتراءى لمحكمة النقض العدول من بعد عما استقر عليه قضاؤها، فتؤول النص -بمناسبة فصلها في أحد الطعون- على وجه آخر.
وفي هذه الحالة تنقض الحكم المعروض عليها وكذلك الأحكام المماثلة المطعون فيها أمامها لخطئها في تأويل القانون وتطبيقه رغم التزامها جميعًا برأي محكمة النقض الأول. ولا ينبغي في هذه الأحوال رمي القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام بأنهم أخطأوا في تأويل القانون؛ لأن تأويلهم إياه عند إصدارها لم يكن خاطئًا، بل كان صحيحًا، إذ لم يكن في وسعهم القضاء بخلافه. ويمتنع عقلًا أن يكون القاضي غير مخطئ قانونًا عند إصداره الحكم ثم يوصم بالخطأ فيه بعد إصداره وعند نظر الطعن فيه. بل إن الأحكام السابقة التي اعتنقت رأي النقض الأول وصارت باتة تظل -في رأينا- صحيحة قانونًا ولو كانت قاضية بالإدانة، وكان من شأن الرأي الجديد لمحكمة النقض أن يقضي فيها بالبراءة. وهذا تأويل قول الخليفة عمر في حالة مماثلة: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي.
(جـ) ويلفت النظر كذلك أن المؤلف خلط بين الخطأ القضائي والسياسة التشريعية، فحمّل القضاء والقضاة تبعة ما اعتبره قصورًا أو خللًا في السياسة التشريعية وعدّ ذلك من أخطاء القضاء. وعلى سبيل المثال فقد قارن بين الإثبات في المواد المدنية ونظيره في المواد الجنائية وخلص إلى أن القانون يكفل للمال حماية تفوق تلك التي يكفلها لحياة الأشخاص وحرياتهم وشرفهم. واستدل المؤلف على ذلك بأن القانون المدني يشترط في الدعاوى المدنية لصحة الحكم للمدعي الدائن بما طلب وجود دليل كتابي يثبت حقه إذا زادت قيمة الدين عن مبلغ معين. أما إذا لم يكن معه هذا الدليل وكان المدعي عليه منكرًا ما ادعاه، فلا سبيل إلى الحكم للدائن بما طلب ولو أشهد على صحة دعواه عشرات الشهود.
لا ينبغي أن تُترك للقاضي الحرية المطلقة في التعويل في إدانة المتهم على الشهادة وحدها، وأنه لا يصح أن تكون عنصرًا من عناصر الاقتناع إلا إذا قلبت على جميع قواعد علم النفس.
أما القانون الجنائي فقد خلا من نصوص صريحة تتعلق بعدد الشهود الذين يصح الحكم بالإدانة بناء على أقوالهم أو تشترط فيهم شروطًا تتعلق بصفاتهم أو أحوالهم. ولهذا فالشهادة الصادرة من امرأة أو من طفل أو من المجني عليه أو من شخص مصاب بمرض عصبي أو من شخص تلطخت صفحته بما يشينه ويعف اللسان عن ذكره- هذه الشهادة كفيلة اليوم بإدانة المتهم والحكم عليه بأغلظ العقوبات. وأورد المؤلف في كتابه أسبابًا كثيرة تنال من صدق الشهادة وتُثبت خطورة التعويل عليها في إدانة المتهم، ووثق ذلك بعديد من القضايا التي دين فيها المتهمون بناء على شهادة ثبت من بعد عدم صحتها ولكن بعد أن أُلقي المحكوم عليهم في غياهب السجون وأمضوا فيها سنين عددًا. وخلص المؤلف إلى أنه لا ينبغي أن تُترك للقاضي الحرية المطلقة في التعويل في إدانة المتهم على الشهادة وحدها، وأنه لا يصح أن تكون عنصرًا من عناصر الاقتناع إلا إذا قلبت على جميع قواعد علم النفس، وأنه يتعين على سلطة التحقيق الابتدائي أن تُبادر بفحص الشهود طبيًّا متى طـُلب منها ذلك ما دامت الشهادة هي الدليل الوحيد الذي سيبني عليه الاتهام، وعلى الأخص إذا كان الشاهد واحدًا.
ورأي المؤلف قريب من ذلك بالنسبة للخبير الذي يندبه القضاء لإبداء الرأي في بعض المسائل الفنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى؛ فقد لاحظ أن القانون المدني -فيما يتعلق بالأموال أو بأهلية الأشخاص- عُني بوضع قيد مؤداه أنه لا يجوز تحرير التقرير الفني إلا بمعرفة ثلاثة من الخبراء، ما لم يتفق الطرفان المتقاضيان على الاكتفاء بخبير واحد، ونص القانون كذلك على أنه إذا لم تتضح للمحكمة حقيقة المسألة من التقرير المقدم منهم جاز لها أن تستبدل بهم آخرين. ويرى المؤلف أن خبير الدعوى هو بمثابة قاض له السلطة المطلقة في حدود المسألة التي طُلب منه إبداء الرأي فيها، وكان ينبغي -لهذا السبب أن يتضمن القانون الجنائي نصًّا مماثلًا لنص القانون المدني، وذلك لتعلق الدعوى الجنائية بحرية الإنسان أو بشرفه أو بحياته. لكن القانون الجنائي خلو مما يلزم سلطة التحقيق بتعيين ثلاثة خبراء، أو إجابة المتهم إذا طلب ندب خبرة ثانية إذا لم يرتض تقرير الخبرة الأولى. وعرض المؤلف عديدًا من القضايا التي وقع القضاء الجنائي فيها في أخطاء فادحة نتيجة تعويله على تقرير الخبير الفرد، ثم ثبت بعد ذلك خطؤه.
وإذا كان صحيحًا أن السياسة التشريعية غير الموفقة تُفضي عند التطبيق إلى نتائج سيئة على نحو ما أوضحه المؤلف ووثقه بعديد من الأحكام التي صدرت في قضايا بعضها مشهورة، فمن التجني مع ذلك تحميل القضاء تبعة هذه النتائج وإضافتها إلى مجموعة الأخطاء القضائية التي تُحسب عليه، وذلك لما هو معلوم من أن دور القضاء ينحصر في تطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، وليس من شأنه وضع هذه القوانين ولا تعديلها، بل إنه لا يؤخذ رأيه فيها قبل إصدارها، كما أنه لا يملك الامتناع عن تطبيق ما قد يراه البعض ظالمًا منها. وأقصى ما يسع القضاء عمله بالنسبة لهذه القوانين إذا قضى بالإدانة بناء عليها أن يستعمل الرأفة مع المتهم فيخفف عقوبته. ولهذا فعلى من يرى في بعض القوانين قصورًا ينطوي على غبن للمتهم أو يرى فيها حيفًا عليه، أن يدعو المشرع إلى جبر قصور هذه القوانين بما يرفع الغبن أو تعديلها بما يُزيل الحيف، لا أن يوجه سهام النقد إلى القضاء باعتباره المسؤول عن النتائج الشاذة التي يُسفر عنها تطبيق هذه القوانين.
أهم الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ القضائي
بعد أن فرغ المؤلف في الباب الأول من تحديد مفهوم الخطأ القضائي أخذ في الأبواب التالية في الحديث تفصيلًا عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوع القاضي في هذا الخطأ. وقد أحسن صنعًا إذ استهل هذه الأسباب بالقاضي نفسه. ولا شك أن كل أسباب الخطأ لا تُحدث أثرها إلا حين يستجيب القاضي لها، سواء بوعي أو بغير وعي. ولم يقصد المؤلف بحديثه عن القاضي في الباب الثاني هذا المعنى، بل قصد -تحديدًا- الأسباب التي ترجع إلى شخص القاضي نفسه. وركَّز المؤلف على صفات إذا توافرت في القاضي قلّ إلى حد كبير ما يقع في قضائه من أخطاء. وجعل على رأس هذه الصفات صفتين، هما الحياد والعلم. أما الصفات الأخرى كالذكاء والبداهة والروية والصلابة في الحق وسلامة الذوق والرصانة واللين والشدة كل في موطنه، فهي -على لزومها- أقل أهمية في رأيه.
ولا يقصد المؤلف بالعلم في هذا المقام العلم بأحكام القانون، فهذا العلم مفترض في كل قاض، وإنما هو يقصد به الإلمام بأطراف من العلوم الإنسانية التي لا يُعذر القاضي المعاصر بجهلها، ومنها علم النفس والمنطق والطب الشرعي وعلم الاجتماع والتاريخ وكذلك الفن والأدب، وذلك لأن القضايا المعاصرة لم يعد لها الطابع القانوني الصرف الذي كان لها فيما مضى، بل إنها أصبحت تُثير البحث في مسائل علمية وطبية ومالية وفنية، وأصبحت هذه المسائل تكاد تغلب في بعض القضايا على المسائل القانونية، فوجب أن يكون للقاضي حظ من تلك العلوم بقدر يُمكِّنه من وزن أقوال الشهود وتقارير الخبراء والمفاضلة بينها إذا تعددت واختلفت بوصفه صاحب القول الفصل في هذا الشأن وخبير الخبراء كما يقال.
أما حياد القاضي فلعله أكثر الصفات ارتباطًا بالخطأ القضائي. ويُقصد بحياد القاضي تجرده وتحرره من الهوى سواء عند تحقيق الدعوى أو عند الحكم فيها؛ لأن الهوى أحد آفتي القضاء، أما الآفة الأخرى فهي الجهل. قال تعالى مخاطبًا نبيه داود عليه السلام: [يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحـق ولا تتبع الهوى فيضلك عن ســبيل الله] (سورة ص الآية 26). وكما أن من يجهل الحق لا يمكنه الحكم به، فكذلك من يغلبه الهوى لا يحكم بالحق ولو كان عالمًا به. وحياد القاضي ضمانة للخصوم؛ لأن ميزان العدل لا يستقيم في يد منحازة. ولا خلاف في أن حياد القاضي يفترض استقلاله، إذ يتعذر على من فقد استقلاله أن يتمسك تمامًا بحياده. لكن الاستقلال -بمعنى التحرر من السلطتين التشريعية والتنفيذية- لا يؤدي بالضرورة إلى كفالة حياد القاضي؛ لأن أسباب الانحياز لا تنحصر فيما يصدر عن هاتين السلطتين، بل تتسع لكثير غيرها. وقد تكون هذه الأسباب عامة أو خاصة. على أن أسباب الانحياز على اختلاف صورها تدور حول محور واحد، هو المصلحة، سواء تمثلت في جلب منفعة عاجلة أو مرجوة للقاضي أو لغيره، أو في دفع مضرة قائمة أو محتملة عنه أو عن غيره.
ولا يشترط للقول باختلال حياد القاضي أن يباشر في الدعوى إجراء يفصح بالفعل عن انحيازه، بل يكفي أن يُظن به ذلك، وأن يكون هذا الظن قائمًا على واقع يسوّغه. وليس في هذا الظن مساس بكرامة القضاء وهيبته، بل هو أحفظ لهما؛ لأن الحياد -وهو من مقومات القضاء- لا يتحقق بمجرد ثقة القاضي في نفسه واطمئنانه إلى قدرته على الصمود لما قد يحوطه من ضغوط، والتسامي على ما قد تجيش به نفسه من عواطف ومشاعر. وإنما يتحقق الحياد أساسًا حين يعتقد الناس في قضاتهم ذلك. فحياد القاضي ليس مجرد اعتقاد ذاتي يعتقده ولا موقف يقفه، ولكنه في المقام الأول اطمئنان الغير إليه واعتقادهم -هم- في حياده. والقضاء إنما يكون محايدًا بقدر ما يظن الناس فيه، لا بقدر ما يظنه القضاة في أنفسهم.
وقد حرص القانون -دفعًا لمظنة الانحياز- على أن ينأى بالقضاة عن مواطن الشبهة، إلى حد حرمانهم من مباشرة وجوه من النشاط تبدو الصلة بينها وبين الدعاوى التي ينظرونها شبه منبّتة. من ذلك أنه حظر عليهم ممارسة التجارة أو الاشتغال بالسياسة، مخافة أن يكون لأي من الأمرين عليهم تأثير-ولو خفي- يُخلّ بحيادهم في داخل نفوسهم، فضلًا عما قد يُثيره لدى الآخرين من شبهات فيهم.
وإذ تجاوزنا عن وجوه النشاط التي حظرها القانون على القضاة لما فيها من تعارض مع عمل القضاء بوجه عام، فإن الأسباب الحقيقية التي تقدح في حياد القاضي بالنسبة إلى دعوى معينة وتقتضي كفه عن نظرها تنقسم إلى طائفتين: طائفة تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى بقوة القانون، وطائفة تجعله كذلك ولكن بإرادة الخصوم إذا أعربوا هم أنفسهم عن عدم اطمئنانهم إلى حياده وطلبوا رده. وتلحق بهاتين الطائفتين حالة أجاز فيها القانون للقاضي -وإن لم يقم به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد- أن يطلب من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا استشعر الحرج من نظرها لأي سبب.
على أن مظنة انحياز القاضي في الحالات التي يُقرر القانون فيها عدم صلاحيته لنظر الدعوى أو التي يُجيز للخصوم فيها رده، وكذلك الحالات التي يستشعر القاضي فيها الحرج فيتنحى عن نظر الدعوى -هذه الحالات ليست من الكثرة بحيث يمكن تحميلها- عند عدم التزام القضاة بأحكام القانون المقررة بشأنها- تبعة جانب ذي بال من أخطاء القضاء. وإنما يحمل تبعة معظم هذه الأخطاء ما يمكن أن يطلق عليه الانحياز الخفي للقضاة. ونعني بذلك الانحياز الذي يستسلم له القاضي دون أن يقصد، وأحيانًا دون أن يدري، ومن ثَمَّ فهو انحياز بحسن نية في أغلب الأحوال.
وقد أسهب المؤلف في هذا الباب -ولعله في رأينا أهم الأبواب- في بيان أسباب هذا الانحياز، وحرص فيه على تحليل شخصية القاضي ومدى تأثره نفسيًّا بطبيعة عمله، وبعلاقته الوظيفية بسلطة التحقيق والاتهام، وبما يحوطه كإنسان من ظروف تؤثر فيه مدًّا وجزرًا لدى نظره وفصله فيما لديه من دعاوى، وأهم من ذلك كله بما يُخوِّله القانون له من سلطة بالغة السعة في تقدير أدلة الدعوى والحكم فيها. ولا شك أن تجربة المؤلف كمحام مكنته من أن يضع يده بدقة بالغة على أسباب الانحياز الخفي للقاضي، وهو الذي يحمل تبعة معظم ما يقع فيه القضاة من أخطاء.
إن المرء ليجد أحكامه في بداية تولـيه القضاء أميل ما تكون إلى التسامح، لكن سرعان ما يعود إليه من قضى من قبل ببراءتهم أو حكم عليهم بعقوبة مخففة فيسمع منهم من وجوه الدفاع ما سبق له سماعه، فيرى أنه يكون أبله أو ساذجًا لو صدقهم.
وقد بدأ المؤلف بتحليل شخصية القاضي ورأى أن الحالة العقلية للإنسان تتغير بتأثير العمل الذي يزاوله، وأن القاضي يكتسب بحكم الاعتياد والسرعة في إصدار الأحكام خبرة تامة بالأشخاص والأشياء، ولكنه في مقابل ذلك تتولد في نفسه النزعة إلى اعتبار كل منهم مجرمًا. ويقول إن القاضي لدى جلوسه أول مرة على منصة القضاء يكون إنسانًا يفيض قلبه بأشرف النيات وأحسن المقاصد، فهو عند التحقيق أو أثناء انعقاد الجلسة يُصيخ بسمعه لأقوال المتهم، ولا يجد في نفسه ما يحول دون تصديقه، بل يميل إلى الرحمة به والعطف عليه، وإن المرء ليجد أحكامه في بداية تولـيه القضاء أميل ما تكون إلى التسامح، لكن سرعان ما يعود إليه من قضى من قبل ببراءتهم أو حكم عليهم بعقوبة مخففة فيسمع منهم من وجوه الدفاع ما سبق له سماعه، فيرى أنه يكون أبله أو ساذجًا لو صدقهم، ومن ثَمَّ ينتقل من النقيض إلى نقيضه، أي من التفريط في العقاب إلى الإفراط فيه، ولا يسلِّم بما يقال أمامه ولو كان صدقًا، إلا أن تكون البراءة ساطعة ناصعة لا تشوبها شائبة.
غير أن المؤلف يبالغ مع ذلك في تأثير طبيعة عمل القاضي على شخصيته، إذ لم يكتف بأنها تُرسخ في نفسه سوء الظن بالآخرين عمومًا، والاعتقاد بأن معلوماتهم تحوطها الريب والشكوك، بل تجاوز ذلك إلى القول باعتقاده أنه معصوم من الخطأ وأنه لم يقع قط فيه، ولا يمكن أن يقع يومًا في وهدته. ويُعلل المؤلف ذلك بأن الإنسان مدفوع بغريزته إلى الدفاع عن الخطأ الذي يقترفه دفاعًا لا يُشبهه في شدته وصلابته سوى دفاع الأم عن صغارها لدرء خطر يوشك أن يحل بهم تحت بصرها. وهذا الرأي - في غالب ظننا- مبناه في أحسن الفروض حالات فردية صادفها المؤلف، لكنه لا يصلح أن يكون حكمًا عامًّا. وعلى أي حال فهذا الرأي حتى لو ثبتت صحته لا علاقة له بموضوع الخطأ القضائي.
ويرى المؤلف أن الأخطاء القضائية في الجنح أكثر عددًا؛ لأن تراكم القضايا أمام المحكمة والسرعة التي يجب أن يتم بها الفصل فيها، مع عدم جسامة العقوبة المقررة لهذه الطائفة من الجرائم، وكذلك جهل المتهم غالبًا بحقوقه واضطرار محاميه إلى التعجل بالمرافعة والاقتصاد بها حتى لا يُثير غضب القاضي المثقل بعدد ضخم من القضايا في الجلسة، واعتماد القضاة في العادة على تحريات الشرطة- كل ذلك مما يُرجح وقوع أحكام قضاة الجنح في كثير من الأخطاء القضائية.
الأفكار المسبقة وأخطاء القضاء
يرى المؤلف بحق أن أغلب وأخطر ما يُخلّ بحياد القاضي ويوقعه في الأخطاء القضائية هي الأفكار المسبقة التي تُهيمن عليه دون أن يقصد، بل دون أن يدري. فالمفروض في القاضي عند اتصاله بالدعوى أن يكون في حالة حياد تام، أي متجردًا من أي رأي فيها، سواء ضد المتهم أو في مصلحته. بل الأصل أن المتهم تصحبه -دستوريًّا- قرينة البراءة إلى أن يدرس القاضي أوراق الدعوى ويُحققها ويسمع وجهتي نظر الاتهام والدفاع ويوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، ثم يتداول بعد ذلك مع نفسه إن كان قاضيًا فردًا، أو مع زملائه إن كانت المحكمة هيئة مكونة من ثلاثة قضاة أو أكثر، ثم يصدر الحكم في النهاية سواء بالبراءة أو بالإدانة. غير أن هذا الكلام نظري إلى حد كبير، وهو لا يتحقق عملًا إلا في حالات نادرة، وهي التي تُرفع فيها الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر من جانب الطرف المضرور. أما إذا كانت النيابة العامة (أو قاضى التحقيق) هي التي رفعت الدعوى، وهو الأغلب الأعم لا سيما في الجنايات، وهي أخطر الجرائم، فإن الأمر يختلف؛ لأن القاضي يتكون لديه انطباع أول ضد المتهم منذ اللحظة التي يبدأ فيها في قراءة أوراق الدعوى، بل قبل أن يبدأ في قراءتها، وعلى وجه التحديد حين يهمّ بذلك.
والسبب في ذلك أن الدعوى تحقق عادة قبل رفعها. والتحقيق إذا كان جوازيًّا في الجنح -وهو مع ذلك يحدث غالبًا- فإنه وجوبي في الجنايات. وجهة التحقيق إذا اتصلت بالدعوى ورأت ما يدعو للانتقال إلى محل الواقعة، فإنها تنتقل إليه للمعاينة وقد تضبط ما ترى أنه يفيد التحقيق، ثم هي تسمع المجني عليه وشهود الواقعة، ولها أن تندب الخبراء إذا وجدت لذلك داعيًا، وتسمع أقوال المتهم وشهوده وتُحقِّق دفاعه. وإذا رأت في نهاية الأمر أن التهمة غير ثابتة وأن هناك سببًا يحول دون عقاب المتهم أو دون رفع الدعوى عليه أصدرت أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وإلا قدمته للمحاكمة. وإذا كانت الواقعة جناية فإن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لا تكون من عضو النيابة الذي حقق الدعوى، بل من رئيسه الأعلى، وهو المحامي العام. وهو يُحيله إلى محكمة الجنايات بقرار منه يشتمل على بيان التهمة تفصيلًا، ويحدد مواد القانون التي تعاقب عليها، ويرفق بقرار الإحالة هذا قائمة بأدلة الثبوت.
والمعلوم أن عضو النيابة الذي يُحقق الدعوى، والمحامي العام الذي يأمر بإحالتها (وكذلك قاضي التحقيق إذا كان هو الذي حقق الدعوى وأمر بإحالتها)- هؤلاء جميعًا أعضاء في ذات الهيئة التي ينتمي إليها القاضي الذي تُحال إليه تلك الدعوى للفصل فيها، وهو يدرك جيدًا أن أيًّا منهم ليس بينه وبين المتهم ضغينة تجعله حريصًا على التجني عليه وعلى إدانته. وإذا كانت هذه هي الصورة التي تنطبع في نفس القاضي قبل أن يشرع في دراسة أوراق الدعوى وقبل أن يَمثُل المتهم أمامه في أول جلسة، فكيف يتوقع منصف أن يكون هذا القاضي عند نظر الدعوى في حالة حياد تام، وأن يظل كذلك في أثناء تحقيقها أمامه وفي أثناء المرافعة فيها!
وقد أشار المؤلف إلى التعاطف الطبيعي الذي يقوم بين القاضي الذي ينظر الدعوى وسلطة التحقيق والاتهام، وخلص إلى أنه من الطبيعي بشريًّا أن يقرّ في نفس هذا القاضي أن المتهم الذي تقرر إحالته إلى المحكمة لا بُدَّ أن يكون جانيًا. وهذا الاعتقاد ينعكس بطبيعة الحال على سلوكه في إدارة الدعوى مهما حاول التظاهر بالحياد. ويتجلى ذلك بوجه خاص -في رأى المؤلف- في الطريقة التي تتعامل بها المحكمة مع شهود الإثبات وشهود النفي، كما تتجلى في احتفائها باعتراف المتهم، لا سيما إذا كان اعترافه على نفسه وعلى غيره من المتهمين معه في نفس الجريمة.
ولا شك -من حيث المبدأ- أن مجرد إحالة المتهم إلى المحاكمة، سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل قاضي التحقيق، يؤدي عملًا وبصفة وقتية إلى نفي أصل البراءة المقرر بنص الدستور، سواء كان محل الاتهام جناية أو جنحة؛ لأن الإحالة في الأغلب الأعم إنما تكون بعد تحقيق، وبناء على أدلة ترى الجهة التي قررت الإحالة كفايتها للحكم بإدانة المتهم، ومن ثم فإن عبء الإثبات ينحط عن كاهل سلطة الاتهام ويُلقي عبء النفي على عاتق المتهم.
ولا شك كذلك في أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى ينشأ لديها -نتيجة هذه الإحالة- ميل إلى الاقتناع بإدانة المتهم بناء على الأدلة التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته الجهة المحيلة، وهي جهة قضائية. ومنشأ هذا الميل هو ما يقال عادة من أن النيابة العامة خصم شريف، وأنها حين تُحقق الدعوى فإنها تتحرى الحقيقة بكل ما أتاحه القانون لها من وسائل، سواء كانت نتيجة التحقيق ضد المتهم أو في مصلحته، بدليل أنها قد تصدر في نهاية التحقيق أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى ضده. بيد أن وصف النيابة العامة بأنها خصم شريف هو في رأينا غير دقيق، بل هو غير صحيح سواء من حيث المنطق المجرد أو من حيث الواقع المشاهد. أما من حيث المنطق؛ فلأن خصوم الدعوى يجب أن تتكافأ وسائلهم في إثبات ما يدعي كل منهم أنه حق له. أما حين يُسلط القانون خصمًا على خصمه فيخوله سلطة القبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه وتسجيل محادثاته الخاصة وضبط رسائله وبرقياته تمكينًا له من الحصول على دليل يقدمه ضده، فهذا لا يكون مجرد خصم، بل هو خصم وحكم، بل خصم وحاكم، ولا محل عندئذ ولا معنى لوصفه بأنه خصم شريف؛ لأنه -بالنظر إلى ما يزوّده به القانون من سلطات- ليس خصمًا أصلًا.
هذا من حيث المنطق، أما من حيث الواقع فقد دلت الخبرة العملية على أن الهِمّة التي تبديها النيابة العامة في البحث عن أدلة الإدانة لا تُبدي مثلها في التحري عن أدلة البراءة، وذلك لأن النيابة العامة تشعر في قرارة نفسها بأنها سلطة اتهام قبل أن تكون سلطة تحقيق. ولهذا فإن حماسها لسماع شهود النفي الذين يستشهد بهم المتهم لا يعدل احتفاءها بسماع شهود الإثبات. ويشكو المحامون من أن النيابة العامة كثيرًا ما تتغاضى عما يقدمونه إليها في أثناء التحقيق الذي تجريه من طلبات لسماع شهود نفي يحددونهم لها بأسمائهم ومحال إقامتهم، بل وأحيانًا يستحضرونهم إليها معهم، لكنها لا تستجيب لهم. وإذا ألحو على المحقق في طلبهم يرد عليهم بأن التحقيق انتهى أو كاد، وأن بوسعهم إعلان شهود النفي أو إحضارهم أمام المحكمة التي ستنظر الدعوى بعد إحالتها إليها. وهذا ظلم للمتهم وإخلال بحقه في الدفاع؛ لأن توقيت سماع شهود النفي لا يقل أهمية عن مضمون ما يشهدون به.
ومما يورده المؤلف دليلًا على هيمنة بعض الأفكار المسبقة على القضاة التي توقع الكثير منهم في الخطأ، اندفاعهم بالرغم منهم إلى اتخاذ الاتهام قاعدة يبنون عليها اقتناعهم. ومن مظاهر ذلك أنه يعتبرون أن ارتكاب الفعل قرينة على توافر العمد، وأنه يكفي النيابة العامة أن تثبت أن المتهم هو الذي ارتكب الفعل لكي يكون هذا دليلًا على تعمده، فلا يلزمها بعد ذلك إقامة الدليل على توافر القصد في جانبه، بل يتعين على المتهم أن يقيم هو الدليل على انتفاء العمد لديه. ومن مظاهر ذلك أيضًا ما ينتهجه القضاة في إدارة شؤون المرافعة وتوجيه الأسئلة للمتهمين والشهود. ويرى المؤلف أن طبيعة علاقة القاضي بالجهة التي قامت بتحقيق الدعوى، وكذلك بمأموري الضبط القضائي وغيرهم ممن لهم يد في توجيه الاتهام تُلقي في روعه أنه إن كذب أحدهم فإنه يمس بكرامته. ولهذا فإنه يتحرج عادة من اطراح أقواله.
ومن الأفكار المسبقة أيضًا لدى القضاة دلالة اعتراف المتهم، فهم يرون الاعتراف أحرى الأدلة بالقبول وأبعدها عن جواز المنازعة أو التشكيك فيه، مع أن الاعتراف لا يعدو أن يكون دليلًا لا يُرجح ما عداه من الأدلة. ويرى المؤلف أن القاضي يحتفي عادة باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين معه في الجريمة، مع أن الاعتراف ليس دائمًا مظهرًا للندم أو الرغبة في التطهر من الجرم باستعجال العقاب، بل إنه يصدر من المتهم في معظم الحالات نتيجة لبواعث أخرى، فقد يقصد به التستر على الفاعل الحقيقي لعلاقة خاصة تربطه به وتحمله على التضحية من أجله، وقد يعترف الشخص على نفسه -تضليلًا للعدالة- بارتكاب جنحة لم يقترفها للإفلات من عقوبة جناية خطيرة ارتكبها، وقد يعترف على نفسه كذبًا من باب التباهي والتفاخر وادعاء البطولة للفت الأنظار إليه، وقد يعترف على متهمين آخرين نكاية فيهم وكيْدًا لهم أو رغبة في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
ومن الأفكار المهيمنة كذلك الاعتقاد بأن أقوال شهود الإثبات التي يُدلون بها أمام القضاة أقرب إلى الصدق وأجدر بالقبول من أقوال شهود النفي. وينسب المؤلف إلى القضاة أنهم يستقبلون شهود الإثبات بصدور رحبة ويسمعون أقوالهم بالرعاية والتعاطف معهم، أما شهود النفي فلا يُحسنون استقبالهم، بل ينظرون إليهم بريبة واحتقار، وقد لا يُصغون إلى شهادتهم، وإذا أصغوا إليها علت وجوههم ابتسامة تُفصح عن معانٍ كثيرة. ويتساءل المؤلف عن علة التمييز بين الفريقين مع أن كلًّا منهما إنما يمثُل أمام المحكمة لإنارة الطريق أمامها وتمكينها من الوصول إلى الحقيقة. لكن المؤلف يغلو في هذا المقام غلوًّا شديدًا، إذ يتساءل عن السبب الذي يحمل القاضي على استبعاد شهادة شاهد والاعتداد بشهادة آخر، ثم يُجيب بأنه لا شك إنما يعمل منقادًا لغريزته ومندفعًا في تيار ميوله، إذ يكون الشغل الشاغل له إقامة الدليل على إدانة المتهم.
من الشهود المتميزين كذلك رجال السلطة العامة، وعلى الأخص رجال الشرطة حين يشهدون على ما أجروه من تحريات أو على ما قاموا به تنفيذًا لأوامر سلطة التحقيق من إجراءات.
ومن الأفكار المهيمنة كذلك في رأي المؤلف أن هناك شهودًا متميزين ينزلهم القضاء منزلة خاصة، منهم المجني عليه؛ فالقضاة أكثر ميلًا إلى إظهار التعاطف مع من وقعت عليه الجريمة، وهم أكثر تصديقًا له وأسرع أخذًا بأقواله، وكأن معاناة المرء للألم أو تكبده للضرر شهادة ناطقة بأمانته وعدم انحرافه عن جادة الصواب. ومن الشهود المتميزين كذلك -فيما يرى المؤلف- رجال السلطة العامة، وعلى الأخص رجال الشرطة حين يشهدون على ما أجروه من تحريات أو على ما قاموا به تنفيذًا لأوامر سلطة التحقيق من إجراءات. ويقول المؤلف إنه يبدو أن للزي الرسمي سرًّا يؤيد الاعتقاد بأن من يرتدونه هم على جانب وافر من الصدق والذكاء والعلم بأدق المسائل المتعلقة بأحوال النفس، وبأنهم في عداد المعصومين من الخطأ والخطل.
ويتحفظ المؤلف بشدة على ما تجري عليه أحكام القضاء من تسامح ملحوظ في التعويل في إدانة المتهمين على شهادة الشهود؛ وذلك لما يقترن بالشهادة من عوارض تقدح في معظم الأحيان في صدقها وتنفي مطابقتها دائمًا لحقيقة الواقع، ومن ثَمَّ فإن بناء الحكم عليها في معظم الأحوال لا يخلو من ظلم بيّن للمحكوم عليه. ويرى أنه يتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يتلقى الشهادة بالاحتياط والحذر، ولا يصح له أن يتخذها مصدرًا لاقتناعه إلا بعد أن يقلبها على جميع قواعد علم النفس.
ويعترض المؤلف بوجه خاص على شهادة النساء والصبية، ويدعو إلى مزيد من الحذر والاحتياط في التعويل عليها عند الحكم بالإدانة. وهو لا يكتفي في اعتراضه على شهادة أفراد هاتين الفئتين بالأسباب العامة التي تقدح في صحة الشهادة عمومًا، بل يبني اعتراضه كذلك على اعتبارات تتعلق بالمرأة كأنثى وبالصبية لطفولتهم. وخلاصة رأيه أن كلًّا منهما يميل بحكم تكوينه إلى الكذب. فالمرأة اعتادت -نتيجة تاريخ طويل من معاناة قهر الرجل لها وبطشه بها- إلى الدفاع عن نفسها بما يسمح به تكوينها، ويرى أن سبيلها إلى ذلك هو التظاهر بالضعف والكذب، هذا فضلًا عما خصت به من سرعة التأثر والانفعال بما يُلقى في روعها أو يوحى به إليها. ويقول المؤلف إن الهيستريا قلَّما تصيب الرجل، لكنها أكثر انتشارًا بين النساء، ومن أعراضها الميل الشديد للفت نظر الآخرين وإثارة اهتمامهم إلى حد أن المرأة لا ترى بأسًا من اتهام نفسها بارتكاب جريمة لا وجود لها إلا في مخيلتها، وهي إذا أدت شهادة كاذبة فليس من الضروري أن يكون الباعث عليها تحقيق مصلحة شخصية. وأورد المؤلف عديدًا من القضايا أدت فيها شهادات النساء الكاذبة إلى إدانة المتهمين ظلمًا.
أما بالنسبة للصبية فيرى المؤلف أن الطفل معروف بقوة الخيال والقدرة الفائقة على تأليف القصص واختراع الأكاذيب، والتظاهر بالأمانة والصدق في النقل والرواية، وينفي ما يقال عادة عن براءة الطفولة. والطفل عنده يُشبه المرأة الهستيرية في ميله الشديد إلى لفت انتباه الغير إليه وإثارة اهتمامه، وشدة التأثر والانفعال والانصياع لما يوحى إليه.
وعندنا أن ما ذكره المؤلف عن المرأة فيه تجنٍّ واضح. نعم قد يكون لتكوين المرأة من حيث هي أنثى تأثير من بعض الوجوه في سلوكها، وعلى الأخص في الحالات التي تعتريها كأنثى. لكن هذا بمجرده لا يبُرر على الإطلاق إصدار حكم عام بأنها تختلف عن الرجل كثيرًا في سلوكها وفي منظومة قيمها الاجتماعية، وأنها أدنى منه في هذا المجال. وإنما النساء كالرجال، فيهن من الفضائل والرذائل ما فيهم. وإذا كان الرجال يتفاوتون في مدى استقامتهم واعوجاجهم فكذلك النساء. ويؤخذ على المؤلف أنه يعتمد على حالات فردية ينتقيها ليستخلص منها أحكامًا عامة، وهذا منهج علمي غير سليم، بل هو في خصوص المرأة بالذات غير صحيح، فقد أثبتت الإحصاءات الجنائية في عامة الدول، المتقدمة منها والمتخلفة، أن إجرام المرأة دون إجرام الرجل، بل لقد دلَّت الإحصاءات على أن نسبة إجرامها إلى إجرامه تتراوح بين 7:1 و10:1، وتقل عن ذلك في عديد من الدول.
علاقة أخطاء القضاء بنظام الإثبات
أبدى المؤلف قلقه في عديد من المواضع من السلطة الواسعة التي يخولها القانون للقاضي في تحقيق الدعوى الجنائية وتقدير أدلتها، سواء كانت أدلة إثبات أو أدلة نفي. ودعا القضاة في أكثر من موضع إلى توخي الحذر في الأخذ ببعض الأدلة عند الحكم بالإدانة، كما دعا المشرع في بعض المواضع إلى الحد من سلطة القضاء التي تكاد تكون مطلقة في مجال الإثبات؛ لأن التجربة دلت على أن معظم أخطاء القضاء ترجع إلى ممارسة هذه السلطة، وهو ما يُنبئ عن العلاقة الوثيقة بين نظام الإثبات وأخطاء القضاء. وهذا صحيح إلى حد كبير. غير أن هذا لا يعني بالضرورة فساد نظام الإثبات الذي كان سائدًا في فرنسا وقت أن وضع المؤلف كتابه، وهو نظام الأدلة الإقناعية؛ فما زال هذا النظام معمولًا به فيها، وهو نفسه المعمول به في مصر حاليًا وفي النظم القانونية المعاصرة بوجه عام. على أن المؤلف مع ذلك مسّ وترًا حساسًا، وأثار مسألة هي على مستوى الفكر القانوني من المسائل المعضلة، ونعني نظام الإثبات الجنائي. ووجه الدقة في هذا الموضوع أنه إنساني في المقام الأول قبل أن يكون قانونيًّا؛ ذلك أن غاية الإثبات هي إدراك الحقيقة، وهي عصية المنال. وقد ذكرنا أن عمل القضاء الجنائي يتمثل في البحث عن حقيقة ما وقع قبل البحث عن بيان حكم القانون فيه. والمعلوم أن البحث في الأول أشد صعوبة من البحث في الثاني.
وقد عرف الفكر القانوني وكذلك التشريعات الوضعية عدة نظم للإثبات الجنائي، أهمها نظام الأدلة القانونية ونظام الأدلة الإقناعية. ويتميز النظام الأول بأن المشرع يُحدد فيه للقاضي الأدلة التي يصح له الاعتماد عليها عند الحكم بالإدانة، وكذلك شروط كل دليل وقوته القانونية؛ فإذا قام الدليل واستوفى شروطه التزم به القاضي ووجب عليه أن يحكم بالإدانة بناء عليه، ولو كان مقتنعًا في قرارة نفسه بغير مؤدى هذا الدليل. وإذا تخلف الدليل أو تخلفت بعض شروطه وجب الحكم بالبراءة ولو كان القاضي موقنًا من إدانة المتهم. ولهذا ساد في ظل هذا النظام القول بأن شهادة الواحد عدم، أي لا يعتد بها. وقام هذا النظام في بدايته على أساس من التجربة العملية، فالإنسان لا يطمئن في خطير الأمور إلى خبر الواحد، لكنه يزداد اقتناعًا إذا تواتر الخبر.
ومن هنا كان تعدد الشهود مدعاة لتصديق الشهادة، فكان اشتراط شاهدين على الأقل لصحة الإدانة. كذلك فقد علم الناس أن المرء لا يُقرّ على نفسه كذبًا بما يلحق به الضرر، فإذا اعترف الشخص مع ذلك على نفسه بارتكاب جريمة، كان اعترافه هذا أحظى بالثقة وأدعى إلى الاطمئنان، ووجب بناء حكم الإدانة عليه. ومن هذا يتضح أن نظام الأدلة القانونية لم يقم أساسًا على التحكم، بل كان ثمرة الخبرة والتجربة الإنسانية، وكل ما فعله المشرع أنه جعل حكم التجربة هذا حكمًا قانونيًّا صار الغالب بمقتضاه حقيقة مؤكدة. غير أن طبيعة الجريمة حملت المشرعين على إعادة النظر في هذا النظام؛ لأن الدليل الكامل -وهو الذي يتمثل في شهادة اثنين فأكثر أو في اعتراف المتهم- قلَّما يتحقق عملًا لأن المجرم يحرص عادة على التخفي عند ارتكاب جريمته، فلا يتيسر في الغالب أن يشهده اثنان عند ارتكابها، أما الاعتراف فنادرًا ما يُقر الجاني على نفسه بارتكاب الجريمة لعلمه بما يترتب على اعترافه من آثار وخيمة. وعلى هذا كان الأخذ بنظام الأدلة القانونية يؤدي إما إلى أن يفلت معظم الجناة من العقاب، أو أن ينتزع الاعتراف منهم بالتعذيب استيفاء للشكل، أي لصورة الدليل اللازم للحكم بالإدانة، وهو ما آل إليه الأمر في الأحوال التي ساد فيها العمل بهذا النظام.
يصح للقاضي أن يحكم بالبراءة رغم توافر أدلة تُعدّ في نظام الأدلة القانونية قاطعة، كتعدد الشهود أو الاعتراف، وله كذلك أن يقضي بالإدانة رغم خلو الدعوى من شهود على المتهم، بل رغم وجود شهود يقطعون ببراءته.
أما نظام الأدلة الإقناعية فلا يُلزم القاضي بدليل بعينه، بل يسمح له بقبول أي دليل، ويدع له وحده تقدير القيمة القانونية لكل دليل. وإذا تعددت الأدلة القانونية أمامه وتعارضت فلا تفاضل بينها في ذاتها، وإنما تنعقد الصدارة لأحظاها بالقبول لديه وأكثرها إقناعًا له. وحددت محكمة النقض في مصر معالم هذا النظام في حكم لها قضت فيه بأن القانون فتح للقاضي باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلًا إلى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه، غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة، بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، بغيته الحقيقة، ينشدها أنّى وجدها ومن أي سيبل يجده مؤديًا إليها، ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده (نقض 12/6/1939 مجموعة القواعد القانونية حـ1 ص28 رقم17). ولا يلتزم القاضي في ظل هذا النظام بتبرير اقتناعه وتعليل أخذه بهذا الدليل واطراحه ذاك؛ لأن الأمر مرجعه إلى اطمئنان وجدانه للأول وعدم تقبله للثاني. ولهذا يصح للقاضي أن يحكم بالبراءة رغم توافر أدلة تُعدّ في نظام الأدلة القانونية قاطعة، كتعدد الشهود أو الاعتراف، وله كذلك أن يقضي بالإدانة رغم خلو الدعوى من شهود على المتهم، بل رغم وجود شهود يقطعون ببراءته.
ولا يمكن الجزم عند المقارنة بين النظامين بصحة أحدهما أو فساده، فلكل منهما مزاياه وعيوبه. والاختيار بينهما رهن بالمزاج العام في كل عصر في ضوء ما يسفر عنه نظام الإثبات المعمول به وما يؤول إليه أمره. أما من الناحية النظرية فكلا النظامين مقبول في ذاته، وقد ارتضى الفكر القانوني كلًّا منهما على مدى التاريخ. والذي نراه أن تحول المجتمعات من أحد النظامين إلى الآخر لا يرجع إلى فساد في ذات النظام الذي تحولت عنه، بل إلى خلل في تطبيقه. ذلك أن النظم القانونية تزدهر وتضمحل تبعًا لحال الأفراد والجماعات. ولعل نظام الإثبات أكثر النظم استجابة لما يسود المجتمع من قيم.
والسائد لدى كثير من الفقهاء أن نظام الأدلة القانونية أقدم نشأة، وأن نظام الأدلة الإقناعية خلفه كرد فعل له لما تفشت مساوئه. بيد أن هذا عند المحققين غير صحيح، بل العكس عندهم هو الصحيح، فهم يرون أن القضاة في العهود الأولى كانوا أفرادًا من عامة الناس يتميزون بالحصافة وسداد الرأي، ولم يكونوا محترفين منقطعين لهذا العمل، وكانوا يفصلون في المنازعات وفقًا لما توحي به ضمائرهم نتيجة لاقتناعهم بما يقرره هذا الخصم أو ذاك. غير أنه لما طال الزمن بدأ الانحراف يتسرب إلى أحكامهم. لأنها كانت تـُبنى على انطباعات شخصية. واقتضى الأمر لهذا السبب تخصيص قضاة محترفين ينقطعون للفصل في المنازعات، ورئي ضبطًا لأعمالهم تقييدهم بألا يحكموا إلا بناء على أدلة محددة لا مجال فيها لأهوائهم، فكان نظام الأدلة القانونية. ولما طال الزمن بهذا النظام أيضًا بدت مساوئه التي أشرنا إليها من قبل، فرئي العدول عنه والعودة مرة أخرى إلى نظام الأدلة الإقناعية، وهو ما يكشف عن حيرة الإنسان وعجزه عن تحقيق حلمه في الاهتداء إلى نظام إثبات محكم يظهر حقيقة الواقع بجلاء، فلا يُقضى بإدانة بريء ولا ببراءة مجرم. من أجل هذا قلنا إن نظام الإثبات الجنائي هو مشكلة إنسانية قبل أن يكون مشكلة قانونية.
على أنه يمكن القول بأن نظام الأدلة الإقناعية المعمول به حاليًا ليس هو ذات النظام الذي كان سائدًا في العهود الأولى، إذ جرى تهذيبه من جهة، وتطعيمه -من جهة أخرى- بشيء من نظام الأدلة القانونية، فصار أشبه بنظام مختلط، وتم ذلك بغية الحد من أخطاء القضاء. وعلى هذا فلم تعد حرية القاضي الجنائي في ظل نظام الإثبات الحالي مطلقة، بل صارت محكومة بجملة مبادئ وضوابط، أحدها أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بإدانة المتهم إلا بناء على دليل بمعنى الكلمة. والدليل في هذا المقام هو كل ما من شأنه أن يؤدي عقلًا إلى الوصول إلى حقيقة الواقعة توطئة للحكم في الدعوى، أمّا ما دون ذلك فلا تـُبنى عليه إدانة. ولهذا يبطل الحكم إذا كان عماده محضر التحريات أو تعرّف كلب الشرطة على المتهم أو امتناعه عن الإجابة عن أسئلة المحقق، أو إقرار محاميه، أو وجود مصلحة للمتهم في وقوع الجريمة، أو سبق وجود ضغينه بينه وبين المجني عليه، وكذلك رأي الشاهد واستنتاجاته من الوقائع التي أدركها ببعض حواسه، كاستنتاجه توافر العمد لدى المتهم، ورأي الخبير في غير المسائل الفنية، ورأي المفتي في القضايا التي يؤخذ فيها رأيه قبل الحكم بالإعدام؛ لأن أيًّا من هذه الأمور لا يرقى إلى مرتبة الدليل، ومن ثم يكون حكم الإدانة مشوبًا بفساد الاستدلال.
والثاني أن يكون الدليل مطروحًا على بساط البحث في الجلسة بحيث يكون في وسع المتهم ومن يدافع عنه مناقشته وإبداء الرأي فيه. ولهذا لا يجوز للقاضي أن يعتمد على دليل قُدِّم إليه بعد قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم؛ لأن هذا الدليل لم يطرح في الجلسة ولم يُتح للمتهم مناقشته، ولا يجوز للقاضي من باب أولى أن يحكم بناء على علمه الشخصي. والثالث أن يكون الدليل صحيحًا، فإذا كان مشوبًا بالبطلان وجب استبعاده؛ لأن الباطل عقيم. ويكون الدليل كذلك إذا كان ثمرة إجراء غير مشروع، كالاعتراف الناجم عن تعذيب، والضبط الناشئ عن تفتيش باطل، والتسجيلات التي لم تأذن بها جهة الاختصاص. ويكون الدليل باطلًا بوجه عام حين يفتقد شرطًا من شروط صحته؛ فالصغير غير المميز لا يعتد بشهادته، والورقة التي ثبت تزويرها لا يعوَّل عليها. والمبدأ الرابع وهو بالغ الأهمية، أن يفصح القاضي في حكمه عن الأدلة التي كوَّن منها عقيدته، وهو ما يُعرف بالتسبيب. وعلة إيجاب هذا الشرط طمأنة الناس إلى عدالة الحكم وتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها عليه. وليس المراد بإلزام القاضي بتسبيب حكمه أن يُبين فيه كيفية اقتناعه أو علة اقتناعه، وإنما المراد حمله على بيان مصادر اقتناعه.
وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات المصرى ينص في المادة 302 منه على أن القاضي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه أورد على هذا المبدأ قيودًا هي من سمات نظام الأدلة القانونية. منها أنه نص في المادة 301 على اعتبار المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يُثبتها الموظفون المختصون حتى وإن لم يكن القاضي مقتنعًا بها، وذلك إلى أن يثبت لديه ما ينفيها. ومن هذه القيود كذلك أن المادة 276 من قانون العقوبات حددت الأدلة التي يصح أن تُبنى عليها إدانة شريك الزوجة الزانية، وحصرتها في أربعة، هي: التلبس بالزنا، والاعتراف، ووجود أوراق صادرة منه تفيد ارتكابه الزنا، ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. فإذا خلت الدعوى من واحد من هذه الأدلة امتنع على القاضي الحكم بإدانة المتهم ولو كان مقتنعًا من دليل آخر بوقوع الزنا منه. ومن هذه القيود كذلك ما نصت عليه المادة 225 من قانون الإجراءات؛ فقد ألزمت القاضي الجنائي بأن يتبع في المسائل الأولية غير الجنائية التي يفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. فإذا كانت الجريمة خيانة أمانة وثار النزاع بشأن العقد وجب إثباته بالكتابة إذا زادت قيمته عن مبلغ معين، وذلك لأن وجود العقد مسألة مدنية أولية إذا أنكره المتهم وجب الفصل فيه قبل الفصل في وقوع الاختلاس أو التبديد.
احتمالات الخطأ القضائي في ظل نظامي الإثبات الجنائي
لما كان القضاء اجتهادًا بشريًّا غايته إدراك حقيقة ما وقع وإمضاء العدالة بتنزيل حكم القانون عليه، فإنه يستحيل عملًا أن يوجد نظام إثبات قانوني من شأنه تجنيب القضاء بصفة مطلقة وقوع الخطأ في أحكامه. ولهذا فالخطأ القضائي وارد دائمًا، سواء كان نظام الإثبات المطبق هو نظام الأدلة القانونية أو نظام الأدلة الإقناعية. وإنما تجري المفاضلة بين النظامين على أساس اعتبارين: الأول أيهما أكثر تحقيقًا للعدالة، والثاني أيهما أقل احتمالًا لتعرض الأحكام للخطأ في ظله.
ويدل استقراء التاريخ على أن نظام الأدلة القانونية حين ظهر لأول مرة كان تعبيرًا عن صحوة ضمير، إذ كانت العقوبات في اليونان وفي روما قبل ظهوره مسرفة في القسوة موغلة في العنف، وكان الموت هو العقوبة المألوفة لعدد كبير من الجرائم، فرأى دعاة الإصلاح التشدد في إثبات الجريمة من جهة، كما رأوا التخفيف من غـُلواء العقوبة من جهة أخرى، وذلك عن طريق التدرج في الدليل كمدخل للتدرج في العقاب. وفي ظل هذا النظام أصبح القضاة مقيدين بألا يحكموا بالإدانة إلا بناء على أدلة معينة، وصُنفت الأدلة بدورها إلى أدلة كاملة تـُوقَّع بناء عليها العقوبة القصوى، وأدلة غير كاملة تؤدي إلى الحكم بعقوبة مخففة، ومن ثَمَّ فقد كانت العدالة هي التي أوحت بهذا النظام. غير أن الأمر آل بعد ذلك إلى غلبة الشكل على الجوهر، فأصبح الحصول على الدليل الكامل غاية يهون في سبيلها كل شيء، وتُنتهك من أجلها كل قيمة وتهدر كل حرمة، حتى لقد قـُنن التعذيب بصور كثيرة بشعة، فصار إجراء مشروعًا لانتزاع الاعتراف من المتهم ليتوافر به الدليل الكامل وتوقع بناء عليه أقصى العقوبة. وهكذا آل أمر هذا النظام إلى أن صار مصدرًا لأشد أنواع الظلم بعد أن كانت الغاية منه تحقيق العدل. غير أنه لما كان القانون في هذا النظام هو الذي يُعين أدلة الإثبات ويحدد القيمة القانونية لكل دليل، وكان دور القاضي فيه ينحصر في التحقق من مدى توافر الدليل والحكم في ضوء ذلك بالإدانة أو بالبراءة، فإن احتمالات الخطأ في أحكام القضاء في ظل هذا النظام كانت محدودة بالرغم من عدم عدالتها في معظم الأحيان.
أما في نظام الأدلة الإقناعية فإن سلطة القاضي الجنائي في مجال الإثبات أكثر اتساعًا. والمعلوم أنه كلمَّا اتسعت السلطة ازدادت احتمالات الخطأ. وسلطات القاضي الجنائي في الإثبات في ظل هذا النظام لها مظاهر عدة؛ منها تحرره عند الإدانة من التقيد بأدلة معينة، وحقه في استدعاء أى دليل يراه لازمًا للفصل في الدعوى، سواء بالإدانة أو بالبراءة، ومنها حريته في تقدير ما يعرض عليه أو ما يتجمع لديه من أدلة وفي الموازنة بينها عند تعارضها دون أن يكون بعضها أولى -في ذاته- بالترجيح من بعض. وبعض سلطات القاضي في هذا الشأن مقيدة، وبعضها مطلقة لا رقابة عليه فيها حتى ولا من جانب محكمة النقض.
وإذا كانت قوانين الإجراءات الجنائية في بعض الدول -ومنها مصر- تعقد بابًا أو فصلًا خاصًّا بالأدلة، كشهادة الشهود واعتراف المتهم وتقارير الخبراء، فالراجح فقهًا والمستقر قضاء أن هذه الأدلة لم ترد على سبيل الحصر، وربما كانت العناية بالنص عليها ترجع إلى أنها الأكثر شيوعًا، أو أنها أكثر احتياجًا إلى أن تُنظم تشريعيًّا. وهذا صحيح بلا جدال؛ لأن النص على حرية القاضي في تكوين عقيدته يقتضي أن يكون حرًّا في اختيار الدليل الذي يُعينه على تكوين هذه العقيدة. ومن ثَمَّ فإن حرية الدليل فرع من حرية القاضي في تكوين عقيدته. ولهذا نص قانون الإجراءات المصري صراحة على أن للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص، ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك (مادة277/2)، ونص على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة (مادة 291)، ونص على أن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تُعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى (مادة 292).
ويترتب على ذلك أن للقاضي مطلق الحرية في اختيار أي دليل يراه لازمًا للفصل في الدعوى؛ لأن بُغيته الحقيقة، ينشدها -كما تقول محكمة النقض- أنـّى وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديًا إليها، ولا قيد عليه في ذلك إلا أن يكون الدليل محظورًا في القانون بنص صريح، أو أن يكون غير مشروع في ذاته كالتنويم المغناطيسي أو استعمال جهاز كشف الكذب أو مصل الحقيقة أو تحليف المتهم اليمين عند استجوابه. ويترتب على ذلك بطبيعة الحال عدم تقييد القاضي بأدلة الاتهام التي توردها النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت عند إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، فله أن يضيف إليها بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه.
أما سلطة القاضي في تقدير الدليل فإنها بالغة السعة. ولو أخذنا الشهادة كمثال فإن سلطة المحكمة إزاءها تكاد تكون مطلقة. ومما يقال في هذا الصدد إن الشهود يوزنون ولا يُعدّون. ولهذا يجوز للمحكمة أن تعوّل على شهادة شاهد واحد ولو كانت له سوابق في الكذب والتلفيق وتطرح شهادة عديدين ولو كانوا عدولًا، وذلك لأنه ليس من المستبعد أن يكذب العدل حينًا وأن يصدق الفاسد أحيانًا. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وتطرح أقوال شهود النفي أو العكس، وذلك تبعًا لاطمئنانها إلى أقوال هؤلاء أو أولئك. وإذا تعددت أقوال الشاهد في مرحلة الاستدلال وتحقيق النيابة والمحاكمة وتعارضت فيما بينها فليس من اللازم أن تعول المحكمة على شهادته أمامها وتطرح ما سبقها، بل يصح لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقواله في أي مرحلة. ولا جناح على المحكمة إن هي جزأت أقوال الشاهد ولم تأخذها برُمتها؛ لأنه من المتصور أن يصدق الشخص في بعض الحديث ويكذب في بعضه. ويصح للمحكمة نتيجة لذلك أن تأخذ بقول الشاهد في حق متهم ولا تأخذ به في حق متهم آخر؛ لأن كلًّا من القولين دليل قائم بذاته، وعدم صحة أحدهما لا ينبني عليه في المنطق عدم صحة الآخر. وللمحكمة أن تعول على شهادة الشاهد إذا اطمأنت إليها وتستبعد ما يخالفها ولو تضمنته ورقة رسمية.
كذلك فإن للمحكمة أن تأخذ بقول من أجرى التحريات بأن المتهم كان يحرز المخدر المضبوط ولا تأخذ بقوله إن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار. والأمر لا يختلف بالنسبة لاعتراف المتهم، فللمحكمة أن تأخذ به ولها أن تطرحه إذا لم تطمئن إليه. ولها أن تجزئ اعترافه فتأخذ به في حق نفسه ولا تأخذ به في حق غيره من المتهمين. ولا تلتزم المحكمة في ذلك كله بتعليل أخذها بما أخذت به واطراحها لما اطرحته، والسبب معلوم، وهو اطمئنانها إلى ما أخذت به وعدم اطمئنانها إلى ما اطرحته.
ونتيجة لهذه السلطة الواسعة يستطيع القاضي أن يحكم بإدانة المتهم كما يستطيع الحكم ببراءته، ويكون حكمه في الحالين صحيحًا قانونًا. وأذكر أن أحد القضاة أعلن ذلك صراحة في جلسة لمحكمة الجنايات كنت حاضرًا فيها، وكانت القضية سرقة بإكراه فيها عدة متهمين حضر للدفاع عنهم عدد كبير من المحامين، وقد تدافعوا للكلام في وقت واحد، وحاول رئيس المحكمة ضبط النظام فيها، ولما ضاق بهم ذرعًا صاح فيهم: يا أساتذة المحكمة تستطيع في هذه القضية أن تكتب حكم الإدانة كما تستطيع كتابة حكم البراءة، ولهذا فالمحكمة ترجو أن تركنوا إلى الهدوء وتلتزموا بالنظام. ولا شك أن ما قرره رئيس الجلسة صحيح واقعًا، لكنه غير صحيح قانونًا؛ فهو صحيح واقعًا لأن المحكمة تملك بالفعل أن تعلن في حكمها أنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات، ومن ثَمَّ تقضي بالإدانة، وتملك أن تعلن بدلًا من ذلك عدم اطمئنانها لهذه الأدلة، ومن ثَمَّ تقضي بالبراءة. أما أنه غير صحيح قانونًا فلأن القضية الواحدة بالنسبة للقاضي الواحد أو المحكمة الواحدة لا ينبغي أن يكون لها غير حكم واحد، وهو الإدانة أو البراءة؛ لأن القاضي إما أن يطمئن إلى الدليل أو لا يطمئن، والاطمئنان وعدمه وإن كان أمرًا ذاتيًّا أو باطنيًّا، إلا أنه ليس إراديًّا بحيث يستطيع القاضي بإرادته أن يطمئن إلى الدليل أو لا يطمئن. ولهذا فإن رئيس المحكمة حين قرر ما قرره فقد أعلن فقط ما يمكنه أن يحكم به. وليس كل ما يمكن للقاضي أن يحكم به هو بالضرورة ما يجب عليه أن يحكم به.
ولا تختلف سلطة القاضي في تقدير العقوبة في ظل نظام الأدلة الإقناعية عن سلطته في تقدير الأدلة، لأن كليهما فرع من حرية الاقتناع. فالمشرع يرصد لكل جريمة عقوبة، وأحيانًا عقوبتين على سبيل الجمع أو البدل. وإذا كانت العقوبة تقبل التفاوت في مقدارها فإنه يجعل لها حدًّا أدنى وحدًّا أقصى؛ فإن كانت جنحة وكانت عقوبتها مقيدة للحرية، فالقاعدة أنها الحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات، وإن كانت جناية معاقبًا عليها بالسجن أو بالسجن المشدد فإن الحد الأدنى يكون ثلاث سنوات، أما الأقصى فخمس عشرة سنة، وذلك ما لم يجعل القانون للعقوبة التي ينص عليها حدًّا أدنى أو أقصى مختلفًا. وتحديد العقوبة التي يحكم بها القاضي نوعًا ومقدارًا -في ضوء ما تقدم- متروك لتقديره مراعيًا في ذلك ظروف الجريمة وحال الجاني كي تكون العقوبة ملائمة ومتناسبة مع الضرر الاجتماعي الذي أحدثته الجريمة ومع الخطورة الاجتماعية للجاني دون إفراط ولا تفريط، وهو ما يحقق العدل.
ولا تقف سلطة القاضي في هذا المجال عند هذا الحد، فقد يرى أن النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى في الحالة المعروضة عليه لا يُرضي حاسة العدالة عنده، وذلك لاعتبارات يراها موجبة لأخذ المتهم بالرأفة، وفي هذه الحالة يجوز له قانونًا أن ينزل بالعقوبة إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لها. وعلى سبيل المثال، فالقانون المصرى يُجيز للقاضي في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفته أن ينزل بالعقوبة المقررة لها درجة أو درجتين. وإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد جاز له الحكم على المتهم بالسجن أو بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة هي السجن جاز له الحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر (مادة 17 عقوبات).
بل إن القانون المصرى يُجيز للقاضي إذا حكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أن يأمر في نفس الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبة إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنـّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون (مادة 55 عقوبات).
وتطبيقًا لهذه الأحكام القانونية يمكن لمحكمة الجنايات -من الناحية النظرية- إذا قضت بإدانة شخص بارتكاب جناية قتل عمد بسيط أن تحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر فقط، وأن تأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة أيضًا. ذلك بأن عقوبة القتل العمد البسيط -أي غير المقترن بأي من الظروف المشددة- هي السجن المؤبد أو المشدد (مادة 234/1 عقوبات). فإذا رأت المحكمة في ظروف الدعوى ما يقتضي معاملة المتهم بالرأفة جاز لها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد المقررة لجريمته إلى الحبس لمدة ستة أشهر، عملًا بالمادة 17، وأن تأمر في نفس الحكم بوقف تنفيذ هذه العقوبة عملًا بالمادة 55 سالفة الذكر.
وإذا كانت سلطة القاضي في نظام الأدلة الإقناعية أو الإقتناع الحر هي على نحو ما بينا من الاتساع، وكان احتمال الخطأ القضائي فيه لهذا السبب أكبر، فهذا لا يعني بالضرورة أن نظام الأدلة القانونية أفضل، بدعوى أن احتمالات الخطأ فيه أقل. ذلك بأن احتمالات الخطأ قلَّـةً وكثرة ليست هي وحدها العامل الحاسم عند المفاضلة بين النظامين، بل هناك عامل آخر ينبغي أن يوضع في الاعتبار، وهو مدى قدرة كل من النظامين على تحقيق العدل في الجملة. بل إن هذا العامل ينبغي أن تكون له الأولوية عند التعارض مع العامل الآخر، لأن الخطأ القضائي في ظل نظام الأدلة الإقناعية عارض يمكن مواجهته والحدّ منه بعلاج أسبابه، أما الخطأ القضائي في ظل نظام الأدلة القانونية فمن طبيعة النظام ذاته، ومن ثَمَّ فإنه يتعذر علاجه.
وفضلًا عن ذلك فالتفريد في نظام الأدلة الإقناعية ممكن لأنه من لوازمه، أما في الأدلة القانونية فممتنع لأنه يسوي بين جميع المتهمين في المعاملة دون اعتداد بما بين ظروفهم وأحوالهم من فوارق. ومن ثَمَّ فإن نظام الأدلة الإقناعية بعد تهذيبه على نحو ما آل إليه في الوقت الحاضر هو أفضل -بغير شك- من نظام الأدلة القانونية. غير أن هذا لا يبُرر غض الطرف والاستسلام لما يقع في ظل هذا النظام من أخطاء قضائية، بدعوى أنه لا مفر منها، وأنه يتعين قبولها كثمن لما ينطوي عليه هذا النظام من مزايا، بل يجب البحث عن أسباب هذه الأخطاء والسعي لتجنبها أو الحد من آثارها؛ لأن الخطأ القضائي يعود بالنقض على عدالة الحكم، وهو غاية القضاء، بل علة وجوده، فضلًا عما ينطوي عليه من نيل من هيبة القضاء ومن ثقة الناس فيه واحترام أحكامه. وقد ثبت بالاستقراء أن أكثر ما يؤتى منه نظام الأدلة الإقناعية هو السلطة الواسعة التي يخولها للقاضي سواء في تقدير الأدلة أو في تقدير العقوبة، وكلاهما من مسائل الموضوع التي تنحسر عنها رقابة محكمة النقض؛ لأن عملها ينحصر في تقويم ما اعوج من الأحكام من جهة القانون، أما ما يقع فيها من سوء تقدير للأدلة أو من شطط في العقوبة فلا شأن لها به ما لم ينطو على فساد في الاستدلال أو على خطأ في القانون.
وقد رأى المؤلف أن الحد من أخطاء القضاء يقتضي الحد من السلطة التقديرية للقضاة، ودعا المشرع إلى التدخل بالنص على ذلك في حدود تحول دون وقوع أخطاء جسيمة. غير أننا نختلف معه في ذلك؛ لأن هذه السلطة هي جوهر نظام الأدلة الإقناعية، والحد منها يعني العودة بصورة أو بأخرى إلى نظام الأدلة القانونية. ولهذا فإنه يتعين الإبقاء على هذه السلطة وتلمس الوسائل التي تحد من أخطاء القضاء في مظانّ أخرى. ولا بأس مع ذلك من الحد من السلطة التقديرية المطلقة التي يتمتع بها القضاة في مجالات معينة، وجعلها في بعض هذه المجالات سلطة مقيدة تخضع لرقابة محكمة النقض، وإن كان قضاؤها مع ذلك مستقرًّا على أن السلطة التقديرية المطلقة وإن كانت تخرج بحسب الأصل عن مجال مراقبتها، إلا أن المحكمة إذا أفصحت عن علة ممارستها لهذه السلطة، فمن حق محكمة النقض أن تراقبها. ومؤدى هذا أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد أو ترفض الأخذ بها، وأن تحكم على المتهم بالعقوبة نوعًا ومقدارًا في حدودها الدنيا والقصوى دون أن تكون ملزمة بتعليل ما قررته على أساس أن سلطتها في هذا الشأن مطلقة وليس لمحكمة النقض أن تراقبها، إلا أنها إذا عللت روقبت، فإن كان تعليلها خاطئًا في المنطق القانوني أو كان مبنيًّا على ما يخالف الواقع الثابت أو على ما لا أصل له في الأوراق، كان حكمها معيبًا وكان نقضه متعينًا.
وسائل الحد من أخطاء القضاء
الحد من أخطاء القضاء إما أن يكون بوسائل وقائية تحول دون وقوعه ابتداء، أو بوسائل علاجية تؤدي إلى علاج الخطأ -إذا وقع- وتدارك آثاره. والحد من الأخطاء القانونية أيسر من الحد من أخطاء الواقع. وهذا متحقق سواء عن طريق الوقاية أو عن طريق العلاج. والفضل في ذلك يعود إلى محكمة النقض؛ لأن المبادئ التي تقررها -والفرض أن القضاة على علم بها أو يجب عليهم العلم بها- تعصمهم من الوقوع في أخطاء قانونية. وإذا وقعوا فيها رغم ذلك، فالطعن بطريق النقض في أحكامهم كفيل بتصحيح هذا الخطأ وتدارك آثاره. وإنما الصعوبة الحقيقية هي في توقي أخطاء الواقع وفي علاجها إذا وقعت.
وقد عنى الدستور وكذلك القانون بالنص على بعض الوسائل التي من شأنها الحد من وقوع أحكام القضاء في أخطاء في أمور الواقع، وعلى تدارك الآثار التي تترتب على ذلك. ومن هذه الوسائل إجازة الطعن بالمعارضة والاستئناف في الأحكام الغيابية والحضورية الصادرة في الجنح. فالطعن فيها يُعيد طرح الدعوى مرة أخرى على محكمة الموضوع حيث يتاح للخصوم أن يناقشوا الأدلة وكل ما بُني عليه وما قضى به الحكم المطعون فيه، وذلك سعيًا إلى تصحيح ما يكون قد شابه من خطأ، سواء في مسائل الواقع أو القانون. أما الأحكام الصادرة في الجنايات فعلى الرغم من أن الحاجة إلى استئنافها أشد نظرًا لأن العقوبات التي تقضي بها أكثر جسامة -إذ قد تصل إلى الإعدام- فإن الطعن فيها بالاستئناف في مصر حتى الآن غير جائز، ولا سيبل إلى الطعن فيها إلا بطريق النقض رغم ما قد تنطوي عليه من أخطاء تتعلق بمسائل الواقع. وإذا طعن فيها بالنقض فإن محكمة النقض تقصر عملها على النظر في وجوه الخطأ في القانون، وتصدّ نفسها تمامًا عن النظر فيما يكون الحكم قد وقع فيه من سوء تقدير للأدلة أو شطط في العقوبة ما دام لم يصل إلى حد الفساد في الاستدلال أو الخطأ في القانون كما ذكرنا من قبل.
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن إيجاب نظر الدعاوى الجنائية على درجتين ليس مبدأ دستوريًّا يتعين على المشرع التزامه، بل هو من المسائل التي تخضع لتقديره. غير أن الدستور الحال -ومن قبله دستور سنة2012م- سوّى بين الجنايات والجنح من حيث مبدأ قابلية الأحكام الصادرة في كل منهما للطعن فيها بالاستئناف، لكنه نص في المادة240منه على إمهال الدولة عشر سنوات من تاريخ العمل به حتى يُتيح لها الوقت الكافي لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية التي يقتضيها العمل بنظام الاستئناف في الجنايات، وهذا يعني أن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنايات قد تتراخى مباشرته إلى سنة 2024م، وهذه المدة في تقديرنا أطول كثيرًا مما يجب. وكان دستور 2012م ينص في المادة 234 منه على أن يسري الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات بعد سنة من تاريخ العمل بذلك الدستور.
ومن الوسائل القانونية أيضًا لتدارك ما تقع فيه أحكام القضاء من خطأ في أمور الواقع نظام إعادة النظر، وهو نظام يفترض أن طرق الطعن في الحكم قد استنفدت، سواء باستعمالها دون أن يُقضى فيها لصالح المحكوم عليه، أو بفوات مواعيدها دون الطعن فيها. وبتعبير آخر فهذه الوسيلة تفترض أن حكم الإدانة أصبح باتًّا ولم يعد قابلًا للطعن فيه بأي طريق. وكان الأصل أن يكون هذا الحكم قد تحصن وتطهر من كل ما قد يكون شابه من أخطاء، إلا أن المشرع مع ذلك لم يستطع أن يغضَّ طرفه ويصم أذنيه ويتجاهل حالات صارخة يبدو التفاوت فيها صادمًا بين ما قضى به الحكم البات وما تجلى عنه الواقع فبات معلومًا لكل الناس. وقد حذا قانون الإجراءات المصري حذو كثير من التشريعات المعاصرة فانتقى أبرز هذه الحالات وأجاز فيها طلب إعادة النظر، وعهد إلى محكمة النقض بالفصل فيه بعد إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق، فإذا رأت قبول الطلب قضت بإلغاء الحكم وبراءة المحكوم عليه إذا كانت هذه البراءة ظاهرة، وإلا أحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكّلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها، ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها (مادة 446).
أما الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح فهي ما يلي: إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حيًّا، وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما، وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو لتقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، وكذلك إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من محكمة مدنية وأُلغي هذا الحكم، وأخيرًا إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه (مادة 441).
وظاهر من ذلك أن كل هذه الحالات تشتمل على أخطاء شابت الحكم البات، وكلها أخطاء لا تتعلق بالقانون، بل تتعلق بالواقع. ووصفها بأنها أخطاء لا يخلو من تجاوز، وإنما اعتبرت كذلك لا على أساس أن المحكمة أخطأت فيما قضت به، بل على أساس أنه تبين بعد أن صار الحكم باتًّا أنه كان مبنيًّا على ما يخالف حقيقة الواقع. وعلى الرغم من أن هذه الحالات تغطي مساحة كبيرة من أخطاء الواقع إلا أنها مع ذلك لا تستغرقها كلها، فما زالت هناك أخطاء أخرى تقصر عنها. والرأي متفق على أن الحالات التي نص القانون عليها وردت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها؛ لأنها تنطوي على خروج على أصل مقرر، وهو قوة الأمر المقضي، فقد اقتضت ضرورة استقرار الأوضاع والمراكز القانونية أن يكون الحكم البات هو عنوان الحقيقة، بل إن الحقيقة التي يُقررها هذا الحكم أقوى من الحقيقة ذاتها.
ولما كانت القاعدة أن النصوص التي تعد خروجًا على أصل يراعى في تفسيرها التضييق، إلا أن في الفقه من يرى أن هذه القاعدة إنما تستقيم بالنسبة للحالات الأربع الأولى من حالات طلب إعادة النظر، لأن عبارة المشرع المصرى في شأنها تتميز بالتحديد والضبط، بخلاف الحالة الأخيرة، إذ تعمدّ المشرع صياغتها بعبارة تتسم بالمرونة ولا تستعصي على التفسير الموسع. فهي تفترض أنه قد حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه، لكنها لم تكن معلومة وقت المحاكمة. ويذهب هذا الرأي إلى أن هذه الحالة تُفسح المجال أمام محكمة النقض لممارسة سلطة تقديرية واسعة، وقد يقتضي فحص هذه الوقائع والأوراق تحقيقًا تقوم به. على أن حالات إعادة النظر على أي نحو فـُسرت لا تتسع لتدارك كل أخطاء الواقع التي تشوب أحكام القضاء بما يعني أن المشكلة ستظل قائمة.
ومن الوسائل القانونية لعلاج أخطاء الواقع أيضًا ما تُقرره المادة 54/5 من الدستور المصري الحالي، فقد نصت على أن يُنظم القانون أحكام حالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. ويفترض هذا النص فرضين: أحدهما أن المتهم حبس احتياطيًّا في أثناء التحقيق الابتدائي معه أو أثناء محاكمته، ثم صدر بعد ذلك أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، أو انتهت المحاكمة ببراءته، أما الثاني فيفترض أن محاكمة المتهم انتهت بالحكم عليه بعقوبة قيدت بسببها حريته فترة من الزمن، ثم صدر بعد ذلك حكم بات ألغى الحكم الذي من أجله قيدت من قبل حريته. وقد قرر الدستور من حيث المبدأ أحقية الشخص في الحالين في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لتقييد حريته، وعهد إلى القانون بتنظيم الأحكام التي تكفل حصوله على هذا الحق- غير أن هذا القانون لم يصدر بعد، والأمل معقود على صدوره في وقت قريب، ليس فقط لجبر الضرر الذي يحيق بكثيرين، بل وللحد كذلك من الإسراف في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي من جهة، ولوضع تنظيم قانوني -من جهة أخرى- يقدم حلًّا لمشكلة التراخي في الفصل في طعون المحكوم عليهم الذين تقيد حريتهم فور صدور الأحكام بإدانتهم.
أما وسائل الوقاية الأخرى التي تُسهم في الحد من أخطاء القضاء في أمور الواقع فيأتي على رأسها حسن اختيار القاضي ابتداء وموالاة تأهيله وعلى الأخص في السنوات الأولى التي يمارس فيها العمل القضائي، وذلك بعقد دورات تدريبية له وحثه على التزود بقدر معقول من العلوم غير القانونية التي تتصل بعمله أوثق اتصال، والتي أثبت العمل أنه في حاجة شديدة إليها لتمكينه من الكشف عن حقيقة الواقعة التي يعهد إليه بالفصل فيها. ومما يؤسف له أننا نقع كثيرًا في مجموعات الأحكام التي يصدرها المكتب الفني لمحكمة النقض على أحكام قـُضي فيها بنقض الحكم المطعون فيه لفساد الاستدلال. وقد نغتفر للقاضي أن تنقض بعض أحكامه للخطأ في تأويل القانون، لكننا لا نستطيع أن نغفر له أن ينقض له حكم لفساد الاستدلال؛ لأن هذا يعني أنه يفتقد الحد الأدنى من أصول المنطق. وهذا عيب جسيم، بل هو نقيصة يدهشنا أن أحكام النقض التي تقضي بذلك تمر على كبار المسؤولين من رجال القضاء مر الكرام.
على أن حسن اختيار القاضي وتأهله التأهيل الكافي بل المتميز لا يؤتي ثماره المرجوة إلا إذا أتيح له من الوقت ما يمكنه من دراسة القضايا التي تحال إليه بتأنٍّ وروّية. غير أن ما يحدث غير ذلك تمامًا؛ فالمشاهد حاليًا أن القضاة -وعلى الأخص شبابهم من قضاة المحاكم الجزئية- يسند إليهم عدد من القضايا في الجلسة الواحدة يبلغ عدة مئات. ولا يقل كثيرًا ما تنظره كل دائرة من دوائر الجنح المستأنفة في كل جلسة عن هذا العدد. وكان العمل يجرى فيما مضى على أن ترسل القضايا قبل الجلسة إلى القاضي لدراستها حتى يكون مستعدًا لاتخاذ قرار في طلبات الخصوم إذا رأى بعضهم تأجيل الدعوى، أو الاستماع إلى مرافعتهم إن شاؤوا المرافعة فيها. أما اليوم -فنظرًا لضخامة عدد القضايا في كل جلسة- فإن القاضي لا يطلع على أوراق أي منها، بل تبدأ صلته بها ساعة النداء على أطراف الدعوى فقط.
ومن المفارقات أن المادة 411 من قانون الإجراءات المصري تقضي بأن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير تسمع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه. وقضاء النقض مستقر على بطلان الحكم إذا خلا من النص على وضع التقرير الملخص وعلى تلاوته في الجلسة. والكل يعلم أن هذا التقرير لا يتلى في الجلسة، بل إنه نادرًا ما يوضع أصلًا. أما دوائر الجنايات فيبلغ ما تنظره كل دائرة في دور انعقادها الشهري قرابة مئة وخمسين قضية، أي بمعدل خمسة وعشرين جناية في اليوم الواحد. وبعض الجنايات قد يتعدد فيها المتهمون، وقد يبلغ عددهم في بعض الجنايات عشرات، بل لقد وصل في بعض القضايا إلى عدة مئات. هذا بالإضافة إلى ما يعرض على القضاة بمختلف فئاتهم في ذات الجلسة من طلبات مدّ الحبس الاحتياطي أو استئناف القرارات الصادرة بشأنه، سواء بمده أو بإلغاء مده وطلب الإفراج عن المتهم. بل إن دوائر النقض نفسها لم تسلم من ظاهرة تراكم الطعون أمامها، ومن ازدحام كل جلسة تعقدها أي من دوائرها بأعداد من الطعون تتجاوز العشرين في كثير من الأحيان.
ولا شك أن تحميل القضاة عمومًا، وشبابهم على وجه الخصوص في مستهل عملهم القضائي، بأعداد من القضايا تتجاوز طاقتهم، هو أهم سبب لما يشكو منه الجميع اليوم من تفشي أخطاء الواقع في أحكام القضاء بمختلف مستوياته. فقد دلت التجربة على أن العلاقة بين الكم والكيف عكسية؛ لأن لكل إنسان طاقة، فإذا كلف شخص بأداء كمّ من العمل على نحو معين في زمن محدد، فإن مستوى أدائه يتوقف على مدى هذا الزمن ومقدار ذلك الكم. وكلما زاد الكم كان ذلك على حساب الكيف. وكيف يتوقع منصف من قاض متخم بالقضايا التي يطلب منه الفصل فيها في خلال أجل محدود أن يبذل الجهد اللازم في تحري حقيقة الواقع في كل قضية حتى يبلغ به حد اليقين!
ولا نعتقد أن هذا الأمر يخفى على من يكلفون بالتفتيش على أعمال القضاة، وأنه لا ينعكس على تقويمهم لما يصدر عن هؤلاء القضاة من أحكام. وهذه حقيقة لا تقبل المكابرة ولا الإنكار، سواء كانت محل رضا أو سخط من جانب الكثيرين. ومع ذلك فليس ما ذكرناه هو مكمن الخطر الوحيد، وإنما يكمن الخطر الأكبر في أن القاضي إذا تعوّد في بداية عمله على بذل بعض الجهد في تحري حقيقة الواقع دون أقصاه، فإن هذا المستوى من الأداء يصبح دأبه وديْدنه، بل قد يطبعه بما يجعله من طبيعة شخصيته، ويظل هذا حال القاضي حتى وإن رُقـّي من بعد إلى درجة أعلى فقلّ عدد القضايا التي يُعهد بها إليه وصار في حدود طاقته. وهذا أمر يلمسه من يطالع أحكام القضاة المعاصرين ويقارنها بأحكام السلف. ونحن إذ نقرر هذا فإننا لا نعمم ولا نصدر أحكامًا مطلقة، وإنما نسجل فقط ما ذكرناه باعتباره ظاهرة. ويبدو لنا أن حل هذه المشكلة ليس بالأمر اليسير على الأقل في زمن قريب؛ لأنها نتاج عقود من التراخي والإهمال. وليس في وسع أحد اليوم أن يلقى مسؤولية هذا الوضع على جهة معينة أو على مسؤول بعينه؛ لأن لكـّل ٍعذره، ولكل عذر ما يوجهه، غير أن الضحية في نهاية الأمر هي العدالة، ومن ورائها المجتمع كله.