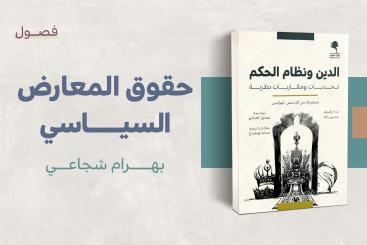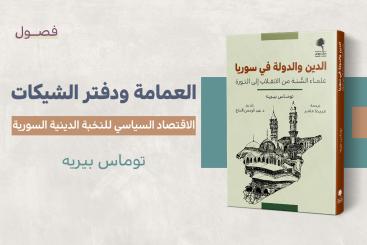جدلية الأخلاق والسياسة.. دراسة تحليلية لكتاب الإجرام السياسي

لا تزال إشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق معضلة إنسانية تبحث عن حلول جذرية لها في ظل حضور منطق المصلحة الانتهازية واستشراء الجريمة السياسية وتعالي لغتها في حقل السياسة الدولية دون الالتزام بأي ضوابط أخلاقية، إذ لا زالت تلك اللغة تلقي بظلالها بكثافة على الواقع السياسي العالمي منذ القدم وحتى اللحظة الراهنة.
فلقد افترقت السياسة عن الأخلاق في الممارسة والواقع الميداني كثيرًا حتى أصبحا نقيضين، فأضحى العمل السياسي فعلًا لا أخلاقيًّا في رأى كثيرين رغم اشتراكهم في ذات الغاية وهي تحقيق خير الإنسان، فإذا كانت السياسة في تعريفها البسيط، وكما يرى البعض، هي وسائل قيادة الجماعة البشرية وأساليب تدبير شؤونها لما يُعتقد أنه خيرها ومنفعتها، فالأخلاق هي مجموعة القيم والمثل الموجهة للسلوك البشري نحو ما يُعتقد أيضًا أنه خير وتجنب ما يُنظر إليه على أنه شر[1].
غير أن ما يشهده الواقع السياسي الراهن من ممارسات سياسية لا أخلاقية سواء على المستوى السياسي الداخلي ومنظومة العلاقات الدولية، أو على مستوى العالم العربي وتحديدًا في تلك اللحظة التاريخية الحرجة التي يمر بها، حتى أضحت العبارة القائلة "لا أخلاق في السياسة ولا سياسة في الأخلاق" هي بحق الحاكمة للممارسة السياسية اليومية متجسدة في صورٍ وواقع في غاية البشاعة، ابتداءً من التدني الأخلاقي للممارسة السياسية الفردية إلى واقع تشريد وتدمير كيانات اجتماعية وسياسية بأكملها، وما يحدث في أفريقيا والعالم العربي والإسلامي هو أبلغ شاهد على انحدار القيم والممارسة السياسية أخلاقيًّا لدى الجميع دون استثناء، وحتى ممن يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان أو ممن ينادون بتطبيق الشريعة.
من هنا كان أمرًا إنسانيًّا حتميًّا أن تتجه جهود الكثير من المفكرين السياسيين والقانونيين نحو الدعوة لإضفاء أبعاد أخلاقية وإنسانية على الممارسة السياسية، والتنبيه إلى أن اعتماد لغة الانتهازية والمصالح وحدها ستقود لاستمرار الصراعات والكوارث عالميًّا، ومن ثَمَّ أهمية محاولة جسر الهوة بين ما هو كائن -عالم الواقع- وما ينبغي أن يكون -عالم المُثُل-في عالم السياسة، أي رأب الصدع بين السياسي والأخلاقي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضمير البشرية.
حيث تعد الجريمة السياسية واحدة من أقدم الجرائم التي بدأ يتبلور مفهومها منذ تكوُّن النواة الأولي لما أصبح يعرف بالدولة، هذا التاريخ السحيق للجريمة السياسية شهد الكثير من الصراعات القاسية بين مجموعة المعارضين الذين يسعون لتحقيق أهدافهم التي يرونها أهدافًا وطنية خادمة للوطن والمجتمع، ضد الأنظمة والحكام الذين يديرون السلطة السياسية في الدولة[2].
وارتبط انتشار الجريمة السياسية صعودًا وهبوطًا بطبيعة الأنظمة الحاكمة ومدى منحها حق المشاركة الشعبية للمواطنين في إدارة الحكم، والسماح بوجود معارضة سياسية في إطار النظام السياسي.
لقد اتصفت الجريمة السياسية في مجتمعات العصور القديمة في الغالب بالصبغة الدينية، حيث اعتبر ملوك وأباطرة هذه المجتمعات القديمة أنفسهم ممثلين لله في الأرض، ومن ثَمَّ فإن تصرفاتهم تعبر عن إرادة الله؛ ولأنها كذلك فإنها غير محدودة ولا يجوز مساءلتهم عنها، وبالتالي فإن مفوضيهم من الموظفين غير مسئولين عن نتيجة تصرفاتهم ما دامت لا تخرج عن حدود التفويض، وأن أي خروج عن هذا التفويض يعتبر جريمة دينية وقانونية[3].
هناك جرائمَ مختلطة بالنظر إلى أنها تتكون من أفعال تعتبر أصلًا من الجرائم العادية ولكنها تُرتكب بدافع سياسي كجريمة قتل بدافع سياسي، أو الجرائم التي يتم ارتكابها في أثناء الثورات كسرقة أسلحة لاستخدامها في تنفيذ انقلاب على السلطة القائمة.
وفي العصور الحديثة ارتبط تطور الجريمة السياسية بالثورة الفرنسية التي اعتبرت مناهضة الحكم المطلق والنظم الاستبدادية جريمة سياسية، وأعطت الشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية لمناهضة هذا النوع من الأنظمة كحق للشعوب، وهو ما يعد مناقضًا لمفاهيم وفلسفة الجريمة السياسية في معظم الحضارات القديمة، ومن ثَمَّ سعت إلى صياغة نظرية أخلاقية وقانونية وسياسية من شأنها تحقيق التوازن في فلسفة الجريمة السياسية -ولو بشكل نسبى- بين الأنظمة والشعوب عبر تطوير نظرية العقد الاجتماعي لتصبح في شكل مواثيق دستورية وحقوقية واضحة المعالم. أدى هذا التباين حول مفهوم الجريمة السياسية إلى إثارة جدل واسع في التشريعات الفقهية المحلية والدولية على السواء، ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من وجود جرائم لا تكاد تُثير إشكالًا من حيث كونها جرائمَ سياسيةً، فإن هناك جرائمَ مختلطة بالنظر إلى أنها تتكون من أفعال تعتبر أصلًا من الجرائم العادية ولكنها تُرتكب بدافع سياسي كجريمة قتل بدافع سياسي، أو الجرائم التي يتم ارتكابها في أثناء الثورات كسرقة أسلحة لاستخدامها في تنفيذ انقلاب على السلطة القائمة[4].
وهناك مذهبان في تعريف الجريمة السياسية، أما المذهب الأول فهو المذهب الشخصي والذي يشترط اعتبار الجريمة جريمة سياسية إذا كان الباعث على ارتكابها باعثًا سياسيًّا بصرف النظر عن موضوع الجريمة، أما المذهب الثاني وهو المذهب الموضوعي فيشترط لاعتبار الجريمة جريمة سياسية أن يكون الباعث عليها باعثًا سياسيًّا وأن يكون الفعل المكون لها -أي موضوعها- سياسيًّا كذلك، كالشروع في قلب نظام الحكم أو محاولة المساس باستقلال الدولة[5].
ولعل أبرز محاولات تطوير وصياغة تعريف للجريمة السياسية ما وضعه المُشرِّع الجنائي الإيطالي، والذي ورد في المادة 8 من قانون العقوبات الصادر عام 1930م جاء فيها أنها "الجريمة التي تمس مصالح الدولة السياسية أو أحد الحقوق السياسية للمواطنين، وتعد جريمة سياسية كذلك جرائم القانون العام التي تُرتكب كليًّا أو جزئيًّا ببواعث سياسية"، ويتضح من هذه المادة تطور مفهوم الجريمة السياسية وفقًا للمُشرِّع الإيطالي بحيث تم التوسع فيها، فإضافة إلى المفهوم التقليدي الذي كان محصورًا في الخروج على الدولة، تم اعتبار المساس بحقوق ومصالح المواطنين على المستوى الجماعي أو الفردي جريمة سياسية أيًّا كانت ممارستها، وبناءً على هذا التعريف تعتبر بمثابة جرائمَ سياسية كل من جرائم عدم النزاهة والاستقامة في إدارة شؤون الدولة وجرائم الصراع السياسي[6].
وبناء على تطور هذه المفاهيم قانونيًّا في المدرسة الغربية عمومًا وعلى الأخص الفرنسية منها التي كانت رائدة في هذا التطور، نمت هذه الموجة من التطور في أنحاء العالم بشكل أو بآخر[7].
والملاحظ هنا أن هذا التطور الإيجابي في تعريف الجريمة السياسية ما زال بالغالب محصورًا بالعالم الغربي، فهناك حالة من غياب التنظيم التشريعي الحديث المقنن للجريمة السياسية في تشريعات ودساتير العالم الثالث والعالم العربي على وجه التحديد، من حيث النصوص أو آليات التطبيق إذ يعاني نقصًا كبيرًا، وبخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المعارضين السياسيين في القيام بدورهم دون توجيه اتهامات زائفة لهم بدعوى ارتكابهم جرائمَ سياسية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سطوة الأنظمة الحاكمة وسيطرتها على التشريعات والأنظمة، ورفض تقييد وتقنين سلطاتهم تجاه معارضيهم، مع التوسع في التشريعات التي تنص على العديد من العقوبات لمن يمس نظام الحكم أو شخص الحاكم، فالجريمة السياسية في الدول العربية مقننة بهدف ولصالح حماية الحكام والأنظمة من المعارضين السياسيين في مقابل، وإهدار حقوق المعارضين من بطش هؤلاء الحكام.
إذ إنه وفقًا للمبدأ القائل بأن: "لا جريمة إلا بقانون ولا عقوبة إلا بنص" فيستحيل تجريم تسلط الحكام تجاه شعوبهم في ظل غياب هذا التقنين، فهو في نهاية الأمر موقف لإرادة سياسية ترفض المُضي قدمًا في تقنين الجرائم السياسية المرتكبة من قبل الحكام تجاه الشعوب أكثر من كونه مبدأً قانونيًّا متفقًا عليه.
لقد حاول المجتمع الدولي وضع ضوابط محددة لتمييز الجريمة السياسية المُعاقب عليها دوليًّا، كان من أهمها تضمين تقرير المؤتمر السادس لتوحيد القانون الجنائي المنعقد بكوبنهاجن Copenhagenسنة 1935م وثيقة مُفصّلة حول مفهوم الجريمــة السياسية، والذي عرفها بأنها: "الجرائم الموجهة ضد تنظيم وسير الدولة وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن المرتبطة بها"، كما تم التوسع في تجريم الأفعال غير الأخلاقية على النطاق الدولي، والتوسع في تجريم الانحرافات السياسية في أوقات السلم والحرب.
وفي هذا السياق من التطور اعترفت الأمم المتحدة United Nations بحق كل إنسان في الحصول على حماية ولجوء يقيه من الاضطهاد، حالة ارتكابه جُرمًا سياسيًّا، كما تنص المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة[8].
لقد كان للأفكار الإنسانية والأخلاقية والحقوقية التي طرحها لويس بورال وغيره والتي مثَّلت تنبيهًا مبكرًا قبل ما يزيد عن قرن، لكارثية الاستمرار في اعتماد وتبني سياسات لا أخلاقية في حياتنا الإنسانية، كان لها دور في تعالي الدعوات الأخلاقية بتجريم أشكال العبودية المختلفة، ودعوات تحرير المرأة من الاضطهاد، ومزيد من الحماية للأطفال كالنص على حظر تجنيد الأطفال في الحروب، وحماية الأقليات الإثنية والعرقية، وحماية حرية الاعتقاد، وغيرها من قيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًّا.
وفي الصفحات القليلة القادمة سنحاول سبر أغوار أبعاد تلك الإشكالية بشكل أكثر عمقًا من خلال تناول هذا الكتاب الذي خصصه مؤلِفه لإلقاء الضوء على ظاهرة الإجرام السياسي كظاهرة تجسد الانفصال بين السياسي والأخلاقي من خلال طرح عدد من التساؤلات المركزية التي تبرز أهمية قيام دار نهوض للدراسات والنشر بدعم من وقف نهوض بإعادة نشر هذا الكتاب، ولماذا الآن تحديدًا؟ وما القيمة التي تضمها دفتيه -بخلاف قيمته التراثية- فهل به من الأطروحات ما يمكنها أن تُقدم إجابات شافية لإشكاليات واقعنا السياسي الراهن؟ أو حتى بدايات تأسيسية يمكن البناء عليها، ومن ثَمَّ تطويرها لتتلاءم وتعقيدات هذا الواقع الجديد؟ وهل هناك في التراث السياسي العربي والإسلامي وكذلك الممارسة السياسية الإسلامية تاريخيًّا ما يتفق مع هذا الطرح الذي قدمه بورال حول ظاهرة الإجرام السياسي، وهل هي -أي تلك المادة الإسلامية التراثية-مقننة في شكل قوانين ومواد دستورية أم لا زالت مجرد اجتهادات ونصوص بحاجة إلى تقنين؟ ذلك ما سنحاول استقصاءه في الصفحات القليلة القادمة.
الكتاب والفكر السياسي الأخلاقي المعاصر
بداية يُعَدّ هذا الكتاب الذي بين أيدينا الإجرام السياسي La criminalité politique واحدًا من المؤلفات التي اكتسبت أهمية قصوى في الأوساط الفكرية الغربية، فهو بمثابة مرجعية مهمة في مجال تطوير دراسات الأنظمة السياسية في القرن الفائت.
ومؤلف الكتاب هو القاضي لويس بورال وهو قاض فرنسي شهير، عمل قاضيًا بمحكمة الاستئناف بمقاطعة أكس أون بروفانس Aix-en-Provence بفرنسا، وقد قام بالعديد من البحوث والدراسات العلمية الفكرية والقانونية رغبة منه في تطوير نظريات وقواعد علم الجريمة والعقاب، كما اهتم بالصور المختلفة للجريمة بالإضافة إلى اهتمامه بالدراسات البينية بين علم الإجرام والعقاب وبين علم النفس الجنائي.
وكما يقال إن المفكر هو ابن واقعه وتتشكل أفكاره وقناعاته استجابةً لظروف هذا الواقع ومتغيراته أو كرد فعل عليها، فإن بورال قد نشأ في واقع سياسي كانت لا تزال الثورة الفرنسية حاضرة فيه بقوة، ومن ثَمَّ تأثر الكاتب كثيرًا بأفكارها وشعاراتها الرئيسة والتي نادت بترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتسامح وإعلاء شأن القيم الأخلاقية في ظل مناخ كانت تسيطر عليه بشكل كبير في المجال السياسي الأطروحات الميكافيلية والتي تمركزت في معظمها حول سيادة المصلحة ومحاولة تحقيقها بأية وسيلة بغض النظر عن مدى أخلاقيتها باعتبار الغاية تبرر الوسيلة، ومن ثَمَّ كان المؤلف واحدًا من الذين يريدون إنزال تلك القيم الإنسانية الرفيعة والتي نادت بها الثورة الفرنسية على واقع مُثقل بالنفعية والذي قادته نفعيته تلك للكثير من الحروب والصراعات السياسية.
ويعد كتابه الجريمة والعقاب Le Crime et le Peine والمنشور في باريس في عام 1892م أحد أهم أعماله القانونية، والذي قدم من خلاله تفسيرًا منطقيًّا للزيادة المضطردة في أعداد الجرائم المختلفة وسُبل تقنين التشريعات الخاصة بها.
وتذخر المكتبات العالمية بما يقارب 26 مؤلفًا له، منها 15 كتابًا و11 بحثًا منشورًا، وقد تم ترجمة العديد منها لأكثر من لغة بلغ بعضها 7 لغات (الإنجليزية - العربية - الصينية - الإسبانية - اليابانية - البولندية - الروسية) بالإضافة إلى اللغة الفرنسية اللغة الأصلية للمؤلف، كما تم إعادة إصدار العديد من مؤلفاته للقراءة حول العالم حتى بلغت مجموع أعماله في المكتبات العالمية باللغات المختلفة 154 كتابًا وبحثًا[9].
والأمر المثير حقًّا أنه ومع هذا الاهتمام العالمي بالمؤلف وأعماله ذات القيمة الفكرية العالية، إلا أنه لم يحظَ باهتمام يُذكر في العالم العربي، اللهم إلا ترجمة وحيدة وقديمة لكتابه الذي بين أيدينا الإجرام السياسي والتي بدورها لم تأخذ حقها من الشهرة والذيوع وتداول أطروحاتها.
ومن أبرز مؤلفاته[10]:
- Les Médecins positivistes et les théories modernes de la criminalité
- Le crime et la peine
- La criminalité politique
- Le Crime passionnel et la littérature contemporaine
- L'expertise médico-légale et la question de la responsabilité criminelle
- Napoléon Ier était-il épileptique?
- L'éducation et le suicide des infants : étude psychologique et sociologique
- Le Crime et la peine ... Quatrième édition
- Les suicides par misere a Paris
- La psychologie de Jean-Jacques Rousseau
- L'esprit satirique de J.-J. Rousseau
وقد صدر هذا الكتاب الإجرام السياسي في نسخته الأولى في عام 1895م باللغة الفرنسية، وتُرجم إلى اللغة الإنجليزية في عام 1898م في الولايات المتحدة الأمريكية[11]، وتُرجم للعربية في عام 1937م في القاهرة [12]، كما تُرجم للبولندية في عام 1906م، وتُرجم مؤخرًا للغة الصينية في عام 2014م[13].

غلاف كتاب الإجرام السياسي الصادر عن مركز نهوض عام 2018م
وتنبع أهمية هذا الكتاب في تأكيده في ذلك الوقت المبكر على ضرورة تنظيم وتأطير العلاقة بين الأخلاق والسياسة، فلقد رأى مؤلفه لويس بورال أن ظاهرة الإجرام السياسي يتحتم ثبر أغوارها بوصفها إحدى المعوقات الأساسية التي تحول دون كفاءة العملية السياسية، وبالتالي فمن المهم إكساب الممارسة السياسية مسحة أخلاقية إنسانية عامة تجعلها أكثر انضباطًا بقيم الصدق والتسامح والعدالة وغيرها من القيم.
وفيما يتعلق بالواقع العربي الراهن ومدى احتياجه لمثل هذا الكتاب فمن دون شك أن المراحل الانتقالية التي تمر بها المجتمعات والدول -كمجتمعاتنا العربية الآن- حيث تزداد بها فرص حدوث الجريمة السياسية في ظل الصراع السياسي بين كافة الأطراف للاستحواذ على السلطة، هي أكثر المراحل التي تتطلب ضبط ممارساتها السياسية أخلاقيًّا، إذ يأتي العمل على إعادة طباعة ونشر هذا المؤلف في وطننا العربي عقب ثورات الربيع العربي، والتي كان لها دور مهم في محاولات إعادة تشكيل الواقع المعاصر وكذلك الفكر السياسي والقانوني والاجتماعي، وأضحت المنطقة أكثر قابلية لتقبل أفكار جديدة بل وتجريبها على محك الواقع حيث قلَّت الثقة في النظم القديمة ومدى قدرتها على الخروج من حالة عدم الاستقرار فيما بعد الربيع العربي.
ومن هنا فإن إعادة نشر هذا الكتاب في ذلك التوقيت هو فعل يكتسب أهميته تأسيسًا على احتياجات الواقع الراهن الذي انحرفت فيه الممارسة السياسية لدرجة الجريمة، ومن ثَمَّ حاجتها لمعالجات ذات نزعة أخلاقية بالأساس تُترَجم لفعل سياسي ومواد قانونية ودستورية تؤطرها، وذلك إذا ما أُريد بناء نهضة حقيقية لهذه الأمة من شأنها أن تُمثِّل انعتاقًا من واقعها الحالي بكل ارتهاناته.
وبالمجمل فإذا ما حاولنا تحديد قيمة وأهمية هذا المؤلف بشكل أكثر وضوحًا، ليس للواقع العربي فحسب بل للواقع والفكر الإنساني بصفة عامة، فلن نجد أبلغ مما أشار إليه "فرانكلين جيدنجز "Franklin H. Giddings في مقدمة ترجمته للكتاب إلى اللغة الإنجليزية والذي عدَّد ذلك في كون هذا الكتاب[14]:
- استطاع التشكيك في المعتقد السياسي الراسخ لدي كثيرين في وقتها بأن -الغاية تبرر الوسيلة- بل وراهن المترجم أنه في المستقبل القريب ستعي الشعوب ضرورة التزام السياسيين بالمبادئ الأخلاقية دون الاهتمام بتفعيل الأجندات السياسية وحدها.
- توسيعه للعينة المسحية التاريخية للبحث على مدى فترة طويلة من الزمن متحديًا في ذلك الصعوبات، مع إبرازه لوجهة نظره في كل حالة، من خلال إسهابه في الأمثلة التاريخية التي قام بنقلها بصورة محايدة من الوثائق التاريخية الأوروبية.
- يُعَدّ هذا الكتاب -بحسب المترجم للغة الإنجليزية- أول محاولة قامت بتوظيف العلوم الحديثة في تحليل وإثبات القناعة القديمة بأن- الاستقامة ترفع من شأن الأمة Righteousness exalted a Nation.
- من شأن هذا الكتاب أن يزود الباحث والرجل العادي بدراسة نقدية حول الجرائم السياسية المختلفة مما يوفر الوقت والجهد للباحثين، كما يوفر معلومات جيدة حول النظريات السياسية السائدة قبل أكثر من قرن من الزمان.
- نأى الكاتب بنفسه عن السفسطة الفكرية لدى العديد من المفكرين والتي تعتمد على عدد من الاعتقادات المأثورة الفاسدة، كالقول بأن السلامة العامة هي القانون الأسمى وذلك دون الحاجة للالتزام بمبادئ العقل والشرف والاعتبار، وكالقول بأن الخداع والكذب أمر مشروع في الحروب وفي المعارك السياسية، وأن الكذب هو أحد أوجه الدبلوماسية السياسية. حيث يقودنا ذلك إلى القول إن السرقة والتشهير والظلم وغيرها من الجرائم الأخرى يمكن تبريرها في الإطار السياسي إذا كانت لها غاية تحقيق هدف سياسي.
- ويواصل السيد فرانكلين جيدنجز تأكيده على التأثير الكبير الذي أحدثه هذا الكتاب، بأنه قد صاحب صدوره صحوة أخلاقية كبيرة، والتي كان الكاتب لويس بورال أحد المشاركين في إشعال جذوتها بكتاباته، فلقد اعتنى المفكرون في العصر الذي سبق صدور هذا الكتاب بالعلوم والنظريات الفكرية المتجردة عن القيم والأخلاق، وفيما يتعلق بالسياسية فقد ركزت على تطبيق النظريات السياسية بدلًا من الاهتمام بالنظر في مدى التزام السياسيين بالمبادئ الأخلاقية، ويعد هذا الكتاب أحد الجهود الحثيثة التي كان نتيجة لها تعالي الصيحات المطالبة بعودة السياسة للأخلاق، في ظل تزايد وعى الشعوب بضرورة التزام السياسيين بالمبادئ الأخلاقية، من خلال تجريم أفعال الانحراف السياسي[15].
وبمرور الوقت تطور الفكر الوارد في هذا الكتاب، وغيره من الأعمال المشابهة، إلى نظريات إنسانية تجسدت في صورة مواثيق ومؤسسات دولية تُعنى بمعاقبة ومحاكمة المجرمين السياسيين على جرائمهم ضد شعوبهم والإنسانية بشكل عام، كمحكمة العدل الدولية International Court of Justice في لاهاي، وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية أو الأهلية.
ومع هذا كله فلا يمكن الجزم بأن أفكار "لويس بورال" الأخلاقية والإنسانية، ورفاقه في هذا الفكر، قد لاقت انتشارًا كبيرًا في أنحاء العالم في واقعنا المعاصر، حيث لا تزال المدرسة الميكافيلية هي المسيطرة بصورة كبيرة على مجريات السياسة المحلية والدولية، وعليه، فأمام الإنسانية الكثير من الجهد لتبذله في هذا الحقل المعرفي، ومن ثَمَّ إنزاله على الواقع السياسي.
والسؤال الآن: ماذا أضاف الكتاب للفكر والواقع السياسي والقانوني؟
يمكن بشكل عام إجمال ما تركه هذا الكتاب من تأثير في الواقع السياسي الميداني إضافة إلى تأثيره الفكري السياسي والقانوني بشكل رئيس في ثلاثة مجالات رئيسة:
المجال الأول: أن هذا الكتاب مثَّل صيحة احتجاج فكرية وقيمية وثقافية قوية ضد المدرسة الميكافيلية النفعية وسيطرتها علي الواقع السياسي، والمتجردة من أي قيم أخلاقية، مؤدية إلى حروب وصراعات سياسية لا تنتهي، ومن هنا طرح بورال البديل وهو حتمية عودة علم السياسة مرة أخري لمربع الأخلاق، ومن ثَمَّ إعادة تموضعه حول تلك القيم الإنسانية والأخلاقية العامة ليكتسب مكانته المركزية اللائقة به، لقد رأى بورال أن ذلك ليس ترفًا فكريًّا بل ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضمير البشرية، إذا ما كنا نبحث عن حياة أكثر إنسانية وقيمية، يقول بورال في ذلك: "إذاَ كَانَ العِلمُ بِدُون ضَمير خَرَاب الرّوحِ... فَإِنْ السِّيَاسَةَ بِلَا أَخلَاقٍ هِي خَرَابُ الإِنسَانِيَّة".
المجال الثانى: ساهمت أطروحات "بورال" مع شركائه في هذا الفكر خلال القرن المنصرم في دعم مسيرة وحركة قانونية وسياسية ساهمت في إصدار تشريعات قانونية وسياسية دولية تُجرِّم وتعاقب جرائم الحروب، وتُغلِّظ العقوبات ضدها بل واعتبارها جرائمَ لا تسقط بالتقادم، وإنشاء مؤسسات حقوقية وقضائية متخصصة في هذا الشأن، والسعي نحو تقييد الأنظمة السياسية المحلية بما يحد من ارتكابها جرائمَ ضد شعوبها ، كقمع حرية الفكر ورفض التعددية السياسية وفرض رؤية أحادية على مجتمعاتها، ومنع تغول تلك الأنظمة الحاكمة على سائر السلطات، وضمان استقلال القضاء والإعلام والجيش وحياد القائمين على العملية الانتخابية ومنع تزويرها، وهي كلها جرائم سياسية عدّدها بورال في مؤلفه هذا مؤكدًا ضرورة تصدي المجتمعات الإنسانية لها.
كما ساهم لويس بورال في بلورة الشروط الواجب توافرها في العمل السياسي، وما يشترط أن يحكم هذا العمل فكريًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا، وساعد في إثارة حراك فلسفي وثقافي في هذا الفضاء، عبر دعوته وتأصيله لتجريم أي انحراف في العمل السياسي، والذي تطور ليصبح أحد أبرز قضايا الفلسفة السياسية في تاريخنا الحديث من خلال تبني العديد من الفلاسفة والمفكرين لإشكالية العلاقة بين العمل السياسي والأخلاق، وقد كان من أبرز من جسدها في حقبة ما بعد لويس بورال الفيلسوف الألماني الكبير ماكس فيبر في كتابه "العلم والسياسية بوصفهما حرفة"[16]، إذ تناول فيه مدى إلزامية أن يكون العمل السياسي مشروطًا بقيم دينية أو ديمقراطية أو إنسانية أو براجماتية ميكافيلية، وقام ببناء تصور فكرى وفلسفي تجسَّد في ضرورة هيكلة وتنظيم الدولة بما يساهم في معالجة هذه الفرضية[17].
ومن دون شك فالحضارة الغربية قد استفادت كثيرًا مما طرحه بورال وآخرون فيما يتعلق بتطوير منظومة حقوق الإنسان وتأطيرها بإطار تشريعات وقوانين لكنها مع هذا كله لم تبلغ الكمال بعد، ولا حتى الحد الأدنى الذي تتغياه البشرية بما يحفظ كرامتها الإنسانية.
إذ رغم كل هذه المسيرة الإيجابية إلا أنه يجب الاعتراف والإقرار أنه قد شابها نوازع غير أخلاقية، فعلى الرغم من تطور ورقي التشريعات الدولية وأهداف المؤسسات الحقوقية، إلا أنه يتم التعامل معها في كثير من الأحيان بشكل مصلحي وانتهازي، حيث تُهيمن عليها القوى الكبرى التي كثيرًا ما تسعى إلى توظيفها في لعبتها السياسية بعيدًا عن جوهر وأهداف هذه المواثيق، وبما يخدم برامجها ومصالحها النفعية الذاتية، وليس من منطلق مثالية القيم الأخلاقية ومقتضيات العدالة.
المجال الثالث: ما أحدثه هذا الكتاب من تأثير كبير في العلوم السياسية وتحديدًا تأثيره في علم الإدارة العامة، وأهمية استقلال وحياد السلطات والإدارات المختصة بإدارة الدولة وتحقيق مصالح المواطنين، بعيدًا عن التوجهات الحزبية بشكل يُحرِّرها من سطوة نظرية الغنيمة spoils system عليها، والذي ظل مسيطرًا لوقت طويل على الإدارة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والذي كان نظامًا سياسيًّا وإداريًّا يُمثِّل حزمة من الأفكار والممارسات اللَّأخلاقية في الحكم تحت إطار شرعي وقانوني زائف، سقط تحت ضغط ثورة سياسية وأخلاقية قضت عليه وحوَّلت مفرداته إلى جرائم قانونية وسياسية واستبدلت به نظرية استقلال وحياد الإدارة العامة في تجربة إيجابية وفريدة سياسيًّا وقانونيًّا وإداريًّا.
ويعود نظام الغنيمة سيئ السمعة هذا، والذي كان مهيمنًا على الإدارة الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الأنظمة الأوروبية، إلى بدايات القرن العشرين، ووفقًا لهذا النظام فالحزب المنتصر في الانتخابات من حقه أن يكافئ مؤيديه بتسكينهم في المناصب الإدارية بغض النظر عن الكفاءة وعن أحقيتهم بذلك، وهو ما يعتبر من منظور فكر لويس بورال ومدرسته الفكرية تصرفًا لا يعدو كونه مجموعة من الانحرافات السياسية التي يتحتم تجريمها، فقد كانت كافة المزايا والخدمات تؤخذ من الحزب الخاسر وتُعطى للحزب المنتصر، ومن ضمن هذه المزايا كانت الوظائف العامة، والتي يتم التعامل معها كغنيمة للحزب الفائز، فيقوم بإقصاء كافة الموظفين الحكوميين الذين ينتسبون للأحزاب الأخرى من مواقعهم الوظيفية وتعيين أنصاره وأعضائه بدلًا منهم[18].
وفي بادئ الأمر كان هذا التغيير في الهيكل الوظيفي للجهاز الإداري للدولة يتم مع كل تداول للسلطة بصورة معتدلة في معظم الأنظمة، إلا أنه في ظل تقلد الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون[19] Andrew Jacksonمقاليد السلطة تغير الأمر حيث تم تطبيق هذا المبدأ الانتهازي بصورة متطرفة ومبالغ فيها، وذلك بسبب كثرة الوعود التي أخذتها الحملة الانتخابية لجاكسون على نفسها، إذ وعدت أنصاره بتوليهم كثير من الوظائف الحكومية في حال فوزه في الانتخابات، وهو ما تحقق بالفعل، حيث صدر في عهده قانون الوظائف العامة والذي ربط بين فترة خدمة الموظفين في الوظائف العامة، والفترة الرئاسية والتي تستمر لأربعة سنوات، وأنه من حق الحزب المنتصر في كل انتخابات أن يُعيد تشكيل الجهاز الإداري للدولة كيفما يشاء، ومن ثَمَّ فقد قام الحزب الحاكم بتغيير الهيكل الوظيفي للجهاز الإداري للدولة، بمنح أنصاره كثيرًا من الوظائف،حتى إن نسبة هذا التغيير بلغت 10% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة[20].
قد يؤدي بقاء الموظفين مدة طويلة في وظائفهم إلى عدم اكتراثهم للمصلحة العامة، والعمل على تعزيز مصالحهم الخاصة، مما يدفعهم إلى التعامل مع الوظيفة العامة كإرث خاص بهم.
وقد ساق المؤيدون لهذا التصرف عدة تبريرات منها أنه يتحتم تعميم فكرة الديمقراطية وتداول السلطة في الوظائف العامة للدولة؛ فالموظف العام -وفقًا لرأيهم- يكون عرضة للفساد، واستغلال نفوذه وسلطاته في حال دوام الوظيفة العامة[21]، كما قد يؤدي بقاء الموظفين مدة طويلة في وظائفهم إلى عدم اكتراثهم للمصلحة العامة، والعمل على تعزيز مصالحهم الخاصة، مما يدفعهم إلى التعامل مع الوظيفة العامة كإرث خاص بهم، وأن هذا التغيير في الوظائف هو أحد وسائل الإصلاح الإداري وتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، بإحلال موظفين أكثر كفاءة، إلا أنه اتضح فيما بعد أن جميع هذه الحجج كانت باطلة، وأن المعيار الوحيد في الاختيار كان الولاء السياسي للنظام الحاكم.
وعلى الرغم من الإيجابيات التي حققها هذا النظام في بادئ الأمر إلا أنه سرعان ما انكشفت عيوبه، فقد أدى إلى انتشار الفوضى في صفوف الموظفين الذين كانوا يعلمون سلفًا أنهم سيبقون لمدة محدودة في وظائفهم، ومن ثَمَّ حاولوا الحصول على أكبر كم من الغنائم فانتشرت الرشوة والفساد الإداري[22].
وقد استمر العمل بهذا النظام حتى تم اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس جارفيلد James Garfield عام 1881م[23]، إذ اغتاله أحد المتضررين من نظام الغنائم والذي تم رفض طلبه بتقلد أحد الوظائف بسبب انتمائه السياسي، وتصف العديد من الكتابات الأمريكية هذه الحادثة بأنها كانت أحد الأسباب القوية لإصلاح نظام الخدمة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة النظر في طرق تولي الوظائف العامة ومحاولة فصلها عن التوجهات السياسية، فقد أدى تزايد الاعتراضات من قبل الموظفين المتضررين من تطبيق نظام الغنيمة بالإضافة إلى عدم استقرار الجهاز الإداري للدولة، إلى تعالي الدعوات المنادية بضرورة إصلاح نظام الخدمة المدنية، وتقرير الاستقلالية اللازمة له عن السياسة، وتكلَّلت هذه المطالب في الولايات المتحدة الأمريكية بصدور قانون بندلتون Pendleton Act في العام 1883م[24]، والذي خفّف من وطأة نظام الغنيمة، حيث نص على إنشاء ديوان الخدمة المدنية Civil Service Commission [25] والذي يتشكل من أعضاء من الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي، ويختص بتنظيم الالتحاق بالوظائف العامة بناء على المنافسة القائمة على الكفاءة والجدارة، دون النظر إلى التوجه السياسي أو الحزبي.
وتأسيسًا على ذلك تم فصل نظام الخدمة المدنية عن النشاط السياسي، وامتد ذلك إلى المطالبة بضرورة فصل الإدارة العامة للدولة عن السياسة، حيث وضع الرئيس الأمريكي الأسبق ودروو ويلسون Woodrow Wilson [26] أُسس هذا المبدأ في العام 1887م، في مقالته دراسة الإدارة العامة Administration The Study of، والتي طالب فيها بضرورة الفصل بين الإدارة العامة والسياسة كي لا ينتقل الفساد السياسي إلى علم الإدارة.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الفيلسوف الألماني الكبير ماكس فيبر كان واحدًا من المتأثرين والمتفاعلين مع مدرسة أخلاقية السياسية التي ساهم بورال وغيره بأطروحاتهم في خلق فكر ومناخ رافض لنظام الغنيمة وداعيًا لاستقلال الإدارة وحيادها عن السياسة، حيث يقول في أطروحته "العلم والسياسة بوصفهما حرفة" : "ولكن ماذا يعني نظام الغنائم هذا، القائم على تحويل كل الوظائف الفيدرالية إلى أتباع المرشح الناجح، بالنسبة لي هي بكل بساطة أحزاب لا عقيدة لها، ومتعارضة فيما بينها، إنها مجرد تنظيمات تسعى إلى اصطياد المراكز فتغير برامجها في كل معركة انتخابية تبعًا لحظوظها في جمع الأصوات، ثم إن بنية الأحزاب قد تم تفصيلها على شكل المعركة الانتخابية الضرورية كليًّا لحصد الوظائف "ويؤكد السلبية الميدانية لهذه الممارسة السياسية غير الأخلاقية حيث يشير إلى سياسات تعيين الموظفين بناءً على ولائهم السياسي وليس المهنى فيذكر أن تعيينهم يتم على معيار أنهم: "من بين أعضاء الحزب المنتصر لا كفاءة عندهم إلا ماقدموه للحزب الذي ينتمون إليه من خدمات ساهمت في فوزه بالانتخابات، قد أدى مع الوقت إلى ظهور مساوىء لا تُحتمل من فساد وتبذير لا مثيل لهما ولايمكن احتمالهما" [27].
وفي التحليل الأخير يمكن القول إن هذا الكتاب قد ساهم في محاصرة نظام الغنيمة وتقليص انتشاره دوليًّا حتى تأسس مبدأ استقلال وحياد الإدارة العامة، وتم تأصيله دستوريًّا وقانونيًّا.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المضمار أن الفكر الإنساني والحقوقي الذي كان قد دعا إليه "بورال" قد بدأ في الازدهار في النصف الثاني من القرن الماضي في الغرب، وتحديدًا بعد سقوط المعسكر الشيوعي، ورغم كل النقص والعوار الذي يعتريه إلا أنه يُمثِّل منجزًا إنسانيًّا كبيرًا، ولكنه للأسف لا يزال متراجعًا كثيرًا في عالمنا العربي والإسلامي رغم وجود ميراث وتراث تاريخي قديم في الحضارة الإسلامية من شأنه أن يدفع باتجاه هذا الفكر الأخلاقي الإنساني، ويُعضده إذا ما حسُن توظيفه وتأطيره دستوريًّا وقانونيًّا.
إذًا فتلك هي بعض الأسباب التي دفعت لإعادة نشر هذا الكتاب الآن، وتحديدًا في عالمنا العربي، فالإشكاليات الرئيسة التي حاول الكتاب معالجتها في وقتها لا تزال حاضرة بقوة في المشهد العربي الراهن، فها هي الممارسة السياسية الحالية بعيدة كل البعد عن أي ضوابط أخلاقية وتعتمد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وما يقود إليه من نفعية برجماتية، كما أن المسيرة القانونية لحقوق الإنسان وحرياته لا يزال أمامها الكثير لتنجزه، وها هي الإدارة العامة للحكم في عالمنا العربي غير مستقلة وغير محايدة وتخضع للاستغلال والتوظيف السياسي الانتهازي والمصلحي.
السياق التاريخي والسياسي للكتاب
الآن وقبل الانتقال لتناول أبرز أطروحات هذا الكتاب الذي بين أيدينا نجد أنه من المهم إلقاء الضوء على السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي كُتب فيه وكان استجابة له أو رد فعل عليه، وذلك إذا ما أردنا تفهُّم تلك الأطروحات بشكل أكثر عمقًا.
بدايةً يمكن القول إن هذا الكتاب قد ظهر في إصداره الأول بفرنسا منذ ما يقارب قرنًا وربعًا من الزمان، أي في نهايات القرن التاسع عشر، وهي فترة كانت تسيطر عليها بشكل كبير في المجال السياسي الأطروحات الميكافيلية للمفكر الإيطالي الشهير نيكولو مكيافيلي Niccolò Machiavelli [28]، والتي بلورها في كتابه الأمير The Prince ، فأمير ميكافيلي هو ذلك الحاكم المطلق، والذي يجد مصلحته في بذر الشقاق بين رعاياه ليحكمهم، لقد تمركزت أطروحات ميكافيلي في معظمها حول سيادة المصلحة ومحاولة تحقيقها بأية وسيلة بغض النظر عن مدى أخلاقيتها، واستشراء النزعة النفعية البرجماتية، والتي فرضت نفسها بشكل كبير علي أرض الواقع في ذلك الوقت، لقد بلغ الأمر بميكافيلي إلى أن ذهب إلى أن السياسة ينبغي أن تتحلل من أي نزعة أخلاقية باعتبار الغاية تبرر الوسيلة، وعندما يرغب السياسي في تحقيق غاية ما فله في ذلك أن يتبع أيًّا من الوسائل دون اعتبار لأي قيود أخلاقية أو إنسانية.
في المقابل كانت لا تزال مبادئ الثورة الفرنسية الداعية إلى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح حاضرة في المشهد الفكري والسياسي، إلا أنها بقيت مبادئ حبيسة العقول والكتب ولم تُطبّق على أرض الواقع، ومن ثَمَّ كان المؤلف واحدًا من الذين يريدون إنزال تلك القيم على واقع مُثقل بالنفعية، إذ قادته نفعيته تلك للكثير من الحروب والصراعات السياسية التي لم تجلب للبشرية سوى الدمار بشكل وضعه على حافة الفوضى.
لقد تأثر الكاتب كثيرًا بأفكار الثورة الفرنسية والتي نادت بترسيخ مبادئ الأخلاق والعدل والإنسانية، ومن ثَمَّ سعى إلى تفعيل تلك الأسس في عالم السياسة، وذلك بدعوته لضرورة إحداث تقارب بين السياسة والأخلاق في محاولة منه لإنقاذ البشرية من خطر محدق ودمار محقق، إذا ما ظلَّت تسير بذات الاتجاه البراجماتي النفعي المتحلل من أي ضوابط أخلاقية.
لقد مثلت الصورة الفرنسية صيحة احتجاج على أوضاع قديمة فاسدة، كان أحدها استخدام الأساليب العنيفة ضد المعارضين السياسيين من قبل الأنظمة الحاكمة في الممالك الأوروبية في العهد الوسيط، والتي أدت إلى تزايد الدعوات المطالبة بمعاملة المعارضين السياسيين المصنفين كمجرمين معاملة إنسانية؛ لأنهم ينطلقون من أفكار ودوافع شريفة تختلف عن دوافع المجرمين العاديين من قتلة ومزورين ولصوص ومنتهكي أعراض[29].
ويرى أحد أساتذة العلوم الجنائية الفرنسيين أن الناس منذ العصور الأولى، كانوا ينظرون إلى المجرمين السياسيين نظرتهم إلى المجرمين الذين يستحقون أشد العقوبات، غير أن نظرتهم سرعان ما تبدلت، وكان أول بوادر التحول القرار الذي اتخذه مجلس النواب الفرنسي عام 1789م بعد الإطاحة بالنظام الملكي، والذي منح حق اللجوء السياسي لكل من يدخل البلاد هربًا من تعسف حكام بلاده، وحين وصل لويس فيليب الأول Louis Philippe I إلى السلطة، أكد نظامه عام 1830م أن بلاده لن تُبعد أي مجرم سياسي دخلها لاجئًا، وهي لن تطلب استرداد أي مجرم فرنسي غادر بلاده لدافع سياسي، وفي عام 1832م أصبح الإجرام السياسي مفهومًا قانونيًّا واضحًا، إذ أصبح يعاقب بعقوبات سياسية خاصة تختلف عن العقوبات العادية، وفي عام 1848م ألغيت عقوبة الإعدام عن الجرائم السياسية، وأصبح المجرمون السياسيون يعاملون في السجون معاملة خاصة كريمة[30].
من هنا يمكن القول إن هذا الكتاب قد جاء كرد فعل ضد أطروحات المدرسة الميكافيلية النفعية من ناحية، واستجابة لمبادئ وقيم الثورة الفرنسية من ناحية أخرى، ومن ثَمَّ قام المؤلف بتوجيه سهام نقده للأنظمة السياسية المتحررة من الأخلاق والقائمة بالفعل في عالم الواقع، ثم دعا إلى إعادة السياسة لحظيرة الأخلاق وبخاصة المستمدة منها من الأديان باعتبارها أكثر شمولًا وعمقًا.
غير أنه يجب أن نعترف أن المقترحات والحلول التي ساقها الكاتب ربما كانت مناسبة لوقت صدور الكتاب وظروفه، أما فيما يتعلق بواقعنا الحالي فهي من دون شك بحاجة لتطويرها وتقنينها قانونيًّا ودستوريًّا بعد الاحتكام للشعب الذي هو صاحب السيادة الحقيقية، ومن ثَمَّ إنزالها على الواقع الذي تبدل كثيرًا مقارنة بالواقع الذي صدر فيه الكتاب أول مرة.
إذن فذلك هو السياق الاجتماعي والتاريخي السياسي الذي صدر فيه الكتاب حاملًا عددًا من الأطروحات المركزية، وهي الأطروحات التي سنحاول إلقاء الضوء على أبرزها في الفقرات التالية.
الأطروحات المركزية للكتاب
يدور المؤلَّف الذي بين أيدينا حول عدد من الأطروحات المركزية التي حاول الكاتب ثبر أغوارها، والتي تدور في مجملها حول حتمية إكساب الممارسة السياسية أبعادًا أخلاقية وإنسانية عامة هروبًا من المصير القاتم للبشرية الذي جرتها إليه القيم المادية النفعية الغربية القائمة على الأطروحات الميكافيلية، ولعل أبرز أطروحات "بورال" هي:
أن الحضارة الإنسانية وعلى الرغم مما حققته من تقدم وتطور في العديد من النواحي العلمية والفكرية إلا أنها في الجانب السياسي قد انتكست انتكاسًا كبيرًا بانفصالها عن الأخلاق، ومن ثَمَّ انزلقت إلى ممارسات سلبية مثل الرياء والنفاق والخداع والنفعية، يقول بورال: "لقد تقدمت المدنية بالإنسانية في كل ناحية من نواحيها إلا السياسة فإنها لا تزال مرتعًا فسيحًا للغش والدس وخنق الحق والحرية. فالجماعة الإنسانية الفخورة بما وصلت إليه من تقدم صناعي واختراعات علمية، لتطأطئ الرأس خجلًا كلما فكرت فيما آلت إليه أخلاقها السياسية والمالية، وكما يقول أحد المفكرين الفرنسيين: (كل شيء عندنا يتقدم إلا الأنظمة السياسية، فإنها بما تقع فيه من أخطاء تسلبنا دائمًا كل منفعة قد تعود علينا).
يرى بورال أن السياسة قد هوت إلى الدرك الأسفل بانغماسها في ممارسات إجرامية ولا أخلاقية، ففي الأوساط السياسية أصبح "كل شيء مباح" فإذا كان الكذب منبوذًا في الأمور العامة، إلا أن كذب السياسيين على شعوبهم هو أمر مستساغ في الغالب، وإن كان القتل يعتبر انتهاكًا وهدمًا للبشرية، إلا أن القتل السياسي قد مورس من جانب العديد من الحكومات تجاه المعارضين والعكس، وذلك اعتمادًا على أن الغاية تبرر الوسيلة.
لعل الفكرة العبقرية التي حملها هذا الكتاب، والتي دفع بها لويس بورال إلى الحد الأقصى هي أنه لا تعارض بين المصلحة وبين الأخلاق، فالتزام الممارسات الأخلاقية في السياسة سيقود إلى تحقيق مصالح الجميع، وأن المصالح التي تتحقق بوسائل لا أخلاقية سرعان ما تجر الويلات على المجتمعات الإنسانية.
مؤكدًا أنه قد يأتي الدهاء والعنف السياسي بنجاح مؤقت ولكنه سيزول حتمًا، كما أن السياسة الفاسدة أخلاقيًّا لا يمكنها أن تُحقق عظمة الوطن ورفاهيته، فالنجاح وليد السياسة الفاسدة لا دوام له، ولقد شهد التاريخ العديد من التجارب السياسية التي تُدلِّل على إمكانية نجاح السياسة دون إخلال بالأخلاق، بل ويُعلن بورال تحديه للمقولة السائدة في عصره بأن الخداع والعنف من حتميات الممارسة السياسية، فيقول: "ومهما قيل فإن الخداع والعنف ليسا من ضروريات السياسة، وكلما ازدادت الهيئة الاجتماعية تنورًا استطاعت السياسة أن تزداد اكتمالًا، فليس الفساد طريقة لا مفر منها للحكم".
ومن ثَمَّ يخلُص إلى أن: "المسألة السياسية هي مسألة أخلاق قبل كل شيء، وينبغي أن يكون هدف السياسة الحقيقي السعي لجعل الناس أكثر فهمًا وأنقى أخلاقًا واتحادًا وسعادة "مؤكدًا أن تمسك السياسيين بالقيم الأخلاقية من شأنه أن يؤدي إلى تجنب العديد من الأخطاء السياسية، يقول بورال بهذا الشأن: "لو أن الساسة كانوا أكثر احترامًا للأخلاق لتجنبوا أخطاء سياسية جمة، فكثيرًا ما تكون أخطاؤهم السياسية أخطاءً أخلاقية. فتفكيرهم السليم ومهارتهم تضعُف بنسبة ابتعادهم عن الإنصاف".
يؤكد بورال أن السياسة القائمة على الفساد وعدم احترام الأخلاق هي سياسات بدائية ولا تليق بالمجتمعات المتحضرة التي يتحتم أن تُدار اعتمادًا على مبادئ العدالة واحترام الحقوق.
يذهب لويس بورال إلى أنه لا مفر من عودة السياسة لانتهاج المبادئ والقيم الأخلاقية وردها إلى الأخلاق ردًا جميلًا إذا ما أردنا الخروج من الهوة السحيقة التي اقتيدت إليها البشرية بفعل انخراطها في سياسات نفعية لا أخلاقية، إذ يقول: "فقدت السياسة مكانتها بسبب الالتجاء إلى الوسائل المجرمة واعتناق المبادئ الفاسدة، وذلك ببعدها عن الأخلاق، لذا فلا بُدَّ أن تنتهج السياسة المبادئ الأخلاقية، فبدلًا من الكذب والخداع والمكر والرياء والعنف، فإن مبادئ مثل الصدق والتسامح والوضوح والعدل كفيلة بأن تنجو بالسياسة وبمجتمعاتنا من الوقوع في فخ الانحلال الأخلاقي والفساد السياسي. يؤكد بورال أن السياسة القائمة على الفساد وعدم احترام الأخلاق هي سياسات بدائية ولا تليق بالمجتمعات المتحضرة التي يتحتم أن تُدار اعتمادًا على مبادئ العدالة واحترام الحقوق؛ فيقول: "السياسة المبنية على الفساد سياسة عتيقة لا تليق بالجماعات العصرية، إنها تدل على احتقار للإنسانية وعداء لا محل له بين الحاكمين والمحكومين، ويجب أن تختلف سياسة الشعوب الحرة عن سياسة الملوك المطلقة، وأن يكون أساسها احترام العدالة والحقوق".
يذهب بورال إلى أن الشقاق بين السياسة والأخلاق كان من شأنه أن أدى إلى تلاشي الغايات العظيمة التي من أجلها كانت السياسة، وهي تحقيق الخير والصلاح والرقي لبني الإنسان، ومن ثَمَّ أصبحت ميدانًا للكذب والخداع وتحقيق مصالح وأطماع شخصية للسياسيين، يقول بورال: "فن الحكم ذلك الفن العظيم قد شوَّهه وبدَّل محاسنه الكثير من مبادئ خاطئة جعلته فنًّا للكذب والخداع والاضطهاد والإفساد، تحت ستر كاذب من العدالة الموهومة. وإنك لتجد بجانب السياسيين الذين حكموا لصالح الشعوب وتفانوا في سبيل النهوض بها، سياسيين آخرين استغلوا السلطة لقضاء مصالحهم وشهواتهم".
في مقارنة رائعة يؤكد بورال على خطورة المجرم السياسي مقارنة بالمجرم العادي، فالمجرم السياسي أكثر شرًّا وضررًا على المجتمع، إذ إن المجرم العادي يمارس إجرامه تجاه فرد واحد أو أفراد قلائل، فعدد ضحاياه محدود، أما المجرمون السياسيون فهم يفسدون ويخربون أممًا بأكملها بسياستهم وإدارتهم السيئة، كما أنهم يُفوِّتون على أممهم فرص الارتقاء والنمو، بل ويتمسكون بالسلطة رغبة منهم في زيادة منافعهم الشخصية على حساب مجتمعاتهم ويسعون للقضاء علي أي بديل حقيقي يرون أنه يهدد بقاءهم في تلك السلطة، يقول بورال في هذا الشأن: "ليس أشر على الإنسانية من الرجل الذي يدعو إلى التفرقة والبغضاء مدفوعًا بطمعه وجشعة وحسده. فالأشرار العاديون الذين تحاكمهم المحاكم إنما يقتلون أو يسرقون أفرادًا قلائل، فعدد ضحاياهم محدود، أما أشرار السياسة فتعد ضحاياهم بالألوف، فهم يفسدون ويخربون أممًا بأكملها".
ومع ذلك فالمجرم السياسي وكما يذهب البعض يَلقى العطف من داخل المجتمع والذي يخلق له الكثير من المبررات لتبرير فعله الإجرامي، وهو ما قد يُفسر عدم الاهتمام بدراسة الجريمة السياسية مقارنة بالجريمة العادية، مشيرًا إلى أهمية عامل الأخلاق في انتشار الجريمة السياسية، والنسبية في تعريف المجرم السياسي، فالثوار هم مجرمون سياسيون من وجهة نظر النظام، كما أن الحكام هم مجرمون سياسيون من وجهة نظر الثوار[31].
يؤكد بورال في معرض بحثه عن حلول جذرية لإشكالية انفصام العلاقة بين السياسة والأخلاق على أنه في محاولة الإصلاح لا يكفي تغيير الأشخاص السياسيين الفاسدين إلا إذا أعقبة إصلاح أخلاق الساسة الجدد، وإلا فقد استبدلنا فاسدًا بفاسد آخر، يقول بورال:" لا يكفي تغيير الأشخاص السياسيين إلا إذا أعقبه إصلاح أخلاقهم. فإذا كان الساسة الجدد مجردين من المبادئ كمن سبقوهم تمامًا، فكل ما يكون قد حصل هو أننا استبدلنا بقرة سمينة بأخرى هزيلة تود بدورها أن تُكدِّس الشحم".
لفت بورال الاهتمام إلى المعنى غير الشائع والمتداول للإجرام السياسي والذي رأى أنه أكثر خطورة وضررًا، فالمتداول في ذلك الوقت بل والآن في كثير من الأحيان هو الجرائم ضد الحكومات -الجرائم التقليدية-، مثل جرائم الخيانة العظمى ومحاولة قلب نظام الحكم، في حين أن المعنى الذي قصده بورال هو الجرائم التي يرتكبها السياسيون أو الحكومات أو الحكام أو المعارضون نتيجة لمبررات مزعومة بتحقيق مصلحة الدولة[32].
يُنبِّه "بورال" إلى أنه لا يجب إخلاء الميدان للسياسيين الفاسدين، ومن ثَمَّ يُحذر السياسيين الصالحين من النأي بأنفسهم عن الممارسة السياسية، وعليه يوجه سهام نقده لكل من أفلاطون وسقراط فقد كان أفلاطون مقتنعًا بأن السياسة والفضيلة لا يجتمعان، لذلك نصح الرجل العاقل ذا المبادئ والأخلاق بالابتعاد عن السياسة إذا شاء أن يعيش سعيدًا، وقدم سقراط النصيحة ذاتها، إلا أن بورال أكد أنهما لم يصيبا في ذلك الرأي، فالرجل الصالح الذي يشغل نفسه بالسياسية باعتبارها واجبًا، يجب ألا يرى في ذلك ما يشينه بل هو واجب عليه، فالضرر الذي يمنعه عن الأمة إرضاء لضميره يفوق ما يحتمله من جهد "فالابتعاد عن السياسة بحجة أنها لا تجتمع مع الأخلاق خطأ جسيم؛ لأنه من شأنه ترك الميدان خاليًا للفاسدين، وهو تصرف لا يدعو للإعجاب ولا هو بالماهر، فتقويم المنكر من أوجب الأمور".
أدرك لويس "بورال" في ذلك الوقت المبكر أهمية دور الدين في إضفاء أبعاد أخلاقية قيمية وإنسانية عامة على الممارسة السياسية، وهو ما أخذ ينتبه إليه كثير من المفكرين السياسيين في السنوات الأخيرة، إذ يقترح بورال أن العلاج الصحيح للأزمات السياسية التي تعصف بالدول، هو بالعودة بالسياسة إلى الأخلاق المستمدة من الأديان، حيث يستحيل تطوير السياسة بعيدًا عن مبادئ الأخلاق وروح الدين، فالتقدم الذي تم إحرازه في ميدان السياسة ما هو إلا نتاج التأثر الفلسفي بالمبادئ الدينية، فالسياسة كالحياة الإنسانية بحاجة إلى المبادئ والقيم الروحية والعقائدية، وفي ذلك يقول بورال:" إن التقدم الكبير المشاهد في ميدان السياسة هو في الواقع وليد التأثير الفلسفي والمبادئ الدينية، فالسياسة المجردة عن المبادئ سياسة وثنية لا تؤدي إلى تقدم الهيأة الاجتماعية"، ويضيف في موضع آخر: "معاداة الدين ليست من السياسة السليمة في شيء... إن العقائد الدينية تدعو إلى حسن الخلق، وأنه كلما زاد عدد المتدينين في دولة قلَّ فيها القلقون والفوضويون والاشتراكيون" [33]*، مؤكدًا أن: "الدين يعلمنا التضحية بالنفس واحترام الفقير ومحبته، ويُشعرنا بالمسئولية نحو الله ونحو الضمير".
ولعل تأكيد "بورال" على أهمية الاعتبارات الدينية هو من قبيل رد الفعل على ما واجهه الدين من موجة كبيرة من التشكيك في عصره، نتيجة الانتهاكات المتعددة التي مارسها رجال الدين في ظل هيمنة السلطة الثيوقراطية على أوروبا، مما أدى إلى انتشار أفكار تدعو إلى التشكيك في جدوى الأديان كردة فعل معاكسة ورافضة لتلك السلطة، فقد كانت الحضارة الغربية في ذروة انتصارها على الكنيسة وما تمثلة دينيًّا، ومن ثَمَّ ازدهرت الأطروحات العلمانية المعادية للدين والداعية للقطيعة معه، وهي الأطروحات التي دفع بها كثير من فلاسفة الثورة الفرنسية إلى حدها الأقصى؛ وعليه حاول العديد من المفكرين والمثقفين -وكان "لويس بورال" واحدًا منهم- حاولوا تأكيد أهمية الدين وما تحويه من قيم أخلاقية وإنسانية.
إذًا فتلك هي بعض الأطروحات المركزية التي تناولها "بورال" في مؤلَّفه الذي بين أيدينا، والتي تدور في مجملها حول حتمية العودة بالممارسة السياسية إلى الأخلاق لتجنب الواقع الكارثي الذي قادت إليه السياسات النفعية الميكافيلية التي أعلت من شأن المصلحة والمنفعة على حساب القيم والاعتبارات الأخلاقية مرددة مقولة: الغاية تبرر الوسيلة، باعتبارها مقولة تأسيسية للفعل السياسي.
ماذا يضيف الكتاب للفكر العربي المعاصر؟
والآن وبعد أن تم تناول أبرز الأطروحات المركزية التي ساقها "بورال"، يبقى التساؤل المتعلق بالمستقبل، ما الذي يمكن أن تقدِّمه هذه الأطروحات للفكر السياسي والقانوني العربي مستقبلًا إذا ما وجدت حظها من الانتشار والذيوع، ومن ثَمَّ أُجريت محاولات جادة من قبل الباحثين لتطويرها وإنزالها على الواقع الراهن؟
وكما سبق القول فالنشاط السياسي في جميع أنحاء العالم لا يزال يحكمه المبدأ المصلحي القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة، وبالرغم من النتائج العملية الوخيمة لهذا المبدأ وما جرَّه من ويلات على البشرية، إلا أنه لم تجر محاولات جادة لتقليص تأثيره في الممارسة السياسية، وهو ما أثار الكثير من المفكرين السياسيين ليبحثوا عن مخرج لهذا المصير الكارثي المتوقع أن تلقاه الإنسانية إذا ما ظلَّت تسير في الاتجاه ذاته، وكان الحل باعتقاد كثير منهم يتجسد في إعادة صياغة نظم سياسية جديدة من شأنها أن تُعطي مكانة مركزية للقيم الأخلاقية والإنسانية العامة في ضبط العلاقات بين الدول بل وبين الحكام والمحكومين في كل دولة، فهي تمثل عودة للأخلاق لكن بشكل أكثر تقنينًا.
ومن دون شك فالتطور الذي حدث في بعض الدول المتقدمة الحديثة في العقود الأخيرة قدم حلًّا لكثير من تلك الإشكاليات التي تناولها لويس بورال في مؤلَّفه، إذ أصبحت هذه الأنظمة أكثر احترامًا لقيم المواطنة وسيادة الأمة وتداول السلطة برضاء الشعب، وأصبحت القوانين مستمدة من الشعب ومعبرة عن قناعاته بشكل كبير، ونال القضاء كثيرًا من استقلاله، كما أن التداول للسلطة لم يعد يسمح بهذا التلاعب من قبل السياسيين، الذي كان ناجمًا بالأساس عن طول بقائهم في تلك السلطة، أضف إلى ذلك ازدياد وعي الشعوب بحقوقها، ومع ذلك يبقى الكثير أمام البشرية لتنجزه وتحديدًا ما يتعلق بإنفاذ المبادئ القيمية الأخلاقية لتنزع نزوعًا إنسانيًّا عامًّا.
كما نأمل أن تدفع أطروحات الكتاب وما يمكن أن تُثيره من جدل نحو إعادة صياغة خريطتنا المعرفية على المستوييْن العربي والإسلامي وفق تلك القيم الأخلاقية والإنسانية، ومن ثَمَّ حدوث حالة من الحراك الفكري في مجال إصلاح وتطوير الأنظمة السياسية بالمنطقة، وتنظيم الحياة السياسية بما يُقلِّص من الانحراف السياسي الأخلاقي ويدعم الاختلافات السياسية القائمة على أرضية من التسامح وقبول الآخر.
وفيما يتعلق بإدارة الحكم، فهذا الكتاب يُمثل -وكما سبق القول- صيحة نحو ضرورة تجريم استخدام الإدارة العامة كأداة في يد الكتل أو الأحزاب السياسية، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلًا والإفادة منه، وبخاصة في عالمنا العربي في مرحلته الانتقالية تلك، فالإدارة العامة ينبغي أن تبقى مستقلة ومحايدة عن أي توجهات حزبية أو تيارات سياسية، وأن تستمر في عملها بما يُحقق مصالح الأمة دون أن تخضع لأي طرف سياسي ليوظفها بشكل يحقق مصالحه الخاصة وأغراضه السياسية الضيقة.
فلا يزال جهاز الخدمة المدنية في الدول العربية يقع تحت وطأة نظام الغنيمة -الذي حذر منه بورال- فالوظائف العامة في الدول العربية هي غنيمة للسلطة الحاكمة، يتم من خلالها التفرقة بين المواطنين بناء على انتماءاتهم الحزبية وآرائهم السياسية، وبالطبع يكون هذا التمييز لصالح الموالين للنظام الحاكم، إذ يتم أخذ هذه الانتماءات بعين الاعتبار عند الاختيار من بين المرشحين لتولي أحد الوظائف، كما يتم إقصاء الموظفين الإداريين المعارضين للنظام السياسي، كما تستخدم الحوافز المادية والقمعية المتوافرة في أجهزة الإدارة في الدولة في شراء الولاءات وقمع الأصوات المستقلة والحرة، ولا شك أن هذا الأمر قد أدى إلى إفساد الإدارة العامة للدولة وأثر بصورة كبيرة في أدائها لعملها، إضافة إلى إفساد الحياة السياسية والمسيرة التنموية.
غير أنه بعد الربيع العربي وما أعقبه من تحولات تزايدت الآمال بضرورة إصلاح نظام الإدارة العامة وفصله عن السلطة الحاكمة، إلا أن هذه الآمال سرعان ما تبددت، ففي البلدان التي تولت فيها المعارضة الحكم بدأت تمارس السياسات ذاتها المتبعة من الأنظمة السابقة، فيما يخص الوظائف العامة، حيث تم إقصاء غالبية الموالين للأنظمة السابقة بدعوى الفساد وعدم قدرتهم على العمل في ظل المناخ الفكري والسياسي الجديد، وفي المقابل تم منح الموالين للأنظمة الجديدة الوظائف الحكومية وبخاصة الوظائف القيادية في المؤسسات الهامة لهذه الدول، وكأن الوطن العربي يُعيد إحياء نظام ما يطلق عليه الغنيمة في الإدارة العامة والذي ثبت فشله منذ فترة طويلة وكما سبق توضيحه.
السلطات الحالية في الدول العربية تلقي باللوم على قيادات المؤسسات الحكومية غير المتوافقة معها سياسيًّا بأنها تعمل على إفشال خطط التنمية.
والمثير للدهشة بحق أن الأنظمة الحاكمة الحالية في الدول العربية، تُعيد تكرار المبررات ذاتها التي اعتمد عليها المروجون لنظام الغنيمة في الولايات المتحدة في العام 1881م، بأن هذا التغيير ضروري من أجل إصلاح النظام الإداري، ومن أجل إنجاز السياسات الحكومية، بل إن السلطات الحالية في الدول العربية تلقي باللوم على قيادات المؤسسات الحكومية غير المتوافقة معها سياسيًّا بأنها تعمل على إفشال خطط التنمية، فتلجأ إلى إقصاء هذه القيادات، وتحل مكانها قيادات ذات انتماءات حزبية أو فكرية موالية للسلطة الحاكمة.
والتخوف الحقيقي من ترسيخ هذه السياسات يكمن في أن أي تغير لاحق لنظام الحكم في الدول العربية، سيؤثر بشكل كبير في الجهاز الإداري للدولة، فتداول السلطة قد يؤدي إلى تولي المعارضة الحالية للحكم، ومن ثَمَّ ستتخذ المبررات ذاتها لتسكين مؤيديها وأنصارها في الوظائف الحكومية، وقد يتحول الأمر إلى رشوة سياسية يتم الاعتماد عليها في الحملات الانتخابية.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق هو بداية بروز بوادر إصلاح في العالم العربي، وإن كانت تتمثل في تجربة وحيدة وهي التجربة التونسية -غير المكتملة-والتي بدأت تتخذ طريقها نحو تجذير مبدأ حياد الإدارة العامة، إذ تم تضمين هذا المبدأ في دستورها الذي أنهت اللجان التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي إنجازه بعد الثورة.
فقد اهتم بمبدأ حياد الإدارة في أكثر من موضع، فأورد المشرع في التوطئة الحياد الإداري ضمن متطلبات بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشارُكي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي للحكم وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها[34]، كما أورد المشرع التونسي مبدأ حياد الإدارة ضمن المبادئ العامة الواردة في الدستور[35].
ويأمل كثيرون أن يتم تعميم هذه المبادئ الداعية للحياد الإداري على سائر الدول العربية فكرًا وممارسة علاوة على التوسع في إصدار التشريعات التي تُعظِّم من التجريم السياسي الفقهي والقانوني في قضايا حقوق الإنسان وحرياته، والعمل على تفعيل المواثيق الدولية المتعلقة بمحاكمة المسؤولين السياسيين عن جرائمهم السياسية تجاه الشعوب، والإفادة بما حققه الغرب من إنجازات في هذا المضمار الأخلاقي والإنساني العام.
الجريمة السياسية في الثقافة والحضارة العربية والإسلامية
الملاحظة المركزية هنا، أن هذا الفكر الأخلاقي الإنساني الذي طرحه لويس بورال وآخرون بما يتضمنه من إدانات لممارسات الإجرام السياسي وتجريمًا لها، موجود بالفعل في التراث الفقهي السياسي الإسلامي، بل إنه نظر للجريمة السياسية نظرة شمولية فلم يقتصر على تلك الجرائم التي يرتكبها المعارضون وحسب بل والحكام أيضًا؛ إذ جعل إخلال الحاكم بوظيفته وواجباته تجاه مواطنيه جريمة سياسية وشرعية[36]، ولكن هذا التراث هو في حقيقة الأمر مطمور تحت ركام ضخم من الجدالات الفقهية والتاريخية، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا من الباحثين، على أن يسير هذا الجهد باتجاهين. الأول: في استخراج وتحرير هذا التراث الفقهي السياسي الأخلاقي والإنساني. والثاني: في تطويره في شكل مواد قانونية ودستورية يمكن إنزالها على الواقع السياسي الراهن.
فلا شك أن المتفحص لتاريخ الحضارة العربية والإسلامية ستتجلى أمامه حقيقة أساسية مفادها أن الإسلام من أكثر الحضارات -على المستوى الشرعي والأخلاقي والقانوني- تجريمًا وتأثيمًا للانحراف والإجرام السياسي منذ بداية قيام دولته داعيًا إلى أن تتسربل الممارسة السياسية -من قبل الحكام والمحكومين-لبوسًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا عامًّا.
وقد تجلت تلك الممارسات الإيجابية في أبهى صورها في معظم حقب الخلافة الراشدة، حتى العهد الأخير من خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه، والتي شهدت ظهور ما يمكن أن يُطلق عليه (الجرائم السياسية) في الحضارة والتاريخ الإسلامي إذ بدأت -وكما يرى البعض- بتجاوزات مالية وإدارية وسياسية في إدارة الدولة، إضافة إلى تصرفات بعض ولاة الخليفة عثمان رضى الله عنه وخاصة في العراق ومصر، والتي يرى البعض أنها مست حقوق ومصالح المواطنين، مما خلق حالة من الاحتجاج السياسي تجاه هؤلاء الولاة، والذي تطور ليتحول إلى معارضة سياسية وصل تأثيرها إلى عاصمة الخلافة -المدينة المنورة- ومن ثَمَّ نمت بشكل سريع لتتحول هذه المعارضة السياسية إلى حركة عنف انتهت بقتل الخليفة عثمان.
وبغض النظر عن التبريرات والتفسيرات المتباينة حول دوافع هذه الأحداث، ومن الجاني أو المجني عليه، إلا أنها في بحثنا هذا تُمثل البدايات الأولى لظاهرة الجريمة السياسية في التاريخ الإسلامي، بصورتيها سواء ارتكبت من قبل النظام السياسي أو ارتكبت من قبل قوى شعبية، ومن دون شك فما استتبعها من فتن سياسية وعسكرية كانت بداية تراجع على مختلف المستويات الحضارية انتهت إلى هيمنة النظام السياسي الحاكم على إرادة الشعوب المسلمة من ذلك التاريخ إلى اليوم، بما في ذلك تقلص مفهوم وتعريف الجريمة السياسية التي اختُزلت فقهيًّا وأخلاقيًّا، وتم حصر تعريفها في الخروج على النظام ومعارضته سياسيًّا فقط.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطورت هذه الظاهرة سلبًا بمرور الوقت، ليتقلص مفهوم الجريمة السياسية نحو تحصين الأفعال التي يرتكبها الحكام من خلال تبريرات فقهية تتذرع بالخوف من تفتت الأمة وانزلاقها لصراعات وفتن.
وعليه يمكن القول إن هذه المسيرة أوجدت مدرستين متناقضتين في موقفهما من تعريف الجريمة السياسية، سواء على المستوى الأخلاقي والفقهي الشرعي القانوني، أو على مستوى الممارسة السياسية الفعلية:
المدرسة الأولى: مدرسة تبرير الأمر الواقع، وهي المدرسة التي قلَّصت لدرجة التجاهل والإلغاء محاولات تجريم الممارسة المنحرفة سياسيًّا الصادرة من الحكام، إذ تبنت من خلال تقنين شرعي وقانوني يُحرِّم التوسع في ذلك سواء لدى السنة أو الشيعة، فمدرسة السنة -بصفة عامة- أنتجت تراثًا فقهيًّا يسوِّغ رفض الخروج على الحاكم أو حتى مناصحته علانية، وعدم تحميله أية مسؤولية تجاه شعبه، ومن ثَمَّ أعطته حماية وحصانة شرعية ضد أي مساءلة أو محاولة تجريم أيّ من أفعاله، بل بلغت الأمور ذروتها بتجريم من يعارض جرائم وانحرافات الحاكم بنزع الغطاء الديني عمَّن تسول له نفسه المعارضة بحجة أنه خروج على إجماع الأمة ومحاولة لتفريق صفها وجرِّها لحروب وصراعات داخلية من شأنها إراقة دماء أبنائها، وفيما يتعلق بالشيعة فقد أضفوا هالة من القداسة الدينية على الحاكم والدولة -الولي الفقيه- بحجة أنه نائب الإمام الغائب، وبالتالي فله من العصمة الشرعية ما تحميه من الوقوع في الخطأ، ومن ثَمَّ من التجريم الديني والقانوني لأي فعل من شأنه معارضته أو مساءلته عما يفعل.
وعلى هذا عرف التاريخ الإسلامي العديد من صور الإجرام السياسي، حيث واجه الفكر والفقه الإسلامي الجريمة السياسية بتجريم البغي، فالجريمة السياسية في اصطلاح فقهاء الإسلام تسمى بجريمة البغي، والمجرم السياسي يطلق عليه الباغي[37]. وأساس هذه الجريمة قوله تعالى: "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"[38].
والبغي يقصد به: "خروج جماعة من المسلمين لهم قوة وشوكة على الإمام أو الحاكم بقصد خلعه أو الامتناع عن تنفيذ ما يجب شرعًا". وعليه فإن البغي لا بُدَّ أن يقع أو ترتكبه جماعة مسلمة ضد الحاكم أو الإمام أو ولي الأمر، وهو في الوقت المعاصر رئيس الدولة، ويشترط بعض الفقهاء أن تتمتع هذه الجماعة بالقوة والمنعة، وأن يكون الهدف من هذا الخروج هو خلع للإمام لامتناعه عن أداء واجب أو إتيان فعل محرم[39].
ويتضح مما سبق أن مفهوم الجريمة السياسية في الفكر الإسلامي قد قُيِّد، واقتصر في حقبة ما بعد الخلافة الراشدة على المعنى التقليدي منه، وهو جريمة الأفراد ضد الحكام وليس العكس، فلا يوجد تجريم لأفعال الحكام في مواجهة الشعوب، وذلك بعكس عهد الخلافة الراشدة التي تقلَّص فيها انتشار الجرائم السياسية، فقد كان الخلفاء الراشدون يجابهون من قبل المسلمين بالنقد المر والعبارات الشديدة، فكانوا لا يجدون عضاضة في الاستماع إليها، وما لجأوا إلى تكميم الأفواه، أو اعتبار ذلك من قبيل الجرائم السياسية، وكانوا يقتدون بهدي الشريعة ويذكر حتى إن الخليفة عثمان بن عفان رفض رفع السلاح ضد معارضيه رغم قدرته على ذلك[40].
ومن مظاهر الإجرام السياسي الذي مورس في التاريخ الإسلامي غلق باب الاجتهاد والتجديد بالقمع وتحويل مسارة ليبحث في قضايا غير جوهرية، ومن ثَمَّ تقليص مبدأ حرية الرأي والبحث العلمي، وفي هذا الشأن يحدثنا الدكتور حسين مؤنس قائلًا: "ولم تتردد أداة الحكم الاستبدادي في استعمال العنف مع الفقهاء وأهل الفكر... فأصيب الفكر الإسلامي بالرعب وهو آفة الفكر الكبرى في كل زمان ومكان، ومن ثَمَّ ابتعد الكثير من رجال الفكر بعد ذلك عن الكلام في سياسة الأمة ومتاعب هذا الكلام، وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر في تلك العصور على النواحي الدينية والقانونية الصرفة. وأصبح المواطن المسلم يعيش دون إطار سياسي سليم. وخرجت الأمة من ميدان السياسة وحُرمت من شرف العمل في بناء أوطانها"[41].
وعليه، يرى كثيرون أن ما قُدِّم من تراث سياسي قد وُضِع في ظل مناخ استبدادي ساد الأمة لقرون طويلة، فهو مناخ قد ألقى بظلاله الكثيفة على الاجتهاد -وبخاصة في جانبه السياسي- ليس فقط بإغلاقه بل وبتوجيهه نحو إنتاج معرفي يبرر للاستبداد ويشرعنه، نعم هناك تراث ضخم من الاجتهاد، غير أنه يتحرك بجناحين. أحدهما عملاق، وهو الاجتهاد في فقه العبادات، والآخر قزّمته الظروف السياسية التي مر بها العالم الإسلامي، وهو فقه المعاملات وبخاصة الشق السياسي منه، وهو من دون شك يُعَدّ جرمًا سياسيًّا في حق الأمة إذ نأى بها عن مناقشة قضاياها المصيرية فخرجت من التاريخ وكان تخلفها الحضاري.
المدرسة الثانية: المدرسة الاجتهادية المقاصدية، وهي المدرسة التي بذلت جهدًا كبيرًا في محاولة منها لتجريم أي ممارسات سياسية سلبية من قبل الحكام تجاه الأمة، عبر تقنين تشريعات فقهية وقانونية من شأنها إحكام الرقابة على الحكام والأنظمة السياسية ووضعهم في دائرة المساءلة والمحاسبة من قبل الأمة أو من يُمثّلها، فهم يرون أن هيمنة المدرسة الأولى تاريخيًّا قد أدت إلى أن تكون الحضارة الإسلامية في أغلب الفترات حضارة غير مسائلة للحاكم مما أدى إلى عدم تطوير تشريعات جنائية فقهية في مجال الجريمة السياسية على الرغم من توافر أساسها سواء على مستوى الفكر أو الممارسة في التاريخ الإسلامي، وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة الإجرام السياسي بشكل كبير والذي زادت وطأته في الواقع المعاصر.
وفي هذا السياق يطرح البعض تساؤلًا على أتباع تلك المدرسة الثانية: في ظل استشراء ظاهرة الإجرام السياسي إقليميًّا وعالميًّا ما الجديد الذي يمكن أن يُقدِّمه الإسلام سواء للواقع السياسي الإسلامي المعاصر أو للواقع الإنساني بشكل عام لتقليص هذه الظاهرة قدر الإمكان؟
ترى هذه المدرسة أن الإسهام الأكبر الذي يُمكن أن يقدِّمه الإسلام كمعالجة لظاهرة الإجرام السياسي تلك، هو في محاولة إكساب الممارسة السياسية بعدًا قيميًّا أخلاقيًّا وإنسانيًّا عامًّا مستمدًا من التصور الإسلامي، والذي يكتسب صفة إلزامية باعتباره جزءًا من المعتقد ذاته، ومن ثَمَّ تتجسد هذه القيم الإنسانية في آليات وسياسات وممارسات وحتى في الممارسة السياسية الفردية وعلى مستوى الأحزاب والمؤسسات الحاكمة، تلك هي الأولوية الأكثر إلحاحًا ليس للأمة الإسلامية فحسب بل للبشرية جمعاء، فلقد تأسس الفكر السياسي الغربي، على الرغم من كل إيجابياته ومنجزاته، على المصلحة والنفعية وسيادة الطرح والمرجعية الميكافيلية وما أفرزته من مفاهيم سلبية، كسيادة مبدأ القوة وفرض الهيمنة واستغلال الأمم الضعيفة، من هنا كانت الحاجة إلى بناء علم سياسة قائم على مبادئ قيمية أخلاقية، كالصدق والتراحم والتكافل وغيرها من القيم التي تتفق عليها كافة الأديان والحضارات الإنسانية فالبواعث ... والممارسة... والمقاصد والغايات كلها يجب أن تكون ذات نزعة قيمية أخلاقية من أجل تحقيق السلام الاجتماعي محليًّا ودوليًّا.
وكما أكد لويس بورال على أهمية الدين في إكساب الممارسة السياسية صبغة أخلاقية، فإن الأخلاق تكتسب أهمية قصوى ومركزية في التصور الإسلامي وبخاصة في شقه السياسي، ففي الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، إذ يستحيل التضحية بنبل الوسائل على مذبح الغايات.
وتؤكد تلك المدرسة أن الإسلام يدعو صراحة وفي نصوص قرآنية قاطعة الثبوت وقاطعة الدلالة ومتواترة بكثرة، على التزام فضائل الصدق والأمانة والتسامح والعفو والإيثار وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ليس في الممارسة السياسية فحسب بل في كل مناحي الحياة[42]، فكل ما قام لويس بورال بإحصائه من مظاهر للإجرام السياسي في مؤلفه الذي بين أيدينا تجد علاجها واضحًا في القرآن الكريم، ولكنها مع ذلك تبقى نصوصًا بحاجة لتقنين لتحديد سبل إنزالها على الواقع دون تركها لاستغلال فرد أو جماعة أو حزب ليضفي عليها التأويل الذي يريد ويحقق مصالحه الذاتية[43].
وبالقطع فليس القرآن وحده هو من يدعو لتلك القيم بل تذخر السنة النبوية الشريفة بالأحاديث التي تؤكد وجوب التزام المسلم بالقيم الخلقية الإنسانية، ويكفي قوله عليه السلام: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وحول حلف الفضول الذي دشّنته العرب لنصرة المظلوم في الجاهلية قال عليه السلام: "لو دعِيت إليه لأجبت" بما يُفهم منه عالمية وإنسانية قيم العدالة والحقوق ونصرة المظلوم -في التصور الإسلامي- وضرورة كفالتها لكل البشر على اختلاف أديانهم وأعراقهم.
وفيما يتعلق بالإجرام السياسي من قبل الحكام تحديدًا، فلقد أكدت السنة النبوية الشريفة في مواضع كثيرة على التبعة الملقاة على عاتق الحاكم حال توليه أمر الأمة، وأنه مساءل عليها لا محالة، يقول الرسول الكريم: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ......"، وفي حديث آخر: "سبعة يظلهم الله بظله منهم الإمام العادل" ، وفي حديث آخر يقول الرسول الكريم: "مَا مِن وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُم، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ"[44].
وفي حديث ذي دلالة يدعو فيه الرسول إلى أن يكون اختيار الحاكم قائمًا على أسس قيمية أخلاقية وليست نفعية يقول صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم منهم:... رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له"[45]، وهي معالجة نبوية واضحة لما يشهده الواقع الراهن من استشراء لمظاهر الفساد المالي والإداري والرشاوى الانتخابية وكذلك نظرية الغنيمة السابق توضيحها، والقائمة على أسس نفعية تتجسد في انتخاب أحد الأحزاب مقابل خدمات ومصالح أو مناصب ووظائف يتم توزيعها على هؤلاء الناخبين حال فوز هذا الحزب.
وفي عهد الخلفاء الراشدين كان مستقرًا في وعي مجموع الصحابة والخلفاء الراشدين حتمية الجانب الأخلاقي في الممارسة السياسية للحاكم، وأنه إذا حاد عنها يتوجب على الأمة الإسلامية عزله عن منصبه، وفي هذا الشأن تتحدث المصادر أنه لما بويع أبو بكر بالخلافة بيعة السقيفة قال في خطبته: "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"[46]، وهي كلمات تشي بحقيقة الفهم المتجذر في وعي أبي بكر رضى الله عنه، بل والأمة الإسلامية في ذلك الوقت بطبيعة دور الحاكم في الإسلام والواجبات التي يتحتم عليه الالتزام بها ودور الأمة في تقويمه إذا حاد عن جادة الصواب.
وها هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يدعو الناس لتقويمه، يقول: "أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمر ماذا كنتم فاعلين؟ فقال له بشير بن سعد: "لو فعلت قومناك تقويم القدح" قال عمر مستحسنًا: " أنتم إذن أنتم"[47].
لقد تجلَّت أخلاقية الممارسة السياسية الإسلامية إنسانيًّا في أبهى صورها في الحرب وتحديدًا في التعامل مع الأسرى، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بني قريظة في الشمس نهى عن ذلك وقال لأصحابه: "لا تَجْمَعُوا عَلَيْهِم حَرَّ الشَّمْسِ وَحَرَّ السِّلاحِ، قَيِّلُوهُمْ حَتَّى يَبْرُدُوا"[48].
كما تمنع الشريعة الإسلامية تعذيب الأسير للإدلاء بمعلومات عن العدو، وقد قيل للإمام مالك: " أَيُعذَّبُ الأسيرُ إن رُجِيَ أن يدلَّ على عورة العدوِّ؟ قال: ما سمعت بذلك، وهذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة عندما ضربوا غلاميْن من قريش وقعا أسيرين في أحداث بدر، فقال لهم معاتبًا ومستنكرًا: "إذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتُمُوهُمَا، وَإِذَا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهُمَا"[49]، كذلك فمن الحقوق التي كفلها الإسلام للأسير حق الطعام فلا يجوز تركه بدون طعام، قال تعالي: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وتذكر المصادر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يُكرِموا الأسرى، فكانوا يُقَدِّمونهم على أنفسهم عند الغداء، وكان رسول الله إذا أراد أن يبعث سرية يقول لهم: "لا تغلوا ولا تمثِّلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تضطروا إليها".
ومن كل ما سبق تتأكد حقيقة أن حقوق الإنسان التي هي خير ضمانة لتقليص حدوث الجريمة السياسية من قبل الحكام تجاه محكوميهم، وهي الحقوق التي لم تتبلور إلا في العقود الأخيرة في الغرب، في المقابل كان الإسلام ومنذ بداية دعوته يُقدم أروع الأمثلة قولًا وممارسة في كيفية حماية تلك الحقوق وخاصة المتعلق منها بمعاملة الأقليات، يتجلى ذلك فيما جاء بوثيقة المدينة ونصارى نجران[50].
لقد أدرك رواد عصر النهضة الإسلامية في العصر الحديث كرفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ورشيد رضا وعبد الرزاق السنهوري وغيرهم، أدركوا أهمية الجانب الأخلاقي في التصور السياسي الإسلامي فمع اقتناعهم بأهمية الاستفادة من الفكر السياسي الغربي المتطور في إحداث النهضة الغربية الحديثة إلا أنهم أدركوا أهمية إكسابه نزعة أخلاقية لتخفف من وطأة الفكر المادي النفعي الكامن داخله، وعليه طالبوا بأهمية بلورة رؤية سياسية إسلامية متكاملة مستفيدة من التطور الإنساني في هذا المجال من ناحية، ومنبثقة من قيم الإسلام السياسية ومقاصد الشريعة الإسلامية في شقها الأخلاقي من ناحية أخرى.
ففي عبارة لا تخلو من عبقرية يدعو خير الدين إلى مبدأ إنساني عام وهو تكاتف بني الإنسان من أجل خير البشرية جمعاء باعتبارها أمة واحدة فيقول: "إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمان، من الوسائط التي قربت تواصل الأبدان والأذهان، لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة، تسكنها أمم متعددة، حاجة بعضهم لبعض متأكدة، وكل منهم وإن كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسه، فهو بالنظر إلى ما ينجر بها من الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه[51].
كذلك دعا جمال الدين الأفغاني إلى المساواة بين نوع الإنسان -مسلمًا كان أم غير مسلم-وخصوصًا في الحقوق العامة، وأن ذكره للمسلمين لأنهم العنصر الغالب بأكثريته في الشرق والملة المسلوبة ممالكها ومقاطعاتها[52]، بل ويؤكد على المشترك بين الأديان السماوية وهو الدعوة لفعل الخير وتجنب كل شر، يقول الأفغاني: "لا ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع البشري، بل بالعكس تحضه على أن يعمل الخير المطلق مع أخيه وقريبه وتحظر عليه عمل الشر مع أي إنسان كان"[53].

جمال الدين الأفغاني
والجدير بالذكر أنه في عام 1954م اتخذ مجلس السلام العالمي قرارًا بإحياء ذكرى الأفغاني كمناضل في سبيل السلام[54]، وذلك لجهوده من أجل إقرار هذا المبدأ، فقد كان يرى أن "الحرب من أقبح ما عمله ويعمله الإنسان في الأرض"[55]، وكذلك يقول : "إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها على تحكيم العقل والعدل فيما فيه يختلفون هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال ويجعل الخلق في سلام دائم وهناء مقيم"[56]، إن "أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب إذا ارتقى العالم الإنساني في حقيقة العلم وعم طبقاته"[57]، إن "العلم الصحيح الذي يمكن للآدمي أن يصل إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن الفساد في الأرض وسفك الدماء"[58].
وحول ظاهرة الاستبداد السياسي كأحد أبرز مظاهر الإجرام السياسي من قبل الحكام، بل هي الجريمة الأم، نجد الكواكبي يؤكد على محاربة الإسلام لهذه الظاهرة فيقول: "القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه... فلا مجال لرمي الإسلامية (يقصد الحكم الإسلامية) بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مئات من أمثال هذه الآيات البينات، فالإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم يأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء ويحضها على الإحسان والتحابب"[59].

عبد الرزاق السنهوري
كما يذهب عبد الرزاق السنهوري إلى أن التجارب السياسية التاريخية في عهد الخلفاء الراشدين بما تحمله من قيم أخلاقية وإنسانية عامة يجب أن تكون مرشدة وملهمة لنا، فيقول: "إن سير الحكومة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين يجب دراسته بكل دقة لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر وحدها حجة في فقه الخلافة الصحيحة، وأنه إذا كان البريطانيون يعتبرون "الماجنا كارتا" الميثاق الأساسي لحرياتهم، والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الإنسان ميثاقهم، فإن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية، وهي ميثاق عملي وليست بيانًا قوليًّا"[60]. أما البيان القولي فإننا نجده في خطبة الوداع التي ألقاها الرسول الكريم، والتي قال فيها: "أيها الناس إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ... لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى"[61].
غير أنه وبمرور الوقت بدأت تتقلص تلك الحقوق بشكل كبير لظروف سياسية ضاغطة -كما سبق القول- فرضيت الأمة بحكم المتغلب المفروض عليها والمغتصب للسلطان، وضيقت البيعة لأقصى عدد ممكن، وحرَّمت مساءلة الحاكم ومحاسبته حتى مناصحته جعلتها بعض الفتاوي سرًّا، في حين أن الثابت فقهيًّا وفكريًّا وممارسة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده أنه لا شرعية لأي نظام سياسي دون موافقة الأمة، وأن الرؤية الإسلامية الحقة تقتضي محاسبة الحاكم ومساءلته.
كما أن حق إعلان الرأي هو واجب والتزام وليس حقًّا ومشاركة، فأعظم الجهاد قولة حق عند إمام ظالم، ومن ثَمَّ فإن احترام الرأي والرأي الآخر هو إحدى القيم الثابتة في التقاليد الإسلامية[62]، والتي يُعَدّ عدم الالتزام بها جريمة في حق الأمة، لقد طالب الكثير من علماء الإسلام في هذا السياق أن يعطوا كلمة "الحرام" حقها لتشمل تحريم الاعتداء على أي من حقوق الأمة وحرياتها العامة، يقول أحدهم: "إن كبت الحريات، والتعدي على حرمات الناس، واعتقالهم، ومحاكمتهم محاكمات ظالمة، وتزوير الانتخابات، ونهب الأموال العامة... كلها محرمات ينبغي أن يعلن عنها العلماء، كما يبالغون في الإعلان عن المحرمات الأخرى المعروفة"[63]، وهي كلها ممارسات سلبية يقترفها الحاكم تجاه شعبه ويحق أن يُطلق عليها جرمًا سياسيًّا يتحتم معالجته بمزيد من التوفيق بين ما هو سياسي وما هو أخلاقي مستمد من التصور الإسلامي وما قدمته الحضارة الإنسانية من إسهامات في هذا المجال فكرًا وممارسة.
وهناك شهادة من الأهمية بمكان حول إمكانية قيام فكر سياسي أخلاقي وإنساني عام اعتمادًا على التصور الإسلامي ليتم طرحه كنظرية مقابلة للنظرية المادية النفعية الميكافيلية الحاكمة للوجود الإنساني المتعين في لحظته الراهنة وما أضفته من تبريرات على الكثير من الجرائم السياسية، وهي شهادة جديرة بالتأمل لكونها تأتي من أحد الباحثين في الغرب من ناحية، ولتميز طرحها من ناحية أخرى، إذ تؤكد على الأهمية المركزية التي يمكن أن تلعبها القيم الأخلاقية الإسلامية في بلورة نظرية سياسية عالمية من شأنها تجنب لا أخلاقية الممارسة السياسية الحالية، وهي أطروحة البروفسير وائل حلاق في بحثة " الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي" والتي نظّر لها في بحثه "الدولة المستحيلة... الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي"، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول: ضرورة إسراع المسلمين نحو إيجاد رؤية سياسية إسلامية ذات منطلقات أخلاقية، لتأخذ على عاتقها إعادة مزج الأخلاقي بالسياسي لتلافي ما أحدثته الحضارة الغربية من انفصال بينهما، وذلك بالبحث في مصادر التراث التي احتوت السياسي والأخلاقي بإطار نظرة كلية ودون فصل بينهما.
المحور الثاني: العمل على إيجاد قاعدة مجتمعية جماهيرية تتبنى الطرح السياسي الإسلامي الأخلاقي، أي البدء بالعمل على التغيير من المجتمع وليس من قمة السلطة.
المحور الثالث: التأكيد على الدور العالمي الذي يمكن أن تضطلع به النظرية الإسلامية مستقبلًا من خلال التواصل مع الأصوات الغربية المنادية بإحياء الأبعاد الأخلاقية في الحضارة الإنسانية، وهو أكثر ما يميز التصور الإسلامي ويدفع باتجاهه.
إذ يرى وائل حلاق أن استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم الحديث هي ناتجة بصورة مباشرة عن غياب بيئة أخلاقية مواتية تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك الحكم وتوقعاته والذي هو أخلاقي بالأساس[64]، ومن ثَمَّ يقترح وائل رؤية للعمل لإنزال الفكر السياسي الإسلامي الأخلاقي على الواقع، فيقول: "يمكن لهذا النظام الأخلاقي في الإسلام وهو رأس مال لا يقدر بثمن أن يدعم وجهتين للعمل على الأقل إحداهما داخلية والأخرى خارجية[65].
الأول الداخلي: يمكن للمسلمين أن يشرعوا في الإفصاح عن أشكال حكم جديدة من شأنها أن تؤسس مجتمعات أخلاقية تحتاج إلى أن يعاد لها ثراؤها الروحي، فالنطاق المركزي للأخلاق سيكون الأساس الذي تنهض عليه نظرية مقنعة في مناهضة النزعة النفعية العالمية.
الثاني الخارجي: يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين فيما يخص ضرورة جعل الأخلاق النطاق المركزي في سياق ضرورة بناء تنويعات للنظام الأخلاقي تناسب كل مجتمع.
مؤكدًا أن "إخضاع الحداثة لنقد أخلاقي يبقى الحاجة الأساس لا لقيام حكم إسلامي فحسب بل لبقائنا المادي والروحي، فليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي والمسلمين وحدهم"[66].
الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسب بل هي مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء.
وتأسيسًا على ذلك الطرح يرى حلاق أن الشريعة كنظام حكم يجب إحياء أبعادها الأخلاقية، باعتبار أن "الترسانة القرآنية الأخلاقية ضاربة بجذورها في نظام شامل للإيمان... وهو ما يعني أن الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسب بل هي مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء، فكل ما في هذا الكون مخلوق ليتمتع به الإنسان، ولكن ليس بالطريقة النفعية بل بطرائق تبرز مسؤولية أخلاقية عميقة، لقد خلقت السموات والأرض بحسب مبادئ الحق والعدل الإلهيين كما تذكر الكثير من آيات القرآن"[67].
وهو هنا يؤكد حقيقة انبثاق المبادئ السياسية الإسلامية الأخلاقية كالعدالة والحرية من التصور الأساسي للعقيدة الإسلامية كوجود الله والتوحيد[68].
إذن فتلك هي بعض مما قدمه الفكر السياسي الإسلامي من إسهامات حول كيفية إكساب الممارسة السياسية أبعادًا أخلاقية وإنسانية عامة، في محاولة لتقليص أي انحراف وإجرام سياسي سواء من قبل الحكام أو حتى المحكومين، ولكنها تبقى -كما سبق القول- لا تعدو كونها حديثًا مرسلًا وعامًّا وبحاجة لجهود جبارة ومؤسسية لتأطير تلك الأطروحات بإطار مواد قانونية ودستورية من شأنها المساهمة في تقليص الجريمة السياسية التي تفشت في الواقع الإسلامي الحالي بشكل يبعث على القلق، فهو واقع بعيد كل البعد عن أي ممارسات سياسية أخلاقية بشكل يجعلنا نقول بكل أريحية إن ظاهرة الإجرام السياسي حاضرة في المشهد العربي والإسلامي الراهن بكل مشتملاتها بما يجعله بيئة نموذجية لأي باحث يتطلع لدراسة تلك الظاهرة بأبعادها المختلفة.
وفي النهاية، وبالعودة للكتاب الذي بين أيدينا، فمن المهم الإشارة إلى أن المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الكتاب هي من القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، والتي قد تكون غير معتادة في وقتنا الحاضر، لذا ينبغي أن يجتهد القارئ برد تلك المصطلحات والعبارات إلى مثيلاتها في وقتنا الراهن وذلك من أجل فهم صحيح ودقيق لمحتوى الكتاب.
وقد قسم "لويس بورال" أطروحته تلك إلى اثني عشر فصلًا، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة. فقد خصص الفصل الأول لاستعراض "الميكافيلية"؛ أما الفصل الثاني والثالث فقد تناول فيهما القتل كإحدى وسائل الإجرام السياسي بصورتين: القتل السياسي وقتل الطغاة، أما الفصل الرابع فجاء حول الفوضوية وأبعادها السياسية، والفصل الخامس لتناول الأحقاد السياسية، أما الرياء السياسي فقد خصص له الكاتب الفصل السادس.
وفي الفصل السابع تعرض الكاتب إلى الاستغلال السياسي كأحد صور الإجرام السياسي، وخصص الفصل الثامن للتعرض إلى صور من الفساد السياسي في روما وأثينا وإنجلترا وفرنسا، وجاء الفصل التاسع لمناقشة صور الفساد والجرائم السياسية التي قد تشوب العمليات الانتخابية في الدول الديمقراطية.
وجاء الفصل العاشر حول تأثير الفساد السياسي في التشريعات والقوانين، ثم تم تخصيص الفصل الحادي عشر للحديث حول إفساد السياسة للقضاء، وكان الفصل الثاني عشر والأخير حول إفساد السياسة للأخلاق العامة.
وفي النهاية، وبعد أن حاولنا الإمساك بالملامح الرئيسة للأطروحة التي بين أيدينا وأهميتها والسياق التاريخي والفكري السياسي التي انبثقت منه، وكيفية تعظيم الإفادة من أطروحاتها مستقبلًا وتحديدًا في عالمنا العربي والإسلامي بما تعصف به من متغيرات جذرية في وقته الراهن، آملين من هذا التقديم أن يكون قد أدخل القارئ الكريم في أجواء هذا العمل التراثي المهم قبل أن يخوض تجربة قراءته والإبحار بين دفتيه، والذي مع كونه كتابًا تراثيًّا كُتب منذ قرن وربع من الزمان إلا أنه وكأنه يخاطب الواقع الحالي بكل التباساته وارتهاناته وأمراضه وعلله السياسية بشكل يثير الإعجاب والاستغراب معًا.
الهوامش
[1] للمزيد راجع: محمد ممدوح علي عربي، الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي والليبرالى والماركسي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م، ص18 وما بعدها.
[2] مهدي فرحان قبها، الجريمة السياسية في القوانين العقابية- دراسة مقارنة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2015م، ص3.
[3] أحمد محمد عبد الوهاب، الجريمة السياسية من نطاق التجريد القانوني إلى مجال التطبيق العملي- دراسة مقارنة، (القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2002م)، صـ19.
[4] موسوعة العلوم السياسية، (تنظيم) جامعه الكويت، تحرير: محمد محمود ربيع، إسماعيل صبري مقلد، (الكويت: جامعة الكويت، الجزء الأول، 1993-1994م)، ص957.
[5] موسوعة العلوم السياسية، المرجع السابق، ص579.
[6] مهدي فرحان قبها، المرجع السابق، ص10.
[7] أبو بكر صالح، الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، (الجزائر: 2004م)، ص22.
[8] عبد الوهاب حومد، الموسوعة العربية، مادة الإجرام السياسي، المجلد الأول، هيئة الموسوعة العربية، (الجمهورية العربية السورية، 1999م)، ص 414.
[9] www.worldcat.org/search?q=au%3AProal%2C+Louis%2C&qt=hot_author
راجع صفحة لويس بروال على موقع الفهرس العالمي World Cat، وهو مشروع فهرس موحد، تابع لمركز المكتبة الرقمية على الإنترنت، يجمع محتوى أكثر من 10,000 مكتبة في أكثر من 40 دولة حول العالم.
[10] المرجع السابق.
[11] صدر بالإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية عن دار نشر New York: D. Appleton and Company, 1898 بمقدمة وضعها Franklin Henry Giddings. كما صدر في لندن في العام نفسه عن دار نشر London: T. Fisher Unwin, 1898 بمقدمة وضعها William Douglas Morrison.
[12] الترجمة العربية صدرت عن مكتبة حجازي بالقاهرة، وقام بترجمتها حسن الجداوي.
[13] الترجمة الصينية صدرت عن دار نشر Bei jing: Gai ge chu ban she, 1999.، وأعيد طباعة الكتاب في عام 2014م.
[14] Louis Proal, Political Crime, with an introduction by Franklin H. Giddings, New Your, D. Appleton, 1898, the University of Michigan.
[15] Louis Proal, Ibid, P.35.
[16] للمزيد بهذا الشأن راجع: ماكس فيبر، العلم والسياسية بوصفهما حرفة، ترجمة: جورج كتورة، مراجعة وتقديم: رضوان السيد، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،2011م، ص348 وما بعدها.
[17] كمال بنعلي، الأخلاق في السياسية من خلال محاضرة ماكس فيبر "مهنة رجل السياسية والتزامه"، بحث منشور على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث بتاريخ 24 سبتمبر 2014م.
[18] Herbert Alexander Simon, Donald W. Smithburg, Victor Alexander Thompson, Public Administration, Transaction Publishers, 1950, P.325.
[19] أندرو جاكسون (1845 – 1767م) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابع في الفترة (من 1829 إلى 1837م)؛ للمزيد راجع: www.whitehouse.gov/about/presidents/andrewjackson
[20] جمال ناصر جبار الزيادوي، طرق اختيار الموظفين وتطبيقاتها في العراق، بحث منشور على موقع hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/21/10.htm
[21] ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، جامعة الموصل، 1997م، ص107.
[22] ماهر صالح علاوي الجبوري، المرجع السابق، ص10.
[23] جيمس أبرام جارفيلد، الرئيس العشرين للولايات المتحدة الأمريكية من 4 مارس 1881 إلى 19 سبتمبر 1881م. تعرض لعملية اغتيال في (2 يوليو 1881م) أدت إلى وفاته في 19 سبتمبر. للمزيد راجع: www.whitehouse.gov/about/presidents/jamesgarfield
[24] للاطلاع على قانون بندلتون http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=48
[25] Darrell Hevenor Smith, The United States Civil Service Commission: its history, activities, and organization, Johns Hopkins Press, 1928, P.19.
[26] وودرو ويلسون (28 ديسمبر 1856 - 3 فبراير 1924م)، الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 4 مارس 1913 إلى 4 مارس 1921، للمزيد: www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson
[27] للمزيد بهذا الشأن راجع: ماكس فيبر، العلم والسياسية بوصفهما حرفة، ترجمة: جورج كتورة، مراجعة وتقديم: رضوان السيد، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، 2011م،ص348 وما بعدها.
[28] نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي (3 مايو 1469 -21 يونيو 1527م)، ولد وتوفي في فلورنسا، كان مفكرًا وفيلسوفًا وسياسيًّا إيطاليًّا إبان عصر النهضة الأوروبية.
[29] عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص414.
[30] راجع كلًّا من: موسوعة العلوم السياسية، مرجع سابق، ص957. عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص414.
[31] Stephen Schafer, The Concept of the Political Criminal, 62 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 380, 1971, pp380-387.
[32] Louis Proal, Political Crime, with an introduction by Franklin H. Giddings, Op.cit., P.6.
[33] * المقصود بالاشتراكيين في ذلك التاريخ هو مرادف للفوضويين الإرهابيين.
[34] راجع دستور الجمهورية التونسية الصادر في 26 جانفي 2014م.
[35] أورد المشرِّع التونسي مبدأ حياد الإدارة ضمن المبادئ العامة، حيث نص الفصل الخامس عشر على أن: "الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدأ الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة". وأعاد المشرِّع التأكيد على هذا المبدأ في الفصل الأول من الباب الأول والخاص بالحقوق والحريات من الدستور، حيث نص الفصل 23 على أن "تسهر الدولة على ضمان حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة، ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي".
[36] للمزيد راجع:
- د. محمد طه بدوي، حق مقاومة الحكومات الجائرة في المسيحية والإسلام في فلسفة السياسة والقانون الوضعي، (القاهرة: دار الكتاب العربي، 1940م).
- محمد عبد الله عنان، تاريخ المؤمرات السياسية، (القاهرة: دار الهلال، 1928م).
- د.عبد الملك منصور حسن، البغي السياسي دراسة للنزاع السياسي الداخلي المسلح من منظور إسلامي، (صنعاء: مؤسسة المنصور الثقافية للحوار بين الحضارات، الطبعة الثانية، 2002م).
- أحمد عامر، حق مقاومة الحكومات الجائرة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، مجلدان، (القاهرة: هلا للنشر والتوزيع، 2011م).
[37] مطهر علي صالح أنقع، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني- دراسة مقارنة، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2003م)، ص83.
[38] سورة الحجرات، آية 9.
[39] مهدي فرحان قبها، المرجع السابق، ص13.
[40] مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الجزء الثاني)، ص740.
[41] حسين مؤنس، الدين والتطور الحضاري العربي، بحث ضمن كتاب ندوة: "أزمة التطور الحضاري العربي"، (الكويت: عام 1974م)، ص364.
[42] محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تحقيق: عبد الصبور شاهين، مراجعة: د. محمد السيد بدوي، (مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة، 1998م).
[43] عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة للكواكبي، (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 1995م)، ص145.
[44] رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه".
[45] أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، (القاهرة: دار الريان للتراث، 1986م)، ص215.
[46] د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، (القاهرة: دار الشروق، 2003م).
[47] ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة بشير بن سعد الأنصاري، وأخرجه الحافظ ابن عساكر من طريق البغوي بهذا الإسناد في ترجمة بشير بن سعد.
[48] الشيباني، السير الكبير، 2/591.
[49] ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/68.
[50] راجع كلًّا من: عبد الملك بن هشام، سيرة ابن هشام، (بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1989م)، ج2، ص94 وما بعدها.
محمود شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص24 وما بعدها.
[51] خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تحقيق: معن زيادة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية، 1985م، ص4.
[52] جمال الدين الأفغاني، الخاطرات، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2002م)، ص 24.
[53] جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، تحقيق: محمد عمارة، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1979م)، ص 342.
[54] محمد عمارة، جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، (القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية، 1988م)، ص282.
[55] جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص431.
[56] المرجع السابق، ص434.
[57] المرجع السابق، ص435.
[58] المرجع السابق، ص433.
[59] عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص145.
[60] عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، تحقيق: توفيق محمد الشاوى ونادية عبد الرزاق السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية ومؤسسة الرسالة، (لبنان، الطبعة الثانية، 2008م)، ص285-286.
[61] خطبة الرسول في حجة الوداع، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، السيرة النبوية (ابن هشام)، مؤسسة علوم القرآن، 1990م، ص604.
[62] حامد ربيع، مدخل لدراسة التراث السياسي الإسلامي، تعليق وتحرير: سيف الدين عبد الفتاح، (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، 2007م، ص32 وما بعدها.
[63] وصفي أبو زيد، حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة، دراسة منشورة على موقع إسلام أون لاين، بتاريخ: 4 مايو 2014م.
[64] وائل حلاق، الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2014م)، ص26.
[65] المرجع السابق، ص293.
[66] المرجع السابق، ص297.
[67] المرجع السابق، ص165.
[68] وهو طرح نجده متأثرًا وامتدادًا لأفكار المفكر الإسلامي إسماعيل الفاروقى (1921 - 1986م)، وهو باحث ومفكر فلسطيني تخصص في الأديان المقارنة، من أوائل من نظروا لمشروع إسلامية المعرفة، وقد انتخب أول رئيس للمعهد العالمي للفكر الإسلامي.