الأخلاق الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق: رؤية التقليدية الجديدة أو ما بعد الديكولونيالية

مقدمة
إن الوضعية الأخلاقية التي تعيشها الإنسانية في العالم الغربي منذ ستينيات القرن الماضي، وخاصةً في مرحلة ما بعد حركة الحقوق المدنية التي ظهرت في الولايات المتحدة سنة 1964م، هي وضعية أزمة من منظور غربي. لكن من منظور الأخلاق الإسلامية التقليدية لا يمكن الاكتفاء بهذا التوصيف؛ ذلك لأن الأزمة كظاهرة حديثة -كما يعبِّر عنها بول ريكور- "تشير إلى انقطاع بين توازن ناشئ وتوازن سابق آخذ في الانهيار. وعلى هذا النحو، يجري الحديث عن أزمة المراهقة"[1]، فقد أوضحت دراسات وائل حلاق (حول الشريعة الإسلامية) العلاقة التباينية بنيويًّا بين الإسلام ومنظومته القيمية وبين الأخلاق الحديثة وما سيتجسَّد عن هذا من مُشكِل إذا حاولنا أسلمة (islamisation) الدولة الحديثة ومؤسساتها. وقد كان وائل حلاق وفيًّا للموقف الفلسفي الذي سبقه فيه رينيه غينون وسيّد حسين نصر اللذان عارضا بشدَّة المواقف القائلة بالتطابق والتناظر بين الروح الحديثة والروح التقليدية. ولذلك لا يمكن أن نعدَّ المنظومة الأخلاقية الغربية مجرَّد أزمة تمرُّ بها البشرية، بل هي تجسيد لرؤية للعالم أو طريقة ما للسكن فيه تختلف عن رؤية الإسلام (التقليدي) للإنسان والمجتمع والنظام السياسي. فما يحدث من أزمة داخل المنظومة الأخلاقية الغربية اليوم مع صعود أشكال اجتماعية مُفرطة في الفردانية (hyper-individualiste)[2] كما يقول إيمانويل تود (حركات الدفاع عن المثلية، وحركات الدفاع عن العنصرية القائمة على اللون والعِرق، وحركات المدافعة عن قضايا البيئة، وحركات LGBTQ)، هي التي تدافع عن كل ما له علاقة بالمشكلات الثقافية التي يمرُّ بها إنسان المشروع الثقافي الغربي في القرن الحادي والعشرين. كما أن هذه الأزمة جاءت في إطار البحث عن حلول لاستئناف حالة من التوازن المجتمعي قد تكون طفرة الحريات الجديدة أحد أهم أسبابها[3].
إن المصطلح الأكثر دقةً الذي يمكن أن يعبِّر عن زاوية نظر الأخلاق الإسلامية للوضعية الأخلاقية في الغرب حسب تقديرنا هو مصطلح المأزق، ليس فقط لكون الحالة التي وصل إليها الغرب هي حالة عطالة في المنظومة الأخلاقية وضعف قدرتها على تحريك الفرد، بل لأن الارتفاع الضخم لحجم الحريات الفردية جعل العالم الغربي يعيد تنظيم بيته الأخلاقي بطريقة تخدم الأخلاق الجديدة ذات الطابع البراجماتي الأنجلوسكسوني. وهي الطريقة المغايرة منهجيًّا مع الطريقة الكلاسيكية التأسيسية التي صاغ مشروعيتها الفلسفية الأولى الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، والتي جعلت الأخلاق خاضعة للحريات المرتبطة بعالم المادة وليس العكس. فمنذ اللحظة التأسيسية الكانطية للأخلاق تحوَّل موضوع الحاجة الأصلية للبشر إلى الدين إلى موضوعٍ يجري تناوله بشروط قبلية في العقل البشري وليس له أدنى صلة بأصل ميتافيزيقي متعالٍ على العالم والكون. وهو ما يجعل من قيمة فكرة الأخلاق في حد ذاتها ضعيفةً من الناحية الميتافيزيقية، التي انتهت بقبول إمكانية أن يكون الواقع هو الذي يحدِّد الأخلاق (خاصةً مع المنعطف البراجماتي)، وهي وضعية جديدة من وضعيات الفراغ الأخلاقي الذي يمرُّ به العالم. ومن هذا المنطلق نجوّز لأنفسنا استعمال مفهوم "ما بعد الأخلاق" من زاوية نظر نقدية، كمصطلح يعبِّر وبدقَّة عن الوضعية الحرجة التي وصل إليها الغرب. كيف يمكن أن تقترح الأخلاق الإسلامية اليوم نظامًا أخلاقيًّا كونيًّا على العالم في عصر "ما بعد الأخلاق"؟ وما الذي نقصده بالرؤية التقليدية الجديدة أو ما بعد الديكولونيالية؟
المحور الأول: المفاهيم الأساسية
1- الرؤية التقليدية الجديدة ما بعد الديكولونيالية
أ- مدخل عام للبراديغم
لقد أثَّرت الدراسات الديكولونيالية (كتابات كلٍّ من والتر مينيولووانريكي دوسيل على وجه الخصوص) في تفكير الدراسات النقدية في العلوم الإنسانية في الحداثة، وأتاحت إمكانية معرفية للنظر إلى الحداثة من داخل جينيالوجية خاصة من موقع الدول والحضارة المُستعمرَة. "فمنذ البداية كان للحداثة أبعاد متعدِّدة، وهنا بيت القصيد، أما متى بدأ مشروع الحداثة؟ فالجواب يكون مختلفًا باختلاف تموقع السؤال. ومن خلاله يتمُّ رسم جينيالوجيا متعدِّدة لأصل الحداثة. فلو أنك -مثلًا- بصدد الحديث مع فرنسي أو مع مَن مرجعيته عن الحداثة فرنسية، فأكيد أنه سيُرجع أصلها إلى سنة 1789م، أي إلى الثورة الفرنسية على النظام القديم. ولو تحدَّثت مع بريطاني، فسيُخبرك أنها بدأت مع ثورة 1648م غداة صلح وستفاليا (peace of westphalia)، وجميع هذه السرديات تعتبر سرديات لتجميل الحداثة"[4]. فقد كشفت الدراسات الديكولونيالية -من خلال فهمها لتاريخ الهيمنة الاستعمارية على الشرق- الكيفية التي حوَّلت دول الشرق ونُخَبه إلى عناصر تابعة لمصالح الدول الاستعمارية وغاياتها. فهي تؤكّد لنا أن "الأجندة الخفية للحداثة هي الكولونيالية، وليس العقل الأداتي كما تقول ذلك مدرسة فرانكفورت"[5]. فالدرسات الديكولونيالية تقدِّم سردية أخرى للحداثة على اعتبار أن الاستعمار والسيطرة والهيمنة على مقدرات الشرق كانت خدمةً للمشروع الأوروبي، وذلك لتمكينه من الأدوات المعنوية والمادية لبناء حضارته. كما أن الدراسات الديكولونيالية تقدِّم بشكل آخر مواطن الكولونيالية في مؤسسات الدولة والمجتمع في العالم الثالث. ومن ثَمَّ فهي تقدِّم لنا خارطة الهيمنة الكولونيالية على دول الشرق، وتوضِّح بشكل آخر الكيفية التي تجري من خلالها عملية إزالة الكولونيالية وتصفيتها من الناحية الاقتصادية والثقافية والسياسية، لكنها لم تقدِّم ما يكفي للنقاش حول الطريقة والكيفية التي يمكن من خلالها تصفية وإزالة هيمنة الحضارة الحديثة أو الحداثة بوصفها حضارةً تفرض نفسها على كل أنماط التفكير في كل مناحي حياة الإنسان وأبعادها[6].
إن ما نقصده بـ"ما بعد الديكولونيالية" هو البديل الحضاري ما بعد عملية تصفية الكولونيالية، والذي لا يقف -كما نراه- في حدود تناوله للمسألة الأخلاقية عند حدود الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية (أبعاد الحياة الحديثة أو حياة الحضارة الحديثة)، بل يصل إلى موضوع الحضارة التي يمكن أن ينطلق منها الشرق (وهنا سنتناول في مقالنا هذا الإسلام على وجه الخصوص)، والتي ستكون بشكل صريح وواضح حضارة مغايرة للحضارة الحديثة. وسنعتمد هنا دراسات كلٍّ من سيد حسين نصر ورينيه غينون لتوضيح ملامح الحضارة التي يمكن أن يقدِّم فيها الإسلام نفسه بديلًا عن الحضارة الحديثة (رغم أن الدراسات الديكولونيالية قامت بعد كتابات غينون وسيد حسين نصر، فإن كليهما يتمِّم بعضه بعضًا منهجيًّا)، حيث إن هذه الحضارة هي التي ستكون الأرضية الصلبة التي يمكن أن يبني عليها الإسلام منظومته الأخلاقية. ولهذا فإن الإجابة عن سؤال ماهية الأخلاق الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق تقتضي منَّا -في مرحلة أولى- الكشف عن شكل الحضارة البديلة عن الحضارة الحديثة، وفي مرحلة ثانية الكشف عن ملامح المنظومة الأخلاقية الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق. فما هو إذن شكل الحضارة الذي يتناسب مع الأخلاق الإسلامية البديلة عن الحضارة الحديثة؟
ب- الحضارة البديلة: التقليدية أو المنظور الحِكمي التقليدي
ميَّز سيد حسين نصر في كتابه "المعرفة والمُقدَّس" بين مفهوم التقليد في الدراسات الثقافية (Cultural Studies) التي تنظر إلى التقاليد كجملة من العادات والأعراف والفلكلور التي صارت جزءًا من تراث مجتمع أو أي مجموعة بشرية ما، وبين مفهوم التقليد في الأنطولوجية التي يقوم عليها الدين، حيث يعتبر التقاليد "مرتبطة بعمق بالحكمة الدائمة أو صوفيا (sophia)... وهو ليس ارتباطًا مؤقتًا"[7]. فالحكمة الدائمة المطلقة التي تربط الإنسان بالذكاء المطلق المتعالي المتجاوز لضرورات عالم المادة وقوانينه هي التي تنبثق منها المعرفة الحقيقية التي تربط بدورها الإنسان باستمرار بالحكمة المطلقة. فالحداثة بالنسبة إلى حسين نصر هي ضربٌ من نسيان الحكمة البدائية (la sagesse primordiale) أو الحكمة المتعالية (sapientiel)، وهنا يورد كلامه كإجابة ضمنية لكلام مارتن هيدغر الذي يعتبر أن تاريخ الفلسفة هو تاريخ نسيان الوجود أو الكينونة (l’être). فنسيان الله أو الأصل- وهي سمة الحضارة المادية التي تسعى بكل الأشكال الممكنة إلى تحويل الوجود إلى وحدات كميَّة (كما يقول رينيه غينون في كتابه "هيمنة الكم")- "جعل من فكرة الله مرتبطة بالقوة وليس بالحكمة"[8]. وهذه الحقيقة البدائية (primordiale) النابعة من المعرفة المقدَّسة هي "حقيقة بمعزل عن التاريخ"[9]. فهو لا يرى أن هذه الحقيقة النابعة من المعرفة المقدَّسة يمكن أن يطرأ عليها أنواع من التحوُّل والتغيُّر فتلبس لبوس الواقع المحسوس، أو أنها تتغيَّر بتغيُّر أنماط تفكير البشرية وصورتها عن العالم (sa vision du monde) ورؤيتها التي يمكن أن يطرأ عليها التغيير في فهمها لقيمتي الخير والشرّ، بل إن الحقيقة في ارتباطها بالذكاء المطلق الإلهي لا يمكن لها إلا أن تكون مفارقةً للتاريخ وعالم الحدث. والإنسان الذي يبحث عن الحكمة مدفوعٌ إلى أن يفهم ويتجاوز قوانين العالم الدنيوي (profane)، فهو يقول: "لهذا السبب، بدلًا من تعريف الإنسان حصريًّا على أنه "حيوان عقلاني"، يمكننا تعريفه بطريقة أكثر مبدئيةً على أنه كائن يتمتَّع بذكاء كامل يتمحور حول المطلق ومخلوق لمعرفة المطلق. أن تكون إنسانًا هو أن تعرف وتتجاوز أيضًا. إن معرفة ذلك تعني -في النهاية- معرفة الجوهر المتسامي الذي هو مصدر الكون الموضوعي بأكمله والذات السامية التي تكمُن في مركز الوعي البشري، والتي ترتبط بالذكاء كما ترتبط الشمس بأشعتها".[10]

إن مفهوم التقليد -كما هو واضح- لا يُقتصر على كونه مجرَّد موروث خاص بجماعة بشرية أو روحية (أُمَّة (كما تريد أن تحصره بشكل ضمني الرؤية التراثوية التي تحمل تصورًا تاريخانيًّا للتراث بشكل صامت، ولا هو مجرَّد نمط من العيش أو شكل من التنظيم الجماعوي الذي يقع على هامش أنماط العيش الحديثة (والذي تدافع الدراسات ما بعد الكولونيالية والديكولونيالية على احترامه وتحرّر البشرية من رؤيته داخل ثنائية التخلُّف/التقدُّم التي فرضتها المعرفة الاستعمارية والاستشراق)، والذي يبحث عن شكل ما من الوجود المُريح داخل الحضارة الحديثة. إنما التقليد هو منظور فلسفي أو حِكمي (perspective sapientielle) الذي لم يصل إلى حالة النسيان في العصر الحديث إلا لأسباب تاريخية وإبستيمولوجية، وقد حاول سيد حسين نصر أن يعرض في كتابه أبرز محطات هذا النسيان. فمن الناحية الإبستيمولوجية، وضَّح حسين نصر كيف كانت العلوم المصاحبة للحكمة المطلقة كالرياضيات الفيثاغورية (وقد كانت آخر المحاولات الجادة لإعطاء روحانية للرياضيات في العصر الحديث هي محاولة الفيلسوف الألماني فيلهم لايبنتز بنزوعه لما هو كيفيّ عن الكميّ)، والفلسفة الأولى البارمينيدية (نسبة إلى بارمينيدس الذي يُعَدُّ أول من وضع ملامح الأنطولوجية في الفلسفة اليونانية كفلسفة وفيَّة للواحدية ضد التشتُّت والكثرة والتغيُّر في مفهوم الحقيقة) ولكن تم الفصل بينها وبين المعرفة المقدَّسة، فـ"نتيجة فقدان المنظور الحِكمي (sapientielle) ونزع القداسة (désacralisation) عن المعرفة لم يكن فقط الحطّ من قيمة اللاهوت الطبيعي (le theologie de la nature)، ولكن أيضًا نتيجة وقوع طلاقٍ (divorce) بين المنطق والرياضيات مع العلم المقدَّس، بحيث أصبحت هذه التخصُّصات هي الأدوات الرئيسة للعلمنة ولرفع القداسة (profane) عن فعل المعرفة في حد ذاته"[11].
أما من الناحية التاريخية، فسنوضِّح ذلك من خلال المقارنة مع السردية التاريخية الحداثية في إطار الحديث عن العلاقة الجدلية بين المقدَّس والدنيوي. وقد وقع اختيارنا على كتاب "المقدَّس والدنيوي" لميرسيا إلياد لعقد هذه المقارنة. يُعَدُّ كتاب ميرسيا إلياد من ضمن الكتب التأسيسية في فهم العلاقة بين المقدَّس والدنيوي من منظور حداثي. حيث يرى إلياد أن الإنسان الذي يعيش في أفق المقدس الديني هو إنسان يعيش في حالة من عدم التجانس مع المكان والزمان، بمعنى أن المكان عنده يكتسب قيمة حسب قيمة المكان بالنسبة إلى صورة العالم عنده (مركز العالم هي الأماكن المقدَّسة: الكعبة وبيت المقدس مثلًا، ويسميه المكان المفتوح نحو الأعلى الذي مكَّنه من الاتصال بالعالم الآخر المتسامي[12]، والباقي هي أمكنة غير مقدَّسة فلا قيمة لها لديه)، والزمان مرتبط بالمناسبات الدينية والشعائرية التي تُذكِّره بالأصل الأسطوري لخلق العالم أو لقصة تأسيس الحضارة التقليدية. فالأعياد الدينية هي مناسبات لإدخاله في الزمن المقدَّس الأسطوري وإخراجه من الزمان الدنيوي (profane) الخاضع لقوانين التاريخ البشري. ولذلك، حسب ميرسيا إلياد، يُعَدُّ الإنسان المقدَّس إنسانًا غير متجانس مع فكرة الفضاء (espace) بالمعنى الحديث- المفارِقة لما يقع خارج الطبيعة -الذي يقاس بالرياضيات الكمية والهندسة الحديثة، فهو ينتظر هذه الأعياد والمناسبات المقدَّسة للحاق بالزمان المقدَّس، فهو (الإنسان الديني) "يرفض أن يحيا فيما يُسمَّى بألفاظ حديثة باسم الحاضر التاريخي"[13]، "الإنسان اللاديني يرى أن اتّصاف الزمان الشعائري المتجاوز للبشرية (trans-humaine) أمر لا يُنال. فالإنسان اللاديني يعتبر أن من المُتعذّر أن ينطوي الزمان على انفصام و"سِرّ"، بل إنه يؤلِّف أعمق بُعْد وجودي للإنسان، إنه متصل بوجوده الخاص؛ ولذا فإن له بدءًا وغاية، هو الموت، تُبدّد الوجود. ومهما بلغت كثرة الإيقاعات الزمنية التي يشعر بها الإنسان اللامتديّن وتفاوت اشتدادها، فإنه يعرف أنها دومًا تجربة إنسانية ليس لأي حضور إلهي من سبيل إليها"[14]. إن هذا الموقف من الإنسان الديني أو إنسان المجتمعات التقليدية -كما رأى ميرسيا إلياد أن يسميه- هو موقف نابع من منظور الرؤية الحداثية لما هو مفارق للمادة وينتمي لعالم الروحانيات الما بعد الطبيعي أو الميتافيزيقي. أما سيد حسين نصر، فقد قامت أطروحته الرئيسة في كتابه "المعرفة والمقدَّس" على أنقاض هذه الأطروحة. فهو لم يناقش مضمون أطروحة ميرسيا إلياد على نحو يقترح فيه إمكانية تنسيب صورة العالم للإنسان الديني (بحيث يقترح إمكانية وجود شكل من التدين يحمل صورة للعالم متجانسة مع فكرة الزمان والمكان أو الفضاء الحديثين كما يفعل بعض الإسلاميين الذي لم يفهموا بشكل عميق الحضارة الحديثة)، بل إن حسين نصر بنى أطروحته وفقًا لبراديغم وأرضية مغايرة (ولهذا ارتأينا تسمية نقاشه للأخلاق والمعرفة والحضارة ضمن براديغم خاص)، وهي إعادة قراءة التحولات الكبرى الشاملة التي طرأت على الفلسفة الحديثة منذ قيامها مع ديكارت.
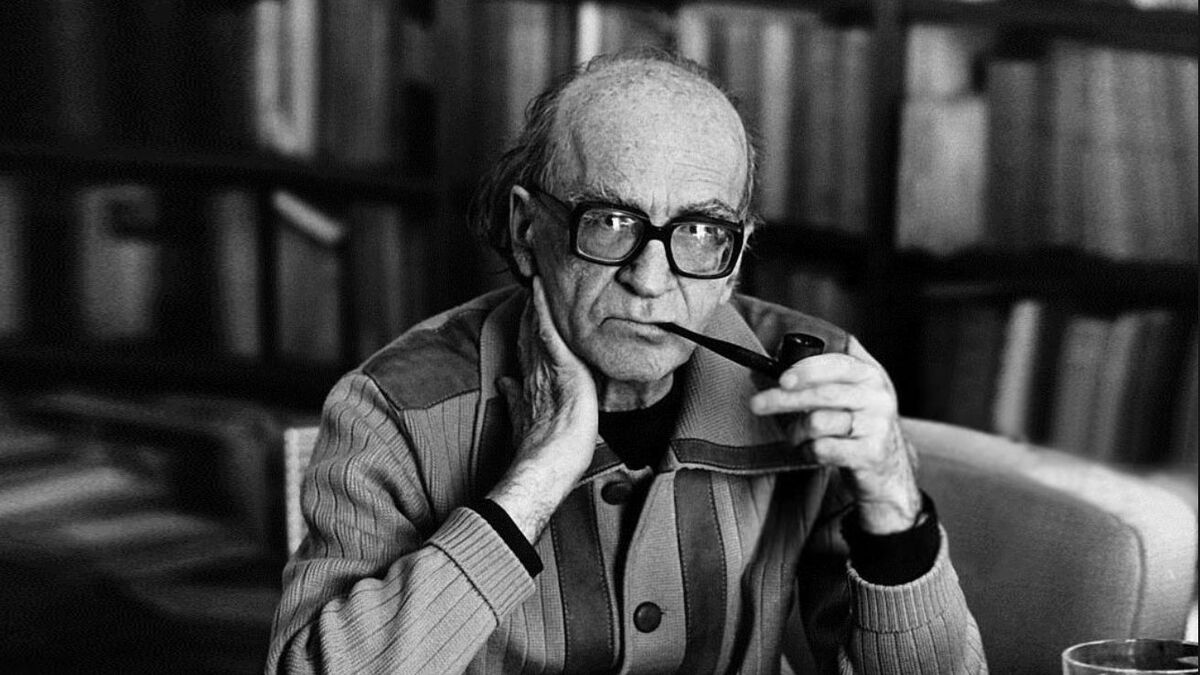
لقد قامت الفلسفية الحديثة -حسب سيد حسين نصر- على تقديم العقل العملي أو الاستدلالي -الذي ينصُّ عليه بكلمة (Reason)- على العقل الفيَّاض أو الخالق (Intellect) (أو العقل الرباني في بعض الترجمات)، فالفلسفة الحديثة قامت على استقلالية العقل الاستدلالي عن العقل الفيَّاض (فصل العقل الاستدلالي Reason عن جذوره الأنطولوجية)[15]، ولم يَعُد العقل الاستدلالي انعكاسًا له. فالعقل الاستدلالي هو عقل أقرب للواقع المحض الدنيوي (profane) وغير قادر على تجاوز الواقع وحدوده إلا بالرجوع والاتصال بالعقل الفيَّاض[16]. وهذا الفصل والقطيعة هي التي جعلت الفلسفة الحديثة غير قادرة على الوصول إلى الحكمة الثابتة والعابرة للتاريخ، وللسبب ذاته سقطت في النسبية وإعلانها عدم قدرتها على الوصول إلى الحقيقة الثابتة والنهائية، بعد أن حوَّلت مضمون مفهوم كلٍّ من الحقيقة الاسمية والفلسفة التي تركِّز على الموضوعية (التخلُّص من الذاتية وتشييء موضوع البحث والمعرفة (والشكلانية والظاهراتية[17]، وجعلته رهينًا للمعرفة المضادّة للباطنية (anti-gnosis).
لقد قامت الفلسفة الحديثة -بحثًا عن الحقيقة داخل الصورة الدنيوية للعالم- بإضعاف العلاقة التي تربط الأديان بالمعرفة المقَّدسة (والتي يسميها سيد حسين نصر باللوغوس في بعض الأحيان) التي تمكِّنها من ترسيخ فكر صلب ومتماسك حول ما ينبغي أن يكون. فهذه المعرفة هي التي تحفظ تماسك العلاقة بين العقل والإيمان والتصوف والعرفان والفلسفة والثيولوجيا. فالمنظور الحِكمي الأعلى هو الذي جرى إضعاف وجوده في التعاليم المسيحية الكنسية، إلى أن جاء عصر النهضة الذي جلب معه معارضة قوية لهذه التعاليم الحِكمية وبرزت البروتستانتية بوصفها مذهبًا مدافعًا عن فصل الكنيسة عن الحياة السياسية، ومن ثَمَّ شكلت رؤية دنيوية للدين اسم الخطاب الديني (رضاء الله بالعمل ومراكمة المال). وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجذور الأولية لهذا المنزع راجعة بالأساس إلى عملية تحوُّل داخل الفلسفة اليونانية. إن بروز الفلسفة الأيونية الطبيعية -حسب سيد حسين نصر- وإفراغ الكون من محتواه المقدَّس في الديانة الأولمبية، وصعود السفسطائية والأبيقورية والبيرونية[18] قد أسهم في إضعاف الحكمة البدائية (primordiale). لقد كسَفت -أو حاولت- هذه المدارس الوظيفة الأسرارية للمعرفة بالكامل، واختزلت المعرفة إلى استدلالات ذهنية بسيطة، ما جعل التمييز بين الحكمة والمعرفة أمرًا لازمًا، وحتَّم ردَّة الفعل المسيحية القاسية ضد الفلسفة اليونانية. إن ما سُمي في حقبة ما بعد عصر الأنوار بـ"المعجزة اليونانية" لهو -من وجهة نظر تقليدية- معجزةٌ معكوسةٌ؛ لأنها استبدلت العقل الفياض (intellect) بالعقل الاستدلالي (Reason) والاستنارة الباطنيَّة بالمعرفة الحسيَّة"[19]. وعقبت هذه المحاولات من إفراغ الطابع الثيو-صوفي أو الأسراري الغنوصي المرتبط بالحكمة السامية المطلقة، محاولات مثلها داخل الفلسفة، ولعل أبرزها حركة الإصلاح البروتستانتية، وأتبع ذلك بروز نظريات فلسفية شمولية داخل الفلسفة كعلم، والتي تمثلت في البداية في فلسفة رينيه ديكارت أبي الفلسفة الحديثة، حيث "جسَّد هو أيضًا روح الفلسفة الحديثة، بل والعلم الحديث، أي اختزال المعرفة إلى وظيفية العقل الاستدلالي الفردي المعزول عن العقل الفيَّاض في وجهيه الميكرو-كوني (microcosmic) والماكرو-كوني"[20]. وهذه كانت الخطوة الأولى في الدخول في الفلسفة الدنيوية المحضة التي تعكس روح الحضارة الغربية الحديثة، فهو يقول :
"في حالتي ديكارت وكانط، كانت وظيفة العقل الاستدلالي مقبولة، والمعرفة التي تنتج عنه لها ثبات المعرفة العقلية النسقية، فرغم عدم اعتراف هذين الفيلسوفين بالطابع المقدَّس للمقولات المنطقية التي تمكِّن الإنسان من المعرفة العادية، فقد حافظا على رؤية ثابتة وصلبة لهذه المقولات التي ومع عدم وعيهم بحقيقة طبيعتها، تظلّ من وجهة نظر الميتافيزيقا انعكاسًا للمقدَّس، وهو أزليٌّ وغير متحوّل في ذاته وفي انعكاساته على عالم الفساد والكون. ومع تطور عملية العلمنة، اختفى هذا الانعكاس في فلسفات القرن التاسع عشر مثل الهيجلية والماركسية اللتين أسّستا الواقع على الصيرورة الجدلية والتحوّل نفسه واستبدلتا الرؤية الثابتة للأشياء برؤية -مادية كانت روحية- دائمة التغيير"[21]. هذا النزوع نحو الجدلية والصيرورة هو الذي كان يسميه رينيه غينون بفلسفة الصيرورة (la philosphie de devenir)، وهي التي مهَّدت لتيار ما بعد النسقية، قبل أن توقع النسبوية العالم في دوامة من الفوضى وغياب البوصلة الثابتة الموصولة إلى معنى ثابت ومطلق وكلي للوجود، فأدَّت هذه الأخيرة إلى حالة من التضاد للفلسفة (anti-philosophie) لا سابق لها.
لا يمكن أن نعتبر أن الحضارة الحديثة هي حضارة قامت بمحْوِ الحضارات التي قبلها وجعلتها خارج التاريخ أو فاقدة لأيِّ صلاحية تاريخية، أو الادعاء الثاني القائل بأن الحضارة الحديثة هي في استمرارية وتكامل مع الحضارة التقليدية. بل هي حضارة مستقلة بذاتها لها مفهومها الخاص عن حقيقة الإنسان المتكوّن من روح وجسد ونفس ومفهومها الخاص عن حقيقة الطبيعة وما وراء الطبيعة
إن هذه الحضارة التقليدية تقدِّم لنا من خلال كتابات رينيه غينون وسيد حسين نصر أصلًا ومبدأً ثابتًا نميّز به بين الحضارة التقليدية والحضارة الحديثة، بعيدًا عن أي قراءة توفيقية لا تبذل جهدًا حقيقيًّا لفهم ما يميز الحضارة الحديثة عن التقليدية، بحيث لا يمكن أن نعتبر أن الحضارة الحديثة هي حضارة قامت بمحْوِ الحضارات التي قبلها وجعلتها خارج التاريخ أو فاقدة لأيِّ صلاحية تاريخية، أو الادعاء الثاني القائل بأن الحضارة الحديثة هي في استمرارية وتكامل مع الحضارة التقليدية. بل هي حضارة مستقلة بذاتها لها مفهومها الخاص عن حقيقة الإنسان المتكوّن من روح وجسد ونفس ومفهومها الخاص عن حقيقة الطبيعة وما وراء الطبيعة، وذلك عبر المعرفة المقدَّسة التي تعتبر أداة ربط بين اللوغوس البشري (أو الغنوص egnos الذي هو انعكاس وتعبير وصورة عن حقيقة اللوغوس الإلهي) واللوغوس الإلهي الذي تكمُن فيه الحقائق من طبيعة إلهية؛ لأن العلم أو المعرفة المقدَّسة تعتبر أن الأساس المطلق للوجود يقع فيما وراء الطبيعة أو ما وراء الكون لا في داخلها (سواء كان الأفق الدنيوي يدَّعي أن الأساس المطلق للوجود من طبيعة مادية أو قائم على المعرفة الما قبلية المتعالية الموجودة في النومان nomene كما هو عند كانط، أو معرفة الكينونة حينما أراد ميشيل أونري أن يقدِّم منوال المعرفة الجديرة بفهم ومعرفة حقيقة الروح l'âme في مقاله)[22]، فهي -إذن- حضارة روحانية بامتياز تعتمد على التجديد العمودي المتسامي/المتصاعد بشكل منتظم ودائري لا يستقرّ صعودًا أو نزولًا ومستمر (أفقيًّا) للحفاظ على انتظامية واستمرارية تقليدها، وهو ما يمكن اعتباره الأرضية الأنطولوجية الوحيدة التي يمكن أن تحقق السكن الملائم لمفهوم الحقيقة داخل الجماعة الروحية المؤمنة بهذه المعرفة المقدَّسة.[23]
لقد حاولنا في هذا العنصر توضيح نقطة فلسفية مهمة، وذلك بإبراز الملامح الأساسية للحضارة التقليدية بالنسبة إلى الحضارة الحديثة، وسنحاول الآن الكشف عن المنظومة الأخلاقية الإسلامية التي يمكن لها أن تعيش داخل هذا النمط من الحضارة الذي شرحناه توًّا.
المحور الثاني: المنظومة القيمية الإسلامية في عصر ما بعد الأخلاق
1- في معنى الأخلاق
يرتكز النقد الديكولونيالي مع دوسيل على تشكيل الأخلاق الحديثة، بالشكلانية التي تهرب دائمًا من تقديم إجابة فلسفية واضحة يمكن من خلالها تحديد المبادئ المادية للأخلاق وتكتفي في صياغتها للحلِّ (بالنسبة إلى المشكل الأخلاقي) برسم المبادئ الأخلاقية بطريقةٍ تقوم على أشكالٍ مختلفةٍ من الشكلية المخاتلة التي لا تناقش المضمون والمحتوى المادي للأخلاق (المبادئ العملية للأخلاق). يعتمد كلٌّ من إينريكي دوسيل ووالتر مينيولو في نقدهم للأخلاق الحديثة على كتابات الفيلسوف الألماني إيمانيول كانط؛ لأن مَن قبل كانط (مالبرانش وديكارت وسبينوزا وغيرهم) لم يكن نقاشهم للأخلاق تأسيسيًّا وواضح المبادئ ومكتمل الصورة كما هو الحال في كتاب "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق" الذي كتبه سنة 1785م، فقد كان تركيزهم في النقاش حول المنظومة الأخلاقية الحديثة ومعايير ما هو كوني في المبادئ الأخلاقية. فالكوني يناقش ضمن تصوّر نقدي يوجّه سهامه صوب الخلفية الجيو-سياسية للمعرفة الحداثية القائمة على التمييز المناطقي (مركز وأطراف وَفق تقسيم تراتبي يضع أوروبا في المركز، أي في مركز الحضارة، ومعيارًا لها) والعِرقي (حسب ترتيبٍ للأعراق يضع الأعراق الأوروبية في المقدمة كادعاء ضمني بأنها متفوقة على باقي الأعراق الأخرى بشكل طبيعي). إن المشكل الأساسي الذي قامت عليه فلسفة الأخلاق الكانطية هو تحديد ما يتعلَّق بمفهوم الصلاحية الكونية للأخلاق، أي تحديد ما هي المبادئ أو القوانين الأخلاقية الصالحة للبشرية من الناحية الشكلية ولا يهمّ المحتوى المادي للأخلاق، أي المحتوى الذي يجيب عن سؤال ما هو خيّر؟ فالأخلاق الكانطية لا تهتمّ بتحديد نوعية الفعل الذي يتعيّن القيام به في المستقبل، أي "ما الذي يتم اقتراحه حين يتمّ التفكير حول الكيفية التي يجب على المرء أن يتصرّف بها"[24]، بل تحديد شروط إمكان المبادئ والقوانين الأخلاقية التي تضمن صلاحية هذه المبادئ أو القوانين في كل الحالات وعدم تعارضها وتناقضها مع الأفق الأخلاقي المرسوم لها، وبهذا "فإنها تحقِّق القبول المحتمل للبشرية جمعاء، المسمَّاة كونية مع الأخذ في الاعتبار كل ما هو "جيّد" ماديًّا لكل واحد"[25]. هنا يعرّج دوسيل قائلًا: "سيصبح تطبيق المبدأ مستحيلًا. إذا لم يتمّ تشكيل القواعد التوجيهية للفعل ( maximes of the action) بحيث يمكنه الصمود أمام الاختبار فيما يتعلّق بشكل قانون الطبيعة بشكل عام، فعندئذ يكون ذلك مستحيلًا من الناحية الأخلاقية".[26]
لقد حقَّق كلٌّ من سيد حسين نصر ورينيه غينون إضافةً فلسفيةً بالنسبة إلى ما وصل إليه التناول النقدي الديكولونيالي على مستوين اثنين، حيث سجّلا من ناحية أولى اعتراضهما على الفلسفة الأخلاقية من زاوية مصادرها التي لا تقف عند حدود العقل الاستدلالي غير القادرة على نيل الحكمة المتعالية والبدائية (Primordiale)؛ لأن العقل لا يمكن وحده أن يكتفي بنفسه لتحقيق أخلاق متسامية وثابتة، بعيدًا عن السيولة التي يحاول باستمرار أن يجرّها إليه عالمُ المحسوس[27]. ومن ناحية ثانية، فإن الاعتراض النقدي لكلٍّ من غينون وحسين نصر على الأخلاق الحديثة لا يتوقف عند حدود تفكيك التمركز الإثنو-ثقافي القائم على تقسيم جيو-سياسي للمعرفة (توزيع المعرفة قائم على تفاضل جيو-سياسي منحاز للغرب، حيث يتم التمييز بين الأشخاص والمناطق وفق تقسيم قائم على أساس عِرقي وإثنو-ثقافي) والذي وإن كان يحمل عمقًا نقديًّا فإنه يناقش زاوية نظر أخرى حول طريقة تقسيم الثقافات وترتيبها داخل الحضارة الحديثة دون أن يقترح حضارة بديلة. وهذا ما سنحاول شرحه في هذا الفصل.
يقول سيد حسين نصر: "الحياة الروحية للإنسان ليست سوى التطور التدريجي لقوى الروح لفهم الذكاء الروحي للكتاب المقدَّس الذي مثل المسيح نفسه، يغذّي الروح، إنه حضور اللوغوس في قلب الإنسان"[28]. فالاعتراض الأوَّلي الذي يمارسه سيد حسين نصر في هذا النص يتعلَّق بالكيفية التي يجري من خلالها تطوير الإنسان أخلاقيًّا، فالأخلاق لا تقتصر على كونها مجرَّد قواعد تنظِّم العلاقة الخارجية بين الأفراد داخل المجتمع الواحد بحيث تصبح مجموعة سلوكيات تنظم مصالح الأفراد وميولهم لحفظ المجتمع الكلي من الانهيار، بل هي مجموعة القيم الروحية التي تقاوم الفراغ الروحي الذي تسبِّبه حالة الانغماس الكلي في عالم المحسوس (وهي حالة اليبوسة كما يسميها ابن عربي). فهي أخلاق لا تقف عند حدود البناء الشكلاني للمبادئ؛ لأنها تستهدف وتُعنى بالحياة الروحية للإنسان، وهي في الوقت ذاته تستجدي منظومة قيم تنظِّم من خلالها العلاقة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد كمنظومة تحمل شكلًا من التعالي والتسامي على الواقع القابل للتبديل. وهنا يجرّنا التناول الفلسفي لموضوع الأخلاق إلى مستويين من النقاش: الأول حول مصدر الأخلاق المطابقة لجوهر الإنسان، والثاني هو النقاش حول منظومة القيم الأخلاقية والكيفية التي يمكن لها أن تتجسَّد على أرض الواقع والتي ستخلق نموذجًا لمجتمع محدّد.
2- المصدر الروحي للأخلاق الإسلامية
إن الحديث عن الأخلاق ومصدرها الروحي سيدفعنا بالضرورة للنقاش حول مفهوم السعادة، فالسعادة بالنسبة إلى المنظور التقليدي هي سعادة قصوى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة الآخرة؛ ذلك أن الوجود بالنسبة إلى إنسان المجتمعات التقليدية هو وجود دنيويٌّ وأخرويٌّ وغير منفصل بينهما بحيث تستقلُّ مصادر النفس البشرية في تحصيل سعادتها الدنيوية بمعزِلٍ عن المآل الأخروي، ولا هي شكل من التوفيق بينهما بحيث يجري تأويل السعادة الأخروية ضمن المنظور الدنيوي (مثل ما يسميه باتريك هايني بلاهوت الازدهار في كتابه "إسلام السوق")[29]، بل هي سعادة لا تطلب مقابلًا دنيويًّا خاضعًا للتغيُّر والتبدُّل، وهي كما يقول الفارابي: "الخير المطلوب بذاته وليست تطلب أصلًا ولا في وقتٍ من الأوقاتِ ليُنال بها شيء آخر، وليس وراءها شيء آخر يمكن أن يناله الإنسان أعظم منها". وهذا الخير المطلوب لذاته يستوجب اتصالًا بأعلى درجات التسامي والإطلاقية، لكي يوجد الإنسان في حالة من السعادة الكاملة. فالعلوم الخاضعة للتغيُّر والتقلُّب لا يمكن لها أن تحصِّل السعادة. كما أن الحكمة المتعالية هي حكمة قائمة على معرفة بالأسباب البعيدة المسامية لكل الموجودات الأدنى منها، والتي تحمل في طياتها معنًى للوجود وغاياته. وقد كان محيي الدين ابن عربي يرى قوة هذه السعادة تكمُن في التطور التدريجي في قوى الروح وفي درجات الفناء الثلاث[30]، وهي درجات متفاوتة من الترفُّع والتغلُّب على عالم المادة والتحرُّر من هيمنته وسيطرته على السلوك (ابن عربي يسمي هذه الدرجات بالمعاريج)، وذلك حينما يبلغ الإنسان في مراحل مقاومته وجهاده النفسي لعالم المادة مرحلة تحصيلِ حق اليقين (بمنحه البصيرة) ومن ثَمَّ عين اليقين (بالكشف) الذي يحمله إلى السعادة الأبدية، وهنا نكتة الاختلاف الأنطولوجي بين اثنين من الفلاسفة المسلمين هما: ابن عربي والفارابي، فعلى خلاف ابن عربي يرى الفارابي أن العلم المدني الذي يجمع كل العلوم العقلية هو الملاذ لتحقيق السعادة داخل المدينة، ففي هذا المضمار بالتحديد كان الفارابي وفيًّا لأستاذه أفلاطون. يقول الفارابي: "ثم بعد ذلك يشرع في العلم الإنسان، ويفحص عن الغرض الذي لأجله كُوّن الإنسان؛ وهو الكمال الذي يلزم أن يبلغه الإنسان؛ ماذا وكيف هو. ثم يفحص عن جميع الأشياء التي بها يبلغ الإنسان ذلك الكمال، إذ ينتفع في بلوغها؛ وهي الخيرات والفضائل والحسنات ويميزها عن الأشياء التي تعوقه عن بلوغ ذلك الكمال؛ وهي الشرور والنقائص والسيئات. ويعرف ماذا وكيف كل واحد منها، وعن ماذا ولماذا ولأجل ماذا هو، إلى أن تحصل كلها معلومة ومعقولة، متميزة بعضها عن بعض؛ وهذا هو العلم المدني. وهو علم الأشياء التي بها أهل المدن بالاجتماع المدني ينال السعادة كل واحد بمقدار ما له أعدَّ بالفطرة. ويتبيَّن له أن الاجتماع المدني، والجملة التي تحصل من اجتماع المدنيين في المدن، شبيه باجتماع الأجسام في جملة العالم، ويتبيَّن له أيضًا في جملة ما تشتمل عليه المدينة والأمة نظائر ما تشتمل عليه جملة العالم"[31].
فالسعادة -إذن- داخل العلوم التقليدية المقدسة (كما بيَّنَّاها في المحور الأول) تتمّ من خلال ضرب من التعالي الذي يتصل بالحكمة الأصيلة السامية ومنبعها يقع فيما وراء كل عقل، ويتعالى على كل قدرة تحاول إدراكه بالعقل الاستدلالي (وهذا الاتصال يسميه ابن عربي بالنبوة الثانية أو الصغرى). فهذا الاتصال يربطه بالحكمة السامية التي تساعده على بلوغ مرحلة الكمال التي تحقق له بدورها السعادة، وهنا تكمل عندنا صورة الأخلاق الإسلامية كما يمكن وينبغي لها أن تكون، وكأخلاق لا يمكن أن تجد مصادر قوتها وحيويتها الروحية إلا داخل الحضارة التقليدية كما حاولنا توضيح ذلك في المحور الأول من هذه الدراسة.
إن الفارابي يرى أن الفلسفة هي منبع الحكمة في عصر ما بعد النبي من خلال تحصيل العلم المدني. يقول: "إذ يوجد قوتان يستطيع الإنسان بواسطتها أن يتصل بالعقل الفعَّال: المتخيّلة والعقل. فعندما يتصل به بواسطة الخيال، يكون نبيًّا منذرًا بما سيكون ومخيّرًا بما هو الآن. وعندما يتصل به بواسطة ملكته العقلية، يكون حكيمًا فيلسوفًا متعقّلًا على التمام"[32]. وهذا يعني أن الفارابي قد ألغى الولاية والتصوف الذي يوصل إلى الحكمة الثيو-صوفية البدائية (primordiale) في مرحلة ما بعد النبيّ. ومن ثَمَّ فمرحلة ما بعد النبيّ هي مرحلة الفلسفة كصناعة تتوسّل بتحقيقها لشرط المدينة الفاضلة، وهذه الفلسفة متجسّدة في العلم المدني لا الحكمة الإلهية. فإن كان الفارابي -كما يقول عبد الرحمن بدوي- يناقض تصوفه في عرضه للعلم المدني (يقول بدوي: "الفارابي عندما يهتمُّ بالسياسة، فإنه يتغافل عن صوفيته أو إنه لا يحاول أن يكون منطقيًّا")[33]، إلا أنه في الحقيقة يحمل رؤية توفيقية صامتة مهيمنة على فلسفته، وهي النزوع نحو التوفيق بين الحكمة والفلسفة على اعتبار أن هذه الأخيرة "هي السلطة الأخيرة والقوة الحاكمة"[34]. لكن بالنسبة إلى غينون الوفيّ للحكمة الثيو-صوفية الغنوصية، فإن الفلسفة ليست إلا شوطًا أوَّليًّا يمارسه الإنسان لتحصيل الاستعداد للدخول في عالم الحكمة السامية، "فليست الفلسفة -إذن- إلا مرحلة أولية تحضيرية، طريقًا إلى الحكمة فهي دون الحكمة في المرتبة، وما كان الانحراف الذي حدث بعد ذلك إلا من إنزال الوسيلة منزلة الغاية، بإحلال الفلسفة محل الحكمة، مع ما في ذلك من نسيان للطبيعة الحقيقية لهذه الأخيرة، أو عدم العلم بها. وهكذا برز إلى الوجود ما يمكن أن نطلق عليه الفلسفة الدنيوية، وهي تلك الحكمة المزعومة ذات الطبيعة الإنسانية المحضة، التي تصدر عن المنظومة العقلية، والتي حلَّت محلَّ الحكمة الحقيقية البدائية، تلك التي تسمو على العقل، ولا تُعزى إلى عالم البشر"[35]. فالسعادة -إذن- داخل العلوم التقليدية المقدسة (كما بيَّنَّاها في المحور الأول) تتمّ من خلال ضرب من التعالي الذي يتصل بالحكمة الأصيلة السامية ومنبعها يقع فيما وراء كل عقل، ويتعالى على كل قدرة تحاول إدراكه بالعقل الاستدلالي (وهذا الاتصال يسميه ابن عربي بالنبوة الثانية أو الصغرى). فهذا الاتصال يربطه بالحكمة السامية التي تساعده على بلوغ مرحلة الكمال التي تحقق له بدورها السعادة، وهنا تكمل عندنا صورة الأخلاق الإسلامية كما يمكن وينبغي لها أن تكون، وكأخلاق لا يمكن أن تجد مصادر قوتها وحيويتها الروحية إلا داخل الحضارة التقليدية كما حاولنا توضيح ذلك في المحور الأول من هذه الدراسة.
إذن، يمكننا القول بأن الأخلاق التقليدية في الإسلام هي أخلاق لا تتطابق مع الأخلاق الحديثة كما أسَّسها كانط؛ لأنها لا تقوم على الفصل بين العقل الاستدلالي والعقل الفيَّاض، ولكنها تحتاج إلى منظومة قيمٍ متعالية لكي تنظِّم بها أفراد الحضارة الواحدة والجماعة الروحية (الأُمَّة).
إن الشرق والعالم الإسلامي لا يختلف مع الغرب فقط في طرق التفكير التي تعكس نمطَيْن من الحضارة (حضارة تقليدية وحضارة حديثة)، بل حتى في تعريفهما للإنسان، فالغرب يعرّف الإنسان بكونه جسمًا أو جسدًا يفكِّر[36] (هذا تعريف الإنسان لدى سبينوزا وهو التعريف المهيمن)، بينما يُعرَّف في ثقافات الشرق (الذي يجد هالته في فلسفة التصوّف) في العموم بكونه جسدًا يفكِّر وله روح، والإنسان هنا هو روح ومادة، وهو برزخٌ بين الوجود الدنيوي والغيب (كما يقول ابن عربي). والنفس تعلُّقها أكثر بعالم الحياة الدنيوية وحقائقها، بينما الروح مرتبطة بعالم الحقائق العلوية (وهذا ما ذهب إليه كلٌّ من إخوان الصفا وابن عربي والسهروردي).
والإنسان (anthropos) (وهو اللفظ اليوناني باعتباره التسمية الغربية النموذجية للإنسان بما هو إنسان) هو كائن يعتقد أن الخلاص يتم بالقوى البشرية وحدها (يقول بروتاغوراس: الإنسان مقياس لكلِّ شيء)، وهذا الاعتقاد هو ما جرى على تسميته في عصر النهضة الأوروبية بالنزعة الإنسانوية (humanisme). والاختلاف بين الشرق والعالم الإسلامي مع الغرب العلماني (يعني: اليونان والرومان حينما تَروْمنَت المسيحية والحداثة) لا يقف عند حدود التعريف فقط، بل يصل إلى حد الاختلاف في نظرتهما للإنسان المثالي أو للإنسان الكامل كما يُسمَّى لدى المتصوّفة، فالغرب يرى كماليّة (anthropos) من خلال التجربة الدنيوية وعالم الحقائق الدنيوية ومعايير الخير والشرّ التي توجد داخل التجربة البشرية المحضة فقط، بينما الإنسان الكامل لدى المتصوّفة يوجد في عملية الفصل بين النفس والروح (وهو شكل من التناظر المميز في تفريق سيد حسين نصر بين العقل الاستدلالي والعقل الفيَّاض)، أي فصل الإنسان وعدم تعلُّقه بعالم الحقائق السفلية وتعلُّقه بعالم الحقائق العلوية. لقد حقَّقت كل المحاولات الما بعد حداثية -حسب تقديرنا- إفادة معرفية في الجانب الأنثروبولوجي والثقافي في البحث عن خصوصية هذا الإنسان (الدراسات الثقافية cultures studies مثالًا)، لكن على المستوى الوجودي الأنطولوجي لم تتعدَّ الحدود التي رسمها النموذج الكمالي لإنسان النزعة الإنسانوية أو إنسان المشروع الثقافي الغربي كما يقول مطاع صفدي، والخطاب الما بعد حداثي هو نوع من "التشويش الأنطولوجي" على أنطولوجيا الإنسان الكامل الشرقي والصوفي، وذلك حينما تدَّعي دراسات ما بعد الحداثة أنها ستستوعب كل تناقضات الإنسان وتقابلاته وثنائياته، لكنها في الحقيقة تسعى إلى حتواء تناقضات الإنسان الغربي. ولكن كيف يمكن لهذه الأنطولوجية التي تحمل ضربًا من التعالي لا مثيل له على عالم المادة بأن تصمد مع عالم غارق في المادة متخطيًا لأشواط هائلة في التطوّر المادي حيث أصبحت الحياة فيه متمركزة على الاستهلاك بعد أن كانت متمركزة حول دور المنتج كما يقول زيجمونت باومان؟
2- نموذج المجتمع الإسلامي في عصر ما بعد الأخلاق
إن النظرية الاجتماعية المبنية على نموذج المجتمع المفتوح -الذي يقدّم كل أشكال الحريات الفردية على كل إمكانية لبناء ضوابط وقواعد للمجتمع، وهو النموذج الذي دشنه كارل بوبر في كتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه"- قد بنتْ أطروحتها على تصوُّر محدَّد في العلاقة بين الحرية والوجود، فهي تقدِّم الحرية مهما كانت تداعياتها على الآخر وعلى المجتمع الكلي بالرغم من أنها نابعة من المصدر نفسِه، وهو العقل الاستدلالي الذي يمثل علامة من العلامات الدالة على الحضارة المادية، الحضارة المادية الحديثة تقيس عالم الأشياء بالكمّ وتحاول جاهدة -كما يقول غينون- تحويل كل عنصر كيفي في هذا الكون إلى وحدات كمية[37]. ومن ثَمَّ هذا التشتُّت في الكثرة (la dispersion dans la diversité) سببه الانغماس في المادة، ونتيجته ما يعبّر عنه غينون بالفوضى الاجتماعية.
فحتى ما تبقى من الأفكار المثالية داخل الحداثة لا معنى له ولا فائدة منه، وهذا بالتحديد ما عنيناه بوضعية ما بعد الأخلاق. فوضعية ما بعد الأخلاق هي حالة تتميز بالخروج من يد الأخلاقيين -الذين يأخذون بزمام الأمور في البحث عن مشروعية أخلاقية لمنظومة قيم جديدة- والذهاب أو الارتماء في يد المنظرين السياسيين بحيث تصبح وضعية ما بعد الأخلاق هي وضعية من النزاعات السياسية والثقافية والأخلاقية التي تستوجب التدخل لوضع سياسات للتفاوض وفضّ النزاع حسب نوعية المطالب والميول الجديدة.
إن المادية ليست فقط دورة وجودية أو حضارية وصل إليها الغرب، بل هي أيضًا حالة من التفكير (un état d’esprit) تتقاطع جوهريًّا مع الرؤية العلموية (scientisme) التي لا ترى أي إمكانية لتحصيل المعرفة خارج العلوم الحديثة[38]. فجميع ما لا يمكن تمثله هو غير قابل للتصور (inconcevable) أو لا مفكّر فيه (impensable). لقد بيّن غينون كيف أنّ المادة هي أصل الانقسام ومعدن الكثرة الصرفة في كتابه "هيمنة الكمّ و رموز الأزمنة"، ولكن ما نبهنا إليه في كتابه "أزمة العالم الحديث" هو التطور الخطي للعلوم الحديثة نحو مسار يتجه نحو إضفاء الصفة المادية على كل شيء، فهو يقول: "وفي هذه الأيام يريد المُحدَثون تطبيق القياسات في مجال علم النفس، مع أنه خارج عن حدودها بحكم طبيعته، وقد آلت الأمور إلى أنهم أمسوا لا يعقلون أن إمكانية القياس إنما تستند إلى خصخصة لازمة للمادة، وهي انقسامها اللامتناهي، إلا إذا كانوا يعتقدون أن هذه الخصخصة لازمة لكل ما شمله الوجود"[39]، وقد قدَّم أيضًا أمثلة في العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء.
لقد حاولت الدراسات الثقافية الرجوع إلى الإتيقا باعتبارها تصورًا قيميًّا محايثًا للفرد ونابعًا من رغباته، لكنها لم تستطع أن تشكِّل من خلال هذه المحايثة نموذجًا متماسكًا يحقِّق التوازن بين البُعْد المادي والبُعْد الروحي للإنسان؛ لأنها لم تستطع الخروج من نموذج الإنسان الكامل الحداثي (المرتبط بفكرة السعادة الدنيوية)، وأعلنت من خلال تقديمها لأشكال من التفرّد (indivualité) (السحاقية، التحول الجنسي، المثلية، النسوية...) الما بعد حديثة انحيازها للعقل الاستدلالي على العقل الفيَّاض؛ ولذلك ظلت عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الحكمة التي تمكِّنها من بناء مجتمع قائم على تراتب منطقيّ كيفيّ. فالنزعة المساواتية (egualitaire) التي تجد هالتها في الديمقراطية التمثيلة[40] والدفاع عن الهويات العابرة للجنوسة (trans-sexualité) هي الركيزة التي دمرت -حسب غينون- أيَّ إمكانية لقيام تفاضل هرمي[41]، وأدخلت العالم الحديث في الفوضى: "وقد أسلفنا أنه لم يعد أحد -في الحالة الراهنة للعالم الغربي- يشغل المكان الذي يلائمه وفقًا لطبيعته عادة"[42]. فالنزعة الفردية هي التي أنهت فكرة المجتمع. وهنا يعلِّق غينون فيقول إن الصراع بين النزعة الفردية وبين ممثلي الدولة الحديثة (من أجل الحفاظ على فكرة المجتمع أمام محاولات حلحلته من الداخل بالنزاعات التي تفكِّك عناصر التضامن المجتمعي) ليس إلا صراعًا بين شكلين من الفردانية؛ لأن الفرد داخل المجتمع الحديث هو المرحلة الأولى التي هيَّأت للوضعية الحالية التي تتميز بكونها -حسب إيمانيول تود- "الشكل الاجتماعي المفرط في الفردانية (hyper-individualité)؛ وذلك لأن العقل الاستدلالي بوصفه مصدرًا للأخلاق هو عقل أقرب للانغماس في عالم المادة وينزع نحو التكميم (La quantification) ".
لقد عبّر عن هذا المأزق الأخلاقي ريتشارد رورتي حينما قال: "الأخلاق المعاصرة عالقة بين كانط وجون ديوي"[43]، أي بين الفلسفة الأخلاقية التأسيسية وبين مذهب البراجماتية الذي يقدّم المنفعة والمصلحة على أي قدرة متعالية في التأسيس للمبادئ والقيم. ولكن حسين نصر وغينون لا يعتبران اختلاف كانط وديوي اختلافًا نسقيًّا بالنسبة لشكل الحضارة التقليدية الذي يريانه الشكل الوحيد الذي يمكن أن تعيش فيه الحكمة الثيو-صوفية والحقيقة البدائية (Primordiale). فقد وصل الأمر بمنظري الأخلاق السياسية -مثل شانتل موف- للقول بعدم فائدة مفهوم الحياة السعيدة والجيدة المثالية في بناء المنظومة الأخلاقية، فهي تقول: "الاختلاف الجوهري يسكن في قبول التعدُّدية، المؤسسة للأخلاق الليبرالية الحديثة، من خلال التعدُّدية، اسمع نهاية مصطلح أساسي وهو الحياة الجيّدة[44]". فحتى ما تبقى من الأفكار المثالية داخل الحداثة لا معنى له ولا فائدة منه، وهذا بالتحديد ما عنيناه بوضعية ما بعد الأخلاق. فوضعية ما بعد الأخلاق هي حالة تتميز بالخروج من يد الأخلاقيين -الذين يأخذون بزمام الأمور في البحث عن مشروعية أخلاقية لمنظومة قيم جديدة- والذهاب أو الارتماء في يد المنظرين السياسيين بحيث تصبح وضعية ما بعد الأخلاق هي وضعية من النزاعات السياسية والثقافية والأخلاقية التي تستوجب التدخل لوضع سياسات للتفاوض وفضّ النزاع حسب نوعية المطالب والميول الجديدة. فيتم بناء خارطة طريق أخلاقية للتقليص من حدَّة النزاع[45]، كما يتم وضع استراتيجية فض النزاع من خلال نظرية اجتماعية جديدة، وهي ما سُميت بنظرية التقاطع (النضال من أجل الدفاع عن أشكال المظلومية المختلفة القائمة على العِرق واللون والطبقة والدين).
يقول إيرنيستو لاكلو: "إن أشكال الهوية والتضامن القديمة المرتبطة بالطبقة قد تآكلت، وقد جاء يومٌ شكَّلت فيه نزعة قوية ذاتية الفاعلين التاريخيين من حيث هويتهم الثقافية[46]". فالقرن العشرون هو قرن الهويات الثقافية بامتياز، لكن كما قلنا في المحول الأول، فإن النموذج البديل عن الحداثة لا يجب أن يقف عند حدود ما هو ثقافي؛ لأن الثقافة دائمًا حدودها دفاعية، ولا تشارك في النقاش الكوني على النحو الذي تقترح فيه نفسها بديلًا حضاريًّا. وهذا ما فعله كلٌّ من حسين نصر ورينيه غينون، فقد حافظا على تصور الحضارة التقليدية للنموذج المجتمعي وفق تراتبية هرمية؛ لأن التفاضل الهرمي هو الذي يحمي الفضيلة داخل المجتمع، ويحفظ استمرارية الحقيقة المطلقة المتسامية بانتظام، وهو نسخة من تراتبية عالم الحقائق حيث توجد الجواهر المجردة -المطلقة اللانهائية التي لا يشوبها التغيير ولا يحدُّها العدد- في القمَّة، والجواهر المقيدة فيما تحتها أو ما دونها. فإذا كانت الحقيقة تفرض شكلًا من التراتب (التراتب القائم على الكيفي وليس القائم على المقياس الكمي) والمعرفة المقدسة تفرض تدرّجًا متصاعدًا وعموديًّا لتطوير الحياة الروحية، فإن منظومة القيم الفاضلة التي تعكس الكمال المجتمعي المطابق لمراد الحكمة الإلهية المطلقة لا يمكن لها أن تكون قائمة على أيّ نوع كميّ ومحض دنيويّ من التفاضل الهرمي، وليس بالضرورة أن تكون نسخة من التراتب الهرمي الأفلاطوني (الحكماء، الجنود، أصحاب الصنائع والباقي)، ولكن تفاضل يحقق التماسك المجتمعي داخل مجتمع لا تجمعه ثقافة (مجموعة قيم ظرفية) ولا عرق ولا انتماء للرقعة الجغرافية، بل مجتمع تربطه رابطة روحية تحمل تصورًا للأخلاق المتسامية النابعة من الحكمة الصوفية الحقيقية (لا النابع من الفلسفة العقلانية)، والذي قد يُصطلح على تسميته بمفهوم الُأَّمة (وهي ليست خاضعة للتاريخ؛ لأن الحقائق التي تعيش بها داخل الحضارة هي حقائق لا يشوبها التقلُّب، وليست طبقة سياسية ولا اقتصادية؛ لأن معيار انتمائها هو الإيمان والعرفان(.
المحور الثالث: الأخلاق الإسلامية والاجتماع السياسي
1- مفهوم الوحدة والتماثل المطرد: وفكرة الأمة أو المجتمع ذي طابع التفاضل الكيفي
يميّز النقاش ما بعد الحداثي بين مفهومي التفرّد (individuation) (حيث يتمثل المجتمع على أنه كيان متماسك كما يقول دوركايم، أو نسق وبنية كما تراه المدرسة الوظيفية) وبين مفهوم الفردانية (individualisation)، حيث تمثل الذات فرادة (singularité) موجودة بذاتها بمعزلٍ عن التمثّل الاجتماعي لها، وتوجد نفسها كذات فاعلة وقادرة على تغيير محيطها الاجتماعي وعلى مفاوضة الإلزامات، معلنة بذلك مرحلة جديدة من تقديس الفرد خارج كل حسابات المشروع المجتمعي الحداثي. كلا النموذجين يحملان تصورًا حول مفهوم الوحدة الإنسانية، فنموذج الحداثة الأولى يرى أن وحدة الإنسانية تتمثَّل في وحدة المجتمع الحديث ونجاحه وتماسكه، وهو ضامن لبناء تجربة كونية عن المجتمع الإنساني العالمي، بينما تنظر الرؤية الثانية للوحدة الإنسانية الكونية على أنها وحدة تقوم على الاختلاف ونفي كل أشكال السلطة (جندر، طبقة، عرق، لون البشرة) التي تحدُّ وتهدِّد الاختلاف والتعدُّد الذي يضمن وحدة البشرية (تقول بريدوتي بأن حالة التشتُّت العالمية الناتجة عن تدفق كبير وسريع من الهجرات واللجوء ما بعد الحروب هي حالة ظرفية يجب أن تمرَّ بها الإنسانية؛ لأنها في حد ذاتها تبحث عن نوع من التجانس والوحدة)[47]، بينما يرى رينيه غينون في تمييزه بين التماثل المُطّرد (uniformité) وبين الوحدة (unité) بأن التماثل المٌطّرد هو نتاج للتشتُّت داخل الكثرة (la dispersion dans la multiplicité)، فهي وحدة وهمية وشكلية (تحت عنوان الإلغاء التام للفروق)، "ولكن الذي هو أجدر بالملاحظة أيضًا هو أن البعض -بوهم غريب- يأخذون بطيبة خاطر ساذجة هذا التماثل المطرد على أنه توحيد (unification)، بيد أنه في الواقع يمثل العكس تمامًا؛ إذ فضلًا عن ذلك يبدو بديهيًّا أن ذلك التماثل يستلزم إبرازًا متزايدًا للانفصالية (Séparativité)، إننا نلحّ على أن الكمّ لا يمكنه إلا أن يفصل لا أن يوحّد؛ وأن كل ما يصدر عن المادة لا ينتج بأشكال مختلفة، إلا تضاربًا بين الوحدات الجزئية الواقعة عند الحدّ الأقصى المعاكس للوحدة الحقيقية"[48].

إن التماثل المطّرد هو نتاج الحضارة المادية التي تسعى إلى تحويل كل ما هو كيفيّ إلى كميّ، وحتى إذا تنبّهت هذه الحضارة لسقوطها في وَحْلِ المادة -بالاستمرارية المتواصلة في تطوير العلوم ومناحي الحياة داخل المنهج الكمي- وتتنبه إلى نقصها فيما هو كيفي، فهي تقوم بتجاوز ذلك بالزيادة في ضبط الكيفيّ وتقييده بالكميّ من خلال محاولة قياس الكيفي بالقياس العددي. ويشير غينون إلى ارتباط وثيق بين كلمة (matière) وكلمة (metiria) اللاتينية التي تعني القياس، وربما حتى كلمة متر (métre) راجعة لهذا الاشتقاق اللغوي والدلالي. بينما مفهوم الوحدة هو مفهوم يعكس التماثل الكيفي، ومن ثَمَّ لا يمكن أن يتم التماثل بين أجناس مختلفة أو أنواع مختلفة داخل الجنس الواحد (le même espèce) لها تمايزات كيفية تميّز بينها، ومن ثَمَّ يصبح الكيفي هو المؤشّر والعلامة المميزة على نحو جذري بين البشرية. وهو ما يجعلنا نقرّ بأنّ كل مجتمع يقوم بنيويًّا على التفاضل الكيفي هو القادر على حفظ كل وحدة متماثلة كيفيًّا داخل كل مجتمع ويحميها من التشتُّت والذوبان أمام متطلبات الواقع المحسوس.
نحن نعيش كباقي الشعوب في ظلّ نظام عالمي يحكمه الاقتصاد والشركات العابرة للقوميات. فهذا العابر وإن كان يسعى لتفكيك الأسواق الداخلية وتحقيق فرص إضافية لهذه الأسواق للتفاوض ولتوزيع بضائعها، إلا أن هذا الانفتاح الذي يرافقه نزعة لإزالة الأقلمة لا يرتكز على غاية ورسالة بالمعنى الأخلاقي النوعي بقدر ما هو تراكمات كميَّة يقودها دافع الربح والسيطرة على زمان ومكان الحركة بطرق انتقائية للغاية، ومحوّلًا أيضًا بشكل سريّ الإنسان إلى إنسان اقتصادي تزداد حاجياته باستمرار وبصفة غير متحكم فيها (لم يعُد يتحكم في رغباته في الاستهلاك، فالاستهلاك هو الذي يتحكَّم؛ ولذلك هو كائن استهلاكي بامتياز)، فيصبح هذا الانسان غارقًا في وَحْلِ المادة؛ لأنه "كلما زادت حاجات الإنسان، زاد خطر عدم توفّر بعض الأشياء، وأفضى ذلك إلى تعاسة"[49]. فتعاسة الإنسان مرتبطة بحاجيات هذا الإنسان الاقتصادي-الاستهلاكي، وكلما زادت حاجاته أصبحت كماليات الأمس ضروريات اليوم، وتصبح السعادة تقاس بحجم الاستهلاك، فتنتفي هنا القدرة على استعادة الإنسان أو بنائه على قاعدة التفاضل الكيفي بلا رجعة. وهو ما جعل البعض يقول بعدم القدرة على التحرّر من عصر الاستهلاك بشكل جذري. فهل يمكن قيام مجتمع يبني هرميته على التفاضل الكيفي من خلال أفراد صاروا سمة فعلية للحياة المتمركزة على الاستهلاك؟ خاصةً أن مجتمعات الشرق لم تعُد كما يظنّ غينون شاهدة على تفرّد الحضارات التقليدية الشرقية ومتمايزة عن الحضارة الغربية، ففي عصر السرعة والتدفّق السريع للمعلومات والرسائل الرقمية، صار العالم ينحو نحو هذا التماثل المُطّرد مع شعوب الشرق، والشرق لم يعُد محافظًا على قِيمه كما كان[50].
لا يرى غينون أن المجال الاجتماعي هو الأرضية الملائمة التي يبدأ منها إصلاح العالم الحديث؛ "لأن هذا الإصلاح لو جرى -معكوسًا- على هذا النحو، أي انطلاقًا من النتائج بدلًا من المبادئ، فإنه سينعدم الأساس المتين ضرورة، ولن يعدو أن يكون وهمًا محضًا: "لا يثمر البتّة شيئًا ثابتًا يُعوّل عليه، وستتجدَّد الحاجة دومًا إلى بدء كل شيء من جديد؛ لأننا أغفلنا الاتفاق -قبل كل شيء- على الحقائق الأساسية"[51]. فالمنظومة الاجتماعية الحديثة لا تصدر عن سلطة روحية، وهي بإيمانها بالديمقراطية جعلت مَن هم في الأسفل المحدد لمن هم في الأعلى (وهنا يحتجّ غينون بحجة منطقية ورياضية، هي أن الأكثر لا يمكن أن يصدر عن الأقل، كما أن الأعلى لا يمكن أن يصدر من الأدنى)[52]. فهيمنة النزعة المساواتية على المستوى الاجتماعي وهيمنة الديمقراطية على المستوى السياسي هو الذي جعل من إمكانيات قيام مجتمع التفاضل الكيفي معدومة وغير قابلة للإصلاح من الأسفل؛ لأن ما هو تحت غارق في التشتُّت في الكثرة، ولا يمكن تجميعه وتحريره من التشتُّت إلا من خلال سلطة متعالية كليَّة بلا رجعة، فهو يقول: "وأن نجعل تلقاء أعيننا تلك الحقيقة المقرّرة التي تقول بأنه إذا كان هناك جماعة من الناس، فإن مجموعة ردود الأفعال العقلية بين أفراد هذه الجماعة تنتهي إلى تكوين نتيجة لا تبلغ رتبة أوساطهم، بل تنحط إلى مستوى أدناهم"[53]. فالحضارة الحديثة في الحقيقة هي ما يمكن تسميته بحضارة كميَّة، التي هي مجرد طريقة أخرى للقول بأنها حضارة مادية[54].
2- السياسة في عصر ما بعد الأخلاق
سنحاول في هذا المبحث أن نتناول الكيفية التي يمكن أن تكون عليها العلاقة بين الأخلاق والسياسة أو الدولة في عصر ما بعد الأخلاق.
إن العلاقة الحقيقية بين الأخلاق والسياسة هي علاقة تتم -حسب مقاربة رينيه غينون وسيد حسين نصر- على أرضية المبادئ الميتافيزيقية التي تقوم على أسس الحضارة التقليدية والحاملة لتصوّر قيمي عمودي متعالية على التقلُّب والتغيُّر. إن الأخلاق باعتبارها جملة من المبادئ والقيم الموجّهة للسلوك لا يمكن لها -حسب تقدير حسين نصر- أن تُنزَّل إلا بعد منحها مشروعية الحكمة المتعالية. وهي تنظّم من الناحية الاجتماعية العلاقة مع الآخر داخل المجتمع الواحد؛ لأن الأخلاق لا تُعنى فقط بالفرد بل هي أيضًا في جانبها الآخر سياسة معيّنة للفعل وللممارسة داخل الدولة أو المدينة أو أي اجتماع بشري ما، يقول فتحي المسكيني في هذا الصدد: "إن القصد هو تبرير الحرية مع الغير باعتبارها جزءًا لا يتجزّأ من هويتها الأصيلة. وحدها حرية مشتركة يحقُّ لها أن تدَّعي فضيلة التعايش"[55]. فمفهوما الحرية والتعايش أو العيش المشترك هما المفهومان المرآويان اللذان يمكن من خلالهما فهم نموذج المجتمع في المستوى الأكثر عمقًا، فهذا المستوى من النقاش الفلسفي نفهم من خلاله سياسات المجتمع وشكل النظام السياسي الذي يمكن أن تكشف عنها سياسات التعايش هذه.
يستعرض فتحي المسكيني في الجزء الخامس من الفصل الأول من كتابه "الهجرة إلى الإنسانية" طرق التعايش ونماذجه التي قدَّمها الفلاسفة المُحدَثون من نيتشه إلى جوديث باتلر مرورًا بكلٍّ من هيدغر وحنة أرندت وجاك داريدا وليفيناس. وهي كلها تنطلق في جانبها المخفي وغير المعلنمن بتشكيل معنى ما حول مفهوم الحرية ورؤية الذات الحديثة للآخر المختلف. يرى حسين نصر في كتابه "حياة الإسلام وفكره" (في الفصل الأول وعنوانه: القانون والمجتمع (law and society أن مفهوم القانون في الإسلام لا يمكن فهمه دون فهم فكرة الحرية، فالحرية في الإسلام -حسب حسين نصر- هي حرية روحية، حيث يمثِّل المتصوفة التيار الفلسفي الأقدر على تقديم تعريف يمثل روح الحضارة الإسلامية الحكمية على نحو عميق. "فالحرية عند المتصوفة هي ضرب من الانفصال الداخلي الروحي عن العوامل الخارجية، وهي نوع من الخلاص أو النجاة من كل أشكال العبودية، وهي تجربة فريدة في العالم حيث توجد الحرية بمعناها الكبير"[56]. ويضيف في السياق نفسه: "كان الاختبار الأكثر أهمية للإدراك الفعلي لوسائل الوصول إلى الحرية في الإسلام هو الدرجة التي تمكَّنت من الحفاظ عليها في أحضان طرق الإدراك الروحي المؤدية إلى الحرية الداخلية"[57].
يمكننا أن نستنتج إذن من خلال منظور سيد حسين نصر ورينيه غينون أن نماذج الفلاسفة المُحدَثين ونظرياتهم حول العيش المشترك لا تتجاوز في عمقها الفلسفي أنطولوجيا الروح الحداثية العقلانية، التي لا تتحمل أي إمكانية للتعالي فوق رغبات الإنسان الحديث الذي يطوق إلى الكمال ذي الطابع المادي، فهو إنسان تحركه الرغبات والحاجيات المادية بدرجة أولى، وهي وإن حاولت الإقدام على ضرب من التعالي والتسامي -لتشكيل المفهمة (conceptualisation) القائمة على مبدأ التعميم- فهي لا تُقْدِم على ذلك إلا عرضًا وبصفة وقتيَّة. ففكرة العيش التي انتهى إليها التصور ما بعد الحديث (سواء بالمعنى الذي أعطاها إياها أنطونيو نيغري أو جوديث باتلر) المرتبطة بشكل محايث بأولوية تحمّل الغير ووجوبية التفات الفلسفة لهذا الغير (مهما كانت عوائق هذا الأخذ بعين الاعتبار للغير والتسامح مع موقفه) هي في جانبها العميق ضربٌ من العمى الأخلاقي (ولهذا أسميناها بوضعية ما بعد الأخلاق) التي تدفعنا إلى قبول أفكار الآخر ومواقفه مهما كانت تداعياتها ونتائجها (سواء كانت الحينية أو طويلة المدى) على المجتمع أو الأُمَّة بالمعنى الشامل. وفكرة باتلر هي في الحقيقة فكرة مخاتلة، والقبول بها يفرض علينا العيش داخل وضعية مفرغة من الأخلاق ولا توجد فيها المبادئ إلا عرضًا. فهي تريد أن توضّح بأن الأخلاق التي تقوم على تحديد مسبق لما هو سويّ هي أخلاق قائمة على الخضوع والإكراه (وقد سبقها ميشيل فوكو في هذا الموقف)، ويجب التخلي عن هذه الأخلاق لتحقيق العيش المشترك بشكل قائم على احترام الغير. وهذه القضية الأخلاقية المعاصرة في غاية الأهمية؛ لأن كل قبول إسلامي من منظور حِكمي لهذا الشكل من العيش المشترك سيؤدّي بنا إلى نتيجة لا مفرّ منها، وهي أن نصبح إزاء إسلام بلا مضمون أخلاقي (وهو ما أراد أن يوضّحه باتريك هايني في جزء من تحليله لظاهرة إسلام السوق في كتابه)[58].
يقدِّم رينيه غينون منوالًا محددًا في تنظيم العلاقة مع الآخر المختلف حضاريًّا، ولا يقوم إلا على ضربٍ من التعالي الذي لا يمكن له أن يتحقق على أرض الواقع إلا تحت مظلَّة مبادئ متعالية تسمو فوق الكل. لأن الأسمى هو الذي يفرض من الناحية الأنطولوجية حقيقته. وهو الثابت، وما هو في الأسفل أو المنبثق من الأسفل هو القابل في كل لحظة للزوال، وإذا تمسّكت البشرية بما هو ظرفي تصبح قابلية الحروب والصراعات ممكنة وبحظوظ وفيرة[59]. فهو يقول: "ويجري الأمر على خلاف ذلك إذا ما وُجدت حضارة لا تعترف بأيّ مبدأ أعلى بل لا تقوم -في الحقيقة- إلا على إنكار المبادئ، فتنعدم -بسبب ذلك- جميع وسائل الوفاق (entente) مع الحضارات الأخرى؛ لأن هذا الوفاق لا يكون عميقًا ذا أثر إلا إذا تحقق من أعلى، وليس من الأسفل، أي من الجهة التي تفتقر إليها هذه الحضارة المنحرفة الشاذة (anormale dérivée). والحاصل أن لدينا -في العصر الحالي- حضارات ظلت وفيَّة للروح التقليدية، وهي الحضارات الشرقية، وحضارة خاصمت هذه الروح، وهي الحضارة الغربية"[60].
ترى باتلر أن سؤال "مَن أنا؟" سؤال لا يمكن له الوجود دون أن يكون هناك آخر يطرحه، وتاريخ الأخلاق الحديثة بالنسبة إليها هو تاريخ "الأنا" بوصفها متجنبة الوقوع في الانحلال والتماس مع "الأنت"[61]. و"هذه الأخلاق الغيرية لا تدَّعي التقمُّص، أو التماهي، أو الخلط، إنها بالأحرى أخلاق ترغب في 'أنت' يكون آخرَ بالفعل، في تفرّده وتميّزه"[62]. وفي معرض توضيحها لمفهوم التفرّد تقول: "فكرة التفرّد ترتبط في الغالب الأعم مع الرومانتيكية الوجودية ومع ادعاء الأصالة، لكني أرى أن تفرّدي -لأنه بدون محتوى تحديدًا- يمتلك بعض الخواص المشتركة مع تفرّدك، وهو لذلك مصطلح قابل للاستبدال إلى حدٍّ ما"[63]. فتحت عنوان عدم اختزال الآخر يتم إفراغ الذوات والأشخاص من أيّ محتوى أخلاقيّ كيفيّ، يصبح الأفراد ماهية أخلاقية مُؤجّلة ومحكومة بالمكوث وانتظار ما يمكن أن يقوله حولها هذا المختلف، وقد تحوّل هذه الاستراتيجية العالم إلى "قاعة انتظار أخلاقية" يفقد فيها الإنسان قدرته -المتجاوزة للواقع والمتأصّلة في طبيعته- على تعريف نفسه على نحو كليّ. فالإنسان بدأ بتعريف نفسه بكونه "حيوانًا عقلانيًّا" فيصبح بعدها حيوانًا يميل إلى تحقيق حريته على حساب الأخلاق، وإذا كان الإنسان الحديث يعيش على وقع هيمنه المجال الاقتصادي واكتساحه معياريًّا لجلِّ مناحي الحياة، فإن النتيجة الحتمية لهذا الإنسان هو أن يتحوَّل إلى "حيوان اقتصادي" بامتياز، كائن تحكمه وتشكِّله قِيَمُ السوق كما تريد.
إذن، نستنتج من خلال النقاش الفلسفي الذي دفعنا إليه رونيه غينون حول المبادئ التي تنظم العلاقة بين البشرية، وهي مبادئ متعالية، أن مفهوم العيش المشترك في مقاربة هذا البحث هو مفهوم متسامٍ وغير دنيوي؛ لأن المبادئ الدنيوية هي مبادئ مادية وخاضعة للتبديل والتغيُّر، وأيضًا للتشتُّت في الكثرة. لكن كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الأخلاق المنبثقة من الحكمة المتعالية وبين الدولة بمفهومها الحديث؟
3- الأخلاق والدولة
إن السياسة -كما وضحنا- علاقة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد التي تنظمها الحكمة المتعالية ومنظومة التشريع التي تنبثق منها، بينما مع أفراد الحضارات الأخرى التي لا تنتمي إلى الحضارة ذات الطابع الحِكمي ولا تمتلك منظورًا حكميًّا في رؤيتها للقانون والقواعد المجتمعية )التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع الواحد والتي تتحول بدورها إلى منظومة حكم سياسي( يصبح الأمر في غاية من الصعوبة؛ لأن هذه الوضعية تستوجب من الحضارة التي سمَّاها غينون باللاطبيعية (anormale) بأن تستأنف الدخول إلى دورة تاريخية ووجودية جديدة. ولكن إذا كان نموذج الدولة الحديث المنبثق من هذه الحضارة اللاطبيعية هو النموذج المهيمن والمسيطر على العالم، فكيف يمكن التعامل معه في هذه الحالة؟
في الحقيقة، لا يمكننا أن نتجاوز ما كتبه وائل حلاق في هذا المستوى من النقاش حول العلاقة بين الأخلاق الإسلامية وبين الدولة الحديثة، ففي كتابه "الدولة المستحيلة" يردُّ وائل حلاق على الإسلاميين الذين يظنون أن الدولة الحديثة هي كيان فارغ يمكن ملؤه بأي محتوى كان: "تفترض الخطابات الإسلامية أن الدولة الحديثة أداة للحكم محايدة، يمكن استخدامها في تنفيذ وظائف معيَّنة طبقًا لخيارات قادتها وقراراتهم. كما تفترض أن بمقدور القادة أن يحوّلوا آلة حكم الدولة، حين لا تستخدم للقمع، إلى ممثل إرادة الشعب، محددين بذلك ما ستكون عليه الدولة"[64]. وهو يعقد مقارنة بين الإسلاميين وبين رؤية أرسطو وأرسطوطاليس للمنطق اللذين يريانه أداة وتقنية محايدة توجه العقل البشري إلى التفكير السليم مهما كانت طبيعة الموضوع، بينما يرى وائل حلاق أن "الدولة الحديثة تصوغ نظمًا معرفية معينة، تحدِّد بدورها وتشكِّل المشهد الذي تبدو عليه الذاتية الفردية والجماعية، وبذلك تحدد قدرًا كبيرًا من معنى حياة رعاياها"[65]. وبالرغم من أن الدولة الحديثة تتعرض لتغييرات (كحال الدولة مع العولمة اليوم)، فإن "أيًّا من هذه التغييرات في الأبنية الحديثة لم يثبت توافقه حتى مع المتطلبات الأساسية للحكم الإسلامي"[66]. وهذا التباين ناتج عن طبيعة إدارة الواجب الأخلاقي داخل الدولة الحديثة الذي يرجع بالأساس إلى سلطة المؤسسات السياسية للدولة، بينما في المجتمعات التقليدية "أي التكوينات الاجتماعية السابقة على الدولة والموجودة خارج أوروبا مستقلة ذاتيًّا، تنظم شؤونها الاجتماعية بنفسها ولم تكن مخترقة بيروقراطيًّا إلا بصورة نادرة وخفيفة. وكانت هذه المجتمعات تنظم ذاتها بذاتها باستثناء حضور الحاكم البعيد ومحاولاته غير المنهجية فرض الضرائب عليها"[67]. فالدول الحديثة تختلف مع الدولة الإسلامية في شكل الضبط الذي تدمج من خلاله الأفراد داخل بنية المجتمع، وأيضًا في النظام الذي يتعلق بكيفية إدارة وتطبيق الواجب الأخلاقي والقانوني (وهو اختلاف ماكرو-سوسيولوجي يتعلق بأركان الاجتماع السياسي ومرتكزاته)، ناهيك عن الاختلاف في مضمون هذا الواجب (وهو اختلاف ميكرو-سوسيولوجي). كما أن تصور رونيه غينون للحضارة المادية وارتباطها بمفهوم القياس وكل ما ينجرّ عنه من دلالات كميَّة يجعلنا نفهم المنهج الذي تتخطاه الدولة الحديثة في حلِّ مشكلاتها، فهي تعتمد على الزيادة في حلِّ المشاكل عبر صياغة قوانين جديدة تضبط وتنظم الظواهر الجديدة (سواء كانت انحرافات فتحدّ منها، أو كانت ممارسات جديدة لا تستطيع أن تضعها في خانة الجريمة فهي تحاول أن تستوعبها). فهي حلول تنتمي لعالم المادة المنغمس في التشتُّت داخل الكثرة، والانقسام داخل التماثل الموهوم بأنه وحدة، فلا حلّ تقدّمه الحضارة المادية إلا الانغماس النازل والعمودي في التقسيم، فعقل الدولة الحديثة متجه نحو تقسيم السلطات وتقسيم العملية السياسية بإنشاء مؤسسات جديدة، ومن ثَمَّ تقسيم المهام والمسؤولية بين العديد من الأطراف الفاعلة داخل السلطة، وكل محاولة للرجوع إلى الوراء والاعتراض على هذا التقسيم والتشتُّت داخل الكثرة سيعتبر استبدادًا ويصل حتى إلى نعته بشتَّى النعوت التي تحيل للفاشية والنازية. هذا ما وصلت إليه الدراسات التي سُميت "ما بعد الإنسان" التي تسعى بكل الوسائل إلى مناهضة كل أشكال السلطة: الجندر (الأبوية)، والدين (الخطاب الديني)، وغيره. هذه الحالة من التشتُّت التي تجد هالتها في عدم التزامن (non synchronisation) بين مجالات الحياة (الثقافة، الاقتصاد، السياسة، الاجتماع)، أي عدم تجانس مسارات تقدّم هذه المجالات، فتجد المجال الاقتصادي يتطور بالنسبة إلى المجال الثقافي دون أن يراعي تأثيرات ذلك (وهو ما آلت إليه الأوضاع العولمية الآن). هذه الحالة من اللاتزامن هي التي فجَّرت مشكلات الهوية والبحث عن الاعتراف في سياق معاصر منذ بدايات القرن العشرين، كما يؤكد هارتموت روزا (Hartmut Rosa) في كتاباته.
إذن، يمكننا استنتاج أن الإسلام في المنظور التقليدي ومنظور الحكمة المتعالية يحمل تصورًا خاصًّا لمنظومة الحكم التي تقوم على التفاضل النوعي أو الكيفي بين الأفراد. وهو تفاضل يقوم على مدى استعدادهم الروحي للاتصال بالحكمة المتعالية[68]، وأن هذه المبادئ لا ترتبط بجماعةٍ ما هي التي تقرّر هذه القوانين وحدها دون أن يكون لها استعداد روحيٌّ لذلك. وما يميز بين مسار تطور نظام الحكم الحديث والنظام الذي يرجو الاتصال بالحكمة المتعالية هو كون الأول يتخذ مسار تطوره نحو التقسيم الأفقي النازل بحثًا من خلال هذا التقسيم على وحدة أوسع (à la recherche d'une entité plus vaste) كما يقول مافيزولي[69]، والذي أدى في نهاية المطاف إلى تشتّت وتصدّع لا مفرّ منه (والبحث يتواصل بشكل مستمر عن الأشكال الديمقراطية البديلة والمغايرة لحل مشكلة السيولة والليونة التي تمرّ بها الذات ما بعد الحديثة)، وهذا ما جعل من القانون الحديث يُتمثّل بكونه ترسانة معقَّدة من الأوامر دون أن يملك القدرة على الإمساك بمنطق واحد يوحّد هذه القوانين[70]، ولا يوحدهم إلا داخل التماثل المطّرد (l'uniformité) وليس داخل الوحدة كما سبق أن بيَّنَّا ذلك. أما الإسلام الروحي الحِكمي فهو يقدّم منظومة قيمٍ تقوم على تربية روحية[71]، تلعب دورًا كبيرًا في تمرير التراث الحِكمي وحفظه دون انتظار ما ستقدّمه سياسات الدولة الحديثة التي لن تكون في الغالب سوى سياسات متحفيَّة. فاحترام هذا التراث من قبل هذه الأجيال يبدأ بتقديم تعليمٍ يُبجّل الحكمة المتعالية ويقدّمها على الوجه الذي يثبت تماسكها وصلابتها واستمرارية حقيقتها، أي أزليتها بالمقارنة مع المنظومات الدنيوية. وهذا ما يجسّد الدلالة المركزية لفكرة الشهادة لله بالنسبة إلى حسين نصر[72].
إن المجتمع الإسلامي لا يُصلح الفرد من خلال الزيادة في القوانين وادعاء أن تطبيق هذه القوانين هو الذي يضمن تحقيق إنسان وفرد مُتخلّق، إنما من خلال الحفاظ على هياكل وبنى اجتماعية تلعب دورًا حيويًّا في حفظ الحقيقة والحكمة المطلقة المعطاة هبةً من الله: {لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا}. إن مجتمع الإسلام الحِكمي هو مجتمع الأمة الروحية، ولا يمكن أن يكون شعبًا بأي حالٍ من الأحوال؛ لأن الشعب تنظمه مؤسسات الدولة -وحدها ولا تنافسها في ذلك أي حكمة ميتافيزيقية- التي تسهر على بنائه وجعله مجتمعًا حديثًا، ولأن الأمة الروحية هي أمة مسؤولة أمام الله (أي أمام الرسالة الروحية الخالدة للإسلام). ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط في ثبات هذه الرسالة تحت أي ظرف حتى وإن ادعى البعض أن هذا التفريط هو اجتهاد ومحاولة لمواكبة العصر، يقول حسين نصر في هذا الصدد: "إن محاولة صياغة القانون الإلهي حسب "الأزمنة" لا تقلّ عن الانتحار الروحي؛ لأنه يزيل المعايير ذاتها من خلال الحكم الموضوعي على القيمة الحقيقية للحياة البشرية والعمل الذي يمكن الحكم عليه بموضوعية، ومن ثَمَّ تسليم الإنسان إلى أكثر الدوافع الجهنمية له إلى طبيعة أقل"[73].

تواجه المنظومة الأخلاقية الإسلامية تحديات جديدة معقَّدة جدًّا فرضتها العولمة والأطروحات المصاحبة لها والمتمركزة أساسًا حول الفردانية، فكيف يمكن أن تواجه الأخلاق الإسلامية من منظور تقليدي (حِكمي) هذه التحديات والصعوبات على المستوى النظري؟
المحور الرابع: في راهنية الأخلاق الإسلامية وأطروحات العولمة
لقد فرضت العولمة على كل الثقافات التقليدية منوالًا معينًا من التفكير، وهو بالأساس تفكير دفاعيّ، تدافع فيه الثقافات عن خصوصيتها أمام برامج الإصلاح والتنمية التي فرضتها الهياكل التابعة لمنظومة العولمة على العالم من خلال مؤسساتها التابعة للأمم المتحدة. ولكن التصور الدفاعي لا يتلاءم مع ما يقدِّمه رينيه غينون وحسين نصر من أطروحات تتجاوز الطور الدفاعي وتقدِّم نموذجًا حضاريًّا شاملًا لا يقف عند حدود الدفاع والانكفاء. فالحضارة تقدِّم أنموذجًا ما عمَّا هو كوني، وتقدِّم بديلًا وحلًّا لمشكل الحضارة المعاصرة ومأزقها. فهي توسُّعية على نحو جذري بلا استئذان. والمجال الذي يعكس قدرتها على أن تتجاوز الطور الدفاعي هو بناها الاجتماعية التي تضطلع بدور المحافظة على قيم الحضارة الشاملة، فالهيكل والبنية الاجتماعية التي من شأنها أن تُكلّف بمهمة أبدية -وهي الحفاظ على استمرارية التقليد- هو العائلة وليست الأسرة؛ لأن الأسرة النووية بالمعنى الحديث هي شكل أوروبي هجين، ولا يتناسب إلا مع شكل الدولة الحديث؛ لأن توسُّع نفوذ مؤسسات الدولة الحديثة أفقيًّا لا يتحمَّل وجود شكل اجتماعي صلب وواسع أفقيًّا وقادر على مواجهة سلطة الدولة. ومن ثَمَّ تعمل الدولة الحديثة على إضعاف هذه البنى الاجتماعية ما قبل الحديثة[74]. فالعائلة النووية المسماة حديثًا بالأسرة هي عائلة ضيقة لا تربطها روابطُ وثيقة بالأصول، ومن ثَمَّ سينجر عن هذه العملية ضعف الروابط مع الفروع (لأن الفروع بدورهم سيتخففون من عبء المسؤولية تجاه أصولهم ما عدا الأصول المباشرة الأب والأم)، بينما العائلة الموسعة هي أكثر متانة وصلابة؛ لأنها ستكون دائمًا مسؤولة بدرجة أولى عن حفظ قيم المجموعة، كما أن هذه العائلة لا تنحصر ولا تتجسَّد في القبيلة والعشيرة حيث تقوم العلاقة بين القبائل الأخرى على ثنائية الانصهار والانشطار (الانصهار في قبيلة كبرى زمن التهديد من طرف خارج القبائل، والانشطار زمن الرخاء، وذلك لأنهم سيلتفتون إلى مصالحهم، وهي نظرية قال بها ايفانز بيتشارد (.
إن شكل العائلة الذي تقدِّمه الأمة الروحية في الإسلام هو العائلة الكبرى ممتدة الجذور في التاريخ -أفقيًّا وعموديًّا- التي تقوم أسس التربية والأخلاق فيها على التربية الروحية كما بيَّنَّا ذلك، وعلى التشريعات التي تحفظ للإنسان التوازن بين العوامل الداخلية/الروحية والخارجية/المادية؛ لأن كل خلل في التوازن بين هذين العاملين سيؤدي إلى التدهور، والإسلام الروحي يقدم توازنًا تكون فيه العوامل الباطنية هي النقطة المركزية؛ لأن الحقيقة الباطنية المتصلة بالحكمة المتسامية هي وحدها مصدر الثبات الأخلاقي، وهي التي تمنح لهذا التوازن استمراريته، طالما أن العامل الروحي هو المحدد للتجديد والتطور العموديَّيْن (على الضدّ من التقدم والتطور الخطي للحداثة وهو تطور أفقي). إن هذا التوازن هو الذي يجعل من العائلة -التي هي جزء من الأمة الروحية والتي تقع في قلب النظام الاجتماعي- مختلفةً على نحو جذري عن القبائل والعشائر التي تهيمن عليها النزعة الغنائمية. وهي حصن ضد كل النزعات الفردية التي تسعى إلى تجريد الفرد من كل منابع الحماية التي يمكن أن يستخدمها أمام تغييرات السياسة (سياسات الثقافة والتعليم) والاقتصاد (هيمنة السوق وفرضه أذواقًا وموضة معينة من شأنها أن تفرض تحولات سوسيو-ثقافية)، والتي تعتمد في الغالب على الخطابات الفلسفية التي تتخفى وراء منظومة حقوق الإنسان، حيث تقودها حركات تحمل تصورات ما بعد حديثة نقدية حول الجندر والعائلة (والتي ترى أن تركيبتها الأبوية هي تركيبة تحافظ على الهيمنة والإخضاع والإكراه). كما أن أفق هذا المنظور النقدي يتجه نحو إشباع الذات الحديثة بكل أنواع الحريات الفردية المضادة للروح (كما وضَّحنا تصور حسين نصر والمتصوفة لفكرة الحرية الروحية) دون التنبُّه لمآلات هذا الإشباع على المستوى الأخلاقي والمجتمعي (الذي سيؤدي إلى التشتُّت والانهيار والتفكُّك). وهو ما أعلن عنه آلان توران بشكلٍ ما في كتابه "نهاية المجتمع" في تعبيره عن هذه الحركات بكونها حركات ما بعد مجتمعية. كما تسميها بريدوتي بحالة "ما بعد الإنسانية"[75].
إن الأمة بالمفهوم الروحي ليست مجرَّد تراث، الأمة هي ما يجعل هذا التراث حيًّا في الذاكرة، والأمة هي التي تحافظ على التراث وتكسر الحواجز التي تضعها المتاحف، وهي الحصن الأول أمام كل رؤية متحفية تريد أن تحصر امتداد تراث ما في حقبة تاريخية بعينها. الأمة التي تكوّنت داخل الحضارة العربية الإسلامية ليست معطًى من معطيات برنامج الدول القومية الأوروبية، فهي ليست أمة بالمعنى العِرقي أو الإثنو-ثقافي؛ لذلك فإن مناهج العلوم الحديثة الإنسانية في العموم (ما عدا بعض المحاولات) غير قادرة على رؤية الأمة العربية الإسلامية إلا كمجموعة قبائل تنحدر من أعراق (الرؤية الإثنولوجية المهيمنة على دراسة الثقافات)، وهذا القصور لا يرجع فقط لكونِ تكوّن الأمة العربية الإسلامية جاء بشكل مغاير عن الأمة القومية الأوروبية التي انحدرت من الأعراق الغربية المهيمنة، بل لأن الأمة العربية الإسلامية لم تكن وليدة برنامج أيّ دولة من الدول القُطرية المناطقية/الحدودية، ولم تكن تشاركها رهاناتها إلا عرضًا. وكل حضور ضعيف لمفهوم الأمة في شعب ما إلَّا ويقابله قطيعة أو تواصل شكلي وضعيف مع تاريخه العميق (وهذا معطى مهم لارتباط السياسة بالحضارة)، وهذا التاريخ العميق هو تاريخ دخول ذلك الشعب في الحضارة، وهذا الدخول في الحضارة هو الذي سجَّل انخراط أفراد الأمة الروحية في التاريخ الكوني، وكل شعب لا يستطيع أن يتحوَّل إلى أمة هو مجرد جماهير (foule/masse/multitude) بلا روح.
إن نظرية ما بعد الإنسانية لدى بريدوتي تعني فضح التسلسلات الهرمية للسلطة التي استبعدت الآخرين (باسم الدين أو باسم القومية الحديثة nationalisme) وحرمتهم من الانتماء والاندماج في مفهوم الإنسانية الحديث. ومن ثَمَّ فإن نظرية ما بعد الإنسان بالنسبة إلى روزي بريدوتي هي نظرية داخل سياق ما بعد الحداثة الذي تبحث فيه الذات الحديثة عن وحدة أوسع من الوحدة التي هندستها نُظُم الدولة القومية الأوروبية. لكنّ حدود هذا الطرح تقف على العتبة نفسِها التي وقفت فيها كتابات جوديث باتلر، والتي أنتجت وضعية إيتيقية مفرغة من كل معطى أخلاقي ما فوق ذاتي/بشري (supra-profane)، وأفضت إلى شكلٍ من المحايثة للجانب المادي للفرد والذي لن يكون سوى انصياعٍ غير مباشر للمنظومة الحسية والشعورية للإنسان والتركيز على تقنيات الجسد (وتحويل هذه التقنيات الجسدية التلقائية والمنفصلة عن الأخلاق الروحية الباطنية الأخلاق الروحية التي تتحاشى الانغماس في عالم الشهوات إلى استراتيجية للسلوك الما بعد إنساني المتحرر من كل أخلاق خارجة عن تقنيات الجسد التلقائية)، التي تتبع الرغبة المنفصلة عن الروح وعن التربية التي تركز على صلابة نور الباطن الذي في الإنسان أمام سياسة الرغبة والجسد الذي يتحكم فيها الواقع الملموس القابل للتغيّر بلا توقّف (وتسعى هذه التربية إلى تهذيب السلوك الخارجي بما يتناسب ويتطابق مع صلابة نور الباطن الذي تم الاعتناء به أصالةً). ما بعد الإنسانية هي "الإنسانية العبورية" المتحولة وفق صيرورة غير محددة بشكل مسبق، وهي تمرّدية[76] وتحوّلية لا تقبل الثبات، والتحوّل عندها هو مؤشر على ديناميكية الذات، والحركة هو المعطى الثابت، إلا أن الحركة لدى الإنسانية العبورية لا تتعدى حدود العالم الخارجي عالم المادة والكم الذي يسير -حسب رينيه غينون- وفق اطراد عكسي مع حركة التطور الكيفي. يمكن اعتبار المنجز النظري الذي حققته الإنسانية العبورية أمرًا مهمًّا على مستوى العقبات التي كانت تعترض الذات الحديثة الحاملة لتصوّر محدّد لكمالية الإنسان (وفق تصور مادي طبعًا)، لكنها لم تستطع تجاوز حدود الحضارة الحديثة؛ لأنها لم تتحرّر من التصور الكمالي للإنسان النابع من الروح الحديثة، ولم تستطع تجاوز المسار الذي دخلت فيه الإنسانية الغربية ولم تستطع الخروج منه، وهو مسار تطوري للإنسان وفق منوال هيمن عليه البُعْد الكميّ إلى الحد الذي اختفت فيه معايير التقييم الكيفيّ من الوجود داخل مصادر القرار في العالم، ولم تعُد هناك أطراف حاملة للسلطة تدافع عنها.
بينما التصور الديني ينظر إلى الطبيعة على أنها مخلوق إلهي قدَّمها الله للبشر. والبشر هم جزء من هذه الطبيعة باعتبارهم مخلوقين مثلها، ولكن الله فضلهم عليها وعلى جميع الخلائق؛ لأنهم يمتلكون العقل الذي يمكِّنهم من حسن التصرف (المطابقة لتمام الآية القرآنية: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا}). 4
لم تقتصر التحديات التي تواجه منظومة الأخلاق التقليدية على مجالات تطبيق الأخلاق فيما صار يُعرف بـ"الأزمنة الحديثة"، أو على إحلال منظومات أخرى محلّها، بل بات التحدي يمسُّ الأُسس والتصورات العميقة التي يقوم عليها البنيان الأخلاقي نفسه. إذ لا يستطيع المتأمِّل في أسئلة الأخلاق المعاصرة أن يتجاهل ما تنادي به المساعي العلمية من إعادة تشكيل الطبيعة البشرية تشكيلًا جديدًا. ولذلك فإن كل نقاش حول طبيعة الإنسان أو طبيعة الجنس البشري -ضمن المنظور الذي أعلنا عنه في بداية هذه الورقة وبينَّاه في العناصر السابقة- لا يراعي فيه طبيعة الحقيقة الحكمية المتعالية لن يكون سوى سجالات حداثية وسقوطٍ في فخاخ الحضارة الحديثة وذهابٍ إليها بلا رجعة. لأن مفهوم الطبيعة البشرية الذي سيحدّد بنية الإنسان الثابتة لن يكون -إذا نوقش ضمن الأفق الحداثي- سوى موقف فلسفي قابل للمراجعة على نحو جذري ولا يمكن حسمه طالما أنه متشبّث بالتصور الدنيوي في تحديد هذه الطبيعة ومنحاز بشكل خفيّ لأحكام "الواقع" على حساب أحكام "القيمة" (ولا ينحاز لأحكام القيمة إلَّا بشكل هشّ وعرضيّ وغير قادر على الصمود أمام انسيابية الواقع وسرعة التغييرات؛ لأنه غير قادر بدوره على التعالي والاتصال بالحقيقة الثابتة). فانفصالُ الأخلاق ما بعد الحديثة عن الأخلاق الدينية وتصورها للوجود والإنسان مؤدٍّ بالضرورة -وفق المنظور الحِكمي- إلى هذه المآلات التي توصف بأنها ما بعد إنسانية أو ما بعد حديثة.
إن الطبيعة الحقيقية للإسلام تكمُن في كونه روحيًّا بامتياز، ولا تقبل أي مجال للمحايثة الفردية الإيتيقية سوى المحايثة الروحية/الباطنية. كما أن تصور الإسلام للعالم الخارجي أو ما يُسمَّى في التقليد اليوناني بالطبيعة هو تصور مقدَّس، حيث يعدُّ الإسلام الطبيعةَ هبةَ الله، وليست أداة أو تقنية يحقق من خلالها الإنسان غاياته. ولذلك يرى حسين نصر أن التناول الحقيقي للمشكل الإيكولوجي أو البيئي -الذي اجتمعت حوله حملات وحركات اجتماعية منذ ستينيات القرن الماضي في الغرب- لا يتم عبر الأرضية الحداثية نفسها التي لا تتناول العلاقة بين الإنسان والطبيعة من خلال المعرفة غير المقدسة التي لا تعدُّ الطبيعة شيئًا مقدسًا إلا على نحو عرضيّ، فقد جلعت الحداثة من الطبيعة كائنًا ميتًا بلا روح، وهي ليست كائنًا إلا مجازًا، بينما التصور الديني ينظر إلى الطبيعة على أنها مخلوق إلهي قدَّمها الله للبشر. والبشر هم جزء من هذه الطبيعة باعتبارهم مخلوقين مثلها، ولكن الله فضلهم عليها وعلى جميع الخلائق؛ لأنهم يمتلكون العقل الذي يمكِّنهم من حسن التصرف (المطابقة لتمام الآية القرآنية: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا}). وهذه المسؤولية تجاه المخلوقات والطبيعة داخل التصور المقدَّس للعالم هي التي تحقق التوازن العميق يين كل عناصر الوجود (الله، الطبيعة، الإنسان) ويجسد نموذج الإنسان -في المنظور التقليدي الحِكمي- في كماليته وفرادته.
إن المنظور الحِكمي-التقليدي يقدّم بدوره تصورًا شموليًّا بالنسبة إلى القضايا البيئية التي طُرحت منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك على أرضية البحث عن مفهوم الطبيعة الذي سينجر عنه تصورات ورؤى ستتوزع على كامل مجالات العلوم التي تسطّر بدورها نظامًا للحياة وتشكّل علاقة خاصة بين الإنسان والطبيعة. فمفهوم الطبيعة بالنسبة إلى النموذج الحداثي قائمٌ على ثنائية الطبيعة والثقافة. والمقصود بالثقافة في هذا السياق هي الثقافة الأوروبية الحديثة وفق تراتبية هرمية قائمة على تفاضل دنيوي، وهذا التفاضل الدنيوي هو تفاضل يجعل من الطبيعة "شيئًا يمكن استخدامه والتمتُّع به إلى أقصى حد ممكن"[77]، والذي شبهه حسين نصر بالمرأة البغيّ التي يستغلها ويستفيد منها المرء دون أي معنى من الالتزام والمسؤولية. أما بالنسبة إلى مفهوم الطبيعة داخل الكتابات الما بعد حداثية، فهي تقوم على "مطلب انهيار الفجوة بين الطبيعة والثقافة"[78]، وهو ما يعني نفي كل أشكال الهرمية بين الإنسان والطبيعة والحيوانات. هذا الاقتراح النموذجي هو بمثابة النموذج التفسيري الذي تنظر عبره الكتابات ما بعد الحداثية إلى المشكلات البيئية حلولًا لها، وهي تنظر إلى الوجود والعلاقات الإنسانية من خلال التراتبية الهرمية التي لا تنظر إليها إلا من زاوية علاقات الهيمنة والقوة المفضية بالضرورة إلى الإخضاع والإكراه. وهذا القصور ناتج عن محدودية هذه النزعة في عدم قدرة رؤية التراتبية إلا من زاوية نظر مادية وليس من زاوية نظر التفاضل الكيفي أو النوعي الذي يحافظ على توازن الكون واستمراريته. يقول حسين نصر: "النظرة المقيّدة للغاية المرتبطة بالعلم الحديث تجعل معرفة علم الكونيات بالمعنى الحقيقي مستحيلةً في مصفوفة وجهة نظر العالم العلمي الحديث. علم الكونيات هو علم يتعامل مع جميع أنظمة الواقع الرسمي، حيث لا يُعدّ النظام المادي سوى جانب واحد"[79].
لقد صرّحت بريدوتي في كتابها باعتراضها على سيادة الإنسان للكون[80]، وهي تعي ما تقول من موقع ما بعد حداثي، فهي ترى أن جشع الإنسان الحديث هو الذي أفضى إلى هذه الكوارث البيئية والطبيعية. لكن حسين نصر يرى أن العلوم الحديثة هي التي حوّلت الطبيعة إلى "شيء" وهي المسؤولة بدرجة أولى على خلق منظومة حوّلت الطبيعة إلى مجرّد أداة أفرغتها من دلالاتها المقدسة[81]. كما أن التصور الأنطولوجي للكتابات ما بعد الحداثية سينجرّ عنه شكل من العلاقة بين الإنسان والطبيعة والله لا يختلف عن التصور الأنطولوجي للحداثة، حيث اختارت روزي بريدوتي نموذج تأليه الطبيعة لسبينوزا[82] (جعل عملية فهمنا للإله مرتبطة بالعلوم الطبيعية، فحجَّة سبينوزا المعروفة في كتابه "رسالة في اللاهوت والسياسة" هي أن حركة الظواهر الطبيعية نابعة من تصرفات الإله، ففهم الطبيعة يعني فهم الإله حسب سبينوزا)[83] للتعبير عن رفضها للرجوع إلى النظريات الشمولية التي تحمل مفهومًا مقدسًا عن الأرض[84]، حيث تعتقد أن هذه النظرة تحافظ على ثنائية الطبيعة والثقافة، ولم تشرح ذلك[85] (والقضاء على الثنائيات هو ادعاء وسمة الكتابات الما بعد حداثية). إن الزاوية النقدية التي تركها لنا سيد حسين نصر تتيح لنا فرصة الفهم بشكل عميق نظرة بريدوتي الاختزالية تجاه الرؤية الشمولية الحاملة لقدسية الفضاء أو المكان والطبيعة خصوصًا.
إن قراءتنا لبريدوتي كانت مناسبة فلسفية حاسمة لفهم قصور دراسات ما بعد الحداثة في فهم الفرق الأنطولوجي والمنهجي بين نموذج الحداثة الذي يحمل بدوره هذه الثنائية وبين الرؤية القدسية عن الطبيعة[86]. إن عملية المصالحة بين الطبيعة والثقافة التي تدعو إليها بريدوتي، وسدّ الفجوة بينهما لا يرتبط بمشروع يجمع بينهما على نحو مطلق ومرتبط بالحكمة المتعالية على أساس المعرفة المقدسة. إنما هي شكل من أشكال الجمع الذي يضاف إلى التماثل المطّرد الذي يجرّد الكائنات من التراتبية الهرمية القائمة على أساس التفاضل النوعي أو الكيفي، ولا تمنح الإنسان صفته السيادية على المخلوقات التي تمكنه من التصرّف بأمانة ومسؤولية تجاه المخلوقات؛ لأن نظام الكون لا يمكن أن يحقق توازنه إلا داخل تسلسل هرمي تفاضلي وحده الإنسان العاقل (sapientiel) القادر على تحقيقه وحفظه (مثلًا لا يمكن أن نترك الحيوانات السامة كالثعابين تنتشر دون سياسة للحدّ من انتشارها على نحو عشوائي وإلا أضرّت الأرض والنسل). كما أن هذه المسؤولية تجاه الطبيعة بالنسبة إلى الدراسات الما بعد حداثية لن تكون على أرضية أنطولوجية متعالية بالشكل الذي تغطي به وتستوعب ثنائيات الكون على نحو ميتافيزيقي قادر على الجمع بين عناصر الكون بشكل يفضي إلى الوحدة؛ لأنها تدافع عن القضاء على كل أشكال التراتبية الهرمية بين الكائنات، والقضاء على كل الفروق النوعية. يقول حسين نصر: "يرجع اختفاء علم الكونيات الحقيقي في الغرب بشكل عام إلى إهمال الميتافيزيقيا، وخاصةً إلى عدم تذكّر التسلسل الهرمي للوجود والمعرفة. يجري تقليل المستويات المتعددة للواقع إلى مجال نفسي فيزيائي واحد، كما لو أن البُعد الثالث جرى إخراجه فجأةً من رؤيتنا للمناظر الطبيعية. ونتيجةً لذلك، لم يُختزل علم الكونيات في العلوم الخاصة بالمواد المادية فحسب، ولكن بمعنى أكثر عمومية، فقد أصبح الميل إلى تقليل المستوى الأعلى إلى الأدنى، وعلى العكس من ذلك محاولة جعل الأكبر يخرج من الأقل أكثر انتشارًا على نطاق واسع. ومع تدمير كل مفهوم التسلسل الهرمي في الواقع، اختفت العلاقة بين درجات المعرفة والتوافق بين مستويات الواقع المختلفة التي كانت تستند إليها العلوم القديمة والوسطى، مما تسبَّب في ظهور هذه العلوم كخرافات (بالمعنى الاشتقاقي من هذه الكلمة) وكشيء تم تدمير أو نسيان مبدئه أو أساسه"[87].
خاتمة
في مقاله "نهاية الفلسفة ومهمة التفكير"، حاول هيدغر قرن نهاية الفلسفة بنهاية الميتافيزيقا الحداثية وتحقيقها لعتبة الكمال: "تتحدَّد نهاية الفلسفة على أنها المكان الذي يجتمع فيه تاريخها في أقصى إمكانياتها، وبهذا فإن نهايتها كتحقُّق أو كمال يعني هذا الاجتماع"[88]. فنهاية الفلسفة تعني نهاية تحكُّم الميتافيزيقا في تاريخ الفلسفة واستقلالية العلوم التي تهتمُّ بالإنسان عن الميتافيزيقا، وتتحوَّل هذه العلوم التجريبية إلى موضوع للتقانة قابل للتجربة: "عبر هذه التقنية يكون الإنسان مقيمًا في العالم"[89]. ونهاية الفلسفة هي إعلان ضمنيٌّ عن نهاية دور الفلسفة في تشكيل أفراد وذوات حديثة كما سطّرها فلاسفة التنوير الذين بنوا حجر الأساس النظري للحضارة الحديثة: "تظهر نهاية الفلسفة على أنها نجاح التنظيم الموجّه للعالم العلمي-التقني ونجاح ترتيب هذا العالم الحضاري في التفكير الأوروبي-الغربي"[90]. لكن هيدغر يعتقد أن مهمة التفكير لا تزال متواصلة وهي تتعلق عنده بموضوع الفلسفة بعد نهايتها/اكتمالها، وهو التفكير في الذاتية[91]. فلئن كان سؤال الوجود وحقيقته هو السؤال المركزي الذي يبني عليه هيدغر فلسفته، فإنه يعقد علاقة وثيقة بين الوجود والتفكير بالإنارة أو التنوير، التنوير أو الإضاءة التي تضيء لنا حقيقة الوجود فتوجّه تفكيرنا نحوه، فإذا كانت مهمة التفكير تتجه نحو نداء للموضوع اللامُفكّر فيه، فإن هذه المهمة تمرّ عبر ضرب من إضاءة المكان الذي بقي تحت حجب الظلام. وحده نور أصيل تنجلي من خلاله حقيقة الوجود اللانهائية ويُحوّل لنا المكان إلى مكانٍ حُرّ وفسيح ورحب يسع الجميع دون أن يترك مجالًا لحضور الظلام على نحو مستمرّ.
بالرغم من قدرة فلسفة هيدغر على مصاحبة موضوعات المنظور الحِكمي، وهي: التنوير المتعالي على العقل الاستدلالي والنابع من مصدر متعالٍ، فإن هيدغر اكتفى بطرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بسؤال الوجود ضمن أفق الفلسفة الحديثة التي لا تستطيع الذهاب بعيدًا في عملية التسامي والتعالي والتجريد، وسقطت في فخ الزمنية والتاريخانية. وربما ادعاؤه في قوله بأنه "ربما هناك تفكير خارج الاختلاف بين العقلي واللاعقلي، وهو أشد يقظة من التقنية العملية"[92]، هو نوع من البحث عن تجاوز العقل الاستدلالي، ومحاولة منه للبحث عن حقيقة الوجود في أفق متجاوز لأفق الفلسفة الحداثية، أو ضرب من النقد الجذري لأنطولوجيا الحداثة قبل دخولها لمنعرج الفلسفة الأخلاقية ذات التصور الأنجلو-سكسوني التي تعتبر "الفصل الكانطي للإمبريقي وغير الإمبريقي هو بقايا التمييز الأفلاطوني بين المادي واللامادي، ومن ثَمَّ التمييز اللاهوتي-الميتافيزيقي للإنسان الإلهي"[93]. هذا الموقف الفلسفي لم يكن مستغربًا، بل هو المآل الطبيعي لمسار التخلي التدريجي عن المعرفة الحِكمية المقدَّسة كما وضحنا ذلك في المحور الأول. يُعَدُّ الفيلسوف اليوناني بارمينيدس (حوالي 500 ق.م) المنتمي للمدرسة الإيلية في مقدمة الفلاسفة الذين اعتقدوا أن الوجود ثابت وواحد، وأن الحواس ليست هي مصدر المعرفة الحقيقية. فرجوع هيدغر لمحاورة برمينيدس وحديثه عن إيثيليا وهي اللاتحجّب والقدرة على اليقين بالكشف[94] هو رجوع إلى المعاجم ذاتها التي تنتمي للمعرفة الحكمية المتمركزة حول الحياة الروحية وحول اليقين الداخلي والباطني الذي لا يؤتى إلا بالكشف. لكن هيدغر يعتبر أن التعرّف على خاصية الوجود لا تتم خارج الصورة الدنيوية للعالم (حينما يعرض دلالة التفسير الهيرونيتيقي وما يمكن أن تقدمه هذه المعرفة حول الظواهر داخل العالم)[95]، فهو يقول: "لذلك فمن حسم الأمور أن نرفع اليوم إلى مبدأ التحليل، على نحو يصبح معه مرئيًّا بعدُ، شيء من قبيل خاصية الوجود، فإنه يتعيّن على هذه الخاصية أن تصبح شفافة وأن تُنقل -بما هي تلك- ضمن دائرة الظاهرة الحدثية"[96].
ولذلك فإن مهمة التفكير الحقيقية ضمن المنظور الحِكمي لا ينبغي لها أن تقف عند حدود المعرفة التي يتوسل إليها هيدغر بحثًا عن خاصية الوجود وحقيقته. ففلسفة هيدغر تنطوي على نوع من القصور الميتافيزيقي حينما يريد أن يصل إلى حقائق ميتافيزيقية حول الوجود (باستعماله لمفاهيم الأليثيا التي تنتمي للمعرفة الحكمية الميتافيزيقية لبارمينيدس) بلا ميتافيزيقا، بالرغم من أنه تدشين لطيف للتحدي الما بعد ميتافيزيقي في البحث عن أسئلة الوجود والتفكير في الذاتية كقضية فلسفية مركزية. إن التعارض القائم بين المعرفة الميتافيزيقية وما يروم إليه هيدغر في البحث عن حقيقة الوجود داخل الهيرمنيوطيقيا الحديثة إنما هو ضربٌ من التوفيقية المعقدة المتخفية وراء لغة طريفة تتطلب قرّاء مختصين بهذا الفن. ولذلك يُعَدُّ هيدغر من ضمن الفلاسفة الوجوديين الأكثر عنادًا والأكثر تعقيدًا؛ لأن فلسفته تروم نوعًا من إعادة السحر (Réanchantement) الذكي، لكنَّ ذكاءه لا يتجاوز ذكاء "الحيوان العقلاني" الفاقد لمضمون المعرفة المقدَّسة التي تتعلق بالباطن وتذهب إليه (ولا تتوجه نحو المشاعر أو العقل الاستدلالي أو العقل الحسابي أو موجهة إلى الجانب الغريزي للإنسان) أو شكل من أشكال البحث عن إطار ووحدة أوسع لرؤية حقيقة الوجود وخاصيته، لكن هذا الاتساع هو اتساع أفقيٌّ لا يستمدُّ منابع تجديده من الأعلى (فهو يقول في نقاشه حول الإضاءة والبحث عن سؤال الوجود من خلال هذه الإضاءة بأنه "تصوّف بدون أساس")[97]، وكل عملية تجديد تتأسس من التوسعة الأفقية إلا واستفاضت من المعاني والدلالات لكن على نحو مستنفد )عاجلًا أم آجلًا(؛ لأن ما هو دنيوي محض هو قابل للنفاذ والزوال والتحوّل، وما هو خاضع للكميّ حدوده مضبوطة وقصيرة (وهما العنصران الأساسيان للحقيقة الدنيوية المحضة التي ارتبطت بالحضارة الحديثة: الزوال والتقلُّب، والقياس الكميّ). لكن التجديد العمودي الذي يرتكز على المعرفة المقدسة وتطوير الحياة الروحية عمليًّا إنما هو استفاضة واستزادة في المعاني والدلالات بشكل لا ينفد: {قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددًا}.
لا تزال الأنطولوجيا الحديثة حاملة لإبستيمية تلاحقها مهما تطورت تتمثَّل في التخاصم مع الدين على اعتبار أن الحداثة حينما علمنت الوعي في الغرب حرّرت الوجود من سيطرة الدين، مما جعل الغرب والفلسفة الحديثة يدّعيان بشكل ضمني التفوق الأخلاقي على الدين. ولذلك فإن الدين داخل المقاربات الحديثة هو المحاور الغائب، وهو كما يقول فتحي المسكيني -في رده النقدي على كتاب عزمي بشارة- هو دين بلا رؤية شاملة وموضوع بلا رؤية يقدمها حول نفسه[98]. وهذه من خصائص العلمنة، فمن خصائص العلمنة تجريد الدين من أسلحته الأنطولوجية التي تمكِّنه من القدرة على أن يقول شيئًا مهمًّا معرفيًّا حول نفسه وحول ما يَعِدُ به البشرية. وكأن الوحدة البشرية من مهام الأنظمة العلمانية وحدها. إن الإسلام من أكثر الأديان المنخرطة في النقاش حول الأخلاق، وهذا راجع بالأساس إلى أنه من الأكثر الأديان التي جلبت معها ترسانة فقهية اجتهادية عجز العالم عن حصرها إلى يوم الناس هذا، فالعمق الذي يحمله الإسلام في تصوره للحكمة الإلهية يتجسَّد في قدرته الهائلة على الذهاب إلى أقصى درجات التجريد الكلي (مع المتصوفة)، ومن ثَمَّ الرجوع إلى الواقع الملموس لا بحثًا على درجة تطابق الحقائق مع صورة العالم الدنيوية[99]، "فهو موقف غير إسلامي في شموليته"[100]، وإنما لإصلاحه. فمحاولة مقارنة الإسلام بمدى تطابقه مع الواقع هي بمثابة عملية إفراغ للإسلام من رؤيته الشمولية الأخلاقية في العمق.
يميل جزء مهم من النُّخَب في العالم العربي إلى اعتبار الانحياز إلى الحريات التي تنادي بها منظومة حقوق الإنسان أو أن تكون يساريًّا (بشتَّى أشكال اليسار وعلى اختلاف ألوانه) هي الأفكار الأكثر طرافةً في هذا العالم، والموقف الكبير المريح أخلاقيًّا، وقد لا يرى البعض حرجًا في استعمال أدوات ماركسية (مثلًا) للانحياز طبقيًّا وحتى ثقافيًّا للشعوب بوصفها جزءًا لا يتجزَّأ من الأمة (يعني البحث عن شكل من الأشكال المغايرة لليسار أو شكل عالم ثالثي لليسار)، لكن من منظور ديكولونيالي -وما بعده- تتضح لنا الرؤية بأن فكرة اليسار في حد ذاتها هي فكرة أورو-مركزية (eurocentric)، والسبب في ذلك لا يقتصر على عدم قدرة الطرح اليساري على تحرير الأمة العربية أو شعوب العالم الثالث من التبعية للغرب، بل لأنَّ ليس هناك أي تصور ماركسي أو يساري إلا ويقوم على جملة من الاهتمامات والأهداف والقضايا المُقدَّمة على قضية تحرُّر الأمة من الحداثة الأوروبية كحضارة تبسط نفوذها على العالم. والتحرّر الحقيقي من المركزية الأوروبية يعني التحرّر من علاقة التبعية للحضارة الأوروبية ومنظومة قيمها الأخلاقية -المنحصرة بين كانط وبراجماتية جون ديوي (كما يقول ريتشارد رورتي)- التي تقترحها على العالم من خلال منظومة حقوق الإنسان. كما أن الاتجاه القويم في إعادة البناء/الاستئناف (le Rétablissement) يتم عبر الشروع في بلورة نموذج حضاري خاص بمصادر تفكيرنا، بحيث يتم اعتبار النتاج الأوروبي نتاجًا معرفيًّا مثله مثل باقي المعارف الأخرى، والذي يحمل في جزء كبير من قيمه الأخلاقية طُعْمًا كولونياليًّا يريد أن يضع كل الناس على الخط نفسِه من مستويات الوعي، فهي وحدة إنسانية نازلة أو هابطة لا ترتقي بالبشرية؛ لأن متوسط خط الوعي لا ينتمي إلى المستويات العليا، فتنتهي هذه الوحدة إلى تحجيم مستويات الوعي المتميزة كيفيًّا. وهي كونية اختزالية اختزلت الإنسان في أبعاد مادية تُقاس بالكمّ وبالحاجيات غير الروحية. فالبديل الحضاري لا يوجد فيما تركته الممكنات الفلسفية الغربية، إنما في كل فلسفة تسعى إلى التوسل بالمعرفة المقدَّسة للوصول إلى الحكمة المتعالية، وهي التي تضمن تحقيق وحدة إنسانية على نحو جذري؛ لأن السمات العليا للأنطولوجيا التي تتأسس عليها الحضارة (كما وضحنا ذلك في المحور الثاني) هي التي تملك في ذاتها القدرة على توحيد البشرية وحماية الأفراد من التشتُّت والتصدُّع في الكثرة.
فالمهام التي يمكن أن يضطلع بها التصوف ضمن هذه الأرضية هي مهمة بسيكولوجية في البحث عن حقيقة الوجود الإنساني المرتبطة بفكرة الروح، ومن ثَمَّ تقديم نموذج نظري علاجي لأزمة إنسان القرن الحادي والعشرين، ومهمة فلسفية وهي التي تتعلق بالتشريع الروحي-الحضاري (على عكس التشريع الروحي-الثقافي الذي ينتج عن حقائق وقيم زمنية مؤقتة) للأمة التي فَقَدت بوصلتها الحضارية ولم تعثر بعدُ على وجهة وقبلة واضحة تتجه إليها.
إن الهدف الذي ترمي إليه هذه الورقة البحثية لا يقف عند العنوان فقط، بل يرمي أيضًا إلى توسيع دائرة النقاش الفلسفي حول الدين وحول سؤال الحضارة والحضارة البديلة على نحو أكثر جدية وعمقًا، بعيدًا عن الرؤى والمواقف المتسرّعة حول الدين والميتافيزيقا التي صاحبتها من ناحية رؤى اختزالية لا ترى من صلاحية للعبور للكونية إلا خارج أفق الدين والميتافيزيقا، والكوني الممكن الوحيد هو كوني ما بعد ديني، والتي عاضدتها من ناحية أخرى ثقةٌ مُفرطة تدَّعي أن تجاوز الميتافزيقا والدين أمر حتميٌّ وضروريٌّ لتطور البشرية.
إن كتابات رينيه غينون وسيّد حسين نصر ليست مجرَّد محاولات استئنافية للمعجم الصوفي بلا أفق فلسفي، بل إن التصوّف مع غينون وحسين نصر يقدِّم نظرية حول الذكاء تحمل درجة ومستوى لافتَيْن للانتباه من النديَّة مع النظريات الغربية. فالذكاء الحِكمي (intellegence sapientielle) لدى غينون وحسين نصر هو ذكاء يتجاوز حدود المعرفة الإمبريقية التي تحاول أن توسّع دائرة التجارب بأكثر عدد ممكن لبناء أكثر ما يمكن من فرضيات ومن ثمَّ امتصاص الواقع نظريًّا لتحسين قدرة الفرد على السيطرة على حدوده. بينما صوفيّة غينون وحسين نصر تقدّم شكلًا آخر من الذكاء البشري لفهم الحكمة وحقيقة الوجود. وذلك حينما تعتبر أن الذكاء الحقيقي يكمُن في الارتقاء التدريجي الروحي عموديًّا ويتوسّل بالمعرفة المقدسة للاتصال بالذكاء المطلق النابع من مصدره الإلهي. فبقدر ما حاولت المعرفة الإمبيريقية أن تتوسّع وأن تنوّع من الفرضيات والتجارب وزوايا النظر، إلا أنها لم تبلغ هذا الذكاء المطلق (لأنها حسب نظرية التصوف لم تستطع الوصول إلى مرحلة الكشف والإنارة التي يستدعيها هيدغر في مقاله "نهاية الفلسفة ومهمة التفكير")، وانتهت إلى السقوط في النسبيَّة بالرغم من ادعائها قدرتها على معرفة كل ما ينتمي إلى عالم الوجود.
لقد حاولنا أن نبيِّن الأرضية النظرية التي من خلالها يمكن للتصوّف أن يغادر جداره الأخلاقي المريح -الذي لم يراوحه منذ مدَّة كبيرة- لينافس أعتى النظريات المعاصرة في البسيكولوجيا والفلسفة الوجودية، فيقدّم نفسه بديلًا فلسفيًّا وحضاريًّا لا مجرّد طقم مفاهيمي متاح لكل من عجز عن إيجاد معجم روحي يستعمله لمقاومة أزمة ما بعد الأخلاق بشكل سطحي (كما تفعل ذلك حركة "العصر الروحي الجديد"New Spiritual Age ). فالمهام التي يمكن أن يضطلع بها التصوف ضمن هذه الأرضية هي مهمة بسيكولوجية في البحث عن حقيقة الوجود الإنساني المرتبطة بفكرة الروح، ومن ثَمَّ تقديم نموذج نظري علاجي لأزمة إنسان القرن الحادي والعشرين، ومهمة فلسفية وهي التي تتعلق بالتشريع الروحي-الحضاري (على عكس التشريع الروحي-الثقافي الذي ينتج عن حقائق وقيم زمنية مؤقتة) للأمة التي فَقَدت بوصلتها الحضارية ولم تعثر بعدُ على وجهة وقبلة واضحة تتجه إليها.
إن الامتياز الفلسفي الكبير في طرح هيدغر يتمثّل بالنسبة إلينا في فهم الطريقة التي آلت إليها الميتافيزيقا وانتهت قدراتها في بلورة مشروعيةٍ ما للقول الفلسفي حول ما يتعلق بالإنسان ومصيره وطبيعته، حتى انفصلت عنها العلوم الإنسانية، فأعلن هايدغر نهايتها، وانغلقت معها أبواب العودة إليها ما عدا بعض النوافذ التي تُترك بحثًا عن جرعات من الميتافيزيقا لإضفاء معنى ما للحياة يتجاوز المعاني والدلالات التي تمنحها المنظومة الحساسية. فبالرغم من أن هيدغر مثَّل لحظة فارقة في إعلانه عن نهاية الميتافيزيقا الغربية (ولذلك يمكن أن نعُدّ الفلاسفة ما بعد هيدغر فلاسفة ما بعد الغرب)، فإن كل محاولة تميل إلى مناقشة كتاباته لهي فرصة في غاية الأهمية، فهي تمكِّننا من فهم المنعطفات الكبرى للفلسفة الحديثة والمنعرجات التي أصابت الميتافيزيقا الحديثة في مراحلها ما بعد الكانطية (لأن الميتافيزيقا الحداثية أسَّسها كانط في كتابه "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق")، وأيضًا البحث عن أسباب تراجع هذه الميتافيزيقا الحداثية وضعفها وعدم قدرتها على الصمود ومواصلة الحياة في الثقافة الغربية، كما حاولنا شرحه في هذه المقالة (حيث نعتبر سبب ذلك من منظور حِكمي هو الفصل والقطيعة التي صارت بين العقل الاستدلالي والعقل الفياض).
هناك تقاطع جوهريّ وخفيّ بين الذكاء الحِكمي المطلق غير المنغمس في عالم المادة وغير الخاضع لغلبة الكميّ على الكيفيّ مع ما يمكن تسميته بالذكاء الحضاري. إن الذكاء الحضاري هو ذكاء يجدّد ذاته بمعاييره المطلقة الحِكمية، من خلال منطقه العمودي المتصاعد بحثًا عن مصدر الذكاء أو عن الذكاء المطلق. وهو ذكاء يعتمد على مقاربات لا تخضع لاستراتيجيات الحداثة التي أسلفنا الحديث عن اختلافاتها الجوهرية مع المنظور الحِكمي التقليدي وحدود تصاعدها وتفلسفها داخل الميتافيزيقا. لقد لاحظ الكثير من المنظرين والفلاسفة المعاصرين الحاجة الماسة للدين، فالعالم الحديث يحتاج إلى جرعات من الدين في كل مرحلة من مراحل التاريخ لتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعيَّيْن (يرى دوركايم أن الدين المسيحي هو أقرب للدين اليهودي في تحقيق الاندماج الاجتماعي في تحليله لظاهرة الانتحار في كتابه "الانتحار"). كما أن الرجوع العولمي للدين وإصراره في البحث عن مقاربات جديدة مع التصوف، وذلك في تناوله لراهنية كتابات محيي الدين ابن عربي على سبيل المثال (تيار العصر الجديد New Age)، لهو شكلٌ من أشكال البحث عن جرعات جديدة من الدين لتحقيق نوعٍ من التماسك الأخلاقي الذي أثبت الدين قدرته الفائقة فيه. والذكاء الحضاري يتميّز بعدم تقديم الدين بالشكل الذي تريده الحضارة المهيمنة التي تسعى بدورها -بشكل خفيّ ومخاتل- لنزع الطابع الشمولي للدين وتطويعه لمقارباتها المنسجمة مع روح حضارة العصر غير الحِكمية والمادية على نحو جذري. فالذكاء الحضاري يتميّز بقدرة متجدّدة على إثبات نفسه كبديل عن حضارة العصر والمصاحبة للحِكمة المتعالية النابعة من الذكاء المطلق-الإلهي، والقادر على طرح نفسه كأنموذج يحمل تعريفًا خاصًّا للإنسان وللمجتمع وللسياسة كنظام حكم، وأيضًا كطريقة شاملة في التعامل مع الطبيعة والكون.
إن الذكاء الحضاري والذكاء الحِكمي المطلق يحملان قدرة فائقة وإمكانات فلسفية وروحية وأخلاقية لا مثيل لها، مما يجعلهما قادرين على نسج تجربة ذوقيَّة خاصَّة وثريَّة في البحث عن حقيقة الوجود تتجاوز حدود تيارات الحداثة وامتداداتها، كما أنهما عنوانان للمقاومة الفلسفية في سياق ما بعد ميتافيزيقي على نحو جذري.
- الهوامش
-
[1] Paul Ricoeur, La Crise: UN Phénomène Spécifiquement Moderne ? (Paris, France, Revue de Théologie et de Philosophie, Troisième série, Vol. 120, No. 1 (1988)), pp. 1-19.
[2] Emmanuel Todd, Aprés l'empire; essai sur la décomposition du systéme amércain (Paris, France, Éditions Gallimard, 2002) p. 48.
[3] لا يمكن أن تُتناول هذه الأزمة ضمن أفق الدين في إطار البحث عن شكل معيَّن لقبول هذه الحريات التي وُلدت خارج أفق الدين، والتي لا يمكن أن تولد من داخله، فالأخلاق الإسلامية من منظور "ما بعد رينيه غينون" ورؤيته التفصيلية للاختلافات البنيوية بين الحضارة الحديثة والروح الإسلامية كما سنوضح ذلك في الحضارة التقليدية على المستوى الأخلاقي، لا يمكن أن تخلق مقاربات لحلحلة هذه الأزمة وإيجاد حلٍّ يعيد التوازن بين هذه الحريات الجديدة وحالة التوازن التي وُجدت ما قبل صعود الحركات الاجتماعية ما بعد الحديثة.
[4] حوار مع رامون غروسفوغل، أدار الحوار فرانسيسكو فرينانديز، "عن استحالة فصل الحداثة الأورو-مركزية عن الاستعمار"، ترجمة: البشير عبد السلام، الجزائر: مجلة حكمة، 2017م.
[5] Walter D. Mignolo, The Darker Side Of Western Modernity Global Futures, Decolonial Options ( Durham and London- UK, Duke of university press, 2011), p. 2.
[6] هي دراسات تركِّز على إزالة الكولونيالية بوصفها نسقًا ثقافيًّا لا بوصفها رؤية حضارية شاملة، رغم أن الكتابات الأخيرة لوالتر مينيولو تقترب وتحتكُّ بالنقد الموجَّه لرؤية حضارية شاملة للحداثة.
[7] Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York Press, 1989), p. 66.
[8] Ibid, p. 69.
[9] Ibid, p. 67.
[10]Ibid, p. 16.
[11] Ibid, pp. 13-14.
[12] انظر:
Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane (Paris, France, Éditions Gallimard, 1965)», pp. 81-81.
[13] Mircea Eliade, Le Sacré et le Profane (Paris, France, Éditions Gallimard, 1965), p. 104.
[14] Ibid, p. 105.
[15] انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York Press, 1989), p. 30.
[16] هي نظرية شبيهة بنظرية الفيض عند الفارابي، لكن هذا الأخير وضع شروطًا قريبة من الشروط المادية الدنيوية؛ لأن الاتصال بين العقل الدنيوي مع العقل الفعَّال أو العقل المستفاد يتم حينما يصل الفيلسوف إلى أسمى درجات الذكاء الإنساني، وهي الحالة الوجودية التي تتيح له الاتصال بالذكاء الذي يقع ما وراءه، وهي وجهة نظر لا يختلف فيها مع ابن رشد.
[17] المنعطف الفينومولوجي: حوَّل مهمة العلوم الإنسانية من مهمة التفسير إلى مهمة الفهم، وهذا الفهم يرتكز على التأويل، ولكن هذا التأويل حصر إجرائيًّا أفق العمل في العلوم الإنسانية في البحث عن معانٍ إضافية وجزئية بالنسبة إلى الظاهرة الإنسانية (في الفلسفة) والظاهرة التاريخية (في علم التاريخ) والظاهرة الاجتماعية (في العلوم الاجتماعية). وقد فرض هذا المنعطف حدودًا وعتبات للتفلسف داخل العلوم الإنسانية بالشكل الذي لم يعُد مسموحًا بتجاوز عتبة التأويل والانتقال بجدية إلى المعاني الكبرى والشاملة (macro-sens où des sens toale) للظواهر الإنسانية التي تُبنى على أساسها النماذج التفسيرية.
[18] انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York Press, 1989), p. 29.
[19] Ibid, p. 29.
[20] Ibid, p. 34.
[21] Ibid, p. 35.
[22] انظر:
Michel Henry, Le concept de l'âme a t-il un sens (Paris, France, Revue Philosophique de Louvain, 1966) pp. 5-33.
[23] يشير غينون إلى أن علوم الباطن يصعب حصرها في الظاهر والشكل والتعبير عنها ظاهريًّا؛ ولذلك وللسبب ذاته يصعب أن تتحقَّق إمكانية التعبير عنها وتحصيلها لدى جميع البشر؛ ولذلك ستبقى معرفة عند خاصة الخاصة المخفيين الذين لا يريدون إخفاء هذه المعرفة الأسرارية، ولعل هذا هو العصر الحيوي الذي يجعلها حيَّة حتى وإن قامت روح الحضارة المعاصرة على الضدّ أو مناهضة لهذا التقليد.
[24] Enrique Dussel, "Ethics of Liberation in the Age of Globalization And Exclusion", Translated by Eduardo Mendieta, camilo Pérez Bustillo, Yolanda Angulo, And Nelson Maldonado- Torres, translation edited by Alejandro A. Vallega, Duke University Press, 2013, Durham And London, p. 114.
[25] Ibid.
[26] Ibid, p. 115.
[27] سواء كان ذلك -كما يقول باومان- داخل الحياة المتمركزة حول دور المنتج: معايير وضوابط صارمة لحفظ العملية الانتاجية الكبرى، أو الحياة المتمركزة حول دور الاستهلاك: غياب المعايير والضوابط بحكم سيولة الرغبة التي يقوم عليها الاستهلاك، وهي وضعية غالبًا ما تُسمَّى بوضعية ما بعد الحداثة.
[28] Seyyed Hossein Nasr, Knowledge And The Sacred (New York, USA, State University Of New York Press, 1989), p. 17.
[29] انظر:
Patrick Haenni, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice (Paris :éditions du seuil et La République des idées, octobre 2005), p. 64.
[30] محيي الدين ابن عربي، ماهية القلب، تحقيق: قاسم محمد عباس، (دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، 2009م)، ص54-68.
[31] أبو نصر الفارابي، تحصيل السعادة، قدَّم له وشرحه وبوَّبه: علي أبو ملحم، (بيروت: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1995م)، ص46-47.
[32] محسن مهدي، الفارابي وتأسيس الفلسفة الإسلامية السياسية ، ترجمة: وداد الحاج حسن، (بيروت: دار الفارابي، الطبعة الأولى، 2009م)، ص187.
[33] Abderahmen Badawi, Histoire de la philosophie en islam (Paris-France, Librairie philosophique J.Vrin, 1972), p. 556.
[34] المرجع نفسه، ص318.
[35] René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946) , p. 23.
[37] انظر كيف ربط غينون إيتيمولوجيا العلاقة بين المادة (materia) والفعل اللاتيني الذي يحيلنا على القياس (Metiri)، انظر:
René Guénon, Le Régne De La Quantité Et Les Signes Des Temp (Paris, France, Éditions Gallimard, 1945), p. 18.
[38] René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946) , p. 96-97.
[39] Ibid, p. 97.
[40] يتفق فرانسيس فوكوياما مع يورغان هابرماس في أن صعود الشعبوية إحدى مشكلات الديمقراطية التمثيلية، بينما من موقع الدول العربية ما بعد الاستعمارية فهي تسبب مشكلة تفكيك استراتيجيات الدولة. ذلك أن مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي تنادي به الديمقراطية التمثيلية يُسهم في إضعاف استمرارية استراتيجية الحكومات، ويجعل الدولة غير قادرة على بلورة استراتيجية صلبة. ومن ثَمَّ تفقد الديمقراطية التمثيلية في دول وبلدان العالم الثالث والعربي القدرة على فرض سيادتها.
[41] Ibid, p. 83-85.
[42] Ibid, p. 82.
[43] Richard Rorty, Entre Kant Et Dewey: La Situation Actuelle de la Philosophie Morale, traduction par: Pierre Steiner (Paris, France, Revue internationale de Philosophie, 2008), p. 240.
[44]Chantal Mouffe, la praxis de la démocratie Traduction : Denyse Beaulieu (Paris, France, Beaux-Arts de Paris, 2018), p. 30.
[45] وهذا ما يفعله كلٌّ من هابرماس واتو آيبل وشانتال موف وجون رولز مع إضافات منهجية لكلٍّ من بريدوتي "ونظرية ما بعد الإنسان" وجوديث باتلر في النظرية التقاطعية.
[46] Ernesto Laclau, la guerres des identités, Traduction : Claude Orsoni (Paris, France , Edition La Découverte, 2015) , p. 7.
[47] انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 184-185.
[48] René Guénon, Le Régne De La Quantité Et Les Signes Des Temps (Paris, France, Éditions Gallimard, 1945), p. 35.
[49] René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946), p. 150.
[50] انظر: الفيلسوف الإيراني حسين نصر، "العلمنة حولت الغرب إلى حضارة بلا روح"، أجرى الحوار حامد زارع، بيروت: مجلة الاستغراب، خريف 2015م، ص45-46.
[51] Ibid, p. 81.
[52] Ibid, p. 85.
[53] Ibid, p. 87.
[54] Ibid, pp. 99-100.
[55] فتحي المسكيني، الهجرة إلى الإنسانية، (تونس: دار كلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016م)، ص38-39.
[56] Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York Press Albany, 1981) p. 22.
[57] Ibid, p. 22.
[58] Patrick Haenni, L’islam de marché : l’autre révolution conservatrice (Paris : éditions du seuil et La République des idées, octobre 2005).
[59] كما تمسكت البشرية بنموذج الدولة-الأمة الأوروبية وأسفرت عنه النازية والفاشية، كما أن غينون يرى أن نموذج العولمة هذا سينتهي بالنتائج نفسها؛ لأنه إعلان عن حالة الصلابة (solidification du monde) والانغماس الكلي في المادية، وهو مؤشر على إعلان نهاية الدورة الوجودية للحضارة الحديثة.
[60] René Guénon, La Crise Du Monde Moderne (Paris, France, Éditions Gallimard, 1946), pp. 31-32.
[61] انظر: جوديث باتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة: فلاح رحيم، (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 2014م)، ص80-81.
[62] المرجع نفسه، ص81-82.
[64] وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان، مراجعة: ثائر ديب، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، 2014م)، ص276-275.
[65] المرجع نفسه، ص276.
[66] المرجع نفسه، ص277.
[67] المرجع نفسه، ص190.
[68] يقدِّم الفارابي من خلال نظرية الفيض نموذجًا مهمًّا حول كيفية الاتصال بالحكمة المتعالية، لكنه يرى أن كيفية الاتصال هذه تتم من خلال أسمى مستويات الذكاء البشري، وهنا يتفق مع ابن عربي ويتقاطع جوهريًّا مع البرهان الذي نراه تجسيدًا للعقل الاستدلالي لا للعقل الفيَّاض؛ ذلك أن الفارابي -كما قلنا سابقًا- يقيم نوعًا من التوافق بين الفلسفة والحكمة على اعتبار الأخيرة خاضعةً للأولى.
[69] Michel Maffisolli, La Réeanchatement du monde : Une éthique pour notre temps (Paris, France, édition De La Table Ronde, 2007).
[70] مثل بعض البلدان التي تعتمد على المنظومة القانونية الحديثة، مثل تونس التي فيها قوانين نابعة من الشريعة الإسلامية ومنطقها الخاص، وقوانين نابعة من القانون الفرنسي، وأخرى نابعة من التحيينات الجديدة لمنظومة حقوق الإنسان التي تدافع على حق المثليين والمختلفين جنسيًّا إلى حدٍّ ما.
[71] هذا من الناحية الروحية، أما من الناحية العملية فإن أسس التربية الروحية تتجسَّد في الدور الذي تلعبه الهياكل والبنى التقليدية في تهذيب سلوك الفرد، ولكن البنى التقليدية لا تتماثل مع مؤسسات الدولة الحديثة، فالبنى التقليدية تتميَّز بكونها تهتمُّ بالجانب الروحي لا تقف عند الجانب الخارجي السلوكي كما تفعل ذلك قوانين تنظيم السلوك في الدولة الحديثة، بحكم تقسيمها للفضاء بين الفضاء العام والفضاء الخاص، لكن النموذج الإسلامي التقليدي الحِكمي لا يعترف بهذا التقسيم ويعدُّه تقسيمًا قابلًا للانفصال والتفكك (كما نرى ذلك في مجتمعات ما بعد الحداثة والسياق الأمريكي(.
[72] انظر:
Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York Press Albany, 1981), pp. 22-23.
[73] Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York Press Albany, 1981) , p. 26.
[74] انظر: برتران بادي، الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي، نقله إلى العربية: لطيف فرج، مراجعة: عومرية سلطاني، (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2017م)، ص117-143.
[75] أي حالة ما بعد الإنسان المتمركز على ثقافته (antropocentrique) حتى وإن كانت باسم ثقافة تدَّعي أنها الأفضل، كما تفعل ذلك أغلب خطابات فلاسفة الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
[76] إن التمرُّد الحقيقي على المنظومة العالمية يبدأ حسب تقديري بالخروج من منطق التموضع (la logique de positionnement) داخل ثنائية الهامش/المركز أو المركز/الأطراف، وعدم تسمية الشعوب العربية الإسلامية بالهامشية (كما تعرّفه فلسفة ميشيل فوكو) أو النوماد (les nomades) ((nomadisme (وهو مفهوم لجيل دولوز ويقصد به الرُّحَّل المقصيين من الروايات الرسمية للتاريخ) والبحث عن مصطلح أو مفهوم آخر يُعبّر عن نموذج العيش الخاص بنا. نحن لسنا رُحّلًا أو مجرّد عابري طريق كما تريد أن تقدّمه الرواية غير الرسمية للمنظومة العالمية التي تؤسس منذ مدة لشتات (diaspora) جديد عابر للقوميات، نحن لسنا هوامش على أطراف المنظومة العالمية، والمنظومة العالمية هي التي تريدنا أن نوصِّف أنفسنا بالهوامش ونكتفي بالتوقُّف عند هذا المستوى من التوصيف ونحوِّله -من ثَمَّ- إلى فلسفة حياة ونظلّ نعتبر هذا التوصيف هو الحجة الأساسية التي يمكن أن نعترض بها على النظام العالمي وندافع من خلالها عن أحقيتنا في الوجود داخل هذا العالم؛ لأن النظام العالمي يريد -بشكل ضمني وغير معلن- أن يرسّخ في أذهان الشعوب غير الأوروبية بأنها غير مندمجة أو مندمجة اندماجًا سلبيًّا في المنظومة، سعيًا منه إلى أن تتحوَّل شعوب الشرق إلى كتلة من البشر غاية وجودهم الثقافي والاجتماعي هي البحث عن مكان أفضل داخل النظام العالمي، فيتحوَّل نمط العيش الأورو-أمريكي إلى حلم كوني يسعى إليه كلُّ فرد يسكن هذا الكوكب، فيغدو نمط وجوده محددًا بـ"سياسات الاعتراف" الغربية (les politiques de reconnaissance occidentales)، يعني يظلّ ساعيًا باستمرار وبشكل غير واعٍ أحيانًا إلى أن يعترف به العالم الغربي ويقبل به كإنسان، لكن إنسان وفق الشروط التي يضعها الغرب ويدَّعي أنها الشروط الكونية الوحيدة. والإسلام يملك تجربة روحية طويلة الأمد بالمقارنة مع تاريخ الحضارات تمكِّنه من بناء منوال حضاري متى سمحت الفرصة، والحضارة العولمية هي شكل من أشكال الحضارة الممكنة وليست الشكل الممكن الوحيد للحضارة أو النهاية المنطقية لتاريخ الحضارة البشرية (وهي الأطروحة الضمنية لكتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" لفرنسيس فوكوياما). وبالطبع هذا العمل النظري لا يمكن أن تقدِّمه النُّخَب التي جرى تثبيتها في منظومة الدول ما بعد الاستعمارية، بل هي مهمة لأشخاص آخرين يقعون على الهامش وعلى التخوم لكنهم لا يرون أنهم مطالبون بتقديم أنفسهم بالمقارنة مع المركز أو كردّ فعل عن خطابات المركز وسردياته، كما لا يقف فهمهم للعالم عند حدود ما تقدِّمه المقاربات الجيو-سياسية للمصالح الرسمية بين الدول (وهو المفهوم الإجرائي للدولة بالنسبة إلى الفلاسفة الليبراليين: بينتام وجون ستيوارت ميل)؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن المعرفة في حدِّ ذاتها تخضع إلى تقسيم جيوسياسي قائم على تمييز عِرقي ومناطقي/جغرافي وثقافي بين الأشخاص.
[77] Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin Paperbacks, 1990), p. 18.
[78] Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), p. 82.
[79] Ibid , p. 22.
[80] انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), p. 78.
[81] انظر:
Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin Paperbacks, 1990), pp. 21-23.
[82] Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 85-86.
[83] عن نزعة تأليه الطبيعة لدى سبينوزا وتأثُّر فولتير بهذه النزعة، انظر: ف. فولفين، فلسفة الأنوار، ترجمة: هنرييت عبوري، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر)، ص25-28. انظر خاصةً في صفحة 26 من المرجع نفسه، حيث يوصّف الكاتب إله سبينوزا بالإله البارد الذي يأبى التدخل في شؤون البشر ويصف نزعته هذه بالحلولية.
[84] انظر:
Rosi Braidotti, The Posthuman (Malden, USA, Polity Press, 2013), pp. 84-85.
[85] Ibid, p. 85.
[86] كما نجد أيضًا في السياق ذاته العمل النقدي المهم الذي قام به طلال أسد، والذي كشف فيه عن قصور ترجمة الخطاب الديني في الخطاب العلماني وحتمية اللايقين في الترجمة والتأويل ضمن الأفق العلماني؛ لأن الترجمات العلمانية تعتمد على فصل الأفكار عن التجارب الشعورية والروحانية. وقد كشف طلال أسد عن هذا القصور انطلاقًا من كتابات يورغان هابرماس، وذلك من خلال المغالطة التي يرتكز عليها هابرماس في موقفه الفلسفي في اعتباره أن العلمنة تنطوي على تصوُّر للغة باعتبارها نظامًا محايدًا للوصف والحِجاج وليس جانبًا من الطريقة التي نسكن بها العالم. انظر: طلال أسد، ترجمات علمانية: الأمة-الدولة والذات الحديثة والعقل الحسابي، ترجمة: حجاج أبو جبر، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 2021م)، ص60-119.
[87] Sayyed Hossein Nasr, Man And Nature: The Spiritual Crisis In Modern Man (London, UK, Unwin Paperbacks, 1990), p. 23.
[88] مارتن هيدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ترجمة: وعد علي رحية، تقديم ومراجعة: علي محمد إسبر، (دمشق: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 2016م)، ص53.
[89] المرجع نفسه، ص55.
[90] المرجع نفسه، ص57.
[91] المرجع نفسه، ص65.
[92] المرجع نفسه، ص78.
[93] Richard Rorty, Entre Kant Et Dewey: La Situation Actuelle de la Philosophie Morale, traduction par: Pierre Steiner (Paris, France, Revue internationale de Philosophie, 2008), p. 240.
[94] انظر: مارتن هيدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ص72.
[95] انظر: مارتن هيدغر، تأويليات حداثية، ترجمة: محمد محجوب، (بيروت: مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2019م)، ص142.
[96] المرجع نفسه، ص143.
[97] المرجع نفسه، ص77.
[98] انظر: فتحي المسكيني، حدود العلمانية: ملاحظات على كتاب عزمي بشارة "الدين والعلمانية في السياق التاريخي"، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسيات، 2016م)، ص11-18.
[99] بل بحثًا عن طرق تنزيل الحكمة الإلهية في الواقع في أدق تفاصيله اليومية. وهذا الامتياز الروحي والأخلاقي العملي في منظومة الإسلام بالمقارنة مع الحضارات التقليدية الأخرى.
[100] Seyyed Hossein Nasr, Islamic Life And Thought (New York, USA, State University Of New York Press Albany, 1981) , p. 29.










