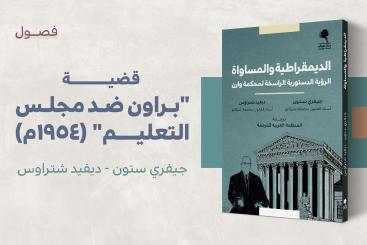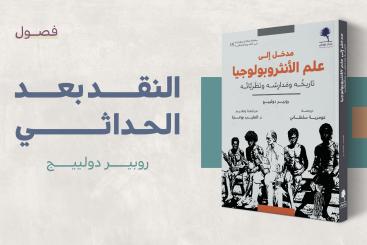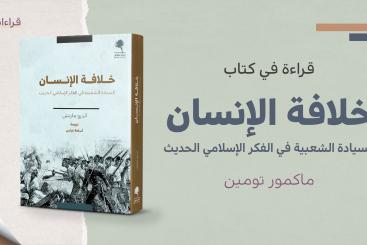الأصولية المسيحية: صحوة فريسيّة بوجه عنصري ونيوليبرالي

كشف هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول عن أزمة سياسية لا سابق لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثارت صور العنف والسطو التي انتشرت عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي تأويلاتٍ متعدِّدةً للواقع السياسي والاجتماعي الجديد داخل أقوى بلد في العالم، حيث ركَّزت أغلبها على شخصية الرئيس ترامب بوصفه مسؤولًا مسؤولية محورية عمَّا جرى من اضطراب، وفي خضم هذا السيل من التحليلات والتعليقات المتشابهة في كثيرٍ من نقاطها أثارني تصريح سريع لمراسل القناة السادسة الإسبانية في واشنطن، غييرمو فيسير، جاء فيه : "يتزعم الخطوط الأولى لهذا الهجوم متعصبون دينيون وجنود سابقون [...] هؤلاء يريدون القيام بثورة شبيهة بتلك التي حدثت في إيران، حيث يجلس رجل دين على كرسي الحكم [...] بالطبع، ليس كلُّ من يؤيد ترامب بالولايات المتحدة أصوليًّا -لسببٍ أو لآخر- لكن كل أصولي فيها هو مؤيد لترامب حتمًا"(1). وقد تزامن هذا التصريح الذي بدا لي حينها مختلفًا عن باقي التحليلات السياسية التي تتكرَّر بصيغ متنوِّعة، تزامن مع اشتغالي على ترجمة كتاب يتعلَّق بالأصولية في نسخها المتعدِّدة وبلاهوت التحرير في العالم، وبدا لي أن إصرار هذا المراسل على جعل الأصولية المسيحية محور الأزمة -إلى جانب عناصر أخرى- في الولايات المتحدة أمرٌ جديرٌ بالمقاربة والتحليل في وقتٍ ما زال العالم ينظر فيه للأصولية الإسلامية باعتبارها الخطر الوحيد، وأن طبيعة الدين المسيحي وتجربة الانتقال إلى العلمانية يُعتبران صمامَ أمان الغرب ضد أي أصولية دينية محتملة! فهل حان الوقت لينتبه الغرب جيدًا إلى خطر الأصولية الخارجة من نسقه الثقافي أم ما زال مُصِرًّا على اختزال الأصولية في نسختها الإسلامية؟
الأصولية ووهم الحصانة
كتب ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي: "ثمة شبح جديد ينتاب أوروبا، وقد اتحدت ضده باطراد رهيب كل قوى أوروبا القديمة: البابا والقيصر، والراديكاليون الفرنسيون، والبوليس الألماني". بالطبع كانا يقصدان بالشبح الجديد: "الشيوعية"، التي تجنَّدت ضدها كل القوى السياسية والأمنية الكلاسيكية، وقد آثرتُ استدعاء هذا التعبير لتوصيف ما حدث في أوروبا والغرب بصفة عامَّة خلال العقدين الأخيرين، وبالخصوص بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001م، من حالة الاستنفار القصوى ضد الشبح الجديد الذي يُسمَّى هذه المرة بــ "الأصولية الإسلامية"، حيث لوحظ اهتمام منقطع النظير بدراسة ظاهرة الأصولية الإسلامية أو الإسلام السياسي، سواء داخل مراكز بحوث خاصَّة أو من خلال أقسام جامعية تُعنى بالعلوم الإنسانية، وبدا أن البحث في تاريخ الإسلام بصفة عامَّة وظهور الحركات الأصولية وتمدُّدها بصفة خاصَّة، يتزايد باطراد مع تزايد وتيرة الهجمات الإرهابية في الغرب تحديدًا، باعتبار أن دراسة هذه الظاهرة أمرٌ حتميٌّ للتعرف إلى العدو الحقيقي الذي يستبيح استقرار الغرب ورفاهيته، ويهدِّد قيمه الحضارية التي كانت حصيلة نضال طويل مع الرجعية الكنسية والإقطاعية.
تفاقمت ظاهرة الإسلاموفوبيا، لا سيما بعد تزايد عدد اللاجئين المنحدرين من الدول الإسلامية، مما نجم عنه حدوث انزلاقات خطيرة على مستوى العلاقات الاجتماعية وتدبير التعايش.
إن هذا الاهتمام (الخوف) بظاهرة الأصولية الإسلامية في الأوساط الأكاديمية والإعلامية كان يحدث بالموازاة مع تركيز الدول الغربية جهودها الأمنية والاستخباراتية -فيما يُعرف بالحرب على الإرهاب- لمواجهة تصاعد موجة التهديد الأمني الأصولي داخل المركز الغربي أو في الهامش، حيث تتموقع مصالحه الحيوية، وهي مواجهة عرفت في أحيان كثيرة تهويلًا كبيرًا لهذا الخطر وتطرفًا في التحليل، وتمَّ توظيف الموضوع لتصفية خلافات سياسية داخلية أو لتشريع قوانين صارمة لها تداعيات خطيرة على حرية وحقوق فئات معينة هي الأكثر هشاشةً، وعلى رأسها فئة المهاجرين أو أبنائهم من الجيل الثاني والثالث. وهكذا تفاقمت ظاهرة الإسلاموفوبيا، لا سيما بعد تزايد عدد اللاجئين المنحدرين من الدول الإسلامية، مما نجم عنه حدوث انزلاقات خطيرة على مستوى العلاقات الاجتماعية وتدبير التعايش. وكأن الغرب الرأسمالي يُصرّ على تكرار تجربة سابقة له مع الخطر الأحمر، التي لخَّصها أمين معلوف في مقولته: "ثمة مصيبتان رئيستان في القرن العشرين: الشيوعية ومناهضة الشيوعية، وفي القرن الحادي والعشرين أيضًا ثمة مصيبتان رئيستان: الأصولية ومناهضة الأصولية"، وهو ما لاحظناه في عدَّة إجراءات وقوانين وتفاصيل إلى حدٍّ اقترن فيه مصطلح الأصولية بالإسلام مباشرةً؛ إذ نجد مثلًا أن قاموس الأكاديمية الملكية للغة الإسبانية في نسخته الثانية والعشرين يُعرِّف الأصولية بأنها "حركة دينية وسياسية جماهيرية تسعى إلى استعادة الطهرانية الإسلامية من خلال التطبيق الصارم للشريعة القرآنية داخل الحياة الاجتماعية". بيد أن مصطلح "الأصولية" في الحقيقة له مدلول مختلف في التراث الفقهي والكلامي الإسلامي، وأما مدلوله السياسي المعاصر فترجع صياغته إلى الغرب تحديدًا، للإشارة إلى طائفة مسيحية محدَّدة، هي الإنجيلية الخمسينية بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم جرى إسقاطه لاحقًا على مجالات تداولية أخرى، مثلما حدث مع مصطلح العولمة الذي نشأ في سياق اقتصادي ليُعمَّم على سياقات أخرى.
الأصولية المسيحية: وجه حداثي وروح رجعية
هكذا إذن، وفي غمرة الاهتمام بالحرب الإعلامية والأمنية على الإرهاب الأصولي الإسلاموي كانت تتصاعد في الظل الغربي أصولية مسيحية متطرفة جدًّا، ولا يقلُّ خطرها عن الأولى، بل هناك من يرى أنها أكثر خطرًا، وذلك لكونها أصولية يعتنقها أشخاص نافذون في الدولة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية الكبرى، الذين وإن كانوا يُظهرون إيمانًا بالديمقراطية والحداثة، إلَّا أنهم بالمقابل يتحالفون مع تيارات مسيحية محافظة ورجعَّية ويتبنون أفكارها؛ إنهم على عكس الأصوليين الإسلاميين -الذين يتعمدون في كثيرٍ من المناسبات أن يظهروا بمظهر متمرد على الحداثة في هندامهم- يُجارون الحداثة في المظهر ويرفضونها في الجوهر. بدأ هذا التحالف يخرج إلى الظل ويظهر جليًّا في شخص بعض الوجوه السياسية المعروفة، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونظرائه في البرازيل والمجر وبولونيا، وبعض المسؤولين البارزين في دولٍ كبرى، من قبيل وزير داخلية إيطاليا السابق ماثيو سالفيني، وكذلك في منظمات كبيرة، مثل جمعية "المحامون المسيحيون" بـإسبانيا أو منظمة "التحالف المسيحي من أجل القيم التقليدية" ومؤسسة "الاقتصاد المسيحي" بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على أحزاب يمينية صاعدة بقوة، مثل حزب باتريوتا في البرازيل أو حزب فوكس في إسبانيا.
وإذا كان الإعلام في الغرب لا يسلِّط الضوء بشكل كافٍ على هذه الظاهرة المقلقة، فإننا نجد نقدًا صارمًا لها لدى بعض السوسيولوجيين واللاهوتيين البارزين، من قبيل الإسباني خوان خوسيه طامايو، لا سيما في كتابه الأخير "تدويل الكراهية: التأسيس والتفكيك"، الذي تعود فكرة تأليفه إلى لحظةٍ كان يقدِّم خلالها محاضرات لطلاب الماجستير في جامعة لاهوتية بالبرازيل، فسأله أحد الطلبة مستغربًا: لماذا حين نكون في الكنيسة يطلبون منَّا عدم الحديث في السياسة في حين أن الرئيس بولسونارو دائم الحديث عن الإنجيل؟ فأجابه طامايو بحزم: "بما أن بولسونارو ليس لاهوتيًّا، بل رجل سلطة، ويتحدَّث عن الإنجيل، فإنه ينتمي لا محالة إلى المسيحية النيوفاشية". وهذا المصطلح الأخير -يؤكِّد طامايو- قد استعاره من اللاهوتية دورثي سول التي وظَّفته للإشارة إلى تحالف الكنيستَيْن الكاثوليكية والبروتستانتية مع الفوهرر (هتلر)، ثم قام طامايو بتعميمه على جميع المؤسسات الأصولية في الولايات الأمريكية وأمريكا اللاتينية التي تدعم قادة سياسيين يتبنون مواقفَ فاشية واضحة، ويضيف أن استخدام اللاحق "نيو/جديد" هو أمر مقصود؛ لأننا وصلنا إلى مرحلة بات كل ما هو "نيو/جديد" أو "post/بعدي" أسوأ من الأصل في المحصلة.
إنَّ خطورة تحالف الأصولية المسيحية وزواجها من القادة النيوليبراليين له تداعيات خطيرة؛ لأنه يدفع نحو رفض كل المقترحات الداعية للمساواة في العلاقات الأسرية، وتجاوز الحالة الكارثية للتغيُّر المناخي، وكل ما من شأنه إقرار مشاريع تؤدي إلى تكافؤ الفرص، ناهيك أنه تحالف عنصري يحاول ترسيخ تفوُّق العنصر الأبيض على باقي الأجناس، و هو ما حدا -على سبيل المثال- باللاهوتي الأمريكي من أصول أفريقية جيمس كُون إلى التنبيه على أن "مسيح الأوروبيين البيض ليس لديه الكثير ليقوله لملايين الأمريكيين السود المحرومين من الحقوق الأساسية"(2)، ولعله نفس تعليق باقي لاهوتيي التحرير من السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية؛ هذه القارة التي تابعنا فيها سلسلة من الانقلابات أو محاولات الانقلاب على حكومات تقدُّمية، كتلك التي عرفتها البرازيل مع ديلما أو بوليفيا مع موراليس، بغيةَ تعويضها بحكومات رجعيَّة متطرفة ومتحالفة مع النيوليبرالية والكنيسة المحافظة التي باتت تزرع الكراهية باسم المحبَّة، وذلك من خلال مؤسساتها وأحزابها غير المباشرة.
يذهب طامايو إلى أن هذا الصمت والتواطؤ من قِبل الكنيسة في إسبانيا مع هؤلاء الناشطين والسياسيين والفاعلين الجمعويين المتطرفين نابعٌ من كون رجال الدين الإسبان لا يشعرون براحة كافية في ظل الديمقراطية ومبدأ فصل الدين عن السياسة.
هكذا بتنا نشاهد باطراد العدِيدَ من القادة الغربيين الذين يُصِرُّون على استدعاء رموزٍ دينية خلال خطاباتهم المُروّجة للكراهية والعنصرية والاستبداد، فخرج ترامب رافعًا الإنجيل كي يندِّد بنتائج الانتخابات الديمقراطية، مثلما خرج حلفاؤه الإنقلابيون في فنزويلا وبوليفيا، وهو أمر كان ماثيو سالفيني بدوره معتادًا أن يفعله في أثناء خطاباته، حيث أنه وإن لم يسبق له أن خضع للتعميد، إلَّا أنه كان يصرّ دائمًا على أن يظهر أمام أنصاره حاملًا السبحة والصليب؛ لا ليدعو إلى المحبَّة كما المسيح، بل ليُعلن إجراءات التضييق على المسلمين وطرد المهاجرين، وكل ذلك من خلال خطابٍ غارقٍ في الذكورية والعنصرية المتعصِّبة للرجل الأبيض، الشيء الذي كان يدفع -في كثير من الأحيان- بعض رجال الدين المسيحيين الشرفاء بايطاليا إلى التبرؤ من تطرفه، وهو ما لا يحدث في كثيرٍ من الدول الأخرى مثل إسبانيا، حيث لا يخرج رجال الدين للتنديد بالتصريحات المحرضة على الكراهية لبعض القادة السياسيين النيوفاشيين في أحزاب يمينية، من قبيل فوكس Vox، أو ضد تصريحات بعض أعضاء الجمعيات المتعصبة، من قبيل "المحامون المسيحيون " أو جماعة Yunque. بل إن بعض هؤلاء قد شارك مؤخرًا في تظاهرة نازية في مدريد تخليدًا لذكرى إرسال الديكتاتور فرانكو للفيلق الأزرق الذي ساعد هتلر في حربه ضد روسيا، وقد رُدِّدت عبارات عنصرية خلال هذه التظاهرة ضد اليهود والمسلمين وأخرى بذيئة ضد اليساريين. ويذهب طامايو إلى أن هذا الصمت والتواطؤ من قِبل الكنيسة في إسبانيا مع هؤلاء الناشطين والسياسيين والفاعلين الجمعويين المتطرفين نابعٌ من كون رجال الدين الإسبان لا يشعرون براحة كافية في ظل الديمقراطية ومبدأ فصل الدين عن السياسة. فعلى الرغم من أن المجتمع الاسباني يُعَدُّ من أشد المجتمعات علمنةً في أوروبا (إسبانيا خامس دولة من حيثُ عدد اللادينيين)، حيث لا تحكمه أخلاق الكنيسة الكاثوليكية، فإن هناك بالمقابل هيراركية كاثوليكية صلبة تدَّعي تمثيل المسيحية، وتتمتَّع باعتراف كل الأحزاب التي حكمت إسبانيا خلال الانتقال الديمقراطي، بما فيها الحزب اليساري.
هل فشل مشروع العَلمنة؟!
يحقُّ لنا السؤال -في ظل هذا المشهد المقلق- عن الأسباب التي تقف وراء هذا الصعود المتنامي للأصولية في الغرب واختراقها للمؤسسات والمجال العام. ويرى طامايو أن تنبؤات مُفكِّري القرن العشرين ومُنظِّريه بخصوص مسار العلمنة لم تكن صائبةً بما فيه الكفاية؛ ذلك أنهم ذهبوا جازمين إلى أن الدين حين يُعزل في المجال الخاص، أي في حقل الإيمانيات ضمن فضاء المعابد أو داخل ما يُعرف في المجال التداولي المسيحي بالضمير، سيكون من شأنه تجنيب المجتمع الكثير من المشاكل التي جاء التنوير لمحاربتها والتأسيس لبدائلها؛ وذلك لأن الدين متى تدخَّل في المجال العام، فإنه يشرعن للديكتاتورية والأنظمة الشمولية. لكن يبدو أن هذا التشخيص ظلَّ تشخيصًا ناقصًا، وهو ما حدا بكلٍّ من ستارك وبينبردج إلى التنبيه بصرامة على أن "الدين سيستمر بالصورة التي وُجد بها على مدار التاريخ، وربما بقوة غير متوقَّعة، وما سيحدث هو أنه سيُعبِّر عن نفسه بطرق متعدِّدة، من بينها الأصولية والطقوسية الجديدة"(3).
هكذا وحين اعتقد منظرو العلمانية أنه مع التقدُّم في الزمن سيفقد الدين كلَّ معنى سياسيٍّ ليتم التعبير عن القضايا الكبرى من خلال مجال عام مستقل، تفاجؤوا في أواسط السبعينيات من القرن المنصرم بصعود ما يسميه جيل كيبل بظاهرة "انتقام الإله"، حيث سيقوم الدين باحتلال المجال العام باعتباره عنصرًا قوميًّا أكثر منه قِيميًّا، أي كمُكون أساسي للهوية الثقافية للشعوب، وهكذا ظهر الإسلام السياسي ليواجه الإمبريالية والتدخل الغربي، وظهرت الصهيونية لتحقيق حلم وطن خاص باليهود، وظهرت الأصولية المسيحية في نُسختَيْها: الكاثوليكية مع انتخاب البابا يوحنا بولس الثاني لرئاسة الفاتيكان وتراجعه عن قرارات مجمع الفاتيكان الثاني الذي كان يشرعن العلمانية، والبروتستانتية لا سيما مع صعود ريغان للحكم في الولايات الأمريكية، حيث سيصبح تداول عبارة "بارك الله في أمريكا" قويًّا في الخطابات الرئاسية، ليرثها باقي الرؤساء من بعده، ويكبر الحنين إلى عهدٍ كانت الولايات المتحدة تُسمَّى فيه بـ "الأمة البروتستانتية"، وقد سبق لروجيه غارودي أن نبَّه إلى أنه منذ عهد واشنطن والقادة الأمريكيون يعتبرون أنفسهم الدراع المسلَّح للعناية الربانية. لكن ما بدأ كدفاعٍ عن الهوية سيأخذ منحًى جديدًا ويتمدَّد إلى مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية أكثر حساسيةً وأشد تطرفًا، لا سيما في النسخة البروتستانتية التي وإن شاركت باقي الأصوليات معالمها العامَّة (غياب أي قراءة هيرمينوطيقة للنص المقدَّس، ونظرة متشائمة للواقع مقابل الحنين لواقع متخيَّل ومزعوم، وأطلقَة النسبي، وعولمة المحلي، وتعميم الخاص، ورفع الرأي القابل للشكِّ إلى مستوى الدوغما، وتبسيط المعقَّد، وتخليد ما هو زمني وتاريخي، واختزال المتعدِّد في الواحد...) إلَّا أنها تبقى أصولية أكثر خطرًا ونفوذًا.
الأصولية البروتستانتية وزواجها بالنيوليبرالية
في مؤلَّفه الشيق "ماذا لو كان الإله ناشطًا حقوقيًّا"، يرى السوسيولوجي البارز بوافنتورا دي سوسا سانتوس أنه إذا كانت الأصولية الإسلامية تثير قضايا متعلِّقة برفض بعض ملامح الحداثة الغربية، وبالتأويل الصارم للشريعة -باعتبارها قانونًا إلهيًّا- وعدم توافقها مع النُّظم الديمقراطية وحقوق النساء، فإن الشيء نفسَه يحدث -وإن بصيغ مختلفة- مع الأصولية المسيحية، لا سيما البروتستانتية منها، التي ظهرت بشكل أساسي في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، وتُعرف باسم "اليمين المسيحي الجديد". ويُعَدُّ القس المعمداني جيري فالويل أحد الموجّهين الرئيسين لليمين المسيحي الجديد، وقد تحوَّل تنظيمه "الأغلبية الأخلاقية" Moral Majority inc -بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مماثلة- إلى جماعات ضغط قامت بتنظيم حملات حول عددٍ كبيرٍ من قضايا السياسة العامَّة؛ كالإجهاض والمثلية، وتدريس نظرية التطور الطبيعي في المدارس، وخطر "الأنسنة العلمانية"، والتشريع الخاص بحقوق الأقليات، والصلاة بالمدارس العمومية(4).
يرى فالويل أنه: "يجب أن نتمرَّد ضد التعديل المتعلِّق بالمساواة في الحقوق، وضد الثورة النسوية والثورة المثلية".
ويرى خوسيه كازانوفا أن التيار المهيمن في البروتستانتية الأصولية قد يعيد تشكيل "الهيمنة الثقافية للبروتستانتية الإنجيلية لأجل إعادة مسحنة الدستور والجمهورية والمجتمع المدني الأمريكي"(5). وتتمثَّل الحجَّة المركزية لدى هذه الحركات الأصولية في أن المجتمع الحديث قام بتحرير ولَبرلة الأسرة والتعليم والإجهاض، وهو ما يُعَدُّ خيانةً لمجموعة من القيم المسيحية؛ ولذلك يدافع أنصار هذا التيار عن أدنى تدخُّل للدولة في الحياة الخاصَّة، وهكذا يقول فالويل: "ندعو إلى سنِّ تشريع لحماية الأسرة يحفز على ترميم وحدة الأسرة وسلطة الأب ومناخ السلطة التقليدية [...] ويقوّي العلاقات التقليدية بين الزوج والزوجة"(6). كما يدعون كذلك إلى إعادة دمج بعض الأمور في المجال الخاص كان قد سبق لحركات تحرُّرية -خاصةً ذات النزوع النسوي- أن قامت بإدخالها للمجال العام، وهكذا يرى فالويل أنه: "يجب أن نتمرَّد ضد التعديل المتعلِّق بالمساواة في الحقوق، وضد الثورة النسوية والثورة المثلية"، كما يكافحون في الوقت نفسِه من أجل مسحنة هياكل الدولة، لا سيما التعليم وإقامة أسلوب عيش أمريكي يطابق (شريعة الرب)؛ إذ يضيف: "إن السلوك القويم يجب أن يصبح هو أسلوب العيش الأمريكي [...] ويجب الاعتراف من جديد بالسلطة الأخلاقية للكتاب المقدَّس باعتبارها المبدأ الشرعي الأساسي الذي يقود أمتنا"(7).
وفي عام 1984م، أكَّد ريشارد فيغيري -وهو أحد أبرز وجوه اليمين المسيحي الجديد- أنه "على المحافظين أن يعملوا جيدًا لبلوغ ذلك اليوم الذي يدور فيه صراع الانتخابات الرئاسية بين ديمقراطي محافظ وجمهوري محافظ، وحينها يمكننا الذهاب إلى اصطياد السمك أو لعب الغولف؛ لأننا سنكون متيقِّنين أنه سواء فاز الديمقراطي أو الجمهوري، فالأمران سيان"(8). وبعد أقل من أربعين عامًا، بدا وكأن هذه النبوءة قد تحقَّقت، ويُعَدُّ ترامب ثالث رئيس أمريكي -بعد ريغان وجورج بوش الابن- يحظى بدعمٍ مباشرٍ من قِبل الأصولية البروتستانتنية؛ ولذلك لطالما أكَّد في العديد من المناسبات عن رغبته في السماح للكنيسة بالحضور في المجال العام وضمان ما اعتبره حقَّها في التعبير عن آرائها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ففي خطابه في بارانكو عام 2016م صرح أنَّ "أول ما سأفعله هو منح الصوت من جديد لكنائسنا [...] سأدافع عن حرياتها الدينية وحقها في الممارسة الكاملة والحرة لها، كأفراد وكأصحاب مشاريع ومؤسسات أكاديمية"، وأضاف: "لقد تأسَّست جمهوريتنا على قاعدة أن الحرية ليست هدية من الحكومة، بل من الرب [...] ومن بين هذه الحريات: حرية التصرف حسب معتقداتنا الخاصَّة". وفي رغبة منه لرد الجميل إلى الأصولية التي أوصلته إلى الحكم، كان ترامب ينوي تعديل قانون جونسون (يعفي المؤسسات الدينية من الضرائب شريطة عدم تدخلها في أيِّ حملة سياسية لترشيح شخصية معينة في منصب عام) ليجعل الإعفاء غير مشروط.
ولا تقتصر عملية إعادة تمسيح المجتمع الأمريكي على استرجاع سلطة الأب والتقاليد، بل تمر كذلك من خلال ترسيخ ما يعتبرونه الأخلاق المسيحية المتعلِّقة بالمسؤولية واقتصاد السوق، ويقدِّم غاري نورث -رئيس مؤسسة الاقتصاد المسيحي (ICE) في تايلر بولاية تكساس- أهداف المؤسسة بهذه الطريقة: "إن ICE تسعى إلى الدفاع عن المقترح الذي يرى أن الأخلاق الإنجيلية تستدعي إحساسًا مطلقًا بالمسؤولية الفردية، وهذا الفعل الإنساني المسؤول يزهر بالطريقة الأكثر إنتاجيةً في نطاق حكومة محدودة وسياسة لا مركزية وتدخل متدنٍّ للحكومة المدنية في الاقتصاد"(9). ويرى نورث أن أكثر الأصوات التي علت خلال الخمسين عامًا الأخيرة هي تلك التي كانت تدافع عن مسيحية اجتماعية، والتي -في رأيه- "تؤيد التدخل الحكومي تأييدًا قويًّا"، وهو التدخل الذي يجب أن يأخذ طابعًا ثيوقراطيًّا واضحًا حسب رأيه، ويرى أن "وصفة الثراء" لأجل تحقيق نمو اقتصادي لمجتمعٍ ما تكْمُن في اتباع شريعة موسى، داعيًا إلى ما يُعرف بـ "لاهوت الرخاء" Gospel prosperity، الذي يعدُّه بوافنتورا سانتوس شكلًا آخرَ لشرعنة الاقتصاد الرأسمالي وما ينتجه من تفاوت طبقي. وإذ ينطلق نورث من الافتراض المسبق بأن الرب يريد أن ينعَم الإنسان بالرخاء، فإنه يرى أن هذا الأخير غير قادرٍ على أن ينعم بالرفاهية بذاته، باعتبار أن الرب هو مَن يشرّع الغنى والاستغناء. وعلى سبيل المثال، تجيب غينز على سؤال: هل من الجشع اشتهاء الماديات؟ قائلة: أن تكون غنيًّا لا يعني أنك إنسان جشع أو غير صالح [...] فالجشع يكون عندما تقول: (أريد هذا الشيء ولا أريده أن يكون عندك. أما قولك: (أريد أن أمتلك الكثير وأريدك أيضًا أن تمتلك الكثير)، فهذا لا يُعَدُّ جشعًا. إذا كنَّا نؤمن بأن نِعم الله لا حدَّ لها، فحينها يجب على كل شخصٍ أن يسعى إلى امتلاك ما يريده إلى أقصى حد، فالمال مثل الحب، كلما منحت أكثر امتلكت أكثر، وكما أن الحب هو مورد غير محدود، فإن المال كذلك أيضًا، وكلاهما خلقهما الرب لأجل إغناء حياتنا، ولكي يتسنَّى لنا أن نعيش حياة طيبة وسعيدة ومكتملة(10).
تحاول هذه الأصولية أن تجعل الفئات الهشَّة التي تعيش على إعانات الحكومة هي التي تسرق المال العام، وتضع الشركات الكبرى المعفيَّة من الضرائب في مرتبة المسيح المتصدِّق.
إن الدولة الاجتماعية -بحسب هذا المنظور- هي بمثابة محاولة مُدنَّسة لتعويض الدور التنظيمي للرب ووسيلة لجعل الأفراد "كسالى". وبحسب كينيث هاغن: "في زمن الكنيسة الأولى لم يكن للحكومات أيُّ مشروع متعلِّق بالرخاء الاجتماعي، وكانت الكنيسة هي التي تتكفَّل باحتياجاتهم الخاصَّة، ومن ضمنهم الأرامل والأيتام [ ...] ولقد ابتعدنا اليوم عن هذا، فالحكومة تقوم بكل شيء وكأنها الربّ، مع أن القديس بولس يقول إن أقارب الأرامل هم من يجب أن يتكفل بهنَّ، ويقول إنه على المؤمنين أن يشتغلوا بأيديهم لكسب رزقهم [...] فالرجل الذي يعيش عالةً على غيره يسرقهم"(11). هكذا تحاول هذه الأصولية أن تجعل الفئات الهشَّة التي تعيش على إعانات الحكومة هي التي تسرق المال العام، وتضع الشركات الكبرى المعفيَّة من الضرائب في مرتبة المسيح المتصدِّق.
إن تمدُّد الحركات الأصولية المسيحية عبر العالم، سواء من خلال حملات تبشيرية أو عن طريق الموارد الإلكترونية، يترك أثرًا سياسيًّا مهمًّا في القضايا المحورية للشعوب، وهو ما نلاحظه في البرازيل مثلًا، حيث يتوفر الخمسينيون الجدد على حوالي تسعة وخمسين نائبًا، ليكونوا ثاني أكبر فريق برلماني في المجلس الوطني، وهو أمر جعل النقاش السياسي خلال الحملات الانتخابية الثلاث الأخيرة يتمحور حول مسألة الإجهاض بدلًا من قضايا أخرى مهمَّة، مثل الاقتصاد والسكن أو التعليم، حتى إنه عندما ترأس ماركو فيليسيانو -راعي إحدى الطوائف الخمسينية Igreia Evangelica Assambleia de Deus- لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان البرازيلي، قام باقتراح قانون مثير للجدل عُرف بـ "علاج الشواذ"، الذي سيسمح -في حال الموافقة عليه- بالتعامل مع المثلية الجنسية باعتبارها مرضًا، وذلك بدلًا من أن يقترح قوانينَ لصالح الفئات الهشَّة اجتماعيًّا واقتصاديًّا(12).
إذن، إننا لسنا أمام حركات رافضة للمشاركة في نُظُم اقتصادية وسياسية بداعي الحنين الثيوقراطي الطهراني البسيط، وإنما نحن أمام استراتيجياتٍ للاندماج في هذه النُّظم التي تُوظِّف آليات خاصَّة بهدف التأثير في أجندتها، وهذا أمر واضح للعيان على مدى عقود، لا سيما في التأثير الذي يمارسه اليمين الجديد على السياسة والتشريع في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. ولذلك لا يتردَّد كلٌّ من دافيدسون وهاريس في اعتبار المسيحيين الثيوقراطيين في أمريكا نسخةً جديدةً للفاشية؛ ذلك أنهم يدافعون عن فرض عقوبة الإعدام بحق المدافعين عن الإجهاض والمثليين والنساء اللواتي يتمرَّدن على الأدوار الجنسية التقليدية، وعن ضرورة ترك غير المسيحيين معتقلين خلال الحرب، والسماح بأن يغادر الأطفال المدرسة العمومية والعودة للمدرسة المنزلية، والاعتماد على الإنجيل بوصفه مرجعًا للحقيقة في العلوم، مع اعتبار التنوير مشروعًا مناهضًا للمسيحية مثله مثل الديمقراطية الليبرالية المنبثقة عن الثورة الفرنسية(13).
إذا كان الهجوم على مبنى الكونغرس من قِبل متطرفين دينيين مسيحيين قد دفعنا إلى كشف الغطاء قليلًا عن هذه الظاهرة المتغلغلة في عدَّة بلدان مسيحية تتغنَّى بالديمقراطية، فإنه نبَّهنا كذلك إلى أنها أصوليةٌ تشتغل على مستويات عدَّة، سواء بشكل قانوني عبر اختراق مؤسسات سياسية واقتصادية مهمَّة، أو خارج القانون من خلال ميلشيات منظَّمة تؤمن بالعنف. فهل الغرب منتبه بما يكفي لهذا الخطر الذي يتهدَّده من داخل نسقه الحضاري أم أنه ما زال يحصر الخطر الأصولي على المركز في نسخته القادمة من الهامش؟ وهل نعتبر تلميح الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب تنصيبه إلى تهديد "الإرهاب الداخلي" بدايةً لمواجهة هذا الخطر؟ وهل يعني ذلك أن الديمقراطيين مستعدون لكل الاحتمالات التي قد تفرزها المواجهة، لا سيما أن دونالد ترامب قد توعد بالانتقام لمشروعه الذي يحظى بدعم أصولي من خلال مقولته "سنعود بطريقة أو بأخرى"؟ وهل الغرب الرأسمالي -في بحثه عن ترياق مضاد لأصوليته الدينية- مستعدّ للتحالف مع لاهوت التحرير أم ما زال يرى الأخير خطرًا على أيديولوجيته الرأسمالية، ولا يسعه إذاك -وهو الخائف من لاهوت الكراهية الذي يهدِّد قيمه الحضارية، ومن لاهوت التحرير الذي يهدِّد نموذجه الاقتصادي- إلَّا أن يُبقي الدولة على حيادها اللاهوتي حتى وهي تواجه مشاكل الدين في الواقع، وأن تكتفي بأدوارها القانونية والأمنية المتاحة، وتنتظر عسى أن تنتهي الأصولية الدينية على يد الدين ذاته، إيمانًا بصدق نظرية إرنست بلوخ التي تقول إن "أحسن ما في الدين هو أنه ينتج هراطقة"؟
الهوامش
(1) https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/guillermo-fesser/guille…
(2) Santos, Boaventura de sousa , Si Dios fuese un activista de derechos humanos, p: 51.
(3) Rodney Stark and William Sims Bainbridge, The Future of ReligionSecularization, Revival and Cult Formation, January 1986 , p: 97.
(4) Boaventura De sousa Santos: Si Dios fuese un activista de derechos humanos, Editorial trotta, 2016 p:53.
(5) Casanova,J. (1994), Public Religions in thr Modern World, Chicago/Londres, The University of Chicago Press. P: 159
(6) Falwell, Jerry (1980), Listen America, Nueva York, Doubleday
(7) المصدر نفسه، ص265.
(8) Bruce, Steve ( 1990 ), “Modernity and Fundamentalism : the New Christian Right in America”: British Journal of Sociology 41:477-496
(9) انظر: http://www.garynorth.com/freebookswhatsice.hcm
(10) Gaines, Edwene (2005), The Four Spiritual Laws of Prosperity: A simple Guide to Unlimited Abundance, Emmaus, Rodale. P: 19
(11) Hagin, Kenneth (1985) ,The Coming Restoration, RHEMA Bible Church. P: 11
(12) أمام الاحتجاجات الواسعة، وجد فيليسيانو نفسه مضطرًا لتقديم استقالته، وسُحب مقترح القانون من الأجندة البرلمانية.
(13) Davidson, Carl y Harris, Jerry (2006), “Globalisation, Theocracy and the new fascism : the US Right’s rise to power” : Race – Class 47/3: 47-67.