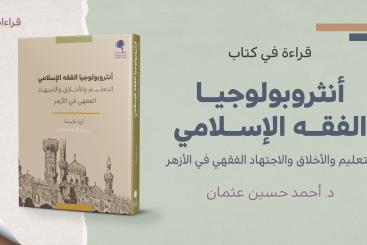إسلام الدولة المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء

ألَّف جاكوب سكوفجارد بيترسون هذه الدراسة وهو في سنِّ الثالثة والثلاثين من العمر، ونُشرت في عام 1997م. جاكوب سكوفجارد بيترسون مؤرخ دنماركي من مواليد عام 1963م، يعمل أستاذًا للأديان بقسم الدراسات الثقافية والإقليمية بجامعة كوبنهاجن منذ عام 2008م، وينصبُّ اهتمامه البحثي على الإسلام الحديث، وتشكُّل الفضاء الإسلامي العام، ودور العلماء في الدول العربية الحديثة. ومن أبرز أعماله: "المفتي العالمي: ظاهرة يوسف القرضاوي" الصادر عام 2009م.
وفي هذه الدراسة "إسلام الدولة المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء"، يتعرض بيترسون إلى جدلية العلاقة بين الإسلام والسياسة في الدولة القومية الحديثة، مَن يحدِّد مَن؟ أهي الدولة القومية بشروطها هي التي تحدِّد ما الإسلام؟ وما المجتمع؟ أم أن الإسلام هو الذي يحدِّد ماهية الدولة والمجتمع؟

يفترض جاكوب بيترسون أن الدولة المصرية منذ أواخر القرن التاسع عشر -ممثَّلة في حكوماتها المتعاقبة- هي من يحدِّد ما الإسلام. وتتضمَّن الأطروحة فرضية أن المفتين الرسميين يُسهمون بسعيهم لخدمة الدولة في إعادة تشكيل الإسلام على نحوٍ يتَّسم بالعقلانية وسهولة التطبيق. فتتتبَّع الدراسة سيرة دار الإفتاء عبر مَن تولوا رئاستها مع التركيز على المنهجيات التي طبقوها، وأهم الفتاوى التي أصدروها، والجدالات التي أثارتها تلك الفتاوى، وأشارت إلى المؤسسات والجماعات التي خُول لها حق التأويل وإصدار الفتاوى. ومن خلال تتبُّع تاريخ دار الإفتاء، نستطيع معرفة العلاقة بين الدولة والعلماء وتطور المجال الديني الرسمي في مصر خلال القرن العشرين[1].
وتبيِّن الدراسة كيفية معرفة التاريخ الفكري والاجتماعي من خلال استخدام الفتاوى بوصفها مصدرًا للتاريخ في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أن الفتوى لا تتمتَّع بصفة إلزامية، فإن كثيرًا من الفتاوى شكَّلت جزءًا من تصور المسلمين للعالم، وكانت جزءًا من فهم المجتمع المسلم وتعريفه لنفسه، وعبر هذه الفتاوى تمَّ تثبيت أعراف وإرساؤها في نسيج المجتمع، فقد كانت الفتاوى رابطةً بين العَالِم والمسلم العادي؛ فعبر الفتوى تنتقل القواعد والقيم الإسلامية من العَالِم إلى المسلم العادي، ومن جيل إلى جيل. فالفتاوى كالمفتين تقع حلقة وسط بين التشريع الديني والواقع الدينوي، فلا بدَّ من الالتفات لسياقها وأسباب ظهورها وتأثيرها وتوظيفها الأيديولوجي والمصالح التي تتنافس فيها قوى مختلفة تسعى لتحقيق مآربها الخاصة[2].
أهمية دراسة الفتاوى
لم تحظَ دراسة الفتوى باهتمامٍ كبيرٍ في النصف الأول من القرن العشرين، ولكن مع تزايد استخدام المؤرخين لسجلات المحاكم وغيرها من الوثائق للتعرف إلى التاريخ الاجتماعي، بدأت بعض الدراسات تلتفت إلى أهمية دراسة الفتاوى، ومنها دراسة جوهانز بينزج عن الفتاوى والتعرف إلى التاريخ الاجتماعي للأناضول في العصر العثماني[3]. وانصبَّ تركيز دراسات المستشرقين على المتون الأساسية للمذاهب الإسلامية. وأول من وجَّه الانتباه لدراسة الفتاوى وأهميتها في دراسة التشريع الإسلامي هو كرستيان سنوك هورخرونيه الذي ألَّف كتابًا عام 1900م حول التسجيل الصوتي[4].
ومن ثَمَّ بدأ الاهتمام بالفتاوى وما تكشفه من حقائق حول الحياة اليومية للمسلمين، وما توفره من مادة ثريَّة لدراسة أحوال المجتمعات الإسلامية، بما فيها الفتاوى الافتراضية التي يردُّ فيها العلماء على وقائع مفترضة لمجادلة الخصوم. ولا يعني هذا أن المستشرقين هم من وجَّهوا الاهتمام للفتوى فحسب، ولكن ساعد انتشار الطباعة وازدهار الفتاوى المطبوعة في المجلات الإسلامية على بروز دور الفتوى في العالم الإسلامي.
تساعد دراسة الفتاوى على فهم تاريخ اللغة والعادات الشعبية والطب الشعبي، كما يمكن من خلال تحليل مدوَّنة فتاوى رئيسة -مثل فتاوى ابن تيمية- التعرف إلى رؤية العالم في عصرٍ بعينه، كما برزت عدَّة بحوث تدرس مناهج فقيه أو عالم محدَّد من خلال فتاواه، مثل محمد عبده ومحمود شلتوت وغيرهما، وركَّزت دراسات أخرى على العلاقة بين الشريعة والتحديث من خلال تحليل الفتاوى البارزة للمخترعات الحديثة، أو فتاوى التكفير (فتاوى الفريضة الغائبة) ودورها في دفع الأحداث التاريخية...إلخ. ولم يُعن بتاريخ دار الإفتاء إلَّا ثلة قليلة من الدراسات أبرزها دراسة أندرياس كيمك بتحليله لدار الإفتاء وفتاوى محمد عبده للأوقاف[5].
شهد منصب المفتي مأسسة تاريخية، فمع مرور الزمن أصبح العلماء جزءًا من بنية هرمية يرأسها شخصيات سياسية ذات نفوذ، جرى إلحاقهم بالمساجد والمدارس الكبرى، وسيطروا على الأوقاف المهمَّة، في حين ظل الإفتاء العادي المتعلِّق بمجريات الحياة اليومية وظلت الفتوى في الوقت نفسِه شأنًا خاصًّا محدود التداول، لا تنشرها وسائل الإعلام الجماهيرية، فقد كان الإفتاء مثل القضاء خارج اهتمام الدولة ومجالها، باستثناء المراحل الأخيرة من منصب شيخ الإسلام، وكان أولئك المفتون الرسميون بدايات إنشاء دار الإفتاء المصرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر[6].
دور الفتاوى بوصفها أداة فقهية إسلامية، ودور المفتين بوصفهم متخصِّصين في الفقه الإسلامي قد شهد تحولًا جوهريًّا في مصر في القرنَيْن التاسع عشر والعشرين.
ويمكن تتبُّع علاقة الدولة بالفتوى في مرحلة ما قبل إنشاء دار الإفتاء من خلال شخصية المفتي الحنفي، ومأسسة هذا المنصب، والتحولات التي مرت بها الفتوى، حيث اتسعت حدودها بدلًا من اقتصارها على المجال الخاص. فيرى جاكوب أن الدولة في سبيل سعيها لضمان سيطرة الدولة على مجال الفتوى والإفتاء عليها اتبعت المركزية في التعليم النظامي وعلمنته، وفي وضع القوانين وجعل القضاة والفقهاء موظفين، أي جزءًا من النظام البيروقراطي والإداري للدولة. وهذا ما حدث في السياق المصري خلال القرنَيْن التاسع عشر والعشرين. فدور الفتاوى بوصفها أداة فقهية إسلامية، ودور المفتين بوصفهم متخصِّصين في الفقه الإسلامي قد شهد تحولًا جوهريًّا في مصر في القرنَيْن التاسع عشر والعشرين، نتيجةً لنشأة دولة مركزية قوية وجمهور مسلم متصل بوسائل إعلام جماهيرية[7]. ويتجلَّى هذا التحول بشكل واضح في موقع المفتي الحنفي في مصر.
أولًا: التحولات التي مرَّ بها منصب المفتي الحنفي وتحوُّل العلاقة بين الدولة والفتوى
في بداية القرن التاسع عشر، كان كبار المفتين المصريين متوفرين بالجامع الأزهر، حيث كان يتمُّ تدريس المذاهب السُّنية الأربعة الكبرى، واعتبارًا من العصر العثماني تبوأ المفتي الحنفي مقام الريادة بين أنداده، ورغم أن السواد الأعظم من المصريين ينتمون للمذهب الشافعي، فإن المذهب الحنفي كان المذهب الرسمي للدولة، ومن ثَمَّ كانت علاقة المفتي الحنفي بالمحاكم أقوى من غيره. وحين أنشا محمد علي مجلس الشورى عام 1829م، عيَّن المفتيين الحنفي والمالكي عضوين فيها، وكان المفتي الحنفي عضوًا بالمجلس الخصوصي للخديوي عباس وريث محمد علي، وكذلك كان المفتي الحنفي وشيخ الأزهر عضوين بمجلس الخديوي إسماعيل (1863-1879م)[8].
تطور دور المفتي في مصر خلال القرن التاسع عشر، فجعل المفتي الحنفي شخصية مركزية في الجهاز الإداري للدولة، وتزايدت سيطرة الدولة على هذا المنصب، فقد تدخلت الدولة في المسارين الأساسيَّيْن لتكوين الفقهاء والقضاة وأصحاب الفتوى: التعليم والنظام القانوني.
الدولة وعلمنة منظومة التعليم
لقد توجَّه النظام التعليمي نحو العلمنة من خلال التعديلات التي أدخلها محمد علي بإدماجه للكتاتيب مع نظام المدارس الحكومية ووضع الدولة نظام مراقبة عامة للمدارس[9]. ومن ثَمَّ تغيَّر أسلوب التعليم الأزهري التقليدي من النظام الحر إلى النظامي، ويخول التعليم النظامي سيطرة أكبر للدولة، ومن ثَمَّ تستمر سيطرة الدولة وإزاحتها لمساحات أوسع من الهيمنة، فتنتقل من التعليم وخريجي هذا النظام التعليمي إلى السيطرة على نظام الفتوى التي يصدرها هؤلاء العلماء فيما بعد.
ويُعَدُّ تيموثي ميتشل من أبرز الباحثين الذين تبنَّوا رؤى أكثر تفاؤلًا لأوضاع التعليم التقليدي في مصر ما قبل محمد علي والاستعمار بوجه عام، حيث يؤكِّد أن التعليم الأزهري في منتصف القرن التاسع عشر كان تعليمًا نموذجيًّا يسمح بتعزيز الحرية في نفوس الطلاب، ولكن تعرضت رؤية ميتشل للانتقاد، فوصف ميتشل لنظام التعليم بالأزهر مستند على نقد محمد عبده للتعليم التقليدي في الأزهر الأقل فاعلية، القاصر عديم النفع، والرازح في فوضى كاملة مع تردي حالة بعض العلوم الإسلامية، فقد كان بعض الطلاب لا يجيدون الكتابة.
وبعيدًا عن نقد التعليم الأزهري التقليدي نفسه، فما لا يمكن نفيه هو أن الدولة أصبحث أكثر انخراطًا في مراقبة منظومة التعليم ومؤسساته، ومن ثَمَّ التحكُّم في منتج هذا النظام. وقد سيطرت الدولة على الطرق الصوفية أيضًا، التي تمثل نظيرًا موازيًا لما يتعلق بالتربية والتعليم[10]، وتدخل محمد علي في تنظيمها لضمان المركزية والتحكُّم في شؤونها، حتى اكتمال التنظيم الرسمي لها في عهد الخديوي عباس حلمي.
خلال القرن التاسع عشر، كان العلماء من خريجي المدارس الدينية، وكان العلماء يحتكرون فعليًّا الوظائف المتصلة بفن الكتابة: الخطاطين والكَتبة والمدرسين والقضاة، وكانوا هم العمود الفقري للإدارة الحكومية الصغيرة[11]. ومع سيطرة محمد علي على الأوقاف، فَقَد العلماء مصدر ثروتهم، وانخفضت أجورهم، وساء وضعهم، واعتمدت الإدارة على خريجي التعليم العلماني النظامي.
تهميش المحاكم الشرعية وتقليص سلطة المفتي الحنفي/ تغيُّر منظومة القوانين
كيف تقلَّص دور المفتي الحنفي وسلطته؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بدَّ من تتبُّع مسار أهمية منصب المفتي الحنفي في السياق المصري، هذا الدور الذي يوضِّح العلاقة بين تقنين الشريعة ودور القانون وعلاقته بالإفتاء والدور السياسي للمفتي والفتوى بوجه عام. ففي الفترة الخديوية، وتحديدًا مع الخديوي إسماعيل وإنشائه للبرلمان، استشارت الحكومة المفتي في بعض قضايا التشريع دون الالتزام بأخذ فتواه.
إذا ما كان المفتون المحليون أنفسهم في شكٍّ أو لبسٍ بخصوص أمر ما، فإنه يتعيَّن حسم الأمر بفتوى من المفتي الحنفي بالقاهرة.
ومع التوسُّع في تنظيم المحاكم الشرعية وإنشائها، أصبح للمفتي دور أكبر، وأُلحق المفتون بالنظام القضائي. فبينما كان يُنظر للفتوى على أنها علاقة خاصَّة بين المفتي والمستفتي، تدخلت الدولة -ممثَّلة في وزارة الداخلية- في تنظيم هذه العلاقة. ففي عام 1865م، أرسل الخديوي لوزير الداخلية إشعارًا باتخاذ إجراءاتٍ ضد من يصدر فتوى دون رخصة. فأصبحت الفتوى جزءًا من إجراء قانوني معياري، ولم يعُد للقاضي حرية اختيار المفتي الذي يستفتيه، وصارت الفتوى نفسها أداةً قانونيةً. وقرَّر قانون إجراءات المحاكم الشرعية عام 1880م أن يطبق المذهب الحنفي وحده في تلك المحاكم، بينما كان مرسوم 1856م يمنح القاضي الحقَّ في أن يستفتي العلماء في المواقف المستعصية، ونصَّ قانون 1880م على أن يكون في محاكم الأقاليم على المستويات الأدنى مُفتٍ للمحكمة، وإذا ما كان المفتون المحليون أنفسهم في شكٍّ أو لبسٍ بخصوص أمر ما، فإنه يتعيَّن حسم الأمر بفتوى من المفتي الحنفي بالقاهرة.
وانعكس هذا التعزيز لدور المفتي على ديباجة القانون، بالنص فيها على موافقة كلٍّ من شيخ الأزهر والمفتي الحنفي وقاضي القضاة على القانون، وكان المفتي عضوًا في لجنة تعيين القضاة[12]. واعتبارًا من عام 1881م، سُمي مفتي القاهرة "مفتي الديار المصرية"، وصار ذلك المفتي عضوًا في العديد من المجالس، مثل: مجلس الخزانة الذي تأسَّس عام 1885م، والمجلس الأعلى للأوقاف الذي تأسَّس عام 1890م.
وبهذا صارت الصدارة للمفتي الحنفي على رأس منظومة هرميَّة من المفتين، وكان المفتي الحنفي بمثابة محكمة نقض عليا مكوَّنة من قاضٍ واحد. وطيلة القرن التاسع عشر كان الخديوي هو مَن يعيّن المفتي الحنفي، وكان المفتي الحنفي هو من يقرّر المسار الفقهي الواجب اتباعه في القضايا المهمَّة، وظلَّ تعيين المفتي امتيازًا للملك ثم لرئيس الجمهورية فيما بعد.
فبينما شهد القرن التاسع عشر ربطًا مطردًا للمفتي الحنفي بالمؤسسات القانونية، فإن الربع الأول من القرن العشرين شهد تخفيفًا لتلك الروابط مجددًا، ففي عام 1914م لم يعُد للمفتي الحنفي شأن مباشر بعمل المحاكم الشرعية من حينها[13]، ولم تكن المكانة التي حظي بها المفتي الحنفي إلا انعكاسًا لتغيُّر منظومة التعليم ومنظومة القوانين وإنشاء المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية التي أثرت في أوضاع المحاكم الشرعية والتعليم والتوظيف في مصر خلال الفترة من عام 1876م حتى عام 1910م.
فقد أدى إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876م إلى تقليص اختصاص المحاكم الشرعية، وجاءت المحاكم المختلطة حلًّا وسطًا بين رغبة الجانب المصري في التخلُّص من الامتيازات الأجنبية والدول الأوروبية في كفالة حقوق رعاياها، فوضعت المحاكم المختلطة معاييرَ لمهنة قانونية لا تقتصر على القضاة، ولكن أدرجت فئة أخرى، وهي المحامون. وقد تطلب وجود المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية إنفاذ مدوَّنة قوانين جديدة للإجراءات المدنية والجنائية مؤسَّسة على القانون الفرنسي، واشترطت فقط تضمين قانون الإجراءات الجنائية مادة تقضي بوجوب تأكيد المفتي قبل تنفيذ حكم الإعدام.
واحتلَّت المحاكم الشرعية المرتبة الثالثة بعد المحاكم المختلطة والأهلية بعد ما كانت هي المحاكم الوحيدة في مصر، وأصبح اختصاصها يقتصر على الأحوال الشخصية والوقف والهبة، وأصبحت المحاكم الوحيدة التي تطبِّق قانونًا غير مقنَّن على نحو تقليدي. وتغيَّر هيكل المحاكم الشرعية وأوضاعها تدريجيًّا من خلال قانون عام 1880م إلى تنظيم شؤون العاملين في تلك المحاكم، وتنظيم ولاياتها القضائية في الأحوال الشخصية وفي بعض الجوانب المرتبطة بالقتل، وقضى القانون بوجوب اتباع الرأي السائد في المذهب الحنفي.
وفيما بعد أصبحت المحاكم الشرعية تابعةً لوزارة العدل، وجرى توسيع مجال التدخل البيروقراطي في عمل المحاكم الشرعية وتدريب القضاة على المهارات العملية لكيفية صياغة الأحكام، وتمَّ تأسيس معهد القضاة لتدريب القضاة والمحامين والكتبة، وعُيّن خريجو هذا المعهد في الوظائف، الذي اشترط أن يلتحق به الأساتذة والطلاب من الأحناف خريجي الأزهر، فأقبل الطلاب على المذهب الحنفي لضمان الوظيفة. وفي عام 1910م، صدر قانون آخر انتزع من المحاكم الشرعية اختصاصها في قضايا القتل. ومع صدور قانون الأسرة العثماني عام 1917م، سار المصريون على النهج نفسِه، فصدر قانون الأسرة عام 1929م الذي اقتصر على الانتقاء من المذهب الحنفي، والذي عُدّل فيما بعد ليشمل المذاهب الأخرى.
مع انتزاع استقلالية المحاكم الشرعية وإخضاعها للمركزية بما يشمله من تحديد المذهب الحنفي مذهبًا رسميًّا، لم يقتصر الأمر على تحنيف الحياة المدرسية والقانونية، فقد تغيَّرت حرفة القضاة من الاعتماد على المنهجية إلى مجرَّد تطبيق مدونة القوانين حتى في قضايا الأحوال الشخصية[14]. وكان تطبيق القوانين يعني السماح بتدخل أكبر لسلطة الحكومة في القضاء من خلال سيطرتها على النظام القانوني، والسعي للتعميم المجرد دون النظر في اختصاص كل قضية أو حالة، وذلك على عكس اعتماد القضاة في النظام التقليدي على المراجع الرئيسة في المذهب وتعزيز الفروق الفردية بين القضاة واستنباط الأحكام من مصادرها الأساسية بدلًا من الانحصار في مواد القانون التي يصعب الادعاء بقربها من الشريعة[15].
أثر ازدهار الحركة السلفية في تراجع سلطة المفتي الحنفي والتمهيد لظهور دار الإفتاء
مع ظهور الحركة السلفية (حركة الإصلاح مع الشيخ محمد عبده ورشيد رضا)، لم يعُد الفقه يحتلُّ المكانة نفسها. حيث يرى السلفيون أن الاجتهاد هو معنى أوسع يتعلَّق بالتفكير القانوني المستقل على أساسٍ من القرآن والسُّنة، بخلاف المفهوم المقابل للاجتهاد التقليدي، أي المحاكاة الحرفيَّة لأقوال الأئمَّة دون تدبُّر أو اعتبار لمعنى الشرع واختلاف الواقع[16].
كان السلفيون خلال هذه الفترة من بدايات القرن العشرين فئةً مختلفةً متأثرةً بالفكر الأوروبي، واجتهدوا في البرهنة على أن قيم الحداثة والعقلانية وكثيرًا من القيم الاجتماعية والأخلاقية والسياسية المهيمنة موجودةٌ في رسالة الإسلام، ومع انتشار الطباعة وتطورها انتشرت أقوال السلفيين ورؤاهم للتجديد والاجتهاد، والدعوة لقراءة النصوص القرآنية والحديث قراءة جديدة[17].
كان نشر الفتاوى في الصحف هو السبيل لاستعادة العلاقة بين العالم والعوام، وتبسيط العلوم الشرعية.
استمدَّت الطباعة أهميتها في المنظور السلفي من كونها أداة صناعة الجمهور، وخلقت ثنائية التجديد والتقليد زخمًا معرفيًّا وتوترًا معرفيًّا بين العامة والخاصة[18]. فقد كان نشر المجلات والصحف متناغمًا مع مشروع الإصلاح السلفي وغايته في إثراء أيديولوجية أمة إسلامية واعية بنفسها مستقلة عن النفوذ الغربي، ومؤمنة بالإسلام بوصفه مكونًا جوانيًّا وحضاريًّا للفرد المسلم[19]. وكان نشر الفتاوى في هذه الصحف هو السبيل لاستعادة العلاقة بين العالم والعوام، وتبسيط العلوم الشرعية.
الصحافة الإسلامية المطبوعة وتغيُّر منظومة الفتاوى
كانت العلاقة بين المسلم العادي والعالم متمثلةً في الوعظ والفتوى في صور شخصية، فلعبت الصحافة الإسلامية دورًا في استعادة علاقة تعليمية أخرى بين العالم والمسلم العادي وتبسيط العلوم الشرعية التي حُصرت في النصوص المتخصِّصة التي يصعب فهمها على غير المتخصِّصين. فقد أحدثت الفتاوى المطبوعة تغيرًا في نشر حيز الفتاوى والتعليم، فلم تعُد الفتوى شفهية ولا فتوى فردية خاصة، وأصبح للفتاوى المنشورة في مجلة المنار مثلًا جمهور أوسع من المتلقين[20].
وقد طُرحت في مجلة المنار قضية انتماء معظم المصريين للمذهبَيْن المالكي والشافعي مع التزام الإفتاء الرسمي بالمذهب الحنفي، فدعت إلى تغيير ذلك، وصدرت فتاوى في مجلة المنار لا تلتزم بالمذهب الرسمي، وانتقد محمد عبده ورشيد رضا أوضاع المحاكم والقضاة، وأيَّدا وجود مفتٍ رسميٍّ يمثِّل جهة استئناف جنبًا إلى جنب مع وجود قانون عقلاني[21].
ومن هنا تلاقى المصلحون السلفيون مع ابن قيم الجوزية لعدَّة أسباب. أولها كتاب ابن القيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين" الذي أشاد به رشيد رضا، لهجومه على التقليد الأعمى، ومناقشته أثر تغيُّر الزمان في الفتوى، وتوسيعه لمعنى الشريعة وتركيزها على مصالح الأُمَّة بدلًا من ضيق النظر في الأحكام الواردة في كتب الفقه[22].
ويورد جاكوب في مبحث مستقل مثالًا للفتاوى المطبوعة وأثرها في أممية الفتوى، أي انتشار الفتاوى والجدال حولها بين أقطار الأمة الإسلامية، وهذه الفتاوى هي المتعلِّقة باستخدام البرق ورؤية الهلال وكيف جمعت بين مناقشة قضايا التقليد والاجتهاد واستخدام تقنيات العصر الحديث وبين أممية الفتوى، فلا تقتصر على قُطر واحد فقط، فقد أقامت فتوى البرق والنصب التذكاري له في دمشق رابطةً بين المسلمين في دمشق ومكة والمدينة، وكان كتاب القاسمي "إرشاد الخلق للعمل بالبرق" دليلًا غير مباشر على النزعة الدولية للعالم الإسلامي، فقد راعى المذاهب الأربعة مجتمعة، وجمع الفتاوى المختلفة في مصر والسودان والجزائر وغيرها. ومن ثَمَّ ساعدت طباعة الفتاوى على توثيق هذه الصلة الإقليمية والعالمية بين الدول المسلمة، وكيف ترد هذه الدول على الاختراعات الغربية، فصارت الفتوى تُقدَّم للأمة بأسرها[23]. ومن ثَمَّ ساعدت هذه العوامل السابقة على تراجع مكانة المفتي الحنفي، والتمهيد لتأسيس دار الإفتاء المصرية.
ثانيًا: التاريخ الاجتماعي لدار الإفتاء
يُعَدُّ يوم 21 نوفمبر 1895م تاريخ إنشاء دار الإفتاء المصرية، ففي هذا اليوم تبدأ سجلات الفتاوى، حيث تُسجَّل الأسئلة والفتاوى وتُوثَّق حتى اليوم. ولم يكن تاريخ إنشاء إدارة الفتوى ميلاد منصب مفتي الديار المصرية، الذي كان قائمًا من قبل ذلك بقرون. وقد تباينت الآراء حول إنشاء دار الإفتاء: هل هو تقليد لدار الإفتاء شبه الرسمية في شمال الهند، أم مستوحاة من الخبرة العثمانية، أم أن الإدارة المصرية استوحتها من خبرتها الخاصة؟
ومن الملاحظات المهمَّة أنه لم يصدر تعريفٌ رسميٌّ لمهام صاحب المنصب حتى عام 1897م، وتقررت مهام دار الإفتاء عبر ممارسات المفتين المتعاقبين التي تولدت منها تقاليد على نحوٍ عفويٍّ بمرور الزمن، ويرصد جاكوب تطور هذه المهام من خلال سير المفتين أنفسهم. كما أن التشكُّل التدريجي لدار الإفتاء تمَّ في وقتٍ كانت الدولة فيه نشطة للغاية في إنشاء إدارة جديدة للمؤسسات الدينية تتَّسم بالمركزية والضبط الإداري، وكان إلحاق مكتب مفتي الديار بوزارة العدل واحدًا من تبعات مرسوم إجراءات المحاكم الشرعية الصادر في عام 1880م، حيث خول للمفتي سلطة تحديد الموقف القانوني في حالة الشك، وبهذا لم يعُد المفتي يتحدَّث من منطلق مرجعيته الشخصية النابعة من علمه، بل من سلطة الدولة الموضوعية.
قسم جاكوب الدور العام لدار الإفتاء إلى ثلاث مراحل أساسية، وسنركز على أبرز سمات كل مرحلة من المراحل الثلاث، وشخصيات المفتين البارزة في كل مرحلة، وأهم الفتاوى، مع التركيز على المرحلة الثالثة تحديدًا ودراسات الحالة للفتاوى التي أوردها جاكوب في دراسته بمزيدٍ من التفصيل في مباحثها الأخيرة من هذه الدراسة.
المرحلة الأولى (التأسيس 1895م حتى عام 1952م)
كانت السلطة الفعلية في المرحلة الأولى بيد الاستعمار البريطاني، الذي لم يتدخل مباشرةً في التشريع الإسلامي أو في اختيار شخصيات المفتين، بل اعتبر شخصيات مثل محمد بخيت ومحمد عبده وعبد المجيد سليم أشخاصًا مستنيرين نسبيًّا، أما العلاقة الأكثر تأثيرًا فكانت بين المفتين والخديوي، الذي يعينهم ويعفيهم من مناصبهم، ثم مع الأحزاب السياسية في وقت لاحق، وخاصةً حزب الوفد بعد ثورة 1919م، وكان المفتي بوزن عبد المجيد سليم قادرًا على تحقيق رؤيته الإصلاحية بالتوازن والتوافق مع الملك والوفد والبريطانيين.
ومن خلال النظر في سيرة المفتين المصريين الأوائل، فإن حسونة النواوي ومحمد عبده كانا مصلحين اختيرا لهذا المنصب بسبب مهارتهما التنظيمية، لاهتمام الحاكم بالإصلاحات في الأزهر، ورغبته في تحديث تعليم العلماء، كما أن ممارسة السلطة والضغط على موظف رسمي واحد أيسرُ من مواجهة جماعة كاملة لها حضور وتأثير في المجتمع. فيبدو أن الدولة -بحسب جاكوب- في عشرينيات القرن العشرين شعرت بضآلة الحاجة إلى دار الإفتاء، فلم تُعين مفتيًا بوزن محمد عبده، ولم يرغب المفتون بدورهم في لعب دور مؤثر في الشأن العام، ومع ثورة 1919م لم يعُد الزخم السياسي لصالح الموظفين الرسميين[24].

شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم
ومن أبرز الشخصيات في هذه المرحلة: عبد المجيد سليم. فمع توليه منصب الإفتاء نجح في تحويل دار الإفتاء إلى جهة لها حجية وتأثير في المجال السياسي لكلٍّ من الدولة والإسلام، وفي مسألة إصلاح المؤسسات الإسلامية، وفي وقتٍ وقع فيه مختلف شيوخ الأزهر في فخاخ السياسة برهن عبد المجيد سليم على كونه إداريًّا قديرًا، وعلى دراية بأصعب قضايا الإصلاح المعاصرة.
ويدلل الجهد الإصلاحي لعبد المجيد سليم على الدور الجديد لدار الإفتاء، فقد مُنحت دار الإفتاء منفذًا دائمًا لنشر فتاواها في مجلة جديدة، هي مجلة المحاماة الشرعية، التي صدرت في أكتوبر 1929م، تلك المجلة الناطقة باسم نقابة المحامين الشرعيين التي تأسَّست في عام 1916م، وكان الموضوع المتواتر على صفحاتها هو الإصرار على أن الاسلام دين ودولة، ومن ثَمَّ فإنه يتضمَّن أحكامًا عن جوانب الحياة، واتخذت منحًى مشابهًا لمنحى جماعة الإخوان المسلمين، إلَّا أن فهمها يعبِّر عن فهم أكثر مهنيةً للشريعة الاسلامية، ونادى محب الدين الخطيب وعبد الرازق السنهوري في العدد الأول منها بوجوب تأسيس التشريع الحديث على تفسيرٍ صحيحٍ للأحكام في الفقه الإسلامي، ورغب المحامون في إصلاح العديد من القوانين بما يتماشى مع الفقه الحديث[25]. ومن المفتين مَن تبنَّى الخط الإصلاحي لمحمد عبده، ومنهم من رفضه مثل محمد بخيت وحسنين مخلوف، ورأس كلٌّ من مخلوف وسليم لجنة الفتوى بالأزهر، وكانا عضوين بهيئة كبار العلماء، ولم ينظر المفتون إلى هذه المؤسسات باعتبارها منافسة لهم في الإفتاء.
وفي هذه المرحلة نلاحظ أن ثمة فارقًا بين مخلوف وعبد المجيد سليم، فلم يقف الخلاف بينهما على إصدار فتاوى متناقضة مثل موقفهما من ترجمة القرآن، ولكن في رؤية كل منهما للإفتاء: ففي حين تمثَّل مشروع سليم في حصر الإفتاء في حدود الفقه التقليدي، مع توظيف التقريب الموسع بين المذاهب الشامل للمذهبَيْن الشيعي والزيدي للخروج بنسخة من الشريعة الإسلامية متماشية مع احتياجات العصر، لم يكن مخلوف يناضل لأجل الإصلاح ومنع حدوث العديد من التطورات الاجتماعية التي اعتبرها مناهضةً لروح الاسلام، فقد كان مناهضًا للحداثة أكثر من أيِّ مفتٍ آخر للديار المصرية. يتخلل هذه المرحلة ولوج فاعلين آخريين مؤثرين، تحديدًا خلال الأعوام 1928-1952م، مع تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، وهيئة كبار العلماء، ولجنة الفتوى بالأزهر، ومحاولات تأسيس مؤسسات إسلامية عالمية، ولكن واقعيًّا لم يأخذ من مكانة دار الإفتاء والمفتي ونفوذهما إلَّا جماعة الإخوان المسلمين.
دور الإخوان المسلمين وتهديد نفوذ المفتي
مع بروز جماعة الإخوان المسلمين والتوجُّه السلفي الآخذ في الانتشار، تصادما مع توجُّه دار الإفتاء ورؤيتها أن المسلم العادي ليس له الحقُّ في الحديث في المسائل الدينية، واتسعت الهوة بينهما بسيطرة الدولة على المؤسسات الدينية بعد عام 1952م. وبينما كان بوسع عبد المجيد سليم أن ينتقد الملك في الأربعينيات ويحظى بتقدير نواب البرلمان، لم يكن هناك متسع للمناورة بين الدولة والإفتاء بعد حركة الجيش 1952م.
ومن مؤسسات الفتوى الأخرى التي ظهرت خلال هذه المرحلة:
لجنة الفتوى بمشيخة الأزهر
حينما تولَّى الشيخ المراغي مشيخة الأزهر مرةً أخرى خلال عام 1935م أنشأ لجنة الفتوى بالأزهر، التي تضمُّ 12 عضوًا يمثلون المذاهب الأربعة، جميعهم تخرجوا في الأزهر، ثلاثة لكل مذهبٍ من المذاهب الثلاثة: الشافعي والحنفي والمالكي، واثنان من المذهب الحنبلي، ورئيس اللجنة. أصدرت هذه اللجنة فتاوى لا تقل عمَّا تصدره دار الإفتاء من فتاوى سنوية، وترأسها خلال أول 25 سنة من تأسيسها ثمانية رؤساء منهم اثنان مفتيان سابقان: عبد المجيد سليم ومحمد حسنين مخلوف. فما الذي دفع الأزهر لإنشاء لجنة للفتوى في ذلك التوقيت؟
أنشأ المراغي هذه اللجنة، وكان على وفاقٍ كبيرٍ مع المفتي الموجود حينذاك، وهو عبد المجيد سليم، ويرى الباحث وولف ديتر ليمك أن تأسيسها قد ترتب على إصدار مجلة الأزهر، فقد أنشأ المراغي قسم الوعظ حين تولَّى مشيخة الأزهر للمرة الأولى (1928-1929م)، وأصدر قسم الوعظ أول مجلة أزهرية "نور الإسلام" التي أصدرت عددها الأول عام 1930م، وحين تولَّى المراغي مشيخة الأزهر الثانية عام 1935م غيَّر اسم هذه المجلة إلى "مجلة الأزهر". واحتوت هذه المجلة على عمود ثابت بدأ من عددها الثاني عن الفتوى، فنظرت الجماهير للفتاوى المنشورة بالمجلة باعتبارها تمثِّل رأي الأزهر في المسألة الخاصة بها، وربما يكون هذا ما أجبر إدارة الأزهر على تشكيل لجنة لضمان سلامة الفتاوى الصادرة عنها. كما أن هذه اللجنة جاءت تطبيقًا لرؤية الإصلاحيين -بما فيهم المراغي- لتوسيع نطاق الوظائف التعليمية المحضة للأزهر، يحيث يشمل دور الوعظ الديني القومي.
وثمة رأي آخر يرى أنه على الرغم من العلاقة بين مجلة الأزهر ولجنة الفتوى، فإن مقترح إنشاء لجنة الفتوى سابق على إصدار المجلة بالأساس، وذلك بتشجيعٍ من رشيد رضا الذي رأى أنه يجب على الأزهر إنشاء لجنة للفتوى في الجامعة وفي إدارات كافة المعاهد الأزهرية بدلًا من إرسال الأزهر مبتعثين إلى أوروبا يعودون أكثر تحللًا وليس استنارة، وذلك بناءً على ما لاحظه من نوعية الفتاوى التي كانت ترد إلى مجلة المنار، فأوصى المراغي أن يشمل دور الأزهر بيان الشريعة جنبًا إلى جنب مع الدفاع عن الإسلام ضد الافتراءات.
من خلال مجلة الأزهر انتشرت فتاوى اللجنة بين جمهور أوسع وشرائح أكثر تنوعًا، وتقرَّر في التسعينيات من القرن العشرين إنشاء لجان فتوى فرعية في المحافظات كافَّة.
وهناك رأي ثالث يؤكِّد أن إنشاء لجنة الفتوى كان جزءًا من الصراع الدائر حول السلفية وظهورها بالمملكة السعودية وتولي الشيخ يوسف الدجوي المعادي للسلفية، وهو أول مفتٍ في مجلة نور الإسلام، الذي دافع عن زيارة القبور بينما أصدر رشيد رضا فتوى بتحريمها في مجلة المنار، وصار هناك جدل بين وجهتي النظر، فاعتبر شيخ الأزهر نفسه مسؤولًا عن المنشور في مجلة نور الإسلام، وحلًّا لتلك الجدالات اقترح رضا أن يكون مفتي الديار المصرية مسؤولًا عمَّا يُنشر في مجلة نور الإسلام من فتاوى، أو يكلف بتلك المهمة مَن يراه مناسبًا لها أو أن يفوض هذه المهمَّة للجنة الفتوى، وفضَّل المراغي الحلَّ الأخير حينما عُين شيخًا للأزهر مرة ثانية[26]. ومن خلال مجلة الأزهر انتشرت فتاوى اللجنة بين جمهور أوسع وشرائح أكثر تنوعًا، وتقرَّر في التسعينيات من القرن العشرين إنشاء لجان فتوى فرعية في المحافظات كافَّة.
هيئة كبار العلماء
أنشأ قانون 1911م هيئة جديدة، لتكون بمثابة هيئة روحية، وهي هيئة كبار العلماء، وتضمُّ 30 عالمًا، موزعين على المذاهب الأربعة، ويشترط في عضو هيئة كبار العلماء ألَّا يقل عمره عن 45 سنة، وأن يكون أعدَّ رسالة علمية في أحد التخصُّصات العلمية ويتصف بحسن السُّمعة...إلخ. ويترأس شيخ الأزهر هذه الهيئة. أما مهام الهيئة فهي: "حمل عبء الإصلاح الديني المرغوب، والنشاط الفكري في مصر والشرق، وخدمة التراث الإسلامي، والإشراف على الثقافة الدينية، وتعزيزها بالمطبوعات والرسائل العلمية". ولكن لم تقم الهيئة بالدور الاجتماعي المأمول منها، ولم تشكِّل أيَّ تهديد لدور المفتي في مجال الخدمة العامة، وانخرطت في جدل مذهبي عقيم[27].
أما المرحلة الثانية فهي ما بين الأعوام (1952-1978م) وهي مرحلة أفول دار الإفتاء
أسهمت البنية الجديدة للسياسة المصرية مع صعود جمال عبد الناصر في تركُّز كل السلطات في يد الجيش والحزب الواحد، واقتصر دور دار الإفتاء على خدمة أهداف الدولة ونظامها الجديد، والدعوة الإعلامية لقضايا تروج لها الدولة وتحتاج لمسوغات شرعية لها، مثل قضايا تحديد النسل والتأميم...وإلخ.
ومع إلغاء المحاكم الشرعية نهائيًّا عام 1955م زادت أعداد الفتاوى، بسبب التباس الموقف الشرعي، وتحويل بعض المهام من تلك المحاكم إلى دار الإفتاء. ورغم ما يبدو من رواج وزيادة لدور دار الإفتاء لتسدّ الفراغ الناتج عن إلغاء المحاكم الشرعية، فإنها أدت إلى تقلُّص دور المفتي إلى كونه مجرد موظف حكومي يصدق على قرارات الحكومة، مما أثر سلبيًّا على مصداقيته ومصداقية دار الإفتاء، وعززت الدولة في الوقت نفسِه من دور مؤسسات أخرى، مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية. أما الجمهور فوجد في ممثلي جماعة الإخوان المسلمين ممثلًا شرعيًّا للإسلام بدلًا من الدور الرسمي لدار الإفتاء ومفتيها[28].
لم يقضِ القانون رقم 462 لسنة 1955م بإلغاء المحاكم الشرعية فحسب، بل نقل الوظائف العامة لرئيس المحكمة الشرعية العليا إلى مفتي الديار المصرية اعتبارًا من يناير 1956م، وتشمل الوظائف الآتي: تولي محمل الحج السنوي ومتابعة كسوة الكعبة، وشهود يوم وفاء النيل، فقد كان يظهر المفتي في هذه المناسبة علنيًّا بصفته ممثلًا لمصر الإسلامية، إلا أن هذه المهمَّة انتهت مع بناء السد العالي، أما المهام التي استمرت فيما بعد فهي تصديق المفتي على أحكام الإعدام، والشهادة بثبوت رؤية أهلَّة الشهور القمرية، فقد أعطت مهمة رؤية الشهور القمرية للمفتي في الثمانينيات دورًا عامًّا بارزًا.
المرحلة الثالثة (من عام 1978م حتى عام 1993م)
مع تولي جاد الحق علي جاد الحق منصب المفتي (1978-1982م) أعاد تنظيم دار الإفتاء، وشرع في نشر فتاواها في الصحف، واهتمَّ بإبداء الفتاوى في القضايا السياسية، التي واجه فيها مناقشات وجدالات السلفيين الجدد، ورغم ما رحَّب به جاد الحق علي جاد الحق من مظاهر أسلمة المجتمع المصري مع المد الوهابي، فإنه أصرَّ على تحديد مسؤولية العلماء عن تعريف الإسلام الصحيح، رافضًا موجات الإرهاب المنتشرة في مصر آنذاك، وأصبح المفتي لاعبًا محوريًّا في الصراع الأيديولوجي حول شرعية الحكومة ومواجهة الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفًا، مؤكدًا إسلامية الحكومية وتطبيق الشريعة التدريجي. ثم جاء محمد سيد طنطاوي لينحو نحو جاد الحق علي جاد الحق، ولكن بوجود وظهور أكثر كثافةً في الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيرية. فاتسمت هذه المرحلة بتجاوز الفتاوى الموضوعات التقليدية للمواريث وغيرها إلى مناقشة قضايا مستجدَّة لظواهر اجتماعية أكثر تعقيدًا في مجالات الطب والسياسة والمالية والاقتصاد.
لقد أصبحت تيارات الإسلام السياسي معارضةً للدولة وللمفتي معًا، وطرحت حلولًا أكثر إسلاميةً من التي يتبنَّاها المفتي الرسمي، ومن ثَمَّ لا يوجد مصدر واحد للفتوى لدى المجتمع أو جهة بعينها هي المخولة بالتعريف بماهية الإسلام مع تزايد حضور الحركات الإسلامية في أوساط المجتمع لمصري، وامتداد فكرة الجمهور القادر على الاختيار ولفظ ما تختاره الدولة رسميًّا له[29]. فتزايدت بضاعة المفتين، وتوفر المفتون من مختلف التيارات والمشارب والأفكار أمام المتلقي الذي يحدِّد المفتي الأكثر ملاءمةً له، فلم يعُد المفتي الممثِّل الأوحد للشريعة، بل الممثل للدولة، وبرز تعارض واضح بين الدولة والمجتمع، ومن ثَمَّ قدَّمت التيارات الإسلامية نفسها وسيطًا وبديلًا.
ومن أبرز الشخصيات خلال هذه المرحلة:
جاد الحق علي جاد الحق
مع تعيين جاد الحق علي جاد الحق مفتيًا في عام 1978م دخلت دار الإفتاء حقبة جديدة، اتسمت بجهود حثيثة لإعادة تثبيت أقدامها كمؤسسة فعَّالة في المجال العام، ومن أهم هذه الجهود إعادة تنظيم دار الإفتاء، ونشر فتاواها في سلسلة "فتاوى إسلامية". تخرَّج جاد الحق في معهد أزهري والتحق بكلية الشريعة، وعمل قاضيًا شرعيًّا لمدة عامين بعد عمله في المحاكم لمدة 7 سنوات، عُين عام 1953م أمينًا للفتوى بدار الإفتاء، وعمل بوزارة العدل مفتشًا على المحاكم ومستشارًا بمحكمة الاستئناف. وعُين مفتيًا للجمهورية في وقتٍ احتدم فيه النقاش حول إقامة دولة إسلامية، وقبل تعيينه بعامٍ صدر حكم الإعدام على بعض أعضاء جماعة التكفير والهجرة، وانتهت هذه الفترة المضطربة باغتيال السادات كما انتهت بولاية جاد الحق لدار الإفتاء.
أصدر جاد الحق بعد اغتيال السادات مباشرةً فتوى مطولة قوية الحجة ضد كتاب "الفريضة الغائبة" الذي يُعَدُّ الدليل العملي لجماعة الجهاد، وشكرت الدولة له هذا الصنيع، فتمَّ تعيينه وزيرًا للأوقاف في يناير 1982م. ثم عُين جاد الحق شيخًا للأزهر، وهو من أطول شيوخ الأزهر بقاءً في هذا المنصب. ويُعَدُّ جاد الحق أهمَّ عالم رسمي مصري في الثمانينيات، لِما تمتَّع به من مهارات إدارية، وما لعبه من دور سياسي من خلال توليه منصب المفتي.

شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق
كان جاد الحق مبادرًا في التعليق على القضايا السياسية التي مثَّلت زخمًا كبيرًا في هذا العصر، وكانت فتاواه سببًا في جعله في عداءٍ مع قطاعات من الحركة الإسلامية خلال الأعوام (1978-1981م). ومن الموضوعات التي بتَّ فيها جاد الحق: سؤال الشريعة وتطبيقها في المجتمع، وموقفه من قانون الأحوال الشخصية، وإصداره فتوى مؤيدة لاتفاق كامب ديفيد، ليعتبره الإسلاميون خادمًا لتوجهات الحكومة.
ويؤكد جاكوب على افتراض أساسي، هو أن دار الإفتاء مؤسسة متمركزة حول شخص المفتي، ويختلف دورها في الشأن العام مع اختلاف مواقف ومؤهلات المفتي الذي يتولى المنصب، ويتجلَّى ذلك خلال هذه المرحلة مع كلٍّ من جاد الحق علي جاد الحق وسيد طنطاوي، والمفتين السابقين لسيد طنطاوي، اللذين لم يكن لهما أي ظهور إعلامي أو دور سياسي أو حضور عام.
فبعد ولاية جاد الحق النشطة والمفعمة بالطابع السياسي، تلتها ولاية عبد اللطيف حمزة المفتي الأكثر انطوائيةً، ويُعَدُّ عبد اللطيف حمزة آخر مفتٍ عمل بالمحاكم الشرعية، ولم يمضِ في منصبه سوى ثلاثة أعوام، وقد نأى بنفسه عن إصدار فتاوى سياسية، ولم يكن له دور في الشأن العام، واكتفى بدوره موظفًا بدار الإفتاء، ولم يُعين أحد بعده، إلا أن وزير العدل المستشار محمد مجاهد سُمي قائمًا بأعمال المفتي، ولم يمض مجاهد سوى عام واحد، ولم يكن له دور بارز، ولم يدلِ بأي بيانات عن دار الإفتاء أو دورها الاجتماعي.
في خضم معارضة قوية لمواقف السادات، لعب جاد الحق دورًا كبيرًا في إضفاء الشرعية على أداء الحكومة، وبوصفه ناقدًا مهمًّا للإسلاميين الراديكاليين وثقت فيه القيادة المصرية، فتولَّى منصب شيخ الأزهر، وجاء تعيين سيد طنطاوي ليدلل بوضوحٍ على أن الحكومة كانت تفكِّر في دورٍ نشطٍ للمفتي، وعندها أصبح المفتي من جديد لأول مرة على مدى قرابة قرن أداة مهمَّة لصنع سياسة الدولة.
محمد سيد طنطاوي
لم يكن سيد طنطاوي أول مفتٍ لم يسبق له العمل بالمحاكم الشرعية أو العادية، بل إنه لم يدرس في كلية الشريعة، وتركَّزت دراساته على القرآن وأصول الدين والدعوة الإسلامية، وانعكس ذلك على إنتاجه العلمي قبل توليه منصب المفتي (من أعماله "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"). يتبنَّى طنطاوي ثقافة الطبقة الوسطى، وهو ما انعكس على فتاواه فيما بعد، ومن ذلك رأيه في عمل المرأة، وعلى الرغم من جهله الشديد بالفن، فإنه رأى فيه رهافة الحس، وصرَّح باستماعه إلى الكلاسيكيات، وهذا أمر مهم لأن السؤال حول الفن والموسيقى من بين الأسئلة التي وُجّهت طويلًا لدار الإفتاء على مدى القرن العشرين. كما عرّف طنطاوي نفسه بأنه تلميذ محمد عبده.

شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي
لماذا وقع الاختيار على طنطاوي؟ المرجَّح أن الدولة اختارته رغبةً منها في إنهاء الفترة التي كانت دون مُفتٍ، فوقع اختيارها على شخص موالٍ لها وراغب في لعب دور نشط في مواجهة التطرف الإسلامي، وفي إقناع المصريين بأن الحكومة القائمة إسلامية. كما أن عمله عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية أكسبه خبرةً في القيادة المؤسسية، وتؤهله دراسته لأصول الدين لخوض معارك أيديولوجية ومناظرات عقائدية، ونشر مقالاتٍ تدين التطرف كما فعل جاد الحق من قبله، وكتب رسالته للدكتوراه عن "بنو إسرائيل في القرآن والسُّنة"، فقيل إن هذا الكتاب ألَّفه عالم طيّع من النوع الذي تريده الحكومة.
بعد تولي منصب المفتي بأربعة أيام، أجرى طنطاوي لقاءً مع جريدة الأهرام، بيَّن فيه خططه لدار الإفتاء، ومنها توحيد الشهور القمرية، ليبدأ رمضان مع الدول العربية، مع مناقشة القضايا التي سادت خلال السبعينيات والثمانينيات مثل شهادات الاستثمار، وإدخال تقنيات طبية جديدة، ومواجهة التطرف في أوساط الشباب، وموقفه المعارض لانتخاب المفتي. وهكذا خطَّ طنطاوي لنفسه خطًّا مشابهًا لخطِّ جاد الحق، من إصدار الفتاوى الاقتصادية والطبية التي فتحت الباب نحو تصاعد الجدال.
يُعَدُّ طنطاوي مفتيًا مجتهدًا بارزًا، ليس بحجم الفتاوى فحسب، ولكن بحجم تصريحاته في الصحف المصرية اليومية. فقد أكَّد على الدور الإعلامي للمفتي، فكان حضوره منتظمًا على شاشة التلفاز، وموجودًا وسط معسكرات الشباب الصيفية يخاطبهم في جولاته عن التطرف. اهتمَّ طنطاوي بقضايا تنظيم الأسرة ومحاربة المخدرات والتطرف، وقام بتشييد مبنى دار الإفتاء الجديد بدعمٍ من الحكومة، وعقد مؤتمرات دولية بها، ومن ضمنها مؤتمر عُقد في عام 1994م للاتحاد العالمي للصحة العقلية، ضمَّ وفدًا إسرائيليًّا أثار معارضة شديدة، ونشر فهمي هويدي مقالًا بعنوان: "إسرائيلون في دار الإفتاء" رفضًا لذلك حينذاك.
قدَّم جاكوب دراسةً للتسلسل الزمني لفتاوى طنطاوي في دار الإفتاء، مقسمًا إياها لفتاوى يسيرة وفتاوى ذات أهمية كبرى: اليسيرة هي التي تدور حول أحكام المواريث ويتبع فيها أسلافه والرؤى التقليدية، والأخرى أكثر تعقيدًا من حيث الحكم على التطرف وتطبيق الدولة لأحكام الشريعة، والفتاوى الاقتصادية والطبية التي تمثِّل نموذجًا لتطور الفتوى المعاصرة، والتي خصَّص لها جاكوب مباحث منفصلة، كدراسة فتوى شهادات الاستثمار وإجراء عمليات التحويل الجنسي.
وكانت فتوى طنطاوي بالحظر الكامل لبيع المشروبات الكحولية في مصر بمثابة إقناع بمصداقيته الإسلامية في مقابل فتاوى أخرى كانت الجماعات الإسلامية تشكِّك فيها، مثل فتاوى تحديد النسل وغيرها. إن ما يميز فتوى طنطاوي هو اقتباسها واعتمادها الدائم على القرآن والسُّنة والاستشهاد بهما، وفتواه أقصر بوجه عام من فتاوى جاد الحق، ويتشابه مع محمد عبده في الإصرار على ممارسته الاجتهاد والتركيز على القرآن، والتأكيد على أنه لا أحد ملزم باتباعه، وعليه أن يقيم الحجَّة على نفسه. ومن أوجه الشبه الأخرى بين طنطاوي ومحمد عبده هو القول بأولوية المصلحة العامَّة، وما خلق داء إلا وله دواء، وغيرها من الرؤى العامة التي تؤيدها فتاوى خاصة، كنقل الأعضاء ومبدأ الضرورات تبيح المحظورات.
المفتون الرسميون فظلوا يؤكدون على التقارب بين القوانين والشريعة والدولة ونهجها في تمثيل الإسلام وتطبيق قواعده بما يتوافق ومتطلبات العصر وتغيراته المادية.
فإذا كان محمد عبده قد رأى ضرورة أن يكون للمفتي دور مركزي في المجال العام، فقد تحقَّق ذلك مع سيد طنطاوي وجاد الحق، ولكن ثمة فارق كبير بين دور المفتي المأمول خلال فترة محمد عبده مع بداية القرن العشرين ودور المفتي خلال فترات التسعينيات: ففي مطلع القرن العشرين، كانت هناك حركة عامَّة للتحوُّل من الشريعة الإسلامية إلى تطبيق قوانين علمانية، والإيمان بأن الشريعة لا تتعارض مع العقلانية والتحديث، كما أن من تولوا منصب مفتي الديار عملوا في القضاء، أي إنهم على علمٍ بالقانون الوضعي، ولديهم خبرة تضمن ألَّا يكون ثمة تعارض بين الفتاوى والقانون. أما في فترة التسعينيات، فتصاعد ضغط تيارات الإسلام السياسي بالدعوة إلى تطبيق الشريعة ورؤية القوانين باعتبارها معارضة ومناقضة للشريعة، أما المفتون الرسميون فظلوا يؤكدون على التقارب بين القوانين والشريعة والدولة ونهجها في تمثيل الإسلام وتطبيق قواعده بما يتوافق ومتطلبات العصر وتغيراته المادية. وانعكس ذلك على فتاوى طنطاوي، مثل التأمين وشهادات الاستثمار وفتاوى تغيير النوع ونقل الأعضاء.
خاتمة
يثير كتاب "إسلام الدولة المصرية" العديد من الأسئلة المهمَّة حول العلاقة بين المفتي والمؤسسة والدولة والجماهير المسلمة، وتأثُّر هذه العلاقة على مدار التاريخ المصري بتغيُّر النظام السياسي نفسه وتوجهاته، وبروز التيارات الإسلامية الراديكالية والإصلاحية على السواء. وخلص الكتاب إلى أن المفتي لديه منصب بيروقراطي ووظيفة حكومية، وقد يؤدي دورًا سياسيًّا، ويحدث تأثيرًا في الشأن العام، سواء في مناقشته الجادة للقضايا الاجتماعية أو خدمة أيديولوجية الدولة، التي خاضت مسيرة طويلة من التدخل والسيطرة للاستحواذ على تعريف ماهية الإسلام الرسمي، الذي يتوافق مع أيديولوجيتها وغاياتها، وفي فتراتٍ أخذت على نفسها عبء الإقناع بأنها التفسير الأصح والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومع انتشار التيارات الإسلامية -وخاصة الجماعات الإسلامية الراديكالية- أخذت على الدولة بُعدها عن النهج الإسلامي وتطبيق الشريعة الإسلامية، ولم يعُد هناك مصدر رسمي واحد للفتوى، وساعدت على ذلك عوامل أخرى، كانتشار الطباعة والمجلات والصحف الإسلامية ومؤسسات الفتوى في المستوى المحلي، وتحوُّل المجلات والصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى ساحاتٍ لعرض الفتاوى ومناقشتها أمام الجمهور المسلم الذي اتسعت الآفاق أمامه والجدالات ليختار التحيز لأيِّ رأي يعبِّر عنه.
إن هذه الرؤى تتوافق مع الفترة التي توقفت عندها دراسة جاكوب، وهي عام 1997م، ولكن ماذا بعد هذه الفترة؟ هناك أسئلة وإشكاليات مفتوحة ليس لها جواب، وإنما تعبِّر الدراسة عن البحث عن أثر تغيُّر هذه العوامل والظروف التاريخية في الفتوى، وفي المستفتين من الجمهور، وفي علاقة الدولة بالمجال الديني وتعريفها للإسلام، ونظرة الجمهور للفتوى ولدور المفتي ومؤسسة دار الإفتاء.
ومن أبرز هذه التغيرات: العولمة واتساع نطاق وسائل التواصل الاجتماعي والثورة المعلوماتية، ومحاولات دار الإفتاء مواكبة هذا التطور بعرض آرائها وفتاواها الرسمية منشورة على هذا الأفق الافتراضي، وانتقاد بعض الجماهير لهذه الفتاوى والقدح فيها، مع ظهور مجالات أخرى للفتوى مثل تطبيق آسك ASK، وتغيُّر مفهوم الشيخ المستفتى مع عدم الثقة الكاملة في كل ما هو رسميّ، ويزداد الأمر تعقيدًا مع التشدُّد والعنف الذي لاحق التيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين المشكّكة في إسلامية فتاوى الدولة، وطرحها لبدائل أخرى، وغياب هذه المساحة لمناقشة هذه الرؤى والرد عليها وسماح الدولة بوجود هذه النافذة للحوار.
ولكن كل ذلك يؤكِّد أن الفتوى بابٌ مهمٌّ لدراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي والفكري لأيِّ مجتمع إنساني في تحولاته الاجتماعية والسياسية المختلفة، فالفتوى ليست مجرَّد رأي الشريعة في مسألة بعينها، فتلك رؤية شديدة الاختزال لدور الفتوى في الحياة اليومية للمجتمعات المسلمة المعاصرة.
الهوامش
[1] جاكوب سكو فجارد بيترسون، إسلام الدولة المصرية: مفتو وفتاوى دار الإفتاء، ترجمة: السيد عمر، الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، ط1، 2018م، ص57.
[2] المرجع السابق، ص45.
[3] المرجع السابق، ص63.
[4] المرجع السابق، ص34.
[5] المرجع السابق، ص40-44.
[6] المرجع السابق، ص34.
[7] المرجع السابق، ص63.
[8] المرجع السابق، ص141.
[9] المرجع السابق، ص81.
[10] المرجع السابق، ص73.
[11] المرجع السابق، ص70.
[12] المرجع السابق، ص143.
[13] المرجع السابق، 143-145.
[14] المرجع السابق، ص99.
[15] المرجع السابق، ص99.
[16] المرجع السابق، ص101.
[17] المرجع السابق، ص103.
[18] المرجع السابق، ص104.
[19] المرجع السابق، ص107.
[20] المرجع السابق، ص108.
[21] المرجع السابق، ص111.
[22] المرجع السابق، ص114.
[23] المرجع السابق، ص138-139.
[24] المرجع السابق، ص192-193.
[25] المرجع السابق، ص219.
[26] المرجع السابق، ص203.
[27] المرجع السابق، 197-198.
[28] المرجع السابق، ص479.
[29] المرجع السابق، ص480-481.