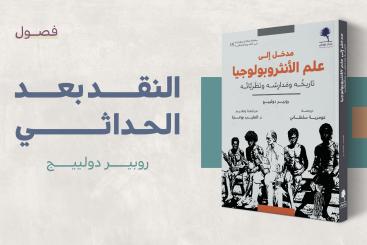تشكلات العلمانية: المسيحية والحداثة والإسلام

صدر هذه السنة عن دار جداول للنشر والترجمة والتوزيع ترجمة لكتاب عالم الأنثروبولوجيا طلال أسد كتاب تشكيلات العلماني: المسيحية والحداثة والإسلام[1]. ويتكون الكتاب الذي جاء في 281 صفحة والذي ترجمه محمد العربي من مقدمة وثلاثة أقسام هي: "العلماني"، و"العلمانية"، و"العلمنة".
قبل عرض مضامين هذه الأقسام الثلاث، تنبغي الإشارة إلى أنه يستحسن أن نبدأ بالإشارة إلى كتاب طلال أسد الصادر سنة 1993 جنيالوجيات الدين[2]؛ الذي يوضح فيه كيف أصبح "الدين" يُنظَرُ إليه كجوهر مستقل ومفصول عن العالم الواقعي للسياسة والاقتصاد والتفاعل الاجتماعي. فقد بيّن أسد أن الرهبان المسيحيين في القرون الوسطى كانوا يُعلِّمون الناسَ الفضيلة الدينية من خلال التربية الجسدية والتطبيق القضائي للألم والإذلال من أجل التوبة. ويلاحظ أسد أن المفكرين في عصر الأنوار هم من تصور الدينَ كمجموعة خاصة من المعتقدات حول العالم الآخر (الآخرة). وبفضل هذا التعريف أصبح "الدين" يعتبر كمقولة إجماليةٍ في الحياة البشرية متاحة للمقارنة العلمية والضبط القانوني في عصر التوسع الاستعماري.
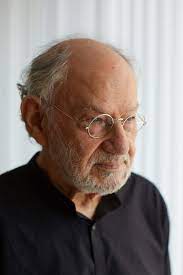
طلال أسد
تقديم: أنثروبولوجيا العلمانية
يبدو أن العالم اليوم تسود فيه إيديولوجيا واحدة هي الديموقراطية. ففي كل البلدان، يمجد الجميع روحَ الديموقراطية وينظرون إليها باعتبارها أسمى إيديولوجيا؛ إلا أن العالم، وبفعل ما يعرفه من تعدد، أصبح يواجه مشكلةَ تحقيق أرض يسود فيها السلام والعيش المشترك.
إن تحدي ادعاءات الحقيقة الدينية تقود المفكرين إلى بناء لغة ثالثة بديلة تسهل بلوغ التسامح، ويمكن أن تتوافق فيها الادعاءات الدينية؛ لذلك انبثقت العلمانية كموضوع للتفكير الأكاديمي وموضوع خلاف عملي، وهو أمر أثار اهتمامًا متزايدًا بقضايا الحداثة؛ إلا أن معظم الأنثروبولوجيين ما زالوا يولون أهمية قليلة للعلمانية والعلمنة. وفي هذا السياق، يشير طلال أسد إلى أن أهم الأعمال المعاصرة حول الدين لا تحيل إلى هذه القضايًا إلا نادرًا.
يعتقد معظم المفكرين أن هناك حاجة إلى نموذج جديد من الدين والحداثة؛ لكم طلال أسد يطالب بإعادة التفكير في الدين والحداثة وفقًا لمبدأ التعدد، حيث يبدأ كتابه بالتساؤل: "هل العلمانية عبء استعماري؛ رؤية عالمية شاملة تعطي الأسبقية للمادي على الروحي، أم هي ثقافة الاغتراب واللذة الجامحة الحديثة؟ أم أنها ضرورية للإنسانوية العالمية، ومبدأ عقلاني يدعو إلى كبت، أو على الأقل إلى تقييد العاطفة الدينية حتى يمكن التحكم في مصدر خطير للتعصب والخرافة، ويمكن تأمين الوحدة السياسية والسلام والتقدم؟" (ص. 35).
يطرح أسد في مقدمة كتابه المسلمة الأساسية لدراسته، وهي أن "العلماني" سابق مفهوميًّا عن مذهب "العلمانية" السياسي، وأن عددًا من المفاهيم والممارسات والحساسيات قد تجمعت عبر الزمان لتشكل ‘العلماني‘" (ص. 30). إن ما يعطي لهذه المسلمة قوتها التفسيرية والنظرية هو تركيزها على أن المفاهيم ليست مجرد أفكار كونية، وليست نتيجة لصراع جدلي من الضروري أن يكون من قبل. تتآلف مفاهيم مع مفاهيم أخرى متعددة وتتمظهر في مجموعة متنوعة من الممارسات التي تتغير عبر الزمن.
ليس هذا الكتاب احتفاءً بالعلمانية، ولا هو في نفس الوقت استكشافًا إثنوغرافيًّا محايدًا للحياة العلمانية؛ بل إنه بحث جنيالوجي في نشأة مفهوم "العلماني".
هكذا يمكن النظر إلى المفاهيم وَفْقَ هذا المنظور على أنها قوية نظرًا؛ لأنها مركبة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأساليب الحياة، لكنها تتميز أيضًا بالهشاشة نظرًا لأنها قابلة للتغيير عبر الزمن. وللكشف عن تركيبة المعتقدات والممارسات التي تكوِّن "العلماني" ولتوضيح الآثار الاجتماعية لهذا المفهوم، آثر طلال أسد ترتيب مقالاته في ثلاثة أقسام تحمل عناوين "العلماني" و"العلمانية" و"العلمنة". ليس هذا الكتاب احتفاءً بالعلمانية، ولا هو في نفس الوقت استكشافًا إثنوغرافيًّا محايدًا للحياة العلمانية؛ بل إنه بحث جنيالوجي في نشأة مفهوم "العلماني"، والتمييزات والممارسات التي تجعلها ممكنة، وتلك التي من شأنها القضاء عليها.
ويحاول أسد مواجهةَ النغمة الواثقة من ذاتها التي تغلب على معالجة الباحثين "العلمانيين" في معالجتهم للموضوع، والتي تجعلهم ينظرون إلى العلمانية وكأنها انتصار للاتجاهات الليبيرالية والأخلاقية في الفكر الأوروبي والديموقراطية الغربية. فبدلًا من أن ينظر إلى العلماني على أنه "فضاء تحرر فيه الحياة الإنسانية ‘الحقيقية‘ نفسها تدريجيًّا من سلطة ‘الدين‘ المهيمنة، وبالتالي تحقق إعادة موضعته" (ص. 214).
يحلل أسد كيف أنتجت الدولة الحديثة التمييز الصارم بين العلماني و"الدين"، حيث تبرر نفسها بعملية العلمنة وتقيد أشكالًا أخرى من الحياة الاجتماعية. ليس الكتاب إذن مناقشة للدين في ذاته، بقدر ما هو مساهمة في بناء نظرية سياسية قائمة على المعطيات التاريخية والسوسيولوجية التجريبية. يعتقد أسد أن العلمانية ليست الشرط الإيجابي للإجماع والنقاش العمومي، كما يطرح ذلك منظرون أمثال شارلز تايلور، بل هي الوسيط السياسي الذي يتم بواسطته تجاوز ممارسات الدين التمييزية.
زد على ذلك أن العلمانية تحدد نفسها ضد "آخر" الذي يصبح بالفعل موضوع مشروعها التعويضي. ومعنى ذلك أن طلال أسد مهتمٌّ في نهاية المطاف في آنٍ واحد بنشأة العلمانية داخل أوروبا المسيحية وندائها الموجه إلى المسلمين ليصبحوا رعايا للدول الديموقراطية الليبيرالية، وبالتالي "تبني العلمانية والدخول في الحداثة" (ص. 24). ينظر أسد إلى العلمانية- شأنها شأن الدين- باعتبارها مفهومًا. إن "العلماني" يضمِّنُ الحياةَ الحديثة بعضَ السلوكات والمعارف والحساسيات. وإن "ما هو مميز في الأنثروبولوجيا الحديثة فهو مقارنة المفاهيم المتضمنة (التمثيلات) بين المجتمعات متباينة التموضع في الزمان والمكان. الأمر المهم في هذه التحليلات المقارنة ليس هو جذورها (الغربية وغير الغربية) ولكن أشكال الحياة التي توضحها، القُوى التي تطلقها أو تعطلها، فالعلمانية مثل الدين تتجاوز كونَه مجرد مفهوم" (ص. 32).
يحاجج أسد- باعتباره عالمَ أنثروبولوجيا- على أن الخطوط الفاصلة بين العلماني والديني وُضعَتْ بأشكال مختلفة في وضعيات تاريخية وسياسية مختلفة.
يدرس أسد العالم "الواقعي" الذي دشنه التعريف الحديث للدين. لا ينبغي النظر إلى العلماني- كما يقول- على أنه "المجال الذي تتحرر فيه الحياة البشرية تدريجيًّا من سيطرة السلطة الدينية". بل يدعونا الباحث إلى ملاحظة كيف ساعد مفهوم العلماني الناشئ على تكوين التقابل أو التضاد بين الواقعي والمتخيل، بين الطبيعي وفوق الطبيعي (الخارق)، بين القانون والأخلاق، وبين المجال الوطني والعام والمجال الخاص للمعتقد والأخلاق. يحاجج أسد- باعتباره عالمَ أنثروبولوجيا- على أن الخطوط الفاصلة بين العلماني والديني وُضعَتْ بأشكال مختلفة في وضعيات تاريخية وسياسية مختلفة. وطرح أسد- باعتباره ناشطًا سياسيًّا- أطروحته كتحدٍّ لنماذج المفكرين الخطية للزمن التاريخي.
هكذا- وكما يوضح ذلك الخطاب السياسي الأمريكي المعاصر- فإن المسلمة القائلة: إن الغربَ علمانيٌّ وحديثٌ ومتقدِّم عن باقي العالم، تبرر استخدام القوة العسكرية باسم التقدم الحضاري. إن ما يميز عمل طلال أسد ليس هو المجموعة المذهلة من المواضيع التي تكشف عن اطلاعه الواسع أو فصاحته الرائعة في العديد من الخطابات الفكرية، وإنما هو تحكمه غير العادي في طريقة الاستدلال؛ إذ لم يسقط أبدًا في الافتتان بالذات أو الهيجان المعادي للتقاليد اللذَيْن يميل إليهما النقاد عندما يضعون أقدامهم في مجال اللاهوت. ويعترف طلال أسد بفضل جينيالوجيا نيتشه في كتابه "جينيالوجيا الدين"، ويقول في مقدمة كتاب "تشكيلات العلماني" أن منهجه الجينيالوجي "مستمد من الطرق التي تم نشرها من قبل فوكو ونيتشه، وإن كان هذا لا يتطلب اتباعهم دينيًّا" (ص. 31).
العلماني
يبدأ أسد باستكشاف إبيستيمولوجيا العلمانية في أوروبا الأنوارية. ويسجل أن إعادة تعريف المقدس جعلت العالم الطبيعي يبدو طبيعيًّا وموضوعيًّا وواقعيًّا. فبينما كان أي موضوع يملكه الإله يعتبر مقدسًا في الجمهورية الرومانية، اعتبر علماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر المقدسَ مقولةً تُوجد خارج الواقع. فالتقسيم بين الخارق والطبيعي، أو بين المقدس والواقعي- شكّل التصور الحديث للزمن التاريخي؛ إذ كان الوحي بالنسبة لأهل القرون الوسطى شغف ينبغي المرور به، وكانوا يضبطون حواسهم لتكرار عبارات الكتاب المقدس وتجربة الألوهية، إلا إن الكتاب المقدس أصبح بعد الإصلاح الديني معلومةً تتعلق بالعالم فوق طبيعي، وهو ما أدى إلى الفصل بين التاريخ العلمي وأدب الخيال.
إن إعادة قراءة الكتب المقدسة من خلال شبكة الأسطورة أدت إلى فصل النص المقدس عن الواقع، وساعدت على بناء العلماني باعتباره المجال الأبيستيمولوجي الذي يتحقق فيه التاريخ الواقعي. ترتكز المقاربة الليبيرالية للفاعلية (أي للإنسان كفاعل) على هذا النموذج التاريخي، أي التاريخ الخطي والواقعي والمشكل حصريًّا بواسطة النشاط البشري. ينتقد أسد التفكير الحديث في الفاعلية بتسليطه الضوء على الإمكانات الخلاقة اجتماعيًّا للألم الجسدي. يؤكد الليبيراليون على ضرورة أن يكون القصد الواعي كامنًا خلف فعل الأشخاص؛ فالألم هنا يعتبر شيئًا يوجد خارج السيادة الفردية. علاوة على ذلك، يتحمل الفاعلون مسؤولية تحرير أنفسهم من الألم.
هذه المقاربة، يقول أسد: تجعل من الصعوبة إدراك كيف يمكن للجسد المتألم نفسه أن يساعد على إنتاج العلاقات الإنسانية. ففي الإسلام الكلاسيكي، لم يكن الإنسان الفرد يملك كليًّا جسده وجميع قدراته؛ إذ كانت العقوبات تعلم الجسد كيف يتصرف بشكل ملائم في علاقته بالآخرين، لقد خلق الألم الشروط للفعل الاجتماعي والعلاقة الإنسانية. ويؤكد أسد على أنه بدلًا من أن يساوي الباحثون بين الفاعلية والفعل الواعي والإرادي بشكل إطلاقي، سيكون من الأفضل بالنسبة لهم أن يدرسوا كيف تكوّن الفاعلون في تقاليد مختلفة.
من بين الأطروحات العميقة التي ضمنها أسد كتابه هذا، هي رفضه المطابقةَ بين العلمانية وعملية نزع الطابع السحري عن العالم، وبالمقابل يؤكد على أن "التصور القائل إن... تجارب الحداثة تكون ‘التخلص من الخرافة‘، والذي يتضمن الولوج المباشر إلى الواقع، والتجرد من الأسطورة والسحر والمقدس- هو ملمح بارز للعصر الحديث" (ص. 28).
هكذا يشدد أسد على أن الاستدلال الذي يربط عملية نزع الطابع السحري عن العالم بالحداثة هو نفسه واحدة من خصائص الحداثة وليس تحليلًا ثاقبًا لها. وفي هذا السياق، يستشهد أسد بحجة فالتر بنيامين التي مؤداها أن "هذا العالم ‘علماني‘ ليس لأنه تمَّ استبدال المعرفة الدينية بالمعرفة العلمية (أي، لأن ‘الحقيقي‘ أصبح واضحًا أخيرًا)، لكن لأنه، على العكس، يجب أن يعاش في شك، بدون مَرَاسٍ ثابتةٍ حتى لدى المؤمنين، أي عالم يعكس فيه الحقيقي والتخيلي بعضهما بعضًا" (ص. 79).
قد يكون التصور الأصلي لماكس فيبر حول نزع الطابع السحري أقرب إلى ذلك مما يوحي بذلك النقد الذي قدمه طلال أسد، لكن من الواضح أن "العلمانية" ليست فقذ مجالًا محايدًا وإنما هي مليئة بالعمليات القوية المهمة التي تشمل تلك التي تجهل العلاقات المتبادلة بين التمثلات وما تمثله، أي "الواقع". من الصعب للغاية تحقيق قراءة موضوعية ومباشرة للعلماني؛ لذلك يعمد أسد إلى سلسلة من الفصول المترابطة بدلًا من الاستناد إلى استدلال خطي، ويقترح طلال أسد أن يقارب العلمانية بطريقة غير مباشرة (ص. 81)؛ إذ يسلط الضوء على "سلالات النسب المعقدة، التي اكتسبنا بموجبها مفرداتنا للحديث عن الوكالة والذاتية" (ص. 58)[3].
ويعارض "الأداء الأخلاقي لإدراك أخلاقي متجسد" (ص. 109) بأفكار علمانية للمسؤولية والعقاب الفرديين؛ إذ ينتقد في الآن ذاته الهدف العلماني الساعي إلى ابتكار ذوات تتميز بكونها تتوفر على قصدية كاملة وقادرة على خلق ذاتها بذاتها، وعلى تمكين ذاتها بذاتها، وكذا التصورات الحديثة لسلبية المعاناة وخصوصية الألم. هذا الموضوع مازال مستمرًّا في انتقادات أشكال العنف العلمانية وخطابات المعاناة "المتزايدة العالمية في نطاقها، لكنها خاصة في محتواها النظري" (ص. 116). ويتساءل أسد عما يعتبر "انتهاكًا لحقوق الإنسان" في الخطاب العام ويشير إلى "الصراع غير المحسوم بين الدعوة الأخلاقية حول "عالمية البشرية" وبين سلطة الدولة لتعريف القانون وتطبيقه والحفاظ عليه" (ص. 156-157).
بالنسبة لأسد، ليست القضية الأساسية في حقوق الإنسان هي النسبية في مقابل الكونية، وإنما كيف يتمُّ تبرير أنواع معينة من التدخلات.
وبالمثل، نشأ الحق الفردي العلماني في حرية المعتقد من خلال النظم القانونية الوطنية، التي تقوم في ذات الوقت بتقويض تهذيب الممارسات ذاتها التي تكون "الكائن الديني". بالنسبة لأسد، ليست القضية الأساسية في حقوق الإنسان هي النسبية في مقابل الكونية، وإنما كيف يتمُّ تبرير أنواع معينة من التدخلات. إن هناك موضوعًا مهمًّا متكررًا يضع المنظور الكانتي (نسبة إلى الفيلسوف الألماني كانت) في تعارض مع المنظور الأرسطي: بين التأمل الخالص والنشاط العملي، بين الأنوار والتقليد، بين حوامل مجردة للضمير الفردي والاستعدادات المستدمجة الجماعية.
ووفقًا لذلك، يؤكد أسد أننا نتصور الثقافة "قد ينظر إليها بصورة بصرية (مثل القول "محدودة بوضوح" و"متلاحمة" و"مجزأة" وما إلى ذلك)، ولكن أيضًا يمكن النظر إليها في شكل الحالات الزمنية للقوة التي يمكن لـ‘الممارسات‘ التي تشكل أنماطًا من الحياة، بشكل صحيح أو خاطئ، أن تتعرض للتجزيء أو للتجريم أو للعقاب، والتي يمكن من خلالها أن توجد ظروف لإنماء ضروب مختلفة من الإنسان" (ص. 173).
هذه الرؤية تتمظهر في تحليلٍ صارمٍ، لكنه معقولٌ للمسلمين الذين يتم اعتبارهم "أقليةً دينية" في أوروبا. ليس الهدف هو "الاعتراف" بالحقوق الجماعية، بل هو "كيف نحيا بأساليب حياة معينة على نحو مستمر وتعاوني وبدون مبالغة في الوعي بالذات" (ص. 199). إن وجود "ممارسات [متنافرة] متجذرة في التقاليد" يستحضر المجتمع المسيحي والإسلامي في العصور الوسطى (ص. 201) في مقابل الطابع الإقصائي والجوهراني والتجنيسي للدول القومية.
العلمانية
في فصول الكتاب الوسطى، يصيغ أسد نقدًا نافذًا لخطاب الحكم الليبيرالي. يرى أسد أن التصور الليبيرالي للشخص- باعتبارها مستقلًّا وسيد نفسه- انبثق في أوروبا في نهاية القرن السابع عشر. فمع تنامي الدين العام الذي قوَّى الشعور بانعدام الأمان لدى الطبقة الوسطى، سعى جون لوك وغيره من المفكرين إلى تحقيق استقرار الذات بالتركيز على المفهوم القانوني للذات الحاملة للحق.
إن المعاناة التي يتحملها شخص ما باعتباره مواطنًا تختلف عن المعاناة التي يتحملها ككائن بشري.
إن هذه الذات ذات السيادة- في الفكر الليبيرالي- هي التي يُفتَرَضُ أنها تفوض حقوقها البشرية إلى الدولة الوطنية. إذ يفترض الفكر الليبيرالي أنه لا يتم انتهاك أي شيء أساسي في الحقوق البشرية للشخص إذا كان هذا الشخص يعاني نتيجة تدخل عسكري أو تلاعب بالسوق قادم من خارج دولته. إن المعاناة التي يتحملها شخص ما باعتباره مواطنًا تختلف عن المعاناة التي يتحملها ككائن بشري. يوضح أسد أن المسلّمات الدولاتية لخطاب حقوق الإنسان تُسلط الضوء على السلطة التنظيمية للحكم العلماني، التي تحمي بالقوة مطالبها المتمثلة في تصنيف وضبط الهويات الاجتماعية والفعل السياسي.
يعارض أسد التصورات المثالية للدولة القومية الحديثة التي تجعل منها مجتمعًا يمكن أن يحققه أي شعب؛ فبينما يكتب معظم المنظرين السياسيين من وجهة نظر الفرد العقلاني أو الجماعة التي تشكل أقلية- تتمثل استراتيجية أسد في التفكير من وجهة نظر الدولة ومؤسساتها. هكذا، وردًّا على تدقيق تشالز تايلور الأنيق لفكرة جون راولس القائلة أنه يمكن للأشخاص الذين لهم "خلفيات تبريرية" مختلفة جدًّا، أن يتوصلوا رغم ذلك إلى اتفاق حول "المبادئ الأساسية" في المداولات العامة.
يقول أسد: إن هذا النوع من التحليل يتجاهل واقع أن من يضع الحدود مسبقًا بين "المبادئ الأساسية" و"الخلفيات التبريرية" ليس هم الأفراد، وإنما هي الدولة بواسطة مؤسساتها القانونية ووسائل الإعلام التي تمثلها. من له سلطة تحديد الاختلافات بين المبادئ والخلفية، بين العام والخاص؟
ثم ينتقل أسد إلى مناقشة الكتاب المقدس والأدب، مقترحًا أن معنى الإنجيل كنص مقدس هو- إلى حد كبير- التكوين الخلفي للقراءة الشائعة لأدب الخيال، الذي حدث في مطلع القرن التاسع عشر.
من يحدد الفرق بين القراءات الأدبية والقراءات المقدسة؟
يقترح أسد بواسطة القياس أن العلمانية هي التي تضع الخط الفاصل بين الأدب والنصوص المقدسة، تمامًا مثلما تفصل بين المبدأ العام والسبب الخاص. ويثير أسد مسألة ما إذا كان يجب على الأدب الإسلامي أن يتبع نفس المسار فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وبعد أن يوجه نقده إلى هذا الموضوع من أجل بيان أنه ليس هناك غرب متماسك وليست هناك حداثة واحدة- يعكف أسد على الدفاع عن التحليل الأنتروبولوجي للمفاهيم ضد الانشغال بخصوصيات العمل الميداني والوصف الكثيف، كما اقترحه عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كليفورد جيرتز.
إن مواطني الدولة الليبيرالية- كما يتم عدهم في إحصاءات السكان- هم مجموعة من الوحدات الفردية المصوِّتة، لكن أسد يوضح في الفصل الثاني من القسم الثاني المتعلق بالأقلية المسلمة في أوروبا أن الجماعات الدينية تتوحد فيما بينها؛ من خلال انتمائها إلى جماعة تشكلت تاريخيًّا، وليس بواسطة وسيط سياسي مجرد؛ فالمسلمون- حسب أسد- لا يمكن أن يُمثَّلوا بشكل لائق في أوروبا؛ نظرًا لأن الخطاب الليبيرالي حول المواطنة يقتضي من المسلمين أن يعزلوا سردياتهم الضرورية لحياتهم كمسلمين.
يعارض أسد المحاولة الحديثة لـ"إدماج" المسلمين الغرباء عن المسيحية والإسلام القروسطويين، وهي المحاولة التي اعترفت بتعدُّد الروابط والهويات المتداخلة. ويشدِّد أسد على أن السؤال الآني الذي يطرحه أوروبيو الحداثة يجب ألا يكون هو "كيف يمكن إدماج المسلمين في أوروبا؟"، وإنما هو "كيف نحيا بأساليب حياة معينة على نحو مستمرٍّ وتعاوني وبدون مبالغة في الوعي بالذات؟" (ص. 199).
العلمنة
لكي نفهم العلمنة، يقول النموذج العلماني الأوروبي: يجب أن نقبل المسافة المتزايدة بين الحياة الخاصة والسلوك العمومي. إن التعبيرات الدينية، إذا اعتُبرت إنجازًا عامًّا- تُمنَحُ مجالها الخاص، أي يرخص لها بالعمل باعتبارها مؤسسة واحدة من بين مؤسسات أخرى عديدة.
هذا التفريق المؤسساتي يسمح بإجراء تمييزات واضحة بين ما هو عمومي وما يشكل سلوكًا خاصًّا. ويُقدَّمُ لنا ذلك على أنه أفول لأهمية الدين في المجتمع؛ إذ تُبين الدراسات أن عدد الناس الذين يذهبون إلى الكنيسة يتضاءل يومًا بعد يوم. في الإطار الديني تشكل المعتقدات في الله والكنيسة وفي شكل آخر من الحياة بعد الموت؛ لكن جاء هنا شيء جديد أصبح يحل محل هذه المعتقدات، إنه "العلماني".
ويأتي كتاب طلال أسد "تشكيلات العلماني: المسيحية والحداثة والإسلام" ليقلب هذا التصور رأسًا على عقب، وذلك من خلال طرح أسئلة عادية حول ما يعنيه "العام"، من يعرّف "الخاص" ومن يحدد مجاله. والأهم من كل ذلك هو استنتاجه الأصيل بأن المجال العام منقوع في تشكيلات للسلطة موجودة سلفًا؛ ذلك أن "استثمار الناس في نقاش بعينه ليس منطقًا مجردًا أو أبديًّا، بل إنه يرتبط بماهية الشخص الذي أصبح المرءُ عليه ويرغب أن يستمر عليه، أي لا يوجد مجال عام لحرية التعبير في لحظة ما." (ص. 206-207).
يتناول أسد في هذا القسم الثالث من كتابه موضوع تضييق نطاق الشريعة في مصر، خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ عندما تم استيراد المدونات القانونية الأوروبية. وفي هذا الصدد، يرى طلال أسد أن ما حدث لم يكن مجرد جعل الشريعة تقتصر على المجال الأسري، بل إنه تحول للشريعة نفسها. إن تقليده الخاص في النقاش، أي طريقته المتميزة في فسح المجال للتفكير البشري، تمت تعريته في عملية التحول إلى "مقدس" وتأسيس "الأسرة" في مصر.
وفي هذا السياق، يبرز أسد كيف تشوه الإصلاحاتُ القانونية الطريقةَ التي اشتغلت بها السلطة في التقليد الإسلامي؛ بسبب سوء فهم طبيعة الإسلام كتقليد. لقد تم تشجيع المصريين من الطبقة الراقية على أن يُصبحوا حاكمين لأنفسهم، في حين أعيد تشكيل الإسلام، والشريعة الإسلامية، ومواضيع هذا القانون (وخصوصًا "الأسرة") داخل قانون الدولة. هكذا، فإن الحدود بين القانون والأخلاق، بين السيادة المدنية والسيادة الفردية، ومضمون كل منهما استخلصت من العلاقات الاجتماعية أكثر فأكثر.
كان محمد عبده يعتبر الشريعة شيئًا ضروريًّا لاستقرار الحياة الأسرية بين أوساط الطبقات الاجتماعية الدنيا.
يجيب القسم الثالث من الكتاب على دعوة أسد إلى اعتماد أنثروبولوجيا مقارنة للعلمانية؛ فاستنادًا إلى فكر محمد عبده وأحمد صفوت ومصلحين آخرين- شرع أسد في استكشاف كيف تمت صياغة العلمانية في مصر في نهاية القرن التاسع عشر. وحاجج المؤلف على أن المصلحين المصرين لم يكونوا مجرد عقول تحاكي أوروبا وتستنسخ سياستها الدينية، بل إنهم أعادوا ترتيب تقليد خطابي إسلامي بالتركيز بشكل جديد ومختلف على الحياة الأسرية، وبإجراء تمييزات جديدة بين القانون والأخلاق. فعلى سبيل المثال كان محمد عبده يعتبر الشريعة شيئًا ضروريًّا لاستقرار الحياة الأسرية بين أوساط الطبقات الاجتماعية الدنيا، غير أن المصطلح الذي استعمله للإشارة إلى الأسرة، "العائلة"، كان شيئًا جديدًا في النحو العربي.
إن انشغال محمد عبده بالحياة الأسرية كان جزءًا من عملية واسعة تحولت بواسطتها "الأسرة" إلى موضوع للتدخل الإداري، أما بالنسبة لمنظرين آخرين أمثال أحمد صفوت، كان يتمُّ تحديد الأخلاق الخاصة والقانون العام بشكل متوازٍ، وكانا يُعتبران مجموعةً من القواعد التي ينبغي احترامُها. كان صفوت ومصلحون محدثون آخرون يجهلون التصورَ الكلاسيكي للشريعة، الذي لم يكن يَعتبر التقليدَ الإسلامي مجموعةً من القوانين، وإنما طريقة يضبط بها المسلمون حياتهم جماعةً باعتبارهم مسلمين.
إن كون العلمانيين والإسلامين يَعتبرون جميعًا الشريعة كقانون مقدس يبرز أنهم يشتركون في أشياء كثيرة؛ ذلك أن هذه الجماعات تؤكد كلها على أن المسلمين في حاجة إلى الإصلاح، وتنظر كلها إلى القانون باعتباره الفاعل الأساسي القادر على تحقيق الإصلاح.
يحتل هذا الكتاب المهم مكانةً هامة في الأدبيات التي تظهر أن الحداثة الأوروبية لم تكن النتيجةَ الحتمية والضرورية لتطور تاريخي كوني. ويبدو أن أسدًا قدم مساهمة فكرية جديرة بالقراءة، وهي معارضته للفكر الليبيرالي بطرح أنماط غير متجانسة من الذاتية القديمة والحديثة.
الهوامش
[1] Asad, Talal, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.
[2] Asad, Talal, Genealogies of Religion, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
صدرت للكتاب ترجمة إلى العربية: أسد، طلال، جينالوجيا الدين، الضبط وأسباب القوة في المسيحية والإسلام، ترجمة وتقديم محمد عصفور، مراجعة: مشير عون، دار المدار الإسلامي، 2017.
[3] يستعمل المترجم كلمة "وكالة" في مقابل الكلمة الإنجليزية agency. والحال أنني أفضل عليها كلمة "فعالية" التي تعني قدرة الفرد على الفعل في العالم والأشياء والكائنات وتحويلها والتأثير فيها، ومنها كلمة "فاعل".