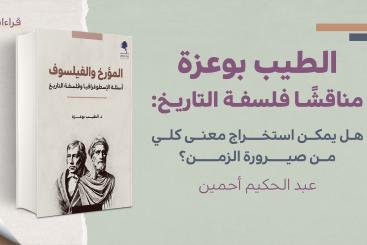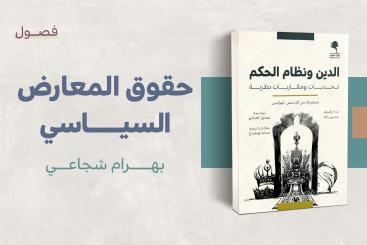قوةُ الدِّينِ ودِينُ القوةِ الشرعيةُ السياسيةُ في دولةِ المماليكِ

الملخّص
يشغلُ مفهومُ الشرعيةِ موقعًا مركزيًّا في تجربة الحُكْم الإسلامي، منذ نشأتها الأولى وعبر مراحل تطورها المختلفة. وليس أدلَّ على هذه المركزية من أن انقسام المسلمين إلى فرقٍ متصارعةٍ ومذاهبَ متنافرةٍ لم يكن إلا أثرًا من آثار الخصومة حول هذا المفهوم، وما نشأ عنه من مبادئ ومقاييس. والحقُّ أن الشرعيةَ مفهومٌ نسبيٌّ متغيِّرٌ؛ يختلف باختلاف المجتمعات ويتبدَّل بتبدُّل المراحل التاريخية؛ تأسيسًا على تباين القيم والمصالح التي يكتسب الحاكمُ شرعيتَهُ بقدر استجابته لها ووفائه بمقتضياتها. ومن هنا كانت تجربةُ الحُكْم الإسلامي – في جانبٍ من جوانبها – أشبهَ بعمليةٍ مستمرةٍ لخلع الشرعية على هذا النظام أو ذاك، أو بعبارةٍ أدقَّ لإعادة بناء الشرعية وفقًا لتغيُّر الأحوال، وتبدُّل الظروف السياسية والدينية والاجتماعية.
ومن الحقِّ أن جملةً من المتغيِّرات الطارئة أوجبت إعادة النظر في مفهوم "الشرعية السياسية" للدولة السُّلطانية/المملوكية؛ تطويرًا لهذا المفهوم، ودعمًا لمرتكزاته الأيديولوجية. ومدارُ هذه المتغيِّرات على ثلاثة أمور:
أولها: طبيعةُ الوضع القانوني للمماليك بوصفهم – في الأصل – رقيقًا مجلوبين دفعت بهم الظروفُ إلى سُدَّةِ الحُكْم.
وثانيها: سقوطُ الخلافة العباسية على أيدي المـُغُول سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م، ومن المعلوم أن هذه الخلافة كانت تسبغ الشرعية على الدول السلطانية من خلال منحها تفويضًا بالحُكْم، أو بعبارةٍ أدقَّ تفويضًا بممارسة السلطة الفعلية.
وأما ثالث هذه المتغيِّرات: فيتمثَّل في تعاظم الأخطار الخارجية التي جعلت تتهدَّد دارَ الإسلامِ في أقاليمه المركزية (إيران، العراق، الشام، مصر)، ونعني بها أخطارَ الصليبيين والمغول. فكيف اكتسبت دولةُ المماليك شرعيتَها في ضوء هذه المتغيِّرات؟ هذا ما ستجيب عنه الصفحاتُ الآتيةُ.