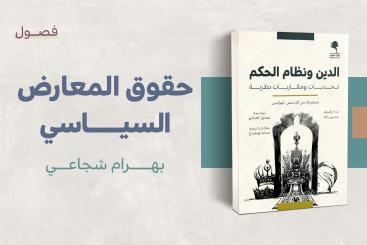دولة الفقهاء: بحث في الفكر السياسي الإسلامي
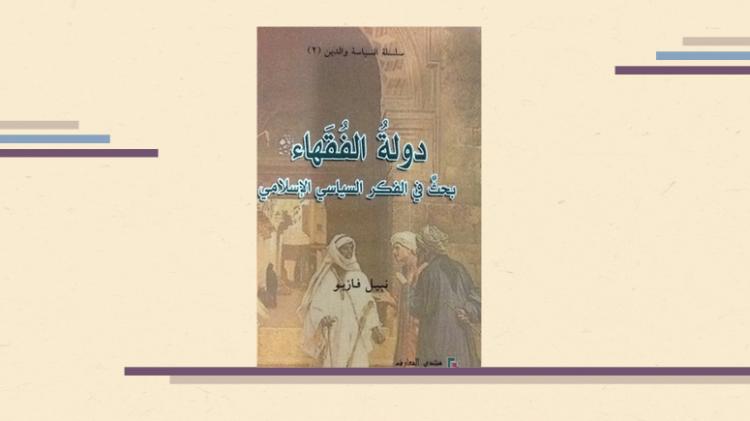
مقدمة
هذا كتاب في فقه السياسة الشرعية، لكنه ليس كتابَ فقهٍ يروم مقاربة الموضوع من منظور ديني وفقهي، لا، بل إنه كتاب فلسفي، أو قُل: كتابٌ في فلسفة السياسة؛ حسبه ينهج منهجًا نقديًّا تحليليًّا في قراءة أمهات الكتب الفقهية التي انصبَّت على السياسة، وما تلاها من مفاهيم أثثت نظامَ التأليف والتفكير في المتن السياسي الإسلامي.
لا يطرق الكتاب هذه المواضيع والمفاهيم إلا لنقدها وتحليلها، بل وحتى هدمها: لا يروم الكاتب إلى التعريف بفقه السياسة الشرعية، ولا يصبو إلى إحرازِ قصب السبق في التأليف والتنظير والتمحيص. ألَا إن الكاتب يقدم لنا كتابًا فلسفيًّا يفتضُّ به بكارة تراث نزل بثقله تأليفًا وتنظيرًا وتطبيقًا، ومع أن الكتابَ لا يخرج كثيرًا عن نصوص الفقهاء إلا أنه يستند عليها طمعًا في النقد وإعادة التأسيس والتوطين.
قد يظنُّ قارئٌ نبيه أو باحثٌ حصيف أن الكتابَ يقوقع نفسَه داخل قوقعة التراث، فيسجن نفسه فيه، ولا يكاد يخرج منه حتى يجد نفسه منجرًّا إليه من جديد، بيْد أن الكاتب استطاع بحسه النقدي وتكوينه الفلسفي المزدوج بشقَّيْه الإسلامي والغربي أن ينفلت من بين يدي تراث ذي سلطة فكرية ودينية؛ حسبه انكب على الفكر السياسي تأليفًا وقراءة وتنفيذًا حتى كاد يُوطن مفاهيمه توطينًا.
ما حفَّزنا على الكتابة عن الكتاب ليس إضافة قولٍ على قول، ولا تعريفًا بالكاتب، فقد سبق زمانه في التعريف، بل ما دفعنا إلى ذلك هو قلة التأليف في مادة السياسة الشرعية، فقد كُتبت كتابات عن الموضوع إما عمومًا تتوخى التعريف، أو كتابة تتشوف إلى التفصيل والتدقيق، لكن لا الأولى ولا الثانية تطرقت الموضوع كلية، بل انبرت إلى الاهتجاس بفلسفة سياسية شُدَّت إلى مغامرات الواقع السياسي الموضوعي، بدل الانشغال بمباحث الميتافيزيقا والطبيعة والمنطق.

نبيل فازيو
صاحب الكتاب هو باحث شابٌّ جدًّا، شغوف بالقراءة والتأليف، لا يكلُّ ولا يملُّ من الاطلاع على أمهات الكتب الفلسفية والفكرية، يمتلك تكوينًا مزدوجًا بين الفلسفة الإسلامية وما يحيط بها من تخصصات، ثم الفلسفة المعاصرة بجميع تلاوينها. تعرفت عليه كتابةً وتأليفًا، فبدا لي كاتبًا كهلًا في القراءة والتأليف، منغمسًا في مباحث الفلسفة والسياسة، حتى لاقيته ذات مرة شاخصًا ماثلًا أمامي: صغير السن، يضطلع بالكشف عن مقاربات المستشرقين للإسلام؛ عقيدة ولغة وأشخاصًا، فجاء كتابه الأول: "الرسول المتخيل: قراءة نقدية في صورة النبي في الاستشراق"، ثم دراسات ومقالات تنبش في مفاهيم العدالة والعدل والإنصاف والمساواة… في الفلسفة السياسية المعاصرة: رولز، أكسيلهونيت، حنا أرندت… وقبل هذا وذاك قارئ نَهِمٌ للفكر العربي المعاصر، حتى تجاوز ما كتب عنه عشرات المقالات والدراسات: من الجابري مرورًا بالعروي، ثم طيب تيزيني وناصف نصار، وهشام جعيط ومحمد أركون، وغسان سلامة وغيرهم كُثر.
في عنوان الكتاب
لا يتردد قارئ للكتاب في التوجس بدءًا من العنوان، حسبه عنوانًا مثيرًا، إن لم نقل مستفزًّا، فتحتَ عبارة دولة الفقهاء يكاد القارئ أن يجزم أن الكتاب يصبو إلى تحديدٍ للدولة التي قام على حكمها الفقهاء، لكن مضامين الكتاب تزيح عن القارئ همَّ الاستفزاز والإثارة. لا يهدف فازيو من دولة الفقهاء سوى الدولة التي تمثلها الفقهاء بوصفها الدولة الموضوعية التي فرضها الواقع الموضوعي آنذاك؛ إنها الدولة الإسلامية التي تصورها الفقهاء تأسيسًا للانتقال من دولة الخلافة التي انقضت وانصرمت، إلى واقع دولة فرضت نفسها حكمًا عضوضًا، وسلطانًا قهريًّا، إن توافقًا ومشورة أو قهرًا وقوةً.
ليس الكتاب كتابًا فقهيًّا في الفقه السياسي[2]، ولو أن مداره على ما ألَّفه الفقهاء، بل إن ما يريده الكتاب ومعه الكاتب هو مساهمةٌ في التحليل والنقد: نقد رؤية الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي إلى المسألة السياسية.
ما يجعل الكتاب ينأى بنفسه عن سياق الفقه والسياسة الشرعية رغم مضامينه الحُبلى بهذا المبحث، هو كونه يبحث أولًا في أسباب مكانة هذا الفقه، هاهنا كان الفقيه ممثلًا للسلطة، لقد كان خائضًا في شؤونها إما تسييرًا أو استشارةً أو تنظيرًا وتأليفًا، وهو بهذا وذاك كان يمثل ركيزةً مرجعيةً للسلطة السياسية.
ثم يبحث ثانيًا في الانتقال من إشكالية السياسة من مستواها الكلامي إلى التشريعي[3].
ثم يكشف ثالثًا عن المكانة النظرية لهذا الخطاب؛ فقد استطاع استيعابَ مختلف تمظهرات تلك الإشكالية، والتأسيس لها من داخل المشروعية الدينية.
كانت لهذه التمظهرات الثلاثة نتائج ضرورية، تمثلت في مُسلَّمتين حسب نبيل فازيو، أولاهما: علاقة هذا القول بأزمة المشروعية التي ألمَّت بدولة المسلمين، ثم ثانيتهما: قدرة الخطاب الفقهي على الإلمام بتلك الأزمة، والتصدي لها من داخل نسقه المفاهيمي[4].
عنوان الكتاب إذًا ليس سوى مطية للبحث في وظيفة التبرير والتسويغ المعياري للدولة وسلطتها السياسية. ليس التبرير هاهنا مجرد تسويغ للوضع السياسي القائم، بل منهج اتبعه الفقهاء لممارسة رقابتهم المعيارية على المجال السياسي الإسلامي، إن على مستوى أجهزة الدولة، أو على مستوى الفعل السلطوي[5].
لا يصبو منهج الكتاب إذًا إلى إضافة قول تراكمي على قول الفقهاء، ولا يهدف إلى التعريف بتصوُّر الفقهاء للدولة، ولا هو منهج فاحص فحصًا فوقيًّا علَّه يجد الخيط الناظم بين كل التآليف الفقهية في السياسة، بل قُل: إنه منهج تفكيكي- تاريخي، يتغيَّى فهمَ النصوص في سياقها التاريخي والكشف عن أغراض التأليف فيها؛ لذلك لا غرابة في استنجاد نبيل فازيو بنسق مفاهيمي أطَّر كتابته من قبيل: الخطاب، نظام القول، المشروعية، الشرعية، الصلاحية، التبرير، الحقل السياسي، السلطة العقابية[6].
ما يحيط العنوان من غموضٍ وعمومية يُضاف إليه ما يمكن أن نسميه التلفيقية؛ فقد انبرى الكاتب إلى التجميع بين مؤلفات فقهاء حول السياسة ومذهبها.
لن نجانب الصواب إن قلنا: إن صياغة العنوان لا تستقيم وواقعَ حال الكتاب؛ ذلك أن الكاتب دبج كتابه بعنوان أقل ما يمكن القول فيه أنه يغرق في العمومية، فما معنى "دولة الفقهاء" هكذا عمومًا؟! ورغم أن الكاتب يُفصِّل القول في مبررات العنوان إلا إنه – ورغم ذلك – ظل العنوان عامًّا، وهي عمومية تكاد تصل إلى درجة التجريد. ما يحيط العنوان من غموضٍ وعمومية يُضاف إليه ما يمكن أن نسميه التلفيقية؛ فقد انبرى الكاتب إلى التجميع بين مؤلفات فقهاء حول السياسة ومذهبها، على الرغم من أن ما يفرق هذه الكتابات أكثر مما يجمعها، صحيح أن جُلَّ هذه المؤلفات تصبُّ في مفهوم واحد، لكن هذا لا يمنع من أن لكل منها خلفياتٍ معينةً وأهدافًا محددةً، بل ومرجعيات مختلفة.
أصول وامتدادات فقه السياسة
يخط لنا نبيل فازيو في الفصل الأول أصولَ وامتدادات خطاب الفقه السياسي. كان ظهور خطاب السياسة الشرعية تعبيرًا عن أزمة المشروعية السياسية التي عصفت بالخلافة العباسية، وعليه فقد كان لهذا الخطاب مبررٌ لوجوده، مبررُ الاندحار والتخبط والتفتت الذي لم ينتج خلافة على شاكلة الأمويين أو الراشدين. فكان خطاب الفقه السياسي الشرعي جاهزًا لتجاوز هذه الوضعية الوهنة، تجاوزًا ستؤسسه الشرعية الدينية أساسًا، وهو ما يكشف عنه نبيل فازيو من خلال هوس الفقهاء بمسألة الأحكام[7]؛ إذ ألَّفوا فيها ما يسعف تنظيرهم لشرعية الدولة برمتها.
هذا على جهة التنظير، أما على جهة التطبيق فقد سار الفقهاء في نفس الدرب الشرعي؛ تبرير سلطة الدولة وما تلاها من آليات من قبيل الهيمنة، والإخضاع على قاعدة الأحكام الشرعية. لا يتحاشى الخطاب السياسي الفقهي مسألة الشرعية الدينية، بل جعلها الأساس الذي ستقوم عليه كل أقواله، ومن ثمة إخضاع الواقع السياسي لمقولات الشرع الإسلامي[8].
فقه السياسة بهذا المعنى هو العقل الفقهي الممتدة جذوره إلى مجال السياسة ليجيب عن أسئلتها، ينجلي هذا الحكم من خلال كتابات الأحكام السلطانية التي أتت لتعبِّر عن الجهد الكبير الذي بذله هذا العقل الفقهي بغية احتواء الدولة وأجهزتها[9]. ليس خطاب الأحكام السلطانية مجرَّد تطور طبيعي ومنطقي لتطور الفقه، بل علَّه يعبر عن ممارسة منهجية تصبو إلى الضبط الشرعي لمختلف المعاملات السياسية في المجال الإسلامي.
وعي الفقيه بهذه الوضعية مرده إلى اعتقاده بامتلاك سلطة شرعية تخوله الحق في ممارسة رقابة معيارية ودينية، لكن هذه الوضعية التي اتخذها الفقيه اتجاه المسألة السياسية ستتخذ أشكالَ التبرير والتسويغ، استغلتها السلطة السياسية في إضفاء المشروعية الدينية على أفعالها واختياراتها. نتج عن هذا الضبط المعياري والديني للمجال السياسي تنظيرُ ما سُمي بكتب الأحكام السلطانية، التي تُورد هاهنا باعتبارها تهتم بالتنظيم الإداري للدولة، بما يفيد الخضوعَ التام إلى منطق الشرع، حتى تغدو أجهزةً مشروعيةً وشرعيةً[10].
الحديث إذًا عن فقه السياسة الشرعية هو حديث عن خطاب معياريٍّ رقابيٍّ يبدأ بهندسة الدولة، وصولًا إلى أمور سياسة الرعية على مقتضى الشرع.
ولعل من أهم مقدمات هذا الضبط المعياري ما ألَّفه فقهاءُ من أمثال الماوردي: نصيحة الملوك، قوانين الوزارة وسياسة الملك، تعجيل النظر وتعجيل الظفر، الأحكام السلطانية والولايات الدينية. وأبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية. والجويني: غياث الأمم في التياث الظلم، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، على الرغم من أن التأليف في مبحث الأحكام السلطانية لا يعدو أن يكون على وجهِ الحق سوى نوع من الكتابة الفقهية في مجال السياسة، تحمس لها المؤسسون[11]. الحديث إذًا عن فقه السياسة الشرعية هو حديث عن خطاب معياريٍّ رقابيٍّ يبدأ بهندسة الدولة، وصولًا إلى أمور سياسة الرعية على مقتضى الشرع، وما يستلزم ذلك من تدخل في ترشيد الفعل السياسي، فكان من الطبيعي أن تلبس المفاهيم الفقهية لبوسًا سياسيًّا ارتقت به إلى مصاف الهم العام؛ هكذا صار العقل الفقهي عقلًا سياسيًّا همه الأساس هو الشأن العام والاجتماع السياسي[12].
يحق لنا التساؤُل في هذا المقام عن الوظيفة الأساسية للفقه السياسي؛ هل هو الضبط المعياري والرقابي للدولة؟ أم التقعيد الشرعي لها؟ لا يكشف فازيو عن مضمرات فقه السياسة الشرعية، ولم يوضح بالضبط ما هي الوظيفة التي اضطلع بها، فمرة يقول: إن وظيفته هي التقعيد الشرعي للدولة، وأخرى يقول بأنها هي الرقابة المعيارية للمجال السياسي.
فإن كانت الأولى هي الأحق بالوصف فكيف يمكن أن تكون الكتابات الفقهية ذاتَ نزوع ديني تقعيدي؟ وكيف آن لها أن ترتقي بمفاهيمها إلى مصاف المفاهيم السياسية؟ بعبارة أوضح: كيف يمكن للعقل الفقهي، كما سماه فازيو، أن يصير سياسيًّا وهو يتشوف إلى بلوغ المراتب السياسية لمفاهيمه، لا نعرف كيف يمكن لخطابٍ دينيٍّ يستند على الدين أن يكيِّف منظومته ومجال التدبير السياسي.
لقد وقع فازيو في فخ النزعة التلفيقية عندما اعتبر أن النصوصَ كانت تصبو للبس اللبوس السياسي، صحيح أنها انبرت إلى مقاربة سياسية للدولة ومعاملاتها المعقدة، لكنها لا تستقيم ووصفها بالكتابات السياسية، بل قُل: إنها كتابات دينية ذات لبوس سياسي غرضُه التبرير والتسويغ.
هندسة الدولة
ارتكزت هندسة الدولة في الفقه السياسي على مفهوم الإمامة، لِما لهذا المفهوم من سلطة مرجعية تستند على الشرع أولًا ثم من ثمة على السياسة ثانيًا. فكَّر الفقهاء إذًا في مسألة الإمامة على مقتضى الشرع، الذي مثَّل بالنسبة لهم الضامنَ الوحيد للعدالة، وعلى ذلك أسس الفقهاء تصورهم على خمسة مرتكزات نذكر منها:
أولها: التمييز بين الدولة والسلطة، ومعناه التفكير في الدولة باعتبارها جهازًا، لكنهم لم يولوا أهميةً لمسألة السلطة، بل حبسوا تنظيرهم في إرادة الحاكم باعتبارها جوهرَ السلطة، وهو ما نلفيه في كتاب الخلافة والملك لابن تيمية؛ حيث التركيز على الفتاوى الشرعية التي تصب في معمعة الحكم، وما يؤكد التمييز بين الدولة والسلطة؛ أي بين الحكم والملك[13].
ثانيهما: مسألة الإمامة بين العقيدة والشريعة؛ حيث انتقل الحديث عن السياسة من كونها مسألةً عقدية إلى مصاف كونها شرعيةً، مفاد هذا الانتقال هو إحداث نقلة نوعية من علم الكلام إلى الشريعة.
كان الفقهاء يعلمون بالبينة أنهم يدورون في فلكِ قضية كلامية خالصة، لكنهم سارعوا إلى قطع الصلة مع التصورات الكلامية حول المسألة السياسية متمثلةً في الإمامة، وبنوا تصوراتهم على قاعدة وحيدة مضمونها المركزي التشريع السياسي[14].
ثالث هذه المرتكزات هو مسألة الإمامة وتأويل التاريخ. سخَّر الفقهاء جهدًا كبيرًا في تأويل التاريخ الإسلامي على مذهب التقعيد التاريخي للمسألة السياسية، لدرجة وصل معها ابن تيمية إلى دفع التهم التي أُلصقت بمعاوية حتى يصير تاريخ الملك امتدادًا للخلافة الراشدة؛ هكذا صار الفقهاء يؤولون التاريخ الإسلامي بما يفيد التبرير الشرعي للمسألة السياسة، ولا ضيرَ أن يوفق الفقهاء هاهنا بين الخلافة والملك بعدها ما دامت الغاية هي التحقيق المعياري للفعل السياسي.
مسألة أخيرة استأثر بها الفقهاء، تمثَّلت في التشريع لمنصب الإمام، وما دمنا قد بلغنا مرحلةَ الشروط المطلوب توفرها في الإمام؛ فهذا يعني أن التقعيد الشرعي لهذا المنصب قد فرغنا منه وجعلناه وجوبًا ضروريًّا.
ما يلفت الانتباه في مسألة هذه الشروط هو أنها جاءت مفصلةً تفصيلًا دقيقًا، فمن الشروط الجسدية مرورًا بشرط العلم إلى مسألة الكفاية، عدَّد الفقهاء شروطَ الإمام حتى كادوا يجعلونه صورةً طوباوية لا تستقيم وواقع الحال. "اهتمام الفقهاء إذًا بشروط الإمامة شكَّل واحدةً من لحظات تفكيرهم في سؤال الإصلاحية الذي أخذ يطفو على سطح منطقهم التبريري، الذي أعملوه في استنباط أحكامهم السلطانية"[15].
لم يقتصر تصور الفقهاء على التقعيد الشرعي والسياسي، بل تعدَّاه إلى التخطيط لهياكل الدولة بما هي تجليات لها. أُولى هذه الهياكل منصب الإمام بما له من حضور رمزي وواقعي، لذلك نلفي القاضي أبا يوسف في "كتاب الخراج" يؤكد على سلطة الإمام، وتعاليها عن كل السلطات اعتبارًا أنها سلطة مركزية تمثل وحدة الدولة الإسلامية[16]. لم يكن تشديد الفقهاء على سلطة الإمام سوى غيض من فيض؛ فالحاكم يجب أن يمتلك سلطةً قويةً ضامنةً لوحدة الدولة، كما أن شبحَ الضعف والوهن الذي طال أنظمةً سياسيةً كان يحلق فوق رءوسهم.
أمَا وإن الإمامَ مجرد إنسان فانٍ، فقد فكرَ الفقهاء في مسألة الولاية، بل جعلوها واجبًا دينيًّا، أتوا لها كل التبريرات الشرعية التي تبوئُها المكانةَ الضرورية الملزمة شرعًا، كيف لا والمسألة على غاية من الأهمية؛ ما دامت تتعلق بخلافةِ الإمام، وتجنب الفتنة والتشرذم، وهو ما كان يخافه الفقهاء ولربما أكثرَ من تهديدات الأعداء.
انتقل إذا الخطابُ الفقهيُّ من المستوى الكلامي إلى المستوى التشريعي، بل تعدَّاه إلى التفصيل في التأسيس نظريًّا وعمليًّا لهرم الدولة، حتى بدا أنه نزل بثقله على المسألة السياسية وجعلها نُصب اهتمامه، وليس بغريبٍ ههنا أن يهتمَّ الفقهاء بالمسألة السياسية تنظيرًا، لكن الأغرب هو الدخول في دواليب الدولة من ألفها إلى يائها؛ فمن الإمام إلى الولاية، ثم الوزارة والقضاء وصولًا إلى المظالم، ثم أخيرًا تشكل الحقل السياسي.
لم يقتصر تنظير الفقهاء لدواليب الدولة على العموميات، بل تعدّاه إلى التفصيل في التفاصيل الدقيقة، التي من شأنها أن تحافظ على سير بناء الدولة وسلطتها. تظهر تجليات هذا التنظير التفصيلي في ما كتبه الماوردي عن الوزارة، وشأنها في دواليب الدولة، نقرأ ما يلي في كتاب الماوردي: الأحكام السلطانية: "الوزارة على ضربين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ، فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبيرَ الأمور برأيه وإمضائه على اجتهاده، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة".
نص صريح في إثبات مشروعية وزارة التفويض بأنها هي وزارة النيابة عن الإمام. وليس في الأمر من غرابة هاهنا لكون الماوردي يستند في ذلك على النصِّ القرآني الذي يمدُّه بالشاهد على إمكانية اتخاذ الوزير في النبوة.أما على جهة القضاء فقد سخر الفقهاء كل رمزيتهم الدينية للرفع من القضاء إلى مصاف المؤسسة القائمة الذات. لا تضاهي محاولةُ الماوردي في هذا الباب سوى تلك التي اضطلع بها أبو يعلى يوسف الفراء، حيث اعتبر القضاء أدخلَ في باب الولايات التي تستلزم حكما شرعيًّا[17].
على أن تبوُّءَ القضاء مكانة المؤسسة والسلطة لم تكن لِتمر مرورَ الكرام لتنتقل إلى سلطة موازية للسلطة السياسية، بل جعلوا هذه السلطةَ تحت تصرف الإمام، بما يفيدُ ضبطَ السير العام لجميع السلطات التي تنهل من سلطة الإمام. لا يحوز القاضي في هذا المقام سلطةَ التصرُّف والحكم والفصل بمعزل عن سلطة الإمام، بل إنه سلطة تابعة ولاحقة لسلطة الإمام؛ أو قُل إنها امتداد لسلطة الأخير[18].
السياسي والديني في تصور الفقهاء
شكلت سلطة الفقهاء الثقافية أداةً طيِّعة في يد السلطة السياسية، لكنها ليست سلطةً قائمة الذات، بل كانت تحتل مكانةَ الاستشارة والتجويز والإفتاء؛ إنها مكانة التبرير الشرعي لسياسة الإمام، وخلق مواءمة بين الواقع من جهة، والقانون والشرع والحق على جهة ثانية[19]. كان الفقهاء على وعيٍ تامٍّ بتحولات الواقع السياسي، وهم في ذلك لعبوا لعبةً ذكية تمثلت في رفع راية مسايرة الواقع وما يحتمله من تغيرات. وفي ذلك نجدهم أحلُّوا إشكاليةَ الشرع والتشريع محل الخلافة وشروطها[20].
تمسك الفقهاء بنموذجِ الخلافة حتى جعلوه مدارَ فكرهم، لكن تشبثهم هذا لم يندرج في مصاف الطوباوية السياسية- الدينية، بل ارتكز أساسًا على أساس شرعي وواقعي تاريخي في الآن نفسه، وهاهنا "بالضبط تتجلى جدلية السياسي والديني في تمثل الفقهاء لفكرة الخلافة؛ إذ بمقدار ما وضعوا لها شروطًا، بدت غير واقعية للباحثين، لم يتنازلوا عن حقهم في ممارسة الرقابة على السلطة، فكان من الطبيعي أن يتمظهر دورُهم في وجهين متقابلين؛ فهم، من جهة أولى، يمثلون سلطةً ثقافيةً يشكل الرأسمال الديني جوهرَها. غير أنهم، في مقابل ذلك، يسعون إلى التأثير في السياسة ومسارها بحكم همهم الإصلاحي. إن التداخل بين السياسي والديني غير مقتصر على المفهوم الذي بلوره الفقهاءُ عن الدولة والخلافة، بل يمتد ليشمل طبيعةَ الدور الذي اضطلعوا به، والموقع الذي اختاروا أداء ذلك الدور منه"[21].
هذا كان على جهة التنظير والتأسيس، أما على جهة التطبيق والشروط العملية فقد أجهد الفقهاء أنفسَهم في تحديد شروط ولاية الإمام. نلفي في هذا المقام الماورديَّ الذي يرى أن "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"[22]. يلاحظ فازيو بنباهةٍ حادة أن تعريف الماوردي لا يستقيمُ وتصورَ الباحثين حوله، بكونه أسَّس للدولة الدينية، ذلك أن الماوردي يشير إلى أن الإمامةَ موضوعةٌ، كما أنه لم يذهب إلى حدِّ القول: إن سياسة الدنيا تكون على جهة الدين[23]. مقابل ذلك لا يتردد ابن خلدون في التأكيد على أن الخلافةَ هي "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، فهي في الحقيقة خلافةٌ عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"[24].

الماوردي
كان الماورديُّ معاصرًا لأزمة الخلافة وتجرَّع مرارة فشل محاولات إصلاحها، فجاء تصوُّره بأن قدَّم للخليفة هندسةً للدولة تُعبِّر عن الممكن في زمانه، فجاء تمسُّكه بالمشروعية الدينية أمرًا بديهيًّا. أما ابن خلدون فكان يجول بفكره في أفق تاريخي مغاير، فالخلافة بالنسبة له ليست سوى مفهومٍ يردد الفقهاءُ والتاريخُ صداه، وكل ما يدركه هو انتصار المُلك الطبيعي والعصبية القبلية[25].
تصدى الفقهاء لحضورٍ قويٍّ للإمام ذي شِقَّين: دينيٍّ وسياسيٍّ، وهم بهذا يخطون نسقًا سياسيًّا يجعل من المشروعية الدينية الأساس. نلحظ خطوطَ هذا النسق من خلال إلحاح الفقهاء على إخضاع مشروعية الإمام لجملة من الواجبات تُحدِّد إطارًا لمقبولية سلطته على الرعية[26]. والتي جاءت نتيجة إلحاحهم ضمان الطاعة للإمام، وهاهنا يؤكد ابن جماعة على ضرورة ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم بدعوى تجنب الفتنة وضمان الاستقرار، اللذين لن يكونا ممكنَيْن التحقق إلا اعترافًا بالأصل الطبيعي (الغلبة) للسلطة والحكم؛ ذلك أن جذرَ السلطان هو "السليط" لأنه يضيء بعدله على رعيته كما يضيء السليط بنوره على أهله"[27]. يقوم أمر الإمام إذًا على الطاعة، وهي ضرورية ضرورةَ الاجتماع السياسي، الذي لا يتحقق إلا بها.
الشرع علة وجود الإمام، كيف لا وأمر الإمام لا يستقيم إلا به، ومن خلاله. لا يستند الفقهاء في تبرير، أو قُلْ في تزكية، موقع الإمام على الشرع إلا لطرح نسق مفاهيمي للدولة يقوم على الدين، طمعًا وتشوفًا في دولة ونظام سياسي يمثل الدين الإسلامي.
أدرك الفقهاءُ أن مشكلة الاجتماع السياسي تكمن في المشروعية، لذلك راحوا يؤسسون كلَّ بناء الدولة على الدين، لكن دونما التفريط في التنظير السياسي باعتباره مجالًا لتقلبات الواقع؛ هاهنا تنجلي رؤية الفقهاء الواقعية للمجال السياسي؛ باعتباره غيرَ ممكن التحقق إلا على المشروعية الدينية كأساس، ثم المشروعية السياسية.
ما معنى أن التصور الفقهي للدولة لا يخلط بين الديني والسياسي؟ وهل فعلًا لم يؤسس الماوردي للدولة الدينية؟ وهو السؤال عينه الذي ينسحب على معظم الكتابات الفقهية؟
الدولة التي أرادها الفقهاء إذًا دولةُ الدين، لكن ليس بالمعنى الذي يُفيد حكمَ الله عن طريق الإمام، بل قُل: ما يستجيب لمتطلبات الدين باعتباره النموذجَ الأمثل في التشريع.
انبرى الفقهاء إلى التقعيد الشرعي لمنصب الإمام، بأن حددوا له شروطًا دينية أساسًا. وما يفيد على جهة الإجمال أن منصب الإمام لا يحوز الرتبةَ الشرعيةَ إن لم يحقق هذه الشروط، وهذا معناه أن الدولة برمتها لا تحوز صفة الشرعية. لم تكن غايةُ الفقهاء هي التأسيسَ الفعليَّ والعمليَّ لمنصب الإمام باعتباره واجبًا؛ إلا لكونه يمثل الدولة الإسلامية على جهة الشرع، أما وأن الإمامَ لا يستجيب لشروطِ الفقهاء الدينية، فإن منصبه لاغٍ من أساسه. الدولة التي أرادها الفقهاء إذًا دولةُ الدين، لكن ليس بالمعنى الذي يُفيد حكمَ الله عن طريق الإمام، بل قُل: ما يستجيب لمتطلبات الدين باعتباره النموذجَ الأمثل في التشريع.
وعلى الرغم من أن فازيو يطرح إشكالية العلاقة بين الديني والسياسي في نهاية الفصل، أو يطرح، بعبارة صريحة، التصورَ الديني للدولة لدى الفقهاء، ورغم أنه يصرح بما لا يدع مجالًا للشكِّ في أن الفقهاء لم يؤسسوا لتصوُّرٍ دينيٍّ للدولة، إلا إنه ينكص عن خلاصته هاته ليؤكد أنهم لم يستطيعوا الفصلَ التامَّ بين الديني والسياسي، رغم أنهم تسلحوا بنزعة ذرائعية تستجيب لفصل السياسي عن الأخلاقي!!
كيف يمكن القبول بفصل السياسي عن الأخلاقي، ثم في نفس الآن الرفض بفصل السياسي عن الديني؟! ذلك أن الرؤية الدينية هي رؤية أخلاقية أساسًا، وحتى إن كان الديني يقبل – من منطق الضرورات تبيح المحظورات – بعضَ التعاملات "غير الأخلاقية" التي تجلب المصلحة، فإنه ورغم ذلك لا يجعلها قاعدةً.
لا تستجيب خلاصات فازيو في نهاية هذا الفصل لاستنتاجاته في مضمونه، حيث خُلط الحابل بالنابل، وجعل من فقه السياسة الشرعية يلعب على حبلين اثنين: النأي به عن تأسيس الدولة الدينية، ثم في نفس الآن عدم الفصل بين الديني والسياسي.
الإصلاح عند الفقهاء
ليست فكرة الإصلاح بعيدةً عن ذهن الفقهاء، بل إنها سليلةُ احتفالهم بالمشروعية[28]. يدرك الفقهاء جيدًا أن فكرة الإصلاح محايثةٌ للواقع السياسي، على الرغم من استناده على المشروعية الدينية. لم يكن الفقهاء في واقع الأمر بعيدين عن واقعهم السياسي، انخرطوا أيما انخراط في بناء وتحليل هذا الواقع، بما يفيد تأسيسَ الدولة والاجتماع السياسي الإسلامي. انخرط الفقهاء في تشخيص الواقع السياسي بدءًا بالمُلك أولًا.
على الرغم من أن المُلك السياسي يقدم نفسَه على مشروعية دينية أساسًا؛ إلا إنه قد تعتريه مظاهرُ فساد مزمن ومستفحل، رغم ما يمكن ملاحظته من غياب لهذا التشخيص في كتابات النصوص التأسيسية؛ إذ نكاد نعدم – كما يلاحظ فازيو – حضورَ التفكير في مسببات فساد المُلك السياسي، بله نلفي أحاديثَ عن إصلاح الراعي والرعية في كتاب ابن تيمية مثلًا دونما إشارة لمكامن فساد وضعف المُلك.
لم يكن غياب تشخيص مكامن فساد المُلك لدى الفقهاء متعمدًا ولا هروبًا من حالٍ قد يفرض نفسه باعتباره واقعًا متغيرًا، بل قُل: إن تصورهم الكامل لهندسة الدولة المذكور آنفًا يقدم كل مضامين إصلاح الفساد وإن بطريقة غير مباشرة. هكذا صار الماوردي على درب تدشين خطابِ آداب النصيحة بما هو خطاب إصلاحي، ومنه تجاوزٌ لمكامن فسادٍ قد يعتري المُلك.
نقرأ للماوردي في هذا المقام ما يلي: "واعلم أن الدولةَ تبتدئ بخشونةِ الطباع، وشدة البطش لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة. ثم تتوسط باللين والاستقامة لاستقرار الملك وحصول الدَّعَة. ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف لانتقاض الأمر، وقلة الحزم. وبحسب هذه الأحوال الثلاثة يكون ملوكها في الآراء والطباع. وقد شبه المتقدمون الدولةَ بالثمرة؛ فإنها تبدو حسنةَ الملمس، مُرة الطعم. ثم تدرك فتلين وتُستطاب؛ ثم تنضج فتكون للفساد والاستحالة… )[29].
يظهر بجلاء كيف أن الماوردي ينبش نبشًا في مكامن فساد الدولة والمُلك، حتى وإن كان ذلك من باب التشبيه اللين، وهو ما يُنذر لديه بضرورة الفساد مثلما تفسد الثمرة بعد نضجها، فيكون جور الدولة أمارةً على فسادها. وإن يكن من مظاهر غياب، أو شبيهه، لعنصر الإصلاح؛ إلا إنه لا ينم عن ضرورة تجنُّب الخوض في هذا القول مغبةَ السقوط في نزعةٍ جبرية تبغي عصمةَ الإمام من الخطأ السياسي والاجتماعي حسبه إمامًا يقوم على الشرعية الدينية، لا، بل إن الأمر يحظر كل نزعة جبرية للإمام، فهو وإن كان ممثلًا للدين في المجال السياسي إلا إنه لا ينأى بنفسه عن الفعل السياسي المشوب بالأخطاء ومظاهر الفساد.
نقرأ في هذا المعرض للماوردي ما يلي: "وأشد ما يمنى به المَلك في سياسة ملكه شيئان: أحدهما أن يفسد عليه الزمان، والثاني أن يتغير عليه الأعوان. فأما فسادُ الزمان فنوعان: نوع حدث من أسباب إلهية، ونوع حدث عن عوارض بشرية"[30].
ما يبتغيه الماوردي هو إقامة مُلك على أسس صلبة، تحول دون سقوطه في براثن الفساد، لذلك جاء خطابه خطابَ نصيحة؛ ينصح ولا يفضح، يكشف ولا يحلل، يهادن ولا يصعد. ليس فساد المُلك من جملة الفساد الذي يعتري المملكة، بل إنه قد يتعدى المَلك نفسه لينسحب على الحاشية والخاصة المحيطة به، وعلاقته الجائرة برعيته، ووهنه وضعفه أمام العدو[31].
لم يكن الغزاليُّ على نفس حال الماوردي في توصيف حال الفساد وأحواله، فقد حصره في عنصرين اثنين: عجز المَلك وجوره. لذلك يفضل الحديث عن خراب الأرض مقابل عمارتها، وعن فساد الملك بدلًا من إصلاحه[32]. ليس المُلك السياسي إلا نتيجة حتمية لعمارة الأرض، ولا تستقيم هذه الأخيرة إلا بالعدل السياسي، " فالمُلك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الجور".
لا يتعرض الغزالي، حسب فازيو، لمسألة الفساد الذي يعتري المُلك، فهو كان منشغلًا بالتربية والتهذيب الروحيين للنفس الإنسانية؛ لقد كانت مقاربته للفساد شموليةً، تنحو منحى روحيًّا خالصًا، كيف لا وهو المتصوف الذي يتشوف لعالم السعادة والكمال. لم تكن مسألةُ فساد المُلك غائبةً عن ذهن الفقهاء، لكنها لم تكن طاغيةً على تصورهم. ما كان يشغلهم هو مسألةُ التأسيس؛ تأسيس المُلك مدخل إلى إصلاحه، وهاهنا يميز الماوردي بين ضروب ثلاثة في التأسيس: تأسيس دين، وتأسيس قوة، وتأسيس مالٍ وثروة[33].
انبرى فازيو في هذا الفصل إلى التأكيد أن الفقهاء تصدوا لمفهوم الإصلاح وبوّأوه المكانةَ التي تليق به، ما دام خطابهم يرمي إلى التأسيس الشرعي للدولة، لكن مرمى الفقهاء في الإصلاح لم يكن مباشرًا وصريحًا، وهو ما ينفي مسألة أنهم كانوا يمتلكون سلطةً رمزيةً في مقابل سلطة الدولة.
لقد كان الخطاب الإصلاحي في فقه السياسة ضمنيًّا، ومهادنًا، ولم نقل أنه كان على جهة خطابٍ للنصيحة، يرمي إلى عدم التخلي عن المكانة الرمزية التي حازوها، أو بعبارة صريحة مخافة غضب السلطان عليهم، وهو ما نلفيه في خطاب الماوردي عندما يشبه الحكم بالثمرة الناضجة الآيلة إلى الفساد.
فإن كان الفقهاءُ – ومنهم الماوردي – يحوز سلطةً رمزيةً، كما يقول فازيو، فقد كان بإمكانهم التصدي لفسادِ المُلك صراحةً، إضافة إلى أنهم تطرقوا لفساد المُلك وليس إلى فساد المَلك، وهم ما يفيد أن الخطاب الإصلاحي لدى الفقهاء كانت له غايتان اثنتان: أولها تفادي المواجهة المباشرة مع المُلك والمَلك، وثانيها: التنبيه لمكامن الفساد اعتمادًا على خطاب أدب النصيحة حفاظًا على المُلك نفسه.
العدل في تصور الفقهاء
يطرح نبيل فازيو سؤالًا استشكالًّيا حول مسألة العدل في علاقتها بالأفق التشريعي المعياري للفقهاء لمسألة الدولة؛ ذلك أن ذهنهم كان مشدودًا لواقع الدولة السلطانية التي أثر حضورها على غياب فكرة الخلافة وترسخها كطوبى لديهم[34]، فكانت مسألةُ العدل لديهم تتجاوز حدودَ وصف الواقع على نحو معكوسٍ؛ لتعبر عن التناقضات التي أفرزها وعي الراهن السياسي.
تحدد لنا كتب الأحكام السلطانية دلالةَ العدل من طريق السلب؛ إذ "الجرح في العدالة هو الفسق"[35]. يحضر شرطُ العدالة في هذا المقام بشكل متفاوتٍ؛ فهو شرط قيام الإمامة، لكنه في نفس الوقت ليس شرطًا محددًا.
نلفي هاهنا تصورَ الماوردي للمسألة الذي يجعلها على رأس الشروط التي يجب أن تجتمع في الإمام؛ أما أبو يعلى الفراء فيذكر العدالةَ في سياقين مترادفين؛ حديثه عن حصول الإمام على ما يتميز به القاضي من صفات من بينها العدالة، ثم ذكره لشرط يكون بمقتضاه الإمام مكتسبًا لصفات العلم والدين.
يلاحظ فازيو هاهنا ملاحظتين أساسيتين
ليست العدالة شرطًا موجبًا إلا في السلطان القوي، أما وإن كان ضعيفًا وهنًا فإن الفقيه يُسقط العدالة من قاموس شروطه ليختار القوة والقهر والغلبة.
أولاهما أن العدالة بما أنها شرط لتنصيب الإمام تتحدد داخلَ إطار أخلاقي وديني أكثر من أنها معطًى سياسيٌّ أو مؤسساتيٌّ[36].
وثانيتهما: فتشير إلى الميز الذي أقامه الفقهاء بين توفر شرط العدالة في الإمام ومشروعية سلطته النابعة من نفوذه وغلبته[37].
ليست العدالة شرطًا موجبًا إلا في السلطان القوي، أما وإن كان ضعيفًا وهنًا فإن الفقيه يُسقط العدالة من قاموس شروطه ليختار القوة والقهر والغلبة. لا تكون العدالة إذًا إلا استعدادًا أخلاقيًّا لدى الإمام، بدل اعتبارها أساسًا من الأسس التي تقوم عليها الدولة.
ورغم أن العدل لم يكن ليتبوأ مكانةً مركزية كمؤسسة، إلا إنه وجد موطأً قدم من خلال غايةً كبرى، تتمثل في الحفاظ على اللحمة والاجتماع السياسي، بما هو أرقى تجليات الدولة.
لم يكن العدل إذًا إلا وسيلةً في يد الفقهاء، يبغون من ورائه إقامةَ المُلك والسلطان ومركزية الإمام، لذلك راح الفقهاء ينظرون للمفهوم من تلك الزاوية؛ زاوية تفادي شقِّ عصا الطاعة والفتنة.
إن المعنى الذي يتخذه العدلُ من هذه الزاوية هو إقامة علاقة توازن بين الرعية والمُلك، إنه عدل بقدر ما يتحقق بتجنب الجَوْر والحيف في التعامل مع حقوق الرعية، بقدر ما يتجنب هدرَ حقوق الملك لما في ذلك من تهديد لوحدة السلطة والدولة[38].
على هذا لا يكون العدلُ سوى الوسيلة الضامنة لمركزية ووحدة المُلك، فلا تكون لهذا الأخير كائنة إلا بالعدل، وبيانه أن العدل ليس تنزيلًا لمقولات الشرع ومقتضياته فقط، بل قُل: إنه نتيجة لفعل المَلك وتأثيره في غيره من عناصر الملك عمومًا، وفي الرعية تحديدًا[39].
من هنا نفهم تصورَ أبي حامد الغزالي لمفهوم العدل في كتابه "التبر المسبوك"، قوامه تحليل فعل الملك وعلاقته الجدلية بالرعية، لدرجة يصل معها الغزالي إلى اعتبار طباع الرعية نتيجة لطباع الملوك، وسببه "أن العامة إنما ينتحلون ويركبون الفساد وتضيق أعينهم اقتداءً بالكبراء، فإنهم يتعلمون منهم ويُلزمون بطاعتهم"[40].
ماذا عسانا أن نستنتج من هذه المقدمات التحليلية للمفهوم؟
ليس العدل، حسب فازيو، مقولة قبلية تجب تنزيلها على الحياة السياسية والاجتماعية، بل إنه قيمةٌ معياريةٌ يؤدي ضخُّها إلى بلورة فهم جدلي للسلطة بما هي علاقة بين الحاكم والمحكوم. إذ خلافًا لكتب الأحكام السلطانية التي نظرت إلى العدل كشرط مفترض توفره في الحاكم، فإن فقه النصيحة فكر في السلطة بما هي علاقة بين مختلف العناصر المتداخلة في صناعة المُلك، غير أن الأولوية، كما يلاحظ فازيو، في ذلك كانت من نصيب الملك[41]؛ لحاجة ذلك إلى الاستقرار، فارتقى مفهوم العدل إلى مصاف المعيار الممارس لرقابة على السلطان؛ إذ يتماهى مع الشرع في توجيه سلوك السلطان وتحديد أوجهه المشروعة[42].
تراث فقه السياسة الشرعية في ميزان التقييم:
ماهي القيمة النظرية والعملية لخطاب السياسة الشرعية؟
لم يجد هذا الخطاب نفسه معزولًا عن السياق الفكري والسياسي الواقعي آنذاك؛ حيث انخرط واقتحم نسق المقولات السياسية ونظَّر لها أيما تنظيرٍ، هاهنا لا يمكن للباحث في هذا المجال إنكارُ الأهمية التاريخية والنظرية التي احتازتها نظرة الفقهاء للدولة، فحسبها ارتقت بسؤال الدولة إلى مصافِّ السؤال المؤسساتي[43].
كان الفقهاء على وعيٍ تامٍّ بأهمية ومركزية الدولة في السياق الإسلامي، وهو وعي إيجابيٌّ بضرورتها، حتى ارتقوا بخطابهم إلى رتبة الشرعية الوظيفية والمؤسساتية. ورغم ما يمكن أن نكيله من مديح موضوعي لهذا الخطاب، إلا إنه لا يشذُّ من نقد موضوعي أيضًا.
انصرف الفقهاء إلى التبرير والتسويغ الشرعي لمفهوم الدولة، في حين أنهم أهملوا كلَّ تصور للبناء النسقي لها؛ وهو ما يؤشر على وعيهم بصعوبة الحديث عن انسجام المجال السياسي ومكوناته[44]. على النحو الذي يسمح لهم بالتفكير في مفهوم منسجم، أو نظرية متناسقة للدولة على جهة القانون والشرع. ما يمكن للباحث أن يخرج به من هذا التحليل، حسب فازيو، هو أن الجهد النظري الذي بدله الفقهاء الأوائل انتهى إلى الإخفاق؛ لم يجد نموذج "دولة الخلافة" صدًى في الواقع السياسي القائم آنذاك.
مردُّ ذلك هو كون خطاب الفقهاء كان نتيجة وسليل الأزمة التي ما انفكت تُحيط بمشروعية الدولة في التجربة الإسلامية. يسعفنا المقام هاهنا للقول: إن خطاب السياسة الشرعية لم يكن خطابَ تنظيرٍ لواقع لم يحصل، بل كان تنظيرًا لواقع قد حصل فعلًا؛ واقع التشرذم والفتنة وتهديد كيان الدولة والمُلك؛ إنه إذا خطابٌ في الماضي، على الرغم من أن مدار فكره هو الحاضر والمستقبل.
دليلنا في هذا القول ما يؤكده فازيو في كلِّ مرة من أن هاجس الفقهاء كان هو المشروعية والشرعية؛ وهذا ما معناه أن الدولة في عصرهم كانت وهنةً، وهذا ما دفعهم إلى إفراد حيز كبير من عملهم لإعادة النظر في مسألة الشرعية، كما تجلّت في علاقة الولاء بين الرعية والحاكم، وبعد انصرام تجربة النبي والخلافة الراشدة وانقلابها إلى ملك عضوض مع معاوية.
ارتبط خطابُ فقه السياسة الشرعية بمفهوم الأزمة؛ فهو إذًا خطاب في الأزمة، أكثر من كونه قولًا في الدولة.
كان ذهنُ الفقهاء مشدودًا إلى الماضي بكل رمزيّتِه الصراعية، رغم أنهم كانوا يكتبون للحاضر والمستقبل؛ كان الصراع الدموي على الحكم والمُلك والسلطة يحلق فوقَ رؤوسهم ويشغل أذهانهم، فلم يجدوا بدًّا من التنظير لمسألة المشروعية؛ حتى لا يعيد الماضي نفسه بصيغ مختلفة، لكن بنفس الدوافع التي ألمّت به. ارتبط خطابُ فقه السياسة الشرعية بمفهوم الأزمة؛ فهو إذًا خطاب في الأزمة، أكثر من كونه قولًا في الدولة[45]؛ لذلك ظل هذا الخطاب مشروطًا بظرفه التاريخي المأزوم، فراح الفقهاء يسخرون جهدَهم للخروج من هذه الأزمة ومن ظلالها الآتية من الماضي، وحتى عندما يؤسسون لمفهوم متكامل للدولة، فهُم لا يجعلون منها سوى الوسيلة المُثلى بُغيَة تجاوز واقع الأزمة: الفتنة والتشرذم.
لم يركب الفقهاء البروجَ العاجية، ولا هم بنوا تصورًا للمدينة الفاضلة على شاكلة الفلاسفة، ولم يركنوا لمقاربات علم الكلام في الموضوع من منطلق اعتقادي محض، بل اقتحموا الميدان والمعترك، وخاضوا "حروبًا" نظرية وعملية، متقمصين دورَ الرقابة الشرعية والدينية.
صحيح أنهم لم يمتلكوا سلطةً فعليةً، وصحيح أيضًا أنَّ السلطة السياسية قزمت دورَهم في بعض الفترات التاريخية، لكن ورغم هذا وذاك استطاع الفقهاءُ امتلاكَ سلطة رمزية رقابية اضطرت السلطة السياسية التنازل لهم في بعض الأحايين. لقد قدم الفقهاء درسًا في الواقعية السياسية، وأتت تنازلاتهم تعبِّر عن تخوفهم على مستقبل الجماعة والأمة[46].
في نقد تصور ومنهج الكتاب
رغم أن مدارَ الكتاب هو فقهُ السياسة الشرعية، ورغم أن فازيو يؤكِّد ما من مرة على أن الكتاب ليس كتابًا في فقه السياسة؛ إلا إن قراءةً موضوعيةً ومتأنية للكتاب تكشف أن فازيو سقط في فخ مبحث السياسة الشرعية. لا يكاد القارئُ يخرج بخلاصةٍ سوى أن الكاتب ظلَّ على طول الكتاب يُسبح في مضامين الفقه السياسي، ما معناه أنه لم يستطع التخلصَ من القراءات الكثيرة والكمية التي ساعدته لإنجاز الكتاب.
لقد ظل فازيو مشدودًا لخطاب الفقهاء بدرجات متفاوتة، ولم يستطع الدخول به إلى معترك الفكر السياسي الحديث بشقيه العربي الإسلامي والغربي، إلا لمامًا، دليلنا في هذا القول هو النسق المفاهيمي الذي يؤسس الكتاب؛ إنه نسق ينضح بالمفاهيم الفقهية، رغم أنه يصرح في مقدمة الكتاب أنه استعان بجملةِ مفاهيم معاصرة تساعده على شق الخطاب الفقهي. وحتى عندما يعود فازيو إلى جبته كباحث في الفلسفة السياسية المعاصرة، فإنه ما ينفك ينزع هذا الجلباب لينغمس في نسق الفقهاء.
كتاب فازيو بهذا المعنى كتاب في الفقه السياسي؛ حيث لم يتوفق، في نظرنا، في مقاربة الخطاب الفقهي نقديًّا، اللهم بعض اللحظات التي كان عليه أن يوجه أسهم نقد لتصورهم.
مردُّ هذا الانغماس المُبالغ فيه من طرف فازيو يعود إلى سببين اثنين:
أولهما: أن مدار الكتاب من الكمِّ الذي يجعله عصيًّا على البحث، فقد ألمَّ فازيو بأغلب التصانيف الفقهية السياسية، قراءةً وتنقيبًا، حتى ألفى نفسَه غارقًا في مباحثهم من دون أن يدري، وكاد يجهز على حسه النقدي والتحليلي في قراءة أمهات الكتب الفقهية.
والثاني: يعود إلى أن قراءة فازيو كانت سطحيةً، أو قُل: فوقية. بالمعنى الذي جعله يسير خطيًّا – النعل بالنعل – مع تصانيف الفقهاء، فتجده يسرد تصوراتهم من العام إلى الخاص، حتى إنه لا يجد غضاضةً في سردها بإطناب دونما التنبه إلى أن هذا الخطاب يحتاج في عصرنا إلى مقاربة نقدية عميقة وليست فوقيةً كما سلف الذكر.
ما أن يطَّلع القارئُ على فهرس الكتاب حتى يشعر بأن الكتاب ينحو منحًى تأريخيًّا محضًا؛ فمن أصول خطاب فقه السياسة إلى الامتدادات، مرورًا بمفهوم الدولة وأجهزته والتفاصيل الملمة به، وصولًا إلى ما يؤسس هذا المفهوم من مفاهيم، يجد فازيو نفسه غارقًا في مضامين الخطاب الفقهي بكل تفاصيله، لذلك لا نجد إلا أن نقول بأنه راهَنَ على الكمِّ وأهمل النوع. رهانه على الكم مرده إلى الموضوع: "دولة الفقهاء بعموم"، وإهماله للنوع مرده هو الموضوع نفسه؛ فلا يمكنه الإلمام بالشقين معًا.
ومع ضخامة الكتاب خضع فازيو لمقاربته التأريخية من دون أن يدري أنه يسقط في فخ التأريخ مهملًا الجانبَ النقديَّ في كتابه. قد نتجنى على الكاتب خصوصًا أننا لسنا بمستوى اطلاعه على مضامين الخطاب الفقهي، لكن لا نجد له العذرَ في هذا المقام؛ لكون الكتاب يفتقر أيَّما افتقار إلى نقدٍ موضوعيٍّ واستخلاصٍ لنتائج نقدية تزيح عن الخطاب الفقهي انغلاقَه في مسألة الشرعية الدينية التي ركز عليها فازيو أيَّما تركيز، وتعتبر النقطة الوحيدة التي استأثرت بنقد لاذعٍ من طرفه.
خلال قراءتي للكتاب طرحت فرضيةً مفادها أن الكاتب سيؤجل خلاصاته النقدية إلى الخاتمة أو فصل عنونه: في تقييم تراث فقه السياسة الشرعية، لكن ما أن بلغت مضمون الفصل المذكور حتى ألفيت خلاصات عامة تكرر مضامين خلاصات الفصول السابقة عليه.
يرتد فازيو عن وعده المذكور في المقدمة والمتمثل في استنجاده بقاموس الفكر السياسي الحديث، ويعتبر أن العناية بفقه السياسة الشرعية لها من الفوائد ما يجعله في مصافِّ المباحث التي تستطيع تأويلَ واقع سياسي إسلامي عربي معاصر يحبل بمفاهيم العصبوية والقبائلية والعقائدية[47]. بل إن الفكر السياسي الحديث لا يكفي اليومَ لفهم هذه الظواهر المعاصرة.
مقابل ذلك يعود فازيو ليؤكد أن فائدةَ الاهتمام بتراث السياسة الشرعية تنبهنا إلى الجهد النظري الذي لا يزال على الفكر السياسي الإسلامي القيامُ به في مواجهته لتراثه السياسي؛ حيث لا يزال التراثُ الفقهيُّ السياسيُّ يُلقي بِظِلاله على تمثلنا لمفاهيم الحداثة السياسية.
هل من تأويل غامض أكثر من هذا؟ كيف تكون لتراث الفقه السياسي فائدةٌ وهو في نفس الوقت يكبس على أنفاسنا في فهم المفاهيم السياسية الحديثة؟ وكيف نستطيع اقتحام النسق المفاهيمي السياسي الحديث دونما قطيعة مع تراث ولَّى عليه الزمن؟
هو سؤال فيه غموض يطرحه فازيو، دونما الإجابة عنه، فهو لا يعنيه الجواب هاهنا، بقدر ما يعنيه مآل فهمنا لمعضلات مجالنا السياسي، في ظل تجاهل حضور مفاعيل التراث السياسي في أمشاج ذلك المجال[48].
هذا على جهة التصور العام للكتاب، أما على جهة المنهج فالأمر يحبل بالمفارقات التي سقط فيها فازيو. لم يتسنَّ للكاتب الدخول في غمار منهج عقد العزم عليه في المقدمة، وهو كما قال بنفسه منهجٌ تاريخيٌّ تفكيكيٌّ، بَيْد أن اطلاعنا المتأني على المضمون يكشف لنا الغياب شبه التام لهذا المنهج، خصوصًا التفكيكي، فإذا كان المنهجُ التاريخيُّ قد أسعفه في مقاربة نصوص فقه السياسة الشرعية – بالنظر لمضامين هذا المبحث الحبلى بكل ما هو تاريخي – فإنه بالمقابل فشل في قراءة هذه المضامين قراءةً تفكيكية، اللهم إذا كان يقصد بالتفكيك التفصيل في مضامين تصور الفقهاء للدولة.
يغيب المنهج التفكيكي بشكل واضحٍ، قد نلتمس العذرَ للكاتب في هذا الأمر لكون الموضوع لا يحتمل مقاربةً تفكيكية، وإلا ستكون عدد صفحات الكتاب ضعفَ ما هو عليه الآن.
أخلف فازيو الموعد مع منهجه التفكيكي، واكتفى بالمنهج التاريخي، أو التأريخي، فسقط في فخ الشرح والشروحات والمقارنات التي طغت على الكتاب، وهو ما فوَّت الفرصة عليه ليكون كتابًا فاتحًا في ميدانه، على الرغم من المجهود الكبير الذي بذله في قراءة أمهات الكتب الفقهية السياسية، وبلورة هذه القراءة على مستوى مضمون الكتاب.
الهوامش
[1] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، دار المعارف، 2015.
[2] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 17
[3] ص 18
[4] ص 2
[5] ص 26
[6] ص 32
[7] ص 42
[8] ص 43
[9] ص 46
[10] ص 76
[11] ص 93
[12] ص105
[13] ص 169
[14] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 177
[15] ص 218
[16] ص 228
[17] ص 291
[18] ص 301
[19] ص 398
[20] ص 404
[21] ص 406
[22] الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ص.5، أورده فازيو في ص 409.
[23] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 409
[24] ابن خلدون، المقدمة، ص 150، أورده فازيو، ص 409.
[25] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 413
[26] نفسه، ص 417
[27] ابن جماعة، تحرير المقال في تدبير أهل الإسلام، ص 25. أورده فازيو، ص.418.
[28] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 427
[29] الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، ص 206، أورده فازيو، ص 436.
[30] الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، ص 247. أورده فازيو، ص 438.
[31] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 455
[32] ص 455
[33] ص 456
[34] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 462
[35] أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص 20
[36] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 466
[37] نفسه، ص 468
[38] نفسه، ص 490
[39] ص 498
[40] الغزالي، التبر المسبوك في نصائح الملوك، ص. 50. ذكره فازيو، ص 499
[41] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 502
[42] نفسه، ص 502
[43] نفسه، ص 508
[44] ص 512
[45] نبيل فازيو، دولة الفقهاء، بحث في الفكر السياسي الإسلامي، م. س، ص 523
[46] نفسه، ص 542
[47] نفسه، ص 543
[48] ص 544