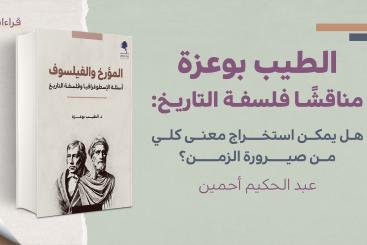العلمانية في الفلسفة المعاصرة - المفهوم الملتبس
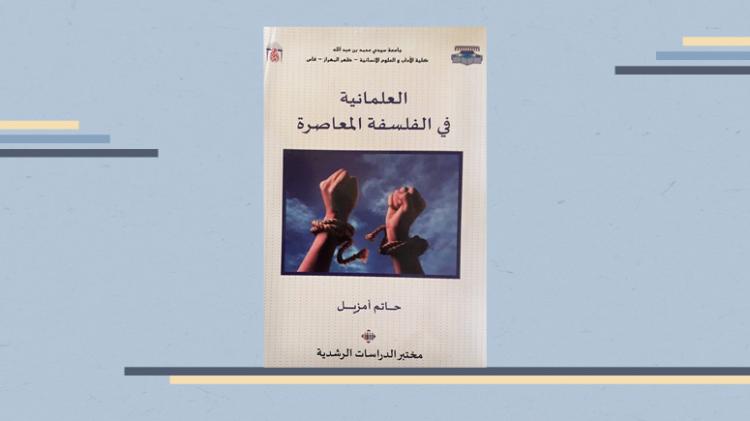
لعل من المفاهيم الكثيرة التي طالها التشويش واللبس والغموض في تاريخ الفكر البشري هو مفهوم العلمانية، فقد عرف المفهوم تجاذباتٍ كثيرةً وكبيرةً حول دلالته ومعناه ومسك حدوده، فبدءًا من فصل الدين عن الدولة، مرورًا باستبعاد الدين من المجال العمومي، ثم فصل الدين عن العلم، وصولًا إلى الفصل الوثيق بين العالم الروحي والدنيوي.
يقف كتاب العلمانية في الفلسفة المعاصرة لمؤلفه حاتم أمزيل[1] عند المفهوم وقوفًا دقيقًا، فهو لا يذهب مذهب المرافعة أو الدفاع عن المفهوم من داخل سجال أيديولوجي، ولا يحاول تحديدَ المفهوم من زاوية دينية أو علمية أو سياسية…؛ بل إنه يسلك طريقًا نقديًّا تاريخيًّا لفهم شروط إمكان المفهوم وتحديد مجال تطبيقه ورسم حدوده[2].
لذلك لن تكون مقاربة الكتاب أيديولوجيةً، ولن تلبس لبوس المنافح والمدافع عن العلمانية، بقدر ما سيحاول الكتاب التنقيبَ والبحثَ في المفهوم لعله ينفض عنه غبارَ الترسبات التاريخية التي علقت به؛ سواء الدينية أو السياسية أو العلمية أو الاجتماعية عمومًا.
يقف حاتم أمزيل عند المفهوم لغويًّا، ويعتبر أنه مشتقٌّ من كلمة (seculum) بمعنى "دهر" أو "عالم" أو "حياة دنيوية"، ثم انتقل المفهوم إلى لغة الضاد انطلاقًا من ترجمته (عَلمانية) رغم الاستخدام المزدوج (عَلمانية وعِلمانية)[3].
لا يسقط المؤلِّف في غياهب السجال الأيديولوجي، فهو على وعيٍ تامٍّ بضرورة الفصل والتمييز بين التحليل النظري الفلسفي، وبين النزعة الأيديولوجية. وعليه، يكون من الضروري التمييز بين نظرية العلمنة والنزعة الأيديولوجية العلمانوية[4].
غرض هذا التمييز هو إلباس الكتاب لبوسًا فكريًّا ينأى بنفسه عن كل أيديولوجية ذات نزوعٍ سياسيٍّ أو اجتماعيٍّ أو دينيٍّ؛ ذلك أن السياق التاريخيَّ يبقى أكثرَ غنًى من التصورات التي تريد احتضان هذا السياق.
لذلك لا يركن المؤلف إلى مجرَّد تفسير أو تأويل المفهوم انطلاقًا من نظرياتٍ معياريَّة؛ لأن النظرية أفقرُ من أن تلمَّ بجزئيات التاريخ وصيرورته[5].
على أن أهمية الكتاب لا تكْمُن في إعادة لوْك ما قيل عن العلمانية وتكراره، ولا يهدف إلى المرافعة الأيديولوجية التي تبتغي الانتصارَ للمفهوم؛ بل إنه يقف مليًّا عند المفهوم في أغلب تحديداته وتجلياته الفكرية والسياسية، وهو بذلك يحاول جاهدًا إرساء تصوُّر جامع للمفهوم؛ يتأسَّس على أسسٍ فكرية وفلسفية.
أضف إلى ذلك أن المؤلف يحفر حفرًا عميقًا في الشروط التي عجَّلت بظهور المفهوم، من بينها لا الحصر:
1-الثورة العلمية التي حرَّرت العلم من المراقبة الثيولوجية لرجال الدين.
2- تأسيس الدولة الحديثة، ساهم في تحرير المجال السياسي من كل شرعنةٍ ثيولوجية للسلطة السياسية، اعتبارًا بأنها ممارسة بشرية تقتضي محاسبة.
3- بروز مفهوم الفرد بما يحمله من إرادة وعقل مستقلٍّ عن الدولة والمجتمع.
4- استقلال المجالات الثقافية والفنية عن هيمنة الكنيسة وتوجيهها.
5- بروز مفهوم الدين باعتباره ممارسةً فرديةً خاصَّة عن المحيط به[6].
لكن رغم هذه التحديدات والشروط التي برز فيها المفهوم، فإنها لم تكن لتشكِّل عند غالبية المناوئين له سوى أسبابٍ لا قيمة لها، فالمفهوم في نهاية المطاف ليس سوى إقصاءٍ للدين حسب هذا التصور الساذج والسطحي.
والحال أننا نلفي في دولٍ غربية معاصرة حضورًا كبيرًا للمؤسسة الدينية والدين في الفضاء العمومي، لكنها في الوقت نفسه مجتمعات علمانية أو شبه علمانية. كما هو حال بريطانيا المعاصرة التي توجد فيها كنيسة رسمية، غير أن المجتمع والسلطة السياسية يبقيان مُنفصلَيْن عنها[7].
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تلفي حضورًا ملحوظًا للدين والتدين، إضافة إلى الحضور الرمزي للرؤساء في الاحتفالات الدينية الرسمية، بيْد أن السلطة السياسية ليست تحت رحمة أي سلطة دينية[8].
من الضروري التمييزُ والفصل بين الدين كنسق متعالٍ، وبين التصورات الدينية المحايثة والتي تفهم الدين وفقًا لمنظور معين.
يحرص المؤلف على التدقيق كثيرًا في مفاهيم تدور في فلك المفهوم الرئيس: العلمانية، اللائكية، العلمنة. وهو هاهنا يميز تمييزًا صريحًا بين العلمانية/اللائكية والعلمنة؛ بحيث يشير لفظ "لائكي" إلى عامَّة الناس، بغضِّ النظر عن رجال الدين؛ في حين تشير كلمة "عَلْمَني" إلى رجال الدين الذين تلقوا تكوينًا دينيًّا في إطار النظام الكنسي، ثم انصرف فيما بعد إلى توجيه الحياة العملية والروحية للناس[9]. يبقى هذا التمييزُ ضروريًّا؛ لأنه سيُمَكِّن من رفع اللبس عن المفهوم، فالعلمنة حركةٌ عامَّةٌ وطويلة الأمد تحررت خلالها مجموعةٌ من المجالات عن هيمنة السلطة الدينية. يجب إذن أن نقف عند هذا التحديد، فنحن لا نُحيل إلى الدين كنسقٍ؛ بل إن السلطةَ الدينية التي شكَّلها رجالُ الدين فيما بعد، وحاولت هذه السلطة الهيمنة على كل مجالات الحياة بما يتناسب وتأويلهم للدين، بيْد أنه من الضروري التمييزُ والفصل بين الدين كنسق متعالٍ، وبين التصورات الدينية المحايثة والتي تفهم الدين وفقًا لمنظور معين – كان هذا التحديد نتيجةً أساسية لظهور مفهوم العلمانية باعتباره يفصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية والدنيوية[10].
فالأولى تدَّعي التعالي والصحَّة المطلقة، بينما الثانية ذات شأن دنيويٍّ يقوم على النسبي والممارسة القابلة للخطأ. أضف إلى ذلك أن العلمانية حاولت أن تجعل من التدين تجربةً شخصيةً خالصة؛ بعيدًا عن رقابة خارجية للفرد[11].
يلحُّ المؤلف على أن مفهومَ الدولة إذن لا يستقيم دون تصوُّرٍ ما للعلمانية؛ شريطة ألَّا نسقط في فخِّ العبارة المكرورة: فصل الدين عن الدولة. تعني العلمانية فصلَ سلطة الشعب عن كل سلطة خارجية في عمليات التشريع، ووضع تصوراتٍ عامَّة للنظام السياسي، بما أن الشأن السياسي هو مجالٌ لتدبير النسبي وليس المطلق؛ إذ يكمن النسبيُّ في الممارسة البشرية القابلة للخطأ، بينما يحيل المطلق إلى كل ممارسةٍ لا يأتيها الباطلُ من أمامها ولا من خلفها.
والحال أن العلمانيةَ لا تميل إلى الفصل بالمعنى الذي يفيد إبعادَ الدين وإقصاءه[12]، بل يعني مما يعنيه حياد الدولة في الشؤون الدينية، باعتبارها مالكةً لسلطة زجرية وعقابية قد تستغلها لنشر دينٍ على حساب آخر[13].
ليس غرضُ الكتاب هو الدفاعَ عن العلمنة بوصفها كفلسفةٍ أو تصورٍ للعالم يهدف إلى إفراغه من المضامين الروحية والدينية والأسطورية، واعتماد العقل الأداتي كآلية مستقلَّة في التفكير، أو جعل الطبيعة والمادة مقولاتٍ لفهم عالمٍ نعتبره حاملًا لمرجعيته الذاتية وقوانينه المستقلَّة[14].
بل إن العلمنة هي نظريةٌ لفهم تطور تاريخيٍّ طويل خضعت له المجتمعات الحديثة إنْ وعيًا أو نظرًا. لذلك يبدو شعار "فصل الدين عن الدولة" ضحلًا للغاية؛ كوننا لا نستطيع تعريف الدين بالتحديد: هل هو طقوس وممارسات؟ هل هو تجربة روحية ووجودية؟ هل يمكن فصلُ الدين عن المكونات الثقافية المحيطة به؟
تجعل هذه التساؤلات من الشعار السالف الذكر ضعيفًا ووَهِنًا؛ كونه يلخص مفهومًا يحمل تراثًا فكريًّا وفلسفيًّا ومعرفيًّا غنيًّا؛ لذلك لا يجوز هكذا بسذاجة تبخيسه وتقزيمه إلى مجرَّد شعار.
وحتى يحقِّق المؤلف غرضَه من الكتاب – بمعنى التحديد الدقيق لمفهوم العلمانية، والوقوف عند دلالاته ومعانيه الفكرية والفلسفية والسوسيولوجية والتاريخية – فإنه يقف عند المفهوم كما تبلور عند فلاسفة معاصرين أهمهم: هيغل، فيورباخ، ماركس، نيتشه، فيبر، شميت، كارل لوفيت.
يذهب هيغل في مشروعه الفلسفي إلى أن مفهوم العلمنة ما هو إلا علمنة لمفهوم العناية الإلهية، وتحويله لأن يصير "العقل الذي يحكم العالم".
لنقف وقفةً تأمُّلية في مضامين تصوُّر هؤلاء للعلمانية ليس بغرض عرض فجٍّ لأطروحاتهم، بل الوقوف عن التشكُّل التاريخي للعلمانية في إطار شروطٍ تاريخية وثقافية واجتماعية وسياسية. يقف هيغل عند مفهوم العلمانية باعتبارِه مشروعًا لتحرير المجتمع الحديث؛ من خلال الانفصال عن الماضي المسيحي واستلهام قيمه وأفكاره في الوقت نفسه[15]. يذهب هيغل في مشروعه الفلسفي إلى أن مفهوم العلمنة ما هو إلا علمنة لمفهوم العناية الإلهية، وتحويله لأن يصير "العقل الذي يحكم العالم"، فالتاريخ تحكمه عناية ما وتوجِّهه، فهو لم يترك فرصةً للصدف والعلل الخارجية العارضة.
يخضع التاريخ لصيرورة العقل الكلي، ويوجِّه هذا الأخير مساره نحو تحقيقِ المطلق، بما فيه الثيولوجيا التي ستحقِّق اكتمالها مع العقل المطلق؛ ذلك أن العقل ليس مجرَّد كائن خارجي، ولا هو بالكائن المتعالي عن التاريخ، بل إنه محايثٌ له، وكما أن الإله يحكم العالم وفقًا لضرورة محددة، فإن العقل هو كذلك يوجِّه عمل التاريخ، بيْد أنه حان الوقت لكي تترك الثيولوجيا مكانها للعقل[16]. لكن ما علاقة العقل هاهنا بالعلمنة؟
إن علمنةً على شاكلة هيغل تنظر إلى المسيحية باعتبارها سالبةً للمؤمنين، لكن ليس الأمرُ على جهة مسيحية بإطلاق؛ بل إن الأمرَ يقتصر على مسيحية ثيولوجية حوَّلت الدين إلى عقائد ثابتة بفعل تحويلِها للإيمان إلى أوامرَ وقراراتٍ؛ انطلاقًا من تجميدِ المضمون الموضوعي والمحتوى المطلق للمسيحية من طرف رجال الدين[17].
تستهدف العلمنة إذن المسيحية في شكلها الثيولوجي، وليس المسيحية المطلقة تلك التي تُمثِّل الدين المطلق كما يتصوَّره هيغل؛ ذلك الدين الذي يتضمَّن قوةً ما تكْمُن في الشعور الداخلي بواجب ما، عكس الدين الطقوسي الذي تحوَّل إلى قوة خارجية قهرية[18].
تحقَّقت العلمنة من داخل الدين نفسه، فمع البروتستانتية تمَّ علمنةُ المسيحية بأن تحولت إلى دينٍ مباشر للفرد دونما وساطاتٍ أو تملُّك للكنوز الروحية والدنيوية.
يقول هيغل بهذا الصدد: "لكي يتحقَّق المبدأ المسيحي في العالم (…) يلزم أن تحدث ثورة روحية"، وهي الثورة التي تمثلت في مسارِ الإصلاح الديني، الذي استعاد حريةَ الإنسان في المذهب البروتستانتي الجديد؛ وعليه فإن البروتستانتية تتقاطع مع الدولة العقلانية في إعادة الحرية للفرد[19]. هكذا تحقَّقت العلمنة من داخل الدين نفسه، فمع البروتستانتية تمَّ علمنةُ المسيحية بأن تحولت إلى دينٍ مباشر للفرد دونما وساطاتٍ أو تملُّك للكنوز الروحية والدنيوية، كما كان الأمر مع الكنيسة الكاثوليكية.
لم يكن فيورباخ راضيًا عن مشروع العلمنة كما تصوَّره هيغل؛ ذلك أن "الفلسفة الهيغيلية هي آخر ملاذ ودعامة عقلانيتين للثيولوجيا"[20].
وأطروحة فيورباخ دهرية بالأساس؛ لكونها تُريد التخلُّص من أوهام الناس في التصورات الدينية باعتبارها تتدخَّل في وعي الإنسان، وعلى الرغم من أن الدين وعيٌ فإنه وعيٌ غيرُ مباشر، يمرُّ عبر مملكة السماء التي وُضع فيها كل شيء من طرف الإنسان.
إن الدين بالنسبة إلى فيورباخ ما هو سوى تمثلاتٍ إنسانية وفقًا لصور مفارقة للعالم، وحتى يستعيد الإنسان وعيَه الكامل بذاته وجب عليه استعادةُ كل المقدَّسات التي أرسلت إلى السماء، وجعلها محايثةً له، فالإيمان مثلًا بحياة مستقبلية أخروية ليس سوى إيمان بالحياة الدنيوية وَفْقَ الصورة التي يجب أن تكون عليها[21].
إنها تحقيق الصورة المثالية للدين في الأرض، وعدم جعله عائقًا أمامَ وعي الإنسان بذاته، بل به ومن خلاله يكون الإنسان على وعيٍ تامٍّ بأنه هو المالك للوجود.
ليست العلمنةُ كما يتصوَّرها فيورباخ تخلصًا من المسيحية والدين عمومًا، بقدر ما اكتشف أن موضوع الفلسفة هو ماهية الإنسان بما هو كذلك، فماهية المسيحية (وهو للإشارة عنوانُ كتاب فيورباخ) تكْمُن في تخليصها من مركزية الإله والسماء، وتسليمها للإنسان والأرض.
لم يكن ماركس ليرضى بهذا التصوُّر، واعتبر أنه ما زال يقبع في مسيحية مغلَّفة بالعلمنة، في حين أن تحرُّرَ الإنسان لن يتحقَّق إلا بالانفصالِ عن ثقافة دينية جُعلت حاجزًا وعائقًا بين الذات والعالم[22].
قد تبدو الأطروحةُ الماركسية قاسيةً، بيْد أنها لم تكن مجرَّد خبط عشواء، بل اتكأت على تحليلٍ واقعيٍّ وعلميٍّ للواقع، ونقدٍ مباشر للواقع الاقتصادي.
يتلخَّص مشروعُ ماركس في "نقدٍ للأرض" يتَّسم بتحرير الإنسان من كل الخرافات المعلَّقة في السماء، والتي تتحكَّم في سلوكاته اليومية، ومن ثمَّ اعتبار الأرض هي المكان الذي تُنتج فيه الأفكار والتصورات التي تتحكَّم في سير الواقع.
ليس النقد الماركسي للدين من طينة التخلُّص من الدين كمنظومة عقدية، بل غايته هو تعرية الأصول الأسطورية للدين.
هاهنا يصير إلهٌ آخر هو من يتحكَّم في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وهو من يسهر على توزيع الثروات، ويشيد الإمبراطوريات ويتحكَّم في التاريخ بعامَّة، إنه إلهٌ لا علاقة له بالعالم السماوي. وحيث إنه أضحى محايثًا لنا، فمن الممكن التحرُّر من "قدريَّتِه" التي قدَّرها علينا. ليس النقد الماركسي للدين من طينة التخلُّص من الدين كمنظومة عقدية، بل غايته هو تعرية الأصول الأسطورية للدين، على الرغم من أن هذا النقد لا يضعف الدين؛ ما دام هذا الأخير يستند على تربة اقتصادية واجتماعية[23].
رامت المقاربة الفلسفية إلى غلو في التحليل التاريخي والفكري والاقتصادي للحداثة في علاقتها بالعلمانية، وراحت هذه المقاربة تُحلِّل مبادئ الحداثة وتفكِّكها علَّها تجد فيها ما يحدِّد دلالةً واضحةً وجليَّة لمفهوم العلمنة.
بيْد أن هذه المقاربة – على أهميتها – لم تستطع النفاذَ إلى صميم الموضوع الذي تطاله العلمانية: محاولة فهم العقلنة الشاملة التي طالت الاقتصاد والسياسة والمجتمع[24].
هذا ما يميز المقاربة السوسيولوجية مع ماكس فيبر حسب المؤلف.
استعمل فيبر مفهومَ العلمنة كوسيلةٍ تأويليَّةٍ ليتمكَّن من استيعاب أنماط السلوك الحديثة[25]، فقد بدا له أن سلوكَ العامل في المقاولة الحديثة شبيهٌ بسلوك المؤمن في البروتستانتية.
لا يهدف فيبر إلى غائية تاريخية تحرِّر الإنسان من قبضة الأسطورة، بل إن كل مشروعه يقوم على الفهم من خلال مقاربة تأويلية سوسيولوجية.
نحت فيبر مفهوم "رفع السحر عن العالم" ليبيِّن أن البروتستانتية أنكرت كلَّ تأثير في قدرة الله من خلال طقوس العبادة؛ وعليه فإن العمل الحقيقي يجب أن يكون في العالم الأرضي انطلاقًا من مقولة الواجب، فقيام الإنسان بواجباته لن يجعله يدخل في غياهب الورع الديني الذي ينفي عنه المسؤولية.
إذن، لم يعد التقديس مخصوصًا بالعالم الفوقي، بل طال أيضًا العالم التحتي؛ لكن ليس بالمعنى الدنيوي المحض، بل فقط على جهة الانهمام بالمسؤولية الذاتية بعيدًا عن كل ورع دينيٍّ.
لقد تحوَّل العالم من مكانٍ يشرئبُّ بعنقه نحو عالمٍ فوقيٍّ إلى عالمٍ محايثٍ لنفسِه، وأضحت أشياؤه المادية غيرَ ذات قيمة أو بُعْدٍ رمزيٍّ يحيل على عالم سحريٍّ، بمعنى فقد الأشياء المادية ارتباطها بالعالم الفوقي.
يحيل مفهوم العلمنة إذن إلى عملية نقل قيمٍ من المجال الديني إلى الدنيوي[26]. وقد عملت الديانات التوحيدية في هذا العمل من خلال تراجع النظرة السحرية عن العالم، وصولًا إلى رفض كل وساطة رمزية للعالم الدنيوي في صلة الإنسان بالعالم المتعالي[27].
ليس هذا التعدُّد الدلاليُّ في مفهوم العلمنة غِنًى وثراءً له؛ بقدر ما يؤكِّد على تأثيرٍ سلبيٍّ قد يُعيق كلَّ عمل تأويليٍّ له.
يشير المفهوم أحيانًا إلى تراجع الدين عن التأثير في الحياة الخاصَّة والعامَّة، وأحيانًا أخرى إلى استمرار القوالب المؤسسية القديمة بعد إفراغها من الحمولة الدينية، ومرة يُستخدم بمعنى الانتصار الذي حقَّقته الحداثة على القيم التقليدية الدينية[28].
لذلك يلجأ المؤلف إلى تمييزٍ واضحٍ وصريحٍ للمفهوم في ثلاثة استعمالات:
–استعمال المفهوم كمشروعٍ يستعيد الكنوزَ المسيحية وإبراز العناية الموجهة للتاريخ، وإقامة ثيوديسيا جديدة قاعدتها العدل في التاريخ (هيغل).
–استعمال العلمنة كمطاردةٍ للدين، مع ماركس ونيتشه، من معقل الإنسان وتحرير هذه المعاقل من إيمان جديد بالعلم والدولة المؤلهة[29].
–العلمنة كسيرورةٍ تأويليةٍ تهدفُ إلى قراءةٍ لتاريخ الأفكار ونقدٍ للثقافة مع ماكس فيبر.
يبتغي مطلب العلمانية – حسب المؤلف – تحريرَ الرقاب من نِيرِ وساطة المؤسسات الدينية، بيْد أن تبنِّيَ هذا المطلب من طرف الحركات التحررية والحداثية لم يكن حاسمًا وصريحًا بسبب التشويش الذي طاله من طرف الحركات المعادية له – الدينية أساسًا – حتى أضحت العلمانية مرادفًا للكفر والخروج عن الدين وإقصائه[30].
فبدا الداعي إلى العلمانية بمثابة من يفتح أبواب الشيطان ويدعو إلى الانحلال وشيوع الرذيلة ومحاربة الأخلاق، في حين أن المفهوم لا يريد سوى فصل واضح وصريح للمجال الديني عن المجال الدنيوي؛ خصوصًا في الحياة الخاصَّة، ولا يُراد من هذا الفصل إبعادُ الدين؛ لأن هذا الأخير كان وما زال وسيظل منظومةً عقديةً وثقافيةً تؤثر في الإنسان بتفاوت، بل إن غاية العلمانية هي حصر الشأن العقدي خاصةً في الحياة الخاصَّة للفرد.
إن وظيفة المؤسسة الدينية ليست هي المراقبة، بل هي التوجيه والنصح.
ومع ظهور مفهوم الأمَّة والمواطنة والحرية، ومع طغيان الفردانية كاختيار حرٍّ، أصبحت مراقبةُ أفعال الناس وسلوكياتهم طيَّ الماضي عندما كانت المؤسسة الدينية تسيطر على الناس. إن وظيفة المؤسسة الدينية ليست هي المراقبة، بل هي التوجيه والنصح. وعندما تكون المجتمعات ذات تعدُّدية دينية، فإن العلمانية تساهم في حفظ الحقوق، بغضِّ النظر عن كل انتماء دينيٍّ، من بينها الحقوق في ممارسة الشعائر الدينية؛ تلك التي تختلف عن طقوسٍ دينية أخرى.
نعطي مثالًا دالًّا في هذا المقام: في الولايات المتحدة الأمريكية هناك حرية دينية تكاد تكون مطلقةً، فبإمكان المواطن أن يمارس ما يشاء من الطقوس الدينية التي تناسبه، ولا ضير في الارتداد عن دينٍ معيَّنٍ واعتناق آخر، ولا يهمُّ إن كانت هذه الديانة ذاتَ نزوع أسطوريٍّ أو خرافيٍّ أو ما شابه ذلك، فكلُّ الديانات إنما تنهل من منبع أسطوريٍّ لا محيد عنه.
هكذا تكون العلمانية ضامنةً للحقوق الجماعية والفردية والحرية الدينية. مقابل ذلك، فإن العلمانية الفرنسية وضعت نفسها في مأزق حقيقيٍّ عندما منعت استعمال الرموز الدينية في الفضاء العمومي، خصوصًا المؤسسات العمومية. فإن كان لهذا القرار من مزايا تجعل من المواطنين سواسيةً أمام المؤسسات، بصرف النظر عن مرجعيتهم الدينية، فإن الأمر فيه ضرب للحرية الدينية، فلكل شخص الحرية الكاملة في أن يرتدي ما يشاء من الألبسة، أو الرموز، ما دامت هذه الرموز لا تؤثر في الآخرين في الفضاء العمومي.
العلمنة إذن تحرُّر من السلطة أنَّى كان شأنها، ومن حقِّ الجماعات الدينية والمؤسسات المشاركة في القرار السياسي وفقًا لمبدأ المساواة، دونما إحالة إلى أية مرجعية يمكنها ادعاء "الحقيقة"؛ لأن الحقيقة الدينية لا وجود لها في الواقع اليومي إلا من منطلق عقديٍّ خالص، أما محاولة مشاركتها فستقود إلى فرضها قسرًا، وهو الأمر الذي يتعارض مع روح الدين نفسه.
الهوامش
[1] حاتم أمزيل، العلمانية في الفلسفة المعاصرة، منشورات مختبر الدراسات الرشدية، جامعة محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس، 2017.
[2] نفسه، ص 9
[3] نفسه، ص 10
[4] ص 14
[5] ص 15
[6] أنظر حاتم أمزيل، العلمانية في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، الصفحات: (16-17- 18)
[7] حاتم أمزيل، العلمانية في الفلسفة المعاصرة، ص 21
[8] ص 21
[9] ص 22
[10] ص 25
[11] ص .25
[12] ص 27
[13] ص 27
[14] ص 30
[15] ص 46
[16] ص 52
[17] ص 61
[18] ص 63
[19] ص 69
[20] ص 73
[21] ص 77
[22] ص 96
[23] ص 104
[24] ص 136
[25] ص 137
[26] ص 145
[27] ص 146
[28] ص 148
[29] ص 149
[30] ص 155