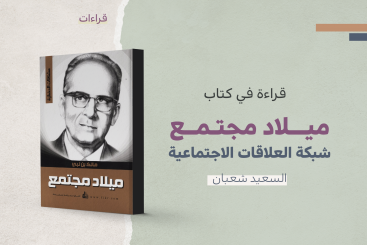لماذا نخضع لهيمنة "الذكاء الاصطناعي"؟

في كتابه "الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني" (The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality)(1)، دق الفيلسوف الإيطالي "لوتشيانو فلوريدي" (Luciano Floridi) ناقوسَ الخطر إلى مسألة هيمنة الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان خلال القرن الحادي والعشرين (التطور التقني والمعلوماتي) بالشكل الذي لم يعد معه من مهرب للإنسان -كما الفلاسفة وعلماء الاجتماع- سوى مواجهة الثورة الرابعة (ثورة الخوارزميات والإنترنيت). وإذا كان الفيلسوف نفسه لا يعترف صراحة بخطر هذا التقدم التقني على حياة الإنسان وخصوصياته في عالم "الأنفوسفير"، إلا إنه يشدد على ضرورة التفكير في نهج أخلاقي جديد -ذي أسس فلسفية- ينظم تفاعلنا مع تبعات هذه الثورة من خلال مناقشة مستفيضة لقضايا الخصوصية وتنظيم البيانات والمعلومات الشخصية في "العالم الافتراضي" (من الناحية السياسية والبيئية أساسًا).
يقترن سؤال الخصوصية في العالم الرقمي اليوم بمنطقين اثنين:
أولًا: بفعل التطور المهول للروبوتات، الخوارزميات والآلات الذكية، باتت حياة وخصوصيات ومعيش الإنسان اليومي في قبضة الذكاء الاصطناعي الذي يعرف توجهاتنا، أذواقنا وميولاتنا أكثر مما يعرف أقرب المقربين إلينا وقد يشكل تطوره في قادم الأيام خطرًا حقيقيًّا على حريتنا وإرادتنا الثمينة.
ثانيا: أضحى واضحًا خلال السنوات الخمس الأخيرة أن بياناتنا ومعلوماتنا على شبكة الإنترنيت غير محمية، وعرضة للاستغلال من قبل القراصنة والمتطرفين كما الجهات الأمنية. بل أكثر من ذلك، سنت العديد من الدول (الصين، ألمانيا…) قوانين تسمح لحكوماتها بالتجسس على مواطنيها ومراقبتهم باسم القانون.
العبودية الرقمية الطوعية أو المختارة
بدءًا، يقوم استعمالنا اليومي لعوالم الأنفوسفير (الغلاف المعلوماتي) على تفاعل مستمر مع الذكاء الاصطناعي. من أجل ولوج أو تصفح أي موقع، نقدم بياناتنا ومعلوماتنا الشخصية التي تحفظ وترتب وتقارن بمعلومات باقي المستخدمين. قد تكون هذه البيانات مباشرة (التسجيل في حسابات التواصل الاجتماعي) أو غير مباشرة (البحث عن كلمات مفتاح بغوغل)، إلا إنها تسمح للخوارزميات الرقمية بمعرفة الاتجاهات العامة لأذواقنا واختياراتنا وإعادة تنظيمها وتصنيفها بما يتوافق ورهانات السوق الاستشهاري والاقتصادي المفتوح. تُمكن هذه العملية البسيطة (الواسعة النطاق) من تجميع معلومات شخصية أكثر بكثير مما نستطيع البوح به بشكل مباشر في تفاعلاتنا اليومية مع الآخرين. لذلك، أصبحت جل الشركات تنفتح على مجال الإشهار الرقمي الذي يقدم نتائج أكثر فعالية من الإشهار التقليدي؛ فعملية بحث عادية عن "هاتف جديد" بغوغل سيفعل جرس تنبيهات الإشهارات بحسابك على "فايسبوك" وقد يعرض لك منتجات مشابهة ومن نفس الفئة (حواسيب ولوحات إلكترونية) بحسابك على "يوتيوب"… لتجد نفسك قد اقتنيت أشياء لم تكن بحاجة إليها ولم تطلبها أصلًا، لكنك راضي وسعيد بما قمت به! يحدث كل ذلك ونحن نوهم أنفسنا بأننا أحرار في اختياراتنا ومحميون فيما يخص بياناتنا.
إننا أمام أجهزة وبرمجيات تخاطب الجانب اللاشعوري والرغباتي الدفين في النفس الإنسانية.
يظهر أننا لا نُجبر على الوقوع تحت سطوة استلاب الأجهزة الذكية أو الأنفوسفير، ولكن نختار بطواعية الانسياق وراء رغباتنا وأهوائنا في ظل وهم "دمقرطة المعلومة" وحرية البحث والوصول إلى البيانات. إن الذكاء الاصطناعي بُرمج للتعامل مع الإنسان بوصفه إنسان ومخاطبة الجانب العاطفي واللاشعوري فيه، وهو على بينة بأننا كائنات لا تعيش في توافق مع ذاتها والآخرين في العالم الواقعي. فبمجرد وضع صورة على مواقع التوصل الاجتماعي، تتحرك الخوارزميات كذلك لتنبيه أصدقائنا (الافتراضيين) وتحدثهم على الإعجاب، التعليق والمشاركة وإعطائنا شعورًا وهميًّا بـ"الاعتراف الاجتماعي" الذي لا يتعدى حدودًا افتراضية أو محدودة زمانيًّا بالتفكير في وضع المزيد والمزيد من الصور. على سبيل المثال، يقوم منطق اشتغال منصة "يوتيوب" الشهيرة على عد نسب المشاهدات وتصنيف جودة المحتوى الهادف انطلاقًا من ارتفاع هذه النسب أو انخفاضها.
بمجرد البحث عن كلمة "موسيقى" -مثلًا-، يقدم الموقع بيانات حول الأغاني والمقاطع الأحدث والأعلى مشاهدة على المنصة، تعريفنا بالقنوات التي حصدت أكبر عدد من المشاهدات والمتابعات، المقاطع الأكثر مشاهدة في المجتمع الرقمي الذي ننتمي إليه… يصبح بناء الذوق الفني غير خاضع للانتماء الاجتماعي والطبقي (كما ذهب إلى ذلك سابقًا عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو) وإنما لمنطق الاختيار الجماعي؛ أي أن ما شاهده الآخرون بكثرة يصلح لكي أشاهده ما دمت جزءًا من هذا المجتمع الرقمي… هنا تكمن خطورة العبودية الرقمية الطواعية. إننا أمام أجهزة وبرمجيات تخاطب الجانب اللاشعوري والرغباتي الدفين في النفس الإنسانية، وتحوله إلى ورقة رابحة في أيدي المستشهرين والفاعلين في إنتاج قوانين السوق، وتجعل من حرية الاختيار فعلًا مبنيًّا وفقًا لما تراه هذه البرمجيات مناسبًا لنا وليس وفقًا لما نريده في حقيقة الأمر.
"غوغل" إمبراطورية تجارة المعلومات والبيانات الشخصية
يصف كتاب "ملف غوغل: كيف تنتهك الشركة الأمريكية البيانات وتتلاعب بالعالم وتدمر الوظائف"(2) (باللغة الألمانية) (Die Akte Google: Wie der US-Konzern Daten missbraucht, die Welt manipuliert und Jobs vernichtet) للباحثان تورستن فريكه وأولريش نوفاك، شركة غوغل بكونها "إمبراطورية" جديدة تهيمن على بيانات ومعلومات ملايين المستخدمين حول العالم. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يُمكن هذا الأخطبوط الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من بيانات حساسة وخاصة تنتهك مختلف أخلاقيات حماية المستخدمين. يحدث كل هذا دون أن تبذل الشركة أي جهد في تجميع أو استثمار هذه البيانات: يقدم المستخدمون بياناتهم طواعية وعن طيب خاطر ويدفع المستشهرون والحكومات ملايين الدولارات للحصول على هذه المعلومات!
نتحدث هنا عن إمبراطورية غوغل (غوغل، يوتيوب، غوغل كروم، جيمايل، أندرويد…) بوصفها "مهندس عالم الأنفوسفير" خلال العقدين الماضيين، لكونها رأت في الإنترنيت قوة الغد وفي البيانات عملة المستقبل. اختار محرك البحث غوغل تجميع البيانات والمعطيات الخاصة بالمستخدمين عوضًا عن جذب المستشهرين إلى الصفحة (كما هو الحال مع ياهو التي لم تستطع منافسة هذا العملاق). بالنسبة ليوتيوب، استطاع إقناع الشباب بأهمية مشاركة حياتهم اليومية على المنصة وجذب التفاعلات، المشاهدات والاشتراكات قصد الحصول على عائد مادي ولما لا مناشدة الثروة والشهرة (كما يحدث اليوم مع شباب ومغني "التراب" (trap) و"الريغيتون" (reggaeton) بمنطقة الكاريبي). إذا كانت غوغل قد بُنيت عبر المتاجرة ببيانات وخصوصيات العالمين، فإنها كذلك تنشر الفكرة القائلة: إن النجاح لا يرتبط بالحصول على الشواهد والدرجات العلمية أو الجهد والاجتهاد، بقدر ما يرتبط بالبحث عن "البوز" (Buzz)، صناعة المحتويات الترفيهية، زيادة حجم المتابعات والمشاهدات والخضوع لقوة "الذكاء الاصطناعي". قد تكون هذه الفكرة لها من المصداقية الشيء الكثير في عالم اليوم، إلا أن المشكل الحقيقي يكمن في غياب المرجعيات الأخلاقية والإنسانية التي تنظم تفاعل هذا الأخطبوط مع الأفراد.
بهذا المعنى، يصبح منطق صناعة النجومية هي الأخرى (خاصة على منصة يوتيوب) خاضعًا لسيرورات عمل الخوارزميات والذكاء الاصطناعي. يكفي أن تشارك خصوصياتك الحميمة وحياتك الشخصية لتكسب عطف ومشاهدة الناس وحتى تصبح مشهورًا؛ دون المرور من معابر الشرعية (الفنية والثقافية والاجتماعية) بالضرورة. نتيجة لكل ذلك، يظهر أن الذكاء الاصطناعي قد غير كثيرًا من خصوصياتنا الإنسانية وهو لا زال في مراحل تطوره الجنينية.. ماذا لو أصبح يملك وعيًا وتحكمًا في كل هذه البيانات؟
هل إنسانيتنا في خطر؟
يكمن جوهر القضية في ضرورة تحكم الإنسان في سيرورة هذا التطور؛ وقبل كل شيء تحكمه في تفاعله واستخدامه لهذا الذكاء الاصطناعي.
قصارى القول، إننا في حاجة إلى أخلاقيات ونظم قيمة تضبط تفاعلاتنا اليومية مع الذكاء الاصطناعي. لا يجب أن تقتصر هذه الأخلاقيات على المستوى الفردي والشخصي (كيف نتفاعل كأشخاص مع الأنفوسفير والذكاء الاصطناعي)، بل يجب أن تشمل المستوى المؤسساتي (كيف تتحكم الشركات الكبرى في حياتنا عبر الذكاء الاصطناعي) والمستوى السياسي (كيف تراقبنا حكوماتنا عبر الذكاء الاصطناعي). ليس المشكل في أن يتطور الذكاء الاصطناعي إلى مستوى يتجاوز الذكاءَ البشري (وإن كان قد دخل في هذه المرحلة) من عدمه، بل يكمن جوهر القضية في ضرورة تحكم الإنسان في سيرورة هذا التطور؛ وقبل كل شيء تحكمه في تفاعله واستخدامه لهذا الذكاء الاصطناعي، والرهان على حماية البيانات والخصوصية كمدخل أساس لتحقيق هذه المعادلة.
ما يثير الاستغراب هو أن بعض الدول قد بدأت تتحكم في مواطنيها من خلال الذكاء الاصطناعي وباسم القيم الديمقراطية: تُقيم الصين خضوع مواطنيها انطلاقًا من استعمالاتهم للإنترنت، تراقب ألمانيا بيانات وتفاعلات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحذف منها ما تراه غيرَ مناسب، دائمًا باسم قيم الديمقراطية والحد من العنصرية وحماية الآخرين. من الواضح أن مسار بناء "الدولة الأخلاقية" و"المواطن الأخلاقي" ما زال بعيد المنال في المجالات التداولية الغربية، فما بالك بسياقنا العربي، وقد لا يصبح سيناريو سلسلة أفلام المدمر (terminator) مجرد خيال.. ربما يتحول إلى حقيقة.. الجواب في قادم الأيام!
الهوامش
(1) لوتشيانو فلوريدي، الثورة الرابعة: كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيلَ الواقع الإنساني، ترجمة: لؤي عبد المجيد السيد، سلسلة عالم المعرفة العدد 452، سبتمبر 2017. (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت).
(2) تورستن فريكه وأولريش نوفاك، ملف غوغل، ترجمة: عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 450 يوليو 2017، (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت).