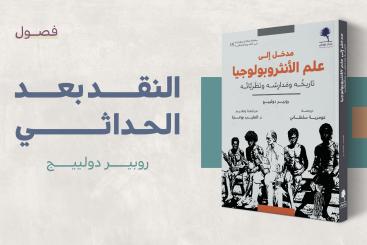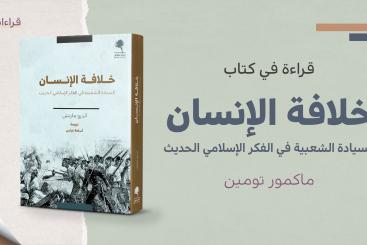الجدل حول العلمانية في السياق الإسلامي (3) البدائل الفلسفية

كما أشرت في المقالين السابقين (١، ٢) فإن الجدل حول العلمانية في العالم العربي استمر لعقود يدور في ثنائية أيديولوجية متضادة، ولم يتجاوز هذا السجال الفكري الحديث إلا مقاربات قليلة، استعرضنا اثنتين منهما على مستوى المنهج، وأشرنا إلى أنهما لم تبحثا في إيجاد البدائل وإنما اكتفتا بالنقد والتوصيف واستشراف الاحتمالات، ونعرض في هذا المقال أهم مقاربتين قدمت كل منهما رؤية فلسفية يمكن عدُّها طريقاً ثالثاً وسطاً تم التمهيد له بنقد طرفيه العلماني والإسلامي، على أنهما على ما بينهما من اختلاف ينطلقان من رؤية إسلامية مرجعياً ومفهومياً وبأدوات فلسفية، وأعني بهما مقاربتي طه عبد الرحمن (المغربي) وأبي يعرب المرزوقي (التونسي).
-١-
مقاربة طه عبد الرحمن للعلمانية صريحة ومباشرة أفرد لها كتابه "روح الدين: من ضَيق العلمانية إلى سعة الائتمانية – 2011م"، وكما هو شأنه في مختلف إنتاجه المعرفي ينحت المؤلف مصطلحاته الخاصة ويعللها، وهي في هذا المجال تبتدر القارئ من العنوان، فهي مقاربة روحية تنتسب إلى الدين تستخلص منه روحه التي تمثل بديلاً عن الرؤية العلمانية (التي تفصل بين الدين والسياسة) أو الرؤية الديانية (التي تصل الدين بالسياسة)، وهي -كما يصفها-مقاربة ذكرية غير نسيانية (ضد النسيان) لأنها "ذكر لما نسيه العلماني وعروج إلى ما قعد عنه الدِّياني"، وبهذا المعنى يصفها بأنه عمودية غير أفقية، لما فيها من استحضار للماضي الإنساني وليست لحظية تنكر تاريخ الإنسان وتكوينه ونشأته. و تتأسس المقاربة الطاهانية البديلة على القول بازدواج الوجود الإنساني، (جانب مرئي وجانب غيبي)، وبتوسل الغيبي من خلال الفطرة الروحية التي تنقل من خلالها كمالات العالم الغيبي.
ولتأصيل نظريته (الإئتمانية) يقدم نقداً نسقياً للرؤيتين العلمانية والديانية، ويبشر بنهاية التسيد العلماني (دعوى العلمانية) التي تقول بالفصل بين الدين والسياسة، وهو الخيار الذي يُضَيَّق الوجود الإنساني ويجزؤه إلى دوائر متضادة توهم الإنسان بأنه سيد نفسه، وأنه يمكنه الاستغناء بتدبيره عن تدبير خالقه، وتعبد ذاته، والمخرج من هذا الضيق هو التزكية الروحية التي تدفع مساوئ التسيد على الخلق بالخروج من التوسل بقوة السلطان إلى التوسل بقوة الوجدان.
أما الاتجاه المقابل (دعوى الديانية) التي تقول بالوصل بين الدين والسياسة بالتداخل دمجاً للدين بالسياسة من قبل السلطة، والذي أدى إلى تدبير للدين يخدم التسيد لا التعبد، أو دمجاً للسياسة في الدين من قبل الديانيين، والذي أدى إلى تبني المفاهيم العلمانية وآلياتها دفعا لتهمة التطرف أو لنيل السلطة دون القدرة على النقد العلمي والفلسفي للعلمانية، أو بالتداخل تماثلاً من خلال مبدأ الحاكمية لله، وحقيقة مجاله هي التدبير الروحي (الأمر الإلهي وشهوده) وليس التدبير السياسي كما توهم القائلون بالحاكمية، أو التماثل من خلال مبدأ ولاية الفقيه الذي بني على تصور صناعي للفقه يهتم بالجانب القانوني منه مع إهمال الأخلاقي الذي يؤسسه.
إن الائتماني يرى أن الدين ليس أحق بالصبغة الشرعية من السياسة، ولا السياسة أحق بالصبغة العقلية من الدين.
أما الحل البديل الذي يقترحه فهو (الدعوى الائتمانية) التي تقول بوحدة أصلية بين التعبد والتدبير سابقة على الفصل العلماني والفصل الدياني، فثمة اتصال بين التدبير والتعبد واتساع للوجود الإئتماني، لذلك هي –كما يصفها- مقاربة روحية لإشكال الصلة بين الدين والسياسة، وبناء لنموذج بديل من نظام الحياة القائم. وإذا كان العلماني ينزع الصبغة العقلية عن الدين ويخصها بالسياسة، والدياني يضفي الصبغة الشرعية على جزء من السياسة والصبغة العقلية على الجزء الآخر، فإن الائتماني يرى أن "الدين ليس أحق بالصبغة الشرعية من السياسة، ولا السياسة أحق بالصبغة العقلية من الدين"، ويقرر رتبة العقل الذي يضبط الظاهر أو العام (يشترك فيه العلماني والدياني)، ورتبة العقل الذي يضبط الباطن أو الخاص (يستقل بها الائتماني)، ويؤسس عقلانية الظاهر على عقلانية الباطن بحيث تستمد الأولى مشروعيتها المعرفية من الثانية.
كما يجعل الوجود على رتبتين الوجود الظاهر والوجود الباطن، ويجمع بين النسبة الخَلقية والنسبة الحقية (مختار في الظاهر مجبر في الباطن)، ويضيف أن هذا التصور أقرب للواقعية لربطه الإنسان بواقعه ظاهره وباطنه، ولأن الائتماني يتوسل الوصول لغايته بالتزكية العملية فهو أرسخ في العقلانية لأنه يعي حدود العقل المعهود فلا يتعداها كالعلماني أو يقابل بينها وبين الشرع كالدياني. فيخرج الائتماني بالتزكية من التسيد على الخلق إلى حب التعبد للحق مورِّثا إياه وازعاً داخلياً.
هذا التعبد للحق يقابل التسيد الذي يعيب العلماني والدياني، فالأول يتسيد بالوازع السلطاني الوضعي منازعاً السيادة الإلهية وينتحل كمال القوة في العالم الغيبي، والثاني يتملك بالأحكام الفقهية بادعاء الاستخلاف في الحكم على الخلق ويتشبه بكمال القوة فيه، فينقلب تسلطهما إلى استعباد لنفسهما.
يستشعر طه عبد الرحمن أن هذا البديل الإئتماني الذي يقترحه سيصدم لدى المتلقي بسؤالي العقلانية والواقعية، ويستبقهما بالإجابة التي تصادر الإشكال ابتداء فـ"العقلانية ليست هي الجمود على العقل، إنما التقلب في أطواره؛ والمتعقل الذي لا يغير عقله، فهو كَلَا متعقل؛ كما أن مقتضيات الواقعية تتغير بتغير التجربة الخارجية، بحيث ما كان يعد واقعياً، قد يصير غير واقعي؛ والعكس بالعكس"، فالمعنى الائتماني والخلق الإئتماني الذي يعتبر في الواقع غير معقول وغير واقعي على الوجه المعهود قد يصير في المستقبل كذلك، و"التحول الإيماني الجذري الذي يحدثه الائتمان في الإنسان، مطلقاً إمكاناته ومخرجاً مكنوناته، يجعله يجدد ممارسته للعقل، موسعاً نطاقه، ويجدد مكابدته للواقع، باسطاً فضاءه؛ بل إن الائتمان هو وسيلة الإنسان الى تجديد نفسه بالكلية على مقتضى الإيمان الحي".
إن هذا الجواب عن استشكال العقلانية والواقعية يحمل في طياته عمق الإشكال الذي يحاول طه عبد الرحمن الإجابة عليه، فنقد التسيدين العلماني والدياني إن أدى الإقرار بنفيهما والتسليم بالائتمانية، وكان ذلك مفهوماً على مستوى السلوك الفردي والمعرفي، فلمن يكون التسيد في الحياة العملية، هل يمكن أن تنتظم حياة المجتمع من غير سلطان، وهل من المسلَّم القول أن كل أشكال التسيد العلماني تنفي السيادة الإلهية وتنازع سلطان الغيب، وبالمقابل هل يستقيم حصر رؤية الدياني بالمرجعية الفقهية والتي ينفي عنها المؤلف البعد الأخلاقي، ويطابق أحياناً بينها وبين القول بالحاكمية أو ولاية الفقيه.
ثمة رؤية تحكمية في تصنيف العلماني والدياني لدى طه عبد الرحمن، ولا يفهم نقده الموجه إليهما إلا في الجانب المتطرف منهما، من جانب آخر فإن الرؤية الإئتمانية (الروحية) البديلة هي أقرب إلى رؤية صوفية عرفانية تصلح للسلوك الفردي، وإذ يبدو المؤلف متشككاً من تعقلها وواقعيتها لدى المتلقي، فإنه محق بذلك ما دام مصراً على تنافيها مع نظيريها، ويمكن القول أن الرؤية الائتمانية يمكن أن تشق طريقها إلى العقلانية والواقعية إذا تمكنت من التوسط في تعديل أنماط من الرؤيتين العلمانية والديانية، فالعلمانية علمانيات والديانية ديانيات، فالإئتمانية إجتراح نظري مبدع، وواقعيته وعقلانيته يمكن أن تتحق بما يتركه من أثر في تقريب الدياني والعلماني ليعدل كل منهما الآخر.
-٢-
لا يختلف أبو يعرب المرزوقي عن طه عبد الرحمن من حيث النأي بالنفس عن طرفي النزاع العلمانيين أو الديانيين (الأصلانيين – بتعبير المرزوقي)، ومن حيث انطلاقهما من رؤية فلسفية (نقداً وتأصيلاً)، واستنادهما إلى مرجعية إسلامية، وإن بدت في مقاربة طه عبد الرحمن أشد وضوحاً على مستوى المصطلحات خصوصاً وبالنزعة الصوفية الظاهرة، فإن مقاربة المرزوقي تستند إلى قراءة فلسفية للقرآن والتاريخ، وتُبنى على قراءة نسقية لتاريخ الفلسفة اليونانية والعربية والغربية، يؤسس عليها رؤية توحيدية مستقبلية ذات بعد إنساني.
علة الصراع بين العلمانية والدين متعينة تاريخياً في الأديان التي تنفي الحرية الروحية بالوساطة الكنسية والحرية السياسية بالحق الإلهي في الحكم.
لم يفرد المرزوقي كتاباً خاصاً في نقد العلمانية أو نقيضها، وإن أفرد لها بعض مقالاته، لكن مجمل ما كتبه يفيض برؤى نقدية واجتراح قراءة تعتمد "وحدة الفكرين الديني والفلسفي"، كما أفرد مقالات وأجزاء من كتبه في نقد وتعرية النخب (العلمانية أو الأصلانية) المتعالمة أو المتحالفة مع الاستبداد، وسألخص رؤيته من مختلف كتبه فيما يخص إشكالية العلمانية والإسلام، والتي يراها إشكالية زائفة أصلاً، إذ "الحكم بالإسلام والعلمانية كذبتان تؤسسان لاستبداد الأنظمة العربية بنوعيها وفسادها."، "فالعلمانية سواء من حيث سلم القيم أو من حيث نظام الحكم ليس فيها ما يمكن أن يعتبر منافيا للإسلام إذا فهم الأمران بمعنى حياد العلاج السياسي."، و"علة الصراع بين العلمانية والدين متعينة تاريخياً في الأديان التي تنفي الحرية الروحية بالوساطة الكنسية والحرية السياسية بالحق الإلهي في الحكم."، ودور الإنسان كما يحدده القرآن أنه مستعمر في الأرض وهو خليفة الله فيها، وكلاهما فرض عين لا وساطة فيه. فإلغاء الحريتين (الروحية والسياسية) ليس من الدين بل من تحريفه. وعليه "فهذه الإشكالية عديمة المعنى في الإسلام"، فثمة اعتراف بتعدد الشرائع في الدولة الإسلامية مما يعني حياد الدولة حتى وإن كان لأغلبيتها شريعة خاصة، فالقرآن يعتبر التعدد شرط التسابق في الخيرات.
ويركز المرزوقي في مواطن كثيرة من كتبه على جوهر الإسلام أو ما يسميه "ثورة الإسلام الروحية والسياسية"، فالرؤية الإسلامية تنفي الخطيئة الموروثة وتعترف بمنزلة الدنيا وتوليها منزلة شريفة، وتلتزم الدولة الحياد الديني وتعترف بحرية المعتقد، ويعتبر الإسلام التعدد الديني شرط التسابق في الخيرات. هذه الرؤية الكلية النظرية التي يفهم من خلالها المرزوقي الإسلام لا تعبر بالضرورة عن التاريخ الإسلامي الذي يرى أنه تأسست فيه خلال عصور الانحطاط كنسية مضاعفة: سلطان الفقهاء (الذين أخضعوه لنزوات الحكام- شبه حق إلهي)والمتصوفة(الذين أخضعوه لخرافة كرامة الأولياء – شبه وساطة روحية وثنية).
وفيما يبدو نقيضاً لرؤية طه عبد الرحمن يرى المرزوقي أن القرآن يرفض التقابل بين الظاهر والباطن لأنه النفاق، بل إن القرآن علاج لما يفرق بينهما فيكون متعالياً على المقابلة ذاتها، كما يقول بتلازم وجهي الوجود: الشهادة (الدنيا) والغيب (الآخرة)، وتلازم العلم والعمل فيهما كليهما، ويؤكد على جوهر الوجود الإنساني الفردي والجمعي: العمران البشري (الاستعمار في الأرض) والاجتماع الإنساني (الاستخلاف في الأرض)، وقيم الاستخلاف تسمو بالحياة الدنيا من أن تكون مجرد لهو لتصبح عبادة وشبه استعداد للسعادة الأخروية التي يكتمل فيها وجود الإنسان.
ويسعى المرزوقي في قراءته الفلسفية للقرآن إلى إثبات حقيقة أن القرآن الكريم فيه إستراتيجية ما بعد تاريخية، تحدد المبادئ العامة التي تحكم مجرى التاريخ الإنساني رغم كونها ليست تاريخية، وهدفها توحيد الأمة بداية، والإنسانية غاية، لتحقيق القيم الخلقية والروحية في التاريخ الفعلي، أو للبلوغ بالاستخلاف إلى غايته شرطاً لفهم حديث الختم والكونية الإسلاميتين. كما يسعى لاكتشاف المبادئ العامة التي تُرد إليها إستراتيجية القرآن التوحيدية.
فالمعادلة الوجودية في الإسلام -من منظور المرزوقي- لا تعترف بالحدود الجغرافية والسياسية لأن البشرية واحدة والعالم واحد وأحداث الطبيعة والتاريخ متفاعلة، ويرى أن المسلمين الآن في طور النقلة الجامعة التي يحققها الاستئناف لتجعلنا أكثر أمم العالم كونية حتى يتحقق التطابق بين وجود الأمة وصورتها عن ذاتها في مرجعيتها القرآنية.
إن نقد المرزوقي لثنائية الدين والعلمانية يستند إلى فكرة مركزية هي تصور الدين خصماً للحرية الروحية والسياسية، وإذ أثبت أن جوهر الإسلام هو إثبات هاتين الحريتين فالإشكالية زائفة، مع تأكيده مشروعية الإشكالية في غير الإسلام، وأن الاصلاح الديني الغربي حل الإشكال من خلال الاستئناس بجوهر الإسلام.
نظرياً يبدو الجواب بسيطاً ومفهوماً، لقضية كلية مركزية، لكن الإشكال في فروعه الجزئية وآثاره، فالحرية الروحية والسياسية قد تؤول فيها اختيارات الناس إلى نقيض تلك الرؤية الكلية الإسلامية، وهل يمكن الجمع بين هذه القراءة الفلسفية للقرآن والقراءة التشريعية التي تحد من إطلاق الحريتين، يمكن للقارئ أن يجد إجابات على جوانب من هذه التساؤلات في كتابات أبي يعرب، لكن سؤالاً مركزياً لا يزال موضع إشكال في هذه المقاربة وهو سؤال التشريع، ففي الوقت الذي ينتقد فيه ابو يعرب أصول الفقه ومقاصد الشريعة ومقاربات الفقهاء لحل القضايا الإشكالية لاسيما المعاصر منها، يصرُّ على مرجعية القرآن والسنة والإجماع دون أن يقدم منهجية بديلة في فهمهما على مستوى أفعال المكلفين والتشريعات، فالإشكال ليس في القراءة الفلسفية التي أبدع فيها إنما في مجال التشريع وتأويله والذي يتصارع فيه الإسلاميون والعلمانيون.
-٣-
لقد أبرز تفي المقالات الثلاثة: المستجدات التي تقتضي إعادة النقاش حول العلمانية في السياق الإسلامي، ونموذجاً لحيوية النقاش والاختلاف حول العلمانية في الغرب، كما أوضحت مظاهر التحول من السجال الأيديولوجي إلى مقاربات تاريخية ومنهجية ومفهومية، ومحاولات اجتراح بدائل فلسفية، وختاماً لما سبق يمكن تلخيص بعض الملاحظات والأسس التي أراها مركزية وينبغي الوعي بها في أية مقاربات تتابع النقاش حول العلمانية في السياق الإسلامي:
العلمانية مفهوم إشكالي في السياق الغربي والإسلامي على حد سواء، والبحث فيها ينبغي أن يتجاوز القوالب النمطية لمفهومها.
لا تلازم بين العلمانية والعلمنة وبين الحداثة والتحديث، بل يمكن أن يكون العكس، بأن تكون الدولة حديثة ومتدينة أو علمانية ومتخلفة.
رغم أن الجدل تاريخياً بين الإسلام وخصومه كان يقوده علماء الدين سواء فلسفياً أو دينياً، إلا أن المقاربة الإسلامية الحديثة للعلمانية كانت سجالية، ولم تقدم بدائل لها، واقتصرت المقاربات النقدية على الحقول الفلسفية، وما يزال جهد علماء الدين في نقد العلمانية أقرب إلى ردود الأفعال.
رغم تحولات الأحزاب الإسلامية في الممارسة السياسية، وقبولها بسقف الدولة الوطنية واللعبة الديمقراطية، إلا أن مقاربتها لمسألة العلمانية لا تزال ملتبسة وغير واضحة، وتخضع لخطاب تلفيقي لا يستجيب لعمق الأسئلة.
إن علمية مقاربة العلمانية تقتضي تجاوز الاستلاب للداخل أو الخارج، وتجاوز ضيق الأحكام إلى سعة الدين.
مناقشة موقف الدين الإسلامي من العلمانية لا تكفي فيه الرؤية الفلسفية الكلية للإنسان والوجود، ولا بيان التمايز المؤسسي بين الدين والدولة، فالإشكال بالنسبة للإسلام إشكال عملي يرتبط بقضايا المرجعية والتشريع، والقيم والسياسة، والفضاء العام والمشترك، والأخلاق والحريات، ولم تقدم المقاربات (المنهجية أو الفلسفية) التي أشرت إليها جواباً لهذا الإشكال، فيما كانت الدراسات الأخرى تصطدم بإشكال القول بالتاريخية للنص أو الأحكام. إن علمية مقاربة العلمانية تقتضي تجاوز الاستلاب للداخل أو الخارج، وتجاوز ضيق الأحكام إلى سعة الدين، وألا تقوم على ردة الفعل، ولا يمكن لرؤية فلسفية أن تحل الإشكال من غير فهم أسئلة الفكر الديني والعكس.
أخيراً.. يمكن القول إن اللحظة الراهنة في الفكر الإسلامي تجاوزت مرحلة السجالات إلى مرحلة المراجعات، ولا ينتظر منها أن تقدم إجابات حاسمة وسريعة لقضايا إشكالية معمرة، والحل إسلامياً مرهون بعنصرين، نظري يرتبط بعمق الاجتهاد والنظر المعرفي أولاً، وضمن حقل الدراسات الإسلامية تحديداً، وفي نجاح الممارسات العملية على المستوى الاجتماعي والسياسي وفي إدارة الشأن العام مع المخالفين ثانياً، على أن الجدل الفكري سيظل بالنسبة للكثيرين نوعاً من الترف في ظل غياب العدالة في المجتمعات الإسلامية، وسيطرة الظلم والاستبداد، ولجوء الناس إلى الدين بصورته الموروثة بحثاً عن الطمأنينة.