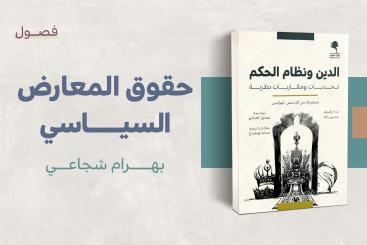النقاشات الدينية والفكرية في الحالة العربية: مداخل للفهم والمقاربة

يعرف المشهدُ الثقافي العربي والإسلامي بين الفينة والأخرى بروزَ مجموعة من القضايا الدينية والفكرية، التي تثير نقاشًا حادًّا ومواقف متباينة بين مكونات المجتمع الثقافية والسياسية والدينية، فتكرّس نوعًا من الانقسام الثقافي والسياسي على مستوى النخب الثقافية والدينية والسياسية. هذه القضايا من قَبيل: حقوق المرأة، واللباس الشرعي، والتنصير، والحريات الفردية، وحرية المعتقد، والحرية الجنسية، والميولات الجنسية المختلفة، والعلمانية، والمواطنة، والتعددية، وحدود الفن والأخلاق...
والنقاش والجدل الفكري مؤشر على دينامية المجتمع؛ بما أنه سبيلٌ إلى خَلق حركية ثقافية تستوعب الأسئلة والتحديات التي تواجه أي مجتمع؛ لكن في الحالة العربية نلاحظ أن النقاش الفقهي والفكري يؤدي إلى نقيض المقصود: الانقسام بدل الالتحام، والنكوص بدل النهوض، والسبب هو خلو هذا النقاش- إلا فيما ندر- من الحس النقدي؛ لأن كلّ طرف يتعامل مع اختياراته التاريخية الزمنية بنوع من الإطلاقية دون إخضاعها للمساءلة المعرفية.
هذا النقاش سيكون مفيدًا لمَّا يتحول من نقاشات جزئية وظرفية إلى مناقشة الأطر الفكرية والمعرفية التي من خلالها تُصاغ المقاربات؛ لأن ما نراه من نقاشات بهذا الصّدد هي نتيجة "صراع" بين مرجعيات فكرية مستبطَنَة؛ فكلّ موقف يستبطن مرجعيةً معينة ويتخفى وراء تفاصيل النقاش، ومن هنا ضرورة التوجّه شطرَ "ما ورائيات" النقاش، والنفاذ إلى طبيعة هذه المرجعيات والنماذج المُولّدة من رَحِمها، واستخراج الرؤى الكامنة وراء كل موقف، وكذا النظر في مدى قدرتها على تفسير وتحليل التحولات التي تحدث في المجتمع. والمرجعية التي أعنيها هنا هي مجموع الإجابات النظرية التي يقدمها الفرد أو الجماعة على الأسئلة المرتبطة بالوجود والعالَم والإنسان.
وأعتقد أن هذا النقاش في الحالة العربية بشكل عام ليس نتيجةَ تعدد النماذج والمقاربات فقط، إنما هو أيضًا نتيجة تعدد المرجعيات؛ تعدد (مسكوت عنه) يتخفى وراء تعدد النماذج والمقاربات. وبالتالي فإن المدخل المعرفي الذي يعمق النظر في طبيعة المرجعية الفكرية التي تصدر عنها جملة المواقف يُعتبر مدخلًا أساسيًّا لفهم واستيعاب مجمل الجدالات الفكرية التي يعرفها الواقع الثقافي العربي.
فعندما يغيب النقاش على مستوى طبيعة المرجعيات المعتمَدة في المقاربات المختلفة فإن كل واحد يمكن أن يحدد المفاهيم كما يريد. خذ مثلًا: نجد من المثقفين العرب من يعلق على فتوى معينة أو حكم وموقف شرعي معين بكونه يناقض العقل والمنطق!
والتساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الصدد هو: عن أي عقل وعن أي منطق نتحدث؟ ما الذي يجعل قراءتك عقلانية ومنطقية وقراءة غيرك بعيدة عن العقلانية والمنطقية؟!
إن إعمال العقل والمنطق يقتضي هنا أن ننظر في مدى اتساق الآراء الدينية والمواقف الشرعية والفتاوى الفقهية مع طبيعة المرجعية المعتمدة؛ فإذا كان الدين عند البعض لا يدخل أصلًا ضمن دائرة العقل والمنطق فطبيعي أن تكون الفتاوى والآراء الوفية للمرجعية الدينية مناقضةً للعقل والمنطق! إذن لابد ابتداءً من تحديد طبيعة المرجعية؛ فهو السبيل لتفادي السقوط في محاولة فرض نظرة معينة لمفهوم العقل والمنطق. وفي نفس الإطار يمكن إدراج مَن يعتمد ثنائية: "مرجعية سلفية" و"مرجعية حداثية" نماذجَ لفهم وتفسير هذا النقاش!
إن هذا التصنيف يوهم بأن المرجعية الأولى مرجعية تاريخية تراثية والثانية مرجعية عقلانية ومُواكِبة للعصر! وهذا الأمر ليس صحيحًا بالمرّة؛ فقد نكون أمام سَلفيات كثيرة: سلفية تبني نموذجها من التاريخ الإسلامي، وأخرى تستلهمه من التاريخ الغربي، وثالثة تؤسسه بالمزج بين تواريخ ثقافية وحضارية مختلفة. رغم أن المدخل السليم يقتضي تحديد بدقة طبيعة المرجعية المعتمدة، ثم النظر في الاتساق بينها وبين الآراء المولّدة من رحمها.
سأورد بشكل مركز بعض الإشارات التي أحسب أنها مهمة في عملية فهم ومقاربة النقاش الفقهي والديني والفكري في الحالة العربية؛ وهي إشارات تخص بدرجة أولى الطرفين البارزين في ساحة النقاش؛ أقصد الطرفَ الذي ينطلق من المرجعية الإسلامية باعتبارها مصدرًا لتأطير المجتمع والحياة، والطرف الثاني الذي يرى الدين شأنًا خاصًّا، ويعتمد مرجعيات أرضية للتعاطي مع قضايا المجتمع:
أولًا: تتصورُ جُلّ الكتابات المنتقدة لبعض الفتاوى الصادرة في منابر إعلامية عربية الفتوى وكأنها "وصفة" تكتسي طابع الإلزامية، رغم أن علماء أصول الفقه عرّفوا الفتوى بأنها إخبار عن حكم شرعي من غير إلزام. إذن لابد من تحديد ماهية "الفتوى" حتى يستقيم النقاش.
ثانيًا: يستبطن الطرف الثاني رؤيةً لدور العالِم يتم حصره في عملية الإطفاء؛ أي إطفاء نيران التطرف والإرهاب... أما أن يقوم العالم بدوره في تجديد الرؤية، والقيم... والإجابة على التحديات المعاصرة سواء فقهيًّا أو معرفيًّا خاصة فيما يتعلق بالمعاملات، أو مناقشة القضايا التي يحبل منها الواقع... فإنه بهذا يكون قد خرج من مهمته الإطفائية ودخل في مهمة تأسيسية. فنعم للإطفاء ولا للتأسيس!
ثالثًا: كرست مؤسسة العلماء والمؤسسات الدينية العربية- بشكل عام- "ظاهرة" الانسحاب من الواقع والتفاعل مع إشكالاته الفكرية الكبرى، فمَارَسَ العالِمُ على نفسه نوعًا من الرقابة الذاتية؛ فما الذي يمنع العلماء مثلًا من مناقشة الأفكار التي تنتقل بسرعة قياسية إلى العالم الإسلامي؟ ما الذي يمنعهم من مناقشة العلمانية؟ والمواطنة؟ والفن؟ والحرية؟ والردة؟... مناقشةً معرفيةً وفكرية؟
عندما انسحبت مؤسسة العلماء من القيام بهذا الدور فإن آخرين شغلوه؛ لأن المجتمع يسأل عن أقضيته، والتي غالبًا ما تكون فقهية؛ فهو يريد أن يميز الحلال من الحرام حتى يستقيم تدينه فيلقى الله تعالى على ذلك. من الطبيعي إذن أن تتولى جهة ما ملأ هذا الفراغ، خاصة أن إقبال غالبية المسلمين على المواقع والفضائيات الدينية هو في الدرجة الأولى بدافع طلب الفتوى والحكم الشرعي.
والمطلوب هو عودة العالم إلى دوره الطبيعي ومشاركة غيره من العلماء في التخصصات المختلفة في نقاشات المجتمع، حتى يتم بناء رؤية للواقع من زوايا مختلفة، وتمكين المجتمع بنخبه ومكوناته من امتلاك تقدير دقيق للواقع وإشكالاته.
رابعًا: الفتاوى عبارة عن أسئلة تخص حالات فردية؛ فالفرد المستفتي يتوجه إلى المفتي ليقدم له الفتوى بناءً على سؤاله، وقد يكون المستفتي دقيقًا في التعبير عن سؤاله وقد لا يكون... وبالتالي فإن عدم الدقة في التعبير عن النازلة قد يجعل الفتوى بعيدة عن الصواب. ثم إن الذين يقرءون هذه الفتاوى، المنشورة على صفحات الجرائد والمواقع، قد يقيسون حالتهم على حالات أخرى، وهنا المشكلة. والحل الأقرب للصواب هو أن تتولى هذه المهمة مؤسسات اجتهادية جماعية تحظى بالإجماع الوطني.
خامسًا: إن عناية الحركة الإسلامية و"أجهزتها الدينية" بمسألة الفتاوى والتعبير عن آرائها في الدين نابعٌ من نظرتها التاريخية إلى نفسها، والتي فيها نوع من التماهي بين روح وفلسفة الإسلام للحياة وبين اختياراتها، كما أن من مبررات ولادة الحركة الإسلامية سعيها لأن تكون بديلًا للدول القائمة ومؤسساتها؛ أي أن تصبح إطارًا مرجعيًّا شاملًا للمجتمع خاصة من الناحية الدينية والفقهية، وأن تشكل ثورة على البنيات المجتمعية القائمة، وأن تخلق للمجتمع ولاءات جديدة بديلًا عن الولاءات القائمة. ولم يكن مطروحًا من قبل- بشكل عام- خيار تفعيل المؤسسات الدينية والعلمية القُطرية التاريخية. ومضت الحركات الإسلامية في هذا الاتجاه ولو أن قسمًا كبيرًا منها قد عرف مراجعات على مستوى تغيير نظرتها إلى دورها التاريخي. ومن هنا أصبحت عناية الحركة الإسلامية بالفتاوى والآراء الدينية مصبوغة؛ شكلًا ومضمونًا برؤيتها التاريخية ونظرتها إلى نفسها.
سادسًا: ليست المشكلة في بناء الآراء الدينية وتقديم الفتاوى للناس، إنما المشكلة في افتقارها إلى أرضية فكرية صلبة؛ والحال أن الحركة الإسلامية العربية مقصرة في تأسيس تقاليد من البحث العلمي بإنشاء مراكز للدراسات والأبحاث تكون متفرغة وقادرة على خلق التراكم المعرفي، وتتميز بنوع من الاستقلالية. إن معظم الآراء التي تتبناها الحركة الإسلامية والمتعلقة بقضايا فكرية، لا تستند إلى عمل فكري مؤسساتي إنما هي آراء فردية تنقصها الدقة. خذوا مثلًا إشكالية العلمانية فلسفةً وممارسةً، فإلى حد الآن لا نتوفر حسب معرفتي على أعمال فكرية كثيرة يستند أصحابها إلى الرؤية الإسلامية تكون دقيقة وثقيلة في المقاربة، لكن في المقابل نجد أن هناك تضخمًا بخصوص المواقف من العلمانية! وقس على ذلك مفاهيم وإشكالات أخرى. ويتم التعامل مع هذه المفاهيم والإشكالات وكأنها قد استوت على سوقها المعرفي والعلمي ولا تحتاج إلى نظر واجتهاد.
كانت تلكم بعض المداخل والإشارات التي نحسب أنها قادرة على فهم ومقاربة مختلف النقاشات الفكرية والدينية التي يعرفها الحقل الثقافي العربي، وهي في مجملها نقاشات تتعلق بقيم ومرجعية المجتمعات العربية والإسلامية.