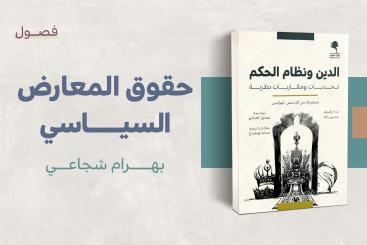الإسلام خارج الحكم الشرعي: العلماني الإسلامي

مقدمة المترجم (۱)
تشبه الكتابةُ في موضوع العلمانية والإسلام السَّيْرَ في حقل ألغام، ومن ثَمَّ تحتاج إلى دقَّة وحيطة وحذر، وإلى جسارة وشجاعة واعتداد بالأدوات المنهجية اللازمة، إلَّا أن هذا ليس بعاصمٍ من سوء الفهم أو الالتباس أو القراءة الخاطئة، لأسباب لا تعود إلى وضوح غاية المؤلف وحججه من عدمه، بل تعود إلى تباين وَقْع المصطلحات والمفاهيم والنماذج على القارئ باختلاف سياقاته. ومن ثَمَّ فالكلام في مجال العلمانية والإسلام تحفُّه خطابات عديدة تفرضها ثنائيات وخلافات مُكرَّسة، ناهيك عن الاستخدامات المختلفة بين الأكاديميات المتخصِّصة والمناقشات السياسية والثقافية والاجتماعية، فتكتسب المفردات المستخدمة معانيها الخاصة في كل سياقٍ بشكل مستقل ومتداخل في آن معًا، فليست هي واحدة عند الحداثيين العرب، ولا الحركات الإسلامية المعاصرة، ولا هي بالضرورة نفسها عند دارسي الإسلام من أكاديميِّي الغرب.
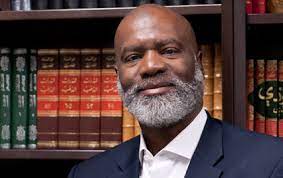
شيرمان جاكسون
والطرح الذي يقدِّمه شيرمان جاكسون في هذه الورقة إنما يسعى إلى تقديم رؤية جديدة في الأطروحة النظرية للعلاقة بين المجال العلماني والإسلام، أو بالأحرى للمجال العلماني في الإسلام. وفي سعيه هذا يتجاوز الكثير من الخطابات الأيديولوجية التي ينصبُّ اهتمامها على العلمانية بوصفها مذهبًا سياسيًّا وقالبًا فكريًّا جاهزًا للعلاقة بين الدين والدولة أو الدين والمجال العام، التي انحصر فيها الفكر العربي طويلًا مكررًا أسئلة من قبيل: هل نقبل العلمانية أم نرفضها؟ ننقدها أم نؤولها(۲)؟
وهو لا يُعنَى بالعلمانية مذهبًا سياسيًّا ولا «نموذجًا معرفيًّا»، وإنما بالعلماني تصنيفًا معرفيًا ومجالًا للتمايُز يقصد به «مجالات السعي التي تكون ماهيتها ومادتها وأدواتها مستقلة عن الخطاب الإلهي الشرعي»(۳). وفي تركيزه على العلماني إنما يستثمر معناه باعتباره «مقولة مركزية حديثة (لاهوتية-فلسفية، وقانونية-سياسية، وثقافية-أنثروبولوجية)، تسعى إلى تأسيس وتنسيق وفهم وتجربة واقع مغاير للديني»(٤) (والمغاير للشرعي في رأي جاكسون في هذه الورقة)، وهذا الاستثمار له تناصٌّ مع كتابات تشارلز تايلور وعمله عصر علماني، وطلال أسد وكتابه تشكُّلات العلماني في المسيحية والحداثة والإسلام، وخوسيه كازانوفا وورقته المعنوَنة «العلماني والعلمانيات» وكتابه الأديان العامة في العصر الحديث(٥)، التي أُحيل إليها في الورقة وتوفر سياقًا مناسبًا لتأطيرها.
وفي طرْح جاكسون في هذه الورقة تحدٍّ لتعميم التجربة الأوروبية على غير الأوروبي التي باتت تحدِّد ما هو ديني وما هو علماني وما بينهما، فلِمَ يبقى المشتغل بالإسلاميات -مسلمًا كان أو غير مسلم- في موقع المتحيِّر الذي لا يقدر على الحوار في حدود التشريع في حضارة الإسلام؟ أو المتطرف الذي يرى الشرعَ مُلِمًّا بكل الموضوعات، مع أن هذا خطأ واضح(٦)؟ والإسلام الذي يعنيه جاكسون في كلمة «العلماني الإسلامي» هو مجال العمل خارج حدود الشريعة الذي يظل مستحضرًا في فكره وتصوراته وسلوكياته نظرة الله المراقِبة له(۷).
هذه النظرة الإلهية الشاملة تجعل من العسير والمستحيل تصوُّرَ حياةٍ تُعاش «كما لو أن الإله غير موجود»؛ ولذلك فإن جاكسون يحاول في البداية تمييز العلماني في الإسلام عن التجربة الغربية، ثم يحاول تمييز دائرتَيْن مختلفتَيْن: دائرة «الشرعي» ودائرة «الديني»، فليس كل ديني شرعيًّا (بمعنى الخطاب الشرعي الصريح)، وليس الحل استبدال العلاقة الوجدانية بين العبد وربه في استحضار معية الله وطلب رضاه في كل أعماله (ما نص عليها الشرع وما لم ينص) بتوسيع مفهوم الشريعة ليشمل كل موضوعات الحياة المعيشة.
ويتراوح جاكسون في طرحه بين دارس الإسلاميات المستكشف للمجال العلماني في الخبرة التاريخية الإسلامية العملية والفقهية والكلامية، وبين صاحب الطرح المدافع عن صلاحية اعتماد فكرة «العلماني الإسلامي» في مقابل محاولات الإصلاح والاجتهاد الحالية التي تسعى إلى معالجة مأزق المسلمين في العالم الحديث، سواء بتوسيع مفهوم الشريعة أو بالتأكيد على مفهوم الاجتهاد وتوسيعه، والتي يحاورها في أكثر من مناسبة. ومن المزالق التي يحذّر منها جاكسون تحميل الإسلام مسؤولية أمور لم يأتِ خطاب الشارع لمخاطبتها مباشرة، وأن يُدخل في أفق التقاليد الإسلامية والفقهية ما ليس منها من تقاليد كانت مجرَّد اجتهادات «علمانية» تاريخية للعلماء في مواجهة مستجدات عصرهم.
لن تكون لهذه الورقة أهمية إلَّا بقدر ما تتجاوز قراءتها التحيزات والتصنيفات المسبقة، فلا بدَّ أن تُثير جدَّةُ طرحها مواطنَ خلاف، سواء في فكرتها الكلية أو بنيانها التفصيلي، لكن رهاني أن الأسئلة التي تثيرها ستكون مختلفة عمَّا اعتدناه، لتستكمل ما بدأه آخرون في ضخِّ دماء جديدة في مقاربة هذه الموضوعات الإشكالية ورؤيتها ومناقشتها.
أما الترجمة فقد سعيت إلى أن تكون سهلة ومُعينة للقارئ في قراءته ومناقشته لأفكار الورقة، وحرصت على العودة في الاقتباسات إلى المصادر الأصلية، وإلى ترجماتها العربية حال توفرها، وهي التي أثبتها، أما في النصوص التراثية فقد عدت إلى مواضع الإحالة وأضفت في الهامش ما استلزمه السياق.
وأخيرًا، أشكر الصديقَيْن عمر عبد الغفار وعمر عبد القادر على مناقشاتهما الثريَّة.
والله من وراء القصد.
عمر عبد الرازق شاهين
ملخّص
من الشائع القول بأن ثمة صدامًا متأصلًا بين ماهية مقولة «الدين» ومقولة «العلماني» على أساس رفض الدين المبدئي للفصل بين المقدَّس والدنيوي، ويُقال أيضًا إن هذا الصدام يبلغ ذروته مع الإسلام. لكن عندما نقول إن الإسلام يرفض ثنائية المقدَّس والدنيوي، فربما تنفتح طرق أخرى لتعريف العلماني في الإسلام والتفكير في علاقته مع الدين. وهو ما تنبري له هذه الورقة، التي تأخذ الشريعة نقطة انطلاقٍ لها، فتنظر إلى حدودها التي قررتها لنفسها باعتبارها الحدَّ بين نسق تقييم الفعل الإنساني القائم على نصوص الوحي المكتملة (أو امتداداتها) ونسق تقييم الفعل الإنساني المستقل عن هذه النصوص، ولكنه ليس بالضرورة خارج حساب الله.
إن واقع «غير الشرعي» هذا -إن جاز التعبير- هو واقع «العلماني الإسلامي»، هو «علماني» بقدر ما هو متمايز عن الشريعة في أساس تقييم الفعل الإنساني، ومع ذلك يظل «إسلاميًّا» ومن ثَمَّ «دينيًّا» في رفضه فكرة التصرف وَفْقَ مقولة «كما لو أن الإله غير موجود». كما سأبيّن أن التفرقة بين الشرعي وغير الشرعي لها أصولها الراسخة في التقليد الفقهي (والكلامي) الإسلامي. ومن ثَمَّ فإننا أقرب إلى التنقيب عن مقولة العلماني الإسلامي من اختراعنا إياها.
مقدمة
ما يزال مصطلح العلماني يشير عادةً إلى علاقة عدائية مع الدين(۸)، وبالرغم من تنبُّه عدَّة إسهامات معاصرة للالتباس المفهومي الذي يحدثه، فقد اكتسب هذه الدلالةَ الشائعة كونه منتجًا للحداثة الغربية الناشئة أو مشاركًا في نشأتها(۹). ودائما ما تُجرد هذه العلاقة العدائية مع الدين من سياقها الغربي، وتُقحَم فيها جميع الأديان في العالم، لا سيما في العالم الحديث (أو يُفترض أن العلاقة يجب أن تكون كذلك). وبالضرورة كما يشير خوسيه كازانوفا (José Casanova): «لم تكن الأديان التي لطالما حملت توجهًا ’دنيويًّا‘ و’عاديًّا‘ بحاجة للخضوع لعملية العلمنة. فأن تُعلمِن يعني أن ’تُدَنْيِن‘ (تجعله دنيويًّا) … وهي عملية لا معنى لها في سياقات حضارية كهذه»(۱۰).
لكن هذه الإسهامات -بالرغم مما فيها من بصيرة- لا تعد بالكثير عندما يكون الموضوع هو الإسلام، فيُفترض أن العداء بين «العلماني» و«الديني» يبلغ ذروته في الإسلام بالرغم من دنيويته؛ إذ يُفهم الإسلام على أنه يتحدى التمييز بين المقدَّس والدنيوي، ويبدو أن الحركات الإسلامية الحديثة مُصمّمة على رفض الحدود بين الديني والعلماني وتركها مفتوحة لتُحكّم فيها الديني. ونتيجة ذلك هي تأسيس ثنائية بين «الإسلامي» و«العلماني»، ينبغي بموجبها وصف الفعل أو الفكرة أو المؤسسة بأنها إسلامية أو علمانية، ولكن يستحيل جمع الاثنين معًا، وهو ما رسّخ في أذهان الكثيرين ضرورة الاختيار بين الاثنين.
سأقترح في هذه الورقة قراءةً للإسلام تقدّم فهمًا مغايرًا لعلاقته مع العلماني. هذه العلاقة تكشفها وتيسرها قراءة متمعّنة للشريعة التي تفترض وضع الحدود الفقهية على هذه العلاقة، وبذلك تتحدى فكرة أن حدود الشريعة هي نفسها حدود الإسلام بوصفه دينًا. إن هذه العلاقة في جوهرها هي المساحة بين الشريعة المحدودة باعتبارها مدونة محددة للسلوك، ومجال الإسلام غير المحدود باعتباره دينًا أو فلنقل حياة تستحضر معيَّة الله ومراقبته. وهذه المساحة هي ما يؤسّس للمجال «العلماني الإسلامي». يظل هذا النطاق علمانيًّا بقدر ما هو متمايز، باصطلاح ماكس فيبر (Max Weber)، بمعنى ألَّا حكم ولا قرار فيه لنصوص الوحي الواضحة ولا امتداداته المعتبرة في أصول الفقه الإسلامي.
العلماني الإسلامي ليس مفروضًا على الإسلام (ولا الشريعة) من الخارج، بل منبثق نتيجة الحدود الفقهية التي فرضتها الشريعة على نفسها طواعيةً.
ويظل إسلاميًّا كذلك ما دام محصنًا ضد الدافع الذي عبّر عنه هوغو غروشيوس (Hugo Grotius) لأول مرة في القرن السابع عشر بأن نعيش «كما لو أن الإله غير موجود»(etsi Deus non daretur)(١١). وفي هذه القراءة، لا يكون العلماني والديني -مع اختلاطهما وتمايزهما عن بعضهما بعضًا- أندادًا متخاصمين كما في العلمانية الغربية. كما لا يكون العلماني علمانيًّا لقدرته على الرقابة على الدين أو تدجينه إياه، ولا يتخذ منها قيمته. فالعلماني الإسلامي ليس مفروضًا على الإسلام (ولا الشريعة) من الخارج، بل منبثق نتيجة الحدود الفقهية التي فرضتها الشريعة على نفسها طواعيةً.
تلزم عن هذه القراءة لوازم وتحديات سأشتبك مع أبرزها خلال مناقشتي. لكن قبل ذلك، وتفاديًا للالتباس، أوضح طبيعة التداخل بين العلماني الإسلامي والعلماني الغربي ودرجة التباين بينهما. وهو ما يقربنا من إدراك أهمية أطروحتي. وذلك أن أهم الفوارق المؤثرة بين العلماني الغربي والإسلامي لا تكْمُن في جوهرهما، بل في وظيفتهما. ويرجع هذا الاختلاف إلى الوقائع التاريخية المختلفة التي واجهتها المسيحية (الغربية) والإسلام، بالإضافة إلى اختلافهما في الروح والبنية. ويُشار هنا إلى التحديات السياسية الدينية التي انعكست خلال «حرب الثلاثين عامًا» Thirty Years War ١٦١٨-١٦٤٨م (١٢).
فوفقًا لجوناثان إسرائيل (Jonathan Israel)، فقد ولَّدت الحرب كذلك ظهور فصيل من المتمردين والجمهوريين الذين تصوروا أنه «قد يكون هناك منطق فلسفي وعلماني تمامًا لتفكيك سلطة الإكليروس (وتعزيز) حرية الفكر واستقلالية الضمير الفردي»(۱۳)، وكانت تلك بداية بواكير عصر التنوير (Early Enlightenment)، وفي القلب منه كان نقاش لاهوتي، وشبح الانقلاب على «كل أشكال السلطة والتقاليد، بما في ذلك الكتاب المقدَّس ورؤية الإنسان اللاهوتية في جوهرها للكون»(۱٤).
وقد تنامى شعور يوميّ بالأزمة قبل ذلك، فكان أحد الدوافع الكبيرة وراء ظهور العلماني الغربي -بحسب نومي ستولزنبرغ (Nomi Stolzenberg)- يتمثَّل في «قبول حتمية تدنس القانون الإلهي ومُثُل العدالة المقدَّسة في ’العالم الزمني‘»(۱٥). وهو ما ولّد مخاوف من احتمال إفساد الدين ومؤسساته وتقويض سلطانه عبر التطبيع مع هذا الدنس. وكانت ردة الفعل -لا سيما من البروتستانتية- هي إنشاء واقعٍ بديلٍ تحكمه قِيمٌ وسلطاتٌ واختصاصاتٌ غير دينية لا يضير الدين ومؤسساته ولا يفسدهما الاستهزاء بها أو تسفيهها. ولم يكن هذا مجرَّد ضرب من ممارسة الانكفاء على الدين أو إزاحة المؤسسات، فقد كان هناك اهتمام حقيقيٌّ بالحاجات العملية والتطلعات اليومية. وكما يُلخص شيلدون وولين (Sheldon Wolin) مخاوفَ مارتن لوثر (Martin Luther) بقوله: «سيستحيل العالم فوضى إذا حاول الرجالُ حكمَه بالإنجيل»(۱٦). إذن، فقد نشأ العلماني الغربي في البداية لحماية الدين والمجتمع. ولا يلزم عن هذا أن طريقة العلمانية في العمل بعد ذلك كانت تطبيقًا لجوهرها أو عودة إلى أصولها.
في المقابل، لم يستنسخ تاريخُ الإسلام قبل الحديث تجربةَ «حرب الثلاثين عامًا» على أي صعيد، ولا حتى الصراع العثماني الصفوي الذي لم يكن له النبرة الدينية نفسها ولا تداعياتها، فلم ينتج المسلمون أي شيء يمكن مقارنته بعصر «التنوير». وفي الحقيقة، لقد سعى الفقهاء المسلمون إلى توسيع نطاق القانون الديني عن طريق القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والقواعد الفقهية، وحتى استقراء نصوص الشريعة. وكان الهدف من ذلك كله -كما كان في العلماني الغربي المبكِّر- حماية مصالح المجتمع والحفاظ على سيادة القانون المقدَّس. وفي هذه المقاربة باتت للطاعة للقانون الديني بنية متغيّرة مع الوقت، فعلى سبيل المثال ظلت الفتوى في المذهب الحنفي قرونًا على عدم جواز بيع الوفاء، إلى أن صار الفقهاء يفتون بجوازه عند الحاجة. ولكنهم في الحالتَيْن يخرّجون الحكم داخل إطار الفقه(۱۷)، وعلى المنوال نفسِه يمكن أن نعدّد أمثلة كثيرة(۱۸). فلم يؤدِّ اتجاه الفقهاء المركَّب نحو توسيع الطاعة وفهمها باعتبارها بنية متغيّرة إلى سعيهم -أو شعورهم بالحاجة إلى السعي- نحو إنشاء مجال مستقل غير دينيّ صريح، يكون بديلًا عن الدين أو مراقبًا له(۱۹).
كما بقي الإدراك الكلي للأصول الإلهية للقانون الديني إلى جانب فهم الإسلام للتوحيد على أنه يعني: أن ما أراده الله وأمر به هو وحده ما يملك شرعية القانون الديني. فعبارة «لا حكم إلَّا لله» التي صاح بها الخوارج -ورأتها الأغلبية غُلُوًّا- لم تكن خاطئة في جوهرها ولا شاذة(۲۰)، والوتر الذي ضربت عليه عاد ينبض إبَّان صعود المعتزلة في القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي عندما بات السؤال عن نطاق الخطاب الإلهي القانوني تحديدًا محلَّ نقاش. وفي النهاية، سيظهر العلماني الإسلامي (أو بالأحرى سينتهي به المطاف) مما كان يُعد محل النظر في هذه النقاشات. ولكنه ظهر منتجًا ثانويًّا «بريئًا» إلى حد ما، ليس خصمًا أو منافسًا للدين أو القانون الديني. ومرة أخرى، في حين يتشارك العلماني الإسلامي والغربي الكثير في الجوهر، أي استناده إلى مصادر وسلطات خارج حدود نصوص (تحديدات) الدين (وفي حالة الإسلام: الشريعة)، فإن وظيفته بيّنة الاختلاف عن الدور الذي أداه التصنيف «علماني» في الغرب.
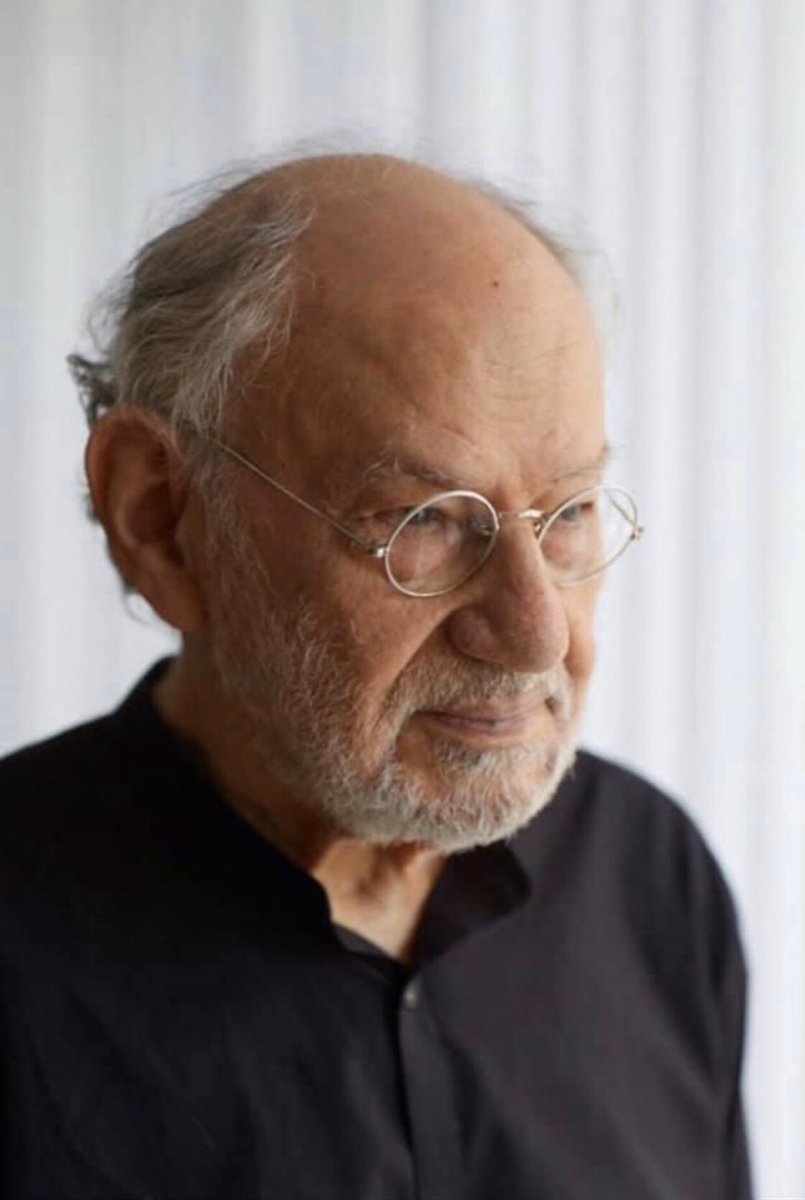
طلال أسد
إن ما يجمع بين التصورات المختلفة حول العلماني الغربي هو الإشارة إلى وظيفته التنظيمية في مواجهة الدين. إذ يشير طلال أسد (Talal Asad) في عمله البارز تشكلات العلماني إلى أن جانبًا من أبرز معاني العلماني (الغربية) يكْمُن في الإزاحة الدائمة التي يفرضها على الدين عبر تأسيس وحشد سلسلة من المتقابلات المعرفية (العقل/الأسطورة، العام/الخاص، الاستقلالية/الخضوع)، وجميعها صُممت ووُظفت معياريًّا لتأسيس تفوق العلماني على الديني وتعزيزه(۲۱). وبعبارة أخرى، لا يتعارض العلماني مع الديني فحسب، بل يُتوقع منه أن يسيطر عليه. ونجد إدراكًا مقاربًا في وصف كازانوفا الذي يحدّد العلماني باللحظة التي يتجاوز فيها الناس ثنائية الديني/العلماني. فيقول: «تعبّر كلمة علماني عن تعلمن مطلق ومكتفٍ بذاته عندما تصف أناسًا ليسوا مجرد «لا مبالين دينيًّا»، وإنما أناس محصنون تمامًا ضد أي صورة من صور التعالي القابعة فيما وراء إطار المحايثة العلماني المحض»(۲۲).
واستنادًا إلى استبصارات فيبر، يحدّد كازانوفا العلمانيَّ بصعود وانتشار حقول البحث والتخصُّص غير الدينية؛ إذ إنها هدمت جدران الدير التي صانت تعالي الدين وانفصاله عن الحياة الدنيا. وعندما انهارت هذه الجدران انكشف النظام الأرضي أمام العلماني وبات مجالًا لغارته، حتى آل الأمر بالدين نفسِه ليصير باحثًا عن مكان له يقاتل دفاعًا عنه(۲۳). وبهذا تتأكَّد -مرة أخرى- العلاقة الهرميَّة «الأبويَّة» بين العلماني والديني. لقد كان ذِكرُ كازانوفا لـ«إطار المحايثة» إشارةً منه إلى عمل تشارلز تايلور (Charles Taylor) الضخم عصر علماني، حيث يصف تايلور -مثله مثل طلال أسد- الحدود بين العلماني والديني بالمسامية، لكن العلماني هو من يحدّد السياق الكلي، «إطار المحايثة»(۲٤) الذي يقيد و«يضغط» على المجالات الأصغر للتأثير الديني. وهذا الضغط يسحب وجود الله من الحياة العامة، ويُسهم في النفور العام من المشاعر والممارسات الدينية، إلى أن يصير الحفاظ على الإيمان مستعصيًا(۲٥). وباختصار، تتعاظم وظيفة العلماني باعتبارها قوة فاعلة في الحياة، بينما يتضاءل الدين إلى دور سلبي ورجعي.
لا يفترض العلماني الإسلامي وجود حاجة أو أحقيَّة لسلطة تقوم بتحديد الديني أو ضبطه، بل هو أقرب إلى أن يكون نتيجة سعي القانون الديني نفسه ليضع حدودًا لنفسه.
تتضمَّن المفاهيم البديلة عن العلماني (الغربي) تنويعاتٍ من اللائكية الفرنسية(۲٦) والمواقف التي ترفض حياة «تجعل الله أولويتها»(۲۷)، ويساوي البعض -تبعًا للنموذج الأمريكي- بينها (أي العلمانية) وبين «حيادية الدولة»(۲۸)، حيث تدجن الدولة العلمانية الدينَ وتشرعن نفسها بموجب وعد ضمني بحماية المجتمع منه. كما تتضمَّن أوصافًا أخرى: «إعادة تكييف للدين … كعنصر يقع تحت إدارة وتدخل مستمرين، وإعادة تشكيل الحياة الدينية وحساسياتها بما يتوافق مع الافتراضات المسبقة والمتطلبات المستمرة للحكم الليبرالي»(۲۹). ويظهر العلماني -مرة أخرى- في كل هذه الصور كأنه عمدة المدينة الجديد الذي يأتي ليحدّد ويضبط حدود الدين المناسبة. وفي المقابل، لا يفترض العلماني الإسلامي وجود حاجة أو أحقيَّة لسلطة تقوم بتحديد الديني أو ضبطه، بل هو أقرب إلى أن يكون نتيجة سعي القانون الديني نفسه ليضع حدودًا لنفسه. وأكرِّر أن حدود الشريعة -في قراءتي هذه- هي إلزام ذاتي وليست تراجعًا ولا تقلصًا نتيجة مواجهة سلطة مستقلة وخارجية تُدعى «العلماني».
ولا شكَّ أن وضع الشريعة في بؤرة النقاش حول العلماني يحوجنا إلى التبرير على ما يبدو؛ إذ إن القانون في الغرب -في نهاية المطاف- نظام علماني دنيوي محض، ويبدو ألَّا جدوى من استخلاص تباين بينه وبين العلماني. لكننا قد نجد ما يدعمنا في دراستنا المقارنة للانقسام الثنائي التقليدي بين المقدَّس والدنيوي. ففي مناقشته للمقدَّس ومقابله يشير طلال أسد إلى:
أن محاولات تقديم مفهوم موحد عن «المقدَّس» في اللغات غير الأوروبية قوبلت بأزمات كاشفة على مستوى الترجمة. هكذا، وبالرغم من أن الكلمة العربية «قداسة» تقابلها بالإنجليزية كلمة «sacredness»، فإنها ستبقى الحالة التي لا تصلح لكل السياقات التي يستخدم فيها المصطلح بالإنجليزية في الوقت الحالي. إن ترجمة كلمة «المقدَّس» تستدعي العديد من الكلمات (محرم، مطهر، مختص بالعبادة، وما إلى ذلك) كل منها يتصل بنوع مختلف من السلوك(۳۰).
إذن، فليس من العسير إدراك أن المرادفات لكلمة «sacred» تقع كلها في إطار الشريعة وسلطانها، فهي الأساس الذي يحدّد دلالتها. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار الشريعة حافظة وميسرة لحدود من نوعٍ ما. وسواء كانت هذه الحدود تقسم العالم إلى «نطاقَيْن يحوي أحدهما كل ما هو مقدَّس، والآخر كل ما هو مدنَّس»، باستخدام ألفاظ دوركايم(۳۱)، أو تقيّد رؤية العالم، حتى باعتباره نطاقًا واحدًا، من خلال عدسة الشرعي، فإن هذا سؤال مستقل (ومع ذلك، فهو وثيق الصلة بالموضوع). لقد لاحظ أسد في بدايات مناقشته أنه «في الجمهورية الرومانية اللاتينية كانت كلمة ‘sacer’ (المقدَّس) تشير إلى شيء كان يمتلكه أي إله، ثم استولت عليه الدولة من منطقة الـ"profane" (الدنيوي)، ومررته إلى منطقة الـ"sacrum" (المقدَّس)»(۳۲).
وهو على النقيض مما يقضي به الإسلام من أن لله ملك كل شيء أولًا وآخرًا. وفي الواقع، يورد البيهقي (ت. ٤٥۸هـ/۱۰٦٥م) رأيًا لغويًّا عن أصل اشتقاق لفظ الجلالة «الله» بقوله: «الهاء التي هي حرف الكناية عن الغائب ثم زيدت فيه لام المِلك؛ فصار ’له‘، ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيمًا، توكيدًا لهذا المعنى، فهو الله مالك كل شيء»(۳۳). إن غاية الشريعة في هذا السياق لا تسعى -كما في الدولة الرومانية- إلى تعيين الملكية ونقلها، وإنما إلى إظهار أن ما يأمر به الله واقعٌ ضمن ملكه وحكمه، هو خطاب جوهري غايته توجيه سلوك البشر.
وفي ظل تلك الملكية الإلهية النافذة في كل شيء في الوجود التي أشرنا إليها، تظهر صعوبة الفصل بين المقدَّس والدنيوي بالمعنى الغربي الذي ألمح إليه أسد. لكن معالم الخطاب الإسلامي الشرعي يمكن تمييزها عن معالم الخطاب غير الشرعي. وإذا ما انفرد الخطاب الشرعي بتمثّل خطاب الله الباتّ في توجيه سلوك البشر، فإن الشريعة بهذا المعنى تمارس دور المحدِّد الذي أشرت إليه في تأسيس مقولة العلماني الإسلامي والحفاظ عليها.
الشريعة: نسق غير محدود في مقابل واقع محدود
يُصور نطاق الشريعة عادةً على أنه غير محدود، فكما قال المستشرق الشهير جوزيف شاخت (Joseph Schacht)، فإن «الشريعة هي مجموعة شاملة من الواجبات الدينية، أي جملة أوامر الله التي تنظّم حياة كل مسلم في جميع مظاهرها. وهي تشمل على قدم المساواة أحكامًا تخص الصلاة والشعائر، وكذلك قواعد سياسية وفقهية بالمعنى الضيق لكلمة فقه»(۳٤). وعرّف وائل حلّاق الشريعة مؤخرًا بأنها «ممثلة لإرادة الله السيادية، التي تنظّم مجال النظام الإنساني بأكمله، إما بصورة مباشرة أو من خلال تفويض محدد جيدًا ومحدود»(۳٥). لكن هذه التصورات تحمل -بالإضافة إلى رفض الإسلام المفترض لثنائية المقدَّس والدنيوي- الافتراضات الشائعة نفسَها عن كون القانون هو المانع ضد استغلال الإنسان للإنسان. أو كما قال جون لوك (John Locke): «يبتدئ الطغيان حيث تنتهي سلطة القانون»(۳٦). وهذا الارتباط الإيجابي بين الشريعة وحكم القانون يحظى بشعبية في الأوساط الإسلامية الحديثة. وباختصار، فإن التصور الذي يقضي بلا محدودية الشريعة، ومطالبتها بمعالجة جوانب الحياة كافَّة، لهو من الذيوع بمكانٍ في الخطابات الحديثة الإسلامية منها وغير الإسلامية.
ومن المؤكَّد أن لهذا الفهم لوازمَ بعيدة المدى. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الدولة المسلمة قد وُجدت -كما قيل- «لهدف رئيس هو إنفاذ القانون»(۳۷)، (وإذا كان القانون غير محدود)، فإن هذه الدولة ستجد ما يبرّر ويؤيد توسيع سلطاتها التنفيذية لتتناسب مع هذا القانون غير المحدود. وهو ما أكَّده وائل حلّاق تأكيدًا غير مباشر، حيث يرى أن السيادة غير المحدودة للدولة الحديثة (العلمانية) لا بدَّ أن تضعها في صدامٍ مع دولة إسلامية قائمة على الشريعة(۳۸).
وبعبارة أخرى، تمثّل الشريعة والدولة الحديثة صدامًا لصورتَيْن غير محدودتَيْن من السيادة. وكذلك فإن ثمة لازمًا آخر إذا عرّفنا الشريعة بأنها لا متناهية النطاق، وهو أننا بذلك نقصي «الشعب» من المشاركة في التفاوض على نُظُمه الاجتماعية السياسية والاقتصادية. فبقدر ما تكون الشريعة هي أساس الإسلام الوحيد للحكم على أفعال البشر، يكون الفقهاء وحدهم -وهم المخوّلون بتحديد موادها- هم أصحاب القدرة على التأثير في صياغة نظام الإسلام المعياري(۳۹).
أكَّدوا -الظاهرية- على أن العديد من القضايا هي خارج حدود النص، وظلَّت كذلك دون معالجة، وأنه من الخطأ ادعاء أن لله أمرًا تشريعيًّا صريحًا في كل القضايا.
إذا كان ذلك كذلك، فإن ثمة قراءةً للتقاليد الفقهية الإسلامية تبدو وكأنها تبرّر فهمًا شموليًّا للشريعة. فمنذ اللحظة التي أُقرَّ عندها القياس وسيلةً لتوسيع نطاق الأحكام الفقهية تحديدًا، اكتسب الفقه -ظاهريًّا- قدرةً غير محدودة لتجاوز حدود نص الوحي المباشر. لكن القياس ظل بعيدًا عن أن يكون محلَّ إجماع لقرون. وقد خاض أهل السُّنة في قضية نطاق الشريعة بمجرَّد مناقشتهم مسألة اعتبار القياس. فعلى سبيل المثال، كان الظاهرية -الذين ظهروا في القرن الثالث الهجري/العاشر الميلادي ولم يكونوا «نصوصيين» كما يشيع عنهم- يرفضون القياس لسبب محدَّد، وهو أنه ليس بوسع المرء أن يتجاوز ما حدَّدته مصادر الوحي مباشرة (وليس «حرفيًّا» كما أشاروا)(٤۰). وكما أشار كيفين راينهارت (A. Kevin Reinhart)، فإن الظاهرية أكَّدوا أن «حكم الوحي لا ينطبق إلَّا على ما نصَّت عليه الأدلَّة الشرعية صراحةً … إنه يُطبَّق بحزم، ولكن الحالات التي يُطبَّق فيها قليلة (نسبيًّا)»(٤۱). وباختصار، فإنهم أكَّدوا على أن العديد من القضايا هي خارج حدود النص، وظلَّت كذلك دون معالجة، وأنه من الخطأ ادعاء أن لله أمرًا تشريعيًّا صريحًا في كل القضايا.
ظل المذهب الظاهري بارزًا حتى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تقريبًا، وقد ضمَّهم الفقيه الشافعي الشهير أبو إسحاق الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء -الذي يحوي كل أسماء ومذاهب «من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع ويُعتدّ به في الخلاف»(٤۲)- إلى مذاهب السُّنة الأربعة الأخرى بالرغم من رفضهم القياس وما يلزم عنه من طرق مُوصِلة إلى الأحكام.
وبعيدًا عن الظاهرية، فقد انعكست أهمية مسألة النطاق في الجدل المبكِّر حول التصنيف الفقهي «المباح»: أهو يشير إلى ما قال الله بإباحته؟ أم ما هو يقع خارج حدود خطاب الله الشرعي من قبيل المصادفة إن جاز التعبير(٤۳)؟ وهي المسألة التي ستظل محلَّ نقاش حتى القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي، كما نراها في اختصار ابن رشد الحفيد لكتاب الغزالي المُستصفَى(٤٤).
والغرض من إثارة هذه المسألة هو أن ثمة قلَّة من كبار الفقهاء ظلوا لقرون متقبّلين أو واضعين في اعتبارهم الفكرة القائلة بأنه ليس لله أوامر مباشرة أو عن طريق القياس في كل شيء، وأن الأغلبية ممَّن يرفضون هذا الرأي لم تَرَ فيه تجديفًا يستحقُّ تكفير أصحابه أو تبديعهم أو تفسيقهم. وخلاصة الأمر أن القول بحدود فقهية على الخطاب الإسلامي الشرعي ليس قولًا جديدًا، وليس هذا القول -نظرًا لعراقته التاريخية- مفروضًا من الغرب الحديث الناشئ المُعلمِن، وبالقطع ليس أيضًا خارجًا عن نطاق التراث السُّنّيّ.
وبطبيعة الحال، أمكن حل الخلاف حول مسألة النطاق في النهاية لصالح الرأي القائل بتوسيع نطاق الشريعة، والقبول بالقياس، ووضع المباح في منزلةٍ بين الواجب والحرام باعتباره جزءًا من خطاب الله الشرعي. لكن لا يجب أن يُعَدَّ هذا متناقضًا مع الحجَّة القائلة بأن الفقهاء المسلمين ظلوا منتبهين لمسألة النطاق، بل حافظوا عن شيء من الريبة -وربما النقد- تجاه التصورات التي تجعل الشريعة شموليةً بطريقة عشوائية. وفي الحقيقة، يكشف التحليل الدقيق أن جمهور الفقهاء -الذين أقرّوا مفهومًا موسِّعًا وإيجابيًّا للشريعة- ظلّوا منتبهين إلى أن للشريعة حدودًا لا تستطيع تجاوزها(٤٥). والخلاصة أنه حتى في فترة ما بعد التكوين(٤٦) -عندما اتخذت الشريعة شكلَها المكتمل- ظل يُنظر إلى الشريعة بوصفها مسألة محدودة النطاق، لا غير محدودة.
العلماني الإسلامي: الشرعي في مقابل غير الشرعي
دارت كثيرٌ من أعمالي حول أفكار الفقيه المالكي المصري الكبير شهاب الدين القرافي (ت. ٦۸٤هـ/۱۲۸٥م)، وأظهرت أنه كان واضحًا وصريحًا في وضع قيود فقهية على الشريعة(٤۷). وقد يعطي هذا انطباعًا بأنه قد تفرَّد في ذلك، لكن الحال ليس كذلك، لولا أن المقام لا يتسع للحصر، إلَّا أن ما يلي فيه الكفاية.
سنجد بعض الدلائل إذا ما عدنا إلى النبي ﷺ. حيث تورد كتب السيرة النبوية المعتبرة أنه عندما أصدر تعليماتٍ لجيش المسلمين في غزوة بدر، سأله الصحابي الحباب بن المنذر: أهو وحي أم مجرَّد رأي النبي؟ (أرأيت هذا المنزل، أمنزلًا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟)، فردَّ النبي بأنه الرأي والحرب والمكيدة. وعندها اقترح الحباب خطته التي ارتضاها النبي(٤۸). كما نقرأ في كتب الصحاح: «قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يؤبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، فقال: ’ما تصنعون؟‘، قالوا: كنا نصنعه، قال: ’لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا‘، فتركوه، فنفضت أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: ’إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر‘، وقال: ’ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل‘»(٤۹)، ثم يُورِد مسلم قول النبي: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٥۰). ويدلُّ ذلك على فهم لحدود النص الإلهي من جهة مجموعة القضايا التي ينظِّمها، ويكون فيها ملزمًا للمسلمين إلزامًا شرعيًّا واضحًا.
ونرى في الأجيال التي جاءت بعد العهد النبوي ضبابيةً في الحدود بين ما هو شرعي في جوهره وما هو غير شرعي. فمنذ وقت مبكِّر، نرى أن تقدير الإمام مالك (ت. ۱۷۹هـ/۷۹٥م) الواقعي لنفقة الزوجة من أنواع المأكل وكمّيته قد تمَّ بغطاء فقهي، بالرغم من عدم استناده إلى نص صريح(٥۱). ونجد ذلك أيضًا عند الشافعي (ت. ۲۰٤هـ/ ۸۱۹م)(٥۲) وتلاميذه في تعاملهم مع هذه الأمور التقديرية، كتحديد اتجاه القبلة، أو إجازة شهادة العدل ومثلها. وكما لاحظ أحمد الشمسي: «بالرغم من أن تحديد اتجاه القبلة هو مسألة تجريبية، بينما النظرية الفقهية تقوم على الأحكام التفسيرية، لا يبدو أن الشافعية في القرون المبكِّرة كانوا يميزون بين الاثنين»(٥۳).
لكن في النصف الأول من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، مع أحمد بن حنبل (ت. ۲٤۱هـ/ ۸٥٥م)، بدا الاعتراف بالحدود الفقهية للنصوص بيّنًا؛ ففي حديث الطبري (ت. ۳۱۰هـ/ ۹۲۳م) عن محنة خلق القرآن المشهورة، أورَد جوابَ ابن حنبل الأوّليّ: «هو كلام الله، لا أزيد عليها»(٥٤)، وهو ما يُظهر أن سؤالَ «هل القرآن مخلوق أم لا؟»، أو ربّما فهم ابن حنبل لهذا السؤال في ذلك الوقت، أمرٌ خارج نطاق ما اعتقَدَ ابن حنبل أن النص يتوجه إليه صراحةً.
ثم بات التمييز بين الشرعي وغير الشرعي أكثر تحديدًا. فعلى سبيل المثال، وبَّخ الغزالي (ت. ٥۰٥هـ/۱۱۱۱م) مَنْ دعاه بـ«صديق الإسلام الجاهل»، الذي أنكر علوم غير المسلمين الطبيعية ظنًّا منه أنها تخالف الشريعة. بينما يقرِّر الغزالي أن «ليس في الشرع تعرُّضٌ لهذه العلوم بالنفي ولا بالإثبات»(٥٥). لكننا نجد مع القرافي التعبير الأوضح(٥٦)، فهو يورد أمثلة للعلوم غير الشرعية «من الحسابيات والهندسيات، وكذلك الأمور العادية كالطبيات وغيرها لا يتوقف دركها على الشرائع»(٥۷).
ولم يتوقف هذا الإقرار الأساسي بحدود الشرعي عند القرافي، فابن تيمية (ت. ۷۲۸هـ/۱۳۲۸م) يستشهد مرارًا بحالات لم يتعرض فيها التقليد الشرعي لا نفيًا ولا إثباتًا لمفهوم وافد أو مصطلح عملي(٥۸). كما يؤكِّد على أن الادعاءات العقلية المحضة (كصحة المنطق اليوناني) لا يجوز أن تُصحح بالنقل، وإنما بمجرد العقل(٥۹). وكذلك يؤكِّد الفقيهان الشافعيان تقي الدين السبكي (ت. ۷٥٦هـ/۱۳٥٥م) وابنه تاج الدين السبكي (ت. ۷۷۱هـ/۱۳٦۹م) في الإبهاج في شرح المنهاج -وهو شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ت. ٦۸٥هـ/۱۲۸٦م)- على التفرقة بين الأحكام التي تتوقف معرفتها على معرفة الشرع (والشرع هو الحكم والشارع هو الله تعالى) وبين غيرها من الأحكام التي لا تُعَدُّ شرعية(٦۰)، أي التي لا تقع ضمن حدود الشرع.
ثم يواصل الفقيه المتأخّر ابن عابدين (ت. ۱۲٥۸هـ/۱۸٤۲م) على المنوال نفسِه، فيذكر -على سبيل المثال- (أن الأحكام المأخوذة من العقل كالعلم بأن العالم حادث، ومن الحس كالعلم بأن النار محرقة، أو من الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفوع) تخرج عن دائرة الحكم الديني، بل يقول في كلماتٍ تذكِّرنا بالقرافي: «المراد بالشرعية … ما لا يدرك لولا خطاب الشارع»(٦۱). وهنا يتضح أن فكرة أن الشريعة (وتتبعها صفتها: شرعي) محدودة لا غير محدودة ليست ابتداعًا من القرافي، وإنما هي محل اتفاق في التفكير الفقهي الإسلامي قبل الحديث الذي شقَّ طريقه إلى العصر الحديث(٦۲).
يرسي هذا الفهم المقيد لفئة الشرعي دعامة تعريفي للعلماني الإسلامي: «فهو معرفة قائمة بذاتها دون اعتماد على نصوص الشريعة ولا أدوات أصول الفقه». وقد يبدو هذا للوهلة الأولى إعادة استخدام متكلف لمفهوم العلماني، نظرًا للارتباط الوثيق بين العلماني والاستهانة بالدين إن لم يكن معاداته. فإذا كانت الشريعة هي الوسيط الذي نعرف من خلاله حكم الله بشكل واضح، ويمكن التحقُّق منه موضوعيًّا (أعني بالموضوعية الإتاحة في المجال العام، حيث الجميع على قدم المساواة في الوصول إليها)، وإذا كانت الشريعة لا تعالج كل القضايا بشكل مباشر، فإنها تعترف بوجود أُسس وقواعد أخرى للتقويم. وهو ما ينسجم مع السمة الأساسية التي منحها كازانوفا للعلماني، وهي «التمايز»(٦۳). وفي القلب من هذا التمايز يقع التخصُّص في حقول اهتمام مختلفة: دينية وسياسية واقتصادية، وما إلى ذلك. وبينما لا يشدِّد الإسلام على هذا التقسيم الصريح والشكلي للمعرفة، فإن التفرقة بين الشرعي وغير الشرعي هي في الحقيقة تعبيرٌ عن التخصُّص. فالعلماني هو التمايز عن الدين عند كازانوفا، أما في عملي عن العلماني الإسلامي فهو التمايز عن الشرعي (لا الديني).
وليس هذا الفهم الجوهري والمقدّر «للتمايز» بحكرٍ على كازانوفا، فقد أدرك طلال أسد هو الآخر دور التمايز ومركزيته عندما كتب: «عندما يُقال عن أمرٍ ما إنه منسوب إلى ’الدين‘، ويكون بالإمكان منازعة ذلك القول، يكون ’العلماني‘ قد ظهر بصورته الأجلى»(٦٤). وكذلك تشارلز تايلور عندما يتحدَّث في إطار فهمه للعلماني عن «الأخلاق السياسية المستقلة» المتحرّرة من الولاءات الطائفية(٦٥).
ولا ريب أن مفهومي عن العلماني الإسلامي -نظرًا لمنحاه الفقهي- قد لا يصمد أمام مختلف الاستبصارات السوسيولوجية والأنثروبولوجية النافذة لمعالجات العلماني هذه (وغيرها). ولكن ما يقطع شوطًا يسوّغ استخدامي للمفهوم، ويمثّل نقطة التقاء له مع الخطابات الراسخة عن العلماني، هو اتخاذي التمايز نقطةً للانطلاق، بالإضافة إلى القول بأن الفقه لم يكن المنبر الوحيد لمناقشة قيمة السلوكيات الإنسانية.
العقل والوحي
أعود لأقول إن القول بأن الشريعة لم تتناول مسألة محددة بخطاب صريح لا يعني أن الإسلام غير مكترث بها. بل إن المسلم في الحقيقة لا يملك خيار إهمال هذه المسألة؛ لأن وعيه الإسلامي هو ما سيقوده إلى تقدير حجم المصلحة أو المفسدة الراجحة في كل مسألة. وبعبارات أوضح، لا شكَّ أن ماهية «المصلحة» و«المفسدة» الحقيقية بحاجة إلى تعريف، وسيكون للإسلام أو الشريعة دور واضح في هذا. لكن بعيدًا عن الإقرار الأساسي بأن الإسلام أو الشريعة يوجبان فعلًا معينًا أو يستحبّانه أو يكتفيان بإباحته، فإن السؤال العملي عن الصورة المخصوصة الأفضل لتمثيل المصالح المرتبطة بهما ليس من أعمال المداولات الشرعية بالمعنى الدقيق للكلمة. وبعبارة أخرى، فإن القول بأن الشريعة تدعم أو تشجّع قيمة خلق الثروة شيء، والقول بأن الشريعة (أو الإسلام) هي مصدر مباشر للأفعال أو السياسات التي تخلق الثروة شيء آخر.
يمكننا الادعاء بأن أهم ما خالف فيه أهلُ السنة المعتزلةَ هو «إلهياتهم» والقول بأن الوحي مُلزَم بقبول ما يصل إليه العقل من المآلات الأخلاقية للأفعال وما يستتبعها من جزاء.
في نهاية المطاف، سيعيدنا هذا إلى الجدل القديم حول دور العقل ومكانته في الإسلام؛ لأن العقل سيكون هو البديل الظاهر عن الشريعة في معالجة المسائل. لكن الإجابة السُّنية على المعتزلة الأوائل (الذين قالوا بأن العقل بوسعه أن يستقلَّ بإدراك المآلات الأخلاقية للأفعال وما تستحقه من ثواب أو عقاب) أدت إلى شيوع النظر إلى أهل السُّنة في الدراسات الغربية بوصفهم رافضين لاستعمال العقل في تقدير الأحكام لاعتبارات دينية فحسب، ما أدى إلى الافتراض الشائع بأن المعيار المعتمد في الإسلام هو «النصوصية» (scripturalism). لكن يمكننا الادعاء بأن أهم ما خالف فيه أهلُ السنة المعتزلةَ هو «إلهياتهم» والقول بأن الوحي مُلزَم بقبول ما يصل إليه العقل من المآلات الأخلاقية للأفعال وما يستتبعها من جزاء(٦٦). وهذا لا يعني أن العقل عاجزٌ عن إصدار أحكام قيمية متصلة بالدين ومستقلة عن الوحي ولا أنه ممنوع من القيام بذلك.
وهذا واضح في ردود الأشاعرة، ألدّ خصوم المعتزلة، وخاصةً الأشاعرة المتأخرين، فالجويني (ت. ٤۷۸هـ/۱۰۸٥م) -على سبيل المثال- يقرُّ في كتاب الإرشاد بأن المجتمعات بحكم اطراد العادات تستحسن الحسن، وتستقبح القبيح، وإن لم يحضر لهم سمع(٦۷). ويشير الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد صراحةً إلى أن ما اعتُبر دائمًا حسنًا أو قبيحًا مرتبط بالنفع أو الضرر وبالمصالح أو الحاجات الفردية والجماعية التي يمكن معرفتها بمعزِلٍ عن الوحي(٦۸). ويؤكِّد فخر الدين الرازي (٦۰٦هـ/۱۲۰۹م) في كتاب الأربعين في أصول الدين على أنه في الواقع «لا نزاع في أنا نعرف بعقولنا كون بعض الأشياء ملائمًا لطباعنا، وبعضها منافرًا لطباعنا»(٦۹).
وعلينا أن نشير إلى أن هذا ليس موقف الأشاعرة وحدهم، فالماتريدية وأهل الحديث يتفقون معهم(۷۰). حتى الحنبلي «المتزمّت» ابن تيمية يصرّح بأن القرآن والسُّنة (الوحي) «لا يُمكن أن يزوّد البشر بكل ما يحتاجون إليه لنجاح حياتهم الدنيوية، بل ولا كل ما يحتاجون إليه لخلاصهم الأخروي»(۷۱). والعقل عنده قادر تمامًا على تمييز المصلحة والمفسدة، ولو لم يرد الشرع، ولكن لا يلزم من حصول الحسن أو القبح إثابة الفاعل أو معاقبته في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك(۷۲).
وفي المحصلة، فإن جميع مذاهب الاعتقاد السُّنية لم تكرّس الشريعة أساسًا وحيدًا للأحكام القيمية، لا سيما في الواقع العملي. ومن ثَمَّ فإن القول بأن النص يغطّي كل نقاشات المسلم في حياته اليومية قولٌ غير دقيق. وهو أمر شديد الأهمية في فهم معنى العلماني الإسلامي. ودون ذلك، سيكون من المرجَّح اتهام مقولة «العلماني الإسلامي» بأنها نوعٌ من الانحراف الذي يسعى إلى منح سلطة ودور غير مستحقين للعقل. لكن في الوقت نفسِه علينا أن ننتبه إلى أن الفهم الإسلامي التقليدي للعقل كان أوسع من مجرَّد التفكير النظري، بل الأدق أن نتحدَّث عن طرق في معرفة الواقع، والإلمام به، وتصوُّره، وحتى الحدس به. وبهذا الفهم يشمل العقل أشياء من قبيل: الإدراك الحسي، والعرف، و«الذوق»، والمخيلة، والتجلّي الروحي، وما شابه(۷۳). ولا بدَّ من أخذ ذلك في الاعتبار حين نقارب تطبيقات العلماني الإسلامي.
المقتضيات العملية للعلماني الإسلامي
نجم عن التصوّر المتصلّب لتعارض الدين والعقل -بالتزامن مع نفوذ الفهم الغربي لمفهوم «العلماني»- ثلاثة مواقف على الأقل للمسلمين المعاصرين في تعاملهم مع العلماني. الأول: رفضه بالكلية (باعتباره غير إسلامي)، ومن ثَمَّ ترك جميع القضايا التي تدور في فلكه للصدفة والعشوائية وعدم التنظيم. والثاني: رفضه (أو بالأحرى تجاهله) (ومرة أخرى، باعتباره غير إسلامي)، ولكن هذه المرة عن طريق إدراجه في المجال الشرعي ليس إلَّا، ومحاولة تنظيم كل شيء بقواعد الشريعة وأدواتها. والثالث: تبنّيه، وهنا في شكله الغربي باعتباره نقيض الدين أو رقيبًا ومروضًا له. وذلك ردًّا على فشل الشريعة المُتصوَّر في التعاطي مع المصالح الإنسانية المشروعة.
ولكننا نرى تهافت الرفض التام للعلماني (أي باعتباره بنيةً) عند التفكير في أسئلة أوَّليَّة من قبيل: السن القانوني لقيادة السيارات، أو ما ينبغي أن تكون عليه خطة الرعاية الصحية الوطنية، أو سياسة الهجرة. ومن الواضح أنها أسئلة لا يمكن تجاهلها لأنها تمسُّ مصالح عمومية واسعة يقرّها الإسلام والشريعة كلاهما، ويسعيان في رعايتها (مثل حفظ الحياة)، وفي الوقت نفسِه ليس ثمة نصٌّ واضحٌ يُملي ماهية هذه القواعد سواء مباشرة أو بالقياس. ومن المؤكَّد أنه قد يُقال إن النصوص توجه المسلمين توجيهًا غير مباشر في هذا الشأن بإلزامهم تجنُّب الضرر وحفظ الاحتياجات الإنسانية الأساسية (أي حفظ النفس وحفظ النسل وما إلى ذلك).
لكن هذه الأسئلة تتجاوز ما هو نظري إلى ما هو عملي لتنظر في السن الأصلح للقيادة، أو في خطة الرعاية الصحية الأنفع، أو في أيِّ سياسة هجرة هي أفضل للمجتمع وتخدم مصالحه بشكل كافٍ. وهذا ما لا يمكن تقديره بالعودة إلى النصوص، أو اللوازم الشرعية، بل يجب أن تتبعها وسائل علمانية غير شرعية (مثل: الملاحظة الإمبريقية، والتجربة العملية، وعلم نفس الطفولة، والطب الحديث، والإدارة العامة، والعلوم الحسابية (الاكتوارية) وما شابهها) وجميعها لا تستمدُّ ماهيتها أو سلطتها من الشريعة، وبالضرورة لا تعارضها. وعندما نوسّع من أفق نظرنا ليشمل: لوائح إدارة الطيران، والسياسة النقدية، وأكواد تنظيم البناء، وسياسة التعليم، وقوانين تقسيم المناطق، وإجراءات الملكية، ولوائح جوازات السفر، وقائمة مما لا يحصى من قضايا المجال العام، سيتضح هذا النطاق وتبرز أهميته.
وحتى تتضح الحجَّة هنا، فهي ليست دعوة للتفكير في هذه القضايا على نحوٍ يخلو تمامًا من الاعتبارات الشرعية وسلطانها. فعلى سبيل المثال، قد يمثّل رأي الشريعة في اعتبار الشفقة والحنان ضروريَّيْن لصالح الطفل مرشدا لتخصُّص علم نفس الطفل، أو رأيها في ضرورة احترام حقوق الجار في بناء المساكن مرشدًا لتخصُّص الهندسة المعمارية. لكن بينما غرض الشريعة هو إصدار الأحكام، فإن معايير تقييم الكفاءة والأمان والربح والجمال والمرح ليست مقولات شرعية. ومع ذلك، فقد تكون ضروريةً لتحقيق ما يقرّه الإسلام -وربما الشريعة- من مصالح. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الادعاء بأن سن القيادة الذي لا يراعي السلامة، أو إقرار خطة رعاية صحية وطنية غير فعَّالة، أمرٌ يخدم الغايات والمقاصد التي تسوّغها الشريعة بل وتنادي بها. ومن ثَمَّ فلا يمكن الجمع بين تجاهل فئات التقييم العلمانية هذه، وتحري تحقيق المصالح التي يقرّها الإسلام أو تؤمّنها الشريعة.
ومع ذلك، لا يمكن القول بأن سن القيادة القانوني أو خطة الرعاية الصحية «قانون إلهيّ» أو ضد «القانون الإلهي»، حتى وإن اندرجت ضمن النطاق العام للقانون الديني (بالرغم من أنه لم ينص عليه كما هو واضح)، في حين يمكن قول ذلك عن وجوب إعالة الأسرة واجتناب الخمر. ولكن من غير الصحيح غالبًا القول بأن تحديد سن القيادة أو صياغة خطة للرعاية الصحية هي أمور «غير دينية»، ناهيك عن القول بتعارضها مع الدين؛ لأن الدين قد يكون مصدر إلهام في هذه المسائل.
ربما تكون أبرز مظاهر الميل لدمج العلماني في مجال الشريعة في العديد من الدوائر الإسلامية هو التركيز المفرط على الاجتهاد. ولا شكَّ أن الاجتهاد مهمٌّ في إطار السعي إلى تجاوز معطيات عالم ما قبل الحداثة وافتراضاته وآرائه السائدة، والإبحار وسط هذه الأمزجة الجديدة والظروف المتغيرة. لكن هذا يرتبط بالمجال الشرعي الصريح بالمعنى الدقيق للكلمة(۷٤). ومن ثَمَّ فإن التركيز المفرط على الاجتهاد يترك التجسيد الملموس والأمثل للقيم الإسلامية أو الشرعية وأظهره في حالة من الالتباس والإهمال. وعادةً ما تكون النتيجة اعتمادًا في غير محله على النشاط الفقهي الإسلامي، وتنافرًا محبطًا بين إدراك المُثُل الإسلامية أو الشرعية، والواقع اليومي الحديث.
فإذا سعينا إلى تقليل هذا التنافر بتكثيف الاجتهاد زاد الأمر إشكاليةً. ولنفترض -كما هو حريّ بنا في كثير من الحالات- أن المشكلة ليست في فحوى الحكم الشرعي بحد ذاته، أو أنه مُحكَم ولا مجال فيه «للتأويل» (مثل تحريم الزنا)، فإن الإشكال ينبغي أن يكون في تنزيل الحكم وتجسيده في الواقع(۷٥). فإذا كان ذلك كذلك، فإن الاجتهاد -بما هو استنباط للأحكام من مصادرها- يغدو غير مجدٍ(۷٦).

محمد عبده
فعلى سبيل المثال، في معرض نقدٍ لاذع لشكل الزواج في أوائل القرن العشرين، انتقد محمد عبده (ت. ۱۹۰٥م) الفقهاء بسبب نظرتهم المثيرة للشفقة إلى مؤسسة الزواج، لا سيما أنها تحطُّ من قدر المرأة. فيقول إن تعريفات الفقهاء لا تركِّز إلا على تمتُّع الرجل بجسد زوجته، و«كلها خالية عن الإشارة إلى الواجبات الأدبية (التي هي أعظم ما يطلبه شخصان مهذبان كل منهما من الآخر)»(۷۷)، ومن ثَمَّ انحطَّ الزواج إلى منزلة وضيعة، بدل أن يكون نظامًا جميلًا أساسه المودة والرحمة بين الزوَجْين. وبالمناسبة، يرى طلال أسد أن النفوذ الأوروبي كان يوجه الخطاب المصري حول الجنس في هذا الوقت بالتحديد(۷۸).
المودة والرحمة قد تعنيان أشياء مختلفة تبعًا لاختلاف السياقات، ومن ثَمَّ يمكن تجسيدهما بطرقٍ لا تُحصى، طرق متغيّرة ومرتبطة بالثقافة الاجتماعية، من إحضار الزهور إلى شراء قطعة مميزة من اللحم.
لكني لن أركِّز على نقد محمد عبده، وإنما على الحل الذي يبدو أنه عَرضه. ويبدو من المنطقي افتراض أن الفقهاء أغفلوا «الواجبات الأدبية»، لا لقسوة فيهم، وإنما لأنها تقع خارج نطاق اختصاصهم الشرعي، باعتبار أنها واجباتٌ لا يمكن للشريعة أن تضع لها تجسيداتٍ جوهرية في شكل أفعالٍ محددة. بعبارة أخرى، فـ«المودة والرحمة» قد تعنيان أشياء مختلفة تبعًا لاختلاف السياقات، ومن ثَمَّ يمكن تجسيدهما بطرقٍ لا تُحصى، طرق متغيّرة ومرتبطة بالثقافة الاجتماعية، من إحضار الزهور إلى شراء قطعة مميزة من اللحم. أي إن تجسيدهما لم يكن أمرًا شرعيًّا، بل نشاطًا يمارسه الناس فرادى وجماعات باشتباكهم الثقافي الواعي مع العلماني الإسلامي. لكن محمد عبده بدل أن يلتفت إلى هذا البُعْد العلماني، غير الشرعي من المشكلة، بدا وكأنه يكثف الاجتهاد بالعودة إلى نصوص القرآن والسُّنة، وتكرار شروطهما لتحقيق السعادة الزوجية، لا سيما بالنسبة إلى النساء، فيقول: «وما علينا إلا أن نسمع صوت شريعتنا، ونتبع أحكام القرآن الكريم، وما صحَّ من سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمال الصحابة، لتتم لها (للنساء) السعادة في الزواج»(۷۹).
وبالرغم من نيَّة محمد عبده الحسنة وعذوبة منطقه، فإن طريقته هنا يهدّدها عدم استيعاب قدرة الثقافة على التأثير في استقبال حكمٍ شرعيٍّ ما، تأثير لا يقلُّ عن فحوى الحكم ذاته. فحتى لو أكنَّ الرجل لزوجته بالغ المودة والرحمة، فإن ذلك وحده لا يضمن شعورها بالحب والحنان. بل إن ذلك يعتمد على قدرته على ترجمة هذه المشاعر إلى أفعال صادقة ينقلها إلى زوجته. وهذا أقرب إلى كونه شأنًا ثقافيًّا من كونه معرفة أو التزامًا بالقانون الديني في حد ذاته.
فالمسلم «الصالح»، على كل حال، قد لا يجيد «التقبيلَ» (أو التأنُّق أو طيب الكلام)، ومن ثَمَّ فإن تكثيف النصائح المنصوص عليها (لا سيما أنها موجودة في حالتنا هذه) عن المودة والرحمة، ليس له عظيم أثر. بينما يبدو أن التعديلات الثقافية -بما في ذلك تعزيز المعرفة الثقافية- تشكِّل جزءًا كبيرًا من الحل، فالثقافة توجه بشكل أساسي طريقة تجسيد القانون، بما في ذلك قيمه الدينية، والفضائل، والرؤية العامة، وتجلّيه في واقع الزمان والمكان؛ ففي حالتنا هذه -على سبيل المثال- يمكن أن نرى بوضوحٍ كيف يخدم الافتتان والجاذبية غير الشرعيَّيْن مقاصد الشريعة في السكن الزوجي.
ومع ذلك، فإن الإنتاج الثقافي في حد ذاته ليس اجتهادًا شرعيًّا. فإن كان القانون يحدد الأبعاد التي يجب على الثقافة أن تعمل فيها، فلا تستطيع الأحكام -حتى في نطاق الحلال- أن تخبرنا ما الجميل؟ أو المرح؟ أو العاطفي؟ أو الأنيق؟ … إلخ. فإنتاج الثقافة ببساطة ليس من اختصاص الفقهاء، بل العكس، إنه مجال العلماني الإسلامي، ويضطلع «الناس» به. وبينما يقرّر الاجتهاد جوهر القانون، فإن الثقافة تشارك مباشرةً فيما سمَّاه بيتر بيرغر (Peter Berger) في سياقٍ آخر «بنية تسويغ» القانون(۸۰). إذ يؤدي منتجو الثقافة -لا الفقهاء- دورًا حيويًّا في تهيئة الظروف الاجتماعية ونشر المعرفة الثقافية للإحاطة بأهداف القانون ومقاصده العليا، ومن ثَمَّ توليد التزام طوعيّ عام به.
وبهذا المعنى يسوغ لنا اعتبار عامَّة المسلمين وفقهائهم مسؤولين عن الحالة العامَّة للنظام الاجتماعي الثقافي والقانوني، وأنهم مشاركون (سواء بشكل بنَّاء أو غير بنَّاء) في الحراك الديني(۸۱). أما الميل إلى «الإفراط في توسيع مجال الشريعة» وتجاهل العلماني الإسلامي، فيحجب هذه الرؤية. وبهذا نصل إلى التعامل الثالث للمسلمين المعاصرين مع العلماني، حيث تتحمَّل الشريعة والمؤسسة الدينية المسؤوليةَ الكاملة عن أيِّ تنافر بين القانون الديني و«مُثُل» الدين، ناهيك عن «تطلعات الناس المشروعة».
ولا أعني بذلك أن العلماني الإسلامي يُختزل في الإنتاج الثقافي. ولكن أهمية الثقافة في هذا السياق، مثلها مثل العمارة وعلم نفس الطفل والعلوم الحسابية أو الهندسية في سياقاتٍ أخرى (سالفة الذكر)، تفيد بأن العلماني الإسلامي ليس مرادفًا للأخلاق، بالإذن من أولئك الذين يرون «الأخلاق» وحدها ترياقًا «للإفراط في توسيع مجال الشريعة»(۸۲). ففي الحقيقة، ليس ثمة ما يربط الأخلاق بالعلماني الإسلامي عادةً؛ لأن القيم والمصالح محل النظر لا تكون أخلاقيةً في ذاتها؛ فمفاهيم من قبيل الأناقة أو الفرح أو الربح، أو حتى الكفاءة، ليست أخلاقيةً بمعنى الكلمة. وإن افترضنا مثلًا أن الكفاءة -في حقيقتها- أخلاقية لأنها عكس التبذير، فإن تحديد ما هو كفء عمليًّا غير ممكن باعتبارات أخلاقية بحتة. إن تحديد ذلك سيستدعي الأدوات العلمانية التي سلف ذكرها، كالتفكير أو العلوم الحسابية أو الخيال الثقافي أو الخبرات القديمة البسيطة.
وكثيرًا ما تتضح الأهمية الهامشية للأخلاق في مساحة الإنتاج الثقافي. ولنأخذ مثالًا ملموسًا، فقد كانت حركة أُمَّة الإسلام(۸۳) -بالرغم من انحرافاتها العقدية- قادرةً على إبداع مقارباتٍ ناجعة للتحديات الثقافية والوجودية والاجتماعية النفسية التي تواجه المسلمين. لقد مكَّن ذلك حركة أُمَّة الإسلام من إنتاج هوية ثقافية «إسلامية» يتردَّد صداها فعليًّا في السياق الأمريكي، دون أن تعتمد على المصنوعات المادية السائدة في العالم الإسلامي (مثل الثوب والطاقية). ومن الواضح أن غالب هذه الإبداعات يتحدى التصنيف «أخلاقي/غير أخلاقي». وحتى الآن كان نهجهم أقرب إلى النجاح من غيره في إنتاج تعبيرٍ ثقافي محلي عن «الإسلام» في أمريكا، تمكَّنوا به من تأمين شعورٍ قويٍّ بالذات، وهوية أخلاقية مستقلة، وهي أمور توافق المقاصد الشرعية والإسلامية بوضوح. ولو اتَّبع أهل السُّنة في أمريكا هذه السيميائية الثقافية، لأعاق ذلك جهود الإسلاموفوبيا الحالية في تصوير المسلمين في أمريكا على أنهم أجانب يمثلون طابورًا خامسًا.
العلماني الإسلامي والسياسة الشرعية
ربما يرى الكثيرون في غالب ما سلف إعادةَ صياغة لمفهوم السياسة الشرعية. لكن السياسة الشرعية -كما أراها، لا سيما في شكلها الحديث والمشهور- ليست مقاربةً مناسبةً للعلماني الإسلامي ولا بديلةً لها. فالقرارات والسياسات -لا سيما التقديرية منها الصادرة عن الدولة، وفقًا لهذه الرؤية (الحديثة) للسياسة الشرعية(۸٤)- ليس من الضروري أن تتأسس مباشرةً على النصوص، بل يكفي أن تتوافق معها(۸٥). لكن المشكلة في هذه القاعدة أنها تختزل أيَّ تقييم إلى السؤال عن «الجواز» أو «الإباحة»، وتغفل السؤال الكيفي عما هو أفضل وأنسب في الواقع. فتبعًا لها يمكن أن يمرر نظريًّا الحد الأقصى للسرعة ۳۰ ميلًا/الساعة على الطرق السريعة، أو ۳۹ عامًا سنًّا للقيادة القانونية.
وكذلك يمكن للسياسيين أو المسؤولين وضع سياساتٍ حكومية أو اقتصادية كارثية دون أن يكون ذلك كله محلَّ جدل من منظور السياسة الشرعية الحديث. لكني أرى -على النقيض من ذلك- أن المشاركة الناجحة في العلماني الإسلامي لا تتوقف عند مساحة كافية من الاجتهاد والنقاش العقلاني غير الشرعي، بل كذلك حق المجتمعات المشروع في الضغط من أجل قراراتٍ وسياساتٍ صالحة نوعيًّا وعمليًّا.
وبدل مقاربة السياسة الشرعية الحديثة، سأحيل إلى بصيرة شهاب الدين القرافي في تفرقته بين الشرعي وغير الشرعي. فهو يقرِّر أن الأداة الوحيدة الملزمة التي لا جدال فيها في الإسلام هي الحكم، لكن الحكم ينقسم في الواقع إلى:
۱- حكم شرعي، ويستند سلطانه إلى اعتماده على النص (وأدلة قاعة المحكمة كذلك في حالة التقاضي).
۲- حكم اجتهادي، ويستند سلطانه إلى سلطة الوالي (أو قُل الدولة) في توخي مصالح المجتمع الراجحة. ثم يفوّض القرافي -الذي لم يكن شعبويًّا (ولا ديمقراطيًّا بالطبع)- سلطة مهمَّة «للأُمَّة». فهو يشدِّد على أن ما ينفُذ من تصرفات الولاة والقضاة ليس ما يصدر منهم لمجرَّد صدوره منهم، وإنما ما يجلب مصلحةً أو يدرأ مفسدةً(۸٦). وهو ما يمكِّن المجتمع من مساءلة هذه التصرفات أو رفضها إذا رأى فيها تعارضًا مع ما هو أفضل للمصلحة العامَّة(۸۷).
واعترف القرافي بنوعٍ من «القرارات الرسمية» غير الحكم، وَضَعه تحت تصنيف «التصرف». والفرق بين التصرف والحكم أن الأخير يُفترض أنه مُلزِم وغير قابل للجدل، بينما الأول مُلزِم إلى حينٍ وقابل للجدل. ففي حالة الإفلاس -على سبيل المثال- يحقُّ للقاضي أن يبيع ممتلكات المفلس، ويُعَدُّ هذا البيع تصرفًا لا حكمًا. وبعبارة أخرى، بينما يُتصور أن هذا التصرف صحيح ومُلزِم، فهو يسوي النزاع في قضية بعينها، فإنه يمكن الطعن فيه وإلغاؤه، وهذا ما لا يحدث مع الحكم. وهذا يعني أن للمدين أن يعترض بصورة مشروعة على بيع ممتلكاته بثمن بخس. ويمكن لقاضٍ آخر (أو مسؤول آخر) عند تلقي الشكوى أن يلغي هذا البيع إلغاءً شرعيًّا ويطالب بثمن معقول.
يمكن للعلماني الإسلامي -باعتباره غير شرعي- أن يكون موضوع الحكم الاجتهادي في حالة واحدة، عندما يخدم الأخير بصراحة وحسم ما سمَّاه القرافي المصلحة الراجحة أو الخالصة. غير أنه من الصعب التسليم بما تتخذه الدولة من قراراتٍ أو سياساتٍ في مساحة العلماني الإسلامي بناءً على أوصاف غير حاسمة ولا مضبوطة، مثل: آمن وفعَّال ومثمر ومتنور ثقافيًّا… إلخ. بعبارة أخرى، ليس العلماني الإسلامي بشكل عام مجالَ الحكم، وإنما مجال التصرف، حيث يمكن الطعن فيه وإلغاؤه بشكل شرعي، سواء في المجال الخاص (كحالة الإفلاس) أو المجال العام (كالسياسات العامة).
وفيما يخص هذا الأخير، أي المجال العام، فإن الحق في الالتماس والاعتراض يعود إلى المجتمع ككل، بما تراكم لديه من حكمة وبصيرة وخبرة، ويمكن للخبراء أن يؤدوا دور المراقبين والضامنين في هذه العملية. وبعبارة أخرى، سيُعد قرار الدولة في واقع العلماني الإسلامي صالحًا ومُلزِمًا ما لم يُثر اعتراضًا واضحًا من المجتمع. أما إذا فشل في التوافق مع معاييره، فللمجتمع أن يسعى في تقويمه دون أن يُتَّهم بازدراء السلطة الشرعية. أما الآليات الدقيقة التي يجري من خلالها التفاوض على هذا كله وموازنته، فهي بطبيعة الحال أسئلة تقنية لا يتسع لها المقام هنا، ولكن يمكن الإشارة إلى نقطتَيْن.
أولًا: أيًّا ما كانت الآليات التي يُتوصل إليها للتفاوض على استخدام سلطة الدولة في الواقع غير الشرعي للعلماني الإسلامي، فإنها ستتولد غالبًا من مداولات هي نفسها ترتكز على تخصُّصات، وأجهزة، ورؤى، وخبرات غير شرعية. ما يعني أن كثيرًا مما يدور في هذه المداولات سيتجاوز أسئلة الجواز وعدم الجواز، ويتوقف على اعتبارات تجريبية (مثل: الكفاءة، والنظام، والعدالة، والخصوصية، وما إلى ذلك)، وكيفية تمثيلها في شروط واضحة، بدل الاكتفاء بالإقرار بها نظريًّا باعتبارها مصالح راجحة. وعلى هذا الأساس، لن يسيطر الفقهاء على هذه المداولات، وإنما ستناط بخبراء من تخصُّصات وحقول أخرى غير الحقل الشرعي. وفي الواقع، ينبغي الاحتراز من أن تتحوَّل سلطة الفقهاء الشرعية إلى سلطة كُليَّة تمكِّنهم، بوصفهم فقهاء، من التحدُّث بشكل مرجعيّ في المجال غير الشرعي للعلماني الإسلامي.
ثانيًا: للتفريق بين الشرعي وغير الشرعي (أي بين الحكم والتصرف) ثلاثُ منافع في التأسيس النظري، لم ترد صراحةً في مقاربة السياسة الشرعية الحديثة، حسبما أذكر. الأولى: عن طريق تعزيز الاعتراف الواسع بشرعية العلماني الإسلامي، لن يكون اتهام المسؤولين في كل مرة يقترحون أو يطبقون قرارات أو سياسات لا تستند إلى أحكام شرعية بحتة بانتهاك الإسلام ذا معنى. الثانية: تمكين المجتمع من فرض قدرٍ من المساءلة على قادته من خلال الحق المشروع في مراقبة جودة قراراتهم الاجتهادية. وأخيرًا: إدماج السلطة في واقع العلماني الإسلامي، بالامتناع عن منح سلطة تلقائية وحصانة للقرارات والسياسات التي تقع داخل نطاقها؛ لأنها ليست أحكامًا تستند إلى الشريعة.
أفكار ختامية
بالرغم من توخّي الحيطة والحذر، سيظل هذا التعبير مثيرًا للشكِّ في أن مؤدى مفهوم «العلماني الإسلامي» هو وضع المسلمين على منحدر الانزلاق إلى العلمنة بالمعنى الغربي والحديث للكلمة. وشيئًا فشيئًا، وتحت وطأة الثقافة والمعرفة الغربية المهيمنة، ستحثّ بنية العلماني الإسلامي المسلمين على تأويل أكبر قدرٍ مستطاع من سلطة الشريعة؛ لتبرير توسعة مجالٍ يشرعن الاعتماد على الأدوات العلمانية من قبيل: العقل، والعلم، والرأي العام، والعرف، والخبرة، والمخيال الثقافي، وما شابه.
وإنه لتحدٍّ حقيقيٌّ، على أن مما يؤكِّد صوابية مسعاي هو تذكُّر حقيقة أن تجاهل العلماني الإسلامي قد أدى إلى إثقال الشريعة وتحميلها مسؤولية معالجة كافة المسائل المختلفة معالجةً عمليةً. وعند الفشل (الحتمي) لهذه المعالجة (فعلى سبيل المثال: كيف يمكن للشريعة أو كيف يمكن للفقهاء أن يعلموا ما يجعل الزوجة تشعر بالحب والحنان، أو كيف يمكن تعظيم الثروة الشخصية أو الجماعية؟)، سيؤدي الإحباط الذي يتبعه إلى زيادة جاذبية العلمانية بالمفهوم الغربي والحديث ليس إلَّا. وباختصار: بالرغم من جسامة الاستحقاقات المترتِّبة على هذا الخيار، فإننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العلماني الإسلامي وإما العلمانية الغربية.
إلَّا أننا سنظل مقصرين إذا تجاهلنا كلمات مونتسكيو (Montesquieu) الأريبة: «ومن أضمن الوسائل أن يهاجَم الدين بالزُّلفى ورغد العيش وأمل الغنى، وألا يهاجَم بما يُنذر، بل بما يُنسى به، وألا يهاجَم بما يغيظ، بل بما يقذِف في الفتور، وذلك حينما تؤثر الأهواء الأخرى في نفوسنا وحينما يصمت ما يوحي به الدين من الأهواء»(۸۸). أي إن إفساح مجالٍ أكبر للعلماني الإسلامي -غير الشرعي- يُسكِت الشريعة ويجمّدها (وربما هذا ما يطالب به خصومها)، وسيؤدي ذلك لا محالة إلى المزيد من اللامبالاة تجاه ما يُعد دينًا صامتًا. ولا شكَّ أن أكبر تهديد للدين ليس الاضطهاد، وإنما اللامبالاة المتولدة من عدم راهنيته.
إلَّا أن ثمة اعتبارين أتمنَّى أن يؤخذا على محمل الجد في مواجهة هذا التحدي. الأول: أن دعاة الاجتهاد لا يتوانون عن الإشارة إلى مضار التقليد(۸۹). ويُفترض بالطبع أن التقليد لا يتضمَّن قراءة المصادر، وإنما تقريرات المذهب التي بدورها يُفترض أنها قرأت المصادر قراءةً صحيحةً. وهو ما يمنح هذه القراءات الثابتة شرعيةً لا تتزحزح. ويتوجه الجزء الأكبر من الاهتمام إلى «التقليد الفقهي»، لكن تأثير هذه الظاهرة ومنطقها يمتدُّ إلى المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي.
فكما يعاني المسلمون المعاصرون من قيود الاستنتاجات الفقهية وشبه الفقهية ما قبل الحديثة، التي كانت بالضرورة مُشربةً بالحقائق والافتراضات والمشاعر ما قبل الحديثة، فإنهم ربما يعانون أكثر من سلطة معايير ما قبل الحداثة الاجتماعية والثقافية والسياسية ونفوذها، التي تستمدُّ مكانتها المفترضة من ارتباطٍ غامضٍ مع النصوص التي يُفترض (أو يُزعم) أنها أساس سلطتها. ومن هذا المنطلق، فإن التغلُّب على تأثير «التقليد العلماني» (لما قبل الحداثة) أصعب من التغلُّب على التقليد الفقهي، فهو أقل وضوحًا، ومن ثَمَّ أقل قابليةً للتحليل النقدي(۹۰).
ومن جهة أخرى، فإن المزيد من الانتباه الواعي إلى العلماني الإسلامي قد يدلنا على أن كثيرًا مما يُعَدُّ «إسلاميًّا» هو في الحقيقة ليس تفسيرًا للنص، ولا استنادًا إلى تقريرات المذاهب، وإنما استعمال فقهاء ما قبل الحداثة (وغيرهم) لعقولهم وتصوراتهم ومعارفهم الثقافية، وغيرها من المَلَكَات في طريقهم إلى اجتهاداتهم وغيرها من الاستخلاصات غير الشرعية المناسبة لسياقهم الخاص. وبإدراك ذلك يمكن للمسلمين المعاصرين التحرُّر مما سبق عليه الزمن من الأعراف، والأنماط السائدة، والتفضيلات، والرؤى، والتحيزات، والافتراضات وما شابه، مما قد يمثّل سلطةً عليهم. فإذا لم يعتمد هؤلاء السابقون بشكل جوهري على النص مباشرة ولا سلطان الشرعي، فإن أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه لن يعدو خيارات اجتهادية عملية، حتى فقهاء ما قبل الحداثة يعدّونها مفتوحةً للنقد والمراجعة المستمرة.
ومن ثَمَّ فإنه يمكننا -بإدراكنا للعلماني الإسلامي والمشاركة فيه- تحريرُ قوى العقل والثقافة والمخيال عند المسلمين المعاصرين -في جميع المجالات والتخصُّصات- من القيود غير المبررة للفهم المفرط في الشمولية للشريعة والتاريخ الإسلامي. وبذلك قد نقرّبهم من اجتناب العلمنة، عن طريق إعفاء الشريعة من المسؤولية عن المعالجة القاصرة لقضايا لم تأتِ الشريعة لمعالجتها من الأساس، وفتح الطريق أمام المسلمين المعاصرين -بما فيهم مَنْ هم خارج دائرة علماء الدين أو ربما هم على وجه الخصوص- إلى استنفار مواهبهم لاستعادة ضربٍ من السلطة المعرفية والثقافية، يمكنهم من خلالها إعادة تأسيس بنية مناسبة وكفؤة عمليًّا للإسلام في العالم الحديث.
ثانيًا وأخيرًا، فكما كررت مرارًا طيلة هذا المقال، فإن الشرعي والديني ليسا مترادفَيْن، حيث ينطوي الشرعي لزامًا على الديني، ولكن الديني ليس حكرًا على الشرعي بالضرورة. وهكذا، فإذا نتج عن مشاركتنا في العلماني الإسلامي راحة وأمل ورغد عيش، دون أن نعتمد في ذلك على «الشرعي» بالمعنى الضيق، فإن ذلك لا يعني -بخلاف مونتسكيو- اللامبالاة بالإسلام بوصفه دينًا. وفي النهاية، بين سياسة اقتصادية معقولة وأخرى، وبرنامج لعلاج الإدمان وآخر، وحد أقصى للسرعة وآخر، ثمة شيء غير العقل سيرشدنا إلى القرار النهائي.
وسيظل الإسلام في هذا السياق (أي الإسلام بوصفه دينًا ومنبعًا للهداية والبصيرة والفضيلة والرشاد يتجاوز العقل) وثيقَ الصلة بالمجال العلماني الإسلامي. وبعبارة أخرى، فإن في أذن العلماني الإسلامي وَقْرًا من مقولة غروشيوس «كما لو أن الإله غير موجود». وهذا هو الفارق الجوهري الأهم بينه وبين العلماني الغربي. وهذا يُلزم المسلم -حتى في أشد مساعيه علمانيةً- أن يكون على ارتباطٍ وجدانيٍّ دائمٍ بالإسلام بوصفه دينًا. وفي النهاية، وكما أشرت إلى ذلك في موضعٍ آخر، قد لا يفتح القول بأن الشريعة نطاق محدود الطريقَ إلى العلمنة الغربية بالقدر نفسِه الذي يفتحه الشعور أو الاعتقاد السائد بين المسلمين بأن الاعتماد على الاشتباك الفكري الخالص مع «الإسلام» أو الشريعة أو العلماني الإسلامي يكفي وحده -دون طلب الهداية والإرشاد من الله- لإتقان فن الحياة(۹۱).
الهوامش
(۱) * نُشِرت هذه الورقة في المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية (American Journal of Islamic Social Sciences)، العدد ۲ من المجلد ۳٤ (۲۰۱۷م). على الرابط:
https://www.ajis.org/index.php/ajiss/issue/view/2.
(۲) الأمثلة في هذا الصدد أكثر من أن تُحصى، لكن راجع على سبيل المثال: عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر: حوارات لعصر جديد (دار الفكر: دمشق، ط٤، ۲۰۱٤م)؛ جورج طرابيشي، هرطقات ۲: عن العلمانية كإشكالية إسلامية إسلامية (بيروت: دار الساقي، ۲۰۰۸م)، خاصةً الجزء الأول من ص۹ إلى ص۹۷.
(۳) من كلمة جاكسون عن «العلماني الإسلامي» في «جامعة جورج تاون في قطر»، على الرابط:
(٤) خوسيه كازانوفا، «العلماني والعلمانيات»، ترجمة: طارق عثمان، أوراق نماء ۸٤ (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات).
(٥) وجميعها مترجمة إلى العربية: الأول ترجمه نوفل الحاج لطيف ونشرته دار جداول عام ۲۰۲۰م، والثاني ترجمه محمد العربي ونشرته أيضًا دار جداول عام ۲۰۱۷م، وترجَمَ كتابَ الأديان العامة في العصر الحديث قسمُ اللغات الحية والترجمة في جامعة البلمند ونشرته المنظمة العربية للترجمة عام ۲۰۰٥م.
(٦) أحمد عاطف أحمد، «إسلامي علماني معًا: حوار بدأه صديقي الأستاذ شيرمان (عبد الحكيم) جاكسون»، مركز نهوض للدراسات والبحوث، ۱۳ أبريل ۲۰۲۰م.
(۷) كلمة جاكسون عن «العلماني الإسلامي»، على الرابط:
(٨) ولا شكَّ أن «الدين» بدوره يثير التباسًا مفهوميًّا كذلك. انظر على سبيل المثال:
R. T. McCutcheon, “The Category ‘Religion’ in Recent Publications: A Critical Survey,” Numen 42, no. 3 (October 1995): 284-309; J. Z. Smith, “Religion, Religions, Religious,” Critical Terms for Religious Studies (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 84-269.
(۹) وفقًا لما يراه تريلوكي ناث مادان، «فكلمة ’علمنة‘ استُخدمت لأول مرة عام ۱٦٤۸م في نهاية «حرب الثلاثين عامًا» في أوروبا للإشارة إلى نقل ممتلكات الكنيسة لملكية الأمراء الخاصة». انظر:
T. N. Madan, “Secularism in Its Place,” Secularism and Its Critics, ed. R. Bhargava, 6th ed. (New Delhi: Oxford University Press, 2007), 297.
ويقول إن الإنجليزي جورج جاكوب هوليوك (George Jacob Holyoake) قد صاغ هذا المصطلح لأول مرة عام ۱۸٥۱م. انظر: المرجع السابق، ص۲۹۸.
ووفقا لرأي أشيس ناندي (Ashis Nandy)، فإن هوليوك قد صاغ هذا المصلح في عام ۱۸٥۰م، في وقتٍ كان ما يزال «ملائمًا للدين». انظر:
“The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance,” in Secularism and Its Critics, 327.
وكانت «حرب الثلاثين عامًا» صراعًا دينيًّا مدمرًا بين الكاثوليك والبروتستانت، في الظاهر، أودت بحياة الملايين وانتهت بـ«صلح وستفاليا» (Peace of Westphalia). وأسجل هنا وجهة نظر مغايرة عن أهمية الحروب الدينية في أوروبا، انظر:
W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (New York: Oxford University Press, 2009), 123-80.
(١٠) وقد أشار كازانوفا عرَضًا إلى الكونفوشية والطاوية كأمثلة في هذا الشأن. انظر:
J. Casanova, “Secularization Revisited: A Reply to Talal Asad,” Powers of the Modern Secular: Talal Asad and His Interlocutors, ed. D. Scott and C. Hirschkind (Stanford: Stanford University Press, 2006), 19-20.
(١١) مقتبس من:
C. Taylor, “Modes of Secularism,” Secularism and Its Critics, 34.
(١٢) راجع الهامش رقم (10).
(١٣) J. Israel, Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670-1752 (New York: Oxford University Press, 2006), 64.
(١٤) Israel, Enlightenment Contested, 65.
(١٥) N. Stolzenberg, “The Profanity of the Law,” Law and the Sacred, ed. A. Sarat, L. Douglas, and M. M. Umphrey (Stanford: Stanford University Press, 2007), 34.
(١٦) S. Wolin, Politics and Vision: Politics and Change in Western Political Thought (Princeton: Princeton University Press, 2006), 147.
(١٧) انظر على سبيل المثال: مصطفى الزرقا، فتاوى مصطفى الزرقا (دمشق: دار القلم، ۱٤۲۰هـ/۱۹۹۹م)، ص٤۰٥.
(۱۸) على سبيل المثال: ينقل ابن رشد (الحفيد) الإجماعَ على أن المسلم لا يرث غير المسلم، بينما يميل ابن تيمية وابن قيم الجوزية الحنبليان إلى جواز أن يرث مَنْ أسلم أقرباءه غير المسلمين، (فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرًا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم، ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئًا). انظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (القاهرة: دار الفكر، بدون تاريخ)، ۲/۲٦٤. وابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ۳ أجزاء، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري (الدمام: الرمادي للنشر، ۱٤۱۸هـ/۱۹۹۸م)، ۲/۸٥۳-۷۲، وخاصةً ۲/۸٥۲-٥۳.
(۱۹) يمكننا النظر إلى حالة ولاية المظالم بوصفها شكلًا من العلماني المعترف به، إلا أنها كانت نظامًا بديلًا لإنفاذ القانون وليس للقانون في حد ذاته. وهو الانطباع الذي يحصل عليه المرء من الوصف الموثق كما عند الماوردي، إذ يقول: «نظر المظالم لا يبيح من الأحكام ما حظره الشرع». انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي (الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، ۱٤۰۹هـ/۱۹۸۹م)، ص۱۰۲-۱۲٦، والاقتباس من ص۱۱٥.
(يقول الماوردي: «ثم انتشر الأمر بعده (علي بن أبي طالب) حتى تجاهر الناس بالظلم والتغالب ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب، فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المتظلمين إلى نظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاء». انظر: المرجع نفسه، ص۱۰٤. - المترجم).
(۲۰) على سبيل المثال، يقرر الفقيه المعاصر محمد أبو زهرة أن «الإجماع في الإسلام قد انعقد على أن الحاكم في الإسلام هو الله تعالى، وأنه لا شرع إلا من الله». انظر: محمد أبو زهرة، أصول الفقه (القاهرة: دار الفكر العربي، بدون تاريخ)، ص٦۹. (هناك خطأ في التوثيق، في الأصل ص٦۳. - المترجم).
(٢١) T. Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003), 21-66.
(الترجمة العربية: تشكلات العلماني في المسيحية والحداثة والإسلام، ترجمة: محمد العربي (بيروت: جداول للنشر والترجمة والتوزيع، ۲۰۱۷م)، ص۳٥-۸۱. - المترجم).
(٢٢) J. Casanova, “The Secular and Secularisms,” Social Research 17, no. 4 (2009): 1052.
(يقول كازانوفا عن إطار المحايثة: «قام تشارلز تايلور في كتابه عصر علماني بإعادة تأسيس السيرورة التي أصبح عبرها ما يسميه ’إطار المحايثة‘ يتبدى فينومينولوجيًّا ككوكبة متشابكة من ثلاثة نُظُم حديثة ومتمايزة: النظام الكوني والاجتماعي والأخلاقي. وأصبحت هذه النظم الثلاثة مدركة بوصفها نظمًا علمانية محايثة بشكل محض، نظمًا مفرغة تمامًا من أية تعال، ومن ثَمَّ تؤدي عملها كما لو أن الإله غير موجود». انظر: «العلماني والعلمانيات»، ترجمة: طارق عثمان، أوراق نماء ٨٤. - المترجم).
(٢٣) J. Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 15, 20-25.
(يقول كازانوفا: «ولعل الصورة المعبرة التي ذكرها ماكس فيبر عن انهيار جدران الدير أفضل تعبير بياني عن إعادة الهيكلة المكانية الجذرية تلك. فالجدار الفاصل بين المملكتَيْن الدينية والزمنية داخل ’هذا العالم‘ ينهار، والفصل بين ’هذا العالم‘ و’العالم الآخر‘ -حتى الآن على الأقل- يظل قائمًا، ولكن ومن الآن فصاعدًا، سوف يكون هنالك عالم واحد، ’هذا العالم‘ العالم الزمني، ولا بدَّ أن يجد الدين فيه موقعه الخاص. ولئن كانت المملكة الدينية تبدو سابقًا كأنها الواقع الجامع الذي وجدت المملكة الزمنية ضمنه موقعها الخاص، فقد أضحى النطاق الزمني الواقع الجامع الذي يجب أن يتكيف معه النطاق الديني». انظر: خوسيه كازانوفا، الأديان العامة في العصر الحديث، ترجمة: قسم اللغات الحية والترجمة في جامعة البلمند (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، ۲۰۰٥م)، ص۳۰. - المترجم).
(٢٤) C. Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap Press, 2007), 594.
(٢٥) Ibid., 2-3.
(٢٦) See O. Roy, Secularism Confronts Islam, trans. G. Holoch (New York: Columbia University Press, 2007), xii-xiii, 7-8, 59
(وموزَّعًا على صفحات الكتاب).
(الترجمة العربية: أوليفييه روا، الإسلام والعلمانية، ترجمة: صالح الأشمر (بيروت: دار الساقي، 2016م). وفيه يفرّق روا بين العلمانية في طريقتها الفرنسية باعتبارها: 1- فلسفة: فهي مفهوم للقيم والمجتمع-الأمة يرتكز على فلسفة الأنوار والأخلاق العقلانية. 2- نتيجة للقانون: تنظيم الديني في المجال العام، أي العلمانية هي مجموعة قوانين. 3- مبدأ سياسي: ويعني به إرادة فك الارتباط بين الدولة والمجتمع والكنيسة. انظر: ص33-45. - المترجم).
(٢٧) S. L. Carter, God’s Name in Vain: The Wrongs and Rights of Religion in Politics (New York: Basic Books, 2000), 4.
(٢٨) انظر على سبيل المثال:
A. March, “Are Secularism and Neutrality Attractive to Religious
Minorities: Islamic Discussions of Western Secularism in the
‘Jurisprudence of Muslim Minorities’ (Fiqh al-Aqallīyāt) Discourse,” Cardoza Law Review 30, no. 6 (2009): 2821-54; A. An-Na‘im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 1.
(٢٩) See H. A. Agrama, Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, and the Rule of Law in Modern Egypt (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 24.
(الترجمة العربية: حسين علي عجرمة، مساءلة العلمانية: الإسلام والسيادة وحكم القانون في مصر الحديثة، ترجمة: مصطفى عبد الظاهر (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2017م)، ص50. - المترجم).
(٣٠) Asad, Formations, 36-37, nt. 41.
(الترجمة العربية: تشكلات العلماني، ص51، وقد ترجمها المقدس والمدنس، وأميل إلى ترجمتها المقدس والدنيوي. - المترجم).
(٣١) Ibid., 31, nt. 24.
(هكذا أوردها طلال أسد وترجمها محمد العربي، ولكني أورد ما قاله دوركايم في الأشكال الأولية للحياة الدينية ففيه فائدة تقرّبنا من فهم ما يعنيه وطبيعة الفصل بين عالمي المقدَّس والدنيوي في التصور «الغربي»، يقول: «لا يبقى بين أيدينا لتعريف المقدَّس بالنسبة إلى الدنيوي إلا التباين بينهما. غير أن ما يجعل هذا التباين كافيًا لتوصيف هذا التصنيف للأشياء، ولتمييزه من أي تصنيف آخر، هو أنه شديد الخصوصية لأنه ’مطلق‘؛ إذ لم يعرف تاريخ الفكر الإنساني مثالًا آخر عن فئتَيْن للأشياء متمايزتَيْن بهذا العمق، ومتعارضتَيْن بهذه الجذرية. والتعارض التقليدي بين الخير والشر لا يُعَدُّ شيئًا يذكر أمام هذا التعارض؛ لأن الخير والشر صنفان متعاكسان من النوع عينه، أي النوع الأخلاقي، مثلما لا تكون الصحة والمرض إلَّا ملمحَيْن مختلفَيْن لنسق وقائع واحد هو الحياة، في حين أن الذهن البشري كثيرًا ما تصور -وفي كل مكان- المقدَّس والدنيوي بوصفهما نوعَيْن منفصلَيْن، وكأنهما عالمان ليس بينهما ما هو مشترك»، ويردف: «يبلغ من هذا التباين أنه كثيرًا ما يتحول إلى تضاد حقيقي. فالعالمان ليسا مُصمَّمين ليكونا منفصلين فحسب، بل ليكونا متعاديين ومتنافسين بشدَّة أحدهما مع الآخر». انظر: إميل دوركايم، الأشكال الأولية للحياة الدينية: المنظومة الطوطمية في أستراليا، ترجمة: رندة بعث (الدوحة/بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ۲۰۱۹م)، ص٥۹-٦٦. - المترجم).
(٣٢) Ibid., 30.
(الترجمة العربية: تشكلات العلماني، ص٤٤).
(٣٣) انظر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، كتاب الأسماء والصفات (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ)، ص۳٥.
(وقد أورد البيهقي هذا الرأي اللغوي مع عدَّة آراء حول أصل لفظ الجلالة، وطعّم كل رأي بدلالات إيمانية، فقال: «الهاء التي هي كناية عن الغائب وذلك لأنهم أثبتوه موجودًا في فطر عقولهم … ثم زيدت فيه لام الملك، إذ علموا أنه خالق الأشياء ومالكها». انظر: البيهقي، كتاب أسماء الله وصفاته المعروف بالأسماء والصفات، تحقيق: محمد محب الدين أبو زيد (القاهرة: مكتبة التوعية الإسلامية ودار الشهداء، بدون تاريخ)، ص۱٤۱-۱٤۲. - المترجم).
(٣٤) Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press, 1964), 1.
(الترجمة العربية: جوزيف شاخت، مدخل إلى الفقه الإسلامي، ترجمة: حمادي ذويب (بيروت: دار المدار الإسلامي، ۲۰۱۸م)، ص۱۱. - المترجم).
(٣٥) W. B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New York: Columbia University Press, 2013), 51.
(الترجمة العربية: وائل حلاق، الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، ترجمة: عمرو عثمان (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ۲۰۱٤م)، ص۱۱۱. - المترجم).
(٣٦) J. Locke, Two Treatises of Government, ed. P. Laslett (New York: The New American Library, 1965), 448.
(«أي كلما هتكت حرمة القانون وأنزل الضرر بالآخرين». انظر: جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة: ماجد فخري (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، ۱۹٥۹م)، ص۲٦٥. - المترجم).
(٣٧) N. J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law,” International and Comparative Law Quarterly 6 (January 1957): 49.
(٣٨) كتب وائل حلّاق بعد أن بيَّن شمولية الدولة الحديثة فيما يتعلَّق بأحكامها السيادية: «وفي حين تتحكَّم الدولة الحديثة بمؤسساتها الدينية وتنظّمها، مخضعةً إياها لإرادتها القانونية، فإن الشريعة تتحكَّم بالمنظومة الكاملة من المؤسسات العلمانية وتنظّمها. وإذا كانت هذه المؤسسات علمانية أو تتعامل مع ما هو علماني، فهي تقوم بذلك في إطار الإرادة الأخلاقية الرقابية الشاملة التي هي للشريعة. ولذلك، فإن أيَّ شكل سياسي أو مؤسسة سياسية (أو اجتماعية أو اقتصادية)، بما فيها السلطات التنفيذية والقضائية، هي في النهاية خاضعة للشريعة». انظر: Hallaq, The Impossible State, 51. (وفي الترجمة العربية: ص١١١). وبالنظر إلى رسوخ هذه الرؤية، وجزء منه بسبب وضوحها، فقد يصعب على القرَّاء التركيز على النقطة الأساسية التي أطرحها هنا. ويكفي أن نقول إن ثمة فارقًا بين الشريعة والإسلام، وحيث تنتهي أحكام الشريعة، فإنه لا يمكنها تنظيم مسألة ما مباشرةً، حتى لو بقيت المسألة نفسها ضمن نطاق قيم الإسلام وفضائله. باختصار، إن كان للإسلام دخل في كل المسائل، فإن الشريعة ليس لها مثل هذا الدور.
(٣٩) يواجه عويمر أنجم (Ovamir Anjum) مشكلة استبعاد المجتمع من التفاوض على نظام الحياة اليومية في كتابه:
Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyan Moment (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
(٤٠) يبيّن إغناس غولدتسيهر في عمله البارز أن قضية الظاهرية لم تكن الحرفية في حد ذاتها، وإنما كانوا يحاولون معارضة الرأي الذي لا يستند مباشرةً إلى مصادر الوحي. انظر:
I. Goldziher, The Zahiris: Their Doctrine and Their History, trans.
W. Behn (Leiden: E. J. Brill, 1971).
(وقد صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب: إغناس غولدتسيهر، الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم، ترجمة: محمد أنيس مورو (بيروت: مركز نماء للدراسات والبحوث، ٢٠٢١م). - المترجم).
وفي الوقت نفسِه، يقرّ ابن حزم (ت. ٤٥٦هـ/۱۰٦٤م) -الذي يُعَدُّ أحد أبرز ممثلي الظاهرية- صراحةً بمشروعية المتشابهات (أو ظن التعارض) في بعض النصوص. انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام، ۸ مجلدات، تحقيق: أحمد محمد شاكر (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ۱۳۰۸هـ/۱۹۹۳م)، ۲/۲۸.
(كان ابن حزم يورد في هذا المقام الردَّ على ما «ادعاه قوم من تعارض النصوص»، ولعل جاكسون يقصد إقراره بورود هذا التعارض ليس إلَّا في معرض الكلام عن موقف الظاهرية من الحرفية والرأي والقياس. - المترجم).
(٤١) A. K. Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim Moral Thought (New York: State University of New York Press, 1995), 16.
(٤٢) انظر: أبو إسحاق الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الرائد العربي، 1970م).
(٤٣) لمناقشة عامة حول هذه النقطة، انظر على سبيل المثال:
Reinhart, Boundaries, 128-32.
(٤٤) انظر: ابن رشد (الحفيد)، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى، تحقيق: جمال الدين العلوي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۹۹٤م)، ص٤۷-٤۸. (قال: «وهنا يتبيّن سقوط قول من قال المباح مأمور به، وكذلك يتبيّن أنه ليس من التكليف، إذ التكليف طلب ما فيه كلفة، ومن سمَّاه تكليفًا وذهب في ذلك إلى أنه الذي كلّفنا اعتقاد إباحته في الشرع، أو أنه الذي كلّفنا اعتقاد كونه من الشرع، فهو مستكره في التسمية…». - المترجم).
(٤٥) جزء من المسألة التي يجب أن أعرضها هو أنه حتى عندما تتطلب الشريعة فعلًا أو الامتناع عن فعل، فقد تظل هناك قواعد تقييمية أخرى تمكِّن من تقييم كيفية القيام بهذا الفعل أو الامتناع بشكل يتلاءم مع الواقع الزماني والمكاني. وهنا قد نفكِّر في حدود الشريعة من حيثُ العمق في مقابل النطاق. انظر ما سيأتي.
(٤٦) التقسيم إلى فترتي «التكوين» و«ما بعد التكوين» محل خلاف، سواء من حيث الزمن أو المعنى أو الأثر. وقد عرضت انتصار ربّ (Intisar Rabb) مؤخرًا مفهوم «فترة التأسيس» بديلًا، مشيرة إلى ثلاث مراحل متميزة: (۱) فترة التأسيس (من القرن السابع إلى القرن التاسع الميلادي). (۲) فترة النصوصية (القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان) وتشمل «إغلاق أبواب الاجتهاد» المزعوم. (۳) فترة توليف السلطة النصية والتفسيرية. انظر:
I. Rabb, Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 8-9.
(الترجمة العربية: انتصار ربّ، قاعدة الشك عند الفقهاء المسلمين: تاريخ القواعد الفقهية والتأويل والفقه الجنائي الإسلامي، ترجمة: سعيد منتاق (بيروت: مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ٢٠١٨م). - المترجم).
(٤٧) يعود تاريخ ذلك إلى أطروحتي في الدكتوراه:
“In Defense of Two-Tiered Orthodoxy: A Study of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī’s Kitāb al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām” (PhD diss., University of Pennsylvania, 1991).
(٤۸) انظر على سبيل المثال: ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد الحفيظ شلبي (دمشق: دار ابن كثير، ۱٤۲٦هـ/۲۰۰٥م)، ص٥۲۳.
(«فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي». انظر: سيرة ابن هشام، ط.عيسى الحلبي، ۱۹٥٥م، ۱/٦۲۰. - المترجم).
(٤۹) انظر: مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ٥ مجدات (بيروت: دار ابن حزم ۱٤۱٦/۱۹۹٥)، ٤/۱٤٦٤.
(٥۰) نفسه.
(٥۱) انظر على سبيل المثال: ابن الحاجب، جامع الأمهات، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضري (دمشق: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ۱٤۲۱هـ/۲۰۰۰م)، ص۳۳۱ وما بعدها.
(قال ابن الحاجب: «وقدَّرَ مالك المُدَّ في اليوم، وقدَّر ابن القاسم أوقيتين ونصفًا في الشهر إلى ثلاث؛ لأن مالكًا بالمدينة وابن القاسم بمصر. وقال وإن أكل الناس الشعير أكلته، وأمر الإدام كذلك، قال: ولا يُفرض مثل العسل والسمن والحالوم والفاكهة، ويُفرض الخل والزيت والحطب والملح والماء واللحم المرة بعد المرة…». انظر: ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص۳۳۱. - المترجم).
(٥۲) انظر على سبيل المثال: الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر (القاهرة: المكتبة العلمية، ۱۳٥۸هـ/۱۹۳۹م)، ص٤۸۷-٥۰۳، في الاجتهاد.
(٥٣) A. El-Shamsy, “Rethinking Taqlīd in the Early Shafi‘i School,” Journal of the American Oriental Society 128, no. 1 (2008): 14-15.
(٥٤) انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، ٦ مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱٤۳۳هـ/۲۰۱۲م)، ٥/۱۹۰.
(٥٥) انظر: الغزالي، المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، تحقيق: جميل صليبا وكامل عياد (بيروت: دار الأندلس، بدون تاريخ)، ص۱۰۲. وما من شكٍّ في أن الغزالي لم يسر على طريق واحد في معالجة هذه المسألة، فيذكر في المستصفى -على سبيل المثال- ثلاثة أنواع من العلوم: «عقلي محض، لا يحث الشارع عليه ولا يندب إليه، كالحساب والهندسة والنجوم وأمثالها من العلوم، فهي بين ظنون كاذبة لا ثقة بها وبين علوم صادقة لا منفعة فيها». وقد انتقد رأيَه ابنُ رشيق المالكي (ت. ٦۳۲هـ/۱۲۳٥م) في تعليقه على المستصفى، مؤكدًا أنه «لا يجوز إطلاق القول بأنه لا منفعة فيها». انظر: حسين بن رشيق المالكي، لباب المحصول في علم الأصول، مجلدان، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي (دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ۱٤۲۲هـ/۲۰۰۱م)، ۱/۱۸۹. ومن المؤكَّد أن كليهما كان محكومًا بسياق تاريخي محدد فيما يتعلَّق بدرجة تعرض العلوم غير الإسلامية بشكل عام أو عدم تعرضها لقضايا تتعلَّق بالدين أو تحتمل إصابته.
(٥٦) انظر عملي:
Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (Leiden: E. J. Brill, 1996), 113-41.
(٥۷) انظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق: المزيدي (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۳۹۹هـ/ ۱۹۷۹م)، ص۱۰۹. (عدت إلى ط. طه عبد الرؤوف سعد (القاهرة: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ۱۳۹۳هـ/ ۱۹۷۳م)، ص۸۹. - المترجم).
(٥۸) انظر على سبيل المثال: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ۱۱ مجلدًا، تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ۱۳۹۹هـ/۱۹۷۹م)، ٤/۱٤٦.
(٥۹) انظر على سبيل المثال: جلال الدين السيوطي، جهد القريحة في تجريد النصيحة (بيروت: المكتبة العصرية، ۱٤۳۰هـ/۲۰۰۹م)، ص۹۱-۹۲. وهو مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية. وهذا لا يعني أن النص ليس له رأي بالضرورة نابع من موقع ديني في ادعاء عقلي محدد. والأمر ببساطة هو أن هذه الدعوى يجب أن تفحص عقلًا لتحديد ماهيتها قبل الحديث عن الحكم الشرعي. وهنا ملاحظة أخرى، فمن الواضح هنا أني لا أتفق مع وجهة نظر زميلي السابق جون والبريدج (John Walbridge) حين كتب: «وقد أبغض ابنُ تيمية -مجددُ القرن الرابع السلفيُّ الكبير- العقلَ أينما تجلَّى في الحياة الفكرية الإسلامية». انظر كتابه:
God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 5.
(الترجمة العربية: الله والمنطق في الإسلام: خلافة العقل، ترجمة: تركي المصطفى (بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، ۲۰۱۸م). - المترجم).
(٦۰) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، ۳ مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱٤۲٤هـ/۲۰۰٤م)، ۱/۳۰.
(٦۱) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ۱۲ مجلدًا، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي أحمد معوض (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱٤۱٥هـ/۱۹۹٤م)، ۱/۱۱۸.
(٦۲) كتَب العالم المتأخر محمد الخضر حسين: «ومَن أمعَن النظر، رأى الفرق واضحًا بين ما أرشد إليه الدين وما تركه لتجربة المخلوقين». انظر دراسات في الشريعة الإسلامية (دمشق: دار الفارابي للمعارف، ۱٤۲٦هـ/۲۰۰٥م)، ص۱۳.
(٦٣) Casanova, Public Religions, 21-25.
(وفي الترجمة العربية: ص٣٤-٤١).
(٦٤) Asad, Formations, 237.
(وفي الترجمة العربية: ص٢٥٩).
(٦٥) C. Taylor, “Secular Imperative,” 32-33.
(٦٦) تلخص انتصار ربّ موقف المعتزلة فيما يلي: «الفكرة هي أن ثمة نظامًا أخلاقيًّا متداخلًا في نسيج هذا العالم يمكن للبشر تمييزه بالعقل، وقد ترك الله البشر أحرارًا في اتباع إرشادات تلك الأخلاق أو تجاهلها، ووعدهم بمجازاتهم على هذا الأساس … وما كان الفكر البشري ينظر إليه أخلاقيًّا على أنه صواب أو خطأ فهو كذلك عند الله … وبعبارة أخرى، الأخلاق موضوعية، بمعنى أن تصورات القيمة الأخلاقية لا ينبغي أن تختلف بين الله والبشر». انظر كتابها: Doubt in Islamic Law, 273. وأودُّ أن أقول إن واقعية المعتزلة لا ملكة حكم العقل في حد ذاتها هي ما كانت محل انتقاد أهل السُّنة الذين فضلوا مقاربة إرادية تقدر الله وقدرته وفعله المستقل. ولا شكَّ أن إرادة الله ذاتها ستكون محلَّ خلاف داخل المذهب السُّني نفسه. فعلى سبيل المثال، بينما اعتبر ابن تيمية موقف المعتزلة ضعيفًا، فقد رفض تمامًا «الطبيعيات الواهية» للأشاعرة. فهو يرفض قولهم إذا تحدث القرآن عن النبي: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر}: «فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم، وينهاهم عمَّا ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليه. بل الأمر والنهي والتحليل والتحريم، ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولا طيب ولا خبيث». انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧ مجلدًا، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (الرياض: مكتبة المعارف، بدون تاريخ)، ٨/٤٣٣.
(٦٧) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية، ۱٤۱٦هـ/۱۹۹٥م)، ص۱۱۰.
(٦۸) الاقتصاد في الاعتقاد (القاهرة: البابي الحلبي وأولاده، بدون تاريخ)، ص۸۰-۸۲.
(وقد رجعت إلى الكتاب بتحقيق مصطفى عمران لتعثُّر وصولي لهذه النسخة التي عاد إليها الكاتب، ولم يذكر الغزالي صراحةً جملة «بمعزل عن الوحي»، وإنما يفهم ذلك من كلامه، وهذا تمامه: «وهذا الانقسام ثابت في العقل، فالذي يوافق الفاعل يُسمَّى حسنًا في حقه، ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه يُسمَّى قبيحًا، ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه». وفي الهامش: «يقول صاحب المواقف وشارحها: وقد يعبر عن الحسن والقبح بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة». انظر: الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: مصطفى عمران (القاهرة، دار البصائر، ۲۰۰۸م)، ص٤۲۰. - المترجم).
(٦۹) كتاب الأربعين في أصول الدين، تحقيق: محمود عبد العزيز محمود (بيروت: دار الكتب العلمية، ۲۰۰۹م)، ص۲٤٤.
(۷۰) عن موقف الماتريدية، انظر على سبيل المثال: كمال بن محمد بن محمد بن أبي شريف المقدسي، كتاب المسامرة في شرح المسايرة، مجلدان (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ۲۰۰٦م)، ۲/۳۸. عبد الرحيم بن علي بن المؤيد شيخ زاده، نظم الفرائد وجمع الفوائد في المسائل المختلف فيها بين السادة الأشعرية والسادة الماتريدية، مخطوط رقم ۸۷٥، علم الكلام، ۱٤ مجلدًا (دار الكتب المصرية).
(۷۱) انظر: أمراض القلوب وشفاؤها (القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها، ۱۳۸٦هـ/۱۹٦٦م)، ص۱۲-۱۳.
(لم أقف على هذا العزو، وإنما كان كلام ابن تيمية أن الإنسان، «وإن كان أقرَّ بأن محمدًا رسول الله وأن القرآن حقٌّ على سبيل الإجمال، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه، وما عرفه فكثير منه لم يعمله، ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسُّنة، فالقرآن والسُّنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية، لا يمكن غير ذلك لا يذكر ما يخص به كل عبد، ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم». - المترجم).
(۷۲) مجموع الفتاوى، ۸/٤۳٤-٤۳٥. (وقد جاءت في معرض حديث ابن تيمية في سياق الكلام عن التحسين والتقبيح عن «أن يكون الفعل مشتملًا على مصلحة أو مفسدة، ولم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم مشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعلم والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة، إذا لم يرد شرع بذلك…». - المترجم).
(۷۳) كان العقل كما استخدمه الفقهاء والمتكلمون المسلمون قبل الحداثة يشمل الوجدان والعناصر التي سعى «التنوير» إلى إزاحتها عن بنية العقل. فعندما يتحدَّث المعتزلة (وغيرهم) عن خيرية إنقاذ الغريق والشر في اتهام البريء زورًا على أنها بديهية عقلية، فمن الواضح أن هذا العقل يتجاوز قواعد العقل باعتباره ملكة مستقلة غير محدودة أو مسيّرة من الثقافة، أو المشاعر، أو العرف. وهو نقيض العقل الذي دعا إليه مفكرو عصر «التنوير» أمثال إيمانويل كانط (Immanuel Kant)؛ إذ دعوا إلى «ملكة مستقلة بمعنى أنها ذاتية الحكم، تؤسس أحكامها الخاصة وتتبعها، ومستقلة عن مصالح السياسة والثقافة واللاوعي». عن هذه النقطة، انظر:
F. C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 8.
(۷٤) قد يُعترض على كلامي بدعوى أنه تبعٌ لتعريفي الضيق للاجتهاد. لكن أي محاولة للعودة إلى منظور فترة التكوين التشريعي، حيث كانت الحدود بين التفسير والتجريب غير محددة أو غائبة، ستقرّ بهذا التعريف. وبالإضافة إلى ذلك، لا بدَّ أن نأخذ في الاعتبار الانتهاكات المحتملة للفقه إذا طُبق الاجتهاد من هذا المنظور في العصر الحديث. وثانيًا: إن أيَّ دعوة أو إقرار بالتمييز بين علماء النصوص وعلماء الواقع لا بدَّ أن تقترن باعترافٍ ضمنيٍّ بأن ما يُراد في كثيرٍ من الحالات ليس حكم الشريعة، وإنما أحكام تقييمة أخرى. وإلا فإننا سنبقى في حدود المجال الشرعي، وفي نطاق علماء النصوص عمليًّا.
(۷٥) حتى قاسم أمين -على سبيل المثال- يذكر أن مشكلته ليست في الحجاب ذاته، وإنما على شكلٍ منه تعارف عليه الناس في مصر في ذلك الوقت: «لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصًا تقضي بالحجاب على ما هو معروف الآن عند بعض المسلمين لوجب عليَّ اجتناب البحث فيه، ولَمَا كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرَّة في ظاهر الأمر؛ لأن الأوامر الإلهيَّة يجب الإذعان لها بدون بحث ولا مناقشة، لكننا لا نجد نصًّا في الشريعة يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة». انظر كتابَه تحرير المرأة في: قاسم أمين، الأعمال الكاملة، تحقيق: محمد عمارة (القاهرة: دار الشروق، ۱٤۰۹هـ/۱۹۸۹م)، ص۳٥۲.
(۷٦) قد يسوغ لنا ذلك إلقاء نظرة على ملاحظة طارق رمضان، أحد أبرز دعاة الاجتهاد: «بعد التأصيل المستمر للاجتهاد والتجديد والإصلاح على مدار أكثر من قرن، ما يزال المسلمون -سواء في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة أو المجتمعات الغربية- يجدون صعوبةً في التغلُّب على الأزمات المتلاحقة التي يمرون بها، وتقديم أكثر من مجرد إجابات جزئية؛ حتى هذه الإجابات ظلت اعتذارية أو (ناتجة) عن مواقف دفاعية في غالبها». انظر كتابه:
Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation (New York: Oxford University Press, 2009), 30.
(الترجمة العربية للكتاب: طارق رمضان، الإصلاح الجذري: الأخلاقيات الإسلامية والتحرر، ترجمة: أمين الأيوبي (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2009م)).
ومن الغريب أنه يبدو أحيانًا واقعًا في شرك تضخيم الفقه إلى حد إسباغ أهمية له تتجاوز ما هو قانوني. وعندما يصل الفقه إلى منتهاه، يشدّد على الأخلاق باعتبارها بديلًا مناسبًا، وهو ما أراه تهافتًا للمقترب الأخلاقي، انظر ما سيأتي.
(۷۷) محمد عبده، الزواج، في: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، ٥ مجلدات، تحقيق: محمد عمارة (القاهرة: دار الشروق، ۱٤۲۷هـ/۲۰۰٦م)، ۲/۷۰ (والمقال من ص ۷۰ إلى ص۷٥).
(۷۸) Asad, Formations, ۲۳۲-۳٤.
(في الترجمة العربية: ص۲٥۳-۲٥۷).
(۷۹) محمد عبده، الزواج، ص۷۳. وبالمناسبة، ليس غرضي من ضرب هذا المثال أن أقول إن محمد عبده أخفقَ -بشكل عام- في إدراك العلماني الإسلامي.
(٨٠) See P. L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion (New York: Anchor Books, 1967), 110-13.
يرى بيرغر أن النجاح الكبير الذي حقَّقته البروتستانتية الحديثة المبكِّرة في تجريد العالم من أيِّ عناصر صوفية أو خارقة الطبيعة قد أدى -من بين أمور أخرى- إلى إضعاف قدرة الدين على الحفاظ على راهنيته في العالم الحديث، مما أدى إلى ظهور وانتشار رؤية علمانية (أي غير دينية) للعالم. ولا أقول إن ذلك ما حدث في العالم الإسلامي (ووضع المسلمين في الغرب أمر مختلف)، بل وجهة نظري ببساطة هي أن «إطار المحايثة» الفكري والثقافي الذي يوجد فيه الدين يؤثر في استساغته بشكل عام أسلوبًا للحياة.
(٨١) وهنا أرى الارتباط الشديد لرأي إدوارد برناي (Edward Bernays)، لا سيما مع معطيات عالمنا المعاصر المعولم: «إن التلاعب الواعي والذكي بالعادات المنتظمة للجماهير وآرائهم عنصرٌ مهمٌّ في المجتمع الديمقراطي. أولئك الذين يتلاعبون بهذه الآلية غير المرئية للمجتمع يشكّلون حكومة غير مرئية، وهي القوة الحاكمة الحقيقية لبلدنا. إن رجالًا لم نسمع بهم يحكموننا، ويقولبون عقولنا، ويشكّلون أذواقنا، ويعدّون أفكارنا، إلى حد كبير». انظر كتابه الذي ظهر للمرة الأولى عام ١٩٢٨م: Propaganda, New York: Ig Publishing, (2005), 37. وقد يوفر لنا ذلك كذلك السياق الذي نقدّر فيه النظرة التي عبّر عنها مؤخرًا الشيخ يوسف القرضاوي من أن التأثير الذي يحتاج إليه الإسلام ليس الجهاد العنيف، أو التزامًا أشد جدية بالعنف المنظم، وإنما: «جيش ضخم من الدعاة والمعلمين والصحفيين المدربين القادرين على مخاطبة الجماهير بلغة العصر وأدواته، من خلال الصوت، والصورة، والكلمة، ولغة الجسد، والكتب، والمنشورات، والمجلات، والحوارات، والوثائق، والدراما، والصورة المتحركة، وأي شيء يمكن أن يربط الناس بالإسلام. هذا الجهاد السلمي الضروري الذي لم نقم فيه بواحدٍ من الألف مما هو مطلوب منا». انظر: يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، مجلدان (القاهرة: مكتبة وهبة، ۱٤۳۰هـ/۲۰۰۹م)، ۱/٤۰۲-٤۰۳. وبالطبع تندرج كل هذه الأنشطة في إطار العلماني الإسلامي؛ فليس منها مسلك شرعيّ.
(٨٢) وهذا يرتبط -فيما أحسب- بالاتجاه إلى مساواة الإسلام بالأخلاقية كأولوية بالتوازي مع افتراض ألَّا قيم أخرى (كالنظام، والخوصصة، والأمان، والخيرية) تنافس الأخلاقية. ويُنظر إلى الشريعة في هذا السياق على أنها مسار حركي أخلاقي يتيح لنا مع الأخلاق ضبط الأشياء. وفي الوقت نفسِه، يغفل عن أن الأخلاقي ما يزال مقترنًا بافعل ولا تفعل، ومن ثَمَّ يستغلق العالم عليه بعيدًا عن الخير والشر.
(٨٣) حركة أمة الإسلام (Nation of Islam)، أو البلاليون، هي حركة للمسلمين السود تأسَّست في أمريكا عام ١٩٣٠م على يد والاس فرد محمد (Wallace Fard Muhammad)، ومن أبرز قادتها إليجا محمد (Elijah Muhammad) وابنه وارث دين محمد (Warith Deen Mohammed). وتجمع أفكارها بين الإسلام وأفكار القومية السوداء. وقد تعرضت للقمع خلال الحرب العالمية الثانية، ونشطت في الخمسينيات والستينيات بفضل انخراط مالكوم إكس (Malcolm X) فيها، ثمّ طُرِد منها وقُتِل على أيدي منتسبيها. ويقودها حاليًّا لويس فرخان (Louis Farrakhan). (المترجم)
(۸٤) أدرك أن إشارتي هنا إلى المقاربة الحديثة للسياسة الشرعية مفرطة في التبسيط، لكن التباين الذي يدور في ذهني يمكن أن يتضح مع المقارنة بين المفهومَيْن الحديث والقديم. يورد محمد جميل غازي في مقدمته لكتاب ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية في معرفة السياسة الشرعية تعريفَ السياسة عند ابن عقيل الحنبلي (ت. ٥۱۳هـ/۱۱۱۹م) جنبًا إلى جنب مع تعريف عبد الوهاب خلاف المعاصر. فيقول ابن عقيل: «السياسة ما كان فعلًا يكون الناس به أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه النبي ولا نزل به وحي». أما تعريف عبد الوهاب خلاف فهو: «السياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين». انظر: ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في معرفة السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي (القاهرة: مكتبة المدني، بدون تاريخ) ص، غ. وقد أورد عبد الوهاب خلاف التعريفَيْن كذلك في كتابه السياسة الشرعية (ص۱٥-۱۷)، وعلى ما يبدو دون أن يرى أيَّ توتر بينهما. وبالمناسبة، يمكننا أن نلاحظ في تعريف ابن عقيل انطواءه على اعتراف بحدود للشريعة، وبعدها ينبغي أن يُعتمد على الأفعال الاجتهادية فيما لم يرد فيه نصٌّ.
(۸٥) انظر على سبيل المثال:
F. Vogel, Islamic Law and Legal System (Leiden: E. J. Brill, 2000), 173-4.
وهو يناقش جوانب هذه المقاربة في حالة المملكة العربية السعودية.
(۸٦) انظر على سبيل المثال: القرافي، الفروق، ٤ مجلدات (بيروت: عالم الكتاب، بدون تاريخ)، ٤/۳۹. حيث يناقش ما ينفذ من هذه التصرفات وما لا ينفذ.
(۸۷) انظر على سبيل المثال: القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، ۱۳۸۷هـ/۱۹٦۷م)، ص۱۸۳. إذ يورد حالات، مثل إعلان الحاكم للجهاد، حيث يمكن للمجتمع أن يتجاهل تصرفاته إذا رأى أنها تفتقد المضمون أو الشرعية.
(يقول القرافي: «النوع السادس: من تصرفات الحكام، الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها، من تحريم الأبضاع، وإباحة الانتفاع، وطهارات المياه، ونجاسات الأعيان، ووجوب الجهاد، وغيره من الواجبات، وليس ذلك بحكم، بل لمن لا يعتقد ذلك أن يفتي بخلاف ما أفتى به الحاكم أو الإمام الأعظم». - المترجم).
(٨٨) مقتبَس في:
J. J. Owen, “Church and State in Stanley Fish’s Antiliberalism,” American Political Science Review 93, no. 4 (1999): 922.
(الترجمة العربية: مونتسكيو، روح الشرائع، ترجمة: عادل زعيتر (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ۲۰۱۳م)، ص۸۱٦).
(٨٩) Ramadan, Radical Reform, 22.
(٩٠) هذا لا يعني أن كلَّ استنتاج علماني توصل إليه المسلمون قبل الحداثة خاطئ وغير شرعي ولا مؤتمن. بل الأمر ببساطة أنه لا يمكن لأيِّ مجتمع أن يستند بالكلية إلى القانون بمعنى الكلمة، ولا حتى بالنسبة إلى مؤسساته القانونية. إذ سيكون على المجتمع الاعتماد على مختلف المعايير والافتراضات غير النصيَّة. وما هو خارج النص ليس بالضرورة خطأ أو غير شرعي. بل إن القرآن أرشد النبي والصحابة إلى الاعتماد على أشكال المعروف الموجودة في الجزيرة العربية من قبل الإسلام. وتأتي المشكلة بالطبع عندما تتوسل هذه الأعراف بسلطة أكبر وأدوم مما يجب أن تكون عليه سلطتها.
(٩١) انظر على سبيل المثال عملي:
“Islamic Law, Muslims and American Politics,” Islamic Law and Society 22 (2015): 289.
(يقول جاكسون في مقاله «الشريعة والمسلمون والسياسة الأمريكية»، إنه لو كانت الشريعة نظامًّا شموليًّا فلن تكون هناك جدوى من طلب الهداية من الله، اللهم إلا في بداية الأمر؛ إذ ستهمش هذه النظرة الشمولية العلاقة الديناميكية الوجدانية بين العبد وربه، وهو ما يعني علمنة للإسلام والشريعة أكثر من أيِّ محاولة لوضع حدود للشريعة. - المترجم).