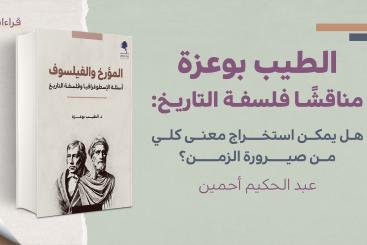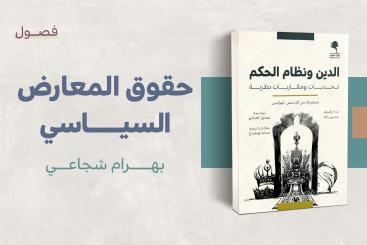فنُّ الحكم في الإسلام..حوار مع المفكِّر التونسي مكرم عبَّاس

كيف فكَّر الإسلام في السلطة والحكم؟ إن مؤلفي "الآداب السلطانية"، والفلاسفة مثل الفارابي وابن خلدون، والفقهاء، لم يتعاملوا مع المسألة بالطريقة نفسها، وبنوا فكرًا معقَّدًا لفنِّ الحكم لا يرتكز على هوية "إسلامية" مقرَّرة سلفًا، بل متحاورة باستمرار مع علم الكلام. هذا ما يتناوله الحوار مع المفكِّر التونسي مكرم عبَّاس أستاذ الدراسات العربية بالمدرسة العليا للمعلِّمين في مدينة ليون بفرنسا، والمهتم بنظرية الحرب في الإسلام والفكر السياسي الإسلامي في العصر الوسيط، والفلسفة السياسية والأخلاقية عند الفارابي وابن رشد وابن باجة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الإسلام والسياسة في العصر الوسيط الذي يستعدُّ مركز نهوض للدراسات والنشر لنشره قريبًا في نسخة عربية من ترجمة معرِّب هذا الحوار(*).
-
أنت مؤلِّف كتاب "الإسلام والسياسة في العصر الوسيط"، وهو الكتاب الذي جذب الكثير من الاهتمام حين نُشر بما أنه تناول عددًا من المواضيع السياسية المتعلِّقة بفنِّ الحكم ومسألة الحرب والسلم؛ ولكن أصالته قد تكون في إبرازه ثلاثة أنواعٍ محدَّدة من النصوص: الآداب السلطانية، وهي نصوص مجهولة عند الغرب ولكن لا ينبغي أن تُفاجئ من يقرأ مكيافيلي؛ والنصوص الفقهية، ونصوص الفلسفة السياسية التي يمثِّل الفارابي وابن خلدون أهمَّ شخصياتها. فما هي نقطة انطلاق هذا المشروع؟
كان هدفنا في هذا الكتاب هو استكشاف عقلانيات الحكم التي نشأت في عصر الإسلام الوسيط (بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر للميلاد)، وقد حاولنا دراسة السياسة من خلال التمايز أولًا عن الأطروحات التي تتناولها من منظور دينيٍّ، ومن ثمَّ الابتعاد عن تحليل الأشكال القانونية أو المؤسسية التي أنتجت الدول المعروفة باسم الخلافة أو الإمارة أو السلطنة. وبابتعادنا عن هاتين الطريقتين، حاولنا من خلال دراسة تبادلية الممارسات الحكومية أو خصوصيتها كشفَ المرجعيات التي حدَّدت منهج فقيهٍ مثل الغزالي (ق 11 و12 م)، أو أحد مؤلِّفي الآداب السلطانية مثل ابن المقفّع (ق 7 م)، أو فيلسوف مثل الفارابي (ق 10 م). وقد سمح لنا هذا الابتعاد عن المقاربات السائدة بالتركيز على الطرائق الفعلية التي تمَّ من خلالها التفكير في السلطة والحكم في الوقت ذاته.
وتوجد في هذا المجال عدَّة تقاليد لا يمكن تجاهل خصوصيتها. فنجد أن مفكرًا سياسيًّا عظيمًا مثل مكيافيلي لا يسلك في أعماله مسلك رجل القانون الحريص على إنشاء قواعد مجرَّدة أو قواعد دستورية، ولا مسلك الفيلسوف الذي يفكِّر في السياسي انطلاقًا من فكرة الخير أو السعادة، بل تنخرط مقاربته ضمن تقليدٍ موروثٍ هو الآداب السلطانية [مرايا الأمراء في التقليد الغربي] التي ترتكز في أساسها على تاريخ كبار الملوك من مؤسسي الدول أو الإمبراطوريات. وتمثِّل مسألة أخلاق الأمير وسلوكه موضوعًا مركزيًّا في هذا النوع من النصوص، بينما نجدها موضوعًا ثانويًّا في المقاربات القانونية والمؤسسية. ومن هنا كان هدفنا هو البحث عن المجالات التي تمتح منها هذه التقاليد النصيَّة مبادئها والمسبقات النظرية التي تنبني عليها النماذج التي تسمح بالتفكير السياسي في كلٍّ منها. وقد أوضحت خاتمة هذا الكتاب أن كتَّاب الآداب السلطانية يعتمدون التاريخ السياسي لكبار الحكَّام من أجل استنباط قواعد الحكم منها، بينما يزعم الفلاسفة بناء خطاب علميٍّ وبرهانيٍّ في السياسة معتمدين نماذج علومٍ أخرى مثل الميتافيزيقيا والبيولوجيا أو العلوم العقلية، وأن موضوع عمل الفقهاء كان في نهاية المطاف هو الاشتغال على التعارض الموجود بين القاعدة والاستثناء، وهذا لعمري من سمات المقاربة الشاملة للمتخصِّصين في القانون. وفي كل تقليد، اعتمد الفكر السياسي مرجعًا ينطلق منه ونموذجًا يسعى للنسج على منواله، سواء على مستوى المبادئ أو من حيث الآثار المترتبة عن النظرية.
الآداب السلطانية أو فنُّ الحكم
-
فيما يتعلَّق بكتب الآداب السلطانية، فهي جنس أدبيٌّ مخصوص. ما هي خصوصيتها مقارنة بالطريقة التي تمَّ بها التفكير السياسي في الغرب في ذلك الوقت؟ كيف تناولت هذا الموضوع؟
تمثِّل الآداب السلطانية جزءًا من الأدب غير الديني الذي تطور منذ بداية الإسلام. فبعد وقوع الحدث الأساسي المعروف بالفتنة الكبرى (منتصف القرن السابع) التي ولَّدت حربًا أهلية، وأدت إلى استيلاء الأمويين على السلطة، وجد المسلمون أنفسهم أمام تشكُّل سياسيٍّ لا عهد لهم به، حيث كان عليهم أن يتعلَّموا كيف يحكمون عالمًا شاسعًا غزوه منذ وقتٍ قريب. وبشكل عفويٍّ، بدأوا في التوجُّه نحو المنهزمين من الفرس والبيزنطيين وهم أصحاب تقاليد سياسية وإمبريالية عظيمة. وعمليًّا، وقبل قرنٍ تقريبًا من بداية حركة الترجمة الكبيرة للنصوص العلمية والفلسفية إلى اللغة العربية، تمَّ في منتصف القرن الثامن ترجمة أدب سياسيٍّ من أصل أجنبيٍّ تمَّ إدماجه في الموروث الإسلام وحتى ما قبل الإسلامي، لكي يشكِّل أساس ما سيُكتب لاحقًا في الآداب السلطانية. وفي هذا دليلٌ على أن المسلمين الأوائل لم يكن لديهم وَهْمُ وجود سياسة "إسلامية" مقرَّرة في النصوص الدينية. بل إنهم على العكس من ذلك، لم ينظروا إلى النصوص المقدَّسة على أنها نصوصٌ في الحكم أو مدوَّنة للعقائد السياسية كما يدَّعي مفكِّرو الإسلام السياسي في الوقت الراهن من خلال التلويح بشعار: "القرآن دستورنا". فالمعارف التي سيتمُّ وصفها لاحقًا بأنها معارفُ "إسلامية"، هي في الواقع نتاجُ انفتاحٍ على العالم واندماج سريع لأعمال الأقدمين في مسائل الإدارة والحكم والتفكير في السلطة. ولا يعني هذا عدم وجود أصالة أو سماتٍ خاصَّة في الأعمال الجديدة، بل يعني أنها كانت نتيجة استيعابٍ عجيبٍ للعلوم القديمة، لا نتيجة موقف مبدئيٍّ باسم "هوية" سبق أن تشكَّلت بالفعل لحظة تأسيس الإسلام في القرن السابع.
وسيتمُّ ترجمة ثلاثة نصوص رئيسة. أولها رسائل أرسطو إلى الإسكندر، وهي تُعزى إلى أرسطو لأنه كان يُعتبر النموذج المثالي للفكر، ولكن هذا الرسائل قد تكون كُتبت في بلاد فارس خلال الفترة الهلنستية. أضف إلى ذلك، أن العرب كانوا لا يعرفون كتاب السياسة لأرسطو، ولم يعرفوا لأرسطو إلا نصًّا سياسيًّا وحيدًا هو كتاب علم الأخلاق إلى نيقوماخوس. وسوف تُغذِّي رسائل أرسطو إلى الإسكندر تقليدَ الآداب السلطانية، أولًا من خلال ما حوته من حِكَمٍ وأفكار حول الحرب والسلم، ثم عن طريق ربط الصلة بين المعرفة (المتجسِّدة في شخص أرسطو) والسلطة (التي يمثِّلها الإسكندر الأكبر)، وأخيرًا ما يتعلق بأخلاق الأمير وبناء نموذج مثاليٍّ للسلطان.
أما النص الثاني الذي ساهم إلى حدٍّ كبيرٍ في تشكيل كتب آداب الحكم، فهو كتاب كليلة ودمنة، وهو كتاب حكايات من أصل هنديٍّ لبيدبا الفيلسوف يقدِّم رؤيةً مخصوصةً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المعرفة والسلطة. وكما هو الحال في النص السابق، فإن الفيلسوف يُجسِّد المعرفة التي يجب أن تثقِّف الأمير وتشرح له واجبات رئيس الدولة. ويتميَّز هذا النص بتفكيرٍ عميقٍ في أخلاقيات البلاط، وبفهمٍ جيدٍ لمسألة ضبط النفس أساسًا لحكم الآخرين. وقد انتشرت هذه الحكايات على نطاقٍ واسعٍ في الأدب العربي، وتمت ترجمتها إلى اللاتينية وعددٍ من اللغات الأخرى خلال العصور الوسطى.
أما النص الثالث، فهو وصية أردشير الملك الفارسي الذي كان عمله حاسمًا في القرن الثالث للميلاد على المستوى السياسي منذ أن قام بتوحيد بلاد فارس وتأسيس الإمبراطورية الساسانية. فبعد غزوات الإسكندر، اهتزت الإمبراطورية الفارسية ووجدت نفسها في سياق تفتُّتٍ سياسيٍّ تعايشت فيه عدَّة ممالك كان يحكمها أمراء وحكَّام محليون، إلى أن وحَّدها أردشير تحت سلطة مركزية واحدة وضعت حدًّا للتشرذم. وإضافة إلى ما احتواه النص من حِكَمٍ بخصوص الحرب والانقسام السياسي والعلاقة بين الحكَّام والمحكومين، فإن أهمَّ ما تناوله هو ما يتعلَّق بمسألة الدين: فقد عاصر أردشير دعوة ماني مؤسس الديانة المانوية المقتبسة من الزرادشتية ومن بعض الأديان الأخرى مثل المسيحية. وهذا ما يتردَّد صداه في وصية أردشير، لا سيما في التأمُّلات الخاصَّة بمكانة الدين في الإمبراطورية وما يتعلَّق بضرورة احتواء السلطان - من أجل تثبيت أركان ملكِه - على نفوذ الكهنة والمتكلِّمين باسم الدين. ولعل الدرس الرئيس من وصية أردشير يتمثَّل في وجوب عدم استكانة السلطة السياسية لرجال الدين؛ لأنهم سيقومون - عاجلًا أم آجلًا - بابتلاعها.
-
هذه الأطروحة حول خضوع الدين للسياسي، هل نجدها في النصوص الأخرى التي ألهمت الآداب السلطانية العربية؟
نعم، يمكن قراءتها في النصوص التي تناولت مكانة الدين في المدينة، على غرار كتاب الملة للفارابي الذي يجعل الدين خاضعًا للفلسفة ومن ثمَّ للسياسي؛ لأن الزعيم السياسي يجب أن يكون فيلسوفًا على صورة الملك الفيلسوف عند أفلاطون. لكن مسألة استقلال السياسي في الإسلام ستتحدَّد بالخصوص في التقليد التاريخي الأدبي للآداب السلطانية، وهذا رغم أنها تعتبر الدين - باعتباره مجموعةً من القيم الأخلاقية أو التقاليد الاجتماعية - أساسَ السلطة الفاضلة. وقد استفاد هذا الاستقلال من الثقافة الإناسية (الأنثروبولوجية) التي حفلت بها عدَّة نصوص، لا سيما كليلة ودمنة، والتي اعتنت في المقام الأول بتحليل المشاعر، على غرار الحسد مثلًا الذي قد يُثير المتملِّقين، والأنانية ونكران الجميل والطموح المفرط والعدوانية، وقد بُنيت تلك التحاليل على أساس تفكيرٍ عميقٍ حول المشاعر التي تحرِّك البشر والمتعلِّقة بالعنف والحرب والسلام والعدل، وفي العموم بالتحكُّم في النفس وفي الآخرين. أما عن رسائل أرسطو إلى الإسكندر، فالكتاب يضعنا مباشرةً في صلب استقلالية السياسة تجاه الدين؛ إذ هو يعرض علم السياسة على أنه شراكةٌ بين الحكيم والأمير، كما يربط غزوات الإسكندر بالقواعد السياسية التي وضعها أرسطو، حيث يتمُّ تقديم هذا الأخير على أنه معلِّم الإسكندر ومستشاره أو وزيره؛ ومن هنا إسناد دور سياسيٍّ كبير له في مفهمة سياسة الأمير وتنفيذها على أرض الواقع. لكن من الضروري هنا تحديد نقطة أساسية، وهي التمييز بين مهمَّة الحكم ومهمَّة المُلك.
على عكس الصور النمطية الشائعة حول الاستبداد الشرقي، فإن أفضل الأمراء وَفْقَ هذه النصوص هو من يفوِّض السلطة الحقيقية إلى أصحاب علوم الحُكْم وإلى الأشخاص القادرين على الحُكْم الرشيد.
فعلى عكس النموذج الأفلاطوني الذي يرتبط فيه السلطان السياسي بالفلسفة من خلال شخصية الملك الفيلسوف، فإن الآداب السلطانية تفصل بين الكفايتين، أي بين سلطة الحكم وسلطة المُلْك. فكفاية الأمراء تتمثَّل في غزو الأراضي وتدمير الأعداء بالقوة أو بالمكْر (يُعتبر الإسكندر في المأثور الشرقي أميرًا عظيمًا واسع الحيلة)، لكن الغزو لا يكفي وحده لتحديد الفن السياسي. فهذا الفن يحتاج إلى معارف حُكْمٍ هي من اختصاص الحكيم أو الفيلسوف. وتتماهى هذه الكفاءة الفلسفية مع الحكمة العملية (phronèsis) الأرسطية، وتنغرس بقوة في التقليد العربي لفنون الحكم. ذلك أن المؤهل لأداء هذه المهمَّة هو في العموم الشخص الذي تأمَّل طويلًا في تجارب الأُمم، وفكَّر في أوضاع بلده، واكتسب ما يكفي من الحكمة العملية لكي يحكم بطريقةٍ جيدة. هذا هو الوجه الذي يظهر به أرسطو في هذه الرسائل، والذي سيتحدَّد بموجبه تكوين مختلف وزراء الإدارة العباسية وكتَّابها واختيارهم على امتداد قرون. وعلى عكس الصور النمطية الشائعة حول الاستبداد الشرقي، فإن أفضل الأمراء وَفْقَ هذه النصوص هو من يفوِّض السلطة الحقيقية (أي إدارة الدولة وليس امتلاك الأراضي أو شارات المُلْك) إلى أصحاب علوم الحُكْم وإلى الأشخاص القادرين على الحُكْم الرشيد. فبفضل مهاراتهم، يتمُّ تحقيق الأهداف العليا لفنِّ الحكم: ضمان ازدهار البلاد، وتحقيق العدالة، وتطبيق الشريعة، وحماية مصالح الناس، إلخ. وهنا نعثر على الوعي بما يعتري السلطة من نقصٍ حين تُقصر غايتها على ما يُعتبر من تحصيل الحاصل، أي حين تكون مركزةً على التوسُّع الإقليمي أو الهيمنة الخالصة.
و"مرايا الأمراء" (Miroirs des princes) هو الاسم الذي يُطلق على النصوص المماثلة للآداب السلطانية في الموروث الغربي، وقد أُطلق اسم "مرآة" (Specula) (على سبيل المثال مرايا الحكَّام Specula principum أو مرايا الملوك Speculum regis)؛ لأنه كان يُفترض فيها أن تقدِّم للملك مثالًا للعدالة والخير مطابقًا لصورته. لذا يجب أن يعكس الكتاب سمات الحاكم الراشد، ويُساعد الأمير على أن يتطابق مع صورته وعلى أن يغدو واعيًا بخطورة مهمته. لكن الأمير نفسه يمكن أن يصبح المرآة الحيَّة التي تنعكس فيها تلك الفضائل.
وعلى الرغم من حضور صورة المرآة أحيانًا في النصوص العربية على المستوى المجازي، فإن اسم هذا النوع من النصوص مختلفٌ؛ إذ يُطلق عليها تحديدًا اسم الآداب السلطانية أو آداب الملوك، بمعنى قواعد سلوك السلطة السياسية أو الملوك. وتُمثِّل قواعد السلوك هذه جزءًا من الأدب الذي يُفترض أنه ما يشكِّل الأديب، أي ما يعادل الإنسان الشريف [في أوروبا] في القرن السابع عشر. وتهدف هذه الرسائل السياسية إلى تأديب الأمير، ولكن أيضًا الكتَّاب والقضاة والمستشارين والوزراء، وبشكلٍ أعمَّ جميع من يشتغل بشؤون الحكم. وهي تمثِّل جزءًا من المعارف الكليَّة التي يجب أن يحصل عليها كل أبناء النخبة الاجتماعية. لكن هذه النصوص كانت متاحةً أيضًا للعامَّة، وانتشرت انتشارًا يفوق بكثيرٍ انتشار النصوص المتخصِّصة مثل كتب الميتافيزيقا والبصريات والرياضيات. بل إن النصوص السياسية مثل نصوص الفارابي لم تنتشر - كما يبدو لنا - بمثل انتشار نصوص الآداب السلطانية؛ نظرًا لاعتمادها تاريخ السلاطين والدول والحِكَم والأمثال والشعر الحِكَمي وأقوال الأنبياء والحكماء. ومن ثمَّ، فإن الوصول إليها كان أَيْسَرَ من الوصول إلى الرسائل العلمية التي تتناول السياسة في علاقتها بنظرية النفس أو الكونيات أو الماورئيات.
-
فيمَ تتمثَّل مرايا الأمراء في التقليد الأوروبي؟
حسب ما جاء في كتاب فنون الحُكْم لميشال سينيلار (Michel Senellart)(1)، وهو كتاب مرجعيٌّ في هذا الموضوع، فإن المرايا كانت موجودةً في التقاليد الأوروبية منذ القرون الوسطى، ولا سيما في شمال أوروبا، وقد ازدهرت بشكل ملحوظٍ في حدود القرن السادس عشر مع صدور كتاب المرآة السياسية (le Miroir politique) لغيوم البرياري (Guillaume de la Perrière) وكتاب السياسات (les Politiques) لجوست ليبس (Juste Lipse). فقبل ذلك بفترة وجيزة، وُجدت أطروحات مهمَّة مثل دليل الحاكم (Policraticus) ليوحنا السالزبوري (Jean de Salisbury) في القرن الثاني عشر، والنظام الأميري (Du régime princier) لجيل الرومي (Gilles de Rome). بل إن القديس توما الإكويني نفسه كان مؤلِّف كتاب ولاية الحُكَّام (De regno ad regem Cypri)، وهو متوافق مع روح تقليد المرايا، في حين لا يُعتبر كتاب الأمير لمكيافيلي سوى مرآةٍ كاذبة؛ لأنه استغلَّ ذاك التفكير الطويل في فنون الحكم مع تغيير التركيز على مسألة الاستيلاء على السلطة والحفاظ عليها، وهو ما كان في أصل كتابة الرسائل الخاصَّة بالمصلحة العليا للدولة كما نجده مع بوتيرو (Botero) أو نودي (Naudé) في القرن السابع عشر. وبشكلٍ عام، فقد تطور التقليد العربي خلال تلك الفترة نفسها مع تداخل كبير في كلٍّ من الشرق والغرب؛ لأن النصوص كانت مستوحاةً من التراث اليوناني الروماني القديم، والتوراتي والشرق أوسطي. فنحن نجد على كلا الجانبين استعادةً لصورة الراعي وفن الرعوية (pastorat) على سبيل المثال، وهي الموضوعات التي حلَّلها ميشيل فوكو (Michel Foucault) مطولًا في دراسته للحاكمية (gouvernementalité).
ما يميِّز المرايا العربية بالمقارنة مع مثيلتها الغربية في العصور الوسطى هو - أولًا - حضور مبحث الحرب، الذي يرتبط تناوله بحفظ الدولة وسلامتها. ففي تقاليد المرايا الغربية وصولًا إلى مكيافيلي، لم تُتناول الحرب على أنها من فضائل الأمير الكامل؛ لأن الحرب في نظر مسيحية القرون الأولى كانت تجسِّد الخطيئة الأصلية، أي الشر وجشع البشر وطمعهم، حتى إن المسيحيين الأوائل كانوا يرفضون الانضمام إلى الجيش الروماني. لكن هذا الأمر تغيَّر خلال الغزوات البربرية: فقد رأى القديس أوغسطين وجود حقٍّ في الدفاع ضد المهاجمين، وهذا ما كان في أصل نظرية الحرب العادلة. لكن الحرب ظلَّت غائبةً عمليًّا حتى عصر ميكيافيللي، باستثناء بعض الرسائل النادرة مثل رسالة جيل الرومي، بينما نجدها في التقاليد العربية متصلة اتصالًا مباشرًا بالتفكير العام حول السياسة، بل وحاضرة حتى في وصف المعقوليات التي تستخدمها، لا سيما فيما يتعلَّق بمبحث الحيلة. وهذا هو السبب في أن لدينا أدبًا يصوغ نوعًا من التفكير الحربي مختلفًا عن ذاك الذي نعرفه عادةً حين نتحدَّث عن الحرب في الإسلام. هنا، لا يُعتمد الأدب المقدَّس واللاهوت أو القانون بقدر اعتماد أخلاقيات الأمير والقواعد التي يتبعها السلاطين العظام في تأسيس دولهم. ويمكننا القول إن المرايا العربية قد اعتمدت منذ وقتٍ مبكِّر نموذجًا لا يخضع لموضوعة الحرب المقدَّسة؛ لأن عدوَّ الأمير في المقام الأول هو منافِسُه على الحكم.
ويتعلَّق الاختلاف الثاني بإضفاء طابع محوريٍّ على الفضائل وجعلها تحتل مكانًا بارزًا في المرايا الغربية، حيث يتمُّ تناولها من منظور دينيٍّ وروحيٍّ، وخاصةً في الرسائل المبكِّرة. فهذا الجانب الذي يتمحور بقوة حول الوعظ، يتمُّ تجاوزه في المرايا العربية من خلال بلورة أخلاقياتٍ مصاغة بالكامل من وجهة نظر مهنة الأمير أو رجل الدولة، حتى وإن ظلَّت تداخلاتها مع الأخلاقيات الفردية أو العامَّة عديدةً. ورغم أن المرايا العربية بدأت في الظهور في القرن الثامن، فإن روحها كانت أقربَ إلى نظيرتها الغربية في أواخر العصور الوسطى الغربية وبداية عصر النهضة؛ إذ ركزت على فضائل الأمير السياسية أكثر من فضائله الدينية. فنحن هنا في مجال الأخلاقيات أكثر منه مجال الأخلاق؛ لأن الأخلاقيات تتعلَّق بقواعد سلوكٍ جوهرية، بينما تحتاج الأخلاق إلى ضمان خارجيٍّ، أي إلى عنصر متسامٍ يمكنه أن ينبثق من واجبٍ مطلق مثل الواجب الكانطي أو واجب الدين، وينطوي في نهاية المطاف على عقوبة أو جزاء في الدار الآخرة. فالأخلاقيات عنصر موجود في كتاب الأمير لمكيافيللي، لكنه مرآةٌ زائفة؛ لأنه يصوغ أخلاقياتٍ غير دينيةٍ ويجدف ضد تيار الإنسية الرائج في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن بعض مبادئ المرايا العربية (استخدام القوة والحيلة، والقدرة على أن يغدو المرء قاسيًا وفظًّا عند الضرورة) كانت حاضرةً بقوةٍ في النصوص العربية منذ القرن الثامن للميلاد، وهو ما يدلُّ على أن التفكير في الصفات السياسية في علاقتها بمهنة رجل الدولة وخصوصية دوره قد بدأت منذ وقتٍ مبكِّر جدًّا.
-
هل ما زالت كتب الآداب السلطانية مقروءةً اليومَ من قِبل النُّخب السياسية أو الدينية؟
في العصر الحديث، تمت العودة إلى الكثير من النصوص المكتوبة بالعربية وتُرجم بعضها إلى التركية أو الفارسية، لكن الإنتاجات الجديدة كانت قليلةً بعد القرن السادس عشر. لقد تجمَّد هذا الجنس من الكتابات، لكنه واصل العيش في شكله القديم حتى بداية القرن العشرين. وبالنسبة إلى بعض النصوص، فقد استطاع التقليد التكيُّف مع الشكل الحديث للرسائل السياسية، وذلك من خلال تبنِّي تعاليم التنوير أو الأفكار الحديثة في القرن التاسع عشر مثلًا حول الدولة والأمَّة والإدارة. وبعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، اختفت المرايا مجددًا، قبل أن تتمَّ استعادتها بفضل أعمال النشر خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لكن العديد منها ما يزال في شكل مخطوطاتٍ غير منشورةٍ قابعة في مختلف مكتبات الشرق أو حتى في أوروبا.
ومع ذلك، فقد كان الاستقبال العربي لهذه النصوص سلبيًّا للغاية وإشكاليًّا. فقد اعتبرها العلماء العرب المعاصرون تأملاتٍ سياسيةً نابعةً من مثقفين عضويين إن جاز التعبير، قريبين من السلطة ويهدفون إلى إضفاء الشرعية على أنظمة حكمٍ استبدادية وغير عادلة. وبتسليط الإشكاليات الغربية الحديثة المتعلِّقة بنقد الهيمنة ومنطقها على تلك الرسائل، فقد رأى فيها العديد من المفكِّرين - ومنهم الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري الذي يعتبر من أهم شخصيات الفكر العربي المعاصر - مصدرَ الشر السياسي العربي في الزمن الراهن.
ولقد حاولت في كتابي وضع هذا الاتهام في سياقاته لإثبات أنه غير مبرَّر، وأن الحُجج المطروحة يجب اعتبارها نسبيةً على الأقل؛ وذلك لكي لا نقع في مفارقاتٍ تاريخية من خلال إثقال تلك النصوص بالشواغل السياسية للعالم المعاصر. فهي وإن كانت تدافع عن شكلٍ من أشكال الاستبداد السياسي، أي عن تصوُّر مفاده أن السلطان لا ينبغي له أن يُتقاسم وأن القوانين يمكن الانتقاص منها باسم الحفاظ على السلطة أو المصلحة العامَّة، فإننا يجب بالمقابل أن نعرف أنها لا تبتغي الدفاع عن الاستبداد أو الطغيان. بل إنه سيكون من باب سوء الفهم عدم الانتباه لهذا الفرق المهم بين مفهوم السلطة المطلقة ومفهوم الاستبداد، فنموذج الاستبداد هو ما حدَّد أيضًا تطوُّر العديد من الفلسفات السياسية مثل فلسفة هوبز. وبشكلٍ عام، فإن الحكم السلبي على مضمون الآداب السلطانية يتمُّ انطلاقًا من تصوراتٍ حديثة لدولة القانون وفكر كتَّاب التنوير مثل روسو الذين حاربوا السلطة المطلقة وحاولوا بناء القانون السياسي على مبادئ جديدة.
التقليد الفقهي وارتباطه بعلم أصول الدين
-
خارج الفكر الفلسفي ذاته، يوجد تقليد فقهيٌّ يخترق الفكر السياسي الإسلامي، وهو التقليد الذي يُمثِّل الجنس النصيَّ الثاني الذي يتعلَّق به عملك. ما هي أهمية هذا التقليد؟
غالبًا ما كان التقليد الفقهي بوابتنا نحو الفكر السياسي الإسلامي، وهذا مبرَّر تمامًا؛ لأن للفقه صلاتٍ قويةً بعلم أصول الدين، ويعود في جزء منه إلى تفسير النصوص التأسيسية للإسلام. وتشمل هذه النصوص المقدَّسة المصادر القرآنية (النص والتفسير)، وأقوال النبي أو الأحاديث، ولكن أيضًا ممارسات المسلمين الأوائل، وخاصةً القادة منهم مثل عمر بن الخطاب ممَّن أسَّس لنوعٍ من الفقه. وفي الواقع، فقد صيغ التقليد السياسي الذي نجده في الفقه إلى حدٍّ كبير حول مسألة ولادة الإسلام التي تحكَّمت فيها ظاهرتان رئيستان: الغزو الإقليمي الذي تمَّ في أجواء صدامٍ بين أوائل المسلمين والقوى المجاورة، والحرب الأهلية أو الفتنة التي اندلعت بين المسلمين أنفسهم.
ولم يستقل الفقه السياسي بشكلٍ ملموسٍ عن مجالات القانون الأخرى إلا في بداية القرن الحادي عشر بفضل كتاب الأحكام السلطانية للفقيه العراقي الماوردي، وهو كتاب معروف جدًّا في التراث الاستشراقي منذ القرن التاسع عشر. وتكْمُن أهمية هذا التقليد في أنه نظر لوظائف السلطان، ولطريقة الوصول إلى السلطة، ولدواوين الحكومة (الوزارة، الجيش، الكتابة، الجباية، المحاكم، والحسبة، الخ) انطلاقًا من الممارسات الفعلية للحكَّام. لذلك، فهو تقليد منغرسٌ في تاريخ الإسلام، ويعتمد تفسير النصوص التي توجد حولها العديد من الاختلافات التي لا يخلو منها أي من مجالات الفقه الأخرى. وفي رأيي، فإن الأهمَّ في تقليد الفقه السياسي في الإسلام، هو التباعد بين المعايير التي غالبًا ما يشير نموذجها المثالي إلى الفترة السابقة للفتنة (ما يُسمَّى بفترة الخلفاء "الراشدين")، وبين التكيفات اللاحقة، أو لنقل التوافقات التي تمت مع حقائق التاريخ باسم الضرورة السياسية أو المصلحة العامَّة أو "المصلحة العليا للدولة".
-
أي إن المشاكل العملية، لا اللاهوتية فحسب، هي مدار اهتمام في الفقه الإسلامي؟
تمامًا. فقد كانت النزعتان المعيارية والبراغماتية في الواقع الديناميتين الفكريتين الأساسيتين التي يدور حولهما التقليد الفقهي الإسلامي. وقد يتأثَّر بعض الفقهاء بشدَّة بالتقاليد اللاهوتية ويركِّزون على المغزى الديني للممارسات التي يستمدون منها الأحكام الأخلاقية والمعايير السياسية، بينما يفضِّل آخرون أكثر براغماتيةً البحثَ عن حلولٍ فعَّالة تتوافق مع احتياجات الناس ومصالحهم؛ ولذلك يركِّزون على آثار الفقه على الفرد وعلى المجتمع والدولة.
القاعدة التي تقرِّر قتل هذه الفئة أو تلك والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين غير مستمدَّة من القرآن، بل من الروايات التاريخية لبداية الإسلام.
ويقترن هذا الصراع بانقسامٍ آخر في التحيُّز للتعليل القانوني (الشافعية) والآراء الشخصية للفقهاء (الحنفية)، أو على العكس، للممارسات القديمة (المالكية) وحرفية النص المقدَّس (الحنبلية). وباستثناء بعض الإجماع، فإن معظم القواعد ممزَّقةٌ بين هذه الأقطاب، وتعكس التباينات على مستوى تصورات الفقه. فبعض الفقهاء لا يزال ينظر إلى الجرائم بوصفها آثامًا، وهو ما يشهد على انخراطهم القويِّ في أفق اللاهوت، في حين يميِّز آخرون بوضوحٍ بين المستويين، وهذا ما يطرح مسألة علمنة الفقه وإخراجه من البوتقة الدينية التي انحصر فيها عند تأسيسه بين القرنين السابع والثامن للميلاد. وعلى سبيل المثال، نجد في فقه الحرب (jus in bello) المسألة المشهورة حول قتل المدنيين أو غير المقاتلين. فجميع مدارس الفقه تُحرم قتل النساء والأطفال في الحرب، لكنها تختلف فيما يتعلَّق بالعمَّال والفلاحين والرهبان وكبار السن والمجانين والعجزة. فالشافعية يرون وجوب قتل هؤلاء؛ لأن معيار الاعتقاد والكفر مهمٌّ في عقيدتهم لتحديد من هو العدو، في حين تحظر المالكية أو الحنفية قتلهم لأنهم لا يشاركون في المجهود الحربي. وهنا ينتقل المعيار نحو طبيعة النشاط الملموس الذي تمارسه هذه الفئات: فطالما أنهم لا يشاركون في الحرب، فهم من غير المقاتلين، ولا يمكن لأي موجبٍ إضفاء الشرعية على قتلهم. ولنلاحظ هنا أن القاعدة التي تقرِّر قتل هذه الفئة أو تلك والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين غير مستمدَّة من القرآن، بل من الروايات التاريخية لبداية الإسلام المتعلِّقة بحالاتٍ مماثلة أو من التعليل الفقهي المتلائم مع المبادئ العامة لكل مذهب.
وفي كل تاريخ الفقه في الإسلام، يلاحظ المرء هذا التجاذب بين النزعتين نحو التديين والعلمنة التي تُفهم هنا على أنها الفصلُ بين المجالات الدينية والمجال السياسي، أي بين ضرورات المعاش وشؤون المعاد. وفي الوقت الحاضر، فإن النزعة الأولى هي التي تسود لسوء الحظِّ؛ إذ تمَّ إضفاء صبغة قداسة على العديد من القواعد أو الممارسات التي نشأت في سياقاتٍ تاريخية محدَّدة أو التي أُنتجت من قِبل مفكِّرين وجدوها حلولًا ذكيَّة بالتأكيد لمشاكل زمانهم؛ ولكننا نجعل من تلك الحلول عقيدةً في الوقت الحالي، وهو ما يفسِّر جزئيًّا أزمة الفقه في العديد من البلدان الإسلامية راهنًا.
-
ما رأيك في فرضية أوليفيه كاري (Olivier Carré)(2)، الزاعمة أن طوبى الإسلام السياسي تعيش في الماضي، أي في نموذج الخلفاء الراشدين؟
أوافق مبدئيًّا على هذه الفرضية؛ فنموذج الخلافة الراشدة هو في الواقع طوبى (Utopie) كثيفة الحضور في العالم الإسلامي. وهو نموذج مثير للاهتمام ولكنه خطير أيضًا؛ لأن الطوبى ليست بالضرورة مبدعةً: فقد يكون لها تبعًا للكيفية التي تتهيكل بها تأثيراتٌ مثبِّطة، وخاصةً إذا لم يُنظر إليها على أنها كذلك. ففي هذه الحالة، لا نكون في طوبى حقيقية تسمح للمرء بالعيش في اللامكان، أي في مكانٍ آخر مؤمثل، ولا في تمثُّل سياسيٍّ متطابق مع واقع المصادر التاريخية التي تمت دراستها بطريقة نقدية وموضوعية ومتحرِّرة من الأهواء المذهبية. وعلى وجه التحديد، فإن النموذج السياسي للخلفاء الراشدين يتماثل مع صورة القائد المهموم بالصالح العام والحريص على أن يكون خادم الشعب، والمثالي على المستوى الأخلاقي لا يسعى بالضرورة للتمتُّع بترف السلطة وما تتيحه من منافع.
ولقد جعلنا حاليًا من هذا النموذج نموذجًا مقدَّسًا ومؤسطرًا قائمًا على صورة زعيمٍ مشرِّع يطبِّق بدقَّة وبطريقة عمياء أحكام الشريعة (وهذا غير صحيحٍ ومتناقض؛ لأن الشريعة لم تتشكَّل تاريخيًّا حينها بعدُ). لكن تُوجد قراءة أخرى يمكن أن نصفها بأنها "أخلاقية"؛ لأنها تربط الممارسة السليمة للحكم أو التفوق السياسي بالصرامة الأخلاقية أو حتى بالزهد. ومن هنا الفرض المستمر والغاشم للخطاب الأخلاقي في السياسة، وخاصةً من قِبل الحركات الإسلاموية في الوقت الحاضر، مع الاعتقاد بأن ذلك يمكنه حلُّ مشاكل الحكم والقضاء على الفساد، في حين أن ذلك لا يُساهم عادةً إلا في المزيد من تدهور الأوضاع القائمة. ولذلك، فأنا أوافق على اعتماد مقاربة تُزيل الصبغة الأسطورية عن ممارسات الحكم في الإسلام، وذلك بإعادتها بكل بساطة إلى مجال السياسة. وإذا ما كان لبعض الناس أن يُتخذوا مرجعياتٍ أو نماذج قيادة، فإنه يجب علينا أولًا تحديد صفاتهم من خلال وظائفهم، بحيث يمكننا النظر إليهم بوصفهم مشرِّعين متميزين أو استراتيجيين كبارًا أو أصحاب كفاءة سياسية عظيمة أو استقامة أخلاقية عالية، دون الشعور بالحاجة إلى ربطهم بأفقٍ لاهوتيٍّ أو أخلاقيٍّ. ولعل أهمية كتاب أوليفيه كاري تكْمُن في أنه أظهر وجود ديناميات علمنة مبكِّرة جدًّا في الإسلام، وهي ديناميات تتطابق في الواقع مع نهاية حكم الخلفاء "الراشدين" والانتقال إلى حكم دولة الأمويين التي كانت فيها طاعة السلطة غير مرتبطةٍ بتديُّن الزعيم، بل بوصفها المنطق الجوهريَّ للدولة.
وإلى حدٍّ ما، فإن الدعوة إلى هذا النموذج الراشدي هي - بالنسبة إلى المنادين به - طريقة لتحدي تلك العلمنة ولاستذكار أمثولة الانصهار بين الوظائف الدينية والوظائف السياسية، وبعبارة أخرى طريقة للمزيد من ربط السلوك السياسي بالنموذج النبوي. لقد كان يُعتقد أن الخلفاء الراشدين كانوا رجالًا أفذاذًا، وأن فذاذتهم كانت نابعةً من الدين؛ ولذلك تمَّ تقديسهم. وها نحن نرى بوضوحٍ في خطابات مؤيدي هذا النموذج رغبةً في إعادة بناء الإسلام (كما لو أنه لم يُوجد قطُّ!)، ومقارنة القادة (الجهاديين، قادة الأحزاب الإسلاموية) بالنبيِّ وصحابته من جهة أولى، ومن جهة أخرى ربط أعمالهم السياسية بتاريخ تأسيس الإسلام، وهذا ما أسميته "لاهوت التأسيس" في كتابي الإسلام والسياسة في العصر الوسيط.
لقد تشكَّل تراث الراشدين من خلال التشكيك في السلطة الأموية التي ورثت هؤلاء الخلفاء، والتي اعتبرها البعض سلطةً غاصبةً؛ لأنها أقامت نظامَ حكمٍ وراثيٍّ، على عكس "الراشدين" الذين لم يستخلف أيٌّ منهم ابنه على رأس الدولة.
لقد اعتمد الأمويون لتحقيق استقرار الدولة شكلَ الدولة السائد في ذلك الوقت عند جيرانهم، أي الحكم الوراثي الذي كان النموذج الرئيس المتاح حينها. وقد تطابق هذا الحل مع التيار السُّني الوليد الذي كان عليه أن يعترف في مجال السياسة بفكرة أن السلطة تكون لمن يستولي عليها بقوة السلاح. وقد كان موقفهم مبررًا بفعل المصائب التي سبَّبتها الفتنة الكبرى التي أدت إلى احتراب صحابة النبيِّ فيما بينهم، أي مؤسسي الإسلام ذاته. ولتبديد شبح عودة الحرب الأهلية التي اعتبرت شرًّا مطلقًا، حرَّموا الخروج على السلطة القائمة وفرضوا الخضوع لها، حتى وإن لم تكن مستوفيةً كامل المتطلبات المعيارية التي يشترطها المثل الأعلى للحاكم الرشيد. وبهذا كانوا دعاةً للمشروعية السياسية والعسكرية.
أما التوجهان الآخران، الشيعي والخارجي، فقد صاغا منذ البداية فكرًا سياسيًّا مختلفًا، ولكنهما انتهيا حين سنحت لهما فرصة تشكيل دولٍ على أرض الواقع، إلى تبنِّي النماذج الإدارية نفسها المعتمدة عند أهل السنة. ومع ذلك، فإنه توجد اختلافاتٌ مهمَّة على مستوى العقائد المؤسسة: بالنسبة إلى الشيعة، فإن الحكم يجب أن يكون في نسل عليٍّ، أي في آل بيت النبي (شرعية دينية أو كاريزمية)، في حين يرى الخوارج أن القيادة العليا للمجتمع يجب أن تعود إلى الأفضل والأكثر عدلًا، حتى وإن كان عبدًا (شرعية أخلاقية). وسيكون تطرف الخوارج وتعدُّد حروبهم ضد الأمويين وراء تحويلهم إلى رمزٍ للعمل الثوري في الإسلام، وهذا هو السبب في أن منع التمرُّد في رسائل الفقه السياسي كان يستدعي على الفور تجربة الخوارج كمثالٍ تاريخيٍّ يجسِّد عصيان السلطة المركزية.
فلاسفة الإسلام الكلاسيكي: الفارابي وابن خلدون
-
تتضمَّن الفلسفة السياسية في الإسلام شخصيتين رئيستين، الفارابي وابن خلدون. وقد نُشر الكثير حول ابن خلدون (3) لكن لنبدأ مع الفارابي، ما هو مشروعه الفلسفي؟
إن طموح فلاسفة الإسلام الكلاسيكي هو إيجاد خطابٍ علميٍّ حول السياسة، وهو طموح مشترك بين كلٍّ من الفارابي وفلاسفة آخرين على غرار ابن باجة أو ابن رشد. وسيرث هؤلاء الفلاسفة الأفكار الأفلاطونية حول الحكومة العادلة كما جاءت في كتاب الجمهورية الذي تُرجم إلى العربية، كليًّا أو على الأقل نقلًا عن تلخيص جالينوس. وفي غياب ترجمة لكتاب السياسة لأرسطو، تأسس الفكر السياسي لفلاسفة الإسلام على كتاب الأخلاق النيقوماخية لأرسطو وكتاب الجمهورية لأفلاطون، بالإضافة إلى نصوصٍ ثانوية أخرى مثل ملخص القوانين لأفلاطون. وعلاوة على ذلك، فإن فلاسفة الإسلام كانوا يمارسون العلوم (بعضهم كان من علماء الفلك مثل ابن طفيل، أو من الموسيقيين مثل الفارابي، أو الأطباء مثل ابن رشد)، فهم علماء صاغوا خطابًا حول السياسة في وقتٍ كان فيه العلم والفلسفة ما يزالان شيئًا واحدًا.
وهذا الجانب واضح عند الفارابي، الذي كان يُسمَّى المعلم الثاني؛ لأنه مفكِّر كانت فلسفته تطمح - قبل كانط بزمنٍ طويلٍ - إلى أن تتشكَّل في نظامٍ تندرج فيه كلُّ مقولةٍ وكلُّ عنصرٍ في مجموعٍ شاملٍ تترابط دوائره فيما بينها بشكلٍ متينٍ. وقد كان أكثر أعماله اكتمالًا كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وكتاب السياسات المدنية، وهذا النص الأخير هو ما اعتبره موسى بن ميمون ذروةَ الفلسفة، والحال أنه لا يزيد عن نيف ومائة صفحة. ويتقاطع هذان النصان ويؤسسان فكرًا منهجيًّا: فهما يبدآن بالنظر في ما وراء الطبيعة والكونيات، تلي ذلك دراسة عقليَّة وتأمُّلات حول مكانة الإنسان في الكون؛ ليتناول السياسة في نهايته ويقدِّمها باعتبارها تتويجًا لجميع العلوم الأخرى وأداةً للتحقُّق من بعض الاستنتاجات التي أدت إليها دراسة القسمين الأول والثاني (الميتافيزيقا والعلوم العقلية). لذا، فإن الفارابي ينظر إلى السياسة على أنها مفتاحُ تحقيق مصير الإنسان، أي السعادة التي تندمج مع تحقُّق غاية ما هو إنساني، أي الجزء العقلاني من الروح البشرية.
الإنسان عند الفارابي يعيش في نظامٍ مزدوجٍ؛ إذ هو جزءٌ من الكائنات السماوية، وجزءٌ من عالم ما تحت القمر الخاضع للصيرورة والتغيُّر والفساد.
لكن هذه العقلانية التي تعتمد على رؤية إنسانية وكونية، والتي تشبه في بعض ملامحها إلى حدٍّ كبير روح النهضة الأوروبية، تظل مع ذلك متأثرةً أشدَّ التأثر بالتمثُّلات الكونية للعصور القديمة والعصور الوسطى، ولا سيما تلك الصادرة عن الأرسطية والأفلاطونية المحدثة. فالإنسان عند الفارابي يعيش في نظامٍ مزدوجٍ؛ إذ هو جزءٌ من الكائنات السماوية (لأنه صاحب العقل الذي يقرِّبه من الأجسام السماوية العاقلة والكاملة بفضل شكلها الكرويِّ وأبديَّة حركاتها الدوارة) وجزءٌ من عالم ما تحت القمر الخاضع للصيرورة والتغيُّر والفساد. وهذا البناء الفلسفي الذي يستند إلى علوم العصر آنذاك، هو ما نجده أيضًا على مستوى المدينة؛ لأن المدينة تحتذي في آنٍ واحدٍ حذو عالم ما فوق القمر (حركة الأجرام السماوية العاقلة، ومختلف دوائرها المتصلة جميعها بالسبب الأول الذي هو الله) وعالم ما دون القمر (من خلال المماثلة بين الجسم المدني والجسم البيولوجي). فالمدينة مرتَّبةٌ هرميًّا حسب جدارة كل طبقةٍ من طبقاتها، ويحكمها رئيس عقلانيٌّ على غرار النموذج الأفلاطوني للملك الفيلسوف، والهدف هو إنتاج النظام والكمال في هذا الكلِّ السياسيِّ.
ويشتغل النموذج البيولوجي أو العضوي الذي سنجده حاضرًا فيما بعد عند مفكِّرين سياسيين آخرين مثل روسو، بشكلٍ فعَّال؛ لأنه يسمح بالتفكير في مسألة الكل، مسألة غائية الجسم السياسي والتراتب الهرمي بين أجزائه. فبالنسبة إلى الفارابي، فإن القلب هو العضو الرئيس؛ لأنه يحافظ على الجسم بتمامه ويمدّه بأسباب الحياة، فإذا اعتلَّ الجسم أو اختلَّ عضو منه، فإن القلب هو الذي يُنجده بما يُزيل علَّته ويُصلح اختلاله ويُعيد إليه اعتداله. ودور رئيس المدينة يشبه دور القلب داخل جسم الإنسان، فهو من يُنظِّم أجزاء المدينة، ويُسند إلى كلٍّ منها وظائفَ ومهامَّ اقتصاديةً وفكريةً وإداريةً وحكوميةً.
إننا أمام تفكيرٍ في المدينة يبتعد عن التوجُّه النفعي والوضعي المستمد من العلوم التاريخية كما نجده في الآداب السلطانية، ويقترب من نموذجٍ معياريٍّ قائم على العلوم. فالآداب السلطانية تقتصر على استدعاء الممارسات السياسية للإسكندر الأكبر وملوك الفرس والأمويين والعباسيين، ومن ثمَّ اعتماد استقراء ما تعلَّق بها من أمثالٍ سائرة من أجل استخلاص قواعد السلوك السلطانية. فالفقهاء محكومون بنظرتهم إلى التعارض بين القاعدة والاستثناء، وبين الشرعية والمشروعية. أما الفلاسفة، فيفكِّرون من وجهة نظر العلم التي توكل للإنسان غاية ثابتة في تطوير ملكته العقلية؛ وفي هذه الملكة العقلية تكْمُن إنسانيته. إننا هنا أمام درسٍ عظيمٍ في النزعة الإنسيَّة، هي ما نجده حاضرًا بقوة أيضًا عند ابن باجة وابن سينا ومسكويه وابن رشد؛ لكن الفارابي هو من أوضح في القرن العاشر أن الملك الفيلسوف يجب أن يهتمَّ بسعادة أرواح مواطنيه. وبالتالي، فإن للمدينة غايةً لاهوتيةً، ولكنها غايةٌ لا ترتبط بتفسير النصوص الدينية: فهي أقرب بالأحرى إلى وجهات نظرٍ علمانية؛ لأن نهاية الوجود البشري محدَّد من قبل العلوم. ففي نظر الفارابي، فإن خلاص روح المواطنين مهمٌّ بشكل خاصٍّ؛ لأن عدم تحقُّق ذلك يعني الحكم على البشرية بالدمار. وأفضل حكومة هي التي تُمهّد الظروف لتحقّق هذا الكمال، مستهدية في ذلك بالنموذجين الكوني والعضواني.
وغالبًا ما قورنت هذه التوضيحات مع طوبى (Utopie) توماس مور (Thomas More)، لكن الفارابي وعلى الرغم من أن نصوصه نادرًا ما كانت تنخرط في حوارٍ مع الواقع والممارسات التاريخية الفعلية، فإنه لم يكن طوباويًّا؛ فقد كان هدفه هو أن يفرض على السياسة نموذجًا مستوحًى من العلوم، ويستجيب لمعايير اليقين البرهاني في هذا الخصوص.
أما عن مكانة الإسلام في أعماله، فيمكن القول دون مبالغة إن الفارابي كان على مستوى الفكر الإنساني من أوائل من اقترحوا فلسفةً حقيقيةً للدين، لا مجرَّد فلسفة دينيَّة؛ لأنه درس الدين في علاقته بالفلسفة من ناحية، وبالسياسة من ناحية أخرى. ففي كتاب الملة، وبصفةٍ أقلَّ في نصوصٍ أخرى، تساءل الفارابي حول الوضعية المعرفية والإدراكية للدين، فضلًا عن دوره الاجتماعي والسياسي. وبشكلٍ عام، فإن الفارابي يربط جميع المعارف الدينية بفروع الفلسفة، والهدف هو إعطاء الفلسفة الأولوية على المستوى الوجودي والأسبقية في الترتيب الزمني، وهو ما يؤدي في مجمله إلى منح الفلسفة دورًا تأسيسيًّا من وجهة نظر تطوير المعارف البشرية. وانطلاقًا من هذه المصادرة، يحلِّل الفارابي الغايات التي يجب إسنادها للدين على المستوى الإدراكي والتعليمي والأخلاقي والسياسي. ومن هنا، استخدامه المنطق أداةً لتحليل الوسائل التي سيتمُّ تطبيقها من أجل تربية المواطنين داخل المدينة المثالية وفقًا لما يتقبلونه من حجج (البرهنة، إما بالجدل أو البلاغة).
وبشكلٍ ملموس، فإن الدين عند الفارابي - في صيغته المعيارية - يحتوي جميع التعاليم التي تقدِّمها الفلسفة، ولكنه يُقدِّمها في شكل صورٍ وترميزاتٍ وتمثيلاتٍ حسيَّة. ولذلك فهو موجَّه إلى جميع الناس بما يسمح بتربية أكبر عددٍ منهم، بينما يختصُّ تعلُّم الفلسفة بنخبة صغيرة. وعلى سبيل المثال، فإن الإيمان بالله عند الفلاسفة يجب أن يقوم على مدارسة أكاديمية، وأن يحصل من خلال بحثٍ يسمح باستخلاص تمثلٍ قائم على العلوم (الفيزياء وعلم الفلك). كيف ندرك وجود الله؟ هل يمكننا التمييز بين ذاته وصفاته؟ كيف نصفه؟ بالنسبة إلى العامَّة، فإن فهم هذه المسائل شديدة الدقَّة والتي تتطلَّب تعلمًا طويلًا على المستوى الفكري، مستحيلٌ بهذه الطريقة. ومن هنا يأتي الدين ليلعب دورًا مهمًّا لا يمكن للفلسفة أن تضطلع به؛ لأنه يستند إلى الحجج البلاغية أو الشعرية على غرار الأمثال والاستعارات، وهي عمليات شائعة في العديد من النصوص الدينية ولكنها تُحقِّق الهدف المنطقي نفسه، أي إنتاج التمثُّل والتصديق. فالهدف هنا هو إرساء تعليمٍ يضمن تصديق الناس للمعتقدات الصحيحة والتمثلات الملائمة، وذلك لارتباط فضيلتهم وسعادتهم بها.
ويُسند الفارابي جميع مظاهر الدين الرئيسة إلى الفلسفة: فيربط ظاهرة الوحي بنظرية الروح والقوة المتخيلة، ويُخضع تقسيم الدين بين آراء وأعمال في المدينة الفاضلة إلى طرائق تعليم المعتقدات والفضائل العملية، ويُسند الحكمة النبوية إلى فنِّ المشرِّع أو مؤسِّس القوانين، ويتفكَّر تغيُّر المجتمع الديني الفاضل من خلال فساد النظام السياسي المثالي وما يتولَّد عنه من دساتير فاسدة.
هذا هو الإطار العام الذي يُدرج فيه الفارابي تفكيره حول الدين. لكن لا بدَّ من إضافة عنصر آخر مهم، وهو أن الفارابي لا يُفكِّر على مستوى الدين الإسلامي فحسب، بل يتحدَّث عن عدَّة مجتمعاتٍ دينية فاضلة. وهنا نكون مرةً أخرى إزاء تفكير كونيٍّ حول الدين، كما هو شأن نظريته السياسية الصالحة لجميع الجنس البشري لا للعرب أو للمسلمين فحسب. فعند الفارابي، فإن للفلسفة وللدين مكانهما في المدينة الفاضلة، وهما مرتبطان إلى الحدِّ الذي تتقاطع فيه الغايات التي حدَّدتها التعاليم الدينية (السعادة الأرضية، خلود الروح، المعتقدات في الله، إلخ) مع مبادئ الفلسفة والعلوم، بما يسمح بتربية العامَّة ولكن بطرقٍ أخرى.
-
إلى أي مدى يتمايز ابن خلدون عن هذه المقاربة؟
تختلف مقاربة ابن خلدون عن مقاربة الفارابي إلى درجة أنه يبدو لنا أحيانًا أنهما لا يعنيان الشيء نفسه بكلمة "سياسة". لكن هذا التباين مفهوم؛ لأنهما لا يعملان بالطريقة نفسها، ولا يفكِّران في مواضيع متشابهة. فما يحضر عند ابن خلدون هو في المقام الأول التفكير في نشأة آليات السلطة. أما الفارابي فهو لا يُثير أبدًا العمليات التي تقود الفرد إلى السلطة، بل ينطلق دومًا من فرضية وصول ملكٍ فيلسوفٍ إلى رأس الدولة، وبعد ذلك يمكن لبرنامج تأسيس مدينة فاضلة أن يُنجز بفضل قوة تدبير الرئيس. فالفارابي لا يستحضر الصراع من أجل السلطة ولا الشروط التي تسمح للفرد أن يتغلَّب على منافسيه، كما لا نجد عنده أيَّ تفكيرٍ ملموسٍ حول الدولة والمؤسسات السياسية، والحال أن هذه النقاط هي التي تحتلُّ جوهر النظرية السياسية الجديدة التي قدَّمها ابن خلدون في القرن الرابع عشر.
وبإدراكه حداثة مساهمته، قام ابن خلدون ببناء خطابه من خلال عرض اختلافه عن تأملات الفلاسفة حول المدينة الفاضلة. وقد كان السياق الذي عاش فيه ملائمًا لنشوء مثل هذا التفكير، فقد عاش في فترة ما بعد زوال الخلافة، وهي فترة كانت مطبوعةً بتراجع استخدام اللغة العربية كلغةٍ رئيسة للتعبير عن شعوب العالم الإسلامي، وكذلك ببداية حدوث تغيراتٍ جيوسياسية كبرى أهمها صعود الأتراك والفرس ليغدوا سادة الشرق الجدد، لا على المستوى السياسي فحسب، ولكن أيضًا على مستوى التعبير الأدبي والفلسفي والفني. فقد برز ابن خلدون في سياق أزمة ونهاية عالم داخل الإسلام تمثَّل في تقدُّم حروب الاسترداد في الأندلس، والحروب الصليبية في الشرق، وغزوات المغول وتدمير بغداد والخلافة في عام 1258م. ونحن كثيرًا ما نتحدَّث عن سياق أزمة أو انحطاط، لكن قد يكون علينا وضع هذه الأزمة في سياقاتها المخصوصة؛ لأن قوىً أخرى كانت حينها بصدد الظهور تدريجيًّا. فقد بدأ مركز السلطة السياسية بالتحول شيئًا فشيئًا من المناطق القديمة التي كان الإسلام يُهيمن عليها (جزيرة العرب والعراق)، للتحرك شمالًا أو شرقًا (آسيا الصغرى، إيران)، وبتنا بهذا نشهد تعدُّد المراكز السياسية الكبرى: المماليك في مصر وسوريا، والصفويون في إيران، والعثمانيون في آسيا الصغرى، وورثة تيمورلنك في الهند. ومن هنا، فقد كان السياق سياسيًّا ويحمل تغيراتٍ كبيرةً سيتمُّ تأكيدها لاحقًا مع اختفاء الإسلام في إسبانيا وتقدُّم الإمبراطورية العثمانية في أوروبا. كما كان لهذا لأمر أيضًا عواقبُ ثقافية؛ إذ سيُفسح الإسلام العربي المجالَ للإسلام التركي والفارسي والمغولي على أعتاب العصر الحديث. لذا، فإن أعمال ابن خلدون تُغلق عصرًا وتفتتح آخر، وإنه لمن المثير أن نرى المثقفين الأتراك يتحدَّثون عنه في القرن السادس عشر لأنهم عرفوه، في حين لم يُعد العرب اكتشافه إلا في القرن التاسع عشر.
إن تفكير ابن خلدون هو في المقام الأول تفكير مؤرِّخ، فالجزء الأول من عمله الموسوم بكتاب العِبَر ينطوي على المقدمة التي عرض فيها رؤيته لعلمٍ جديدٍ كان يسعى إلى تأسيسه، وهو علم المجتمعات البشرية أو العمران البشري، وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه كان أبا علم الاجتماع. ومع أنه استفاد من العديد من المفكِّرين السياسيين، وخصوصًا مؤلفي الآداب السلطانية، فقد تميَّز ابن خلدون بقراءته الشمولية للتاريخ وباكتشافه - من جهة أولى - للمنطق الكامن وراء تأسيس الإمبراطوريات والأُسرات الحاكمة، ومن جهة ثانية للدورة الأبديَّة للسلطة السياسية الدائرة بين قطبي البداوة الرعويَّة والتحضُّر. ومن هذا الجانب، فإن فكره أقربُ إلى فلسفة التاريخ منه إلى الفلاسفة الكلاسيكيين في الإسلام مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد. وعلاوة على ذلك، فقد كان ابن خلدون - على غرار معظم مؤلفي زمنه - معاديًا للفلسفة.
لقد كان الأفق السياسي لهذا الفكر هو نموذج الدولة الوراثية التي تعني اليوم الدولة في معناها الدارج. ولم يهتم ابن خلدون بممارسات الحكومة وأساليب إدارة الدولة كما نجده في الآداب السلطانية، حيث لم يكن يبحث عن الخلاص أو الغاية (télos) من خلال حكمٍ رشيد؛ ولذلك لم يكن ما قام به تحليلًا للسلطة من الناحية القانونية وتحديدًا للقواعد التي تسمح بتحقيق تماسك المجتمع سياسيًّا. لقد بحث بالأحرى في الأُسس الإناسية (الأنثروبولوجية) لظهور السلطة: كيف يمكن لإنسانٍ عاديٍّ أن يصبح قائدًا، ويصل إلى السلطة ويؤسِّس لها، ويُرسخها ويُورثها أبناءه؟ لقد تركَّز تفكيره على ظروف نشأة السلطة التي وجد أنها مرتبطةٌ بشكل أساسيٍّ بالآليات التي تدفع ببعض الأفراد في مرحلةٍ من مراحل التاريخ إلى واجهة المسرح السياسي، وفق خطاطة شبيهة بالنموذج البيولوجي للانتقاء الطبيعي.
وقد كان العنصر الأساسي في تحليله هو مفهوم العصبيَّة، وهي شبيهة بالروح الحزبية أو المناضلة في زمننا المعاصر، غير أن هذه العصبية تكون منغرسةً في العواطف الإنسانية وفي الصراع بين العشائر والشعوب والقبائل. فنحن نلاحظ - في أوقاتٍ مختلفةٍ من التاريخ - انتصار إحدى العشائر على الأخرى، وسيطرة أمَّة واحدة على العالم، وهذا ما يبرِّره ابن خلدون بأن العشيرة المتغلِّبة كانت في الأصل ملتحمةً بالنَّسَب، أي بالقوة المادية للنواة المؤسسة، وهي القوة التي سمحت لها باستتباع العشائر الأخرى أو إضعافها من خلال المواجهات الحربية. وبهذه الطريقة تجد العشيرة الصاعدة نفسها، وهي في الغالب من بيئة رعويَّة بدويَّة، ومن ثمَّ تتمتَّع بصفاتٍ طبيعية تؤهِّلها للحرب والاستيلاء على السلطة، مدفوعة نحو البيئات المستقرة حيث تحكم أسرة مالكة قائمة منذ مدَّة. وقد سبق لهذه الأُسر المالكة بالفعل سلوك الطريق نفسه منذ بضعة أجيال؛ ولكن الاستقرار في المدن وتذوُّق الترف الذي توفِّره السلطة، أضعفا حميَّة الحرب لديها، لتنتهي في نهاية المطاف ورغم قدرتها على إدارة إرث المؤسسين إلى الانحلال والسقوط على يد عشيرةٍ أخرى دقَّت ساعةُ مجدها. ولهذا السبب، يُقسم ابن خلدون سلطان الدولة الأسرية إلى ثلاثة أطوار يشكِّل تكرارها دورة التاريخ الأبدية: طور الغزاة، وطور مُدبِّري الملك، وطور الانحلال والموت. ويجب أن نتذكَّر أن هذا المخطط يصف بناء السلطة في العالم الإسلامي، سواء من خلال الشعوب التي طمحت إلى إنشاء سلالاتٍ حاكمة أو من خلال وصول غزاة من خارج العالم الإسلامي (مثل المغول).
-
هذه الفكرة لا تزال تغذِّي التفكير السياسي، إذ تُوجد - على سبيل المثال - مقارناتٌ بين البورجوازيات الغربية التي أوجدت قوات أمن محلية لجماعاتها، والبورجوازية السُّنية التي استدعت قوى خارجية استولت هي نفسها فيما بعد على السلطة. فالخارج هو الذي يلعب بالفعل دور المهدِّد للدولة في فكر ابن خلدون.
بالفعل، فالسلطة السياسية عند ابن خلدون تتعرَّض بالضرورة لهجومٍ من الخارج من قِبل جيل جديد من الغزاة، وقد استوعب الفقهاء السُّنيون - الذين يعتبرون أنفسهم ممثِّلي قواعد الإسلام، والأوصياء على تقاليده، ومهندسي التماسك الاجتماعي والسياسي للأمَّة - هذه الحقيقة بشكلٍ جيد. فسواء في القرن السابع بعد إقامة الأمويين سلطة متعالية عن الخلافات السياسية والدينية سعت إلى اكتساب طاعة الرعية بالقوة، أو بعد ذلك بقليل، نحو القرنين العاشر والحادي عشر حين تدفقت جحافل الشعوب الغازية، فقد أدرك الفقهاء الحاجة إلى تكييف القاعدة المثالية للحكم مع سياقاتٍ تاريخية ملموسة.
ولئن كان هذا التفكير هو ما جعل الفقه غير فعَّالٍ تجاه شهوات الأمراء، إلا أنه استطاع بانخراطه في منطق السلطان الحفاظَ على تماسك مختلف البنى الاجتماعية في العالم الإسلامي. وبغضِّ النظر عن الاعتبارات الدينية، فإن ابن خلدون سيُنظِّر لهذا الواقع السياسي القائم على الحرب أو الغزو إلى حدِّ أن جعل منه محرِّك التاريخ، حيث إن الحرب هي التي تُسبِّب التغيُّرات على مستوى الدول والإمبراطوريات. فالحرب في مرحلةٍ أولى هي ما يُشكِّل وجهًا من وجوه تحدي السلطة من خلال الثورة والمعارضة، قبل أن تغدو لاحقًا وسيلةً للحفاظ عليها. وبهذا، فإن التغيرات التاريخية تحدث بفعل ثوراتٍ سلالية، وهذا ما كان يُميز بنية السلطان في العصر الوسيط، وهي بنية استمرت في بعض جوانبها فاعلةً حتى يومنا هذا. ولعل مشكلة فكرة السلطان هذه التي غدت قانونًا في التاريخ والسياسة تتمثَّل في أنها تُؤدي إلى شكلٍ من الحتميَّة المتَّسمة بديناميةٍ عنيدةٍ ومنتظمةٍ للتداول على السلطة (وهذا هو المعنى الأوَّلي للفظ دولة).
-
يبدو أن هذه النظرية لا يمكن أن تنجح دون الدين؛ فما هي المكانة الممنوحة للإسلام في رؤية ابن خلدون السياسية؟
لا يحضر ابن خلدون الديني بأتمِّ معنى الكلمة في دورة التناوب بين القطبين البدوي والحضري؛ لأن هذا التناوب بين شعوب العالم وأعراقه يتحرَّك بحتميَّة طبيعيَّة، ويقوم بالتالي على مخططٍ "ماديٍّ" تقريبًا. وقد دفعت القناعات الدينية عند ابن خلدون إلى اعتبار أن عجلة التاريخ هذه تخضع لقوانين مزروعة في الطبيعة من قِبل الله، وبالتالي سيكون من قبيل العبث مواجهتها أو محاولة تعديلها. فمن دون عصبيَّة، لا يمكن لأي سلطةٍ أن تقوم، ولا لأي دعوةٍ دينية أن تُحمى وأن تستقرَّ. والدرس الذي حوَّله ابن خلدون إلى نظريةٍ يتمثَّل في أن كسب معركة سياسية يقتضي أن يكون لديك حلفاء، وأن تبني حزبًا يكون دعمه ضروريًّا للفوز ضد المعارضين.
لكن الدين يجد مكانه على مستوى أعلى ويعرض نفسه ضامنًا أو كافلًا لسموٍّ أخلاقيٍّ يجب أن يكون حاضرًا لكي يقوم في آنٍ واحدٍ بتأكيد العصبيَّة وتنقيتها في المجتمع. وتساعد ضمانة الدين والسمو في تأسيس حكمٍ متوافقٍ مع متطلبات الإسلام الأخلاقية. فالدين لا يتدخَّل إلا بصفةٍ لاحقةٍ وبعد الاستيلاء على السلطة، لكي يضمن ألَّا تكون قائمةً فحسب على المصالح الأنانية للزعيم أو للعشيرة المهيمنة، بل على استفادة المجتمع في مجمله حسب نموذجٍ يحكمه الشرع ويحترم مبادئه العليا. ولكي نظل في مجال تمثلات العصور العتيقة والوسطى، فإنه يمكننا أن نقول إن المهمَّة الدينية للقائد تتغذَّى من نموذج السلطة الرعوية، وأنها تتماهى تقريبًا معه. وفي هذه المسألة، يتقاسم ابن خلدون الرؤية نفسها مع العديد من مفكِّري زمانه، لكنه يتميَّز عنهم بالتنظير - الاجتماعي قبل أوانه - للآليات التي تحكم تشكُّل السلطة.
إن أساس سلطة الدولة يخضع من حيث التخلُّق إلى آلياتٍ وقوانين مترسخة في نظام الأشياء كما في الطبيعة البشرية، ولكن الدعوة الدينية تُيسِّر عمل الخارجين على السلطة.
كما يلعب الدين دورًا آخر إلى جانب السلطة التي تظهر في شعبٍ ذي عصبية قوية. ويتمثَّل هذا الدور في قوة الاعتراض التي يمنحها للخارجين عن الدولة القائمة، وفي التحام تلك العصبية من خلال اجتماعهم على عقيدةٍ واحدة. فحين يمتلك الزعيم السياسي إلى جانب الحلفاء رجالًا مستعدين للموت دفاعًا عن قضيته أو دعوته الدينية، فإنه سيكون متأكدًا من النصر، ويمكنه - كما يقول أردشير في عهده - أن يهزَّ أُسس أشد الممالك رسوخًا. ويستشهد ابن خلدون في هذا الخصوص بالمهدي ابن تومرت، مؤسِّس عرش الموحدين الذين سيحكمون المنطقة المغاربية والأندلس من منتصف القرن الثاني عشر حتى منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. فبعد فترة من الدعوة في جنوب المغرب الأقصى جمع من خلالها بعض القبائل، بدأ المهدي تدريجيًّا بمهاجمة عاصمة المرابطين مراكش، متهمًا إيَّاهم بمخالفة الشريعة والانحلال الأخلاقي. وبعد سنواتٍ من القتال والحروب، انتهى الأمر بانتصار دعوته وانهزام المرابطين. ويمكننا القول - وفقًا لفكر ابن خلدون - إن أساس سلطة الدولة يخضع من حيث التخلُّق إلى آلياتٍ وقوانين مترسخة في نظام الأشياء كما في الطبيعة البشرية، ولكن الدعوة الدينية تُيسِّر عمل الخارجين على السلطة كما يظهره مثال ابن تومرت: فهي تُحرِّض الأتباع وتُظهر أن مطلب الرئيس لا يتعلَّق بتحقيقِ مصلحةٍ مادية أو مكاسب دنيوية، بل بخير الأمَّة بأسرها، وخير الإسلام ذاته.
إنه منطق قديم استنسخه الفكر الإسلاموي في القرن العشرين، لكنه لم يقم في الواقع إلا بمسخه؛ لأنه لا يُعير اهتمامًا للتغيرات الكبيرة التي حدثت في تصوُّر السلطة منذ عدَّة قرون، ويكتفي باجترار بنية عتيقة على أساس أنها تجسيدٌ لما يقوله الإسلام في هذا الخصوص. فهذا الفكر يسمح للانشقاق أو للتمرُّد السياسي بالتطوُّر في تربةٍ دينيةٍ يمكن أن تتخذ شكلَ إعادة تعريف العقائد (البحث عن "الإسلام الحقيقي") أو أخلقة السياسة دون أن يكون هناك برنامج حقيقيٌّ أو حتى موقف واضح في مجالاتٍ مثل الاقتصاد والصحَّة والسياسة الخارجية، إلخ. بل إن الغالب هو الاكتفاء بمسائل الأخلاق والمجتمع (المرأة، العقوبات الشرعية، إلخ) مع اعتقاد أنها تقدِّم مفتاحًا لتغيير الواقع. ولكن المشكلة هي أن المنشقين سيجدون أنفسهم - إذا ما وصلوا إلى السلطة - في حالة تنافسٍ أو استبعادٍ من قِبل فاعلين يرفعون المبادئ نفسها ويعرضون البرامج الزائفة نفسها، لنجد أنفسنا مرةً أخرى نكرِّر الدورة نفسها (إذا ما أُقيمت الدولة)، أو في حالةٍ من الفوضى (إذا لم يكن لدى الفاعلين ما يكفي من الدُّربة أو الثقافة السياسية لبناء دولة بحقٍّ). ففي الصومال، على سبيل المثال، نهض تنظيم شباب المجاهدين منذ بضع سنواتٍ للاستيلاء على السلطة بهدف إقامة حكومة إسلامية، ولكن سرعان ما وُلدت تنظيماتٌ أخرى رفعت السلاح في وجهه مدعيةً الانتماء إلى الخطِّ الأيديولوجي والديني نفسه.
إنها دينامية تؤدي إلى تدمير السياسة؛ لأنها قد تؤدي إلى حربٍ أهليَّة دينيَّة أو إلى تفكُّك هياكل الدولة، وهذا ما يصنع الفرق مع حركات العصور الوسطى التي قام ابن خلدون بوصفها وتحليلها. ذلك أن هذا التصوُّر الحربي للرئاسة كان على الأقل ممتزجًا في ذلك الوقت بثقافة التدبير ومعارف إدارية وحتى بثقافة دينية راقية، بينما يتصرف الفاعلون السياسيون الحاليون داخل سياقٍ يتميَّز بضعف ثقافة تدبير النفس وتدبير الآخرين، ناهيك عن السفسطة التي تجعل من العقيدة الدينية (خاصةً في سياق الجهاد المعولم) الرابطَ الوحيد الذي يسمح بإقامة دولة. فمثل هذه الدولة ستكون بالنتيجة محفوفةً بما هو غير سياسيٍّ لتجد نفسها مدفوعةً نحو مجالاتٍ تُحظر فيها العقلانيات التدبيرية (القانونية والاقتصادية والأخلاقية، إلخ)، ولو في مستوى العناصر الأساسية مثل تأمين الممتلكات والأرواح. ولذلك، فإن التقويض الذي يتمُّ من الداخل قد يكون في بعض الأحيان أشدَّ من الغزو الأجنبي.
* انظر الحوار الأصلي في:
« L'art de gouverner en Islam », Entretien avec Makram Abbès, propos recueillis par Olivier Mongin et Xenophon Tenezakis, Esprit, n° 8-9, Août/septembre 2014, p. 163-186.
* - والكتاب المقصود هو: الإسلام والسياسة في العصر الوسيط، ترجمة: محمد الحاج سالم، مركز نهوض للدراسات والنشر، بيروت، 2019.
Islam et politique à l’âge classique, PUF, Paris, 2009.
(1) Michel Senellart, les Arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Le Seuil, 1995.
(2) Olivier Carré, l’Islam laïc ou le retour à la Grande Tradition, Paris, Armand Colin, 1993.
(3)< Hamit Bozarslan, le Luxe et la violence. Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, Paris, Cnrs Éditions, 2014 ; Gabriel Martinez- Gros, Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s’effondrent, Paris, Le Seuil, 2014.