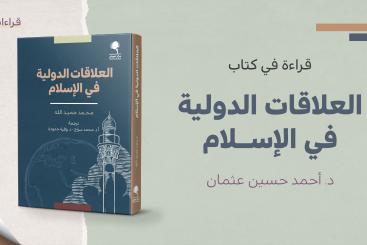العلمانية والإسلامية في سياق الاستعمار والتحرّر- حوار مع حسن أبو هنية

الأستاذ حسن أبو هنية، نسعد باستضافتك في مركز نهوض للدراسات والبحوث في هذا الحوار حول «العلمانية والشريعة والدولة»، حيث نتطرّق إلى الجدالات السياسية والثقافية حول العلمانية العربيّة وظروف تكوّن الدولة العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار، كما نتناول تفاعلات الحركات والخطابات الإسلامية مع هذه الثنائية (الإسلامي-العلماني)، التي حكمت النقاش النظري حول الدولة والقانون في العالم العربي منذ عقود، كما نحاول أن نستشرف تحوّلات هذه العلاقة في ظلّ الموجة الشعبوية العالمية وآثارها البعيدة.
- مركز نهوض: دعنا نبدأ بلحظة دخول «العلمانية» إلى المشهد السياسي الإسلامي والعربي خصوصًا. متى بدأت العلمانية تبرز بوصفها منظومة بديلة لمنظومة الحكم التقليدية القائمة على الشريعة؟ وكيف أثّرت ظروف النشأة هذه في مجريات العلاقة اللاحقة بين الشريعة والعلمانية، أو بين الدين والعلمانية بصورة أعم؟
حسن أبو هنية: دخلت العلمانية بوصفها أيديولوجية سياسية إلى العالم الإسلامي ومنه العالم العربي (وهي تسميات استشراقية كولونيالية)، لحظة تشكّلها في الغرب الأوروبي في القرن التاسع عشر، وهذه الأيديولوجية هي نتاج قصة تشكّل العلماني بوصفه مقولة معرفية، والتي بدأت عقب حروب القرن السادس عشر الدينية بوصفها محاولة لحل المشكلات السياسية للمجتمع المسيحي الغربي في صدر الحداثة، ولذلك فإن معظم المفاهيم والمؤسسات والممارسات العلمانية فُرِضَت على كافة البلدان المستعمَرة بطرق متنوعة من خلال الحكم الكولونياليّ الغربي، إذ لم يكن ممكنًا في الماضي ولا يمكن في المستقبل الفصل بين الكولونيالية والإمبريالية والليبرالية والعلمانية، فهي مكونات شكَّلت الذات والكينونة الغربية وطموحاتها الكونية بالهيمنة والسيطرة، فقد لعبت الكولونياليّة دورًا مركزيًّا في نشأة وتطور الليبرالية، وكان الإسلام حاضرًا -وما يزال- في لحظة تشكّل الليبرالية بوصفه نقيضًا معرفيًّا وخطرًا جيوسياسيًّا على المركزية الغربية، فلم تكن الكولونيالية والإمبريالية والعنصرية التفوقية العرقية البيضاء مجرد آثار جانبية ضارة لمشروع الكونية الليبرالية، وإنما سمة تأسيسية في تكوينها وبنيتها.
ينبغي التيقظ إلى أن العلمانية مصطلح يندرج في إطار مفهوم «المحيط الإشكالي» الذي صكَّه الأنثروبولوجي ديفيد سكوت، فمقاربة الديني والعلماني على أنها محيط إشكالي تعني أن ننظر إليها من خلال ما شكَّلها تاريخيًّا من أسئلة ومحكات ورهانات وأجوبة مطروحة، ويقع في صلبها مجموعة متكاملة عن السؤال حول الحد الفاصل بين الدين والسياسة، وتوضح هذه المقاربة ماهية التواشج التاريخي بين العلمانية والليبرالية، كما بيَّن حسين عجرمة في كتابه «مساءلة العلمانية». ولا بُدَّ من التنبه هنا إلى التمييز الذي بات واضحًا منذ تسعينيات القرن الماضي بفضل جهود طلال أسد حول العلماني بوصفه مقولة معرفية، والعلمانية بوصفها عقيدة سياسية، والعلمنة بوصفها عملية تاريخية.
في هذا السياق فُرِضَت العلمانية بالقوة المادية على العالم، فمنذ خضوع العالم الإسلامي في بداية القرن التاسع عشر للاستعمار الأوروبي، تم إزالة وتفكيك ومحو وطمس النظام الاجتماعي السياسي الاقتصادي الذي كانت تُنظِّمه الشريعة هيكليًّا، وأُفرِغت الشريعة من مضمونها كما بيَّن وائل حلاق، واقتصرت الشريعة على تزويد تشريعات قوانين الأحوال الشخصية في الدولة الحديثة بالمادة الخام. وحتى في هذا النطاق الضيق، فقدت الشريعة استقلالها ودورها بوصفها فاعلًا اجتماعيًّا لمصلحة الدولة الحديثة.
لم تكن عملية إزاحة الشريعة واستبدالها نتاج عملية تثاقف -وحتى في هذا النطاق لطالما كان التثاقف مسألة غزو كما يقول طلال أسد- لكن واقع الحال أن الاستعمار الأوروبي فرض حكمه بعنف كولونيالي لا نظير له في التاريخ الإنساني، فخلال القرن السادس عشر الطويل الذي شهد نشأة الكولونيالية، أكد الفيلسوف إنريكي دوسيل أن الذات الغازية كانت شرطًا للذات المدركة عند ديكارت، فـ«أنا أغزو إذن أنا موجود» هي أساس «أنا أفكر إذن أنا موجود» وذلك بعد توسط «أنا أُبِيد إذن أنا موجود»، وهو ما أدى إلى سلسلة من أربع عمليات إبادة منذ عام ۱٤۹۲م، استهدفت الأولى مسلمي الأندلس، والثانية السكان الأصليين في الأمريكيتَيْن، وكانت الثالثة والرابعة ضد الأفارقة والسحرة الأوروبيين، فالمنطق العملي للاستعمار الاستيطاني هو «القضاء على السكان الأصلانيين» -حسب باتريك وولف- ولكن الشعوب الأصلانية موجودة وهي تقاوم وتستمر من ناحية، ولذلك فالاستعمار الاستيطاني هو بنية تستوعب الأصلانية، كما تحاول إخفاءها من ناحية ثانية.
هكذا إذن لم تكن العلمانية في العالمَيْن العربي والإسلامي مجرد عملية تثاقف وتأثير وتبادل، وإنما عملية غزو وإزالة ومحو؛ فبعد أقل من عشر سنوات على الثورة الفرنسية ۱۷۸۹م قام نابليون بغزو مصر في إطار الحملة الفرنسية على مصر والشرق عام ۱۷۹۸م، وقد أباد الفرنسيون نحو سُبع الشعب المصري خلال سنتَيْن فقط، حيث أبادوا نحو ۳۰۰ ألف من شعب مصر الذي كان تعداده آنذاك أقل من ثلاثة ملايين مصري، وقد وصف الجبرتي في تاريخه ذلك الحدث الكبير بقوله: «وبعد هجعةٍ من الليل، دخل الإفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقَّة والشوارع، لا يجدون لهم ممانعًا، كأنهم الشياطين أو جُند إبليس، وهدموا ما وجدوه من المتاريس.. ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر، وهم راكبون الخيول»، وفي الجزائر أُبِيدَ نحو ثُلث الشعب الجزائري، وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية مؤخرًا أن ضحايا الاستعمار منذ ۱۸۳۰م إلى ۱۹٦۲م يبلغ ٥ ملايين و٦۳۰ ألف شهيد، ورغم اشتهار الجزائر بثورة المليون شهيد، إلا أن بعض المؤرخين الموثوقين يُشير إلى أن ضحايا الاستعمار الفرنسي في الجزائر يصل إلى نحو ۱۰ مليون جزائري، وقد أُبِيدَ كذلك نحو نصف الشعب الليبي، إذ تولَّى الاستعمار الإيطالي إبادة نحو عُشر سكان ليبيا، أي واحد من بين كل ثلاثة رجال قادرين على حمل السلاح أثناء العقود الثلاثة الأولى من حكمه، ذلك الاستعمار الذي وجد في ليبيا فرصة لخلق «الإنسان الفاشي الجديد».
أول من استخدم لفظة «علمانية» بالعربية هو إلياس بقطر واضع «المعجم العربي» الصادر عام ۱۸۲۸م وقد عاش إلياس بقطر معظم حياته في فرنسا، وكان خبيرًا لغويًّا للحملة الفرنسية.
في سياق التدخل الكولونيالي الإمبريالي الأوروبي الإبادي العنيف في العالم الإسلامي، دخل مصطلح العلمانية إلى المنطقة بالتزامن مع الغزو الاستعماري، وتبعه جهاز «الاستشراق» بوصفه بنية وخطابًا ومنشئًا لشكل المؤسسة المعرفية والرمزية للكولونيالية المادية العنفية، بهدف إعادة إنتاج الشرق وتمثيله على الشاكلة التي تخيله الغرب عليها، وتثبيت استعمار المعرفة والخيال، في الوقت الذي كانت الاستعمارية تزيح وتمحو وتُغيِّر الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ماديًّا من خلال القوة العسكرية الإبادية الباطشة. وكان أول من استخدم لفظة «علمانية» بالعربية هو إلياس بقطر واضع «المعجم العربي» الصادر عام ۱۸۲۸م وقد عاش إلياس بقطر معظم حياته في فرنسا، وكان خبيرًا لغويًّا للحملة الفرنسية، ومع ذلك لم تُسْتَخدم الكلمة على نطاق واسع إلا بعد نحو قرن ونيف من الزمان، إذ لم تُسْتَخدم في النقاشات والمناظرات على نحو صريح.
يُركِّز التاريخ الرسمي للدولة ما بعد الكولونيالية في العالم العربي حول العلمانية، على عملية التثاقف بين الشرق والغرب ودور النخب المحلية من خلال آلية التفاوض التي جرت بين المستعمِر والمستعمَر، دون الإشارة إلى عملية الفرض والإكراه والعنف. وينتقد وائل حلاق بحق في كتابه «قصور الاستشراق» نظرية الفاعلية في الإطار الكولونيالي في رده على إدوارد سعيد وهومي بابا وأنصار نظرية الفاعلية عمومًا، التي تقول بأنّ السكان المستعمَرين قد شاركوا باختيارهم في تبنّي منظومة المستعمِر عبر عمليات من التفاوض والتعديل، من خلال التأكيد على «أن هذه النظرية لا تُفسر أبدًا العمليات التاريخية التي أدت إلى هذه الشروط التي تؤسس -بدورها- هذه العمليات وتوضح «الفاعل» داخل تلك الشروط وتقيده فيها... لقد فشلت نظرية الفاعلية في إثبات نجاح فاعلية غير الأوروبيين في صد هجوم الكولونيالية، وستستمر في هذا الفشل.
ولكي تُفْهَم الفاعلية لا بُدَّ من افتراض عمل الفاعلية فقط داخل نظام القوة نفسه الذي يعمل فيه الفاعل... فلو قبلنا حقيقة التحولات الهيكلية العميقة في المناطق التي أخضعتها الكولونيالية (التي فشلت في مواجهاتها حتى أشد أشكال المقاومة شراسة)، وجب علينا أن نقبل بأن عزو الفاعلية إلى سكان البلاد الأصليين والمغلوبين على أمرهم هو بمثابة فرض نظرية تحديث تقدمية عليهم وعلى تاريخهم، وهي بالطبع نظرية التقدم وعقيدته نفسها التي أخضعت هؤلاء السكان في المقام الأول. فـ«مساحة التفاوض والتغيير» التي عزاها هومي بابا إلى السكان الأصليين ممكنة فقط إذا سُمِحَ لهؤلاء السكان بالدخول في نظام قوة القوى الكولونيالية، وبعد أن يُحوَّلوا ثقافيًّا بصورة ممنهجة وبعد أن يصبح من العسير استعادة هويتهم الأصلية... تبدأ الفاعلية إذن هنا في التفكير في كيفية هدم بيت السيد باستخدام عُدَد السيد نفسه أو غيرها في أي مكان مهمش».
إذن، كانت عمليات الفرض والتفاوض حول شكل النظام تجري وفق شروط المستعمِر، فكل مقاومة من طرف المستعمَر كانت تواجه بعنف يقوم على الإبادة والاستئصال، وكانت المقاومة توصف بالإرهاب، وهو نهج لم يتبدل حتى اللحظة الراهنة، فاستراتيجيات ما يطلق عليه مكافحة التمرد والإرهاب المعاصرة تستند إلى ما دُشِّنَ إبان الحقبة الكولونيالية التاريخية. أما عملية تفاوض النخب الاستعمارية مع النخب المحلية المستعمَرة فكانت تجري وفق شروط المستعمِر، فلم يكن الدور التفاوضي لمن يطلق عليهم «الإصلاحيون» يتجاوز تحسين الشروط دون المساس بجوهر عملية الفرض الاستعماري، فقد قام الاستعمار بإزاحة وإزالة النخب المحلية المقاومة واستبدلها بنخب جديدة طيّعة؛ فقد كانت الكولونيالية تقوم على العنف المادي والحروب والمعارك من خلال الجهاز العسكري والعنف الإبستمولوجي باستعمار المعرفة والخيال من خلال مؤسسة «الاستشراق».
وهكذا استبدلت الدول الاستعمارية -الاستعمار البريطاني على وجه التحديد- بنظم التشريع الإسلامي في الدول التي استعمرتها كالهند ومصر، منظومة قانونية حداثية من خلال آلية الفرض، من أجل تسهيل السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادية في البلاد المستعمَرة، فالقانون بطبيعته القمعية من أهم الوسائل التي استخدمتها الدول المستعمِرة على المناطق المستعمَرة. ويؤكد حلاق على أن عملية استبدال النظم التشريعية للشريعة الإسلامية لم تكن لتحصل لولا تحالف النخب المحلية التي كانت ترى في تبني النظم القانونية وشكل الحياة الغربي المتقدم عنها شكلًا من أشكال التقدّم لدولها التي تسعى لمواكبة الحداثة الفكرية والصناعية التي بدأت في الغرب.

ورغم أن عِزة حسين في كتابها «سياسات تقنين الشريعة» تعارض جزئيًّا أطروحة حلاق المتعلقة بآليات الفرض والتفاوض، وتُحاجّج بأن آلية الاستبدال كانت تتم من خلال مفاوضات حصلت مع النخب المحلية في كل من الهند ومالايا ومصر، فإنها تُقِرّ أيضًا بأن هذه المفاوضات أسفرت في النهاية عن هذا الاستبدال. فعلى خلاف حلاق الذي يُشدِّد على عملية الاجتثاث والفرض والإكراه والقهر الذي مارسته السلطة الاستعمارية، تُركِّز حسين على أهمية التفاوض ودور النخب المحلية وتصوراتها الخاصة بالتوفيق بين التراث والحداثة.
فسيرورة تقنين الشريعة حسب حسين جرت وفق عملية فرض وتفاوض معقدة تقاسمتها النُّخبتان الكولونيالية والمحلية، وأفضت في النهاية إلى معضلة مَرْكَزة القانون الإسلامي وتقسيمه إلى نطاقَيْن: يختص أولهما بشؤون التجارة وجباية الضرائب والإنتاج «المادي» الذي يخدم السياسات الاستعمارية، ويقتصر الآخر على الأمور الدينية الثقافية من الشعائر وأحكام الأسرة والمواريث وغيرها. فالنخب المحلية التي أسهمت في تقنين الشريعة، قامت بذلك خدمة لمصالحها في الهيمنة والسيطرة، حيث خدمت عملية تقنين الشريعة ومركزتها مصالح نُخب محلية بعينها اتفقت مع أهداف وغايات السلطة الكولونيالية ومصالحها، وصعدت بها إلى أعلى سُلَّم السلطة والثروة. وهي عملية أفضت إلى اختفاء نُخب محلية أخرى مثل علماء الشريعة، أو أجبرتها على تغيير نظرتها إلى نفسها ودورها، وأفضت أيضًا إلى تحوّل جذريّ في معنى الشريعة (أو القانون الإسلامي) وفي إعادة تعريف سؤال السيادة.
إن السمة المميزة لهذا التحول التقنيني هو استحواذ الدولة القومية على القانون، وهو تحول أوصل رسالة واضحة مفادها أنه حتى لو كان الحكم في جوهره ومادته من أحكام الشريعة، فإن الدولة هي صاحبة الحق المطلق في تقرير هذه الحقيقة وتقرير ما يُعَدُّ من أجزائها أو أحكامها قانونًا وما لا يُعَدُّ كذلك. وهذا بالتحديد هو معنى السيادة ولا صلة لغير الدولة بالسيادة، وحسب طلال أسد فـ«عندما انبنت الشريعة أساسًا بوصفها محددًا للأحوال الشخصية في القانون طالها تحول جذري.. فما حدث للشريعة لم يكن تحجيمًا بل تبدلًا جوهريًّا، لقد أُحِيلَت للتبعيض الجاري في قانون معتمد من قبل دولة مركزية... وعُلْمِنَت بأساليب مميزة»، ولم تتمحور عملية العلمنة هذه حول الفصل بين الكنيسة والدولة أو إقصاء الدين إلى حيز خاص، وإنما حول حق الدولة وقدرتها على أن تمنح الدين دوره المخصوص، وتُحدِّد هذا الدور في إطار التبعية للدولة.
وهكذا فإن ما نعرفه اليوم على أنه قانون الأسرة الإسلامي مثلًا هو نتاج الجهود التي قامت بها الدولة القومية لتحديث قوانينها، وقد تضمنت هذه العملية تشكيل لجان لاختيار أحكام محدَّدة من كل من الفقه والقوانين الاستعمارية، وتضمّنت التقنين الذي قامت به الأجهزة التشريعية في الدولة، ثمّ الإنفاذ من قبل السلطات التنفيذية في الدولة. لقد كان المصلحون أنفسهم خريجي كليات القانون في أوروبا الغربية وكانوا متأثرين بالنظم القانونية وفلسفة القانون التي درسوها في أوروبا وجلبوها معهم في أوطانهم وشرعوا في محاكاتها.
وفي حين يقال إن محتوى القانون مستقى من الشريعة من حيث الواقع والروح، فإن المنهجية التي اتُبعت في اختيار القانون وتنفيذه كانت قائمة بالكامل على نماذج أوروبية وعلى فلسفة القانون والنوع الاجتماعي الذي كان سائدًا في أوروبا في ذلك الوقت. فبحسب وائل حلاق فإن قانون الأسرة العثماني لعام ۱۹۱۷م لم يغادر نصوص الشريعة بيد أنه قنّنها، مخضعًا إياها لثبات لغة خطية واحدة خالية من التعدد والفروق الفقهية الدقيقة المتعددة والاختلافات التي كان يبديها الفقه. اسْتُخدِم القانون في بنيته الإكراهية القمعية بوصفه أداة للقوة الاستعمارية، فالقانون جزء لا يتجزأ من بنية الاستعمار وليس حدثًا عرضيًّا نتج عنها، وهو قوة تأسيسية في إنتاج المستعمِر، وكذلك إنتاج أمة ما بعد الاستعمار. وشكَّلت آلية التقنين الأداة الكولونيالية المفضلة لإفراغ الشريعة من مضمونها وآليات عملها الاجتماعية ومن معناها الأخلاقي بوصفه نطاقًا مركزيًّا في الإسلام.
كان لا بُدَّ من تحويل القوانين المحلية التي كانت سائدة في الأراضي المستعمَرة على نحو يجعلها خاضعة للإملاءات الاقتصادية والتجارية.
بدأت دينامية علمنة العالم الإسلامي من خلال عمليات الفرض والتفاوض الاستعماري مع حلول نهاية القرن التاسع عشر، وقد تتبَّع هذه العملية البروفيسور وائل حلاق في كتابه المرجعي الماتع «الشريعة»، حيث كانت أوروبا قد أخضعت ما يُقارب من تسعة أعشار أراضي المعمورة لحكمها الاستعماري، ومع تطويرها لأشكال غير مسبوقة من القوة العسكرية والاقتصادية التي مكّنتها من اجتياح الأراضي التي كان المسلمون يحكمونها طوال قرون، كان الاستعمار المباشر وغير المباشر يصب في الانتفاع المادي بالدرجة الأولى من هذه الأراضي، فكان لا بُدَّ من تحويل القوانين المحلية التي كانت سائدة في الأراضي المستعمَرة على نحو يجعلها خاضعة للإملاءات الاقتصادية والتجارية. أعقب هذه التدخلات التجارية المباشرة وغير المباشرة من الدول الاستعمارية، تأسيس القوانين الجزائية الأوروبية، التي لم تنفصم عن المجال السياسي الذي شَرْعَن هذه القوانين من أجل الهيمنة. وهذه الهيمنة على ثروات البلاد لم تكن ممكنة دون ضمان المجالَيْن السياسي والثقافي من خلال القانون في الدولة القومية الحديثة.
إن دخول العلمانية إلى العالم الإسلامي -إذن- لم يكن وليد عملية تثاقف أفضت إلى إصلاحات وفق ديناميات محلية إصلاحية، بل إن مصطلح «الإصلاح» في الماضي كما الحاضر لا يكاد يُشِيرُ إلى أكثر من عملية تكيُّف مع النموذج الغربي وشروطه ومقولاته الكونية ورؤيته الأيديولوجية للتقدم. فقد برزت الدينامية التي سُمِّيت بـ«الإصلاحات» في الإمبراطورية العثمانية في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر، بعد أن خاضت الدولة العثمانية ثلاث حروب ساحقة مع روسيا، وولَّدت هذه الهزائم موجة من الامتيازات العثمانية السخية الممنوحة لعدد من الدول الأوروبية، وكان انهيار الاقتصاد العثماني من العوامل الرئيسة التي تسبَّبت في حركة الإصلاحات القانونية التي بدأت بإصدار فرمان «كلخانة» عام ۱۸۳۹م، الذي يُشكِّل النقطة المحورية في مرحلة التنظيمات العثمانية، ثمّ شهد عام ۱۸٤۰م سنَّ قانون عقوبات جديد ذي نزعة حداثية مع مفاهيم جنائية إسلامية.
وعلى إثر الضغوط الكبيرة الناجمة عن تراكم الديون على عاتق الإمبراطورية العثمانية لفرنسا وبريطانيا بعد حرب القرم مع روسيا، جاء فرمان «همايون» لعام ۱۸٥٦م وكُتب بعد مشاورات مع سفراء فرنسا وبريطانيا والنمسا، واختلف هذا الفرمان عن فرمان كلخانه بابتعاده عن مبادئ الإسلام في الحكم، ولم يُذْكَر فيه القرآن أو الشريعة ألبتة وشُدِّد فيه على إنشاء حكومة تمثيلية على الطراز الأوروبي. وقد تجلَّت المرحلة الأولى من انتقال السلطة التشريعية في تحول الفقه الإسلامي من دائرة الفقهاء المستقلة وغير الرسمية بدرجة كبيرة إلى إدارة الدولة الرسمية، وهو ما ظهر في حالة مجلة «الأحكام العدلية» التي اضطلعت بإصدارها لجنة كان يرأسها فقيه الشريعة أحمد جودت باشا الذي كانت له السلطة العليا في صياغتها، في مقابل الشخصية التغريبية وهو عالي باشا الذي أراد تبني القانون المدني الفرنسي لعام ۱۸۰٤م، إلا أن جودت باشا أصر أن تكون المجلة موافقة للبنية الثقافية للإمبراطورية العثمانية، وبين عامَيْ (۱۸۷۰م -۱۸۷۷م) طُبِعَت المجلدات الستة عشر التي تؤلف المجلة.

وفي مصر ظلَّ محمد علي خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر متمسكًا بروح البرنامج الإصلاحي للباب العالي في الإمبراطورية العثمانية، مع اهتمامه الكبير بتحديث مصر. وفي عام ۱۸۳٦م سلَّم خبراء فرنسيون تقريرًا لمحمد علي يتضمن كيفية إجراء تحسينات في المجال العسكري والاقتصادي بعد دعوة وجهت لهم، وكان جوهر هذه التوصيات ضرورة إيجاد إدارة مركزية يمكنها تنظيم جميع شؤون الحياة في مصر، من الجيش والطوائف إلى المرور العام وقنوات مسيل المياه، وقد نُفِّذت توصيات الخبراء من قبل محمد علي عندما أصدر ما سُمِّي بسياسة نامة عام ۱۸۳۷م، وهي خطة إصلاحية اتخذت بقصد احتذاء نُظم الحكم الأوروبية.
تلك هي قصة دخول العلمانية إلى العالم الإسلامي عن طريق العنف الاستعماري، وهي عملية أفضت في النهاية إلى إلغاء الخلافة الإسلامية عام ۱۹۲٤م. فعصر التنظيمات الذي بدأ في أربعينيات القرن التاسع عشر في الإمبراطورية العثمانية، واستلهم شكل أنظمة الحكم الغربية من التقنين والبيروقراطية والعسكرة، لم يكن مجرد تثاقف ومحاكاة لعملية العلمنة التي حدثت في الغرب أو إصلاحات لا بُدَّ منها، وإنما كان صورة لعملية كولونيالية عنيفة تهدف إلى الإزالة والمحو والاستبدال، وهي عملية ما تزال فاعلة وتحرسها القوى الإمبريالية حتى اليوم، فالاستعمار «بنية وليس حدثًا» -كما حاجج باتريك وولف- فهو عملية مستمرة دون توقف.
والعلمانية يمكن مَفْهَمتُها بوصفها مشروعًا كونيًّا غربيًّا ينطوي في سياق ما بعد كولونيالي حسب صبا محمود «على إخضاع متواصل للمجتمعات اللَّاغربيّة لشتّى أشكال الهيمنة الغربيّة»، ذلك أن الخلافة بوصفها نظامًا سياسيًّا اجتماعيًّا يستند إلى الشريعة ليست مجرد تهديد ثقافي أو سياسي تجاه المركزية الغربية والكينونة البيضاء، بل هي أيضًا تحدّ معرفي قادر على كسر الجوهرانية الأوروبية ودعواها بالعالمية والخاتمية حسب سلمان سيد. ولم يتبدل الحال اليوم فالقوى الإمبريالية الحديثة التي وَرِثَت التركة الكولونيالية الكلاسيكية تتعامل مع مسعى استعادة الخلافة كما تعاملت معها بالأمس، فكل من يدعو إلى عودة «الخلافة» حتى لو كان على شاكلة تنظيم «الدولة الإسلامية-داعش» ورؤيته وتطبيقاته الكاريكاتورية الساذجة للخلافة يُوصَم بالإرهاب، وتُسْتَخدم ضده تكتيكات الأرض المحروقة وسياسات مكافحة التمرد، ويُنعَت بالتخلف والرجعية ومعاداة القيم الأخلاقية التقدمية.
لقد تجنبت هنا الجدلَ الفكري الذي خلقته الكولونيالية حول العلمانية في البلدان المستعمَرة، وعلاقة الديني بالسياسي في الإسلام، فقد كانت تلك العلاقة من المسلّمات البدهية إبان الحقبة الاستعمارية، فعندما أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» عام ۱۹۲٥م بعد عام واحد من إلغاء الخلافة، لم يجد من يؤيده من العلماء والشيوخ والدعاة، وقد طُرِدَ عبد الرازق من الأزهر وجُرِّد من ألقابه العلمية، وصدرت عشرات الردود على أطروحته التي تفصل بين الروحي والزمني والسياسة والدين، فضلًا عن عقد مؤتمرات عدة في دول مسلمة تدعو إلى إحياء الخلافة، بل إن الدكتور عبد الرازق السنهوري -وهو أبو القانون المدني وواضع المقومات الدستورية والقانونية للكثير من البلاد العربية، وكان عند صدور كتاب عبد الرازق في باريس يعدّ رسالة دكتوراه عن «الخلافة الإسلامية»- أكَّد في أطروحته على شذوذ وغرابة دعوى عبد الرازق، وكتب تحت عنوان «رأي شاذ» عن شمول الإسلام للسياسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة إسلامية في المدينة المنورة، وأن الصحابة بعد وفاة النبي لم يُنشئوا دولة، وإنما وسَّعوا رقعة الدولة التي أنشأها.
- مركز نهوض: في مرحلة الانتقال السياسي القصير بعد اندلاع الثورات العربية مطلع العقد الماضي، بَرَز مصطلح جديد في المعجم السياسي، وبدا وكأنه يُمثِّل نقطة تلاقٍ بين التيارات الإسلامية التي كانت تدعو تاريخيًّا إلى إقامة «دولة إسلامية»، وبين التيارات العلمانية بأطيافها المختلفة، ألا وهو مصطلح «الدولة المدنية». كيف تقرأ هذا المصطلح؟ وهل يُمثّل خيارًا ثالثًا أم أنه كان مجرَّد حيلة خطابية لتأجيل الصراع بين طرفَيْن لا يلتقيان؟
حسن أبو هنية: مصطلح «الدولة المدنية» لا وجود له في أي قاموس سياسي معروف، وهو اختراع عربي برز بقوة عقب ثورات «الربيع العربي» عام ۲۰۱۱م، عندما احتدم الجدل حول هوية الدولة والمجتمع في العالم العربي، واحتل المصطلح موقعًا مركزيًّا في حرب المفاهيم بين الأطراف العلمانية والإسلامية، فقد أصبحت كلمتَيّ «الدولة المدنية» الأكثر تداولًا دون وجود محدد مرجعي للمصطلح، حيث فسّرته الأطراف الإسلامية والعلمانية وأوّلته على مقاسها، واختُلِف عليه داخل كل توجه، حيث تمسك بعض الإسلاميين بمصطلح الدولة الإسلامية، وأصرّ بعض خصومهم على مصطلح الدولة العلمانية. فقد تبنَّت جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر فكرة «الدولة المدنية» مع اقترانها دائمًا بقيد يُؤكِّد على مرجعيتها الإسلامية، وهو الموقف الذي تبنّاه حزب العدالة والتنمية المغربي وحركة النهضة التونسية، وصدرت مؤلفات ورسائل إسلامية عدة حول مدنية الدولة بتأويل إسلامي، ورفضت بعض الجماعات التسمية كجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وبالطبع ترفض الحركات الجهادية وحزب التحرير والجماعات الدعوية مصطلح الدولة المدنية وتعدّه جسرًا وحيلة لتمرير العلمنة.
لم يكن الجدل حول هوية الدولة والمجتمع وليد أحداث الربيع العربي، إذ لم تنقطع المناظرات بين التوجه العلماني والتوجه الإسلامي منذ إلغاء الخلافة، ذلك أن موقع الدين في الدولة العربية ما بعد الكولونيالية ومجال وظيفته وحدود اشتغاله يُمثِّل إحدى أكثر المسائل الإشكالية، وقد دفع هذا الالتباس في تحديد هوية الدولة العربية ما بعد الكولونيالية بين الديني والعلماني، الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن إلى تعريف هذه الدولة ما بعد الكولونيالية بـ«الدولة المشتبهة»، بينما استخدم عالم اجتماع الشرق الأوسط آصف بيات مصطلح الدولة العلمادينيّة (العلمانية الدينية)، ونظرًا لإشكالية المصطلح والتباس هوية الدولة العربية المعاصرة تجنب معظم المفكرين العرب استخدام مصطلح العلمانية، أمثال حسن حنفي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وغيرهم.
وقد شكَّل مصطلح الدولة المدنية سرديةً توفيقية بين التيارَيْن العلماني والديني، ذلك أن المصطلح غير محدد ومن الممكن تأويله بطرق عدة، فهو طارئ على حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفة السياسية التي خَلَت معاجمها من أي ذكر لـ«الدولة المدنية»، فمصطلح «الدولة المدنية» هو اختراع عربي مُحْدَث وُلِدَ في خِضَمِّ السجال العلماني/الإسلامي حول طبيعة الدولة المراد تأسيسها بعد مرحلة التغيير التي يُبشِّر بها كل طرف.
- مركز نهوض: مثَّلت أطروحة وائل حلاق في «الدولة المستحيلة» تتويجًا لتيار النقد الأخلاقي والمابعد استعماري للدولة الحديثة، بوصفها جهازًا قمعيًّا يعمل على ضبط المواطنين وتشكيلهم لخدمة مصالحها دون اعتبارات أخلاقية متعالية، وفي الوقت نفسه بوصفها (أي الدولة) ذات شرعية وسيادة مطلقتَيْن لا نزاع فيهما. ولكن أطروحة حلّاق أسهمت أيضًا -بحسب بعض القراءات- في تعميق المشكلة وتأبيدها، إذ أغلقت المجال أمام أي نوع من الحلول التوفيقية أو التدريجية الإصلاحية. برأيك، هل تمتلك التيارات النقدية والتيارات المابعد استعمارية القدرة على تقديم مثل هذه الحلول؟ أم أن مهمّتها تقتصر على إبراز آليات عمل السلطة وتاريخيّة المعرفة التي تنتجها؟
حسن أبو هنية: نعم. تسببت أطروحة وائل حلاق النقدية الراديكالية بردود فعل متباينة وأدَّت إلى سوء فهم والتباس، وخصوصًا من قبل أتباع وأنصار تيار الإسلام السياسي، إذ يُمكن تسمية كتابه ببساطة «دولة الإسلام السياسي المستحيلة»، وهي مقولة كان أوليفيه روا قد أشار إليها مطلع تسعينيات القرن الماضي في كتابه «فشل الإسلام السياسي»، ذلك أن الإسلام السياسي تخلَّى عن مفهوم «الخلافة» التاريخي وتبنّى مقولة الدولة الإسلامية التي تستند إلى آلية تطبيق الشريعة، وهي رؤية تبسيطية تتلخص في مقولة أسلمة الدولة القومية، وهما مفهومان ينتميان إلى مجالَيْن مختلفَيْن على الصعيدَيْن الأنطولوجي والإبستمولوجي، فكلاهما يُنتِج ذاتيات وكينونات مختلفة من عالمَيْن مختلفَيْن، وهو طرح نقدي يتوافق مع أطروحة سلمان سيد الذي يؤكد على أن «الخلافة» ليست مغايرة لمفهوم الدولة الحداثي فحسب، وإنما تُشكِّل تحديًا إبستمولوجيًّا وتهديدًا جيواستراتيجيًّا للمركزية الغربية البيضاء.
في الوقت الذي يُشكِّك فيه بعض المنظرين الغربيين في استمرارية الدولة القومية في المستقبل؛ فإن الإسلاميين في العصر الحديث يقبلون الدولة بوصفها أمرًا مفروغًا منه، ويرونها ظاهرة تصلح لكل زمان ومكان.
لقد لاحظ طلال أسد في هذا السياق أن كلا الفريقَيْن -القوميين العلمانيين والإسلاميين- قد تبنَّيا نظرة دولتية نَظرَا فيها إلى الشريعة بوصفها «قانونًا مقدسًا» تم تأطيره ولكن ينبغي أن يُدار من خلال مؤسسات الدولة، ولا يخرج حلاق عن هذا الرأي حيث ذهب إلى أن كبار مفكري الإسلاميين قبلوا بالدولة الحديثة بوصفها أمرًا مفروغًا منه وصار حقيقة طبيعية، وافترضوا في أغلب الأحيان أن هذه الدولة لم تكن قائمة على مر تاريخهم فحسب، بل ساندتها أيضًا سلطة القرآن نفسه، ويرون أن الدولة القومية الحديثة -التي تُعَدُّ ظاهرة غير مسبوقة وفريدة- قد دُشِّنت في «الدستور الإسلامي» الذي وُضِع في المدينة المنورة منذ أربعة عشر قرنًا. وفي الوقت الذي يُشكِّك فيه بعض المنظرين الغربيين في استمرارية الدولة القومية في المستقبل؛ فإن الإسلاميين في العصر الحديث يقبلون الدولة بوصفها أمرًا مفروغًا منه، ويرونها ظاهرة تصلح لكل زمان ومكان، وذهبوا إلى حد الادعاء بأن مفاهيم المواطنة والديموقراطية وحق الاقتراع من إنجازات المجتمعات الإسلامية الباكرة، ولذلك فقد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن الدولة المدنية أو القومية لا تعارض الشريعة الإسلامية.
إن وائل حلاق يؤكد على أن الحكم الإسلامي ساد على مدى قرون وطبَّق حكمًا جيدًا بكافة المقاييس، وهو حكم يستند إلى الشريعة التي تُعَدُّ النطاق المركزي في الإسلام وتقوم على أسس أخلاقية راسخة، وهو يؤكد على إمكانية بل وجوب عودة هذا الحكم الذي يُنتج ذوات وكينونات إسلامية أخلاقية مناقضة لأي مفهوم للدولة الحديثة، فنقد حلاق ينصبُّ بصورة جلية على تصورات الإسلام السياسي التي أُعيدت قولبتها لتتواءم مع «الدولة المستوردة» حسب عبارة براتران بادي، وهي الدولة ما بعد الكولونيالية التي أسسها المستعمِر، والتي حافظت دولة ما بعد الاستقلال على فلسفتها وبنيتها ومؤسساتها وأجهزتها القمعية والأيديولوجية.
على هذا النحو، يحاجج حلاق بحق أن مقولة «الدولة الإسلامية» ظهرت في الفكر السياسي العربي المعاصر استنادًا إلى مفهوم الدولة القومية الغربية، فمقولات الإسلام السياسي مقولات دولتية في جوهرها، إذ تفترض الخطابات الإسلامية الحديثة -حسب حلاق- أنّ الدولة الحديثة أداة محايدة للحكم، يمكن استخدامها في تنفيذ وظائف معيّنة طبقًا لخيارات قاداتها وقراراتهم، وهذه الفكرة كانت توليفة لتجاوز فكرة الخلافة التي تراءت يومئذ غير ممكنة التحقّق. لهذا سيُستَعار هيكل الدولة الحديثة المعاصرة، على أن يكون قانونها إسلاميًّا وهو الشريعة، فالدولة في هذا المتخيَّل أشبه ما تكون بقوالب محايدة يمكن أن يُصبّ فيها ما نريده، وهذا غير صحيح بالطبع.
- مركز نهوض: في ظلِّ تصاعد المدّ اليميني الشعبوي عالميًّا، والذي اتسعت حدوده في السنوات الماضية حتى صار يشمل الولايات المتحدة وعددًا كبيرًا من الدول الأوروبية (بما في ذلك فرنسا)، إضافة إلى الهند والصين، تتزايد المؤشّرات على حضور الأبعاد الدينية والحضارية في السياسة العالمية، وذلك على الرغم من خضوع الدول الغربية لصيرورات علمنة مديدة. برأيك، وبعد عاصفة الربيع العربي العاتية التي أنهت وأنهكت مسيرة الأحزاب الإسلامية، كيف يقرأ الإسلاميون المشهد اليوم بخصوص موقع الدين من الفضاء العام؟ وهل نشهد انقسامًا في التيار الفكري الإسلامي الواسع بين خيارَيْن: أحدهما ما بعد إسلاموي تجذَّر قبوله لمنظومة الدولة الحديثة وصار يرى دوره هو المشاركة بوصفه حزبًا محافظًا دون حمولة أيديولوجية كثيفة، والثاني راديكالي يميل إلى التنافي المطلق مع منظومة الدولة وينادي بيوتوبيا بعيدة التحقق؟
حسن أبو هنية: في العالمَيْن العربي والإسلامي لم يَغب الدين عن الفضاء العام يومًا، وقد تراجع دور الدين في الغرب لكنه لم يختفِ إذ ظهر بطرق عديدة، بحيث صارت مقولة «أفول الدين» التي هيمنت على منظِّري السوسيولوجيا الكلاسيكية من ماركس إلى دوركايم وفيبر متجاوَزَة، وهي نظرية سوسيولوجية تطورية آمنت بخرافة التقدُّم الخطي، وزمن الخروج من العالم المسحور. فمنذ تسعينيات القرن الماضي غدت نظرية العلمنة مبتذلة وبالية إلى الحد الذي دفع بخوسية كازانوفا إلى التساؤل «من الذي ما زال يؤمن بأسطورة العلمنة؟»، إذ قامت هذه النظرية على مقولتَيْن رئيستَيْن: مقولة تأسيسية ادعت أن تمايز النطاقات «الدينية» و«الدنيوية» سيؤدي بالضرورة إلى اضمحلال الدين وأفوله واندثاره، وترتب عليها مقولة أخرى لازمة، تُفيد بأن هذا التمايز سيؤدي إلى فقدان الدين لوظائفه الاجتماعية وتراجعه من المجال العام وحصره في نطاق خاص ومحدد، وقد اصطدمت توقعات العلمنة بـ«أفول الدين» بوصفه نتيجة حتمية للتحديث بواقع «عودة الدين» على أنه فاعل يقاوم ويرفض البقاء على الهامش الذي رسمته له نظريات الحداثة والتحديث.
لكن مؤشرات «عودة الدين» لا تتمثَّل بمظاهر التدين والصلوات الجماعية واللباس وغيره، فهذه العلامات كانت حاضرة باستمرار في مجتمعات متعددة، فما استجد هو أن «الدين» رفض أن ينحصر دوره في تنظيم أمور الأفراد الروحانية، أو أن يتحول إلى حالة إيمانية صرفة تحكمها علاقة الفرد بالله، أي إنه رفض أن يبقى ضمن إطار الحيز الخاص كما افترضت وفرضت عليه نظريات العلمنة، تلك النظريات التي تنظر إلى التاريخ بوصفه مسارًا خطيًّا ينتقل بحتمية حداثية «من التطيّر إلى العقل، ومن الإيمان إلى الإلحاد، ومن الدين إلى العلم» حسب كازانوفا الذي بيَّن من خلال دراسة حالات لأربع دول (الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إسبانيا، بولندا) كيف استطاع الدين أن يصمد أمام مزاعم نظرية أنساق العلمنة، ولهذا دعا إلى ضرورة العمل على مراجعة ثلاثة من المبادئ التي قامت عليها نظرية العلمنة الجديدة: وهي انحيازها إلى الأشكال الدينية البروتستانتية الذاتية، وانحيازها إلى المفاهيم السياسية «الليبرالية» وخاصة المتعلقة بـ«النطاق العام»، وأخيرًا انحيازها إلى الدولة-الأمة ذات السيادة بوصفها وحدة التحليل المنهجية .
كانت إسهامات طلال أسد حاسمة في إعادة النظر في مقولات العلماني والديني، والتمييز بين العلمانيّة بوصفها نظامًا للحوكمة السياسيّة أو «المشروع الدولتيّ» (الأيديولوجيا)، وبين العلمانيّ بوصفه مجموعة من المفاهيم والممارسات والحساسيّات والتدابير التي تُميِّز الذات، وبين العلمنة التي تُعرَف بوصفها تصورًا تحليليًّا لعمليات تاريخية عالمية حديثة، وبذلك صار العلماني فئة تصنيفية محورية، مع ضرورة التأكيد على أن «الديني» و«العلماني» يصوغ أحدهما الآخر دائمًا وفي كل مكان» كما حاجج أسد.
لقد برزت إشكالية الديني/العلماني في العالم الإسلامي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، عندما تخلَّت بريطانيا العظمى وفرنسا وقوى أوروبية أخرى عن مستعمراتها في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا -حسب مارك فتحي مسعود- إذ واجه قادة البلدان ذات السيادة الجديدة وذات الأغلبية المسلمة قرارًا ذا عواقب هائلة: هل ينبغي لهم أن يبنوا حكوماتهم على أساس ديني إسلامي القيم أم عليهم تبنّي القوانين الأوروبية الموروثة من الحكم الاستعماري؟ ويُظْهِر بحث مسعود التاريخي أن القادة السياسيين لهذه البلدان الناشئة اختاروا الحفاظ على أنظمة العدالة الاستعمارية بدلًا من فرض القانون الديني.
تتضاعف الإشكاليات والالتباسات في فضاءات الشرق الأوسط حول العلماني والديني، نظرًا لخصوصية المنطقة، التي تتمثل في جدلية العلماني والعلمانية وأسبقية الظهور التاريخي، ففي العالم الغربي ظهر مفهوم العلماني بوصفه مقولة معرفية قبل تبلور مذهب العلمانية بوصفه عقيدة سياسية، حيث تجمعت العديد من المفاهيم والممارسات والحساسيات مع الوقت لتشكل العلماني، فالعلماني ظهر في الغرب أولًا بوصفه مقولة إبستمولوجية أنتجت لاحقًا العلمانية بوصفها أيديولوجيا ومذهبًا سياسيًّا وقانونيًّا، وذلك بخلاف ما حصل في العالم العربي والإسلامي، حيث فُرِضَت العلمانية من قبل الكولونيالية، وترسخت بوصفها أداة تقنية وسياسية قبل ظهور العلماني على أنه رؤية أنطولوجية ونظرة إبستمولوجية، وهو ما خلق حالة من التوتر بين قيم المجتمعات الإسلامية التقليدية، وقيم الدولة العلمانية الحداثية، وأنتج حالة علمانية بديلة تجمع بين المادي والروحي والتقليد والحداثة.
فبحسب صبا محمود، فإن عدم التزام دول الشرق الأوسط بالليبرالية والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان لا يعني أنها ليست دولًا علمانية، ولا يعني تمييزُ هذه الدول بوصف «الاستبدادية» -بسبب انتهاكها الصارخ للحريات الفردية- أنها علمانية ولكن بصورة غير كافية، أو أن الأمر يستلزم وضع تصنيف خاص من العلمانية لتمييز هذا الطراز السلطوي المغاير للطراز المُمارس في المجتمعات الأورو-أطلسية العلمانية النموذجية، فهذه الطريقة في صياغة الاختلاف تُعمينا عن السمات المشتركة للمشروع العلماني التي تشترك فيها المجتمعات الشرق أوسطية والأورو- أطلسية.
في حالة العالم العربي والإسلامي كان الدين حاضرًا دومًا، فالإسلام هو دين الدولة كما تنص معظم الدساتير العربية، وأحيانًا هو مصدر التشريع. ويشير عمل جاكوب بيترسون حول مؤسسة الإفتاء في الحالة المصرية (وهو ما ينطبق على بقية البلدان العربية والإسلامية) إلى أن عملية المأسسة التدريجية للمجال الديني برهنت على التزامها بالحفاظ على الإسلام الصحيح وتشجيعه، وبهذا الشكل وجهت حركة المأسسة تجاه العلمنة بحركة أخرى صوب دمج الإسلام داخل مجال نشاط الدولة، ومن ثَمَّ انبثق إسلام رسمي جديد أكثر تسييسًا.

ولكن يجب التنبيه كما يؤكد بيترسون على أن مؤسسة الإفتاء مثلت أداة الإسلام الرسمي المفضلة للتكيف بين الدولة والدين، والتي تُحدّد حلولًا داخل إطار عمل قوانين الدولة السارية، فمفتي الديارالمصرية -وهو ما ينطبق على وظيفة المفتي في بقية الدول العربية- يسعى إلى تقديم النظام القائم على أنه طبيعي وعادل ويتماشى مع التطور وأنه صالح لكل زمان ومكان. وهو ما يكشف عن أن العلمانية السياسية -على عكس ما يُشاع عنها- ليست هي مبدأ حيادية الدولة، وإنما هي إعادة تنظيم الدولة للحياة الدينية، إذ تحوّل السياسات العلمانية الدينَ وفق عملية يتداخل فيها الديني والعلماني. فقد أصبحت الدولة الحديثة منخرطة في تنظيم الحياة الدينية وإدارتها بدرجة لم يسبق لها مثيل رغم زعمها الحياد الديني، ما يستدعي زج الدولة في المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقائد والممارسات الدينية.
في هذا السياق اتبعت السياسة الدينية في العالم العربي مسارًا انتهازيًّا مزدوجًا من الأسلمة: الأسلمة من أعلى من خلال الإسلام الرسمي، والأسلمة من أسفل من خلال حركات الإسلام السياسي الدولتية، وقد أفضت السياسات الدينية الانتهازية إلى تشكل ثلاثة نماذج لحركات الإسلام السياسي حسب أوليفيه روا، الأول: حزب من النمط اللينيني يقدم نفسه على أنه طليعة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وينكر شرعية كل الأحزاب الأخرى. والثاني: حزب سياسي من النمط الغربي يسعى -داخل إطار انتخابي ومتعدد الأحزاب- إلى تمرير الحد الأقصى من عناصر برنامجه. والثالث: جمعية دينية نشطة تسعى إلى ترويج القيم الإسلامية، وتغيير العقليات والمجتمع عبر استحداث حركات تشاركية والتغلغل في أوساط النخب.
لقد حدّدت السياسة الدينية للدولة-الأمة في العالم العربي مسارات الإسلام السياسي وحدوده، إذ ترتبط مشاركة وهيمنة الإسلاميين وتمدد الإسلام السياسي وانحساره بالتحالفات التاريخية مع الأنظمة المحلية القائمة على المصالح الوقتية المشتركة، التي تعتمد بدورها على معطيات الظروف الاستراتيجية الدولية والتحولات السياسية المحلية. ومع تغيّر وتبدل تلك الظروف وتحولها، كانت تتبدل التحالفات، ففي حقبة الحرب الباردة شكل «العامل الديني» الاستراتيجية المعتمدة للولايات المتحدة والغرب للتحالف مع الإسلاميين في إطار مواجهة الخطر الشيوعي عبر مدخل محاربة الإلحاد الشيوعي، ثم تبدَّلت هذه العلاقة بعد سقوط جدار برلين في عام ۱۹۸۹م وانهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المنظومة الاشتراكية، حيث تغيرت خطوط الخطاب الغربي حول العلمانية مرة أخرى، وصار الإسلام يُعامل على أنه تهديد لنظام يُنظر إليه بوصفه ديمقراطيًّا ومسيحيًّا، وهو ما انعكس على خطاب الأنظمة المحلية التي تبدلت نظرتها إلى الإسلام السياسي من حالة الحليف إلى وضعية العدو.
لم تُفْلِح الأوجه المتعددة للإسلام السياسي في اختراق منظومة سلطة الاستعمار الداخلي، فآثار الكولونيالية والإمبريالية وفعاليتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ما تزال مهيمنة على سياسات الأنظمة ما بعد الكولونيالية في كافة المجالات.
وقد بلغت هذه الدينامية على صعيد الخطاب والممارسة ذروتها عقب انتفاضات «الربيع العربي» ۲۰۱۱م، إذ سرعان ما تحول «الربيع العربي» من فرصة سانحة للإسلام السياسي وطموحاته بالمشاركة في الحكم إلى حالة ووضعية باتت تسعى فيها حركات الإسلام السياسي جاهدة إلى مجرد الحفاظ على شرعية بقائها ووجودها السياسي والاجتماعي، وبات ينظر إليها على أنها خطر وتهديد للاستقرار والأمن، ثمّ تحولت الخطابات الرسمية من تعريفها على أنها جماعات وحركات وقوى معتدلة، إلى حركات ميسِّرة للتطرف والعنف في أحسن الأحوال، أو بوصفها جماعات متطرفة وعنيفة وإرهابية، حيث صُنِّفت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عدة دول عربية، وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات، ولم يكن غريبًا أن تدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثورة المضادة وانقلاب الأنظمة العربية الاستبدادية على الإسلاميين، تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار والأمن، وبحجة حماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. في نهاية المطاف لم تُفْلِح الأوجه المتعددة للإسلام السياسي في اختراق منظومة سلطة الاستعمار الداخلي، فآثار الكولونيالية والإمبريالية وفعاليتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ما تزال مهيمنة على سياسات الأنظمة ما بعد الكولونيالية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تزال تتحكم في بناء وصياغة خطاباتها وتصوراتها وممارساتها.
ومهما قولبت حركات الإسلام السياسي من أيديولوجيتها وخطاباتها وعدّلت من سلوكياتها وممارساتها، ستظل تُعرّف بالإسلام على أنه دين وسياسة، وهو إسلام يُنظَر إليه دومًا بوصفه نقيضًا للغرب ويناهض المركزية الغربية البيضاء، وبوصفه كينونة تناهض ادعاءات الكونية والعالمية، ويتمّ التعامل معه على أنه مشروع مفكك للاستعمار سياسيًّا وثقافيًّا. إن الترابط بين الكولونيالية بوصفها بنية وما بعد الكولونيالية بوصفها حدثًا، يَبْرُز أوضح ما يكون من خلال الاستراتيجيات والتكتيكات العربية المتبعة في التعامل مع الإسلام السياسي بأوجهه المتعددة، وذلك من خلال مختلف آليات القمع والاحتواء، فالوجه الراديكالي للإسلام السياسي الذي تُجسّده الجهادية العالمية يتم التعامل معه بالاستئصال الأمني والتدخل العسكري المباشر، ومن خلال تكوين تحالفات عالمية مع الأنظمة ما بعد الكولونيالية المحلية، والوجه الحزبي المحافظ للإسلام السياسي تُسلَّط عليه المقاربات الإكراهية الأمنية والقانونية.
إن تبدل الظرف الجيوسياسي الدولي اليوم وعودة منظورات التنافس بين الدول، خلق رؤية إمبريالية غربية جديدة، فالإمبريالية بوصفها شكلًا متطورًا من الكولونيالية بلغت ذروة العدوانية تجاه الإسلام والإسلاميين في المنطقة، وهو ما تجلَّى في بناء استراتيجية تقوم على تسليم قيادة المنطقة للمستعمرة الاستيطانية اليهودية، ومحو وإزالة وتصفية القضية الفلسطينية.
فمنذ أنشأت الإمبريالية الغربية دولة «إسرائيل» على أنقاض فلسطين، وهي تقوم بوظيفة حارسة الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المعروف أن الإسلامية بأوجهها المختلفة مناهضة للإمبريالية والصهيونية، فالإسلامية اليوم هي من يقاوم الهجمة الاستعمارية في المنطقة، والتي تقوم أنظمتها من خلال الاستعمار الداخلي للسلطة على ديمومة الهيمنة الإمبريالية وضمان الحفاظ على الصهيونية، ولذلك باتت متطلبات إعادة بناء الشرق الأوسط الذي اهتزت أركانه عقب ثورات «الربيع العربي» التي جاءت بالإسلاميين، تقوم على استراتيجية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتطبيع وجود المستعمرة الاستيطانية «إسرائيل»، بل وترسيخ دورها القيادي المركزي الأمني الحراسي في المنطقة من خلال نسج تحالفات مع الأنظمة العربية الاستبدادية ما بعد الكولونيالية، عبر رعاية اتفاقات السلام «الإبراهيمية» وبناء تحالفات عسكرية مشتركة، وهي استراتيجية غربية طموحة تسعى إلى إدماج المستعمرة الاستيطانية اليهودية في نسيج المنطقة العربية الإسلامية، تحت ذريعة مواجهة خطر مشترك اختُزِلَ في مقولة «الإرهاب» الإسلامي، الذي بات يكافئ مصطلح «الإسلام السياسي» وحركاته المقاومة بنسختَيْها السنية والشيعية، وممثليها في المنطقة من المنظمات السنية المنبثقة عن أيديولوجية الإخوان المسلمين المسندة من تركيا، والحركات السياسية والمقاومة الشيعية المنبثقة عن أيديولوجية ولاية الفقيه المسندة من إيران.
إن الصراع على هوية الدولة والمجتمع في العالم العربي لم تُكتَب نهايته بعد، وقد بلغت الأنظمة الإمبريالية والصهيونية والدكتاتوريات ما بعد الكولونيالية ذروة ترابطها ووقاحتها وعنفها، وذلك يعود إلى سبب بسيط وهو أنها تعيش لحظات شك حول ديمومة هيمنتها وبقاء وجودها. والتيارات الإسلامية اليوم بكافة أصنافها تُعبِّر عن كينونة في المنطقة تُشكِّل بديلًا لا منافس له لتفكيك الاستعمارية.