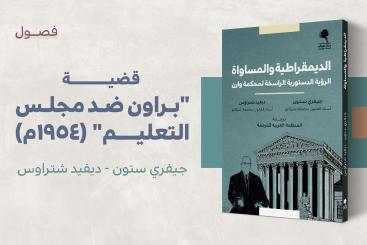أثر مدرسة الحقوق الخديوية (1886-1925م) في تطوير الدراسات الفقهية

جاءت الدراسة المعنيَّة بإخراج أدبيات مدرسة الحقوق الخديوية تحت عنوان: «أثر مدرسة الحقوق الخديوية (1886-1925م) في تطوير الدراسات الفقهية»، وكانت أطروحة نلتُ بها درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة[1].
وكتبت هذه الدراسة تحت رعاية معالي المستشار طارق البشري رحمه الله الذي كتب لها مقدمة راقية، وقد وجَّهني خلال كتابتها كثيرًا من التوجيهات النافعة، كما أن المرحوم الدكتور جمال الدين عطية (ت 2018م) استحسنها وأشاد بها في أكثر من مرة ومناسبة، وأما الدكتور محمد سليم العوا فقد حفزني لإخراجها من الأرشيف المعرفي إلى الحياة العلمية، وذلك لما عرضتُ عليه خطتها المبدئية، ورحم الله الدكتور محمد كمال إمام (ت 2020م) الذي كان متفاعلًا معها تفاعلًا كبيرًا.
وقد ظلَّت هذه الدراسة حبيسة أدراج المكتبة إلى أن نهض بها مركز نهوض للدراسات والبحوث ليخرجها بالطباعة والنشر للحياة العلمية والحقوق المعرفية، فخرجت في طبعتها الأولى عام 2020م مكونةً من (670) صفحة.

وتهدف هذه الدراسة البحثية إلى بيان الجهود العلمية لأعلام مدرسة الحقوق الخديوية وتأثيرهم فيمن جاء بعدهم، لا سيما كتاباتهم المعنيَّة بعلوم الشريعة الإسلامية الغراء، إلى جانب المحاولة الجادة في الكشف عن مَواطن الثراء في الفقه الإسلامي، بالتعريج على بداية ظهور بعض الموضوعات الفقهية الجديدة، التي أضحت ضرورةً عصريةً يقتضيها الواقع التشريعي والاجتماعي المعاصري، كالإشارة إلى بدايات التقنين، ومساراته التي سار فيها، وكذلك التنظير الفقهي ومنهجه، والمقارنات التشريعية ومستوياتها، مع بيان دور المدرسة في هذه الحقول الثلاثة. وتسعى كذلك هذه الأطروحة للخروج بالدراسات الفقهية من الحيز الضيق -المتمثِّل في دراسة مناهج الفقهاء القدامى، أو تخريج الفروع على الأصول لدى إمام من الأئمَّة الأوائل- إلى آفاق أرحب وأوسع تُلبي ضروريات الأمة، وتسدُّ حاجياتها، وتوفر تحسينايتها.
وقد اعتمدتُ في هذه الدراسة على المنهج الوصفي أولًا، وذلك بوصف الفترة التاريخية للمدرسة من الناحية السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. ثم اعتمدتُ أيضًا على المنهج الاستقرائي، وذلك بمطالعة وسبر الإنتاج العلمي لأعلام هذه المدرسة. وأخيرًا، جعلتُ المنهج التحليلي سبيلًا للتحليل الموضوعي للتراث الفقهي للشخصيات؛ لمعرفة مناهجهم العلمية في الدرس الفقهي والأصولي والقانوني، وكان الغرض الأول والأخير من هذا المزج بين المناهج البحثية المختلفة هو الوصول إلى نتيجة علمية مُرضية تفيد البحث العلمي.
تقسيمات الكتاب
وقد جاء هذا الكتاب مكونًا من مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول مدرج بها الكثير من المباحث والمطالب.
فجاء التمهيد بعنوان: أهمية الدراسات الفقهية والقانونية وكيفية تطويرهما، ويشير إلى كيفية تطوير الدراسات الفقهية والقانونية، وذلك من خلال المحاور الرئيسة التالية: إجراء الدراسات المقارنة، والصياغة الفقهية الجديدة، وتفعيل دور المجامع الفقهية، وعقد الندوات والمؤتمرات الفقهية، وتبسيط وتسهيل المادة الفقهية في المدونات الفقهية، وأخيرًا تفعيل دور الكليات والمعاهد الشرعية. وانتهى التمهيد بالإشارة إلى الضوابط المنهجية لقضية التجديد الفقهي.
ثم تبعه الفصل الأول وكان بعنوان: التعريف بمدرسة الحقوق الخديوية وعصرها، واشتمل على تعريفٍ بعصر المدرسة من النواحي السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية. وعرج كذلك على تاريخ نشأة مدرسة الحقوق الخديوية، بالإشارة إلى تاريخ تأسيس المدرسة، والتعريف بعمداء المدرسة، مع بيان الاتجاهات العلمية، والمناهج التعليمية الموجودة خلال عصر المدرسة. ومن الواضح أن هذا الفصل قد اصطبغ بالصبغة الوصفية، لكونه سردًا تاريخيًّا لعصر المدرسة في النواحي المشار إليها آنفًا.
فيما جاء الفصل الثاني تحت عنوان: التعريف بأعلام مدرسة الحقوق الخديوية، وقد بدأ ببيان حالة الفقه الإسلامي خلال عصر المدرسة، ثم ألقى الضوء على التراجم العلمية لأبرز أعلام هذه المدرسة، متوخيًا الترتيب الزمني لهؤلاء الأعلام، فعرَّف بالشيخ محمد سلامة بك السنجلفي (1276-1347هـ/1859-1928م)، من خلال الإشارة إلى حياته العلمية، وكتاباته ومؤلفاته، ومنهجه في الدرس الفقهي. ثم عرض لترجمة الشيخ محمد زيد الإبياني (1862-1936م)، ورحلته العلمية ومؤلفاته وألقابه، ومنهجه في الدرس الفقهي. وكان ثالث هؤلاء الأعلام الشيخ أحمد أبو الفتح (1283-1365هـ/1866-1946م)، الذي عرض لترجمته، ورحلته العلمية، ومنهجه في الدرس الفقهي. كما أشار هذا الفصل إلى الترجمة العلمية للشيخ أحمد إبراهيم (1291-1364هـ/1874-1945م)، بالنظر في ترجمته، وبحوثه ومؤلفاته، ومنهجه في الدرس الفقهي. وكان ختام هذا الفصل بالعلامة الدكتور عبد الرزاق السنهوري (1895-1971م)، فتعرض لبيان ترجمته، ومنهجه في تجديد الفقه الإسلامي.
ويُعَدُّ هذا الفصل -على الحقيقة- خريطةً توضيحيةً للأُطر التي ستسير عليها الدراسة فيما تبقى من فصول، حيث إنه حدَّد أبرز الأعلام الذين برزوا في الجوانب الفقهية والتشريعية والقانونية، وأسَّسوا للصحوة والثورة التشريعية اللاحقة.
وأما الفصل الثالث فجاء بعنوان: جهود أعلام مدرسة الحقوق الخديوية في المقارنات التشريعية، واعتنى ببيان تعريف المقارنات التشريعية وتاريخ نشأتها وأهدافها، وركَّز على توضيح دور المدرسة في تطوير المقارنات التشريعية، وذلك من خلال التعريج على جهود الأعلام: قدري باشا (1821-1886م)، وأحمد أبو الفتح، وأحمد إبراهيم، والسنهوري. وألقى هذا الفصل أيضًا الضوء على جهود عمداء المدرسة الأجانب في المقارنات التشريعية، وذلك بالإشارة إلى جهود كلٍّ من لامبير (Lambert)، ووالتون (Walton)، وإيموس (Amos)، وجودبي (Goodby). وختم هذا الفصل بتوضيح أثر المقارنات التشريعية في تطوير الدراسات الفقهية، وذلك عن طريق توليد بعض المصطلحات الفقهية، وبناء النظريات الفقهية، وتيسير التقنين الفقهي، وتكوين المَلَكَة الفقهية، والتقريب بين النُّظُم القانونية.
وجاء الفصل الرابع بعنوان: دور أعلام مدرسة الحقوق الخديوية في التنظير الفقهي، وبدأ ببيان تعريف التنظير الفقهي، وأهميته، ودوافعه، وتاريخ نشأة النظريات الفقهية، وأهم موضوعاته، وركَّز بعد ذلك على دور أعلام المدرسة في مجال التنظير الفقهي، بالتعريج على جهود كلٍّ من الشيخ أحمد إبراهيم والسنهوري في مجال التنظير الفقهي. ومال هذا الفصل إلى بيان جهود تلامذة أعلام المدرسة في التنظير الفقهي، وذلك بالإشارة إلى جهود الشيخ عبد الوهاب خلاف (1305-1375هـ/1888-1956م)، والشيخ علي الخفيف (1891م-1978م)، والشيخ محمد أبو زهرة (1316-1394هـ/1898-1974م). وخُتم هذا الفصل بتوضيح أثر التنظير الفقهي في تطوير الدراسات الفقهية، من خلال التجديد في أسلوب التأليف، وعقد الموازنات بين النُّظُم التشريعية، وتربية المَلَكَة الفقهية، وتسهيل دراسة الفقه، وتيسير الاجتهاد.
ثم جاء الفصل الخامس والأخير بعنوان: جهود مدرسة الحقوق الخديوية في تقنين الفقه الإسلامي، وقد عرج على تعريف تقنين الفقه وتاريخه، ثم وضَّح دور أعلام المدرسة في التقنين الفقهي، بالإشارة إلى شروح تقنينات العلامة قدري باشا، وجهود أساتذة المدرسة في لجان تقنين الأحوال الشخصية، وجهود عبد الرزاق السنهوري في تقنين الفقه الإسلامي. وخُتم الفصل ببيان أثر التقنين في تطوير الدراسات الفقهية، وقد تمثَّل في حُسن ترتيب المادة الفقهية، وتيسير عقد المقارنات بين الشريعة والقانون، وتيسير حركة التنظير الفقهي.
الأفكار الرئيسة للكتاب
تدور المحاور الأساسية لهذه الدراسة حول مجموعة من الأفكار والمبادئ التي يمكن استظهارها، فالفكرة التي تؤصل لها هذه الدراسة -بدايةً- هي الكشف عن الطبيعة النمطية التقليدية للدراسة قبل إنشاء هذه المدرسة، حيث إن المناهج والكتابة الدراسية المقررة في المدارس العلمية آنذاك كانت تقوم بالأساس على الحفظ والتلقين، وهذه المنهجية في التلقي هي التي خرجت عن إطارها المدرسة بمناهجها، ومن يومها إلى الآن والسجال بين أنصار المعسكرين -أعني التقليدي المحافظ والإصلاحي التجديدي- دائرٌ لا تنتهي صولاته وجولاته.
ولا أبالغ إن قلتُ إن المنهجية الجديدة التي أرستها المنهجية العلمية للمدرسة إلى جانب الحقوق المعرفية التي أضافتها للخطط الدراسية قد بعثتْ -من وجهة نظري- الحيوية والنشاط في كتب التراث الفقهية المطمورة، التي كادت تُهجر من قِبَل المشتغلين بالتشريع والقضاء.
كما أن الدراسة ركَّزت على التحولات الجوهرية في العملية التعليمية التي أحدثتها مدرسة الحقوق الخديوية بالإشارة إلى ثلاثة حقول معرفية أُضيفت للمناهج الدراسية في تلك الفترة، وهي: المقارنات التشريعية، والتنظير الفقهي، والتقنينات، وقد عالجت الدراسة كل فكرة منها بالوصف والتحليل في فصل مستقل.
كان لمقارنة الشيخ مخلوف المنياوي التي أجراها بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي، أثرٌ كبيرٌ في دفع فكرة المقارنات إلى الأمام.
فالحقل المعرفي الأول الذي اعتنت به المدرسة، وقد ركزتُ على إبرازه، هو فكرة المقارنات التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار أن منهج المقارنة لم يكن يومًا من الأيام غريبًا عن بيئة الدراسات الفقهية، وإنما كان منهجًا أصيلًا وثابتًا في تراثنا على وجه العموم، والتراث الفقهي على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور محمد أحمد سراج: «كثف الباحثون المسلمون جهودهم على مرِّ العصور في دراسة الفقه الإسلامي، بحكم عالمية هذا الفقه، ونجحوا إلى حدٍّ كبيرٍ في ريادة التفكير القانوني العالمي فترة طويلة من الزمن، وذلك حتى نهاية القرن السادس عشر في تقدير المستشرق الإنجليزي شاخت». وقد كان لمقارنة الشيخ مخلوف المنياوي التي أجراها بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي، أثرٌ كبيرٌ في دفع فكرة المقارنات إلى الأمام.
لذا سعت المدرسة إلى تأسيس وإرساء المنهجية المقارنة لإجراء العديد من المقارنات التشريعية بمستوياتها المختلفة. وفي الوقت التي كانت دائرة المقارنات منغلقة على الفقه الإسلامي بمذاهبه، بدأت المدرسة تلفت الانتباه إلى مستويات أرقى من المقارنة، وهي المقارنة بين نظامَيْن تشريعيَّيْن أو أكثر بضوابط منهجية محدَّدة ومعروفة في كتب الأشباه والنظائر. وقد كان لمقارنة الشيخ مخلوف المنياوي (1235-1295هـ/1878م) التي أجراها بين الفقه المالكي والقانون الفرنسي، والتي بعنوان: «المقارنات التشريعية: تطبيق القانون المدني والجنائي على مذهب الإمام مالك»- أثرٌ كبيرٌ في دفع فكرة المقارنات إلى الأمام، ما حدا بالوزير الهمام محمد قدري باشا إلى إجراء مقارناتٍ بين الفقه الحنفي والقانون المدني المصري القديم، وجاءت بعنوان: «بيان المسائل الشرعية التي وُجدت في القانون المدني مناسبة وموافقة لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»[2]، وكذلك كتاب محمد حافظ صبري المسمَّى بـ«المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى»، وقد طُبع بعناية المرحوم الدكتور محمد كمال إمام وإشراف مركز نهوض للدراسات والبحوث، ثم جاءت دراسة الأستاذ سيد عبد الله حسين (ولد 1309هـ/1889م) بعنوان: «المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي: مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس»، وقد طُبعت بتحقيق وعناية الدكتور محمد أحمد سراج والدكتور علي جمعة. ثم حمل الراية معهم أعلام كثيرون على رأسهم العلامة السنهوري، والشيخ أحمد إبراهيم، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، وعلي الخفيف.
وهذه الطريقة الجديدة في التدريس حفزت أعلام المدرسة -كالشيخ أحمد أبو الفتح وأحمد إبراهيم- إلى تبنِّي هذه المنهجية في كتاباتهم وتدريسهم، وهي طريقة لم تكن معهودةً في التحصيل قبل ظهور المدرسة، ما جعل المنهجية تنتقل إلى كليات الحقوق والشريعة فيما بعد. وأما الحقل المعرفي الثاني الذي اهتمَّت به المدرسة، فقد تمثَّل في تأصيلها لفكرة التنظير الفقهي، الذي يعني جمع شتات الموضوع الفقهي الواحد في باب واحد مرتبًا ومنسقًا بطريقة تُسهل على الدراسين تحصيله دون عناء أو تكلُّف. مع العلم أن تراثنا الفقهي لم يَعرف كلمة النظرية بوصفها مصطلحًا متداولًا، وإن وُجِد مضمونها، أما ما عُرف من كتب تراثية تحمل اسمَ النظرية مثل كتاب «نظرية العقد» لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من تصرُّف الناشر من باب التسويق غالبًا، لكنها لم تُعْرَف وتتداول إلَّا في العصر الحديث، عصر النظريات عمومًا، والنظريات القانونية على وجه الخصوص.
وقد تزامن هذا مع حرصِ عددٍ من الفقهاء المعاصرين على تجديد الفقه وتطويرِه، لينبعثَ من جديد قائمًا بمهمَّته في نهضة الأُمَّة ووحدتها وتفرُّدها، حيث رأوا أن الفقه قد تخلَّى عن دَوْرِه في مواطِنَ كثيرة حلَّ محله القانون الوضعي فيها، ولعلَّ أهمَّ الأسباب في نظرهم عدم مجاراة الفقه للواقع، فلا بدَّ من تجديد الدراسة والبحث الفقهي بإنشاء أو استخراج النظريات الفقهية.
وقد كان لأعلام مدرسة الحقوق الخديوية لمَّا تطرقوا لفكرة التنظير الفقهي دوافعُ حفزتهم على الكتابة بهذه الطريقة الجديدة المبتكرة. وبتتبُّع الأحوال والنظر في الملابسات في تلك الفترة، يمكن إرجاع الدوافع التي أدت إلى ظهور التنظير الفقهي إلى:
1- دوافع عقائدية: حدت بطائفة من فقهاء المدرسة إلى الكتابة في النظريات الفقهية بقصد البرهنة على ثراء الفقه الإسلامي وغناه وحيويته، وكان ذلك من قبيل إقامة الحجَّة على المناوئين للشريعة والمعادين لمرجعيتها ممَّن ينتقصون قدرها، ويغضون من شأنها، ويزعمون أنها غير صالحة لاستمداد التشريعات المعاصرة منها.
2- دوافع تعليمية: جعلت لزامًا على أعلام المدرسة تغيير طريقة الكتابة التقليدية لمجاراة المنهجية الغربية في تناول الموضوعات القانونية، وهذا يظهر من كلام الشيخ أحمد إبراهيم لمَّا بدأ تدريس مادة الفقه في كلية الحقوق، حيث رأى لزامًا عليه أن يجعل المادة الفقهية المدفونة في بطون الكتب والمدونات والمطولات الفقهية سهلةً وميسرةً في متناول الدارسين للشريعة والقانون.
يقول الشيخ أحمد إبراهيم وهو يشير إلى الدافع إلى الكتابة على هذا النسق: «وبذا تقف الشريعة الصحيحة المحررة أمام القانون المُدل بجدته وتحريره إلى حد بعيد جدًّا وجهًا لوجه، كل يعرض ما احتواه من الآراء والنظريات والقضايا الأساسية التي هي مبنى الأحكام التفصيلية، وقد يتراءى بعد ذلك أنهما متقاربان لا يكاد يكون بينهما فرق من وجهة النظر التشريعية المراعى فيها من الطرفين جميعًا جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد يكون في الكنوز الثمينة النفيسة التي خلفها لنا سلفنا الصالح من فقهاء الشريعة الإسلامية ما يصلح -بحقٍّ- أن يكون مورد تغذية كافية هنيئة مريئة للقوانين الوضعية فتنميها وتصلح من شأنها»[3].
3- دوافع سياسية: حيث استطاعت القوى المحتلة فرض سيطرتها ونفوذها على البلاد التي احتلتها، وقد وقعت مصر فريسةً للاحتلال الفرنسي من بدايات القرن التاسع عشر، وبعد خروج الاحتلال الفرنسي وقعت تحت وطأة الاحتلال البريطاني الذي بدأ في عام 1882م، وكان لهذا الاحتلال المتعاقب على البلاد أثره السيئ في استجلاب التشريعات الأجنبية، وتعمّد تنحية الشريعة الإسلامية من شتَّى مجالات الحياة.
ولما وصلت الأمور لهذه الحالة من التردي والهوان، انبرى الأساتذة المتخصِّصون في دارسة الشريعة والقانون ليواجهوا هذا الغزو التشريعي الزاحف عليهم، بإعادة صياغة المادة الفقهية وَفْقَ الأُطر القانونية الحديثة، التي أملتها عليهم ظروف المرحلة دون الإخلال بمضمونها الفقهي. وتأسيسًا على هذا، فقد نفرت فرقة من الفقهاء -منهم بل على رأسهم الشيخ أحمد إبراهيم- للنظر في النظريات القانونية الوافدة، والفقه الإسلامي لاستخراج ما يقابل هذه النظريات من الفقه الإسلامي، ليجعلوا من الفقه الإسلامي منظومةً تشريعيةً متكاملةً تفوق المنظومات القانونية العالمية الحديثة، التي يتشدَّق بسموِّها أنصار العلمنة والتغريب.
إن الظهور الحقيقي لفكرة التقنين بدأ مع الشروع في تأليف مجلة «الأحكام العدلية».
وأما الحقل المعرفي الثالث الذي ركَّزت عليه الدراسة، فهو التقنينات التشريعية، وذلك بالتأريخ لها، وإظهار جهود علماء المدرسة في هذا السياق. وفي بيان تاريخ فكرة التقنين يرى الدكتور محمد مصطفى شلبي أن كل ما كان من محاولات عبد الله بن المقفع (106-142هـ) وأبي جعفر المنصور (ت 158هـ)، بغرض جمع القضاء والفتيا على مذهب واحد أو رأي واحد، ليس من قبيل التقنين في شيء، فيقول بهذا الخصوص: «لم يعرف الفقه الإسلامي طريقة التقنين بالفعل إلَّا في هذا الوقت، وما وُجِد قبل ذلك كان مجرَّد محاولة أو اقتراح جمع الناس على رأي واحد، يُقضى به بين الناس دون تقيُّد بمذهب معيَّن، وإنما يتبع قوة الدليل وملاءمة أحوال الناس، ويلزم به القضاء في أنحاء الدولة الإسلامية»[4]. وتأسيسًا على هذا، فإن الظهور الحقيقي لفكرة التقنين بدأ مع الشروع في تأليف مجلة «الأحكام العدلية»[5] التي صدرت بين عامي (1285-1293هـ/1869-1876م). ثم توالت مشروعات القوانين المستمدَّة من الشريعة، التي قام عليها أفراد، وإن لم يصدر بتطبيقها قرارات رسمية، كالتقنينات الثلاثة التي وضعها العلامة محمد قدري باشا[6]، وكتقنين مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية للقاضي أحمد بن عبد الله القاري، وظهرت بعدها تقنينات العائلة العثمانية (1917م)، وتقنينات الأحوال الشخصية المصرية (1920م) و(1929م) و(1936م)، وهي التي شارك فيها عدد من أعلام المدرسة.
وقد أدى أساتذة الشريعة بمدرسة الحقوق الخديوية دورًا فاعلًا وإيجابيًّا وحيويًّا في لجان الأحوال الشخصية، وكان لهم وجود بالأفكار والرؤى التي ساعدت على صياغة هذه التقنينات، والتي انتقلت بعد ذلك إلى سائر البلاد العربية والإسلامية، فالشيخ محمد زيد الإبياني، والشيخ أحمد إبراهيم، والشيخ محمد سلامة بك، كانوا أعضاء بارزين في لجان الأحوال الشخصية بداية من عام 1914م حتى عام 1945م وما بعدها. وأما العلامة السنهوري، فهو فارس هذا المضمار بلا منازع، حتى عُرف بأبي القوانين، وعنه يقول تلميذه الدكتور محمد زكي عبد البر: «ولا بدَّ لنا ونحن نكتب عن التقنين أن نذكر -إقرارًا بالحق والفضل لذويه- أستاذنا الجليل المغفور له الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، فهو الذي -في جِيلنا- وجَّه إليه وبيَّنه ونفذه في مصر والعراق وسوريا وليبيا والكويت، ونحن نترسم خطاه ونبني في الفقه الإسلامي على أسسه في القانون، مراعين طبيعة الفقه الإسلامي واستقلاله، وما تقتضيه هذه الطبيعة وذلك الاستقلال من تغيير أو حذف أو إضافة»[7].
ومما سبق يمكن القول بأن الكتاب ركَّز على محاور أربعة، هي: تغيير الطريقة النمطية التقليدية في دراسة الفقه الإسلامي، ومعالجة فكرة المقارنات التشريعية من جوانبها كافَّة، والتنبيه على التنظير الفقهي وبداية ظهوره وأهميته، ثم كانت الخاتمة بالإشارة إلى فكرة التقنين والتأريخ لها ودور أعلام المدرسة في ذلك.
استدراك على الكتاب
أشرتُ في بداية المقال إلى أني لقيت عددًا كبيرًا من فقهاء الشريعة والقانون، وكانت لهم وجهات نظرٍ متقاربة، وقد أضافت هذه اللقاءات إضافاتٍ ضافيةً لهذه الدراسة، وكان من بين القضايا التي لم تبرز بالشكل الكافي: العناية بدور المدرسة في تحفيز الاجتهاد الفقهي والعناية به، مع العلم بأن المدرسة كانت من المؤسسات التي تبرهن على أن الفقه الإسلامي لم يجمد يومًا ما، بل كان دائمًا أبدًا حيًّا وموجودًا على الساحة على الرغم من التربُّص به ومحاولة إزاحته من الساحة التشريعية.
كما أن الكتاب غاب عنه الإشارة إلى دور المدرسة بأعلامها في تقديم النظام المالي الإسلامي إلى الساحة العلمية في ثوب جديد، من خلال الدراسات والأبحاث التي أجراها أعلام المجال في هذا المضمار، وقد لفت انتباهي لهذه الجزئية المرحوم الدكتور حسين حامد حسان (ت 2020م).
وأما الجزئية الأخيرة التي أرى أنها كانت من المحسنات التي تجوّد هذه الدراسة غير أن القيد الزمني منع من الخوض في غمارها، فهي الجهود اللاحقة على المدرسة من تلاميذ أعلام المدرسة. ولعل هذه الاستدراكات على الكتاب تُتَدارك في الطبعة القادمة إن شاء الله.
الهوامش
[1] كاتبها من أبناء الأزهر الشريف، حيث تلقى تعليمه الأزهري إلى أن حصل على درجة الليسانس في اللغات والترجمة، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الرابع على دفعته، ثم التحق بعدها بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، فحصل على دبلوم الدراسات الإسلامية الخاصة بتقدير عام ممتاز، وسجَّل بعدها هذه الدراسة التي كانت من بنات أفكار أستاذنا الدكتور محمد أحمد سراج، الذي أشرف عليها منذ خطوطها الأوَّليَّة حتى خروجها في هذا الثوب العلمي التي بدت عليه، وهو حاليًّا ملتحق بكلية الحقوق.
[2] وهي موجودة في صورة مخطوطتَيْن بدار الكتب المصرية تحملان العنوان نفسه، فالمخطوطة الأولى رقم (80) قوانين، وتقع في مائة وأربع عشرة ورقة من وجهين، والثانية برقم (9914)، وتقع في مائة واثنتين وثلاثين ورقة، وقد قام بدراستها الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج والأستاذ الدكتور علي جمعة، وهي في طور الطباعة بمكتبة دار السلام بالقاهرة.
[3] بحث عن «العقود والشروط والخيارات»، للشيخ أحمد إبراهيم، ص641.
[4] محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي: تعريفه وتاريخه ومذاهبه، ونظرية الملكية والعقد، بيروت: الدار الجامعية، الطبعة العاشرة (1405هـ/1985م)، ص158.
[5] تكونت لجنة المجلة من سبعة من العلماء برئاسة أحمد جودت باشا، ناظر ديوان الأحكام العدلية، وكان أعضاؤها في البدء السادة: أحمد خلوصي، وأحمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية، ومحمد أمين الجندي، وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة، والسيد خليل مفتش الأوقاف، والشيخ محمد علاء الدين بن عابدين، ولكن تشكيل هذه اللجنة تغير في أثناء مدة عملها، فاستُبدل بعض أعضائها وزيد عليها أعضاء آخرون. انظر: صبحي محمصاني، فلسفة التشريع في الإسلام، بيروت: مكتبة الكشاف ومطبعتها (1365هـ/1946م)، ص71؛ محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، بيروت: دار النفائس، الطبعة الثانية عشرة (1433هـ/2012م)، ص553-554.
[6] مشروعات قدري باشا في التقنين:
مرشد الحيران إلى معرفة حقوق الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان: تضمَّن الكتاب سبعة وسبعين فصلًا، وثمانية وعشرين كتابًا، وألفًا وخمسًا وأربعين مادة (1045).
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان: يتناول هذا التقنين مجال الأسرة أو ما يُعرف حديثًا بالأحوال الشخصية، وقد جاء هذا التقنين في سبع وأربعين وستمائة مادة (647).
قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف: جاء هذا الكتاب في سبعة أبواب، اشتملت على عددٍ من الفصول التي ضمَّت ستًا وأربعين وستمائة (646) مادة، مع الأخذ في الاعتبار أن قدري باشا لم يُسبق إلى تقنين أحكام الأوقاف، مما يؤكد أن هذا التقنين كان له أثر كبير في الصياغات القانونية لنظام الوقف، التي توالى صدورها في البلاد العربية والإسلامية في القرن العشرين.
ومن هذا يمكن القول إن تقنينات العلامة قدري باشا كانت فتحًا عظيمًا على دارسي الشريعة طلابًا وأساتذةً في مطلع القرن الماضي، وبهذه التقنينات استحقَّ لقب الفاتح الأول، كما لقَّبه الشيخ أحمد إبراهيم.
[7] محمد زكي عبد البر، تقنين الفقه الإسلامي، ص15.