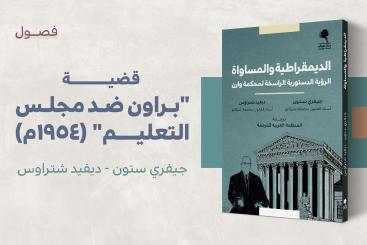في أصول النظام القانوني الإسلامي

يمثِّل هذا الكتاب عصارة أفكار أستاذنا الدكتور محمد أحمد سراج، الذي نشأ وترعرع في الأزهر الشريف إلى أن أتمَّ به المرحلة الثانوية، وهو ما كان له أثره الفاعل في التأثير في تكوينه العلمي وبنائه الفقهي، ثم انتقل بعدها إلى رحاب كلية دار العلوم، التي ظلَّ بها إلى وقتنا هذا إلى جانب تدريسه حاليًّا للدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وهذا الكتاب كان تطورًا طبيعيًّا لفكر أستاذنا الذي بدأ الفكرة بتأليف كتابٍ تقليديّ دراسيّ في أصول الفقه لطلاب كلية الحقوق منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، ليفكِّر صاحبه فيما بعد تفكيرًا طويلًا وعميقًا في كيفية تقديم النظام الأصولي في ثوبٍ جديدٍ يخرج به عن الإطار التقليدي للكتب الدراسية، ويقدِّم فيه المساقات المعرفية التي يتوقع أن تُحدث تزاوجًا بين الجانب النظري الدراسي والجانب العملي التطبيقي.

على أن هذا العمل لم يكن ميسورًا أو سهلًا، لدرجة أن بعض الأفكار والموضوعات قد أعاد أستاذنا كتابتها أكثر من مرة، بسبب وضعها الشائك وطبيعتها القلقة، وسعى في هذا التناول الجديد إلى لفت الانتباه إلى ضرورة رعاية المبادئ والآليات التي يمكن توظيفها في النظام الأصولي، لكونها تساعد على الفهم المنضبط للأدلة وكيفية استثمارها استثمارًا صحيحًا في استنباط الأحكام.
ولعل من أبرز ما يؤكِّد عليه أستاذنا في هذه الدراسة أنه يتحدَّث عن أصول نظام قانوني منطقي، يسعى إلى تحقيق نوعٍ من المواءمات الاجتماعية بين النصوص أو التشريعات المنزلة والواقع الاجتماعي، ولم يكن الهدف فيه سوى بيان الأوجه والطرق الكفيلة بتحقيق هذه المواءمات، من مثل المصلحة والعرف والاستحسان والاستصحاب وغيرها.
تقسيمات الكتاب
جاء هذا الكتاب في ثمانمائة واثنتين وستين (862) صفحة، مقسمًا إلى خمسة أقسام رئيسة، جاءت على النحو التالي:
تناول في القسم الأول مقدمات في علم الأصول، بالتعريج على الإطار المنهجي، وتاريخ أصول الفقه، وأهم المؤلفات فيه، وتمثِّل هذه المقدمة خريطةً كاشفةً لخطة العمل المتبعة على طول الدراسة.
واحتوى القسم الثاني من الكتاب على نظرية الحكم الشرعي، التي اشتملت على مقدمات في الحكم الشرعي، كتعريفه، وبيان علاقته بالأحكام التشريعية والقضائية والإفتاء، وعرج على المحكوم به، وأنواعه ومصدره ومتعلقه، منبهًا على مدى استيعاب معايير الأحكام الأصولية للتصرفات القانونية.
وساق أستاذنا القسم الثالث تحت عنوان: الأدلة النصية وغير النصية، ليبدأه بتمهيد حول نظرية المصادر الأصولية، ثم أدرج فيه فصلين، الأول منهما جعله بعنوان: الأدلة النصية، ذكر تحته ثلاثة مصادر، الأول: القرآن الكريم، وقد نبَّه في هذا المصدر على ضرورة تناول القرآن في تشريعات البلاد الإسلامية الحديثة، وطبيعة التشريعات القرآنية، وفكرة القصص القرآني والتشريع، وأسلوب القرآن في مواجهة الأوضاع الاجتماعية السائدة، وكيف أن المفاهيم التشريعية القرآنية مبنيَّة على العدالة. وأما المصدر الثاني فعرض فيه للسُّنة النبوية من حيثُ حجيتُها في الدلالة على الأحكام وأنواعها، وختم هذا الفصل بالحديث عن الإجماع بوصفه مصدرًا نقليًّا ثالثًا، وعرض أنواعه وصوره التي يمكن أن يتحقَّق من خلالها في العصر الحديث. وعقد الفصل الثاني للأدلة غير النصية، وساق تحته تسعة مصادر، بدأها بالتعرض للاستدلال، فعرَّفه، ثم عرج على الاستدلال القانوني (Legal Reasoning)، وجعل القياس مصدرًا ثانيًا، عرض فيه لتعريفه وحجيته وأركانه وأنواعه وأحكامه، وشروط العلة، والمناسبة بين العلة والحكم، وختمه بالحديث عن القياس في القانون المدني. وذكر في المصدر الثالث المصلحـة، فتناول فيها فكرة تطور النظر إلى المصلحة، والمصلحة ومقاصد الشريعة، والسياسة الشرعية، وعرض للاستحسان بوصفه مصدرًا رابعًا، ووضع العرف في المصدر الخامس، وأرَّخ له تأريخًا أظهر فيه دور الشيخ عبد الوهاب خلاف في وضعه ضمن مصادر الاجتهاد، وجعل العمل والسوابق القضائية المصدر السادس كإضافة جديدة في هذا الباب، وأما المصدر السابع فكان التشريع، ليعرج فيه على أصل التشريع المتمثل في التقنين، وقد أشار إلى أبرز التقنينات الشرعية، ونبَّه على الشروط التي يلزم توافرها في التشريع، وتعرَّض لسدِّ الذرائع والاستصحاب في المصدرين الثامن والتاسع.
وجاء القسم الرابع بعنوان: تفسير النصوص ودلالات الألفاظ، مشتملًا على أربعة فصول، جعل الأول منهما لمقدمات عامَّة، ذكر فيها منهجية التناول، التي عرج فيها على تعريف التفسير والتأويل، وأنواع التفسير ومذاهبه، وعرض لقواعد التفسير العامة، وتفسير النصوص القانونية في ضوء قواعد التفسير الأصولية، وإجمال قواعد التفسير لدى محكمة النقض المصرية. وأما الفصل الثاني فكان عنوانه: وضوح الدلالات وخفاؤها ومراتبها، وأدرج فيه خفي الدلالة، والواضح الدلالة، وأنواع الدلالات وأوجه دلالة اللفظ على المعنى. وعقد الفصل الثالث للتفسير اللغوي، وذلك بالتعريج على الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والأمر والنهي، والمشترك. وختم هذا القسم بالفصل الرابع الذي جعله للتفسير المقاصدي والقانوني، فعرض فيه للتفسير المقاصدي أولًا بالتنبيه على أنه لا تقصيد إلَّا بدليل، وكشف عن قواعد التفسير المقاصدية، وطرق الكشف عنها، والمنهج المقاصدي والعمل القضائي، ثم عرض للتفسير القانوني للنصوص الجنائية والمدنية بذكر بعض القواعد مع تفسيرها.
وختم الكتاب بالقسم الخامس وجعله تحت عنوان: الاجتهاد والتقليد، وذلك في فصلين، الأول منهما جعله للاجتهاد، وتناول فيه تعريف الاجتهاد ومراتبه، وعرض فيه للاجتهاد الإفتائي والقضائي، ونوَّه ببعض الممارسات الاجتهادية في المراحل التاريخية الأولى من عمر هذه الأُمَّة، وشدَّد على عدم صحَّة الفكرة القائلة بأن باب الاجتهاد قد أُغلق مدَّة من الزمان ثم فُتح، ثم أشار سريعًا إلى الاجتهاد في العصر الحديث، ومجالاته ومبادئه وأنماطه، ومؤسسات الاجتهاد الجماعي. وختم هذا القسم بالفصل الثاني الذي عقده عن التقليد، فعرض لتعريفه وحكمه، ومسألة التمذهب بمذهب معيَّن، وعرج بعد ذلك على وظائف التقليد.
المنهجية العلمية للكتاب

د. محمد أحمد سراج
أعلن أستاذنا في مقدمته الرصينة الخطوطَ العريضة للمنهجية التي يتوخَّى السير عليها، حيث نصَّ على أن المنهج الذي اعتمد عليه يتَّسم على نحو بالغ الإيجاز بالشمول والتحليل للسياقات التاريخية، والنظر للسياقات القانونية المعاصرة، والعمل على تجديد مباحث علم أصول الفقه كي يؤدي دوره في خدمة العدالة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
الأفكار الرئيسة
يتمثَّل الهدف الأبرز لهذا الكتاب في البرهنة على أن علم أصول الفقه -شأنه شأن غيره من العلوم- قد خضع للتطور والنمو، وتفاعل في المباحث التي ضمَّها مع التطور المعرفي والمنطقي والكلامي واللغوي والفقهي الذي عاشته الأمة الإسلامية.
وبناءً عليه، فإن الواجب على الباحث في أصول النظام القانوني الإسلامي أن يمدَّ بصره إلى اكتشاف آليات تحديد الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق في العمل القضائي والتشريعي الموازي للنظر الفقهي في الأعم الأغلب، وإن كان من الوارد أن يختلف العمل عن النظر قليلًا أو كثيرًا، لاعتبارات المصلحة والعدالة، طبقًا لما تفيده الدراسات المتعلِّقة بالتشريعات التي أصدرتها الدول الإسلامية المتعاقبة، وكذا تلك المتعلِّقة بأحكام القضاة، مما جرى الاهتمام به في العقود القليلة الأخيرة.
والافتراض الأعم الذي تبدأ منه هذه الدراسة هو أن الصياغة المعاصرة لأصول النظام القانوني الإسلامي يجب أن تستمدَّ مشروعية الإقدام عليها من وظيفتها العملية المتمثلة في تحقيق المبادئ والمقاصد القرآنية الداعية إلى العدالة في ثمانية وعشرين (28) موضعًا، ومنع الظلم بلفظه ومشتقَّاته في مئتين وثمانية وثمانين (288) موضعًا، وما إلى ذلك مما أكَّدته السُّنة النبوية وطبَّقه الفقهاء في اجتهاداتهم، ويلزم -بعبارة أخرى- أن تعكس هذه الصياغة الرغبةَ الكامنة لدى الشعوب العربية والإسلامية في تطوير أوضاعها التشريعية والقانونية مما هي عليه الآن إلى ما ترجوه هذه الشعوب وَفْقَ رؤيتها الخاصة للكون والحياة.
وقد تناول الكتاب المحاور البارزة في علم الأصول أولًا، كنظرية الحكم الشرعي وما يندرج تحتها من أبواب ومسائل جمعها كلها في سياق واحد، ثم بدأ يربط بينها وبين الواقع القانوني والقضائي المعاصر بالآليات والطرق التي تحقِّق هذا، ولعل الإضافة الجديدة لهذه الجزئيات والمباحث هي محاولة الربط بين النظام الأصولي الإسلامي والنُّظُم القانونية المعاصرة.
واعتنى الكتاب بالأدلة عنايةً فائقةً، حيث قسمها لأدلة نصية نقلية، وأخرى أدلة اجتهادية عقلية، وكانت الطريقة التي عرض بها للأدلة النصية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية والإجماع طريقةً جديدةً، حيث استغنى عن بعض المسائل التي تُعَدُّ حشوًا في باب الدراسة الأصولية، كالتعرض للقراءات القرآنية والأحرف السبعة وغيرها من الفروع التي يصلح أن يكون محلها مباحث علوم القرآن، وأدرج بعض الموضوعات التي أحسن توظيفها في هذا السياق، كفكرة التشريعات القرآنية، واستخراج التشريع من القصص القرآني، والسُّنة التشريعية، وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاول جاهدًا توظيف الإجماع للإفادة منه في الجوانب العملية في الوقت الحاضر.
وعرض في سلسلة مترابطة الأفكار ومتماسكة المبادئ لعددٍ وفيرٍ من المصادر الاجتهادية العقلية التي اجتهد في التأريخ لها أولًا، ثم بيان تأثيرها في الواقع القانوني والقضائي، وكشف عن بعض المصادر التي ذاع صيتها في الحقول المعرفية القانونية مع أن لها نظائرَ وأمثالًا في الفقه الإسلامي، وهذا يتجلَّى في وضعه للسوابق القضائية -في سابقة هي الأولى من نوعها- ضمن المصادر التي يمكن الاستعانة بها في التشريع الإسلامي بالرجوع لفتاوى الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- وأقضياتهم، بنفس الطريقة والكيفية التي تُطبَّق بها في النظام القانوني.
لعل في التفسير المقاصدي ما يعين على إيجاد آلية عملية لتطوير البحث في المقاصد، والانتقال بها من الزهو النظري إلى التطبيق العملي.
وتبدو الطريقة السلسة الانسيابية التي رُتبت بها مباحث الكتاب واضحةً للعيان، حيث بدأ بعد بيان الحدود المعرفية لنظرية المصادر الأصولية في وضع الإطار المنهجي لفهم النصوص الشرعية والقانونية على حدٍّ سواء، وكشفت هذه الدراسة عن الأساليب التي يحسن اتباعها في تفسير النصوص، فعرجت على المنهجية المتبعة في فهم النصوص الشرعية، وحاولت بالطريقة نفسِها التعاطي مع النصوص القانونية، وبرهنت على هذا بسوق عددٍ من القواعد التفسيرية المتبعة في المجالات المدنية والجنائية وغيرها، ويُعَدُّ هذا الفصل محاولةً لتوسيع مدى القواعد الأصولية في الاستجابة لعمل القضاة المعاصرين، ورصدًا لما تضمَّنته القوانين العربية المعاصرة من هذه القواعد. ولعل في التفسير المقاصدي الذي أطلنا في الإشارة إليه بعض الشيء ما يعين على إيجاد آلية عملية لتطوير البحث في المقاصد، والانتقال بها من الزهو النظري إلى التطبيق العملي.
وكانت الخاتم مع بيان آليات التطوير ووسائله المتبعة والمرجوة، فتحدَّث عن الاجتهاد على اعتبار أنه من بين تلك الوسائل والآليات المتوقع استخدامها في تطوير هذا النظام، وقد ركَّز فيه على خطأ الدعوى القائلة بأن باب الاجتهاد قد أُغلق وانسدَّ، وأن الفقه الإسلامي مرَّ بحالة جمود وتدهور وانكماش حسب التقسيم التقليدي المتبع في أغلب المداخل الفقهية المقررة على طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق، ولعل الدراسة نوَّهت بسجلات المحاكم الشرعية التي تُعَدُّ بمثابة البرهان الساطع والدليل القاطع على أن النظام القانوني الإسلامي لم يتوقف يومًا واحدًا عن العمل، بل لم يتأخَّر عن مواكبة التطورات والمستجدات الاجتماعية المتلاحقة.
وأشارت الدراسة إشاراتٍ سريعةً لدور المصلحين والمجتهدين الذي حملوا مشعل التطوير والإصلاح، بدايةً من جمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي، مرورًا بمحمد عبده ورشيد رضا، وانتهاءً بالسنهوري ورفاقه، وهذا ما نصَّ عليه المؤلف بقوله: "ويلزم أن أسجل هنا بالتقدير جهود هؤلاء المجددين في الفقه والقانون الذين بدؤوا بمحمد عبده وانتهوا بالسنهوري، مما يلزم معه استحياء ما قدَّموه ودراسته دراسة نقدية تيسِّر إعمال ما طالبوا به، وأنبِّه إلى أن فكرة طارق البشري عن الإسناد الشرعي لأحكام القوانين القائمة مما يساعد على التأسيس للمرجعية الإسلامية، ولعل رسالة محمد إبراهيم عن مصدرية الشريعة الإسلامية للقانون المدني المصري تكون بدايةً قويةً في هذا الاتجاه".
وقد أزاحت الدراسة بعضَ الركام الجاثم على صدر حقبة تاريخية كانت ولا تزال غنيةً بالكنوز والجواهر المعرفية، أعني نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فوجَّهت الأنظار إلى الدور الحيوي الذي لعبه الأزهر الشريف بمعاونة بعض المؤسسات التعليمية، كمدرسة الحقوق الخديوية (1886-1925م) ومدرسة القضاء الشرعي (1907-1930م) ومدرسة دار العلوم، في التصدي للغزو التشريعي الطارق والمداهم للبلاد في تلك الفترة العصيبة من عمر الأُمَّة.

مدرسة دار العلوم القديمة بحي المنيرة-القاهرة
وعملت الدراسة على توظيف التقليد توظيفًا جديدًا مغايرًا للتصورات المتعلِّقة به، والمرتكزة حول تعريفه وذمِّه والتحذير منه، فتخطَّت كافة هذه التصورات بالتعريج على دور التقليد في بناء المذاهب الفقهية، بالإضافة إلى وظائفه المختلفة، التي من بينها تطوير الفقه الإسلامي، وقد كانت هذه الجزئية عند كتابتها سببًا في تسجيل أطروحة للدكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، عن دور التقليد في بناء المذاهب الفقهية وأثره في تطوير التفكير الفقهي. وقد أمدَّ التقليد النظام القانوني الإسلامي -على المستويين النظري والعملي- بطاقاتٍ خلَّاقة وإبداعية عن طريق التخريج والتصحيح والترجيح على نحوٍ ضمن استمرار النظام، وكفل له تدفُّقه وحيويته، مع ما يقدِّمه في المحافظة على استقرار النظام القانوني، والقدرة على تنبؤ الاحتكام إليه، وما تقضي به مؤسساته.
كما أن الدراسة عقدت مبحثًا خاصًّا لمناقشة أهم الإسهامات المستحدثة في العصر الحديث في مجال أصول الفقه، وذلك بالتعريج على كتابات الدكتور وائل حلاق، التي اختلف المؤلفُ مع المنهجية المتبعة فيها، وكذلك النتائج التي توصل إليها، فقد زعم أنه يهدف إلى تفكيك المشروع الاستشراقي لدراسة أصول الفقه، فإذا به يؤيد -بدرجة أقل- مشروع محمد شحرور (1938-2019م)، ومحمد سعيد العشماوي (1932-2013م)، وفضل الرحمن (1919-1988م)، فاستعاد بناء ما أراد هدمه وهو لا يدري.
وأحسنت الدراسة لما حدَّد فيها أستاذنا وظائف أصول الفقه الأخرى التي نصَّ عليها بقوله: "إن لأصول الفقه -فوق وظيفته التاريخية المتمثِّلة في تفسير التراث الفقهي وفهمِ منهجه- وظيفةً عمليةً تتمثَّل في تشكيله منهج النظر إلى الصياغات والتطبيقات التشريعية القائمة، والعمل على وصلِ الحاضر بكامل الذاكرة التشريعية السابقة، لاستنبات منهجٍ تشريعيٍّ يُحيي آمال الأمَّة في استعادة خصوبتها التشريعية الكامنة، وإرهاف إحساسها بالعدالة، وتأثيرها وقدرتها على التفاعل الإيجابي والمثمر مع الأنظمة القانونية العالمية. ولا يمكن لهذه الدراسة وحدها أن تضطلع بهذه المسؤولية البالغة التنوُّع، ويكفيها في الواقع أن تجهر بالنداء إلى وجوب حملها، ولفت النظر إلى أهميتها، بعد أن بلغت الأمور في بلادنا العربية والإسلامية في ميادين تصريف العدالة وإدارتها، بل وتعليمها، ما بلغت من سوء؛ مما يرجع سببه -ولو جزئيًّا- إلى غياب الإطار المنطقي العلمي الواضح الذي يستوعب جوانبها، وييسِّر ذلك بالتأكيد التقدُّم الذي حقَّقته الدراسات الفقهية الحديثة في مجالات التنظير والتقنين والمقارنة مع النُّظُم العالمية الحديثة، فضلًا عن التحرُّر من التعصُّب المذهبي، والارتقاء إلى الإفادة من المذاهب الفقهية جميعها باعتبارها تفسيراتٍ متنوِّعة للنص الشرعي".
وقد سعت هذه الدراسة -ولو بإيجاز- إلى تعميق الإحساس بالمضامين التشريعية والفقهية التي تعبِّر عنها القواعد الأصولية التي عكفت الأجيال المتتالية على الإسراف في تجريدها، بُغية الإيجاز والاختصار، والانصراف إلى الاستدلال عليها، والجدال مع المخالفين فيها.
لا يصحُّ ما ذهب إليه الأستاذ شفيق شحاتة في ادعائه أن أصول الفقه نشأ نشأةً مستقلةً عن علم الفقه، وأن مباحثه قد تطورت على نحو نظريّ.
على أن هذه الدراسة بمباحثها تضمَّنت -وَفق تعبير المؤلف- إشاراتٍ ولو موجزة إلى نوعٍ من الفرق بين أصول الفقه الذي يتجه إلى أن يكون علمًا نظريًّا، وما ينبغي أن يكون عليه أصول النظام القانوني الإسلامي بأضلاعه الثلاثة التي يتألَّف منها، وهي: الفقه، والقضاء، والتشريع. وقد برهنت الدراسة بما لا يدع مجالًا للشكِّ على أن أيًّا من هذه الأضلاع لم ينعزل في الواقع عن قرينيه الآخرين.
وأكَّد أستاذنا في خاتمته على أنه ينبغي التنبيه على أن هذه المنهجية لا تتناقض مع منهجية التناول الأصولي التقليدي، وإنما هي بناء على هذه المنهجية بتحليلها ونقدها. وإذ تطورت هذه المنهجية في أحضان المذاهب الفقهية تأسيسًا لها، وتخريجًا عليها، وتحقيقًا لأقوال أئمتها، وتخريجًا على أحكامها، وترجيحًا بين الآراء المتضمنة فيها، فإنه لا يصحُّ ما ذهب إليه الأستاذ شفيق شحاتة في ادعائه أن أصول الفقه نشأ نشأةً مستقلةً عن علم الفقه، وأن مباحثه قد تطورت على نحو نظريّ، دون أن يتأثر هو أو يؤثر في علم الفقه أو في تطوره، وهو ما ذهب إليه يوسف شاخت ببيانه أن تأثير أصول الفقه في تطور التفكير الفقهي كان تأثيرًا ضئيلًا.
لقد استطاعت الدراسة أن تعطي تصورًا جديدًا من نوعه في كيفية الكتابة والبحث في أصول الفقه، حيث إنها جمعت بين أصالة المنهج التقليدي المتبع في مثل هذه الكتابات وبين المنهجية المقارنة الجديدة والمتمثلة في فتح مجالات وطَرقِ موضوعات جديدة يصلح أن تكون معينًا خصبًا في تزويد النظام بمزيدٍ من الحيوية والنشاط، كالإفادة من الأعراف والعوائد والمصلحة والاستدلال وما لهم من أثرٍ محوريٍّ في مسايرة المتغيرات والنوازل.
ولعل من ميزات هذه الدراسة أنها توجِّه أنظار الدراسين والباحثين والمشتغلين بالفقه والأصول إلى أهمية أعمال القضاة وأحكام المحاكم، وذلك من خلال القضايا وأحكام المحاكم التي يتعرض لها الكتاب في كثيرٍ من مباحثه، وذلك لأنها الجانب التطبيقي العملي الذي يلزم الوقوف عنده كثيرًا للإفادة منه وتعميمه في كافة المباحث والدراسات كلما كان ذلك متاحًا؛ إذ هذا هو التجديد الحقيقي الذي نصبو جميعًا إليه.
كما أن الدراسة أكَّدت على أن مبدأ العدالة يُعَدُّ أحد أبرز وأهم المبادئ التي عالجها القرآن الكريم وتشريعاته، ودعمته السُّنة النبوية القولية والفعلية، وشهدت له فتاوى الصحابة الكرام في كثيرٍ من القضايا التي عُرضت عليهم، وهو المبدأ الذي يمثِّل نقطة التقاء جامعة بين كافة النُّظُم التشريعية والقضائية، ويمكن لأجله أن تلتقي هذه النُّظُم كافَّة على اختلاف هويتها وثقافتها، وهذا بدوره يدفعنا للدعوة إلى استغلال أمثال هذه المبادئ العامَّة لمدِّ جسور التواصل والحوار بين هذه النُّظُم المختلفة للإفادة منها في الواقع، لنأخذ منها في نهاية الأمر ما يتوافق مع مبادئنا الشرعية، ونتخلَّى عن تلك التي تتصادم مع ثوابتنا الشرعية.
وأرى أن هذا البحث قد دفع الدراسة الأصولية خطواتٍ تقدُّمية للأمام، يلزم الانطلاق منها في الدراسات المستقبلية وعدم الارتداد إلى الوراء، حتى لا نكون كحال تلك المرأة الخرقاء التي ذكر القرآن أمرها في سورة النحل بقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا}، على أنه بإنعام النظري فيه نجد أنه يحوي كثيرًا من المسائل والموضوعات التي يحسن إفرادها بالبحث والدراسة في دراسات مستقلة، وهذا ما يتعيَّن علينا توجيه الباحثين والدارسين إليه في المرحلة المقبلة؛ ليحقِّق هذا البحث بعض أغراضه السابق ذكرها.
وعلى كل حال، فإني أرجو ألَّا يُفهَم الغرض من الدراسة على غير ما وُضِعت له، أو يظن أحدٌ أن الدراسة أرادت أن تناصب المدرسة التقليدية العداء، فهذا ليس من منهج المؤلف ولا أهدافه الكبرى، ولكن الدراسة تمثِّل مساراتٍ معرفية لمعالم أصول النظام القانوني تسعى لإكمال الجهود التي بدأها أئمتنا الأوائل، كالشافعي والكرخي والدبوسي والشاطبي، وانتهاءً بما قدَّمه جيل العمالقة، كأحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف ومحمد زيد الإبياني والسنهوري، ما يعني أن الكتاب ليس من بين أهدافه على الإطلاق إثارة العداوة أو إذكاء نار العصبيَّة بين أنصار المدرسة التجديدية والتقليدية، أو الانتصار لواحدة منهما على حساب الأخرى، وإنما يهدف إلى إيجاد تقاربٍ بين أصول النظام الإسلامي والنُّظُم القانونية المعاصرة، مع محاولة إحداث تزاوجٍ بينها للإفادة من ذلك في الجوانب التشريعية والقضائية.
وعليَّ هنا أن أسجل شهادتي على هذا العمل على اعتبار أني كنتُ شاهد عين على كل جزئية ومسألة ذُكِرت فيه، فأقول إن هذا البحث -بحقٍّ- خالص تجربة أستاذنا العلمية الطويلة مع التراث الأصولي والفقهي والقانوني، التي تمتدُّ لقرابة أربعين عامًا. وعلى الرغم من ذلك، فإن أستاذنا كان يتوقف طويلًا إزاء بعض الموضوعات نظرًا لطبيعتها الشائكة، فتارة يكتب أشياء ثم يزيد فيها وينقص حسبما يتراءى إليه بعد مناقشات وسجالات مطوَّلة في السياق ذاته، وهكذا كانت الحال على مدار عامَيْن من الكتابة هي عُمر هذا البحث، انقطع خلالهما أستاذنا عن كثيرٍ من الأنشطة العلمية والاجتماعية التي كان يمارسها، للتفرغ لكتابة هذا السفر العظيم، وكثيرًا ما كانت تأتيني الوصية من معاليه أن أفكار الكتاب وموضوعاته أمانة في رقبتك إن حدث أمرٌ أو طرأ طارئ.
وفي الختام، أرى أن هذه الدراسة من أهم الدراسات التي خرجت في الفترة الحالية في بابها، وأنها كانت فيضًا إلهيًّا وفتحًا ربانيًّا فتح الله بها على أستاذنا، وأنها ستكون من الدراسات التي ستحدث آثارًا عظيمة في المرحلة المقبلة، وأنها ستثير كثيرًا من المناقشات والسجالات العلمية اللازمة للتدليل على حيوية النظام وبقائه وعدم جموده وصلاحيته لإجراء كافة مستويات المقارنة التي يمكن إجراؤها بين النُّظُم القانونية المختلفة.