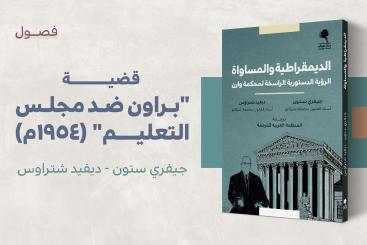إحياء التشريع الإسلامي

تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة من الدراسات الأكاديمية المعنيَّة ببيان حالة الفقه الإسلامي وتشريعه في فترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بالإضافة إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع الإسلامي والغربي. وتُعَدُّ هذه الدراسة -إلى جانب كتاب "أثر مدرسة الحقوق الخديوية"، و"المقارنات والمقابلات"، و"في أصول النظام القانوني الإسلامي"، وجميعها من إصدار مركز نهوض للدراسات والبحوث- من الدراسات التي ستضيف كثيرًا إلى القارئ المتطلِّع لمعرفة السياق التاريخي والتعليمي والاجتماعي والسياسي والتشريعي لهذه الفترة. لذا ينبغي أن تكون هذه الدراسة من الدراسات التي تدفع بالباحثين صوب الاتجاه الصحيح عند اختيار الموضوعات الأكاديمية وكيفية بحثها؛ لكونها تضع منهجًا متكامل الأركان في كيفية التعاطي مع مثل هذه الموضوعات.
وتعمل هذه الدراسة وأمثالها على الكشف عن مكنونات التراث الإسلامي المتوارية بين طبقات التاريخ المنسيَّة، بغيةَ تقديمها في تصورات وأنماط معرفية صحيحة، ما عساه أن يساعد في تكوين أُطر منهجية وتصورات حقيقية من شأنها التوصُّل إلى نقاط التقاء مشتركة بين النُّظُم التشريعية التي قد تبدو مختلفةً في أحيان كثيرة، مع محاولة الإفادة من القواسم المشتركة التي يتوصل إليها في بناء جسور من الثقة والتواصل بين هذه النُّظُم من جهة، ثم العمل على استغلال مواطن التشابه والاتفاق، وتفادي مواضع التصادم والاختلاف من جهة أخرى.

وصف الكتاب
ينتظم هذا الكتاب -المكوَّن من خمسمائة وإحدى عشرة (511) صفحة- في عشرة فصولٍ منتظمة في أربعة أقسامٍ رئيسة، جاء القسم الأول منها بعنوان: أصول الإحياء التشريعي، محتويًا على ثلاثة فصول، الأول منها بعنوان: استقبال القانون الأوروبي في السياقَيْن السياسي والاجتماعي، وعرجت فيه الدراسة على اختلاط سلطة إسلامية المحاكم والقوانين، والاستقبال المصري للقانون الأوروبي والتخصُّص القانوني الحديث في الاقتصاد في إطار السياقَيْن الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى الإحياء الإسلامي ومركزية العقد الثالث من القرن العشرين. وأما الفصل الثاني فجاء بعنوان: الإحياء التشريعي الإسلامي المبكِّر والقبول الوطني، وتناولت الدراسة أفكارًا مهمَّة، منها: الدفاع عن النموذج النظري للنظام التشريعي الإسلامي، وإرهاصات النزعة الإحيائية في الصحافة ومدارس القانون، ونبهت كذلك على دور الأستاذ محمد رشيد رضا وإسهامه في الإحياء التشريعي الإسلامي بوصفه أيديولوجيا، وخُتم هذا القسم بالفصل الثالث، وعنوانه: مجلة نقابة المحامين الشرعيين والمنعطف الإسلامي، ويتناول هذا الفصل عددًا من الأفكار الرئيسة، أهمها: ادعاء الخمول في العلوم الفقهية الإسلامية، وعدم ملاءمة القانون الأوروبي، وثنائية المفردات القانونية بوصفها أداة أيديولوجية، وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والاجتهاد بوصفه مجالًا بحثيًّا، وخُتم هذا الفصل بالتعريج على أفكار الفقهاء.

الشيخ محمد رشيد رضا
وأما القسم الثاني فكان عنوانه: دور القانون الأوروبي والحملات الإمبريالية في الإحياء التشريعي الإسلامي، وتضمَّن ثلاثة فصول رئيسة، أولها عنوانه: التدخلات الأجنبية في القوانين المستمدَّة من الشريعة الإسلامية، وشمل هذا الفصل عددًا من النقاط المهمَّة؛ كالدراسات الأكاديمية للشريعة في أوروبا، ودور المستشرقين والباحثين الموالين للسلطة الاستعمارية، وبيان القانون العثماني والنزعة الإسلامية الأوروبية المقارنة، وجهود سافاس باشا وسنوك هرغونيه ولامبير في التشريع الإسلامي. وجاء الفصل الثاني في هذا القسم تحت عنوان: امتداد الفكر القانوني في الجزائر وفرنسا وألمانيا، وعرج المؤلف فيه على جهود المدونين والمقارنين قبل تأسيس مدرسة القانون بالجزائر، وأشار إلى تدشين عمليات جمع القوانين ومقارنتها ومعالجتها داخل التقاليد القانونية في الجزائر، وبداية إعادة صياغة القانون المقارن، والوحدة القانونية والعالمية والعلمانية والإمبريالية في مؤتمر 1900م، والوقوف على مدى التأثير الألماني المتفشي في القانون المقارن والنظريات القانونية، والمدرسة القانونية الرومانية والقانون المدني الألماني، ثم ختم هذا الفصل بعرض تأثير الأفكار الألمانية في المذهب الفرنسي. وأما الفصل السادس في ترتيب الدراسة والثالث في هذا القسم فجاء بعنوان: البرنامج المقارن للإصلاح التشريعي الإسلامي، وعرض فيه عددًا من الأفكار الرئيسة، أهمها: النزعة المقارنة والإحياء الإسلامي من وجهة النظر العالمية لإدوارد لامبير، وتطلعات القانون المقارن ومناهجه ومقدماته بشكل عام، ونظرية التاريخ القانوني العالمي، والإطار المنهجي المسبق للنزعة المقارنة، والمواجهة بين النزعة المقارنة والنزعة الاستشراقية، وتطبيق التاريخ القانوني ومبادئ النزعة المقارنة على الإسلام، ثم كان الختام مع فكرة المرونة ومناهضة النزعة الشكلية في الاجتهاد.
وجاء القسم الثالث من هذه الدراسة بعنوان: التحولات في التعليم والمجال الدراسي، وشمل ثلاثة فصول رئيسة، هي السابع والثامن والتاسع على حسب ترتيب الدراسة، وقد حمل أول هذه الفصول عنوان: التعليم والمجال الدراسي للقانون الفرنسي-المصري والقانون الفرنسي قبل عام 1923م، وأشار فيه المؤلف إلى مدرسة الحقوق الخديوية (كلية القاهرة) قبل تأسيس المحاكم المحلية وبعدها، كما أشار إلى بيان السباق الإنجليزي-الفرنسي للهيمنة على عمادة مدرسة الحقوق الخديوية، وأوضح كذلك حال القانون الفرنسي تحت قيادة تيستو وسكوت، والهيمنة الإنجليزية وإقصاء التعليم الفرنسي، ثم عرج على فترة ما بعد رحيل لامبير عن عمادة مدرسة الحقوق الخديوية، ودور الكلية الفرنسية وتواصل النفوذ الفرنسي. ثم جاء الفصل الثامن بعنوان: التعليم والدراسات العلمية في التشريع الإسلامي في الفترة من عام 1868م إلى عام 1923م، وعرض هذا الفصل مجموعةً من الأفكار من أهمها: الإحياء والمنهج الدراسي في جامعة الأزهر ومدرسة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي ومدرسة الحقوق الخديوية، وخُتم هذا الفصل بالتنويه بالكلية الفرنسية واستمرار التقاليد الفرنسية. وجاء الفصل التاسع والأخير في هذا القسم بعنوان: ازدهار الدراسات المتقدمة بعد عام 1923م، وحوى هذا الفصل عددًا من الموضوعات الأساسية، منها: التمصير والتعريب وإحياء النفوذ الفرنسي والتوجُّه اللامبيري، والعمداء والأساتذة المصريون، والدراسات العلمية الفرنسية-المصرية، والباحثون الواعدون والدراسات المتقدمة وبرنامج الدراسات العليا، وإحياء الشريعة الإسلامية في المنهج الدراسي الجديد، وخُتم هذا الفصل بالإشارة إلى الرابط بين عملية إحياء الشريعة الإسلامية والتطورات الدولية من حيثُ الاختلاف والمنافسة والآفاق الدولية والقانون المقارن في كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وخُتمت الدراسة بالقسم الرابع الذي جاء تحت عنوان: أشكال جديدة من الفكر التشريعي الإسلامي، واشتمل على فصل واحد، وهو العاشر، وعنوانه: أصول النظرية العامة في الفكر التشريعي الإسلامي، وقد احتوى على مجموعة من الأفكار الرئيسة من بينها: القانون الفرنسي-المصري والمجال الدراسي الجديد، وأصول النظرية العامة في الفقه المصري، وخُتم هذا الفصل بالحديث عن روابط التأثير بين القانون الأوروبي والفقه الإسلامي. ثم جاءت الخاتمة لتتناول فكرة تحجيم النزعة الإحيائية المعتدلة وتراجع التوجُّه المصري-الفرنسي، وكذلك فكرة النزعة الاستبدادية والتوجهات الفرنكو-مصرية.
المنهجية العلمية للكتاب
من الواضح أن المؤلف قد اعتمد أساسًا على المنهج الوصفي، حيث إنه تعرَّض لفترة زمنية محدَّدة بالوصف والبيان، بغيةَ إعطاء صورة كاملة للقارئ عن هذه الحقبة التاريخية، كما أن المنهج التحليلي بدا واضحًا في مواضع كثيرة من الدراسة، فقد اعتنى المؤلف بالوقوف على بعض الأحداث، وأخذ في تحليلها وتفكيكها، ثم عمد إلى قراءتها في سياقاتها التاريخية والاجتماعية السابقة واللاحقة عليها للوصول إلى نتيجة مُقنِعة، ولم يغفل المؤلف المنهج الاستقرائي، وذلك باستقرائه لبعض الجزئيات والموضوعات التي وضع لها إحصائياتٍ دقيقة. وكل هذا من شأنه أن يدلِّل على أن المناهج العلمية تتداخل وتتكامل للوصول إلى النتائج العلمية المعتبرة.
الأفكار الرئيسة
جاء هذا الكتاب ليميط اللثام عن فترة زمنية وحقبة تاريخية (1975-1952م) مليئة بالأحداث العظام من الناحية السياسية والاجتماعية والتعليمية، وقد حاول مؤلفه -وهو أكاديمي بارع ومحامٍ ماهر- جاهدًا أن يقف بالقارئ على حقيقة يرتاب فيها كثيرٌ من الباحثين، وهذا جهد مشكور بذله في تسطير هذه الدراسة، بغيةَ كشف خفاياها وتبيين غوامضها، وقد هُدي في كثيرٍ من أجزائها إلى الوصول إلى نتيجة منطقية مُرضية. ولا تزال هذه الحقبة بحاجة إلى بعض الدراسات الأكاديمية العميقة في بعض الموضوعات التي عرج عليها المؤلف سريعًا مع التنبيه على أنها تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث.
عرضت الدراسة إلى بداية ظهور القانون الأوروبي وأسباب هذا الظهور، وهل نتج ذلك عن الدور السياسي الذي لعبه الاحتلال الفرنسي لمصر مع بداية القرن الثامن عشر أم نتيجة تقاعس الفقهاء المسلمين عن أداء دورهم في النهوض بالفقه الإسلامي؟ وساقت الدراسة الأدلَّة على محاولة الهيمنة على الجانب التشريعي بفرض القانون الفرنسي الذي تُرجم إلى العربية، ثم السيطرة على الجانب القضائي بإنشاء المحاكم المختلطة (1875م) والمحاكم الأهليَّة (1883م) تباعًا، وأشارت إلى دور علماء الشريعة الذي اقتصر على بيان أحكام العبادات دون البحث عن حلول عملية للخروج من الأزمة التي أضحت الأُمَّة على وشك الوقوع فيها آنذاك بسبب رفض الفقهاء الاستجابة لطلب الخديوي بوضع تقنينٍ قانونيّ فقهيّ على غرار كود نابليون في المعاملات المدنية، ما دفع الخديوي في نهاية الأمر إلى أن يميل إلى فكرة ترجمة التقنينات الفرنسية والعمل بها.
أشارت -الدراسة- إلى أن الدور الذي لعبه غير المسلمين في بناء النظام القانوني الجديد -من أمثال مكرم عبيد ويوسف وهبة- ربما يكون من أسباب الاستبعاد الكُلي للشريعة الإسلامية.
وبيَّنت الدراسة أنه أمام هذا الزحف التشريعي المُحكَم في كافة المجالات المدنية والتجارية والجنائية وغيرها، اقتصر الوجود الشرعي الكامل على مجالات الزواج والطلاق والوصايا والوقف والميراث، فيما عُرف بالأحوال الشخصية، ليتقلَّص الدور التشريعي للشريعة الإسلامية وأدبياتها في مجال الأحوال الشخصية فقط، ولم يعُد لها وجود فعَّال في الجوانب العملية إلَّا ما ورد من بعض الإشارات الخاصة ببعض القضايا التي تستلزم النص عليها. وحاولت الدراسة أن تبرِّر هذا الاقتصار والتقليص للفقه الإسلامي، فأشارت إلى أن الدور الذي لعبه غير المسلمين في بناء النظام القانوني الجديد -من أمثال مكرم عبيد ويوسف وهبة (1852-1934م)- ربما يكون من أسباب الاستبعاد الكُلي للشريعة الإسلامية، لكنها لم تقطع بذلك، وأكَّدت على أن هذه الفكرة بحاجة إلى مزيدٍ من العناية والتدقيق للوقوف على صحتها من عدمه.
لقد عمد الاحتلال إلى مناهضة الحركة العلمية المُعلية من قيمة التراث الفقهي على حدِّ تعبير الدراسة، ودلَّلت الدراسة على هذا الأمر بقولها إن الوزير محمد قدري باشا (1821-1886م) فَقَد منصبه بسبب إعلانه عن ميوله الشرعية وإعداده مشروعاته التشريعية الثلاثة في باب المعاملات، والأحوال الشخصية، والوقف. كما عمل الاحتلال أيضًا على تهميش الشريعة الإسلامية والتقليل من أهميتها التشريعية بشتَّى الطرق وكافة الوسائل، وسعى في سبيل ذلك إلى إعاقة كافة الجهود الرامية إلى إحياء التشريع الإسلامي.
وأظهرت الدراسة الجهود القيّمة التي قام بها السيد جمال الدين الأفغاني (1897م) وتلميذه الأستاذ الإمام محمد عبده (1905م)، وكيف أنهما عملا على وجود الشريعة الإسلامية في كافة الميادين. وأكَّدت بما لا يدع مجالًا للشكِّ على أن الإمام محمد عبده قد ورث الأفكار الإحيائية التي وضع أُسسها السيد الأفغاني، وفي سبيل ذلك بدأ الإمام في دعوته الواضحة والصريحة الرامية إلى التجديد في طريقة تناول التراث الفقهي وعرضه، الأمر الذي أثار حفيظة كثيرٍ من رجال الأزهر على الأستاذ الإمام. وأشارت الدراسة إشارة دقيقة -حسبما أرى- إلى أن نظرة الأستاذ الإمام محمد عبده إلى الشريعة قامت على اعتبارها أسلوبًا للحياة، الفكرة التي لم تكن لتخدم أفكاره الإصلاحية ومنهجه الإحيائي؛ إذ الأَولى -من وجهة نظر المؤلف- أن يُنظر إليها بوصفها نظامًا قانونيًّا متكاملًا، وأنا أوافق المؤلف تمام الموافقة على رأيه هذا، وأؤكِّد على أن الفقه الإسلامي نظام قانوني، يملك كافة مقومات التجديد والنهوض والاستمرار، شريطةَ أن يلقى العناية اللازمة لذلك.
ولم تغفل الدراسة كذلك الدور البارز الذي لعبه الشيخ محمد رشيد رضا (1935م) في الدعوة إلى إحياء التشريع الإسلامي، وقد صرح بذلك في مجلته التي عالجت هذه الجزئية في كثيرٍ من المقالات، وأوضحت أن رشيد رضا كان أكثر وضوحًا وصرامةً في مطالبته بالإحياء الديني على كافة المستويات من شيخه الأستاذ الإمام محمد عبده.
وفي سياق الكشف عن المحاولات الجادة المطالبة بالعودة إلى التشريع الإسلامي، بيَّنت الدراسة الدور الأزهري الذي قام به الأزهر الشريف ورجاله في سبيل ذلك، وألقت الضوء على التيار المحافظ الذي رفض استقبال القانون الأوروبي رفضًا تامًّا، لكنه على الرغم من رفضه واستنكاره لم يقدِّم شيئًا يُذكَر في سبيل الاحتفاظ بالتشريع الإسلامي، مكتفيًا بالرفض والاستنكار، فكان سببًا -على ما أرى- من أسباب التمهيد للقانون الأوروبي الوافد، ثم نبهت الدراسة على وجود تيارٍ أزهريّ إصلاحيّ نادى كثيرًا بإجراء العديد من الإصلاحات التعليمية والتشريعية، كفكرة إصلاح التعليم في الأزهر وتنقيح مناهجه وترتيب مواده لتكون مواكبةً للمستجدات العصرية، وساقت الدراسة طرفًا من السجالات والمحاورات التي دارت بين شيوخ الأزهر ورجاله حول هذا الأمر. ولعلَّ هذا يدفعني للتأكيد على أن الأزهر على الرغم من الدور التعليمي والسياسي والاجتماعي البارز الذي يؤديه عبر التاريخ، فإنه لم يأخذ في تلك الفترة بزمام المبادرة للمسارعة في وضع بعض التقنينات الشرعية على غرار التقنينات الغربية ليقطع السبيل على المناوئين لفكرة إحياء التشريع الإسلامي، وهذا السبب من أبرز الأسباب التي فتحت الباب على مصراعيه أمام القوانين الغربية لغزونا في عقر دارنا.
كما أن الدراسة في بيانها للدور الذي أدته المؤسسات التعليمية الشرعية قد أوضحت الأدوار التي أدتها المؤسسات التعليمية الموازية للأزهر الشريف؛ كمدرسة دار العلوم، ومدرسة الحقوق الخديوية، ومدرسة القضاء الشرعي. حيث أشارت الدراسة إلى دور مدرسة دار العلوم في إحياء التشريع الإسلامي، وأنها لم تضطلع بأكثر من تخريج مُعلِّمي اللغة العربية وإعدادهم في أول الأمر، ثم سعت بعد ذلك إلى تخريج عددٍ من الطلاب بغيةَ حصولهم على أماكن شاغرة بالسلك القضائي، الأمر الذي قابله الأزهر ورجاله بالرفض التام، ما لفت الأنظار إلى إنشاء مدرسة متخصِّصة في تأهيل القضاة الشرعيين وإعدادهم، وقد تبلور هذا المجهود في عام 1907م بتأسيس مدرسة القضاء الشرعي، المدرسة التي استقبلت عددًا من خريجي الأزهر ودار العلوم والحقوق الخديوية للتدريس بها، وقد أبلت هذه المدرسة بلاءً حسنًا في الجانب التشريعي والقضائي، فأخرجت مجموعةً من النابهين في المجال الشرعي والقانوني من أمثال: محمد أبو زهرة (1898-1974م)، وعلي الخفيف (ت 1978م)، وعبد الوهاب خلاف (1888-1956م). غير أن عمر هذه المدرسة كان قصيرًا، فلم يكتب لها البقاء طويلًا نظرًا للمعارضة الشديدة التي أظهرها الأزهر لبقاء هذه المدرسة، ما أدى في نهاية المطاف إلى إغلاقها نهائيًّا بحلول عام 1930م، والتحاق مُعلِّميها بالجامعة المصرية أو الأزهرية لتدريس الشريعة الإسلامية وعلومها.
لم تعُد الدراسة التقليدية للمطولات الفقهية المشحونة بالحواشي والمتون التي يحار فيها اللبيب المنهجَ المعتمد للدراسة، ما أدى إلى ظهور الأساليب الفنيَّة الجديدة في الكتابة.
وأرى أن هذه الدراسة كانت موفقةً إلى حدٍّ كبيرٍ في عرضها لجهود مدرسة الحقوق الخديوية في إحياء التشريع الإسلامي، حيث إنها كشفت بما لا يدع مجالًا للشكِّ عن الدور الفاعل للمدرسة في مجابهة الأوضاع التشريعية المتزامنة مع إنشائها. وكيف أنها استطاعت -بفضل جهود أعلامها- أن تظهر الوجه الحقيقي للفقه الإسلامي وتراثه؛ وذلك لأن المدرسة قد أحدثت تغيرًا واضحًا وبارزًا في طريقة عرض المادة الفقهية وتناولها، ما كان سببًا في تقديم الفقه الإسلامي في ثوب جديد، فلم تعُد الدراسة التقليدية للمطولات الفقهية المشحونة بالحواشي والمتون التي يحار فيها اللبيب المنهجَ المعتمد للدراسة، ما أدى إلى ظهور الأساليب الفنيَّة الجديدة في الكتابة؛ كالتنظير الفقهي، والتقنين الفقهي، والمقارنات التشريعية، وهذه الأساليب إنما نشأت وترعرعت في ظلال مدرسة الحقوق الخديوية.
هذا، وإذا كانت الدارسة قد اهتمَّت اهتمامًا كبيرًا بالجهود المؤسسية في إحياء التشريع الإسلامي، وهذا توجُّه محمود لها فيما أرى، إلَّا أنها سلطت الضوء على بعض الشخصيات البارزة التي حاولت جاهدةً تقديم سياقٍ معرفيّ شرعيّ مختلف عن نظيره التقليدي لخدمة فكرة الإحياء والتجديد التشريعي، وكان من بين هؤلاء الدكتور شفيق توفيق شحاتة، وهو مصري مسيحي درَّس القانون المدني بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، وقدَّم أطرحته للدكتوراه عن نظرية الالتزامات في الفقه الحنفي عام 1936م، بإشراف علمي من الشيخ أحمد إبراهيم (1874-1945م)، وقد مثَّلت دراسة شحاتة مسارًا معرفيًّا جديدًا من نوعه في مجال الدراسات الفقهية، حيث كتبها شحاتة باللغتَيْن العربية والفرنسية، وامتازت أطروحة شحاتة بأنها قدَّمت أنموذجًا معرفيًّا ورؤيةً مستقبليةً لما ينبغي أن تكون عليه الدراسات الفقهية، إلى جانب فتحها المجال لمناقشات علمية إزاء بعض الفروع الفقهية عند الحنفية، كحرية التعاقد مقارنةً بالقانون الفرنسي.
وقد كانت هذه الأطروحة مصدرَ إلهام لمن جاء بعد شحاتة وتعرَّض لنظرية الالتزام أو العقد بالكتابة، كالشيخ أبي زهرة وأحمد إبراهيم والسنهوري (1971م)، وقد تناول جميعهم نظرية العقد والالتزام بالتدريس والكتابة. وعليَّ هنا أن أسجل بالغ إعجابي بهذه الدراسة وصاحبها، وأنها كانت من الدراسات الدافعة للفقه الإسلامي في مجال القانون المقارن، وأرى أننا بحاجة ملحَّة لدراسة علمية رصينة تكشف عن السياق المعرفي والمنهجي لشفيق شحاتة وكتاباته على وجه العموم، وأطروحته هذه على وجه الخصوص.
وأما الشخصية الثانية التي تعرَّضت لها الدراسة بالحديث، فكانت شخصية العلَّامة لامبير (1947م)، عميد مدرسة الحقوق الخديوية ما بين عامي 1906-1907م، الذي كان له دور عظيم في تقديم الفقه الإسلامي للمجتمع الدولي ليصبح واحدًا من المنظومات القانونية الدولية المعترف بها في مؤتمر القانون المقارن عام 1937م، وساعد بجهوده المضنية وأفكاره الشمولية على تطوير القانون المقارن، وأسهم إسهامًا كبيرًا في تكوين العقلية القانونية للعلَّامة السنهوري وغيره من المصريين، الذين استقدمهم إلى جامعة ليون وأشرف على أطروحتهم العلمية، كالدكتور محمود فتحي، صاحب رسالة التعسُّف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. غير أن المؤلف انتقد هجوم لامبير غير المُبرَّر على المذاهب الفقهية الأربعة، ونظرية الإجماع، وسلطة الفقهاء. وينبغي أن أشير هنا إلى أنه من الضروري لمعرفة موقف لامبير من الفقه الإسلامي الوقوف على ما دوَّنه في كتابه "القانون المدني المقارن" من صفحة (279) إلى صفحة (389) باللغة الفرنسية، والسعي في ترجمة هذا النص لمحاولة فهم توجُّه لامبير فيما يتعلَّق بالشريعة الإسلامية، لمعرفة السبب الكامن وراء هذا الاهتمام، هل كان بدافع من الدراسة المتعمقة للتراث الفقهي، أم بتأثيرٍ من الدراسات الاستشراقية؟ وهذا بدوره سيساعد على فهم كثيرٍ من القضايا والمسائل التي تعرَّض لها أحد أبرز تلاميذه -السنهوري- في تصوراته ومناهجه التشريعية، التي كانت وما زالت مثارًا للجدل، لكونه قد أثَّر تأثيرًا مباشرًا في التكوين القانوني لعقلية السنهوري.
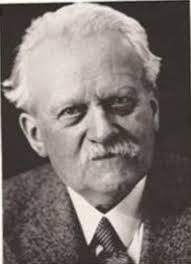
إدوارد لامبير
إن هذه الدراسة جاءت لتسدّ فراغًا في المسار المعرفي لفترة تاريخية مهمَّة من تاريخ الدولة المصرية، حيث إنها تعرض لبداية ظهور القانون الوضعي في السياقَيْن السياسي والاجتماعي مع محاولة ربط ذلك بحالة التشريع الإسلامي وقتئذ. وقد نجحت الدراسة إلى حدٍّ كبيرٍ في رصد حالة المؤسسات التعليمية الشرعية خلال هذه الفترة، وردود أفعالها إزاء ما نزل بالأمة المصرية، وكيف أن بعضها استسلم للأمر الواقع، في حين أن بعضها الآخر لم يستسلم لهذا الواقع المرير، فسعى دون هوادة للبحث عن أُطر ومناهج معرفية مُقنِعة لتقديم التراث الفقهي مرةً أخرى، لعله بهذه الطرح الجديد يجد مخرجًا من الأزمة التي باتت تحيط بالتشريع الإسلامي.
وتفتح هذه الدراسة لمن يطالعها بعناية كثيرًا من الموضوعات في مجالات بحثية متنوِّعة، تصلح أكثرها لتكون أطروحات علمية مستقلة، حيث إنها عرضت عرضًا سريعًا لبعض الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد بحث وعناية للوقوف على نتائجها العلمية، فعلى سبيل المثال من الموضوعات التي بحاجة إلى أبحاث مستقلة: جهود غير المسلمين في خدمة التشريع الإسلامي من أمثال شفيق شحاتة وسليمان مرقص، وكذلك فكرة الإسناد الشرعي للقوانين العربية الحالية على غرار ما تمَّ بالقانون المدني المصري في أطروحة الدكتوراه للدكتور محمد إبراهيم طاجن، واستكمال مشروعات الأعمال الكاملة التي بدأها الدكتور محمد عمارة لكثيرٍ من أعلام الدراسات الشرعية والقانونية لهذه الفترة، وإجراء المقارنات والمقابلات بين النظام القانوني الإسلامي والنُّظُم القانونية الأخرى في كثيرٍ من الموضوعات، إلى جانب وجود عددٍ لا حصر له من الموضوعات التي تقدِّمها هذه الدراسة وأمثالها. ما يعني أننا بحاجة ماسَّة لنجد تجليات ليونارد وود ورسالته في كثيرٍ من الدراسات الأكاديمية.
على أنه لا يفوتني أن أثمّن وأشيد بالجهود التي بذلها المؤلف في جمع المادة العلمية لهذه الأطروحة، وقد كان للقاءات الشخصية التي أجراها مع أساطين الشريعة والقانون في مصر أثرها الطيب في إخراجها على هذه الصورة التي بين أيدينا، حيث أفادت الدراسة من لقاء المرحوم الدكتور محمد كمال إمام (2020م)، وأستاذنا الدكتور محمد أحمد سراج، والمرحوم الدكتور برهام عطا الله (2020م)، وغيرهم ممَّن أشار المؤلف إليهم في مقدمته، كونه أفاد منهم إفادة تامَّة في جميع مسارات الدراسة.
سعت هذه الدراسة بحيادية تامَّة إلى إزاحة الركام الهائل الجاثم على صدر هذه الحقبة التاريخية، بغيةَ إبراز الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استيطان القانون الغربي وإحلاله محلَّ الشريعة الإسلامية في كافة المجالات باستثناء أبواب الأحوال الشخصية، وسعت كذلك إلى رصد تطوُّر حركة الإحياء التشريعي الإسلامي الجماعية والفردية، وحاولت تفسير بعض المواقف والأحداث حسب المعطيات المتاحة بحيادية كاملة دون تقديم تبريراتٍ لا توحي إلَّا بالميل لفكرة ما أو الترويج لها، وهو ما يُحمَد للمؤلف على طول الدراسة. كما أنَّ لوفرة المصادر والمراجع العربية والأجنبية النادرة أثرًا قويًّا في الرفع من قيمة الدراسة، والإسهام في قبول ما فيها من أفكار وما توصَّلت إليه من نتائج، يمكننا البناء عليها في إطار تعزيز نشر الثقافة القانونية.
وأستطيع القول في ختام عرض أبرز الأفكار والمبادئ التي تناولتها الدراسة بالعرض والتحليل والمناقشة: إنها قدَّمت خدمة جليلة للباحثين في الدراسات الشرعية الإسلامية، لا سيما المهتمين بالجوانب التشريعية والقضائية، وأنها بالتضامن مع أطروحة "أثر مدرسة الحقوق الخديوية" للدكتور محمد إبراهيم طاجن، التي نشرها مركز نهوض للدراسات والبحوث بالتزامن مع نشر هذه الدراسة، ستفتحان المجال أمام الباحثين الأكاديميين الحريصين على تقديم ما يعود بالنفع على الأمة العربية، بل وعلى الإنسانية جمعاء، وأنهما يكمل بعضهما بعضًا في إماطة اللثام عن هذه الفترة التاريخية المليئة بالأحداث والحوادث التي كان لها أثرها في السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.