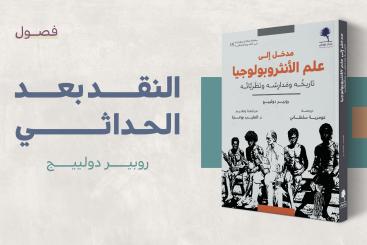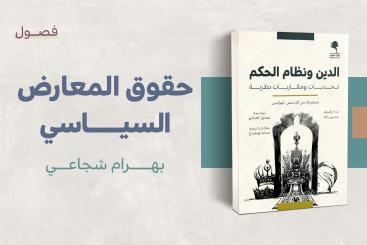الحداثة والهوية: سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة- مساءلة المفهوم بين ثنائية الدعوة والدعاية

تعد مسألة التسليم للمفاهيم/المرجعيات، أحد المعضلات الأساسية التي ساهمت في بنية الوعي العربي؛ حيث إن الرؤية النقدية تكاد أن تكون غائبةً عن هذه البنية، بتعاطيها مع مجموع المفاهيم باعتبارها مرجعيات أساسية لا يمكن نقدها.
ومن بين تلك المفاهيم الهوية كنموذج، والتي غالبًا ما تُحيل إلى التراث والتقاليد واللغة والجغرافيا، إلا إن سياقها التكويني يُسائل عددًا من الأبعاد التاريخية والمرجعية التي ساعدت على تركيبِه وإفرازِه، وبالمثل أيضًا مفهوم الحداثة، وإن كان التعاطي معه عربيًّا يشوبه التحفظ والنقد اللاذع، إلا إنه أيضًا لا يخرج من سياق جبهة الدعوة، كجزءٍ من الدعاية المشكلة لصراع المرجعيات العربية (الدينية والعلمانية).
هذا الأمر، يطرح معه إشكالية التعاطي مع أي مفهوم تقليدي أو عصري ضمن منظومتنا القيمية العربية، سواء بالتسليم التام أو إبراز العداوة المطلقة، وهو الأمر الذي يجسده واقعًا خطابُ المرجعيات الفكرانية، بين الجبهة الدعوية ذات المشارب الدينية، والذي تسعى لفرض منظومتها الاجتماعية والسياسية ضمن وعائها الديني/الإسلامي، وفي المقابل الجبهة الحداثية، والتي تعمل على إبراز برامجها ضمن صيغته الكونية، كتجاوز للمحلي، باعتباره مرادفًا للتأخر عن ركب التقدم. في غياب لإمكانية التوفيق بينهما ضمن إطار مشترك يوحد المصير بين مختلف هذه المكونات.

د.عبدالله حمودي
وضمن هذا الصراع المرجعي، يأتي كتاب الإنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي: "الحداثة والهوية: سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة"، الصادر عن المركز الثقافي المغربي، حيث يقع هذا الجهد المعرفي ضمن 238 صفحة وخمسة فصول، مقسمة على أربعة دراسات منفصلة، تتمحور حول الهوية والحداثة والدين واللغة والجغرافيا والمصير المشترك.
وذلك ضمن منهج علمي اعتمده الكاتب في صياغة كتابه، وأشار إليه بكونه: "ينبني أولًا، وقبل كل شيء، على الشك الإيجابي الذي يمكِّن من نقد المسلَّمات، ثم معاودة النظرة المستدامة في الواقع وكيفية ربطها، مما يساعد على تفادي السقوط في الحلقات التأويلية المفرغة"[1].
ولعل النظر المتمعن لهذا المنهج، يبرز كيفية التعاطي مع المسلَّمات انطلاقًا من شك إيجابي؛ وذلك في نقده للمعرفة الحسية والعقلية، وعلى الرغم من أن هذا المنهج يسلم بوجود الحقيقة بمعناها الفلسفي، إلا إنه لا يسلم بها تسليم الاعتقاديين، وإنما يعمل على الاتجاه به إلى نقد هذه المعرفة، ومحاولة اكتشاف بدايتها ومصادرها، وربطها أيضًا مع الواقع، الأمر الذي يمكِّن- حسب الكاتب- من عدم السقوط في الحلقات التأويلية المفرغة، وإنما يمكِّن من الوصول إلى نتائج متقدمة.
وبذلك، فإن هذه الورقة تحاول أن تقدم قراءةً نقدية في هذا الكتاب، مركزة في الوقت نفسه على محورين أساسيين، الأول هو محاولة تحديد التمايز بين مفهومي الدعوة والدعاية، أما الثاني فهو الصراع الفكراني بين جبهتي الدعوة والحداثة.
أولًا: في التمايز المنهجي بين مفهومي الدعوة والدعاية
يأتي هذا الفصل كإطار منهجي، يوضح آليات العمل بين الجبهتين الحداثية والدعوية، ويمكِّن أيضًا من استيعاب ممكنات الدعاية وغلبتها على الدعوة، باعتبارها أحد الجبهات الأكثر تنافسية، والتي أصبحت اليوم تطرح مشروعَها بقوة، على الرغم من صدماتها القوية من الناحية السياسية والدعوية، وبالتالي فإن هذين المفهومين، يطرحان أهميةَ النقاش والتمايز بين روح الدعوة المبنية على النصوص والتراث، وتلبسها لباس الدعاية، وتحولها إلى تنظيمات تعمل ضمن قوالب تأويلية لهذا التراث حسب فهومها له وقدرتها على الاستيعاب والتعبئة.
فالكاتب بهذا، أراد أن يخصص هذا الفصل لإيضاح علاقة الدعوة بالدعاية، باعتبارها أحد مرتكزات جبهة الدعوة (التيارات والتنظيمات الدينية)، ويوضح من خلالها طبيعة تشكل الدعاية وتمظهراتها، وكيف تقف طرفًا في صراعها الفكراني مع جبهة الحداثة.
الدعوة توجه إلى الناس في كلام متعدد الأساليب والنبرات والإيقاعات، أما الدعاية فإنها تعتمد منهجيات مدروسة وقوالب تم التفكير فيها مسبقًا.
كما أن التعاطي مع مفهومي الدعوة والدعاية ضمن هذا الكتاب، لا يقف عند محدوديتهما المفاهيمية، بل يتعداه إلى اعتبارهما إطارًا نظريًّا في فهم التمايز بينهما انطلاقًا من الواقع، أي فك الالتباس بين النص كدعوة وتأويله كدعاية، وأيضًا بين الديني والسياسي، باعتبار ما تلعبه الدعاية من تعبيرات تنظيمية تهدف لفرض أطروحاتها الدعائية. فهذا التمايز إذن يمكِّن من إيجاد مكامن السياسي في الديني والأخير في الحركي والتنظيمي، ويمايز أيضًا بين أصل الفكرة وتسويقها. وبهذا الخصوص بقول الكاتب: "الدعوة توجه إلى الناس في كلام متعدد الأساليب والنبرات والإيقاعات، أما الدعاية فإنها تعتمد منهجيات مدروسة وقوالب تم التفكير فيها مسبقًا"[2]. ما يعني أن الدعاية تسعى لسد الآفاق إلا ما يروق لأصحابها.
ولرفع اللبس أكثر عن العلاقة الشائكة بين المفهومين، فإن الكاتب لم يدخر جهدًا لسرد العديد من الأمثلة التي تبرز محدودية كل واحد منهما، اشتملت على جوانب تاريخية وأخرى سياسية وغيرها، وأبرزت ما يمكن للدعاية أن تقوم به من أجل تمكين روح الدعوة واقعًا، وإلباسه تأويلات الدعاية بآليات الخطاب والبلاغة التي ساهمت في إشعاعها، وما زادها قوة هو ظهور الآليات الحديثة على إثر التكنولوجية، وما أفرزته من وسائل اتصال حديثة، مكَّنت أصحاب الجبهة الدعوية، من تحقيق دعاية مكنتهم من قوة التأثير والإقناع.
وفضلًا عن ذلك، أبرز عبد الله حمودي أيضًا نماذج تفسيرية دالة لهذا التمايز المفاهيمي؛ حيث إن الجبهة الدعوية هي تجسيد لفكرة "الدعوة إلى الله"، وهي تتمظهر في الحركات الإسلامية وتسميات أخرى من قبيل "إسلامي" و"إسلاميون" وغيرها.
وهو الأمر الذي يفرض سؤالَ تسمية الأغلبية الباقية ممن لا تنتمي للمشروع الدعوي، مما يفهم منه بأن احتكار هذه التسمية هو دعاية ووسيلة دعاية، للتفرقة بين عوام الناس وباقي التنظيمات الفكرانية الأخرى الحداثية وغيرها. وفي هذا الصدد يقول حمودي: «إن الدفاع عن الحداثة لا يعني محاربة الدين أو استئصاله، وهل يعقل في بلداننا أن نحصر صفة "إسلامي" على المنتمين لحركات من قبيل "الإخوان المسلمين" و"حركة النهضة" و"حركة التوحيد الإصلاح"… الظاهر إذن هو أن احتكار لفظ "إسلامي" من طرف حركات تتصدر "الدعوة إلى الله"، هو بالأساس دعاية، والدعاية تمكن في هذا الاحتكار نفسه مع أن الشعب مسلم في سواده الأعظم»[3].
ومقابل تجنب الدعاية في التسمية، حاول الكاتب، وهذا اجتهاد يحسب له، كونه أيضًا مساهمة تنظيرية، أمكنته من إبداع مفاهيمي ينزع الدعاية عن مفاهيم "إسلامي" و"إسلاميون" وغيرها، مستبدلًا إياها بما أسماه "الدعويون" وهو مزج بين (الدعوة/الدعاية)، وجاء هذا المقترح بناء على منطلقين، الأول مرتبط بإسلام الشعب في أغلبه، وهو لا ينتمي حركيًّا أو تنظيميًّا لهذه الدعوات، والثاني هو الامتزاج الحاصل بين الدعوة والدعاية. وهو البديل الذي حسب الكاتب من الممكن أن يساهم في تجنب مزاعم التسميات السابقة[4].
وعلى الرغم من هذا التمايز، إلا إن أحد العناصر الأساسية المؤسسة لحركية الدعاية مقابل الدعوة، تعمل على استخدام تقنيات تأثر في النفوس والعقول، وهي تتحدد حسب الكاتب بـ "بناء الصورة"، وهي وسيلة دعاية تتم بوسيلة الموضعة، والتي يتمحور دورها في الإقناع بمشروعية رؤية دينية أو سياسية أو اجتماعية. كما أنه له تمظهرات جلية، كالكنية (أبو قتادة، أبو مصعب، أبو بكر..)، وأيضًا اللباس من جلاليب وعمامات..، وطريقة إطلاق اللحية، سواء تلك الخشينة السميكة، أو الطويلة والمهذبة وغيرها، وأيضًا التفنن في موضة التقوى والخشوع.. إن عملية بناء الصورة في مجال الدعوة، هو وسيلة دعاية أصبحت تنافس اليوم أبطال الألعاب الرياضية والموسيقى وغيرها، وهي عناصر كلها أصبح لها دور اليوم في بناء القناعات والتأثير في النفوس.
إن هذا المحور، يبرز قوة الطرح الدعوي استنادًا على الدعاية في مجابهة قوى الحداثة في المجتمع، وهو الصراع الذي لم تهدأ وطأته منذ سقوط الخلافة ودخول الدول العربية/الإسلامية في صدمة الاستعمار الغربي، ثم التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي أدخلت العالم ضمن عولمة قاهرة أذابت الهويات المحلية. فكان نداء العودة منطلقًا للتنظيمات الدعوية، ولم يكن أمامها سوى الجبهات الحداثية كصادٍّ لحملاتها الدعائية، وهي دعاية متبادلة يسعى كلُّ طرف من جهة إلى فرض أطروحاته من خلالها.
ثانيا: الدعوي والحداثي صراع جبهتين ومصير مشترك
يخصص عبد الله حمودي في كتابه فصلًا طويًلا حول جبهتي الدعوة والحداثة، وهو بذلك يقصد الجبهة الإسلامية من جهة[5]، ثم الجبهة العلمانية بتصنيفاتها الرأسمالية والاشتراكية. محاولًا أن يبرز خصائص كل طرف وما يميزه عن الآخر، ومحاولًا في الوقت نفسه إبداء ملاحظاته عليهما انطلاًقا من قراءة منهجية توفيقية، تعتمد على مفهومين، الأول هو "سياسة الخطاب" والثاني هو "إنتاج الحكم المعرفي"، معتبرًا بأن هذين المفهومين، سيمكنان من إيجاد المشترك بين الجبهتين، وأوجه التوافق الممكنة في اتجاه منظومة سياسية تعالج مخلفات الانفصام، وتعمل على التوفيق بين الجبهتين.
إن سياسة الخطاب المنتهجة من طرف الجبهة الحداثية، بمختلف روافدها الرأسمالية والاشتراكية، قد برزت جراء ممارساتها المتناقضة، حيث إن تركيزها انصبَّ على مجالات التسيير والتدبير والإدارة والإصلاح الاقتصادي والعلم والتكنولوجيا، في حين نجد مقابل هذه الهالة الرهيبة- حسب تعبير الكاتب- هو الحرج الذي وضع فيه قادتها وزعمائها اتجاه القيم والتراث الديني، معتبرًا أن هناك تداخلًا لا شعوريًا بين حياتهم اليومية وهذا الرصيد الديني، الذي قد يشكل مصدر قوة إن تم استغلاله دون الحرج منه.
هذا التناقض إذن، هو أحد الـمُعيقات التي تسببت في تحجيم العلاقة مع الجبهة المقابلة، وبنت لصراع طويل تأجَّجَ ببناء فكري وإيديولوجي زاد من الهوة بين الجبهتين، وغذته نعرة الدعاية. وفي هذا الصدد يقول الكاتب: " إن سر سياسة الخطاب الذي وقفنا على بنيته، يكمن في التناقض بين القوة التي يستمدها زعماء الحداثة من التأهيل العلمي والتقني من جهة، والضعف الذي يسكن موقفهم من القيم الدينية والأخلاقية التي تتداخل مع قيمهم الحداثية من جهة أخرى"[6]. وفي نظره أن هذا التناقض هو ما يغذي الجبهة الدعوية ويقوي خطابها وقدرتها على الاستقطاب الحاد داخل المجتمع.
وفي مقابل الجبهة الحداثية، نجد الجبهة الدعوية، والتي ترتكز سياسة خطابها على ثنائيات تسعى من خلالها إلى تفرقة أطياف المجتمع حسب فهومهما وتأويلاتها الخاصة للمجالين الديني والسياسي، وهي بذلك تضع مفردات من قبيل إسلامي/علماني، تقليدي/حداثي، الأصيل/الدخيل، وغيرها من المفردات، وهذا الخطاب هو أحد المعيقات الأساسية، التي تنبني على استقطابٍ جوهرُه التفرقة وليس البناء. وهو أيضًا مرتبط بوعي قادة الجبهات الدعوية بامتلاك "الحقيقة"، ودخولهم ضمن معترك تأويلي للنص الديني (القرآن والسنة)، بما يوافق آرائهم السياسية ومواقفهم اتجاه خصوهم الحداثيين.
ومن مرتكزات سياسية الخطاب لدى الجبهة الدعوية أيضًا، هو التصدر للدفاع عن "شرع الله" بشكل إطلاقي، وهو تنصيب بشريٍّ لمهمة "سماوية"، وهذا التصدر لا يفتح مجال الحوار والنقاش مع باقي الجبهات إلا وجوبَ الأمر بالطاعة والاتباع، وإن فتح وجب أن تكون مرجعية النقاش نفسها المرجعية الدعوية، مما لا يمكن من بناء توافق معها. ما يشكل مجالًا للتعبئة داخل صفوف المجتمع، ويسهم أيضًا من رفع صبيب التوتر بينها وبين الجبهة الحداثية من جهة، وباقي أطياف المجتمع من جهة أخرى.
إن إنكار المشترك يبدأ بمحاولة رفع الحداثة عن الدعويين، ورفع الأصالة عن الحداثيين، وهو إنكار تتداخل فيه أبعاد الذات مع الآخر.
إن هذا التناقض والاستقطاب بين الجبهتين، يقابله على مستوى سياسة الخطاب وإنتاج الحكم المعرفي قدرة على بناء التوافق، وإيجاد المشترك بينها، وهو ينطلق أساسًا من ضرورة التخلي على الثنائيات المكبلة، وإيجاد أجواء من الحرية تمكن من التناظر والنقاش الإيجابي، حيث إن إنكار المشترك يبدأ بمحاولة رفع الحداثة عن الدعويين، ورفع الأصالة عن الحداثيين، وهو إنكار تتداخل فيه أبعاد الذات مع الآخر، حيث ترى كل جبهة في ذاتها أصالةَ خطابها وحركتها، وتنظر للآخر سواء بالتبعية للغرب أو الغرق في الماضي والموروثات المتجاوزة.
وعلى العموم، فإن الكاتب قد انطلق من هذه الأرضية ليبدأ نقاشه حول المصير المشترك بين كلا الجبهتين، وقد سرد أمثلة كثيرةً في كتابه، تتداخل مع الاجتماعي والسياسي والقيمي والتاريخي وغيرها، ولعل أبرز الأمثلة التي سردها، والتي يمكن إبرازها في هذه الورقة، هو مثال يرتبط بقيمة التراث الإسلامي نفسه وكيفية التعاطي معه.
في ما يرتبط بهذا المثال، فإن تعاطي الدعويين مع التراث مرتبط بصرامة مطلقة، حيث يرون فيه قيمهم ودستورهم في الحياة، ناظرين لما استجد في عصرنا من البدع التي من اللازم تركها، وهو أمر يتناقض مع التراث نفسه، حيث يرى الكاتب أن التراث وعلى مر العصور منذ انتهاء مرحلة النبوة، قد كان منتجون مواكبون لزمانهم، فاجتهاداتهم الفقهية والعقدية واجتهاداتهم الفكرية والثقافية، كانت لصيقة بعصورهم وأزمنة عيشهم، وأيضًا نتيجة احتكاكهم بالآخر المختلف دينيًّا وثقافيًّا. ولعل ترجمة النصوص الفلسفية لقدماء الفلاسفة اليونان، في زمن الخلافة العباسية، يعد أحد أوجه هذا التلاقح الزماني، وارتباط ما كتب وصيغ في حينه بمشكلات ذلك العصر.
وبالتالي فإن التجديد ممكن، وهو تجديد يستوعب ماضيه ويبتكر لحاضره، وقد نضيف هنا الطريقة التي اعتمدها الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري، عند تعاطيه مع مسألة التراث، حيث ابتدع مفهوم القطيعة الإبستيمولوجية لمواجهة دعوات الجبهة الحداثية المنادية بالقطيعة الكلية مع التراث، باعتباره تراثًا سلفيًّا لا يمكن أن يوافق العصر الذي هو منتوج غربي. وهو بذلك حاول التوفيقَ بين الجبهتين، ودعا إلى القطيعة مع القراءة السلفية للتراث، باعتبارها قراءة لاتاريخية، ولا يمكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم للتراث هو "الفهم التراثي للتراث"، وهي القطيعة التي -حسب الجابري- ستحولنا من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث[7]. وهذا المقترب يشبه الطرح الذي جاء به صاحب كتاب الحداثة والهوية.
على سبيل الختم
حاولنا من خلال هذه الورقة، تقديم قراءةً ناقشنا من خلالها أهم الفصول والأفكار التي طرحها الإنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي في كتابه "الحداثة والهوية"، وهو كتاب يكتسب أهميته من طبيعة مواضيعه التي أصبح لها اليوم راهنية قصوى، خاصة بعد مرحلة ما سمي بـ "الربيع العربي"، وما أنتجه من صراع فكري وثقافي وسياسي وديني حادٍّ بين مختلف الجبهات، وشكل أيضًا في دول أخرى مسارات من العنف الشديد الذي احتكم إلى إيديولوجيات عنيفة، فمجيء هذا الكتاب، هو -في نظري- مساهمةٌ في النقاش الفكري الذي يحمل غايةً توافقية، ويميط اللثام عن عديد الممارسات التي تكرس واقع الانقسام والاستقطاب.
كما أن كتاب "الحداثة والهوية"، بما يحمله ضمن طياته من أفكار نقدية، يعد عملًا فكريًّا متزنًا، يحاول صاحبه المرور من خلاله لأَبرزِ المشكلات الأنثروبولوجية/السياسية، التي تعد اليوم قضايا راهنية. حيث إن إشكال الهوية لم يعد معطًى اجتماعيًّا أو ثقافيًّا فقط، بل أصبح معبرًا عن مشروع سياسي ضمن جبهات فكرانية مختلفة، وأصبح هذا المفهوم حاضرًا في الصراع الفكري بين الحداثة والتقليد من جهة، وأيضًا عنصرًا في تعزيز الأبعاد العرقية على حساب الوطن والأمة.
الهوامش
[1] حمودي عبد الله (2015)، الحداثة والهوية: سياسة الخطاب والحكم المعرفي حول الدين واللغة، (الطبعة الأولى) المركز الثقافي العربي، ص:7.
[2] المرجع نفسه، ص: 36.
[3] المرجع نفسه، ص: 45.
[4] المرجع نفسه، ص: 46.
[5] أشرنا سابقًا أن الكاتب يتحفظ على هذا المصطلح، باعتبار الإسلام يشمل الشعب قاطبة عوض فئة محددة منه، وهو يفضل بدل ذلك مصطلح الدعوي أو الدعويين.
[6] حمودي عبد الله، مرجع سابق، ص: 72.
[7] الجابري محمد عابد، (1980) نحن والتراث: قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، (الطبعة الأولى) الدار البيضاء/ بيروت: المركز الثقافي العربي ودار الطليعة، ص 19.