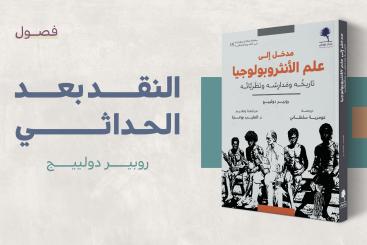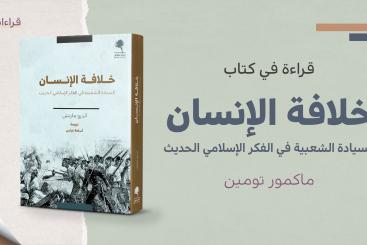نقد العقل العلماني: دراسة مقارنة لفكر زيغمونت باومان وعبد الوهاب المسيري

الحداثة، مشروع غربي، استهدفَ القطيعةَ، مع أسس المجتمع الأوروبي القائمة على: الدين الكنسي، والأعراف والتقاليد التي سادت في القرون الوسطى، وبناء أسس جديدة تدخل أوروبا التاريخ من جديد. وقد ظلَّ التباين في النظر إليها على أشده في الثقافة الغربية وخارجها، حتى وصلنا لمرحلة ما بعد الحداثة، التي تعتبر بمثابة رفضٍ لكثير من الأسس التي قامت عليها الحداثة، والتي تعددت وجهات النظر إليها بين رافض ومؤيد.
ومن أهم صور نقد الحداثة وما بعد الحداثة، استخدامُ النماذج والمجاز. فالنموذج أداةٌ تحليلية ومقولات وخريطة ذهنية، ونسقٌ كامنٌ يُدرك الناس من خلاله واقعَهم ويتعاملون معه ويصوغونه، ورؤية للكون تحوي داخلها صورةً مجازية أساسية، فيصبح التصوير المجازي آليةً أساسيةً في رسم الخرائط الإدراكية ومساعدتنا في فهم كيفية تحوُّل النماذج ورؤى العالم أو حتى تحديها وإسقاطها. ويعدُّ عبد الوهاب المسيري وزيغمونت باومان من أهمِّ نُقاد الحداثة وما بعد الحداثة، ويقوم نقدهما لهما على استخدامِ النماذج كخرائط إدراكية وصور مجازية فيفك شفراتهما، واقتراحِ السبل للتعامل معهما. وقد حفَّز نقدَ المسيري وباومان للحداثة وما بعد الحداثة حجاجُ أبو جبر، على المقارنة بينهما، محاولًا قراءة نقد المسيري في ضوء كتابات باومان، متصديًا لأصعب أنواع التأثير بين المفكرين، ألا وهو التأثيرُ الضمنيُّ.
وحجاج أبو جبر، باحثٌ ومترجمٌ مصريٌّ، يدرّس الأدبَ والنقدَ في أكاديمية الفنون، له بحوث عدة بالعربية والإنكليزية، منها: رسم خرائط العقل العلماني، الحداثة في خطاب عبد الوهاب المسيري، ماكس فيبر ومراجعة العلمانية في مصر، سلطة الخريطة الإدراكية، ومن ترجماته: الحداثة والهولوكوست، وسلسلة السوائل لزيجمونت باومان[1].
والكتاب، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017م، في (336) صفحة من القطع الكبير، ويشمل مقدمةً تتناول أسباب تأليفه، وسبعةَ فصول، بالإضافة لملحقين: مراسلات مع باومان، وحوار مع المسيري. يتناول الأول فكرةَ الخطاب الإسلامي والهولوكوست ودورها في تطور نظرة المسيري وباومان للحداثة. ويحلل الثاني النماذجَ والمجازَ ودورهما في نقد الحداثة. ويركز الثالث على نقد مفهوم التنوير. ويحلل الرابع جذورَ مفهوم الحداثة كحركة غنوصية. ويناقش الفصلين الخامس والسادس عواقبَ الحداثة ومآلات ما بعد الحداثة. ويتتبع السابع، مفهوم الحداثة العلمانية في مرحلة السيولة لديهما. وخاتمة بأهم نتائج الدراسة.
السياق التاريخي
هذا الكتاب، نتاجُ جهد عدة سنوات في قراءة المسيري وباومان وفوجيلين، تطور خلالها موقفُ المؤلف من الكاتبين، وخصوصًا موقفه النقدي من المسيري بعد قراءته لإريك فوجيلين، (ص8). والسياق الذي كتب فيه الكتاب (2006- 2015) يتميز بوفرة الكتابات المتعلقة بنقد الحداثة وما بعد الحداثة، واحتدام الجدال بين المفكرين العرب حول العلمانية والحداثة وما بعد الحداثة، وكانت كتابات المسيري في قلب هذا الجدل.
الأطروحات المركزية للكتاب
يسعى الكتاب، إلى المقارنة بين ثلاثة مفكرين: اثنين غربيين والثالث عربي، في نقدهم للحداثة وما بعد الحداثة، واستكشاف الخرائط الإدراكية للحداثة الغربية والعقل العلماني لديهم، وكيفية صوغ النماذج التفسيرية والصور المجازية والخرائط الإدراكية وتوظيفها في هذا النقد (ص21- 22).
كما تهدف إلى استقبال نقدي جاد يليق بالمسيري ورحلته الفكرية، لا مجرد استقبال محفلي أو توظيف أيديولوجي للنقد الغربي (ص11). بالإضافة إلى تحديد الموقع المعرفي للعقل العلماني وعلاقته بالعقل التوحيدي. ورسم خرائط، تعيننا على الاختيار الواعي بنزعات رؤية الحداثة الغربية للعالم وعواقبها. وتعديل الخريطة إذا اتضح أنها تؤدي إلى الطريق الخطأ أو ربما إلى طريق مسدودة. (ص24- 25).
منهج الدراسة
تستخدم الدراسة، منهجَ النقد الثقافي لتتبع النماذج والصور المجازية التي طرحها فوجيلين وباومان، وأثرها على رؤية المسيري للحداثة العلمانية (ص40). وتجعل السلطةَ الأولى للنصوص التي كتبها المسيري وباومان وفوجيلين، إضافة إلى السياق الثقافي الذي ظهرت فيه هذه النصوص، ومدى التناص بينها، و إبراز مواطن الشبه والاختلاف بينهم في نقد العقل العلماني. (ص20)
مفهوم النموذج كأداة تحليلية
تناول المؤلف فكرةَ الأنموذج عند توماس؛ كون صاحب الفضل في انتشار مصطلحي الأنموذج وتحول الأنموذج، وعند غراهام كينلوخ الذي أبرز خصائص صوغ النموذج كأداة تحليلية؛ لأن لهما تضمينات بالغة الأهمية في فهمنا للتحليل المجازي عند باومان والمسيري (ص55- 58)، كما تناول فكرة الأنموذج وتوظيفها في تاريخ الأفكار عند إريك فوجلين قبل أن يوظفها باومان والمسيري.
ويرى المؤلف، أنه يمكن استخدام الأنموذج وتحول الأنموذج لتأسيس قرابة اختيارية بين نقد باومان وأطروحة "كون" وفهم دعوته للانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة؛ من خلال ظهور أنموذج تفسيري جديد. كما يمكن تتبع هذه القرابة الاختيارية نفسها في مؤلفات المسيري، وإن كان مفهومُ الأنموذج لديه أكثر شمولية من فكرته عند "كون"، لأنه لا يقتصر على العلوم الطبيعية ولا يتجاهل القضايا الأنطولوجية الكبرى للوجود الإنساني. وأنه من خلال دراسة أعمال باومان يمكن تحديد مدى اقتراب فكرة الأنموذج؛ مما جاء في نصوص المسيري التي تتناول نقدَ العقل العلماني، ومدى ابتعاده عنه. (ص56- 59).
المسيري وفوجيلين
يعتبر المؤلف، أن النقد الذي طرحه فوجيلين للعلمانية هو نقطة انطلاق المسيري في تصويره الحداثة الغربية كسردية غنوصية (ص 120). فقد افترض فوجيلين أن الحداثة الغربية أنموذج علماني حلولي بزغ على نحو جزئي في القرن الخامس عشر، وتبلور ووصل إلى مداه وصورته الكلية في القرن العشرين. (ص 126).

عبد الوهاب المسيري
فالرؤية، التي يطرحها المسيري والمصطلحات التي يستخدمها، عدا الجزء الخاص باليهودية، تقترب كثيرًا من التمرُّدِ العام الذي شنه فوجيلين على الحداثة (ص141). كما أن تتبع أثر فوجيلين في المسيري يبين أن فوجيلين هو المرجعية الحقيقية للنماذج التفسيرية الأساسية التي قدمها المسيري للقارئ العربي. (ص125).
بين باومان وفوجيلين
يرى المؤلف مع آخرين، أن نقدَ باومان للحداثة يلتقي في وضوح شديد في كثير من الأوجه مع نقد فوجيلين، الذي رأى الحداثة انتشارًا لنزعة غنوصية، تؤول بالضرورة إلى تاليه الإنسان وإحلال الحياة المسيحية الأخروية في عالم الدنيا… ومن ثم يرى، أن لفوجيلين عظيم الأثر في رسم باومان الخرائط الإدراكية للحداثة بوصفها رؤية كونيةً غنوصية. (ص132)
المسيري وباومان ونقد الحداثة وما بعد الحداثة
يرى المؤلف، أن الخطاب النقدي الذي طرحه زيغمونت باومان كان له عظيمُ الأثر في تفكيك المسيري لمفهومي الاستنارة والحداثة بوجه عام (ص239). فقد استخدم الصورَ المجازيَّةَ لرسم الأسس الأنطولوجية والإبيستمولوجية للحداثة وطموحاتها وعواقبها (ص62).
وذهب إلى أن الحداثة العلمانية أخذت تتطور في صورة متتالية نماذجية، تبدأ بالحداثة الصلبة وتنتهي بالحداثة السائلة، ومن هنا على الأرجح، أضاف المسيري صفتي الصلابة والسيولة لنموذجه التفسيري، وصارت المتتالية تبدأ بالحلولية الكمونية الواحدية المادية العقلانية الصلبة (العلمانية الجزئية)، وأخذت تتحقق إلى أن صارت الحلولية الكمونية الواحدية المادية اللاعقلانية السائلة (العلمانية الشاملة).

زيغمونت باومان
اتخذ باومان، من حركة التنوير نقطةَ انطلاق نقده المجازي للحداثة وطموحاتها. ويتخذ المسيري، مثل باومان، حركة التنوير نقطة انطلاقه في رسم الخرائط الإدراكية للحداثة (ص64، ص66).
ويقوم رسم الخرائط الإدراكية، لنقد الحداثة لديهما على صورتين مجازيتين أساسيتين: "الحداثة الصلبة" و"الحداثة السائلة" عند باومان. أو "المادية العقلانية الصلبة" و"المادية العقلانية السائلة" عند المسيري. (ص40). كما اتخذا من "الطبيعة" مفهومًا ثقافيًّا أساسيًّا، يشكل محتواه الفكري شيفرةَ الحداثة العلمانية (ص110).
وفي حين أدرك باومان عواقب الحداثة، فانتقد مشروع اليوتوبيا الحديثة لأنه قلب اتجاه العلو، وجعل منه صورة مجازية لتخطي حدود الإنسان وانتهاكها، حتى تحول إلى شكل من أشكال الحلولية الكمونية الغنوصية. (ص 135)
ولهذا، دعا إلى سوسيولوجيا نقدية تقوم على تقويض التماثل الظاهري والضمني بين الكائن الحي والمجتمع الإنساني، رافضًا استخدام الأنموذج البيولوجي في التعامل مع الأنساق الثقافية والاجتماعية (ص 46). كما، بحث عن مخرج من تناقضات الحداثة العلمانية، ظنه في فلسفة ما بعد الحداثة بما تُعطيه من فرصة لانفتاح الأنساق المغلقة التي جاءت بها الحداثة العلمانية. (ص192-194). إلا إنه أدرك، أيضًا، مأزق ما بعد الحداثة ومعضلاتها ولا سيما نزوعها نحو التشكيك في جميع الأسس والمرجعيات. (ص194-195) فتخلَّى عن مصطلح ما بعد الحداثة، واحتفى بالحداثة السائلة كصورة مجازية للوضع الإنساني المعاصر، تهيمن عليها صورتان مجازيتان: الجنس والجسد. (ص 241-242).
لكن المسيري،انشغل بالوجه الآخر للتنوير "الاستنارة المظلمة" وحاول كشفَ الأسس المعرفية والأنطولوجية، والأساسَ النماذجي الذي تقوم عليه الحداثة، ووجد في التنوير الأساسَ الفلسفي للعلمانية الشاملة (ص99- 101). وهمَّش الجانبَ المضيء من هذه الحركة تهميشًا كليًّا، وفق تبرير منجي قائم على فكرة الأنموذج وعلاقته بالمجاز، فتحول العصر كله إلى "التنوير المظلم"، والحضارة الغربية إلى التجسيد الحقيقي للأنموذج المادي (ص 103).
لم يقبل المسيري، الخروجَ من مأزق الحداثة العلمانية من خلال تأسيس أخلاقيات بلا ميتافيزيقا، أو بتأسيس أخلاقيات قائمة على ميتافيزيقا حلولية.
وأبرز فشل الحداثة ووعيها الزائف، ولم ير في فلسفة ما بعد الحداثة نسقًا منفتحًا، بل وجدَها منذ البداية نظامًا مغلقًا تمامًا يستبعد كل مظاهر العلو، وهكذا استطاعَ أن يطور رسمه خريطة ما بعد الحداثة من دون شعور بالاضطراب أو الارتباك، ومن دون الحاجة إلى الدورة الطويلة التي دارها باومان ليقدم للقارئ صورة "السيولة". (ص 206). ولم يقبل المسيري، الخروجَ من مأزق الحداثة العلمانية من خلال تأسيس أخلاقيات بلا ميتافيزيقا، أو بتأسيس أخلاقيات قائمة على ميتافيزيقا حلولية. (ص 204- 205). لكنه دعا إلى إحيائية إسلامية توحيدية، بعدما وصل إلى يقين تامٍّ بأن الإسلامَ أكثر العقائد ابتعادًا عن الحلولية وعن توحد الخالق بمخلوقاته (وحدة الوجود) وتتوافق والعلمانية الإنسانية. (ص209).
علم جديد واسمان مختلفان
كرَّس باومان والمسيري جهدهما النقدي، على الرغم من الاختلافات الثقافية والدينية والأيديولوجية بينهما، لكبح غرور العلمانية وكبرها، خصوصًا احتفاءها بعالم كوني متمركز حول الطبيعة، وبرؤية إبستمولوجية للعلوم الطبيعية تتسم بتمركزها حولَ الإنسان.
ويتضمن جهدهما النقدي دعوةً جادة إلى تأسيس علم جديد تحت اسمين مختلفين، وإن كان الهدف واحدًا في الأعم الأغلب: "السوسيولوجيا النقدية" باومان، و"فقه التحيز" المسيري، وكلاهما يدعو إلى هيرمينوطيقا أنطولوجية تتجاوز الثنائيةَ الصلبة التي تقوم على التعارض بين الموضوعية والذاتية. (ص29).
مراجعة لمقولات الكتاب
نناقش هنا أهمَّ النتائج التي توصل إليها الكاتب، وهل اتسقت مع منهجه الذي ألزم به نفسه:
1- يدعي المؤلف أن المسيري وضع شيفرات جديدة تدفع القارئ العربي المسكين إلى رفعِ الراية البيضاء والتسليم في نهاية الأمر، بأن الأنموذج المادي العلماني هو بالفعل الأنموذج المهيمن في الحضارة الغربية، بصورة تبدو كأنها حتمية، فلا يستطيع الإنسانُ الغربي الفرارَ من قبضته (ص70).
فهو لا يتحدث عن عصر التنوير باعتبارِه ظاهرةً ثقافيةً حضارية شهدت اهتمامًا كبيرًا بالفن والموسيقى والشعر والأدب. كما أنه يدعو إلى تجاهلِ الاختلافات الفكرية والمنهجية والثقافية والحضارية كلها بين مفكري الغرب، ويجعلنا نراهم المتلاعبين بالعقول، الذين أسسوا رؤيةً ماديةً إلحادية ونسجوا خيوطَ المؤامرة الكبرى والأنموذج المهيمن (ص75).
نقد المسيري للتنوير، يتلاقى في كثير من الأوجه مع الهجوم العنيف الذي شنَّته الدراساتُ التاريخيةُ في القرن العشرين ضدَّ أنصار الفلسفة المادية.
فتحولت الحداثة الغربية في ذهن القارئ إلى بنًى حتميةٍ جامدة وقوالب ثابتة واستبعاد للنماذج المعرفية الأخرى التي تتجاوز الفلسفة المادية؛ لأنها لا تحظى بنفس الوزن أو الثقل الذي يتمتع به النموذج المادي. (ص 105). وهي ادعاءات يقينية، تخالف ما ألزم المؤلف به نفسَه في منهجه المعلن بعدم التحيز؛ فمن الصحيح أن المسيري كانت لديه على الدوام تحفظاتِه على الحضارة الغربية وانتقاداته لها. ونموذجه التفسيري الناقد لها، يعلن عن نفسه وعن تحيزه في نقدها بصورة لا لبسَ فيها، حتى يحمي المتلقي من وهم الموضوعية المطلقة فيأخذ حذره[2]. لكن ذلك لم يَعْنِ أبدًا أنه يراها شرًّا كلها، بل كان المسيري مدركًا للجوانب المضيئة في الحداثة ونوَّه بها، فـ"إنجازات الإنسان الغربي الحديث، إنجازات إنسانية عظيمة، لا يمكن التقليلُ من قيمتها الإنسانية، فهي إبداعاتٌ مهمة وإسهامات حقيقية للتراث الإنساني، لكنه لا يلحُّ على أهميتها؛ لأن احتمال إهمالها أو التغاضي عنها أو عدم إعطائها حقَّها هو احتمالٌ غيرُ واردٍ على الإطلاق"[3]. كما أن نقد المسيري للتنوير، يتلاقى في كثير من الأوجه مع الهجوم العنيف الذي شنَّته الدراساتُ التاريخيةُ في القرن العشرين ضدَّ أنصار الفلسفة المادية (ص 105)، فهل تكون تلك الدراسات قد قبَّحت الحداثة والعلمانية للغربيين وغيرهم؟
2- ينفي المؤلف، أن يكون المسيري قد أتى بخطاب إسلاميٍّ جديد،لكنه نقل المعرفة النقدية الغربية ووضعَها في السياقين العربي والإسلامي، (ص21). وأن نقده للحداثة محاولةٌ لأسلمتها عن طريق النقد الغربي نفسه (ص31). ومن ثم فهو ليس خطابًا إسلاميًّا جديدًا، ولا هو لغة عربية نقدية جديدة، وإنما هو مجرَّدُ خطابٍ غربيٍّ نقدي أصيل يكشف الوعيَ الزائف للحداثة العلمانية الغربية حتى تضبط مسارَها وتتجاوز تناقضاتها. (ص16).
كما يذهب إلى أن "الأنموذج الإسلامي" أو "المرجعية الإسلامية" يفقد كلَّ خصوصية، لمجرد أن المسيري يؤكد أن جوهرَه هو "أنسنة المعرفة"، وهو ما يجعله لا يختلف كثيرًا عن خطاب مدرسة فرانكفورت. وحتى الاختلاف الذي يذهب إليه المسيري بينه وبين خطاب مدرسة فرانكفورت الذي يصفه بالمأساوي وأن خطابه الإسلامي فمفعم بالأمل – يراه المؤلف كلامًا مثيرًا للضحك، ولا يمكن أن يصدر عن مفكرٍ كبيرٍ مثل المسيري. (ص13). كما أنه لا يرى في تفرقة المسيري بين الخطاب الإسلامي القديم والجديد أيَّ جديد، ولا حتى في قدرة أنصار الخطاب الإسلامي الجديد على إدراك الوجه الآخر للحداثة الغربية (ص13)، ولا تصنيف المسيري نفسه ضمن مستوى الإسلام الفكري الحضاري الثقافي الذي يُطور رؤيةً إسلامية تتعامل مع العصر الحديث ضمن آخرين. (ص 14).
وحتى ما يراه المسيري من أن هذا الأنموذج يسهم في تجديدِ الفقه الإسلامي، فهو يعتبر أن عدمَ حدوث التجديد دليلٌ على فشلِه أو محدوديته، بل إنه يتحيَّز لوجهة نظره تلك بشكلٍ غيرِ علميٍّ؛ حيث يقول أنه حتى لو نجح التجديد، فالفضل يعود للنقاد الغربيين الذين صاغوا فكرةَ الأنموذج ونقلها المسيري عنهم. والتناقض هنا واضحٌ والتحيُّز ضدُّ الذات كما يسميه المسيري. وهي نتائج في غاية الخطورة – إن صحت – لأنها تهدم جهدَ المسيري كله، فلم يكن خطاب المسيري مجردَ صدًى للنقد الغربي للحداثة، فقد ابتكر نموذجَ التكامل الفضفاض غير العضوي، الذي يحاول أن ينسلخ عن الحداثة الغربية ليستلهم التراث ويولد منه حداثةً جديدةً ونظمًا في الإدارة وتحريك الكتلة البشرية بأسرها[4].
الخطاب الإسلامي الجديد خطابٌ جذريٌّ توليديٌّ استكشافيٌّ، لا يحاول التوفيقَ بين الحداثة الغربية والإسلام، بل يبدأ من نقد جذري للحضارة الغربية الحديثة.
وفيما يتعلق بالاستفادة من النقد الغربي للحداثة، فالمسيري يدعو لإمكانية الاجتزاء من الآخرين؛ استيراد الأفكار والأشياء، وهو فعل واع يقوم به الشخص الواثق من نفسه ومن هويته الإدراكية، ويقف على أرضيته الخاصة، وله تحيزاته الخاصة، ولكنه يزن ما يستورده بميزانه، ويعيد صياغته بما يتفق مع معاييره.والخطاب الإسلامي الجديد "خطابٌ جذريٌّ توليديٌّ استكشافيٌّ، لا يحاول التوفيقَ بين الحداثة الغربية والإسلام، بل يبدأ من نقد جذري للحضارة الغربية الحديثة، ويحاول اكتشافَ معالم المنظومة الغربية الحديثة، باعتبارها رؤيةً متكاملة للكون، ويعود إلى المنظومة الإسلامية بكلِّ قيمها وخصوصيتها الدينية، والأخلاقية والحضارية ويستبطنها ويستكشفها، ويحاول تجريد نموذج معرفي يتمكن من خلاله من توليد إجابات على الإشكاليات التي تُثيرها الحداثة الغربية، وعلى أية إشكالات أخرى جديدة"[5]. فالخطاب الإسلامي الجديد، ليس الماركسية كشكل من أشكال نقد الحداثة الذي نبعت منه مدرسة فرانكفورت وعمقته، وليس اليسارَ الجديد، وليس الأدب الرومانسي الذي كان احتجاجًا على الحداثة وصار أكثر عمقًا وجذرية مع الأدب الحديث، كما أنه يختلف عن أشكال نقد الحداثة في العالم الثالث[6].
3- يدعي المؤلف، أن المسيري أصرَّ على تجاهل التاريخ الغربي لمصطلح الأبستمولوجيا؛ إذ يجعل منه مرادفًا للأنطولوجيا والميتافيزيقا (ص70)، فهو يقلب الرؤية الغربية وأنطولوجيتها التي تتحدد معرفيًّا في مقابل الرؤية المعرفية الإسلامية التي تتحدد أنطولوجيًّا (ص 71)؛ إذ يرتبط هذا التعريف مباشرةً بإمكان التحيز الثقافي والتوظيف الأيديولوجي لفكرة الأنموذج، وإن كان المسيري ينطلق من المسلمات الأنطولوجية والأبيستمولوجية للتصور الإسلامي؛ من خلال تأكيد استحالة الفصل بين الجوانب الإدراكية المعرفية للإنسان الباحث عن المعرفة، وباقي جوانب الوجود الإنساني من النواحي الوجدانية والتراثية والذاتية والشعورية والخيالية (ص 65).
وهو نقد غريب؛ فالمسيري يستند لمرجعيته الإسلامية ليبني من خلالها نموذَجه المعرفي ومسلماته، فهل مخالفته للنموذج المعرفي الغربي ما يُشينه أم ما يدعو للاحترام؟ أم تكون المجادلة بخصوص رؤيته ومدى صحتها منطقيًّا وليس بمقدار قربها أو بعدها عن التاريخ الغربي للمصطلح الذي دعا لفقه مخصوص للانعتاق منه.
4- أما أخطر مقولاته التي تهدم منهجَه الذي ألزم به نفسه، ما يخوض فيه في موضوع التأثير والتأثر، فهو يقول عن تأثر المسيري بباومان في وضع نموذج "الجماعة الوظيفية"، يغلب الظن أن المسيري نسج الخيوط الأولى لأنموذج "الجماعة الوظيفية" وتطبيقه على الجماعات اليهودية بفضل كتاب الحداثة والهولوكوست، وإن أشار دائمًا إلى دور كتابات أخرى سطرها ماركس وسومبارت وزيمل وفيبر. لكن لا غرابة في ذلك؛ لأن باومان نفسه تأثر بكل هؤلاء، وتشكلت رؤيته للحداثة والمسألة اليهودية من خلال أعمالهم (ص51).
كما يذهب، إلى "أن الأرجح أن المسيري قد تعرف على فكر فوجلين في الستينيات أو السبعينيات، عندما كان يعد لأطروحتي الماجستير والدكتوراه بالولايات المتحدة (1963- 1969)، أو عندما كان يعمل مستشارًا ثقافيًّا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة (1970- 1975)، (وهو تاريخ خطأ، فالمسيري عمل في الجامعة العربية خلال الفترة 1975- 1979). وهي ترجيحات مبهمة لا دليل عليها، ثم يتمادى في ترجيحاته وتخميناته، فيقول: "أو ربما أعدت إحدى مساعداته الباحثات أو أحد مساعديه الباحثين بحثًا للمسيري عن أطروحة فوجيلين من دون الإشارة إليه وإلى المصادر والمراجع". وهي تخمينات لا أساس لها ولا تثبت للنقد، وقد قضى المؤلف في مكتب المسيري عامين، وعرف كيف يعمل، واطلع على مكتبته وكتاباته، فلِمَ لَمْ يسأله عن ذلك؟
كما أن آخر كلامه يناقض أوله، فلو أن باومان تأثر بهؤلاء، فلِمَ لا يكون تأثرُ المسيري بهؤلاء أكبرَ من باومان؟ مع الأخذ في الاعتبار أن المسيري له سرديته المتعلقة بتكوين النماذج التي يهدرها المؤلف لمجرد غلبة الظن، والظن في هذه المواضع من المقارنات العلمية لا يغني عن الحق شيئًا.
5- يدعي المؤلف، أن مصطلح "المتتالية" أوقع المسيري في حتمية نماذجية تفترض الانتقالَ الحتميَّ من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة، وهو ادعاءٌ لا دليل عليه أيضًا، فالمسيري تنبه للأمر، وطرح أن المتتالية ليس شرطًا أن تتحقق تمامًا (ص69)، وأن اللحظة النماذجية قد تحدث فجأة قبل اكتمال المتتالية، وقد لا تحدث أبدًا، لكن افتراضها مهمٌّ لأنه سيمكن الباحث من تخيل ما هو قائم وما يمكن أن يكون[7]. فالنموذج احتمالي وفرضية منفتحة، تحاول أن ترصد ما هو كامن، لترى هل سينتقل من عالم الإمكان إلى عالم التحقق أم لا؟[8]
6- يدعي المؤلف، أن أحدًا (لم يحدده) لن يقبل بدفاع المسيري عن العلمانية الجزئية، مهما حاول أن يثبت أنها لا تعارض الرؤية الإسلامية (ص69)، بعدما رسَخ في ذهن القارئ العربي والمسلم حقلٌ دلالي ضخم، يضم الجوانب المظلمة للعلمانية في سياقها الفلسفي والتاريخي والاجتماعي. وهو دليل على أن المؤلف لا يفرق بين رؤية المسيري للعلمانيتين أو يتجاهل ذلك.
أما عن ذهابه إلى أن أعمال المسيري، لن تستطيع، مهما حاولت، أن تقنع القارئ العربي أو المسلم بإمكان قبول العلمانية الجزئية، بعدما صورها كأنها علمانية مقيتة مظلمة ستتحول لا محالة إلى العلمانية الشاملة (ص19) – فهو مردود عليه بأن آحادًا كُثرًا قد قبلوا مفهوم المسيري عن العلمانية، وهو ما يُظهر استقبالَ الجماعة البحثية وخصوصًا دعاة الخطاب الإسلامي الجديد[9].
7- يدعي المؤلف، أن المسيري حاول التأسيسَ لفكرة "الإسلام العلماني"، وهو ما لم يقله المسيري إطلاقًا، وإن أكد أنه لا تعارض بين العلمانية الجزئية والرؤية الإسلامية، فالمسيري دعا إلى حداثة إنسانية جديدة من خلال اكتشاف ذاتنا مرة أخرى، ومن خلال توليد بعض الأبعاد الأخلاقية والدينية التي يمكنها أن تتعايش مع هذه الحداثة.
وتطوير منظومة تحديث إنسانية إسلامية، هدفها ليس التقدم المستمر وإنما التوازن مع الذات ومع الطبيعة. حداثة تتبنى العلمَ والتقنيةَ ولا تضرب بالقيم أو بالغائية الإنسانية عرض الحائط، تنمي وجودنا المادي ولا تنكر الأبعادَ الرُّوحية لهذا الوجود[10].
8- يعتبر المؤلف، أن المسيري لم يهد أيًّا من أعماله إلى باومان، ويعده علامة استفهام كبرى، ويرجعها إلى فهم المسيري عقليةَ الاستقبال العربي التي لا تطمئن إلى ما ينتجه أعلام الجماعات اليهودية، حتى لو كان فكرًا نقديًّا يقاوم العلمانية المتطرفة والإمبريالية الرأسمالية والصهيونية الاستيطانية الاستعمارية (ص14-15).
وهو أمر لا يستقيم مع مفكر عقلن رؤيتَنا لليهود، ودعا إلى أنسنتهم واتُّهم بالتحيز والدعوة لهم من البعض، فهل بعد إطرائه له ولغيره من المفكرين الغربيين وأصدقائه في أعماله وسيرته الفكرية، يستنيم لضغط عقلية الاستقبال العربي التي لا تطمئن لما ينتجه أعلام الجماعات اليهودية؟! وهو الذي صدم هذا العقل برؤيته لليهود واليهودية والصهيونية، وهو الداعي لإنسانية عالمية يتحالف فيها كلُّ أبناء آدم ممن يُؤمنون بوجود مرجعية متجاوزة أيًّا كانت لخلق حداثة إنسانية جديدة؟

إريك فوجيلين
9- اعتقد أن إعادة النظر في عنوان الكتاب ليضاف إريك فوجيلين للمقارنة، وكذلك ترتيب فصول الكتاب لتبدأ بفوجيلين وصولًا لباومان بحثًا عن تسلسل منطقي لحجته ستكون أفضل، وهو ما التزمنا به في هذه المراجعة، خاصة أن المؤلف له دراسة طويلة عن علاقة المسيري بفوجيلين[11].
10- يدعي المؤلف، أن المسيري هو من أعاد صوغَ مبادئ حزب الوسط، وهو أمر غير صحيح بالنسبة لكل من انخرطوا في تجربة هذا الحزب قبل ثورة يناير. فقد كتب المسيري مقدمةَ برنامج المحاولة الثالثة في عام 2004، وشارك في ورشات العمل التي تناقش وتصيغ البرنامج، وساهم في صياغة أجزاء منه خاصة في مجال الثقافة والفنون[12]، لكنه لم يعد صوغ مبادئه.
11- وأخيرًا، هل استطاع أبو جبر أن يلتزم بمنهجِه الذي أعلنه، لا أعتقد، لقد تحيَّز أبو جبر تمامًا لفكرة نقل المسيري لأفكاره من باومان وفوجيلين ومدارس النقد الغربي للحداثة، ونفى عنه أيَّ أصالة أو تجديد، كما أنه لم يقدم المسيري كما يجب أن يقدم، بعد أن انتهى إلى عكس ما يريد، وعكس ما التزم من منهج، بعد أن أوحى لكل من لم يطلع على أعمال المسيري أن يتشكك في أصالته، كما أنه في انشغاله بإثبات انتحال المسيري أفكار غيره نسي أن يحدد الموقع المعرفي للعقل العلماني وعلاقته بالعقل التوحيدي. ورسم خرائط تعيننا على الاختيار الواعي بنزعات رؤية الحداثة الغربية للعالم وعواقبها. وتعديل الخريطة إذا اتضح أنها تؤدي إلى الطريق الخطأ أو ربما إلى طريق مسدودة لعقلنا العربي اليوم، كما ادعى في بداية أطروحته.
خلاصات عامة
قليلة هي الأعمال التي تدعوك لقراءتها مراتٍ عدة، والتي تفتح طرقًا جديدة للفكر ومجالات رحبة للبحث لنقد الأفكار السائدة والمهيمنة على المجتمعات. وكتاب حجاج أبو جبر من هذه الكتب؛ فهو كتاب سلس اللغة، أنفق فيه صاحبه سنوات عديدة في متابعة علاقة التأثير والتأثر بين المسيري وبعض رواد نقد الحداثة الغربيين، مما يجعله حجرًا كبيرًا في بحيرة فكرنا الراكدة تدفعها للحركة والفوران، من خلال الدعوة إلى فهم تطورات فكرنا العربي في ضوء تأثره بالفكر الغربي.
ومن ثم، فإنه يحتاج لتفاعل يليق به ومناقشة استنتاجاته، واستقباله استقبالًا نقديًّا جادًّا بعيد عن الاحتفال الكرنفالي ممن يرفضون الفكر الإسلامي، أو النقد المتشنج ممن يؤمنون بهذا الفكر.
كما أن أعمال المسيري وباومان وفوجيلين، تحتاج إلى قراءة ناقدة في عالمنا العربي؛ لأنها شديدة الأهمية للحظتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية المعاصرة، لمعاصرتها الكبيرة لما نعانيه من مخاضٍ أليم للخروج من نص التخلُّفِ المغلق إلى بُحبوحة المحجة البيضاء المفتوحة على الله والإنسان والطبيعة.
الهوامش
[1] راجع الرابط التالي: https://bit.ly/2Vb5FoT
[2] المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1999م، ج1، ص111.
[3] حرفي، سوزان. حوارات الدكتور عبد الوهاب المسيري: العلمانية والحداثة والعولمة، دمشق: دار الفكر، ط1، 2009م ص199-200.
[4] المرجع السابق، ص 164.
[5] مقال معالم الخطاب الإسلامي الجديد، على الرابط التالي:
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=479:m3…
[6] المسيري، عبد الوهاب. العالم من منظور غربي، القاهرة: دار الهلال، ط1، 2003م، ص173-174.
[7] المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج1، مرجع سابق، ص117.
[8] المرجع السابق، ص133.
[9] راجع في ذلك كتابات هبة رؤوف عزت سيف الدين عبد الفتاح وعبد الله إدالكوس وغيرهم.
[10] حرفي، سوزان. حوارات الدكتور عبد الوهاب المسيري: العلمانية والحداثة والعولمة، مرجع سابق، ص220.
[11] أبو جبر، حجاج. الحداثة والمجاز.. مقاربات، مجلة عالم الفكر، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجلد 43 (أبريل- يونيو 2015)، ص90-132.
[12] http://islamion.com/news/1977-2017 -شخصيات-عرفتها-د-المسيري-والسياسة-4