الأرض والوقف في الفقه المالكي: (فتح العلي المالك) نموذجًا

الوقف هو أحد الأنظمة التي نشأت في كنف الحضارة الإسلامية، وكان محكومًا طوال تاريخه بقواعد الفقه. والفقهاء هم المسؤلون عن مراعاة تطبيق النُّظَّار لهذه القواعد، وإليهم المرجع في بيان الجائز وغير الجائز من التصرفات الوقفية، ومنذ مطلع القرن التاسع عشر شهد النظام الوقفي تغيرات عدة قامت بها الدولة من أجل تحديثه ليتوافق مع بنيتها الحداثية، فتحول الوقف خلال عقود قليلة من مؤسسة كلاسيكية بسيطة إلى إدارة بيروقراطية معقدة ضمن الجهاز الإداري للدولة، وأشرف عليه موظفون معينون، وصدرت اللوائح والقوانين المنظمة للعمل به وفقًا للقواعد البيروقراطية الحديثة، واستُبعد العلماء شيئًا فشيئًا من إدارة الشأن الوقفي.
خلَّفت السياسات الحكومية آثارًا عميقة في بنية الوقف، وارتباكًا للواقفين والمستفيدين، وهو ما يتضح من التساؤلات التي رُفِعت إلى علماء الشريعة حول مدى مشروعية هذه السياسات، وحول أشياء أخرى تتعلق بملكية أرض الفلاحة وجواز وقفها، وهي مسألة على قدر من الأهمية؛ لأنه وفقًا للمنظور الفقهي فإن معظم البلدان فتحت عنوة وليس للفلاحين تملكها أو توريثها أو وقفها أو غير ذلك من التصرفات الدالة على الملكية، وإنما يحق لهم زراعتها والإفادة منها، وهو ما يعرف بحق الانتفاع، واستمر العمل بهذا التقليد الفقهي لأزمنة طويلة في مصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية، إلا أن الفقهاء المتأخرين وخصوصًا المالكية أعادوا النظر في هذه المسألة تحت تأثير المتغيرات الحاصلة في البنية الاجتماعية، فأجازوا للفلاحين تملك أرض الزراعة ودللوا على ذلك بأدلة واقعية وبضرورة اتباع المصلحة.
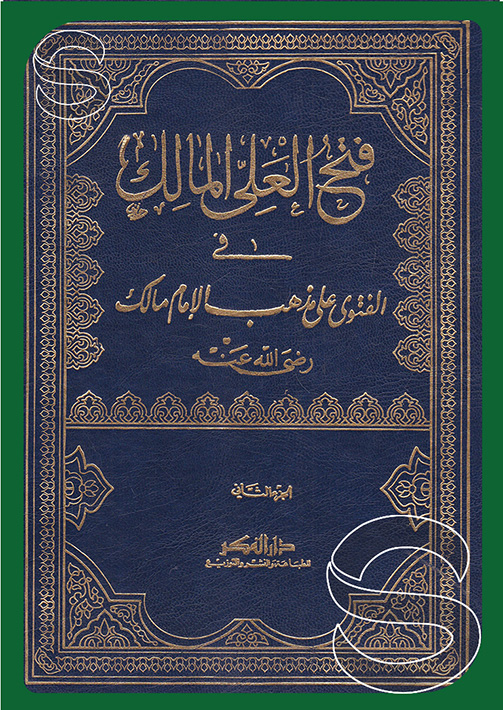
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
وتفتح هذه الإجازة المجال أمام طرح قضية الاجتهاد، حيث تنتشر فكرة جمود الفقه الإسلامي منذ القرن الرابع الهجري، وركون الفقهاء إلى التقليد وتقاعسهم عن الاجتهاد، ورغم أن بعض الدارسين قد فند هذا الادعاء، وأبرزهم وائل حلاق، إلا أني خلال البحث أحاول فحص هذا الادعاء بشقَّيه: جمود البنية الفقهية، وتنكب الفقهاء عن الاجتهاد، وذلك من خلال باب الوقف في المذهب المالكي تطبيقًا على مجموعة فتاوى الشيخ محمد عليش المالكي (ت:1882م) المعنونة: (فتح العلي المالك في الفتوي على مذهب الإمام مالك)، وهي مصدر مهم للتعرف إلى موقف الفقه المالكي من قضايا الوقف قديمًا وحديثًا، ورغم ارتباطها بالحالة المصرية في القرن التاسع عشر إلا أن صاحبها قد ضمنها نصوص المذهب ونقاشاته في القضايا المطروحة ورصد تطوراتها عبر القرون، وعلق عليها بالترجيح أو التضعيف، فأضحت مرجعًا لمعرفة التطورات التي طرأت على المذهب في القرون المتأخرة، وليس هذا فحسب، بل إن هناك عوامل تجعلنا نقف أمام هذه المجموعة دون غيرها من المصادر المالكية، وهي:
أولًا: انتماؤها إلى حقبة تاريخية مهمة شهدت متغيريْن كان لهما أبلغ الأثر في مصر والعالم الإسلامي بأسره وهما: تأسيس الدولة القومية الحديثة في مطلع القرن التاسع عشر، وانتهاجها سياسة التحديث التشريعي والمؤسسي، وهي تعد مثالًا جيدًا يوضح لنا كيفية تعاطي الفقيه الكلاسيكي للوهلة الأولى مع هذيْن المتغيريْن.
ثانيًا: يُصنَّف الشيخ عليش -عادة- وفقًا لثنائية التقليد والاجتهاد التي حكمت تاريخ الفقه الإسلامي، وبمقتضاها يقع الشيخ على رأس تيار التقليد الفقهي في مقابلة تيار الاجتهاد الذي تزعمه غريمه الشيخ محمد عبده (ت: 1905م)، ومن خلال الفتاوى نفحص جدوى هذه الثنائية التي حكمت أنظار الدارسين للفقه الإسلامي، ذلك أن الشيخ عليش من خلال فتاويه لم يلتزم التقليد المطلق كما نعتقد، بل غلب الاجتهاد في بضع فتاوى من أشهرها فتوى تمليك الأرض الزراعية للفلاحين، وفتوى إجازة العمل بالتلغراف، وهي من أوائل الفتاوى الصادرة في هذا الشأن، إن لم تكن أولها لصدورها عام 1865م.
ثالثًا: يمكن النظر إلى سؤال الفتوى وإجابة المفتي في ديباجتهما وبنيتهما الفكرية بوصفهما خطابًا موازيًا لخطاب السلطة الرسمي، فالشيخ لم يتبوأ منصبًا حكوميًّا، وظل متمتعًا باستقلالية مواقفه ومحتفظًا بخصائص الخطاب الشرعي الكلاسيكي الذي لا يعتمد مفردات خطاب الدولة ولا يتقيد بها، والتساؤلات التي رُفِعت إليه هي خطاب شعبي صاغه العقل المصري الذي كان يئن من وطأة الدولة الحديثة المهيمنة، وهي تختلف عن الفتاوى التي تُرفع أمام المفتين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين التزموا في إجاباتهم بخطاب الدولة المصرية، وعمدوا إلى تعديل صيغة سؤال الفتوى وفقًا للصيغ القانونية لتصبح فتوى قضائية، وهكذا تغدو فتاوى الشيخ عليش مرآة ونافذة على تاريخ مصر الاجتماعي خلال هذه الحقبة.
ومن الناحية المنهجية، يمكن تصنيف فتاوى الشيخ عليش الوقفية ضمن فئتيْن: فئة الفتاوى السياسية والحداثية، وفئة الفتاوى الاجتماعية والعرفية، ومنهجنا في التعاطي معها يتراوح بين: تحليل بنية الفتوى وردها إلى مكوناتها الأولية، والإشارة إلى الأدوات المستخدمة في الإجابة، وبيان علة التحريم أو التحليل حال عدم التنصيص عليها، وفتح باب المقارنة المذهبية مع فتاوى الشيخ المهدي العباسي أحيانًا (لإعطاء صورة أكثر شمولًا عن طبيعة باب الوقف في الفقه الإسلامي؛ ولأنها تُمثل المذهب الحنفي مذهب الدولة الرسمي الذي عليه مدار عمل القضاة)، وأخيرًا الحفاظ على الصيغ والتعبيرات الأصلية للنص الإفتائي؛ لأنه محمَّل بمدلولات تاريخية واجتماعية وقانونية يتعذر التعبير عنها بصيغ أخرى.
ونسعى من وراء هذا كله إلى الإجابة عن التساؤلات التالية، كيف تأثر الوقف بنشوء الدولة القومية الحديثة؟ وكيف كانت استجابة المفتي لكل من المستجدات السياسية والحداثية والمتغيرات الاجتماعية؟ هل التزم المفتي التقليد في مواجهتها أم جنح إلى الاجتهاد؟ وما صيغة هذا الاجتهاد -إن وجد- وهل هو انزياح يحدث في إطار الآراء السابقة أم خروج عنها إلى آراء جديدة اتباعًا للمصلحة؟
الشيخ محمد عليش وكتابه (فتح العلي المالك)
وُلد الشيخ محمد عليش في حارة الجوار القريبة من الجامع الأزهر عام 1217هـ/1802م، وهو ينحدر من أصول مغربية مثل كبار شيوخ المذهب المالكي في مصر حسن العطار ومحمد الأمير، التحق بالأزهر عام 1816م، ودرس على يد الأشياخ محمد الأمير، ومصطفى البولاقي، وجلس للإقراء حوالي عام 1830م وظل يمارس التدريس ولم يُشرك معه أي عمل آخر طيلة حياته، واختير من قبل شيوخ المذهب ليصبح مفتي السادة المالكية بالديار المصرية وهو أرفع منصب يمكن أن يشغله فقيه ذلك الحين، واستمر في منصبه حتى وفاته عام 1882م.
ترك الشيخ عليش عددًا من المصنفات أحصاها ولده في ترجمته له فبلغت سبعًا وعشرين مصنفًا، أشهرها شرحه لمختصر خليل، وشرحه على مجموع الشيخ الأمير، وفتاويه المعنونة (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) التي تقع في مجلديْن. وبفضل هذه المؤلفات، يصنفه مؤرخو الفقه الإسلامي ضمن أهم فقهاء القرن الثالث عشر الهجري، إذ يذهب الحَجْوي الثعالبي إلى أنه يناظر الشيخ كنون عالم المغرب ومعاصره ونظيرهما الإمام الشوكاني في اليمن والألوسي في العراق[1].
يبدو أننا أمام مجموعة إفتائية مفتوحة أو بعبارة أخرى حوارية ممتدة تُعبر عن رأي المذهب المالكي في مسائل الوقف، وليس أمام تساؤلات رُفِعت إلى الشيخ عليش وأجاب عنها استنادًا إلى المذهب.
يشغل باب الوقف الصفحات من (237-267) من المجلد الثاني في (فتح العلي المالك)، وهو يتميز من جهتيْن، الأولى: تضمنه فتاوى بعض كبار مفتي المالكية من المصريين في القرنيْن الثامن عشر والتاسع عشر كالأشياخ: أحمد الدردير ومحمد الأمير والعدوي ومصطفى البولاقي، وهذه الفتاوى لها أهميتها، إذ تسمح لنا بتتبع اجتهادات الفقهاء المالكيين في مسائل ملكية الأرض والخلو وإيجار الوقف لمدد طويلة، وتُبيّن أن ما ذهب إليه الشيخ له أصل في المذهب. والثانية: حرص الشيخ على التعليق على كل مسألة بما ورد فيها من النصوص المعتمدة داخل المذهب، ولم يكتف بهذا، وإنما أضاف بعض النصوص المتعلقة بالوقف وهي: رسالة «ذكر ما لأهل المذهب من الخلاف في العقار الموقوف» لمؤلفها الحطاب المكي[2]، وفصل في (شروط صحة الخلو) من ضوء الشموع للشيخ الأمير[3]، وهكذا يبدو أننا أمام مجموعة إفتائية مفتوحة أو بعبارة أخرى حوارية ممتدة تُعبر عن رأي المذهب المالكي في مسائل الوقف، وليس أمام تساؤلات رُفِعت إلى الشيخ عليش وأجاب عنها استنادًا إلى المذهب.
ويتسم منهج الشيخ الإفتائي بخصائص مميزة من أبرزها:
- الميل للإسهاب ودعم الجواب بالنصوص الفقهية وثيقة الصلة بواقعة السؤال، والتعامل الإيجابي مع هذه النصوص بالشرح أو التعليق أو التلخيص.
- الاعتماد على مصادر كثيرة ومتنوعة، فقد جمع بين الاقتباس من أمهات كتب المذهب كالمدونة، ومؤلفات المتأخرين كالمجموع وضوء الشموع.
- الدراية التامة بأقوال المذاهب الفقهية، ومقارنتها المستمرة بأقوال المذهب المالكي، وهو لا يقطع معها إذ يُقر ما توصل إليه مفتو المذاهب الأخرى إن كان صحيحًا في المذهب.
ظهرت شخصية الشيخ في الفتاوى ولم تختف وراء النقول، فكثيرًا ما علق على فتاوى الآخرين بقوله (أقول) أو (قلت) ثم يشرع في بسط رأيه في المسألة مع التعليل، كما كان يُطلق العنان لآرائه الذاتية لتتسلل إلى النص الإفتائي دون مواربة[4].
ويبدو الطابع الفريد لباب الوقف في (فتح العلي المالك) إذا ما قورن بكتاب الوقف[5] ضمن (الفتاوى المهدية) لمفتي الديار المصرية محمد العباسي المهدي الحنفي (ت:1897م) ورغم أن كتاب الوقف بها يقارب الأربعمائة صفحة إلا أنه يتوزع حول بضعة أنساق/تساؤلات محدودة مغلقة يدور حولها ولا يشذ عنها، وهي: تفسير شروط وقفية تفسيرًا قانونيًّا، كيفية توزيع غلة الوقف، دواعي عزل ناظر الوقف وشروطه، رفع يد مغتصب للوقف، إبداء الرأي القانوني في القوانين والمنشورات التي تصدرها نظارة الأوقاف. أما باب الوقف في فتح العلي المالك فيدور حول تساؤلات مغايرة مثل: تملك الفلاحين أرض الزراعة وصحة وقفها، والدولة والاستيلاء على الوقف وإثقالها كاهل الواقفين بالضرائب، ومشروعية بعض التصرفات الوقفية من: بيع واستبدال وإيجار الوقف لمدد طويلة، وما إلى ذلك من موضوعات تعطي صورة واقعية عن وضعية الأوقاف المصرية، والإشكالات التي طرحتها على الفقه الإسلامي في مرحلة صعود الدولة الحديثة.
حيازة الأرض في المنظور الفقهي: مراجعات واجتهادات
قُبَيل دراسة موقف المذهب المالكي من تملك الأرض، تجدر الإشارة إلى أن أرض مصر في أواخر الحقبة العثمانية كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأراضي الخراجية: وهي الأراضي التي تُمنح على هيئة حصص التزام لبعض الملتزمين، وتنقسم بدورها إلى نوعيْن:
- أرض الفلاحة وهي تُشكِّل معظم الأراضي وتوزع على الفلاحين لزراعتها، وتُعرَف أحيانًا باسم: «أرض الأثر»، ولم يمتلك الفلاحون أو حتى الملتزمون هذه الأرض بل كانت ملكًا للسلطان -ولي الأمر- يقوم بتوزيعها على الملتزمين نظير دفع أموال للخزانة وهم يوزعونها بدورهم على الفلاحين، ويحق للفلاح الاستمرار في الأرض التي وزِّعت عليه ما دام قائمًا بسداد ما عليها من الضرائب، وله حق الانتفاع بها بنفسه أو تأجيرها أو رهنها لمدة قصيرة إذا دعته ظروفه إلى ذلك، غير أنه لم يكن مسموحًا له أن يورثها أو يوقفها. ويسمى النوع الثاني (الوسية) ويُمنح للمتلزم نظير خدماته، وهذا القسم مُعْفى من الضرائب، ويقوم الفلاحون بزراعته للملتزم على سبيل السُّخرة أو ربما لجأ إلى تأجيره لهم نظير قدر معلوم من المال.
2- أراضي الرزق: وتُمثِّل مساحات واسعة من الأرض في جهات عديدة، أنعم بها الحكام السابقون على بعض الوجهاء وكبار الموظفين والملتزمين، وكان لأصحابها حق الانتفاع والتصرف فيها بكافة وجوه الانتفاع وتوريثها، ولما كانت هذه الأراضي معفاة من الضرائب مال الملتزمون إلى وقفها حماية لها وضمانًا لعدم خروجها من بين أيديهم أو بين يدي ورثتهم، وفي المقابل لم يجنحوا إلى وقف أرض الفلاحة إلا نادرًا، وهكذا زادت أراضي الرزق حتى صارت بعض القرى موقوفة بأكملها، والبعض الآخر وُقِف نصفها أو ما يزيد.
3- أراضي الإطلاق: وهي أرض معفاة من الضرائب مخصصة للباشا والبكوات، وستعرف فيما بعد باسم الجفالك، وتؤول إلى الأسرة العلوية المالكة[6].

محمد علي
وما يهمنا هنا هي أراضي الرزق الموقوفة، فمنذ عام 1809م صدرت سلسلة أوامر من محمد علي (1805-1848م) بالكشف عن الرزق الموقوفة في النواحي المختلفة، وضم الزائد منها إلى أرض الفلاحة الأميرية، واستولى بذلك على مساحات شاسعة في صعيد مصر مرصدة على المساجد والخيرات والبر والصدقة، وعلل ذلك بأن ابنه إبراهيم كشف على هذه المساجد فوجدها خرابًا والنُظّار يأكلون الإيراد، وانتهى الأمر بأن من كان لديه سندٌ يُثبت ملكيته للرزقة تم تعويضه بمعاش سنوي يساوي نصف أجر رزقته، أما من لا يملك سندًا أو لم يجدده فتم الاستيلاء على رزقته دون تعويض[7]. وفي 1837م صدر قرار يمنح أصحاب الرزق حق توريثها، ثم تلاه قرار آخر بعد خمس سنوات يُجيز وقفها، لكن في عهد محمد سعيد باشا (1854-1863م) أُثير الموضوع مجددًا حين سعت الدولة إلى إبطال قرارها السابق والاستيلاء على الرزق[8]، وقد وجد ذلك صداه في فتوى رُفِعت إلى الشيخ عليش ونصها كالتالي:
"(ما قولكم) في الرزق المحبسة التي أبطل الحاكم تحبيسها وردها للديوان، هل لا يُعتبر إبطاله وتكون باقية على تحبيسها لا تباع ولا ترهن ولا تورَّث أم كيف الحال، أفيدوا الجواب"[9].
وجاءت إجابة الشيخ عنها مفصلة ووافية، وتضمنت كل ما يتعلق بهذه المسألة من جزئيات فرعية، وبإمكاننا النظر إليها على مستويين: مستوى بنية الفتوى، ومستوى المنهجية المتبعة في الإجابة.
أما البنية فهي تتألف من أربعة أقسام وخاتمة:
الأول: ما نصَّت عليه قواعد المذهب وأصوله بخصوص الأرض، وملخصه أن أرض مصر الصالحة للزراعة ودورها وقِفَت بمجرد فتحها عنوة على يد الفاتحين المسلمين، والوقف لا يوقف مرتين، وعليه فالرزق ليست محبسة تحبيسًا آخر مخصوصًا بها، وإنما هي مقطعة [مخصصة] من الإمام ونائبه، والإمام لا يملك أن يقطعها ملكًا لأنها أرض المسلمين، وإنما يُقطعها إمتاعًا وانتفاعًا، فلا يملك المُقطَع له [المستفيد] بيعها أو توريثها، وترجع بمجرد موته إلى بيت المال وقفًا، يُقطعها الإمام ونائبه لمن يشاء، وعلى هذا فإن «الحاكم لم يُبطل تحبيس محبس، إنما رد المقطعات التي انتهى إقطاعها بموت المقطع لهم إلى محلها، مع بقائها على وقفيتها لمصالح المسلمين العامة والخاصة فلا تُباع ولا تُرهن ولا تُورَّث».
الثاني: رأي فقهاء المالكية المتأخرين، الزرقاني والشبرخيتي والشاوي والأمير، الذين خالفوا قواعد المذهب وأجازوا تمليك الأرض وتوريثها، ودليلهم في ذلك أنها تلحق بالخلو في الوقف، ومن المعلوم أن الخلو ملك للمستأجر ولا يتبع الوقف في أحكامه.
الثالث: رأيه الذي يؤيد ما ذهب إليه المتأخرون من جواز تمليك الأرض لواضعي اليد عليها من الفلاحين، وهو يدعمه بثلاثة أدلة:
-الدليل الأول: أن واضع اليد (الفلاح) أحدث أثرًا في الأرض يشبه الخلو، بإزالة شوكها أو حرثها أو نصب جسر عليها أو نحو ذلك مما يلحق بالبناء في الأوقاف بإذن الناظر فيكون خلوًّا ينتفع به ويُملك، ومن ثَمَّ عبّر الفلاحون عنه بـ«طين الأثر» نظرًا لما أحدثوه في الأرض من آثار دالة على الملكية.
-والدليل الثاني: أن واضع اليد دفع مالًا لملتزم الأرض نظير تمكينه منها، وهذا المال بمثابة المال الذي يدفعه الملتزم للسلطان نظير تمكينه من أرض الالتزام، وقد أثبت الفقهاء بهذا المال حقًّا للملتزمين حتى أفتوا لهم بالشفعة رغم أنهم لا يمتلكون أرض الالتزام.
-والدليل الثالث: غياب الملتزم الشرعي الذي يمكن أن يُفتى بالأرض له، فالملتزم هو من يلتزم بدفع المظالم عن الناحية مما يضرها، ولذلك قالت الحنفية «الجباية بالحماية»، ويقوم بما تحتاج إليه الأرض من المصالح ويدفع الخراج لبيت المال «وهذا مفقود الآن وإنما الملتزم يسلب الأموال، ويؤذي الفلاحين، ويتوقف في دفع ما عليه المسمى "بالميرى" لجهات بيت المال، ويصرف الخراج الذي يجبيه في جهات تغضب الله عز وجل، وما على هذا الوجه مكّنه نائب السلطان، بل لو وقع التمكين على هذا الوجه فهو فاسد شرعًا... فلو قلنا الآن الطين للملتزم لحُرِم منه الفقراء، وأُخذ عليه مالًا كثيرًا من الأغنياء مجاوزًا للحد، والطين والبلاد بلاد الله والخلق عباد الله وعيال الله فليُفت بالإرث في منفعة الطين وإسقاطها بين الفلاحين، والملتزم ليس له إلا الخراج من باب من اشتدت وطأته وجبت طاعته».
- الدليل الرابع: الأحكام المترتبة على القول بتوريث الفلاحين، وهو يتحدث عن حكميْن شرعييْن، أنه لا يجوز عزل فلاح عن أثر تحت أي مسمى، ولا يجوز منع البنات منه ولو جرى عرف فاسد بمنعهن لا يُعمل به»، وما ذهب إليه الشيخ في هذه الجزئية الأخيرة على قدر من الأهمية؛ لأنه سمح -ربما للمرة الأولى- بتوريث النساء أرض الزراعة الأميرية، وكان القانون المعمول به في الدولة العثمانية والولايات التابعة لها ينص على دفع أرض الزراعة لابن المتوفى القادر على زراعتها، ودفع خراجها دون الإناث اللواتي لا يمكنهن ذلك.
وأما الخاتمة، فتناقش مسألة ضرورة جمع المفتي بين حسن النظر في النصوص واتباع المصلحة «لأنه تحدث للناس أقضية بقدر ما يُحدثون»، وهو ما يعني بوضوح ترجيحه المصلحة إن عجزت النصوص عن تحقيقها.
التزم الشيخ عليش في اجتهاده المنهجية الفقهية الكلاسيكية وأدواتها المعتمدة، وأهمها القياس الذي استخدمه في موضعيْن على الأقل في فتواه.
وتُحيلنا هذه الخاتمة إلى منهجية الفتوى والأدوات التي استند إليها الشيخ للقول بجواز التمليك اتباعًا للمصلحة، وأول ما يسترعي النظر أن هذا القول يُمثل خروجًا عن أقوال المذهب السابقة إلى قول جديد لم يقل به شيوخ المذهب، وهو بهذا المعني يُعَدُّ اجتهادًا، ولكنه اجتهاد تم في إطار المذهب وليس خارجًا عنه، فالشيخ أبدى احترامًا للنصوص وأتى على بعضها في القسم الأول من الفتوى، لكنه بعد تأمل وحسن نظر فيها –كما يقول- رجح خلافها اتباعًا للمصلحة ومراعاة لتغير الزمان والأحوال، واستبق بذلك ما ذهبت إليه الدولة التي لم تشرع في اتخاذ بعض الإجراءات الدالة على الملكية إلا عام 1855م بصدور اللائحة السعيدية، واستغرق الأمر قُرابة أربعة عقود للوصول إلى الملكية الكاملة عام 1891م. من جهة ثانية التزم الشيخ عليش في اجتهاده المنهجية الفقهية الكلاسيكية وأدواتها المعتمدة، وأهمها القياس الذي استخدمه في موضعيْن على الأقل في فتواه، الأول: حين قاس الجسور والترع وما يُحدثه الفلاحون في أرض الزراعة على الخلو في الوقف، والثاني: حين قاس المال الذي يدفعه الملتزم للسلطان نظير تمكينه من الأرض بالمال الذي يدفعه الفلاح للملتزم، فكأنه دفع ثمن الأرض لمن مكّنه الحاكم من الأرض ولم يضع يده عليها دون مقابل فحُق الملك نظير المال، ومنه نستنتج أن القضية ليست في الأدوات الفقهية الكلاسيكية وحتمية استبدالها بأخرى إن أردنا الاجتهاد، لكن في حسن توظيفها، وهي مسألة إجرائية تتعلق بالفقيه وليس بالنظرية الفقهية.
ويتبقى أخيرًا الإشارة إلى مآل هذه الفتوى وكيف تعاطت معها الدولة، ذلك أنها شكلت – مع فتاوى متأخري المالكية- المتكأ الشرعي لها حين أرادت تمليك الأرض للفلاحين، أما المذهب الحنفي فلم يدعم مسعاها؛ لأنه لا يُجيز تمليك الأراضي الخراجية، وظل مفتي الديار المصرية الشيخ المهدي الحنفي متمسكًا بعدم جواز التوريث في جميع الفتاوى التي رفُعِت إليه ذاهبًا إلى أنه ليس للفلاحين سوى حق الانتفاع بالأرض.
الإشكاليات الوقفية في ظل الدولة الحديثة
لم تكن مسألة تمليك الأرض الزراعية هي المسألة الخلافية الوحيدة التي طرحها الشيخ عليش، فهناك إشكاليات أخرى بعضها يتصل بالدولة وسياستها، وبعضها يتعلق بالممارسات والأعراف الاجتماعية، ومن خلالهما يمكن استخلاص كيفية عمل النظام الوقفي في مصر في مطالع العصر الحديث الذي جمع بين الحداثة والتقليد، وكيف مارس الفقهاء عملهم في ضبط أداء هذا الجهاز، وكيف استجابوا لمؤثرات الحداثة.
أ- الفتاوى السياسية والحداثية
يأتي في مقدمة الإشكاليات فرض الدولة ضرائب على الوقف تسمى «السنوية» على الدور والعقارات، أثقلت كاهل الواقفين والمحبس عليهم، وكادت تودي بالوقف، وهو ما تبينه الفتوى التالية ونصها:
"(ما قولكم) في عامل يأتي من طرف السلطان ويجعل مالًا على بلادنا يُسمونه بالسنوية، فيوزعونه على العقارات، والحال أن جُلها مُحبس، ولا يجد المحبس عليه من أين يدفع مناب [مقدار] ما صار إليها من توزيع ذلك العامل، وليس له غلة تفي بما يصلحه وبذلك الموزع، وإن لم يعطه يصير فيه العذاب الأكبر من السجن والضرب وربما يؤول للنفس، فهل يجوز له أن يبيع من تلك العقارات المحبسة لأجل ما يقضي به ما وزع عليه ارتكابًا لأخف الضررين؛ لأنه إن امتنع إما أن يقع له العذاب في بدنه أو يغصبون العقار أصلًا"[10].
وجاءت الإجابة وجيزة وخالية من الاستشهادات النصية، وجاء بها أنه: «لا يجوز له بيع شيء من الحبس لذلك...، ويدفع ما ينوبه من الغلة ولو لم يبق شيء منها للإصلاح إذا خاف على نفسه، أو يخلي بينه وبينهم يفعلون به ما بدا لهم وحسابهم على الله تعالى»[11]، ويتبين منها حرص الشيخ على المحافظة على كيان الوقف وعدم التفريط فيه تحت أي ظرف[12]، وتبصره لمآلات الفتوى أو الآثار المحتملة المترتبة على القول بجواز البيع، إذ ستغدو فتواه، وهو رأس المذهب المالكي بالديار المصرية، سندًا شرعيًّا لمن يواجهون مثل هذه الظروف وهم كُثر، الأمر الذي يُنذر بتحلل الوقف واندثاره.
وثمة إشكالية أخرى مشابهة ارتبطت بالدولة، وأربكت الواقفين والمستفيدين، ألا وهي اعتماد نظام التوثيق أساسًا لعمل الجهاز القانوني للدولة مع استبعاد ما عداه من وسائل الثبوت الشفهية التي كانت وسائل قانونية مقبولة قبيل الدولة الحديثة. وكان الأخذ بنظام التوثيق يعني أنه لم يعد ممكنًا ثبوت الوقف بـ«السماع الفاشي» كما تقضي بذلك الأدبيات الفقهية الكلاسيكية، وينبغي للواقف أن يترجم إرادته عمليًّا في صيغة وثيقة تُحفَظ في سجلات المحاكم.
تطلب التوثيق توسعًا في الإجراءات التي تلائم الجهاز البيروقراطي للدولة، كاشتراط معرفة بينة السماع –شهود الوقف الشفاهي- تفصيلات دقيقة كحدود العقار الموقوف وغيره.
خلَّف ذلك بدوره إشكاليات مختلفة، فمن جهة ربما وقع خطأ في كتابة حجة الوقفية بحيث تخالف ما ثبت بالسماع الفاشي، وعندئذ يصير السؤال «هل يعتمد على السماع ويصرف النظر عن الوثيقة أو يعمل بمقتضى الوثيقة ويُلغى السماع»[13]، وإجابة الشيخ كانت دائمًا: «يعتمد على السماع ويصرف النظر عن الوثيقة؛ لنص الأئمة على أن الوقف مما أُثبت بالسماع الفاشي»، ومن جهة أخرى تطلب التوثيق توسعًا في الإجراءات التي تلائم الجهاز البيروقراطي للدولة، كاشتراط معرفة بينة السماع –شهود الوقف الشفاهي- تفصيلات دقيقة كحدود العقار الموقوف وغيره، ومرة أخرى كانت إجابة الشيخ في غير صالح التعقيد البيروقراطي الحكومي، وأنه لا يشترط في البينة أن تكون عاينت العقار ويُكتفى منهم بالقول أنهم سمعوا بوقفه.
ولا يشذ موقف فقهاء الحنفية عما ذهب إليه الفقيه المالكي، فحين سُئل الشيخ المهدي العباسي عن واقف فقد وثيقة الوقف ومعلوم شروطها، فهل يعمل بما في الوقفية المفقودة التي تعضدها البينة العادلة، أم يُعمل بما في السجل الحكومي الموثق «الذي هو غير مأمون من التغيير والتبديل»، أجاب يُعمل بما ثبت بالبينة العادلة من شرط الواقف ولو خالف ما في السجل[14].
ويحتاج مسلك الشيخين إلى بعض التعليل؛ فما ذهبا إليه ليس رفضًا منهما للتحديث أو تقاعسًا عن واجب دمج الإجراءات الحديثة ضمن البنية الوقفية، وإنما هناك عوامل موضوعية دعتهما لرفض هذه الإجراءات الحداثية.
وأولها: أن إجراء التوثيق بهذه الكيفية لم يكن معمولًا به قبل ذلك، وإقراره على هذا النحو فيه مشقة على الواقفين والمستفيدين الذين لم يألفوا مثل هذا التعقيد البيروقراطي الذي صاحب نشوء الدولة الحديثة، وثانيهما: ما شاب إجراءات التوثيق من عوار، فكاتب الوثيقة كثيرًا ما كان يخطئ أثناء الكتابة تحت وطأة العمل الشاق، وربما تقاضى من أحدهم مالًا ليُحرِّف في مضمون وثيقة ما أو ليحذف أحد المستفيدين ويضع آخر محله، وثالثها: أن جُلَّ الواقفين لم يقوموا بإجراءات توثيق الوقف اعتمادًا على «السماع الفاشي» فاعتماد الوثيقة كأساس وحيد لثبوت الوقف ربما أضر بفئة من المستفيدين لم تقم بالتوثيق أو فقدت وثائقها[15]، وهكذا يتراءى لنا أن مسلك الشيخين الرافض للتوثيق أقرب لروح العدالة منه إلى التعنت في رفض الإجراء الحداثي.
ب-الفتاوى الاجتماعية والعرفية
وهناك طائفة من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بالممارسات والأعراف الاجتماعية، ومنها حرمان النساء من الوقف، وهي ممارسة شاعت في هذا العهد، وقبيل تناول الفتاوى المتعلقة يحسن أن نُجمل رأي المذهب المالكي الذي يتلخص في أن: «الذكر والأنثى سواء في الوقف إلا أن يكون في لفظ الواقف ما يقتضي التفضيل فيُعمل به»[16].
يبدو أن ظاهرة استبعاد الإناث من الوقف كانت تخضع لموازين القوة الاجتماعية التي احتكرها الرجال وافتقدتها النساء.
ولكن الأمر تجاوز حد التنظير إلى التعاطي مع الإشكاليات الواقعية ومنها: أن عُرف بعض القبائل كان يقضي بحرمان النساء من الوقف وتخصيص الذكور به، وهنا يُطرح سؤال هل يُعمل بهذا العرف، وهو ما لم يجزه الشيخ ذاهبًا إلى أن «توريث الذكور دون الإناث عرف فاسد لا يجوز العمل به»[17]، ورفض الشيخ يأتي على الرغم من اعتداد المذهب المالكي بالعرف، وقد أضفى فقهاء المالكية المشروعية الدينية على عدد لا بأس به من الممارسات والأعراف الاجتماعية التي لا تصطدم بالشرع؛ كما هو الحال مع الإجارة الطويلة للوقف، والخلو. ويبدو أن ظاهرة استبعاد الإناث من الوقف كانت تخضع لموازين القوة الاجتماعية التي احتكرها الرجال وافتقدتها النساء، وهو ما نستشفه من فتوى وردت للشيخ حول أب له أبناء ذكور وإناث حبس على الذكور ظاهرًا، وأشهد خفية أن تخصيص الذكور بالتحبيس «إنما هو خوف منهم ولا يمضي» ثم خصص ومات بعد ذلك، وهي تسأل «هل لا يمضي التحبيس على الذكور للبينة المذكورة» فأجاب أن تخصيص الذكور بالحبس لا يمضي لبينة الاسترعاء[18] ولعدم التزام الأب التخصيص باطنًا»[19] .
وقد وُجِدت محاولات لإبطال التحبيس على الذكور مخالفة بذلك إرادة الواقفين، ومستعينة في ذلك برجال السياسة وإكراهاتهم، وهو ما نجده في الفتوى التالية:
"(ما قولكم) في حبس معقب على البنين دون البنات من عقار وغيره عمل به الناس وحكم به الحكام [القضاة] قديمًا وحديثًا قرنًا بعد قرن، ثم رام بعض من في عصرنا من الموسومين بالعلم إبطاله ونقضه، وخلط الأمر على الناس؛ لأن غالب أحباسهم على هذه الكيفية، وساعده على ذلك بعض حكام السياسة، واشتد الكرب على الناس بذلك، فهل لا يجاب إلى ذلك"[20].
وأجاب الشيخ بعدم جواز نقضه مستدلًا على ذلك بأدلة منها: تشويشه على الناس وفتحه باب هرج وفتنة، ووجوب العمل بما حكم به الحكام وجرى العمل به حتى ولو كان ضعيفًا، وأن قواعد المذهب تنص أنه يُكرَه لمن حبس أن يُخرِج البنات من تحبيسه، فإن نزل مضى ولا يفسخ واتُّبع شرط الواقف، ويُستَشف منها مراعاة إرادة الواقفين، وألا يتوسل في تغييرها بالسلطة وأدواتها الإكراهية، ولعل هذا ما استدعى هذه اللهجة الحادة في خطابه.
وعلى صعيد آخر، كانت هناك أعراف وممارسات اجتماعية أخرى تركت آثارها على الممارسة الوقفية من مثل: إجارة الوقف مدة طويلة، وتمليك الخلو وما إلى ذلك؛ وهي تُبيِّن واقع النظام الوقفي وكيف كان يُدار خلال هذه الحقبة.
وفيما يخص الإجارة، تُبيِّن الفتاوى أن دور الوقف وأراضيه كانت مطمعًا للمستأجرين الذين ابتغوا إجارتها بمبالغ زهيدة ولمدد طويلة ربما تصل إلى تسعين عامًا، والقاعدة فيها أن وقوع الإجارة دون أجر المثل[21] يُعَدُّ «إجارة فاسدة»، وينبغي جبر المستأجر على تتميم الأجرة كما يقررها أهل الخبرة، وإلا فالتتميم على الناظر الذي أجّرها كما أفتى بذلك الشيخ عليش[22]، هذا من الناحية النظرية لكن إهمال النظار للوقف وعدم صيانته جعل أجرة الوقف ثمنًا بخسًا لا يكاد يفي بمتطلباته فضلًا عن تعميره، وعندئذ لم يكن بمقدور الشيخ فسخ الإجارة كما توضح ذلك الفتوى التالية:
"(ما قولكم) في أرض نحو ألف ذراع محبسة على الجامع الكبير بمدينة إسنا بأقصى صعيد مصر، طرح الناس أتربة وأقذارًا فيها حتى صارت تلًّا لا يُنتفع به في الحال، فأجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل ما فيها من الأتربة والأقذار ويبنيها خانًا كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير، وأزال المكتري ما فيها وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة، فهل تفسخ تلك الإجارة ويصير الأنفع للوقف؟ أفيدوا الجواب"[23].
وإجابة الشيخ عليش عن هذا السؤال جاءت في قسمين أفاد في أولهما: أن الإجارة تنفسخ إن وُجِد حين العقد من يستأجرها بأزيد مما ذُكر، أما إن لم يوجد فإنها لا تُفسخ، ولا تعتبر الرغبة في إجارتها بأزيد من أجرتها بعد عقد الإجارة ونقل ما فيها، وما أفتى به ليس غريبًا فصيانة العقود وحماية العاقدين سمة لازمة لأي نظام قانوني، وإلا فقد هيبته وأصبحت أحكامه وعقوده الموثقة عرضة للنقض بمجرد رغبة الراغبين. وعرج في ثانيهما على موقف المذهب المالكي من مسألة الإجارة الطويلة للوقف الذي يتلخص في حدوث تغير في موقف المذهب من هذه المسألة، أو بعبارة أخرى انزياح في الرأي الفقهي تحت وطأة تفضيل المستأجرين للإجارة الطويلة، وعليه فقد ذهب الفقهاء المتأخرون -خلافًا لأسلافهم-إلى جواز الإجارة الطويلة لمن يعمّره ويختص بغلته الزائدة، لكنهم اشترطوا لذلك شروطًا منها: ألا يكون للوقف ريع يُعمر به، وأن تقع الإجارة بأجرة المثل في وقتها.
وما ذهب إليه متأخرو المالكية يُغاير موقف الأحناف الذين التزموا بعدم جواز إجارة الوقف فوق الثلاث سنوات، ومدار الفتوى لديهم كانت على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود متتالية كل عقد إثر الآخر «فلو أجّرها المتولي أكثر من ثلاث لم تصح الإجارة فتنفسخ في كل المدة؛ لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله» كما أفتى بذلك الشيخ المهدي العباسي[24]، واستنادًا إلى ذلك كان جلّ المصريين يوثقون عقود إجارة الوقف في المحاكم وفقًا للمذهب المالكي حتى فرضت الدولة المذهب الحنفي وجعلت عمل المحاكم مختصًّا به، فقضت بذلك على المرونة الفقهية المستمدة من آراء المذاهب في المسألة الواحدة التي كان يفيد منها الأفراد الذين يختارون منها ما يتلاءم مع ظروفهم وما يحقق مصالحهم.
أما الخلو فهو من المسائل المتواترة في الفتاوى، وله عدة معاني فهو يُطلَق أولًا على خلو العقار أي إفراغه والتخلي عنه لغير من هو بيده، ويُطلَق على البدل النقدي الذي يأخذه مالك هذا الحق مقابل التخلي عنه، ثم أطلق على المنفعة المتخلَّى عنها نفسها، وقد وقع بهذه المعاني كلها في فتاوى الشيخ عليش[25]، وللخلو صور عديدة منها: أن يكون الوقف آيلاً للخراب فيدفع به ناظره لمن يُعمّره على أن يدفع أجرة الوقف أقل من أجرة المثل بعد التعمير، ويُشترط في هذه الحالة ألا يكون للوقف ريع يُعمَّر به[26]، ومنها أن الواقف حين يريد بناء محلات للوقف يأتي له أشخاص يدفعون له أموالًا على أن يكون لكل شخص منهم محل من تلك المحلات يسكنه بأجرة معلومة كل شهر، فكأن الواقف باعهم حصة من المحلات وحبس الباقي، فليس للواقف تصرف في المحلات إلا بقبض الأجرة، فكأن دافع الأموال شريك للواقف بتلك الحصة[27]، ومن هنا صار الخلو كالملك وجرت عليه أحكام البيع والإجارة والرهن ووفاء الدين والإرث، ورغم هذا لم يخل الأمر من حدوث إشكاليات يمكن تبينها من الفتويين التاليين:
"(ما قولكم) في رجل بيده قطعة طين رزقة بعضها على عمل وبعضها على البر والصدقة، غرس فيها نخلًا وبنى فيها منزلًا، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى عن زوجة وابن ولم يترك غير النخل والمنزل، فهل للزوجة أخذ صداقها من ذلك، ولا يلتفت لقول من قال بضياعه عليها في هذه الحالة أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله ما بُنِي أو غُرِس في أرض الوقف على الوجه المذكور يكون من باب الخلو يُقطع فيه الإرث ووفاء الديون؛ لأنه يملك لفاعله ويجوز بيعه، لكن من استولى عليه يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه وقف الأرض يسمى عندنا بمصر حكرًا لئلا يذهب الوقف باطلًا، فتحصل أن الخلو من بناء وغرس يملك ويورث وتوفى منه الديون وأنه لا بُدَّ للوقف من حكر أي أجرة تصرف للمستحقين بعد هذا هو الذي أفتى به علماؤنا، ووقع العمل به عندنا في مصر من غير نزاع"[28].
وفي حالة ثانية استأجر أحدهم من ناظر وقف مسجد محلات من الوقف، وأذن له الناظر في العمارة والخلو والسكنى، فقام المستأجر بوقف هذه المحلات على جهة وقف أخرى، ومضت خمسة وسبعون عامًا على ذلك، ثم أراد ناظر آخر استرجاعها لجهة الوقف، ورفعت الفتوى للشيخ وهي تسأل: "هل ترجع المحلات لجهة الوقف، وإذا وضع أحدهم يده عليها واستغلها هل لناظر الوقف أن يحاسبه على ما استغله"، وأجاب الشيخ أن المحلات لا ترجع لجهة الوقف الأول وتظل وقفًا على الجهة الأخرى، ولا يحق للناظر محاسبة واضع اليد ولا أخذ الغلة منه وإنما له الحكر –أي الأجرة المقررة- كل شهر أو حول، ويستفاد من فتوى الشيخ أن الفقهاء اعتبروا الخلو كيانًا مستقلًّا منفصلًا عن كيان الوقف، وأنه كانت تجري فيه سائر التصرفات الشرعية الدالة على الملكية بما فيها الوقف[29].
ويتفق الشيخ العباسي المهدي مع ما ذهب إليه الشيخ عليش، فحين سُئِل في وقف تخرب وليس هناك من يرغب في إيجاره بحالته تلك، وليس له عائد يفي بإصلاحه، وليس هناك من يُقرض ناظره بعض المال لينفق على تعميره، فهل يحق للناظر أن يؤجره لمن يضع به خلوًّا بحق القرار نظير تعميره، أجاب المهدي السائل إلى طلبه على الرغم من وجود اعتباريْن:

العباسي المهدي
الأول: أن المذهب الحنفي لا يجيز الخلو، وقد أجمل الشيخ حسن الشرنبلالي رأي المذهب في رسالة أسماها "مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى"، صنفها لتنزيه المذهب عما ذهب إليه نفر من أهله من إجازة الخلو الذي هو «مخترع محدث مجرد منفعة يباع ويشترى»[30]، والثاني: أن الشيخ المهدي عُرِف عنه اعتداده بمذهبه وأنه لا يفتي إلا بأصح الآراء في المذهب الحنفي، ولذا وصمه المؤرخ الهولندي رودلف بيترز بالجمود المذهبي، وأنه أعاق تطور المنظومة القانونية المصرية طيلة نصف قرن هي فترة توليه منصب مفتي مصر المحروسة لتنكبه عن الاجتهاد وتمسكه بالإفتاء وفقًا لأصح الأقوال في المذهب الحنفي[31]، لكن ما ذهب إليه الشيخ في مسألة الخلو ينفي عنه هذا الادعاء[32] ويبرهن أنه لم يكن بمقدوره إبطال الاجتهاد أو شطبه من الممارسة الفقهية ولو أراد، خصوصًا أن ما ذهب إليه لا يُعَدُّ خروجًا عن المذهب وحسب، لكنه تطوير في البنية الفقهية ذاتها حيث تنص القاعدة الفقهية أن النص لا يتقيد إلا بعرفٍ عام، ولكن الشيخ جعل العرف الخاص يقيد النص ويخصصه[33]، وما ذلك إلا تيسيرًا على الناس حتى لا يجري عملهم على غير مقتضى الشرع.
ويتبقى لنا الإشارة إلى مسألة كانت من أهم اختصاصات المفتي وهي صيانة التوزيع العادل لغلة الوقف وفقًا لكتاب الواقف وضمان وصوله لكافة المستفيدين، فكان إخلال النظار بكتاب الواقف محل نقض، ومن أمثلتها إفتاء الشيخ عليش بعزل ناظريْن على مرتبات وأوقاف ضريح ولي من أولياء الله، بعد أن زادت هذه المرتبات فأرادا الاختصاص بجميع المرتبات مع أخواتهما ومنع باقي الذرية من مستحقاتها، رغم مخالفة ذلك لنص الواقف، وقد أرجع الشيخ جواز العزل إلى ثبوت خيانتهما وعدم قيامهما بالمصلحة وفتحهما باب الهرج والفتنة والشر بين الناس[34]، ولم يقتصر عمله على ذلك وإنما طال كيفية توزيع غلة الوقف، حيث ذهب الشيخ إلى أنه يسوغ قسمة الوقف قسمة اغتلال وانتفاع بين المحبس عليهم كأن يستقل أحدهم بالشجر ويعالجه بالسقي والتدبير، والبعض الآخر بالثمر وذلك «صيانة لثمرته من الضياع وللأصول من التعطيل باتكال بعضهم على بعض»[35] وحجته في ذلك أنه يجب ترك أهل البلاد على عادتهم فلا يشوش عليهم بآراء أخرى في المذهب، لكنه لم يجز أن يختص كل منهم بما تحت يده ويقتسمونه كما يتصرف المالك في ملكه؛ لأن في هذا تبديد للوقف ومخالفة لكتاب الواقف[36].
الخاتمة
من خلال الفتاوى السابقة نستخلص أن عمل المفتي لم يكن تقديم صك المشروعية لمحاولات التحديث التي تبنتها الدولة، وإنما فحصها فإن وافقت -أو لم تصادم نصًّا شرعيًّا على الأقل- أخذ بها وقبلها، كما هو الحال مع مسألة توريث الأرض التي استبق الدولة فيها، كما لم تكن غايته في المقابل إلباس الأعراف والممارسات الاجتماعية الفاسدة مُسوحًا دينية، فلم يكن بمقدوره إقرار عرف فاسد يقضي بحرمان النساء من الوقف، وإنما كان بإمكانه أن يوفر المظلة الدينية لبعض الممارسات التي باتت واقعًا لا يمكن تجاهله ومحاولة إعادة تكييفها وضبطها حتى تتلاءم مع الشريعة، كما هو الحال مع مسألة الخلو والإجارة الطويلة، حتى لا يجري عمل الناس على غير مقتضى الشرع وعملًا بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والأحوال.
المسألة الثانية تتعلق بالاجتهاد ومآلاته في المجال الوقفي، ففي جميع الفتاوى السابقة نجد أننا إزاء أمريْن، إما التحول عن الرأي السائد في المذهب لصالح رأي آخر في البنية المذهبية، وهذا الأخير ربما لا يفضل القديم لكن الفقهاء اضطروا إليه تحت وطأة تغير العادات والممارسات الاجتماعية، كمسألة الإجارة الطويلة للوقف التي أقرها فقهاء المالكية من المتأخرين، وإما الخروج عن رأي المذهب والقول برأي جديد أو ما يسمى الاجتهاد، كما هو الحال في فتوى تمليك الأرض الزراعية للشيخ عليش وفي فتوى الخلو للشيخ المهدي، الأمر الذي ينفي ما ذهب إليه البعض من جمود بنية الفقه الإسلامي في القرون المتأخرة، ويلفت الانتباه أن الاجتهاد مورس على يد من يوصمون بالتقليد كالشيخ محمد عليش -والمهدي العباسي بصورة أقل- لكنه لم يتم تحت مسمى أو لافتة «الاجتهاد»؛ إذ لم يُطلق عليش وصف الاجتهاد على عمله، لكن غياب اللفظ مبنى لا يعني غيابه معنى، إذ كان حاضرًا تحت اسم «اتباع المصلحة» وضرورة الموائمة بينها وبين النصوص الفقهية، فإذا ما تعذر الجمع بينهما غلبت المصلحة على النص، وعلى أي حال يمكن القول إن إعمال الاجتهاد في مجال الوقف قد أفضى إلى نتيجة مزدوجة: تطوير البنية الوقفية وتمديدها وذلك بتمليك أرض الفلاحة للمزارعين وإجازة وقفها من جهة، وإضفاء الشرعية على الممارسات العرفية التي لا تصادم أصلًا شرعيًّا، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها من جهة أخرى.
وأخيرًا نُشير إلى أن إدارة العلماء للشأن الوقفي حَكَمها محدد رئيس ألا وهو الحفاظ على الوقف وتغليب مصلحته وعدم تبديده تحت أي ظرف حتى ولو كان سلطة قاهرة أو عرفًا مستقرًّا، حيث كانت أعراف بعض المناطق تُجيز بيع الوقف، دون تمييز بين هذا وذاك. وضمن هذا الإطار يمكن أن ننظر لإجازة بعض الممارسات الوقفية مثل إجازة الخلو والإجارة الطويلة للوقف بوصفها أحكام ضرورة لجأ إليها الفقيه مضطرًا، وربما تعرض الوقف بدونها للتحلل بفعل إهمال الواقفين وعدم صيانة البنية الوقفية.
الهوامش
[1] الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج2)، ص360.
[2] أبو عبد الله محمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، (القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د/ت، ج2)، ص262-267.
[3] فتح العلي المالك، 2/250-253.
[4] فاطمة حافظ، الفتوى والحداثة، تطور علاقة الدولة بالشريعة في القرن التاسع عشر، (بيروت: مركز نماء للدراسات والبحوث، 2019م)، ص85-87.
[5] محمد العباسي الحنفي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، (القاهرة: المطبعة الأزهرية المصرية، 1301هـ، ج2)، ص 443-836.
[6] عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الريف المصري في القرن التاسع عشر، (القاهرة: مكتبة مدبولي، 1986م)، ص86-88.
[7] أحمد أحمد الحتة، تاريخ الزراعة في عهد محمد علي الكبير، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012م، سلسلة تاريخ المصريين 291)، ص58-62
[8] أثار قرار إبطال التحبيس ردودًا من العلماء فبعضهم أجازه وبعضهم لم يُجزه، ووضع الشيخ العباسي المهدي رسالة في ذلك أسماها: «الصفوة المهدية في إرصاد الأراضي المصرية»، ذهب فيها إلى عدم الجواز، وعلل ذلك بأدلة شرعية وأنه لا ينبغي إبطال الأوامر الشريفة التي تصدر لمرحمة الرعية، ولمعاش من انتسبوا إلى الدولة العلية. انظر نص الرسالة في الفتاوى المهدية، ج2، ص645-650.
[9] فتح العلي المالك، 2/244.
[10] فتح العلي المالك، 2/257.
[11] فتح العلي المالك، 2/257.
[12] ثمة فتاوى عديدة أفتى فيها الشيخ بعدم جواز بيع الوقف حتى وإن كان هذا عرفًا لبعض الجهات أو كان صادرًا عن أحد القضاة دفعًا لغائلة فقر المستفيدين وعوزهم، انظر ذلك في فتح العلي المالك، 2/253 و255.
[13] فتح العلي المالك، 2/256.
[14] الفتاوى المهدية، 690/2. فتوى بتاريخ 27 جمادى الأولى 1281هـ/27 أكتوبر 1864م.
[15] انظر نماذج واقعية من الإشكالات التي أثارها اعتماد التوثيق في: فاطمة حافظ، الفتوى والحداثة: ص 118-120.
[16] فتح العلي المالك، 2/258.
[17] فتح العلي المالك، 2/248.
[18] بينة الاسترعاء: أن يكتب أحدهم كتابًا في الخفاء يذكر فيه أنه يفعل هذا التصرف لأمر يتخوفه على نفسه، ويرجع فيما عقد عند أمنه، ويُشهِد على ذلك شهودًا يسمون شهود الاسترعاء. انظر الموسوعة الكويتية، المرجع السابق، 26/241.
[19] فتح العلي المالك، 2/241.
[20] فتح العلي المالك، 2/257.
[21] يستخدم الفقهاء مصطلح "أجر المثل" ويراد به الأجرة العادلة التي يُقدِّرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض، وينظر في تقدير أجر المثل في الأعيان إلى: المنفعة العادلة للمأجور وما يبذل مقابلها من عوض، وإلى زمان الإجارة ومكانها.
[22] فتح العلي المالك، 2/259-260.
[23] فتح العلي المالك، 2/239.
[24] الفتاوى المهدية، 2/732 فتوى بتاريخ 1 رمضان 1286هـ/14 ديسمبر 1869م.
[25] الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، 19/277.
[26] فتح العلي المالك، 2/239.
[27] فتح العلي المالك، 2/ 249-250.
[28] فتح العلي المالك، 2/243
[29] فتح العلي المالك، 2/249.
[30] حسن بن عمار بن علي الشُرنبلالي، مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى، (القاهرة: المكتبة الأزهرية (مخطوط)).
[31] Rudolf Peters, Muhammad al-Abbasi al-Mahdi (D.1897), Grand Mufti of Egypt, and His “al-Fatawa al-Mahdiyya”, Islamic law and Society, Vol. 1, No. 1. (1994). P.73.
[32] ما ذهب إليه الشيخ المهدي في هذه المسألة يصح الاحتجاج به على أن مسألة جمود الفقه الإسلامي في القرون الأخيرة ليست دقيقة، وأن الممارسة الاجتهادية ظلت تمارس على يد من تم نعتهم بالجمود.
[33] Muhammad Almarakeby, Modernity and Islamic law in EGYPT’S nineteenth century: a socio-legal study, University of Edinburgh
[34] فتح العلي المالك، 2/259.
[35] فتح العلي المالك، 2/254.
[36] فتح العلي المالك، 2/254.
المصادر والمراجع
أولًا: المصادر العربية
- أبو عبد الله محمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، القاهرة: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د/ت، ج2.
- أحمد أحمد الحتة، تاريخ الزراعة في عهد محمد علي الكبير، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012م، سلسلة تاريخ المصريين ع. 291.
- الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج2.
- حسن بن عمار بن علي الشُرنبلالي، مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى، القاهرة: المكتبة الأزهرية (مخطوط).
- عاصم الدسوقي، رؤوف عباس حامد، كبار الملاك والفلاحين في مصر (1837-1952م)، القاهرة: دار قباء، 1993م.
- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، الريف المصري في القرن التاسع عشر، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1986م.
- علي مبارك، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1888م، ج4.
- فاطمة حافظ، الفتوى والحداثة: تطور علاقة الدولة بالشريعة في القرن التاسع عشر، بيروت: مركز نماء للدراسات والبحوث، 2019م.
- محمد العباسي الحنفي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية، القاهرة: المطبعة الأزهرية المصرية، 1301هـ، ج 2.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت: دار السلاسل، الطبعة الثانية.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
- Muhammad Almarakeby, Modernity and Islamic law in EGYPT’S nineteenth century: a socio-legal study, University of Edinburgh.
- Rudolf Peters, Muhammad al-Abbasi al-Mahdi (D. 1897), Grand Mufti of Egypt, and His “al-Fatawa al-Mahdiyya”, Islamic law and Society, Vol. 1, No. 1. (1994).










