التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية (١٨٣٩-١٨٧٦م)

في مواجهة هدير التوسُّع السياسي والاقتصادي الأوروبي في القرن الثامن عشر، صعدت إلى السلطة في الدولة العثمانية نخبة من البيروقراطيين العلمانيين، درست على يد البيروقراطيين الأوروبيين، وزارت أوروبا وتلقت فيها تعليمًا معمقًا، ولمَّا عاد هؤلاء إلى بلادهم أقروا بأن المؤسسات الدينية والسياسية والعسكرية القديمة ما عادت تلبي حاجات الإمبراطورية في العالم الحديث، وأن ضعف الدولة ومؤسساتها يعود إلى تلك المواريث القديمة، التي أضحت -في نظرهم- تتعارض مع روح العصر وحياته.
لم يكن يُقصَد بذلك التراث في الواقع سوى قوانين الشريعة الإسلامية، التي ظلَّت حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر -أي قبل دخول المؤثرات الغربية إلى الدولة العثمانية- بمثابة القانون الأساسي، باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع، الذي لم يكن ليقبل المساس به بأي شكل من الأشكال.
وبناءً عليه، صمَّم أولئك التغريبيون، الذين قُيض لهم أن يتولوا مناصب مهمَّة في الدولة العثمانية، على «تحديث» الدولة وهَجْر المبادئ الإسلامية السياسية فيها، من أجل نموذج غربي «متنور». وهكذا بدأت جذور العلمانية تظهر في التشريعات العثمانية، كما بدأت تعبّر عنها المراسيم السلطانية.
فبمقتضى مرسومَيْن سلطانيَّيْن صدرا في عهد السلطان عبد المجيد الأول، وهما: «خط شريف جولهانه» 1839م، و«الخط الهمايوني» 1856م، أُعلن عن التنظيمات الخيرية Tanzimat، وتعني إعادة التنظيم. وتأثَّرت التنظيمات العثمانية تأثرًا شديدًا بقانون نابليون والقانون الفرنسي في ظل الإمبراطورية الثانية، فتحوَّل الجيش والتعليم والإدارة والقضاء في أثناء فترة التنظيمات (1839-1876م) تحولًا جذريًّا من خلال علمانية أكثر راديكالية؛ حيث جرى إلغاء الجزية سنة 1856م، ووضع نظام ثابت للجندية والضرائب، يشمل السكان المسلمين وغير المسلمين، وفي عام 1847م تشكَّلت المحاكم المختلطة المدنية والجنائية، وبقوانين الإثبات والإجراءات المستمدَّة من الممارسات التنفيذية الأوروبية بدلًا من الممارسات الاسلامية.

السلطان عبد المجيد الأول
وفي عام 1850م، صدر القانون التجاري، الذي مثَّل اعترافًا رسميًّا بنظام القانون والقضاء المستقل عن علماء الدين، والتعامل مع القضايا بشكل خارج عن نطاق الشريعة، كما جرت علمنة التعليم. لقد أعلنت التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية عن بدء علمنة العالم الإسلامي، ولقد ظلَّ تيار التغريب والعلمنة الذي انبثق عنها يمثِّل في الكتابات التاريخية والأكاديمية -حتى يومنا هذا- نموذجًا لحركة الإصلاح والتحديث في العالم الإسلامي، على الرغم من كونه منافيًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن ثَمَّ فإن هذه الدراسة سوف تحاول البحث والتعرف إلى النتائج التي ترتبت عن إدخال القوانين والنُّظُم العلمانية على الدولة العثمانية، مع مقارنة هذه الآثار بالفترة الأولى التي أبدى فيها العثمانيون احترامًا كبيرًا لمبادئ الشريعة. فهل كانت نتائج القوانين العلمانية الجديدة إيجابية على الدولة العثمانية كما كان أثرها في الغرب؟ وهل حقَّقت التنظيمات الأغراض المتوخاة منها؟ وإلى أي مدى أسهمت في وقف انحطاط الإمبراطورية والرفع من أدائها؟ وهل خففت من وطأة التدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية، بحرمانها -كما كان يأمل رجال التنظيمات- من ذرائع التدخل باسم حماية الأقليات المسيحية فيها؟ وهل نجحت في القضاء على سخط القوميات؟ وبالمجمل، إلى أي مدى أصبحت السلطنة قادرةً على السيطرة على جميع «مواطنيها»؟
ضمانات التحوُّل السريع من الشريعة نحو العلمنة
شكَّل خط شريف جولهانه الصادر في 3 نوفمبر 1839م منعطفًا كبيرًا في تاريخ الدولة العثمانية، حيث مثَّل نقطة الانطلاق لبرنامجٍ واسعٍ من التغييرات الراديكالية التي استهدفت تغيير جلد الدولة العثمانية، والتي «سوف تؤدي في غضون بضعة عقود إلى تبديل المشهد المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد».(1)
ولم يكن إجراء هذه التغييرات الراديكالية في مؤسسات الدولة العثمانية ليتم دون معارضة عنيفة، فقد كانت الاتجاهات المحافظة لا تزال قوية، كما لم تكن لتختفي في الحال(2). ولذلك فقد كان على مهندس التنظيمات الخيرية مصطفى رشيد باشا(3) وهو ينوي القيام بها أن يراعي عدم إثارة القوى المحافظة -وعلى رأسها علماء الدين- التي كانت ترى أن سبب اضمحلال الدولة هو عدم العمل بمبادئ القرآن؛ ولذلك عمد رشيد باشا إلى أن يستهلَّ خط جولهانه بالمقدمة التالية:
«من المعلوم لدى الجميع أن تعاليم القرآن المجيدة وشرائع السلطنة كانت أبدًا محترمةً على عهد الدولة العثمانية الأولى، فازدادت من جراء ذلك قوة السلطنة وعظمتها، وبلغ كافة الرعايا بلا استثناء أعلى مراتب البحبوحة والازدهار. لكن حدثت خلال المائة وخمسين سنة الفائتة سلسلة من الأحداث والأسباب المختلفة أدت إلى تجاهل الشرائع المقدَّسة والأنظمة المستمدَّة منها، فانقلبت القوة والازدهار السابقان إلى ضعف وفقر. والواقع أن الدول تفقد استقرارها حالما تتوقف عن التقيُّد بشرائعها... لذلك رأينا مناسبًا -ونحن على ثقة بمعونة العليِّ وعلى يقين بتأييد نبيّنا- أن نزوِّد الولايات التي تتألَّف منها السلطنة بإدارة صالحة»(4).
وهكذا فعلى الرغم مما نصَّ عليه الخط من أن مرجع ضعف الدولة هو عدم تطبيق مبادئ القرآن، فإنه أشار إلى أن العلاج لا يكْمُن في الرجوع إلى القوانين القديمة، بل في إيجاد نُظُم ومؤسسات جديدة «بعون الله تعالى ورسوله»، وهو ما يعكس الازدواجية التي ستتميز بها شخصية عهد التنظيمات الخيرية، الذي سيشهد تنفيذ الوعود التي تضمَّنها الخط الشريف، والتي يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط ينبغي للمؤسسات الجديدة أن تضمنها:
1- ضمانات لأمن جميع رعايا الدولة على حياتهم
2- وشرفهم وأملاكهم.
3- توفير نظام ثابت للضرائب.
4- توفير نظام ثابت للجندية ومدَّة التجنيد(5).
وبعد عزل مصطفى رشيد باشا، تولَّى مسؤولية التنظيمات عالي باشا وفؤاد باشا(6)، وهما من الجيل الثاني لعهد التغريب؛ ولذلك بديا أكثر جسارةً من مصطفى رشيد باشا في التحرُّك الحاسم صوب علمنة الدولة والقوانين وصبغها بالصبغة الأوروبية(7)، وقد ظهر أثر ذلك في الخط الهمايوني لسنة 1856م، الذي على الرغم من تكراره للضمانات التي أُعلنت في خط شريف جولهانه سنة 1839م، فإنه كان أكثر دقةً في تحديد التغييرات الواجب إجراؤها، ولم يبدُ فيه ازدواج الشخصية الذي ظهر في خط جولهانه، كما أن صيغته جاءت أكثر اقتباسًا عن الغرب بصورة لم يسبق لها مثيل في الوثائق العثمانية، فهو لم يستشهد بآية قرآنية واحدة ولا بقوانين الإمبراطورية القديمة وأمجادها(8).
إلغاء الجزية وتجنيد غير المسلمين ونتائجه
قامت الإمبراطورية العثمانية على مبادئ إسلامية، سمحت بقسطٍ كبيرٍ من المرونة فيما يتعلَّق بالعلاقات القائمة بين أجزائها المختلفة، وهذه المبادئ قد تضمَّنتها الشريعة التي أقامها الفقهاء والمشرعون خلال القرون الأولى للتاريخ الإسلامي على نصوص القرآن والسُّنة والإجماع(9).
وقد أبدى سلاطين آل عثمان الأُول احترامًا للشريعة فاق ما أبداه أسلافهم من الخلفاء والسلاطين المسلمين، وهكذا ظلت الشريعة حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر -أي قبل دخول الأفكار والمؤثرات الغربية- تمثِّل قانون الدولة العثمانية ودستورها. صحيح أن السلاطين أصدروا لوائح كل منها يُسمَّى قانونًا (القانوننامات)، إلا أنه لم يذهب أحد إلى أن قوانين السلاطين تؤلِّف قانونًا علمانيًّا يناظر الشريعة، فهي لا تعدو أن تكون تنظيمات تتناول شؤونًا لم تحدِّدها الشريعة، ورغم ذلك فقد كان يجب أن تكون متمشية مع أحكامها(10).
وطبقًا لأحد مبادئ الشرع، ينقسم العالم إلى قسمَيْن: دار الإسلام ودار الحرب، وكان حقًّا على المسلمين أن يوسعوا رقعة الأولى على حساب الثانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. وفي دار الحرب نوعان من السكَّان: عبدة الأوثان الذين كان عليهم إما أن يقبلوا بالإسلام أو يُقضى عليهم بالموت، وفي دار الحرب كان باستطاعة أهل الكتاب أن يحافظوا على عقيدتهم ويصبحوا من رعايا الحاكم المسلم بشرط أن يوافقوا على دفع الجزية، وبذلك يرتبطون طواعيةً بدار الإسلام برابطة التبعية(11).
وفي مقابل دفع الجزية تمتَّع أهل الذمَّة في الدولة العثمانية بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، وبالإعفاء من الخدمة العسكرية لكونها ترتبط في الإسلام بمبدأ «الجهاد»؛ إذ لم يكن ممكنًا ولا معقولًا أن يُعهد لغير المسلمين بتوسيع رقعة دار الإسلام أو بالدفاع عن بيضته. وهكذا كان من واجب الدولة الإسلامية حماية رعاياها «الذميين» في أرواحهم وأملاكهم وشرفهم، دون أن يكون عليهم المشاركة في هذه الحماية، وهي المهمَّة التي كانت منوطةً بالمسلمين دون غيرهم.
لم يكن أهل الذمَّة في الدولة العثمانية مواطنين من الدرجة الثانية، بقدر ما كانوا خاضعين لمؤسساتهم الخاصة، ومندمجين في البنية الفوقية الاجتماعية للأمة الإسلامية.
ومنذ فُتحت إسطنبول، تمتَّعت الأقليات الدينية في الدولة العثمانية بقسطٍ وافرٍ من التسامح الديني، ففي إطار نظام «الملَّة» العثماني منحتهم الدولة قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي في شؤونهم الداخلية العامة، حيث كان للبطارقة والأساقفة المنتخبين عادة -حسب إجراءاتهم التقليدية- قضاؤهم الروحي والزمني المعترف به من السلطان. وهكذا لم يكن أهل الذمَّة في الدولة العثمانية مواطنين من الدرجة الثانية، بقدر ما كانوا خاضعين لمؤسساتهم الخاصة، ومندمجين في البنية الفوقية الاجتماعية للأمة الإسلامية، التي لا يخضعون لمبادئها -كونها لا تتفق مع معتقداتهم- ما عدا القوانين المتعلِّقة بالأمن العام(12). ولكن ضعف الدولة العثمانية منذ القرن السابع عشر شجَّع الدول الأوروبية على التدخل في شؤونها، وبمقتضى معاهدات الامتيازات التي أجبروا الدولة على توقيعها، حصلت الدول الأوروبية على حق حماية الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية: روسيا على حق حماية الأرثوذكس، وإنجلترا على حق حماية البروتستانت، بينما نصبت فرنسا نفسها حاميةً للكاثوليك في الشرق. ولم تكن الدول الأوروبية -التي لم تعُد تكترث لشأن الدين بعد أن جرى تقويض دعائم الكنيسة وسلطة الإكليروس فيها- لتُعنى كل هذه العناية بمسيحيي الشرق إلَّا لتتخذهم مطيةً للتدخل في شؤون الدولة العثمانية تحقيقًا لمصالحها.
وبلغت التدخلات الأجنبية أوجها بدخول الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر طور الاضمحلال، حيث استغلَّت هذه الدول فرصة ضعف الدولة العثمانية وحاجتها للمساندة الأوروبية، ولا سيما بعد هزيمتها المنكرة أمام قوات واليها محمد علي باشا في نزيب سنة 1839م، ثم أمام روسيا في حرب القرم (1853-1856م)، وأخذت تضغط على الحكومة العثمانية وتطالبها بإدخال إصلاحاتٍ وتحسين أحوال المسيحيين، وكان من بين مطالبها إلغاء الجزية، التي كانت ترى فيها مثالًا صريحًا للتمييز بين المسلمين وغير المسلمين. وقد استجاب رجال التنظيمات لهذه المطالب؛ إذ كانوا بحاجة إلى كسب ودِّ الدول الأوروبية وإقناعها أن بإمكان الدولة أن تحرز التقدُّم وأنها تستحقُّ الإنقاذ، وليقطعوا الطريق أمام التدخلات الأجنبية باسم حماية الأقليات المسيحية. واعتقدوا أن من شأن ذلك أيضًا تقوية الدولة وإضعاف النزعات الانفصالية داخلها، عن طريق تعزيز ولاء سكانها المسيحيين.
وهكذا صار بمقدور المسيحيين -بموجب خط شريف جولهانه 1839م- الدخول إلى الجيش ودفع الضريبة مثل المسلمين، وفي سنة 1855م صدر قانون نصَّ على وجوب تجنيد المسيحيين في الدولة العثمانية(13). ثم جاء الخط الهمايوني لسنة 1856م ليؤكِّد -باسم الإصلاحات- على الوعود التي تضمَّنها خط جولهانه، واعدًا بالمساواة القانونية الكاملة للمواطنين من جميع الأديان، ومنذ ذلك الوقت أُلغي استلام الجزية من غير المسلمين(14). فماذا كانت نتيجة هذا الإلغاء؟
لقد رحَّب المسيحيون بقرار إلغاء الجزية، ولكنهم رفضوا القيام بالخدمة العسكرية، فهي على أية حال لم تكن تجذبهم كثيرًا(15). وقد شرح السفير الفرنسي في إسطنبول بنفسه الأسباب التي جعلت المسيحيين راغبين عن أداء الخدمة العسكرية في الجيش العثماني، واللافت فيها أنها جسدت -في الواقع وبكل وضوح- الأسباب نفسها التي جعلت الشريعة (الواقعية) تحرّم على غير المسلمين المشاركة كجنود في جيش الدولة الإسلامية. حيث نجده يقول:
«نصَّ قانون عام 1855م على وجوب تجنيد المسيحيين في الدولة العثمانية، وقد حاولوا الرفض لأنهم لا يريدونه ... إن التعايش بين هذين الصنفَيْن -المسلم والمسيحي- لا يمكن أن يستمر، من حيث أن يجتمعا في مركز واحد، وفي قطعة عسكرية واحدة، وتحت إمرة قائد واحد، فهذا من المستحيلات، كما أنه في ظل اختلاف ألسنتهم وأخلاقهم وأديانهم وأجناسهم المختلفة، فإن جمعهم في مكان واحد سوف يسبب مشكلة لا حل لها ... وأيضًا لأنه إذا التحق المسيحي بالجيش، فإن عليه أن يحارب بني جنسه ويُجبر على ذلك، أما في حالة المسلمين الذين هم تحت إمرة ضابط مسيحي، فهناك من المشكلات ما لا يُحصى، أولًا: الجندي المسلم لن يطيع أوامر قائده المسيحي، وكذلك كيف يتم تسليم السلاح إلى عدوه؟ ولهذا كانوا حذرين وخائفين من هذه الإشكالات ... إن الجيش العثماني أُسِّس على الشريعة الإسلامية، وهو على ذلك إلى الآن»(16).
لقد كان المسلم وغير المسلم مختلفَيْن ومنفصلَيْن، ويمثِّل تحقيق المساواة بينهما واختلاطها إهانةً، سواء للدين أو للسلوك العام(17). وعلى هذا الأساس، جاء رفض تجنيد المسيحيين من جميع قطاعات المجتمع. فعلى حين ذهب المسلمون إلى أن حياتهم ستكون عرضةً للخطر فيما لو جرى تسليح المسيحيين، فقد أبدى المسيحيون رغبتهم في عدم القتال تحت راية الرسول أو ضد مسيحيين آخرين(18).
وأجبر امتناع المسيحيين عن القيام بالخدمة العسكرية الحكومةَ العثمانية على مزيدٍ من التنازلات، فعلى الرغم من أن قانون عام 1855م نصَّ على وجوب تجنيدهم، فإن معارضتهم جعلت مرسوم 1856م يسمح لمن لا يريد التجنيد منهم أن يدفع بدل الخدمة مقابل إعفائه منها. وإنه لمما يبعث على الاستهزاء أنه لم يكن لهذه الضريبة المسمَّاة بـ«البدل العسكري» من معنى أكثر مما تعنيه «الجزية» التي كانت تُستلم من المسيحيين في السابق، وللسبب نفسه، أي نظير إعفائهم من الخدمة العسكرية. وهو ما يعترف به انجلهارد قائلًا: «إن البدل النقدي يوازي الضرائب التي كانت على المسيحيين التي أعفوا منها»(19). بل إن تحصيله كان يتم بنفس طريقة جباية الجزية المُلغاة(20).
ومهما يكن الأمر، فإن هذه التنازلات التي أساءت للمسلمين، الذين رأوا فيها انتقاصًا من الشريعة، لم ترضِ غير المسلمين أيضًا، فقد احتجوا مرةً أخرى ورفضوا دفع ضريبة «البدل»، في الوقت الذي لم تكن الدولة تقوى على إجبارهم بسبب الحماية التي كانت توفرها لهم الدول الأوروبية.
والحقيقة أن هذه الامتيازات التي سعت الدول الأوروبية جاهدةً لانتزاعها من الحكومة العثمانية لصالح الأقليات المسيحية فيها، لم تكن سوى أداة لخلق مجتمعات منفصلة ومتنافرة داخل جسد الدولة المتهالك تسهيلًا لتمزيقها، وهو ما تؤكِّده مواقفها المختلفة من الحوادث الكثيرة التي وقعت بسبب مشكلة اختلاف الدين عند تطبيق الإجراءات الجديدة. إذ عملت على وضع الدولة العثمانية محل جذب شديد، وأثارت الصعاب في وجه الحكومة العثمانية لمنعها من «توحيد الأفكار»(21) بشأن الإصلاحات التي كانت تنوي القيام بها، وهو ما تؤكِّده مواقفها التي تباينت كالتالي:
- فرنسا التي توافق على تشكيل جيش مختلط من المسيحيين والمسلمين(22).
- إنجلترا التي تريد تشكيل لواء خاص لكل فرقة(23).
- روسيا التي تطلب إعفاء المسيحيين من الخدمة في الجيش، بدعوى أن اجتماع المسيحيين مع المسلمين لا يؤمن المساواة(24).
- النمسا التي تدعو العثمانيين للعودة إلى النظام القديم المأخوذ من الشريعة الإسلامية؛ لأنها تتناسب مع عقيدتهم وعاداتهم، بينما القوانين والنُّظُم المأخوذة من الأوروبيين تناسب الدين المسيحي، ولكنها لا تتماشى مع العادات والتقاليد الشرعية ولا توافق أحوال الدولة العثمانية(25).
وعلى الرغم من أن آثار التنظيمات الخيرية على الدولة العثمانية ستُثبت لاحقًا -كما ستبيِّنه هذه الدراسة- أن نصائح النمسا للعثمانيين -التي جاءت على لسان رئيس وزرائها مترنيخ - كانت صحيحةً إلى أبعد مدى، فإنها لا تعدو أن تكون -في نظرنا- كلمة حق أُريد بها باطل، فهي لم تكن تستهدف مصلحة الدولة بقدر ما كانت تخدم سياسة عدم توحيد الأفكار بشأن الإصلاحات التي كانت الدول الأوروبية تنصح الدولة العثمانية بإدخالها، وذلك لجعلها في موضع شدٍّ عنيفٍ فيما بينها، وتشتيت أفكار المصلحين فيها وجهودهم، فقد كان من شأن ذلك أن يعجِّل بانهيارها.
كما كان ناجمًا عن نقمة النمسا على تعاظم النفوذ الفرنسي في الدولة العثمانية، والتقدُّم الذي أحرزته فرنسا فيها خلال فترة التنظيمات، حيث نجحت في فرض اعتماد النموذج الفرنسي للإصلاحات، الذي اختير من بين جميع مشاريع الإصلاح التي تقدَّمت بها الدول الأوروبية. وهو ما امتعض منه مترنيخ قائلًا: «إن اتخاذ تركيا القوانين الفرنسية نموذجًا واستغناءها عن بقية قوانين الدول الأخرى لمن العجيب»(26). وهو قول يؤكِّد أنه لم يكن صادقًا في نصائحه السابقة للمسؤولين العثمانيين، التي وصلت حدّ مخاطبته لهم قائلًا: «ابقوا أتراكا، تمسَّكوا بالدين والشريعة، واستفيدوا من التسهيلات التي تمنحها الشريعة الإسلامية لبقية الأديان»(27).
القضاء على نظام المِلل وإصدار قانون الجنسية 1869م
اعتقد رجال التنظيمات أن تطبيق مبدأ المساواة بين جميع رعايا السلطان كفيلٌ بصهر جميع طوائف الدولة في بوتقة «العثمنة»، فقاموا بشرح فكرة «العثمانية» كوسيلة لخلق قومية مشتركة بين الملل المختلفة في الإمبراطورية(28)، وتُوّج ذلك بصدور قانون الجنسية سنة 1869م، الذي نصَّ على أنه «يهدف إلى تكوين المواطنة العثمانية المشتركة، بغض النظر عن الانقسامات الدينية أو العِرقية»(29).
كان ذلك يعني القضاء على نظام «المِلل» الذي ظلَّ معمولًا به في الدولة العثمانية حتى ذلك الوقت، فقد بدى لرجال التنظيمات نظامًا متأزمًا، تسبَّب في خلق أشكالٍ من الوعي القومي و«الهويات» بين الإثنيات والطوائف المختلفة في الدولة العثمانية، وساعد على تفاقم التدخل الأجنبي بتقاطعه مع نظام الامتيازات الأجنبية الذي زاد في تمييز الطوائف المسيحية عن بعضها، بوضعها تحت أنماط مختلفة من الحماية.
بَيْدَ أن الحكومة العثمانية لم تكن مطلقة الحرية عند اتخاذ هذه الإجراءات الراديكالية التي كانت تعني تحويل الدولة العثمانية من سلطنة إسلامية إلى سلطنة يكون فيها أتباع جميع الأديان أعضاء متساوين في جسم الجماعة السياسي، ومشتركين معًا في شعور الولاء الوطني(30). إذ كانت واقعةً تحت ضغطٍ كبيرٍ مارسته عليها الدول الأوروبية، وبخاصة فرنسا، لتجسيد مبدأ المساواة القانونية الذي وعد به مرسوم 1839م.

نابليون الثالث
واتَّهم الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث ووزير خارجيته الدولةَ العثمانية بأنها «لا تريد تطبيق قانون المساواة بين المسلمين وغيرهم، وهي تفضِّل العنصر المسلم عن غيره على الدوام، كما أن رفاهية الشعب لن تتحقَّق ما لم يُطبَّق قانون المساواة بين جميع أفراد الشعب»(31). واتَّهمت الدول الأوروبية المسلمين بمعارضة التنظيمات، وسبب معارضتهم -في نظرها- أنهم كانوا ينظرون للمسيحيين على أنهم دونهم في المرتبة، مما حال دون حصول المسيحيين على حقوقهم كاملة(32). وقد حاول وزير الخارجية العثماني الدفاع عن نفسه إزاء هذه الاتهامات فقال: «إن أوروبا عندما كانت تعيش في ظلام دامس وجهل مُطبق، كان المسيحيون في الدولة العثمانية يعيشون على أكفِّ الراحة وبمطلق الحرية في دينهم وعقائدهم»(33).
وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت الدول الأجنبية تتَّهم الدولة العثمانية بالمماطلة والتسويف في تنفيذ وعود الإصلاح، حتى وجدت في انعقاد صلح باريس في عام 1856م فرصتَها المواتية لإجبار الحكومة العثمانية على التحرُّك بوتيرة سريعة نحو العلمنة، حيث أعلنت «صراحةً (أنه) إذا بقيت الشريعة تفرِّق بين المسلمين والمسيحيين، وإذا لم تُلغ فلن يكون هناك حلٌّ لهذه المشكلات»(34).
وهكذا فإنه تزامنًا مع المفاوضات التي كانت تجري في باريس لإنهاء الحرب التي كانت قائمةً مع روسيا، واستعطافًا للدول الأوروبية لدعم موقف الدولة العثمانية في مقررات الصلح، قام السلطان بإصدار برنامج إصلاحي جديد تضمَّنه الخط الهمايوني الصادر في 18 فبراير 1856م، وقد أُعلن عنه في اجتماعٍ حضره الوزراء وكبار الموظفين وشيخ الإسلام وبطارقة المذاهب المسيحية كافَّة وحاخامات اليهود، وفي معاهدة باريس التي أنهت حرب القرم أخذت الدول المتعاقدة علمًا به، وجاءت فقراته العشرون لتؤكِّد المساواة التامَّة بين جميع رعايا الدولة أمام القانون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن مِللهم ومعتقداتهم.
سعى الخط الهمايوني لكي تكون الامتيازات الممنوحة للأقليات الدينية في الدولة العثمانية أكثر تحديدًا ووضوحًا، ولتأكيد مبدأ المساواة التامَّة في جميع المجالات، حيث نصَّ على المحافظة على أرواح وأموال وأعراض جميع الرعايا والمساواة بين الجميع أمام القانون، ومراعاة الحقوق الشخصية إلى جانب الحقوق المشتركة، والمساواة في التوظيف وفي الضرائب وفي الحصول على الخدمات العامة، مع علانية المحاكمات، والتساوي في الشهادة من قِبَل الشهود، وتحريم مصادرة الأموال، وإنشاء محاكم مختلطة للمسلمين وغير المسلمين، والموافقة على وجود أعضاء غير مسلمين في المجالس الإدارية والمحاكم، وتجريم استعمال ألفاظ محقرة للجماعات غير المسلمة في الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة(35).
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان جاء تحت ضغط الدول الأوروبية، فقد ادعت حين أُبلغت به في مؤتمر باريس أن هذا التبليغ لا يمنحها الحقَّ في التدخل لا جماعيًّا ولا فرديًّا في علاقات السلطان مع رعاياه أو في إدارة شؤون إمبراطوريته(36).
لقد أكثر الخط الهمايوني من دلائل العطف على الأقليات؛ ولذلك فقد قوبلت هذه التنازلات بارتياحٍ كبيرٍ من جانب غير المسلمين(37). أما المسلمون فرآها عقلاؤهم تعديًا جديدًا على حكم الشريعة، في الوقت الذي رأى عامتهم أن ما أحرزه النصارى من الامتيازات جاء عن طريق أوروبا(38)، وأنها «دليل على إملاء القوى الأوروبية السياسة على السلطان»(39).
وفي الوقت الذي سعى فيه الأغوات والوجهاء المسلمون في الروميللي والأناضول إلى المحافظة على النظام الاجتماعي التقليدي الذي يستند إلى مبادئ الشريعة، احتجَّ الجوربجية (أعيان المسيحيين) -الذين كانوا يدفعون ضرائب قليلة، أو لا يدفعون ضرائب على الإطلاق حتى ذلك الوقت- على مبدأ المساواة في دفع الضرائب، وما ترتَّب عليه من إلغاء كل الإعفاءات والمزايا. في الوقت الذي أدى فيه فرض الضرائب على الأوقاف الدينية المسيحية وما ترتَّب عليه من قلَّة موارد رجال الدين المسيحيين -الذين كان نفوذهم قويًّا على أبناء طوائفهم- إلى سخط مسيحيي البلقان على الإصلاحات الجديدة(40).
وقوبل تدخل الحكومة المباشر في شؤون البطريركية باعتراض طائفة الروم الأرثوذكس(41) التي دعت أوروبا للتدخل في هذا الشأن، متهمةً الدولة العثمانية بالبُعْد عن الصدق والإخلاص حين إعطائها تلك الامتيازات والإعفاءات للمسيحيين(42).
كان يونانيّو حي الفنار في إسطنبول قد حازوا -منذ تشكيل بطريركية الروم عقب فتح القسطنطينية- وضعية متقدِّمة في الدولة العثمانية، حيث تشكَّلت منهم أغنى الفئات الاجتماعية في المدينة وأكثرها ثقافةً ونفوذًا، وكانوا يعملون إلى جانب الصرافين الأرمن في الصرافة والبنوك، وينهبون خيرات البلاد ويتهربون من الضرائب إلى جانب إعفائهم من الخدمة العسكرية. ولذلك لم يكونوا يرغبون أو يحتاجون إلى تبديل حياتهم الاجتماعية، مما جعلهم يعارضون التنظيمات الخيرية التي كانت تهدِّد بفقدان الكثير من امتيازاتهم التي ظلوا متمتعين بها حتى ذلك الوقت(43).
أما الدول الأوروبية، فبعد أن كانت تضغط بكل قوتها للدفع بالحكومة العثمانية في اتجاه فرض المساواة التامَّة بين المسلمين وغير المسلمين، مما يستوجب توحيدها للقوانين، والاستعاضة عن قوانينها المستقاة من الشريعة الإسلامية بالمبادئ العلمانية المقتبسة من أوروبا، التي تنصُّ على إعطاء الحقوق والواجبات نفسها لجميع المواطنين بصرف النظر عن أديانهم ومعتقداتهم، فإنها سرعان ما غيَّرت من خط توجُّهها بعد أن تحقَّق لها هذا الهدف بفعل مقررات خطي شريف همايون لسنة 1856م. حيث تبدت لها المصلحة السياسية من الإبقاء على استقلالية الطوائف المسيحية، وعلى الحقوق والامتيازات التي كانت تتمتَّع بها هذه الطوائف ضمن نظام الملل القديم الذي جرى تحطيمه!
ومن دون الشعور بالحاجة إلى تبرير التناقض الحاصل في مواقفها، فإن موقف الدول الأوروبية -وعلى رأسها فرنسا وروسيا- من توحيد المِلل غير المسلمة في الدولة العثمانية كان المعارضة، على الرغم مما ينطوي عليه من مناقضة لمبدأ التآخي والمساواة التامَّة الذي كانت تصرُّ على أن يشمل المسلمين وغير المسلمين دون تمييز، رغم ما بينهما من اختلافاتٍ لا يمكن تجاهلها.
وهكذا أعلنت دون مواربة أنه «من المستحيل توحيد المِلل غير المسلمة في الدولة العثمانية ووضعها تحت حكم واحد ... وذلك لأن الروم لا يريدون أن يتبعوا السلاف، والسلاف لا يريدون أن يتبعوا الأرمن(44)». وما دامت المذاهب لا تريد الاتحاد ولا توافق عليه، فيجب أن تكون هناك قوانين وأنظمة مخصَّصة لكل فرقة على حدة لكي يتم جمعهم تحت سماء واحدة»(45).
يبرهن هذا المطلب الأخير بما لا يدع مجالًا للشكِّ أن المشكلة لم تكن أبدًا في نظام المِلل القديم(46)، وأن مطالبة الدول الأوروبية بإعادة العمل به، بعد أن ألجأتها مصلحتها في حصول المسيحيين على حقوق مساوية للحقوق التي كان يتمتع بها المسلمون، كانت لتقويضه، وعندما تجسدت لها هذه المصلحة واقعيًّا بسن قانون المواطنة والجنسية، رأت أنه جاء الوقت المناسب لإعادة النظام القديم الذي كان مطبقًا على الطوائف الدينية -بعد تحويره وتخليصه من العناصر التي كانت تحول في الماضي دون استفادة المسيحيين من الامتيازات التي كانت حكرًا على المسلمين- بالعمل على الإبقاء على امتيازاتهم السابقة والحؤول دون المساس بها في آن واحد.
إن سياسة الكيل بمكيالَيْن التي انتهجتها الدول الأوروبية قد أُجبرت الحكومة العثمانية على اعتمادها رسميًّا في مرسوم 1856م، فعلى الرغم من نصِّه على معاملة جميع رعايا الدولة معاملةً متساويةً مهما كانت أديانهم ومذاهبهم، فقد نصَّ أيضًا على المحافظة على الحقوق والامتيازات التي تمتَّع بها رؤساء المِلل غير الإسلامية، وذلك على الرغم من استهدافه القضاء على حواجز نظام المِلل، وتمتّع كل سكان الإمبراطورية بمواطنة عثمانية عامة(47)!
استفادت الطوائف غير الإسلامية إلى حدٍّ كبيرٍ من التغلغل الأوروبي في الدولة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، ومن التنظيمات نفسِها، مما زاد في ثروتها ومكانتها ونفوذها.
وذلك بالإضافة إلى تقاطع هذه السياسة مع نظام الامتيازات الأجنبية، بأنواعها المختلفة التجارية والثقافية والقنصلية، الذي كانت الدول الأوروبية قد عملت على أن يستفيد منه بشكل خاص المسيحيون الذين كانوا تحت حمايتها، عن طريق تشغيلهم كوكلاء لتجارتها في الدولة العثمانية(48)، وتدريسهم في مدارس الإرساليات التي ضمنت لهم الحصول على تعليم حديث(49). ثم لم تلبث إصلاحات عهد التنظيمات أن زادت في تقدُّم المسيحيين بسماحها لهم بالدراسة في المدارس الحديثة التي أنشأتها الدولة، وكذلك بفتحها مجالات التوظيف في وظائف الدولة الرسمية أمامهم. وهكذا استفادت الطوائف غير الإسلامية إلى حدٍّ كبيرٍ من التغلغل الأوروبي في الدولة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، ومن التنظيمات نفسِها، مما زاد في ثروتها ومكانتها ونفوذها.
لقد أكَّدت جميع سياسات الدول الأوروبية سالفة الذكر تجاه الطوائف المسيحية في الدولة العثمانية، أنها كانت تستهدف الصعود بهم ليصبحوا أكثر العناصر ثراءً وثقافةً ونفوذًا في الدولة. وبتوجيهها لسياسة التنظيمات -بالشكل الذي رأيناه- إنما سعت إلى منحهم حقوقًا وحرياتٍ تساوي أو تفوق تلك التي كانت للمسلمين. ولذلك فلا غرابة أن يكون إحدى نتائج سياسة التنظيمات هو شعور المسلمين بالغبن وبتفوُّق غير المسلمين عليهم، وهو شعور لم يكن ناجمًا عن تعصُّبهم أو عن كونهم ظلوا يعدّون المسيحيين في المرتبة الثانية كما وصفتهم الدول الأوروبية(50)، بقدر ما كان -في نظرنا- تعبيرًا عن ردة فعل حقيقية على سياسة هذه الدول التي أثبتت أنها كانت تريد الحصول على نتيجة عكسية تمامًا، وهي تحويل المسيحيين -الذين لم تكن نسبتهم تزيد على 10% من مجموع شعوب الإمبراطورية(51)- إلى مواطنين من الدرجة الأولى، في مقابل تحويل المسلمين -الذين كانوا يشكلون الأغلبية- إلى «أهل ذمَّة» في دولة إسلامية!
كانت إحدى نتائج هذه السياسة أن الطوائف التي كانت قد عاشت قرونًا طويلة في تعايشٍ حضاريٍّ مُثمِر بفضل سياسة التسامح الديني التي مارسها الحكم الإسلامي تجاه «أهل الذمَّة» عمومًا والمسيحيين على وجه الخصوص، اندفعت في عهد التنظيمات الخيرية بصورة معاكسة تمامًا لمبدأ الاتحاد والتآخي الذي دافع عنه المصلحون من أجل سحب ذرائع التدخل الأجنبي، بحيث «شكَّلت الصدامات الدامية التي وقعت بين الرعايا المسلمين وغير المسلمين السمةَ السائدة في الأحداث الداخلية لذلك العهد، ومهَّدت السبيل ليس لتحريض الدول الأوروبية فحسب بل لتدخلاتها أيضًا»(52).
وهكذا كان تحرُّك المسلمين ضد المسيحيين في بلاد الشام سنة 1860م ردًّا على سياسة التنظيمات الخيرية التي كانت تشكِّل -في نظرهم- خطرًا على الإسلام بما أحرزته من تقدُّم للمسيحيين، أو بما نجم عنها من نموٍّ للنفوذ الأجنبي الذي يستند إليه المسيحيون(53). وهكذا كان يبدو للمسلمين «أن الحضارة التي تجلبها أفكار المسيحيين تهدِّد الإسلام في مهده، حيث يجب أن تظل العقيدة الإسلامية سيدةً لا تُمس»(54).
ومن ثَمَّ استغلَّت فرنسا الفرصةَ للتدخل في بلاد الشام بحجَّة حماية المسيحيين الذين تعرضوا للقتل على أيدي المسلمين(55). والواقع أن فرنسا هي التي مثَّلت تاريخيًّا حتى ذلك الوقت «سياسة الحماية للكاثوليك» في الشرق، وسيكون تدخلها في لبنان عام 1860م استنادًا إلى هذه الحجة أيضًا، حيث استمرت حتى ذلك الوقت تمارس -عبر تدخل حكومتها وسفرائها وقناصلها- أشكالًا مختلفة من الحماية للمسيحيين الكاثوليك والموارنة(56). وهو ما أكَّده مؤلف معاصر لتلك الفترة، حين ذكر أن الموارنة كانوا يعدّون أنفسهم من الفرنسيين ويحبون فرنسا ويتظاهرون بالانتماء إليها، وأن لقنصل فرنسا نفوذًا وكلمةً في بلادهم(57).
ولم تُبد الحكومة الفرنسية هذا الاهتمام بنصارى المشرق إلَّا لأنها أرادت أن تضع موطئ قدم لها في لبنان تمهيدًا للسيطرة عليه، وذلك بزرع بذور الشقاق بين المسلمين وغير المسلمين. وهو ما كشف عنه واحدٌ ممَّن شهدوا فتنة 1860م، حيث قال: «كانت المملكة الفرنسية في ذلك الحين قد بلغت من القوة مبلغًا عظيمًا، وحلَّت من المجد في عهد إمبراطورها نابليون الثالث أوجًا رفيعًا، وقد كان هذا الإمبراطور يحدق إلى جبل لبنان تحديق طامع إلى افتراع هضبة، طامع في ضمِّه إلى ملكه، ويؤنسه فيه وجود الطائفة المارونية(58) الشديدة الإخلاص والتعلُّق بالدولة الإفرنسية (كذا)، فكان الفرنسيون لا يفتؤون عن بثِّ روح الشقاق والنزاع بين سكان الجبل، لعل لهم في نشوب حرب ضروس بين الدروز والنصارى سبيلًا إلى احتلال لبنان ووضع سيطرتهم عليه، فانبثت هذه الروح الشريرة بين جميع النصارى»(59).
وهكذا استغلَّت فرنسا الآثار التي ترتَّبت عن سياسة التنظيمات الخيرية في بلاد الشام، والتخلخل الذي أحدثته في المجتمع بسبب ما أضافته من امتيازات جديدة لصالح المسيحيين المستفيدين أصلًا من وضعهم قبل ذلك تحت الحماية الأجنبية، وتدخلت باسم حمايتهم لبسطِ سيطرتها على المنطقة. وكانت صدامات أخرى بين المسلمين والمسيحيين قد وقعت في جدة سنة 1857م، فتدخل الإنجليز من جهتهم وأنزلوا جنودهم إلى البر، في الوقت الذي انتشرت فيه حركات السخط في البوسنة والهرسك وبلغاريا وكثرت الصدامات في أنحاء متفرقة منها(60).
من جهة أخرى، أعطى ترك الحكومة العثمانية للطوائف حرية تسيير شؤونها الداخلية الحقَّ في أن تنغلق على نفسها في كياناتها الخاصة، فكانت تلك أيضًا من أبرز مفارقات التنظيمات. فالمثل الأعلى للاتحاد والإخاء الذي كانت تنشده كان براقًا من الناحية النظرية على الأقل ليتم الترحيب به، ولكنه ترافق عمليًّا مع نتيجة عكسية، وهي نهضة مختلف «أُمم» الإمبراطورية، واستعادة مصطلح «المِلل» الذي كان يشير إليها مفهوم الطوائف الدينية، ولكن هذه المرة تحت تأثير النزعات القومية الأوروبية والمبدأ العثماني الخاص «حرية التصرف» في مجال إدارة شؤون الطوائف(61).
كان من شأن ذلك كله أن يمنح المناطق ذات الأكثرية المسيحية في الدولة العثمانية والمستظلة تحت مظلة الحماية الأجنبية فرصًا جديدة تتيح لها أن تقوِّي نفسها وتثور، فالشعوب المسيحية في البلقان كانت تشعر بشعورٍ وطنيٍّ خاص، وكانت ترغب في الاستقلال، بينما كان الشعور الوطني العثماني يكاد يكون غير موجودٍ هناك(62)، مما أدى إلى انتشار حركات السخط والانفصال.
لقد منحت التنظيمات الخيرية حريةً للمسيحيين دون أن تزوِّدهم بمبدأ الولاء للسلطنة، ورغم تطلُّع المصلحين إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع رعايا السلطان بهدف صهر جميع طوائف الدولة في بوتقة «العثمنة»، فإن الولاءات الدينية كانت لا تزال من القوة بحيث يصعب القضاء عليها في الحال، وهكذا ظلَّت الطوائف غير الإسلامية غير مقتنعة أو غير متأثرة بسياسة «العثمنة»، وبدلًا من إبداء ولائها للدولة ازدادت مطالبتها بمزيدٍ من الحقوق(63) استنادًا إلى الحماية التي كانت توفرها لها الدول الأوروبية.
توحيد القوانين وعلمنتها في إمبراطورية متعدِّدة الإثنيات والأديان ونتائجه
شملت التنظيمات العثمانية السياسةَ العثمانية التي كان من المفترض أن توحّد شعوب الإمبراطورية المسلمة وغير المسلمة، التركية والعربية واليونانية والأرمنية واليهودية والكردية مع امتداد نحو مناطق البحر المتوسط. ولهذا الغرض وُضعت الشريعة الإسلامية جانبًا لمصلحة البدء بالعلمنة، أي إصدار القوانين المدنية التي تكفل علمنة البلاد وترسيخ «المواطنة»، عن طريق إعلان المساواة أمام القانون بين العثمانيين كافَّة بصرف النظر عن مِللهم وأعراقهم ومذاهبهم.
بيد أن تقارير مدحت باشا التي أرسلها إلى إسطنبول عندما كان واليًا على سورية عام 1879م تشكِّل مصدرًا مهمًّا للكشف عن مظاهر المأزق التطبيقي للتنظيمات، حيث يشدِّد على عنصرٍ من عناصر أزمة التنظيمات، وهو خلوّها من أخذ التنوّع في البلاد بعين الاعتبار، حيث يقول في أحد تقاريره: «مما لا يحتاج للبيان والتعريف لديكم أن ولاية سورية أوسع من غيرها من ولايات الدولة، وأن أهلها من العرب والأتراك والتركمان والدروز والنصيرية والروم والموارنة والكاثوليك والبروتستانت والسريان والأرمن، ويتألف من هؤلاء شعب عدده أربعة وعشرون نوعًا من المِلل والأديان والمذاهب، ينضمُّ إليهم الجزائريون والشراكسة والتتار وغيرهم من المهاجرين. ومن جهة أخرى، فإن أطوار وأحوال العربان والعشائر معلومة لديكم، وإن إدارة هذه الأجناس المختلفة على قاعدة واحدة وما تولده من مشاكل غنيّ عن التعريف والتوضيح»(64).
أضف إلى ذلك أن انتشار الأفكار الغربية الناجم عن تزايد النفوذ الأوروبي وتغلغله في بلاد الشام أضاف بعدًا جديدًا على أبعاد النزعات المحلية(65)، بينما قامت القنصليات الأوروبية -التي تأسَّست في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياته- بدعم مصالح غير المسلمين(66). وهو ما أكَّده أحد المعاصرين(67) حين روى أن «كل واحد من طائفة النصارى له أقارب داخل أحدهم تحت حماية أحد الأجانب ويُعد من رعيته، وكان أكثرهم تحت الحماية الفرنسية»(68).
وكان من آثار معاهدات الامتيازات الأجنبية أن أصبح الاقتصاد المحلي مرتبطًا بفلك الاقتصاد الأوروبي، وفُتحت السوق السورية للبضائع الأوروبية. فلم يتوانَ الكثيرون من المسيحيين واليهود عن العمل كوكلاء للمصالح الأوروبية مقابل الثروة الكبيرة التي حصلوا عليها(69).
ويبيِّن محمد أبو السعود الحسيبي الدمشقي في مذكراته العلاقات الاقتصادية التي كانت قائمةً بين المسيحيين والفرنسيين في بلاد الشام بقوله: «...صاروا (المسيحيون) هم والفرنج يدًا واحدة، حتى صار الفرنج يعطونهم مبالغ من الدراهم لخزن الحنطة والشعير، وسائر أنواع الحبوب والسمن والصوف والقطن، وسائر ما يلزم الفرنج يأخذوه ويرسلوه إلى بلاد الفرنج، وكان غالب شغلهم من الفرنساوي»(70).
لقد كان التجار الأوروبيون بحاجة إلى وكلاء وتراجمة ومقاولين، فلم يكن لهم من خيار سوى الاستفادة من المسيحيين الذين كانوا على استعداد للانضمام إليهم، وهكذا كانت كل التجارة الأوروبية في أيدي المسيحيين واليهود، وكانت شركة اللفانت الفرنسية لا تتعامل إلَّا مع من هم تحت الحماية الفرنسية في مصر وسوريا، وكان الأرمن يقومون على معظم التجارة بين حلب وبغداد، وكانت التجارة المحلية في مصر وسوريا والأناضول في أيدي السوريين المسيحيين واليونانيين والأرمن واليهود من رعايا الدولة العثمانية(71).
وزاد من تقدُّم المسيحيين وتفوُّقهم تلك الامتيازات التجارية التي منحتها الدولة العثمانية للدول الأوروبية؛ إذ جرى بمقتضاها تخفيض ضرائب الاستيراد، فكان المسيحيون السوريون واليهود أكبر المستفيدين؛ لأنهم استطاعوا الحصول على حماية قنصليات الدول الأجنبية بمقتضى معاهدات الامتيازات الأخرى، وبذلك شملتهم أيضًا بالحصانة إزاء الضرائب العثمانية، وذلك في الوقت الذي أضرت فيه بالحِرفيين المسلمين؛ لأنها تركت الضرائب الداخلية مفروضةً كما كانت على الصُّنَّاع المحليين، الذين كان عليهم أن ينافسوا ببضائعهم بضائعَ مستوردة رخيصة من صنع الآلة، فُرضت عليها ضرائب أخفُّ من تلك التي فُرضت على منتجاتهم المحلية(72). وعلى الأرجح، كانت تلك هي الأسباب التي جعلت المسلمين العاطلين عن العمل -بسبب تراجع الحِرف المحلية أمام البضائع الأوروبية- يصبون غضبهم على المسيحيين المحليين الذين كان عامَّة الناس يقرنونهم بالمصالح الأوروبية(73).
وخلاصة القول أن الطوائف غير الإسلامية استفادت إلى حدٍّ كبيرٍ من التغلغل الأوروبي في الدولة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، ثم جاءت التنظيمات لتزيد من نفوذهم وتفوُّقهم دون أن تضع في الاعتبار النتائج التي ترتَّبت عن تقاطعها مع نظام الامتيازات الأجنبية على أرض الواقع، التي كانت نكبةً على المسلمين. وهكذا فإن التنظيمات التي لم تتمكَّن من إكساب الدولة ولاء رعاياها المسيحيين، فاقمت من مظاهر السخط بين المسلمين بسبب «ما اعتبروه تعزيزًا آخر لمنزلة غير المسلمين»(74).
القانون التجاري ونتائجه
كان الضغط الأوروبي -المتمثِّل في رأسماليات توسعية وتنافسية تبحث عن أسواق ومناطق نفوذ- يعمل جاهدًا على الدفع بالحكومة العثمانية نحو إدخال إصلاحات مواكبة لهذا التوسُّع، كالقانون التجاري مثلًا. إذ كان التحديث من جهة الرأسماليات الأوروبية وسيلةً لتسهيل علاقات التبادل وتوسيع السوق الرأسمالية وحماية الجاليات الأجنبية ووكلاء التجارة المحليين(75).
لقد أدى اتساع العلاقات التجارية مع الغرب إلى خلق مشكلات ووضعيات اقتصادية معقَّدة لم تألفها أعرافُ الحرفيين والتجَّار المحليين وتقاليدُهم في المدن، الذين اعتادوا فضَّ خلافاتهم في إطار التنظيم الاجتماعي لطوائف الحرف أو لدى القاضي مباشرةً في المحاكم الشرعية(76). بينما كانت الوضعيات التجارية المستجدَّة التي انخرط فيها التجَّار الأجانب ووكلاؤهم المحليون، مع اتساع حركة «التتجير» جراء ازدياد الامتيازات الأجنبية، تستدعي لدى هؤلاء الأجانب ووكلائهم نصوصًا قانونية تستجيب لمعطيات التجارة العالمية وقوانينها الدولية من جهة، وتنظم علاقاتهم التجارية مع المدن والموانئ الإسلامية من جهة أخرى.
وفي عام 1850م، اتُّخذت في هذا الصدد خطوة أكثر راديكالية تمثَّلت في صدور قانون رشيد باشا التجاري، وكان علماء الدين قد نجحوا في السابق في تأخير تطبيق القانون التجاري الجديد، بدعوى أنه يتناول دائرةً من الحياة قد عالجتها الشريعة بتفصيل ودقَّة(77)، وذلك عندما قدَّمه رشيد باشا إلى المجلس الأعلى في عام 1841م، ووقتها سُئل رشيد باشا إذا ما كان موافقًا للشريعة، فأجاب بأن «ليس للشريعة علاقة بهذا الموضوع»، فاحتجَّ العلماء الحاضرون، وهو ما جعل السلطان يقوم بطرده فورًا من المجلس(78).
ومنذ عام 1850م، أجاز هذا القانون التجاري الجديد -الذي تمَّ إعداده استنادًا على النماذج الفرنسية- التسليف مقابل فائدة (الربا)، وأدخل أشكال مشاركة لم يعرفها القانون الإسلامي(79)، فكان صدوره -على الرغم من اعتراضات العلماء الذين رأوا فيه انتقاصًا من الشريعة- بمثابة أول اعتراف رسمي في الدولة العثمانية بنظام القانون والقضاء المستقل عن العلماء، والتعامل مع القضايا بصورة خارج نطاق الشريعة. وكان ذلك يعني خروجًا جذريًّا عن الممارسات العثمانية السابقة، ونذيرًا بقيام ثورة قانونية واجتماعية كاملة(80).
وعلى الرغم من أن هذا القانون لم يحقِّق الإجماع، مما أدى إلى نشوب سجالات حارة، فإنه لم يتسبِّب في مواجهات إلا نادرًا، ويعزو بعض الباحثين ذلك إلى «أن تشريعات التنظيمات (كانت) تعرف بوجه عام المزج جيدًا بين الإسلام والتجديد»(81).
محاولات اعتماد القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) ونتائجها
كان الصدر الأعظم عالي باشا شغوفًا بأن يتبع سابقة القانون التجاري ويتبنَّى القانون الفرنسي قانونًا للإمبراطورية(82)، وكان يسانده في ذلك قبولي باشا وزير التجارة، الذي كان يصرُّ على هذا الرأي، حتى إنه عمد إلى ترجمة مواد القانون الفرنسي إلى التركية، وسعى إلى دفع الوزراء للتصديق عليه، في الوقت الذي كان فيه السفير الفرنسي -أكثر السفراء نفوذًا في إسطنبول وقتئذ- يضغط بشدَّة في اتجاه العمل بالقانون الفرنسي في المحاكم العثمانية(83).

أحمد جودت باشا
بيد أن عددًا آخر من الوزراء -وعلى رأسهم أحمد جودت باشا(84) وزير العدل، وشرواني زاده رشدي باشا الذي شغل منصب وزير المالية لفترة ووزير الخارجية لفترة أخرى- كانوا يرون -على العكس من الفريق الأول- أن تُجمع المسائل الشرعية بما يوافق متطلبات العصر، التي تدخل في باب المعاملات من الفقه، لتكون هي الأحكام الشرعية للمسلمين، وفي مقابل ذلك يتمُّ تأليف كتاب يكون قانونًا لرعايا الدولة غير المسلمين(85).
وبسبب انقسام الأفكار، تقرَّر إنشاء لجنة وزارية خاصة لدراسة هذه المسألة، تمكَّن في خلال مناقشاتها أحمد جودت باشا ورشدي باشا -بما ساقوه من أدلة وبراهين- من إقناع اللجنة بالعدول عن قرار اعتماد قانون نابليون في الدولة العثمانية، وانتهى الأمر -كما يقول أحمد جودت باشا- بقرار اللجنة «تشكيل جمعية علمية تضمُّ كبار الفقهاء تحت رئاستي، لوضع كتاب بعنوان: «مجلة الأحكام العدلية»، تُجمع فيه المسائل المسايرة لمتطلبات العصر في باب المعاملات من الكتب الفقهية ... وهذه الجمعية العلمية المشهورة هي التي أُطلق عليها اسم «جمعية المجلة»، وأصبحت مجلة الأحكام العدلية معمولًا بها الآن في كل المحاكم النظامية»(86).
احتلَّت مجلة الأحكام العدلية مكانة خاصة لا في تاريخ القانون العثماني وحده، بل في تاريخ الحقوق الإسلامية عمومًا بوصفها النموذج الأول لعملية التقنين الرسمي في التشريعات الإسلامية.
جرى إعداد مجلة الأحكام العدلية -وهي المرادف العثماني للقانون العثماني- اتباعًا للنظام التقليدي الإفتائي في الفقه الإسلامي، وبذلك لم تخرج عن كونها جمعت بين أحكام القوانين الإسلامية التي كانت سارية المفعول حتى ذلك الوقت، في حين انحصر تأثُّرها بالقوانين الغربية في الجوانب الشكلية دون سواها(87). واحتلَّت مجلة الأحكام العدلية مكانة خاصة لا في تاريخ القانون العثماني وحده، بل في تاريخ الحقوق الإسلامية عمومًا بوصفها النموذج الأول لعملية التقنين الرسمي في التشريعات الإسلامية(88). فقد ظل معمولًا بقوانينها في تركيا إلى أن أُلغيت على يد الجمهورية في عام 1926م، ولا تزال تشكِّل أساس النُّظُم القانونية للعديد من الدول الإسلامية التي خلفت العثمانيين في آسيا(89).
علمنة التعليم ونتائجها
لم يُشر خط شريف جولهانه إلى التعليم بكلمة واحدة، ولكن رجال التنظيمات سرعان ما أدركوا أن التغييرات الجذرية التي كانوا ينوون إدخالها على نُظُم الدولة العثمانية وقوانينها في مختلف الجوانب العسكرية والعدلية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى تكوين نخبة نادرة تكون قادرةً على إدارة عملية التحديث على النمط الغربي بفعالية كاملة(90).
ولكن علمنة التعليم ستسير ببطء شديد بسبب قصور في الإمكانيات من جهة، ولعدم وجود عدد كافٍ من المدرّسين المتشبّعين بثقافة الغرب وعلومه لتسيير المدارس الحديثة التي أنشأتها الدولة من جهة أخرى. وهو أمر لم ينطبق على مدارس الأقليات غير الإسلامية التي شهدت رواجًا تعليميًّا حقيقيًّا(91).
تناول الخط الهمايوني سنة 1856م مسألة التعليم بمادة وحيدة نصَّت على أن «يجري قبول رعايا الدولة العثمانية دون أي تمييز في المدارس العسكرية والمدنية ... كما يحقُّ لكل طائفة دينية أن تقيم مدارس لها في مجالات العلوم والفنون والصنايع». ويفهم من هذه المادة الوحيدة أن الهدف الرئيس منها هو ضمان حق الأقليات غير المسلمة في إقامة المؤسسات التعليمية الخاصة بها، مع منحها امتيازاتٍ أخرى كحق الالتحاق بمدارس المسلمين، بالإضافة إلى الاستقلالية في التعليم(92).
وكانت نتيجة ذلك أن ظهرت إلى الوجود في غضون بضعة عقود مئاتٌ من المدارس التي تقدِّم تعليمًا حديثًا في الدولة العثمانية، ولكن هذه المدارس لم تُفلت من يد رجال الدين الذين يشرفون على الطوائف(93). ومن جهة أخرى، أغرى منح التسامح الديني للمسيحيين الأوروبيين بإرسال البعثات التبشيرية، فازداد عدد الإرساليات الأجنبية: أمريكية ونمساوية وفرنسية وانجليزية وألمانية وإيطالية(94).
وقد احتلت البعثات البروتستانتية الأمريكية موقع الصدارة في هذا الصدد، ففي عام 1870م كان هناك 205 مدارس أمريكية في الدولة العثمانية، وارتفع عددها إلى 390 مدرسة عام 1885م تضمُّ 13800 تلميذ. كما أسست البعثات البروتستانتية الأمريكية العديد من الكليات، كان من أشهرها: كلية روبرت (Robert College) في إسطنبول (1863م)، والكلية السورية الإنجيلية في بيروت (1866م)(95).
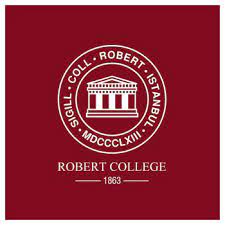
شعار كلية روبرت
بينما تمتَّعت البعثات التبشيرية الفرنسية بحرية أوسع، فعلى الرغم من تقدُّم المدارس الأمريكية، فإن فرنسا هي التي أكَّدت بشكل أكثر قوة وجودَها الثقافي في الدولة العثمانية، فاللغة الفرنسية كانت هي اللغة السائدة في الحياة الثقافية، وكان لفرنسا دور في تأسيس الكليات، كما أسَّست المئات من المدارس من خلال تعاونها مع البعثات التبشيرية اليسوعية والعازارية(96). وبالإضافة إلى ذلك، كان لبريطانيا نشاطها في البعثات التبشيرية أيضًا، وكذلك كان هناك نشاط تعليمي لألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، بيد أنه كان محدودًا(97).
وفي الولايات العربية نشطت البعثات التبشيرية في تأسيس الكليات والمدارس، وقد سهلت الدولة العثمانية سُبل ذلك بسبب ضعفها وضغط الدول الأوروبية عليها، فانتشرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية المتعدِّدة، وانضمَّت إليها في هذه المرحلة البعثات البروتستانتية المتنوِّعة الدول بمدارسها الابتدائية والثانوية للبنين والبنات في معظم أنحاء الولايات العربية، وبخاصة في المناطق التي تتجمَّع فيها الطوائف المسيحية مثل لبنان من بلاد الشام(98).
وعلى الرغم من أن هذه المؤسسات التعليمية والثقافية المتنوعة التي أنشأتها مختلف البعثات الدينية الغربية في البلاد العربية قد فتحت هذه البلاد على عالم الغرب وحضارته، فإنها تركت تيارات فكرية متباينة ومتلاطمة بما أوجدته من اتجاهات بعيدة أحيانًا عن الأصالة العربية والدين الإسلامي، وبما ولدته من نزعات استقلالية طائفية وتصدعات في المجتمع العربي(99).
من جهتها، توسعت الدولة العثمانية خلال حقبة التنظيمات في إنشاء المدارس الحديثة، فإلى جانب مدارس الصبية الابتدائية (لتحفيظ القرآن) التي حافظت على أسلوبها القديم، ازداد عدد المدارس الأعلى منها في الترتيب الهرمي للتعليم العثماني، حيث تأتي المدارس الرشدية وتليها المدارس الإعدادية، وقد تضاعف عدد هذه المدارس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بنسبة 1000% للمدارس الرشدية، و1800% للمدارس الإعدادية(100).
وبموجب الإرادة السَّنية الصادرة في 22 فبراير/شباط 1867م، أصبحت نظارة المعارف العثمانية تابعةً في برنامجها التعليمي للنظام الفرنسي(101)، وذلك تحت ضغط فؤاد باشا الذي كان وزيرًا للخارجية، حيث قدَّم له السفير الفرنسي مشروعًا لإصلاح النظام التعليمي العثماني على أُسس فرنسية، ووعده بتقديم المساعدة على تنفيذه، وذلك عن طريق تزويد الدولة بالمدرسين الفرنسيين، ولم يكن يوجد في ذلك الوقت -في نظر انجلهارد- مَنْ يفهم هذه الأفكار ويقدّرها أكثر من فؤاد باشا(102) الذي كان قد درس أصلًا في فرنسا وتأثَّر بنظمها.
كانت الحكومة العثمانية قد أصرَّت على التدريس باللغة التركية في المدارس، ولكن فرنسا أصرَّت على التدريس باللغة الفرنسية؛ لأن أكثر المدرّسين فرنسيون.
وبناءً عليه، تغيَّرت المناهج الدراسية للمدارس الرشدية والإعدادية لتشمل إلى جانب مختلف العلوم الحديثة اللغة الفرنسية، التي كانت لها حصة الأسد بين المواد الدراسية بحيث تجاوز نصيبها الساعات المخصَّصة للغة التركية. وكانت الحكومة العثمانية قد أصرَّت على التدريس باللغة التركية في المدارس، ولكن فرنسا أصرَّت على التدريس باللغة الفرنسية؛ لأن أكثر المدرّسين فرنسيون، وبدعوى أن التدريس باللغة التركية لن يحقِّق المطلوب من هذه المدارس الحديثة وستبقى كما في الماضي، كما أنه يجب أن يدرس المدرّس بلسانه، وهو اللغة الفرنسية(103).
وفي عام 1868م، التقى السفير الفرنسي في إسطنبول بالصدر الأعظم عالي باشا ووزير الخارجية فؤاد باشا، وأجروا محادثاتٍ حول إقامة مدرسة تمارس التعليم الفرنسي على مستوى المدارس الثانوية (الليسيه) في فرنسا، كما وعد وزير التعليم الفرنسي مسيو فيكتور دوروي بتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لإقامة المدرسة(104).
وهكذا أُنشئت مدرسة غلطة سراي، فكانت بمثابة المحاولة الأولى من جانب حكومة إسلامية لتوفير تعليم علماني قوامه اللغة الفرنسية، ويشترك فيه التلاميذ المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب(105). وكان تأثير هذه المدرسة تأثيرًا ضخمًا في الدولة العثمانية، فالتلاميذ الذين تخرجوا فيها والذين جرى تزويدهم بتعليم علماني مستورد بالكامل من الخارج وبلغة فرنسية، كان بوسعهم أن يصلوا إلى أعلى مراتب الوظائف العامَّة في الدولة(106)، وقد قُدّر لهم أن يلعبوا دورًا بارزًا في سياسة الإمبراطورية العثمانية وإدارتها بعدها في سياسة الجمهورية التركية(107).
لقد كان من نتائج هذه السياسات التعليمية التي شهدها عهد التنظيمات الخيرية ازدياد الهوَّة في النظر إلى الأشياء بين فئات المجتمع وطوائفه، ففي حين وصل إلى السلطة نخبة متأثرة بالغرب تلقت تعليمًا علمانيًّا، فسعت إلى إدخال مؤسسات أوروبا بالجملة إلى الدولة، فقد فرضت منطقها وإرادتها على مجتمع ظلَّ -في أغلبه- محافظًا ورافضًا لأي مساسٍ بسلطة وسيادة الشريعة.
وفي حين كان المسلمون يتهربون من دخول تلك المدارس المختلطة التي أقامتها الدولة(108)، كان غير المسلمين -من جهتهم- جدّ متعلقين بتراثهم اللغوي والثقافي، بحيث يصعب عليهم الذوبان في نظامٍ تعليميٍّ يحمل -رغم حداثته- علامةَ التركية والإسلام، ناهيك عن أنه كانت لديهم مدارسهم الخاصة الأفضل غالبًا من المؤسسات التي كانت تحت إشراف الدولة، وهي المدارس التي سوف تُسهم في اليقظة القومية للأقليات(109)، مما سيؤدي إلى نتيجة عكسية للأهداف التي في سبيلها رأينا الخط الهمايوني يرصد كل الامتيازات التعليمية للأقليات غير المسلمة، دون أن يرصد أي هدفٍ لأجل الحياة التعليمية والعلمية الخاصة بالمجتمع المسلم. وهكذا لم تترك التنظيمات -سواء عن قصد أو دون قصد- أمام المسلم إلَّا أحد خيارين: إما أن ينسلخ عن جلده ويتنكر لتراثه، وإما أن يبقى غارقًا في جهله.
السماح للأجانب بشراء الأراضي وبيعها ونتائجه
كانت «دار الإسلام» تعني في نظر الشريعة الإسلامية المناطق المنفصلة عن دار الكفر التي لا يحقُّ للكفار أن يمارسوا سلطة عليها أو يتملكوها، وعلى هذا الأساس فإنه لم يكن يُسمح للأجانب بالتملُّك أو التصرف في الأملاك والأراضي العثمانية(110)، ولكن الدول الأوروبية أخذت تضغط على الحكومة العثمانية لاستصدار قانون يعطي الأجانب حقَّ شراء الأراضي في الدولة العثمانية وحقَّ تملُّكها والتصرُّف فيها. ورغم أن وزير الخارجية العثماني لم يكن يطلب أكثر من السماح للحكومة بالعمل بهدوء لتحقيق هذا الأمر، الذي ينطوي على مناقضة لأحكام الشريعة دون إثارة حفيظة المحافظين، قائلًا: «نحن نحاول قدر الإمكان الترويج لمثل هذا الأمر قبل الإقدام عليه»(111)، فإن السفراء الأجانب أخذوا يطالبون الحكومة العثمانية بإعطائهم موعدًا نهائيًّا لتنفيذه(112).
وتحت هذا الضغط صدر في 18 يونيو/حزيران 1867م قانون أعطى للأجانب حقَّ شراء الأراضي في الدولة العثمانية وحقَّ ملكيتها والتصرف فيها(113). حيث نصَّ على أن «امتلاك الأراضي وحرية التصرف بها يجب أن يُطبَّق على كل مالك أجنبي مثلما هو مطبَّق على الأهالي المقيمين في ذات المنطقة مع المحافظة على امتيازاتهم القديمة»(114).
وناهيك عن مخالفته للشرع، فإن تنفيذ هذا القانون كان كفيلًا بخلق مشاكل مستعصية للدولة العثمانية، وقد وجدت نفسها مجبرةً للبحث لها عن حلول؛ ذلك أن هؤلاء الأجانب القاطنين في الدولة العثمانية لم يكونوا -باعتراف الحكومة- يخضعون للقوانين المحلية؛ إذ كانت لهم محاكمهم الخاصة، وهي محاكم قنصليات الدول التي يتبعونها، ولم يكن استقرارهم في أراضي الدولة دائمًا. كما أن أكثرهم كانوا مقيمين حول مراكز سفاراتهم في العاصمة أو قنصلياتها في بقية المدن، وصدور قانون كهذا كان سيؤدي إلى تفرقهم داخل الدولة وانتشارهم في أنحائها المتفرقة، مما سيتطلب أن يكون في كل بلدٍ سفراء للدول الأجنبية كافَّة، وهو أمر مستحيل(115).
وقد انتهى هذا الأمر بالاتفاق على السماح للسلطات العثمانية بالتحقيق في القضايا المتعلِّقة بهؤلاء الأجانب في المناطق التي تبعد عن سفاراتهم، مع إرسال صورة الضبط إلى مركز السفارة بالسرعة الممكنة! وفي حالة الاستئناف يجب أن يكون هناك مترجم من السفارة، بحيث يسمح له بحضور جلسات المحاكمة مع منحه مدَّة الاستئناف(116).
أما المشكلات الجديدة التي نجمت عن هذا الاتفاق الأخير فظهرت فيما بعد، حيث لم يعُد بالإمكان إخراج الأجنبي الذي بحوزته محل أو منزل منه حتى لو ثبتت عدم أحقيته في تملُّكه؛ لأن إخراجه وإخلاء المكان يكون مرهونًا بوساطة السفارة، أما المترجمون والقناصل فقد أضاعوا حقوق الرعايا العثمانيين بتزويراتهم المختلفة في هذا الخصوص(117). ويسهب أحمد جودت باشا في شرح بقية آثار حصول الأجانب على امتياز حق التصرف في الأملاك الذي حرموا منه قبل بقوله:
«...والحاصل أن الأجانب نالوا بهذه الطريقة امتيازًا جديدًا عقَّد الأمور في الدولة العليَّة، وأصبح الأجانب في الدولة العلية في وضع ممتاز، في الوقت الذي نجد فيه أن المواطنين في أية دولة من الدول هم أصحاب المكانة، وبسبب حرمان رعايا الدولة العليَّة من تلك الامتيازات أصبحوا يميلون ويحرصون على التبعية للدول الأجنبية، وأصبحت امتيازات الأجانب في المحاكم على وجه الخصوص أمرًا يفوق الاحتمال ... وقد تأسفت عندما اطلعت على هذا الأمر... لكن ما العمل؟ فليس من الممكن تدارك هذا الأمر مرةً أخرى بعد ربطه بميثاق»(118).
تقييم التنظيمات
على الرغم من أن الدولة العثمانية وضعت التنظيمات الخيرية لتقطع الطريق أمام الدول الأوروبية للتدخل في شؤونها الداخلية، فإن التدخل الأجنبي ظلَّ قائمًا، فقد استغلت الدول الأوروبية الكبرى -فرنسا وإنجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا- ضعف الدولة العثمانية وعجزها لكي تتدخل تدخلًا مباشرًا في شؤونها الداخلية. بل إن التنظيمات زادت من فرص التدخل الأجنبي وذرائعه بحجَّة السهر على تنفيذ وعود الإصلاح التي شملت الامتيازات الممنوحة للأجانب والحقوق المستحدثة لصالح الأقليات الدينية المشمولة بحمايتهم.
ومع أن التنظيمات أكثرت من مظاهر العطف على غير المسلمين، وزادت في ثروتهم ومكانتهم ونفوذهم بالصورة التي استثارت غيرة المسلمين على اختلاف طبقاتهم، الذين لم يكونوا من جهتهم ليقبلوا بالتعدي على تفوُّق الإسلام ووضعهم البارز بوصفهم مسلمين(119)، فإن تطبيق سياسة التنظيمات جعل الأقليات تقترب أكثر إلى تحقيق أهدافها الانفصالية(120).
وقد قابل المسيحيون قانون تجنيدهم في الجيش العثماني وفتح الباب أمامهم لتولي الوظائف العامَّة بفتور شديد، ويُعزى ذلك -بحسب انجلهارد- إلى أنهم كانوا يشعرون أنهم أسرى في الدولة(121)، وهو شعور لم تبدِّده كل التنازلات التي قدَّمتها لهم الدولة لتضمن ولاءهم، والسبب في ذلك أن الدولة بقيت رغم كل شيء تمثِّل -في نظرهم- رمزًا للسيادة الإسلامية عليهم، ولم يقتصر الأمر على انعدام ولائهم الديني لها، بل إن ولاءهم السياسي صار للدول (المسيحية) التي باتوا يشعرون بقدرتها على مساعدتهم في الانعتاق من تلك السيادة الإسلامية عليهم.
وهكذا، فلا عجب أن يصل الأمر لدى المسيحيين القاطنين في المناطق الحدودية في إقليم الروميللي، حيث يسود المذهب الأرثوذكسي، إلى الحد الذي أعلنوا فيه العصيان والهروب إلى الجبال أو اللجوء إلى البلدان المسيحية المجاورة فرارًا من الخدمة في الجيش العثماني(122). أما فيما يتعلَّق بتوظيفهم في وظائف الدولة الحساسة، فكانوا -بحسب انجلهارد- «عند استلامهم المراكز في الدولة تجدهم مفرطين في الخدمة أو كسولين أو مقصرين فيها»(123).
أما خارجيًّا، فلم تنجح التنظيمات في وضع حدٍّ لانحطاط الإمبراطورية المعرَّضة للأخطار الأجنبية أيضًا، وبذلك ستظهر ليس فقط بوصفها «عهد تجديد»، بل أيضًا عهد تمزقات كبرى(124). وفي الحقيقة، لم يدرك المسؤولون العثمانيون أن تلك التنظيمات التي اقتبسوها عن الغرب إنما كانت تتناسب فقط مع معطيات الواقع الأوروبي ومجتمعاته، فالدول القومية الحديثة التي كانت قد نشأت في أوروبا على أنقاض الإمبراطوريات القديمة كانت تتمتَّع بقدر كافٍ من التجانس بحيث كان بإمكان مبدأ المساواة التامَّة في الحقوق والواجبات أن يؤتي أُكله فيها.
أما هذا الشكل من المساواة التامَّة الذي لم يكن يعني سوى «المُماهاة» بين مختلفين ومتمايزين في العقيدة والتفكير، فكان كفيلًا بوضع الإمبراطورية العثمانية موضعَ جذب عنيف بين مكوناتها المختلفة وتمزيقها. وهو ما غفل عنه رجال التنظيمات، بينما لا يبدو أن الدول الأوروبية كانت غافلةً عنه، بل إن ذلك ما كانت تسعى إليه في الواقع. والدليل على ذلك أن فرنسا التي كانت مُدركة -بحسب انجلهارد- أنها «إذا ما استعملت الشدَّة مع الدولة العثمانية للقيام بما تطلبه، فستكون نهاية الدولة بالسرعة القصوى ... كان كل أملها أن تتمكَّن من إجبار الدولة عليها وعلى مرأى من نظر الفرنسيين»(125).
وهكذا كانت الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة مفروضةً عليها من قِبَل أوروبا، وأدت نظرة المسلمين إليها على أنها ليست من مصلحتهم وليس لهم فيها أيُّ تفوُّق أو خصوصيَّة(126) إلى نموِّ رأي ثالث وسط بين المعارضين للتنظيمات جملةً وتفصيلًا من المتدينين المحافظين الذين كانوا يحرصون على الاحتفاظ بأساس الإمبراطورية العثمانية التقليدي، وذلك إما لارتباط مصالحهم به وإما لاعتقادهم بأنه موافقٌ لإرادة الله وبأنه الضمانة الوحيدة للاستقرار، وبين أولئك التغريبيين الذين كانوا يرون في أوروبا مصدر إلهامهم الوحيد.
وقد مثَّل هذا الرأي الوسط أولئك الذين لم يعترضوا مبدئيًّا على التنظيمات، إلَّا أنهم كانوا يعتقدون أن تطبيقها يستحيل في دولة كالسلطنة العثمانية؛ لأنه يعطي للدول الأخرى فرصًا جديدة للتدخل، كما يعطي للشعوب المحكومة فرصًا جديدة لتقوِّي نفسها وتثور، وكانوا يقولون إنه ناهيك عن كون هذه التنظيمات مبنيةً على مبدأ لم يُمتحن بعدُ، ولم يكن يؤمن به حقيقة أحدٌ، فإنها ولا بدَّ ستهدم المبادئ التي شكَّلت كيان الإمبراطورية وقوتها، وعلى رأسها سلطة الشرع الإسلامي. فمن الأفضل -إذن- الاحتفاظ بالنظام القديم على أن يُطهَّر من الفساد والجمود(127). وهذا كان رأي أحمد وفيق الذي كان يقول: «إن محاولة إدخال مؤسسات أوروبية بالجملة إلى تركيا، وتلقيح النظام التركي السياسي التقليدي القديم بالمدنية الأوروبية قبل أن يكون مهيَّأ لمثل هذا التجديد الحاسم، لا يمكن أن ينجح، بل لا بدَّ لها من أن تُضعف السلطنة العثمانية إضعافًا يُفقدها القوة الضئيلة والاستقلال اللذين تبقيا لها»(128).
ويبدو أن مثل هذه الأفكار لم تكن خافيةً على بعض المسؤولين في الحكومة العثمانية، الذين لم يكونوا يُقدِمون دائمًا على تنفيذ الإصلاحات حسب البرامج التي كانت تقدِّمها لهم الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا(129). وهو ما كان يعرّضهم لنقمة الفرنسيين، الذين كانوا يرون أن «الدولة تلعب بهم لعبة (ليت ولعل)، ولا تريد المساعدة، وتريد إضاعة الوقت، وفرنسا تريد أن تطبّق أفكارها كلها وإجبار الدولة على قبولها ... وترى أنه من الواجب المحافظة على كيفية الإصلاحات كما هي من دون تبديل أو تحريف، ويجب أن تُعامل كما يُعامل المريض الذي يوصف له دواء مُرّ ويقال له بأنه حلو فيه الشفاء»(130).
الإنسان في مجتمعات الشرق -مسلمًا كان أو غير مسلم- لم يكن ينظر إلى الأشياء أو يفكِّر فيها إلا بصددها الديني، وزاد دخول الأفكار الغربية من انتشار الأفكار القومية في صفوف إثنياته المختلفة.
ومهما يكن الأمر، فقد خاض رجال التنظيمات غمار الإصلاح وأعينهم مثبتة على أوروبا، ولم يدركوا أن الدواء الذي كانت تقدِّمه لهم أوروبا لم يكن لينفع مع عِللهم، وأن ما حقَّقت به أوروبا نهضتَها وتقدُّمها لا ينجح في إمبراطورية متعدِّدة الأديان والمِلل والإثنيات كالإمبراطورية العثمانية، فالدين الذي لم يعُد يشكِّل عاملًا لتعارض الحريات والنزعات في أوروبا -كما كان في السابق- كان في الشرق المحور الذي يدور حوله تفكير الناس وسلوكهم، والإنسان في مجتمعات الشرق -مسلمًا كان أو غير مسلم- لم يكن ينظر إلى الأشياء أو يفكِّر فيها إلا بصددها الديني، وزاد دخول الأفكار الغربية من انتشار الأفكار القومية في صفوف إثنياته المختلفة، وأدى إلى تمايزها بتشجيعٍ من الخارج إلى انفصالها.
وعلى الرغم من أن وفاة عالي باشا وفؤاد باشا في عام 1871م قد تزامنت مع انهزام فرنسا راعيتهما ومرشدتهما، فقد أتاح ذلك الفرصة لإمعان النظر في آثار إنجازاتهما وعيوبها، ولعودة الاتجاهات القديمة التي سوف تدرك أكثر الحاجة إلى الوحدة الإسلامية، وتركِّز بشكل أكبر على السمة الإسلامية للدولة(131)، وذلك تحت حكم السلطان عبد الحميد الذي سوف يعلن نفسه لأول مرة وبشكلٍ لم يسبق له مثيل لا بوصفه سلطانًا على رأس الإمبراطورية العثمانية فحسب، بل بوصفه خليفةً لجميع المسلمين داخلها وخارجها أيضًا.
كانت التنظيمات -عن طريق إزالة العوامل الشخصية من النظام العثماني وتقليص حيز الإسلام فيه- قد زادت في توسيع الهوَّة بين الحكَّام والمحكومين، وعندها بدأ الشعور بالحاجة لنظام قِيم مركزيّ و«مرساة ثقافية» ومصدر للهوية يمكن عن طريقه التحكُّم بالحشود والحفاظ على شرعية الحكم العثماني(132). وهكذا سعى السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) إلى استخدام الثقافة والأيديولوجية الإسلامية بغرض تعزيز الشعور بالولاء لدى الشعوب الإسلامية التي كان ولاؤها عرضةً للتزعزع من جراء علمنة القوانين وانتشار الأفكار الليبرالية، منتهجًا سياسة الجامعة الإسلامية(133).
بيد أن تغيير الدولة لبوصلتها خلال عهد السلطان عبد الحميد في اتجاهٍ كان يبدو في الظاهر معاكسًا لسياسة العلمنة التي تميَّز بها عهد التنظيمات، لا ينفي حقيقة القول بأنه ما إن حلَّت سبعينيات القرن التاسع عشر حتى كانت سياسة التنظيمات قد سارت بالدولة العثمانية في طريقٍ يستحيل معه العودة للخلف. إذ كان النظام القديم قد دُمِّر بالكامل بحيث يستحيل استرجاعه، ولم يعُد أمام الدولة العثمانية سوى المضيّ قدمًا نحو مسار واحد هو التغريب، وسواء حدث ذلك بسرعة أحيانًا وببطء أحيانًا أخرى، وبشكل مباشر تارة وملتوٍ تارة أخرى(134)، فإن أخطر ما خلفته التنظيمات الخيرية من آثار في الدولة العثمانية تمثَّل في سدِّها طريق العودة لقوانين الشريعة، التي ما انفكَّ احترامها يتضاءل حتى أصبح تطبيقها اليوم في الدول الإسلامية التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية مقتصرًا على ميدان محدود جدًّا هو ميدان الأحوال الشخصية.
الهوامش
(1) بول دومون، «فترة التنظيمات (1839-1878م)»، بحث ضمن كتاب: تاريخ الدولة العثمانية، ج2، إشراف: روبير مانتران، ترجمة: بشير السباعي، (القاهرة: دار الفكر للدراسات، 1992م)، ص63.
(2) على الرغم من أن نفوذها كان قد أخذ يتضاءل بتأثيرٍ من إصلاحات سابقة جرت في عهد السلطانَيْن: سليم الثالث (1789-1807م)، ومحمود الثاني (1808-1839م).
(3) مصطفى رشيد باشا (1800-1858م): من بين المؤسسين الرئيسين لحركة التنظيمات، ومُلهم مرسوم جولهانه السلطاني، يُعَدُّ «أبا التنظيمات»، انحدر من أسرة متواضعة جدًّا، وبدأ بدراسة علوم الدين، ثم تسنَّى له العمل أمينًا للباب العالي، فتمكَّن بذلك من الارتقاء في مختلف المراتب والصعود إلى أعلى وظائف الدولة، ففي عام 1832م شغل منصب السكرتير الأول للآمدي، وهي خدمة مسؤولة عن إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للإمبراطورية، وبعد ذلك بعامَيْن أُرسل سفيرًا إلى باريس مما شكَّل الخطوة الأولى لعمل دبلوماسي سوف تكون الإقامة في لندن أبرز علاماته، وفي عام 1837م عُيّن وزيرًا للشؤون الخارجية، ثم صعد إلى منصب الصدر الأعظم عام 1846م، حيث أصبح واحدًا من أبرز شخصيات الباب العالي، وبدأ في إرساء سياسة التنظيمات معتمدًا على إتقانه اللغة الفرنسية وخبرته الجيدة بالشؤون الأوروبية، وبوفاته في عام 1858م كان قد خلّف وراءه خمس توليات لمنصب الصدر الأعظم، وعدَّة بعثات إلى الخارج وفترتي تعيين لمدتين طويلتين نسبيًّا على رأس وزارة الشؤون الخارجية، وبشكل أهم اعتباره الشخصية البارزة للتنظيمات (دومون، «فترة التنظيمات»، مرجع سابق، ص67-68).
(4) الدستور، ترجمة: نوفل نعمة الله نوفل، ( بيروت: المطبعة الأدبية، 1883م)، وهو يشتمل على نصوص التنظيمات العثمانية بالإضافة إلى نصوص القانون الأساسي (الدستور).
(5) المرجع نفسه.
(6) عالي باشا (1815-1871م): وُلِدَ في إسطنبول لأسرة متواضعة، دخل الخدمة المدنية مبكرًا وارتقى في سُلَّم الرتب الرسمية، وبسبب اكتسابه بعض المعارف الفرنسية عُيّن في عام 1833م في وظيفة الترجمة في الباب العالي، وخلال عمله في هذه الوظيفة أحرز تقدمًا جيدًا في اللغة الفرنسية بمساعدة مدرس فرنسي. وفي عام 1836م أُرسل في بعثة إلى فيينا، ليبدأ سلسة من التعيينات الدبلوماسية تُوِّجت بتعيينه سفيرًا في لندن عام 1840م. وبعد عودته إلى بلاده عُيّن عضوًا في مجلس العدل، وتقلد بعد ذلك عددًا من المناصب الرفيعة كان معظمها بالاشتراك مع مصطفى رشيد باشا، وفي عام 1852م طُرد رشيد باشا فعُيّن مكانه في وظيفة الصدر الأعظم التي على الرغم من أنه لم يبق فيها لأكثر من شهرين، فقد كان في مركز الأحداث، وأصبح في عام 1854م رئيسًا للمجلس الأعلى للتنظيمات، ثم عاد مرة أخرى للصدارة العظمى قبيل إعلان خط همايون، ثم تقلد الصدارة العظمى وعدَّة مناصب أخرى فيما بعد وفي فترات مختلفة، حيث كان له دور مهيمن في سياسة التنظيمات استمرَّ حتى وفاته عام 1871م.
وكان فؤاد باشا (1815-1869م) مساعده ومعاونه الأقرب خلال هذه الفترة، وقد وُلِدَ في إسطنبول، وكان والده كج هجى زاده محمد عزت أفندي رجل دولة وعالمًا وشاعرًا عثمانيًّا مشهورًا. درس فؤاد باشا في مدرسة الطب التي أنشأها السلطان محمود الثاني في غلطة سراي عام 1827م، والتحق بعد تخرجه بالهيئة الطبية العسكرية الحديثة، وبسبب معرفته باللغة الفرنسية عُيّن في عام 1837م في وظيفة الترجمة بالباب العالي، وفي عام 1840م عُيّن مترجمًا في سفارة الدولة بلندن، ثم تقلد بعدها عدَّة مناصب دبلوماسية، وأصبح في عام 1852م وزيرًا للخارجية في صدارة عالي باشا، وعضوًا في المجلس الأعلى للتنظيمات أيضًا ثم رئيسًا له فيما بعد. ويُعَدُّ عالي باشا وفؤاد باشا ومعهما مصطفى رشيد باشا المهندسين الرئيسين والمنفذين لحركة التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية.
انظر: برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، ترجمة: قاسم عبده قاسم وسامية محمد، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2016م)، ص147-148.
(7) المرجع نفسه، ص150.
(8) أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ( القاهرة: دار الشروق، 2010م)، ص211.
(9) هاملتون جب وهارولد بوون، المجتمع الإسلامي والغرب، ج1، ترجمة: أحمد عبد الرحيم مصطفى، ( مصر: دار المعارف، د.ت)، ص33-34.
(10) المرجع نفسه، ص36-37.
(11) نفسه، ص33.
(12) مارسيل بوازا، الإسلام اليوم، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1986م)، ص112.
(13) السفير الفرنسي انكه لهارد (انجلهارد)، تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية، نقله إلى العثمانية: علي رشاد، ترجمه إلى العربية: محمود علي عامر، ( دمشق: دار ومكتبة رسلان، 2017م)، ص199. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب يُعَدُّ مرجعًا مهمًّا للتأريخ لإصلاحات عهد التنظيمات الخيرية، حيث كشف لنا خبايا سياسة التنظيمات، ومواقف الدول الأوروبية منها وسياساتهم فيها، وكان مؤلفه قد شغل منصب السفير الفرنسي في إسطنبول لمدة عشرين عامًا، واطلع عن قربٍ على آثار التنظيمات الخيرية في الدولة العثمانية.
(14) سيار الجميل، العثمنة الجديدة: القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب والأتراك، (قطر، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015م)، ص116.
(15) لويس، مرجع سابق، ص146.
(16) انجلهارد، مرجع سابق، ص199-200.
(17) لويس، مرجع سابق، ص137.
(18) Elliott, Ch. (Odysseus), Turquey in Europe, (London : Frank Cass, 1965) p 293.
(19) تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص200-201.
(20) لويس، مرجع سابق، ص146.
(21) وهو ما كان يشتكي منه الوزراء العثمانيون، مطالبين الدول الأوروبية بإعطائهم الفرصة لتوحيد أفكار الإصلاحات وتهيئة الجو لها قبل البدء في تنفيذها، والسماح لهم بالتحرُّك كدولة مستقلة لديها مجلس مخصَّص لدراسة المسائل المتعلِّقة بالتنظيمات، محاولين بذلك مقاومة مضايقات الدول الأوروبية قدر الإمكان، ومخاطبين لها بقولهم: «دعونا نعمل بحرية». انظر: انجلهارد، مرجع سابق، ص156-157.
(22) المرجع نفسه، ص156.
(23) نفسه.
(24) نفسه.
(25) وهو ما نصح به رئيس وزراء النمسا مترنيخ الدولة العثمانية عن طريق سفيره في إسطنبول، ولكن نصائحه لم تلق استجابة من أحد. انظر: انجلهارد، مرجع سابق، ص48-49.
(26) ذكره انجلهارد في كتابه «تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية»، ص49.
(27) نقلًا عن: المصدر نفسه، ص48.
(28) Mim Kemal, Öke, The Turquish war of Independence and the truggle of the ssouth Asian muslim , "The Khalifat movement", (1919-1924), (Turquey: ministry of culture, 1997), p157.
(29) سيار الجميل، مرجع سابق، ص117.
(30) ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة (1798-1939م)، ترجمة: كريم عزقول، (بيروت: نوفل، 2001م)، ص58.
(31) انجلهارد، مرجع سابق، ص179.
(32) نفسه، ص93.
(33) نفسه، ص184-185.
(34) نفسه، ص181.
(35) نقلًا عن: انجلهارد، مرجع سابـق، ص117-118.
(36) حوراني، مرجع سابق، ص59.
(37) دومون، مرجع سابق، ص121.
(38) عبد اللطيف الطيباوي، «نصوص وحقائق لم تنشر عن أصل النهضة العربية في سوريا»، مجلة مجمع اللغة العربية، مج42، ج4، دمشق، أكتوبر 1967م، ص778.
(39) ديفيد دين كومنز، الإصلاح الإسلامي: السياسة والتغيير الاجتماعي في سوريا أواخر العهد العثماني، ترجمة: مجيد راضي، (دمشق: دار المدى، 1999م)، ص20.
(40) أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص203.
(41) كان تنظيم الأرثوذكس القاطنين في الدولة العثمانية قد جرى باعتبارهم ملَّة الروم، وعلى ذلك أصبح اليونانيون والصرب والبلغار والرومان بل والعرب المسيحيون الأرثوذكس يشكلون ملَّة الروم، وكانت بطريركية حي الفنار في إسطنبول هي المركز الديني لهذه الطائفة. انظر: محمد عاكف آيدين، «الطوائف غير المسلمة»، بحث ضمن كتاب: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مج1، تعريب: صالح سعداوي، (إسطنبول: إرسيكا، 1999م)، ص501.
(42) انجلهارد، مرجع سابق، ص125.
(43) المرجع نفسه، ص119.
(44) نفسه، ص180.
(45) نفسه، ص180-181.
(46) والحقيقة أنه كان نظامًا صالحًا استفادت منه الدولة العثمانية مرونةً في تنظيم شؤون عناصرها غير المسلمة، دون الإخلال بالحريات الدينية التي منحتها لهم من جهة، ولا بمركزها بوصفها دولة إسلامية بالأساس من جهة أخرى، وقد أثمر ذلك عقودًا طويلة من التسامح والتعايش السلمي بين الطوائف المنضوية تحت لوائها، ولكن رجال التنظيمات لم يدركوا أن ما جعل نظام المِلل متأزمًا إنما هو تقاطعه مع نظام الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والتدخلات الأجنبية، ومع أشكال من الوعي القومي و«الهويات» التي اجتاحت نخب الإثنيات والجماعات المختلفة في مناطق الدولة العثمانية.
(47) انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص211.
(48) انظر ما سيلي من هذه الدراسة.
(49) بينما استنكف المسلمون عن إرسال أبنائهم للدراسة فيها؛ وذلك لأنها إلى جانب تدريسها للعلوم الغربية الحديثة كانت تبشيريةً بالدرجة الأولى. حول المؤسسات التعليمية التي رصدت لتعليم الأقليات المسيحية في الدولة العثمانية، انظر ما سيلي من هذه الدراسة.
(50) انجلهارد، مرجع سابق، ص93.
(51) المرجع نفسه، ص126.
(52) كمال بكديللي، «الدولة العثمانية من معاهدة قينارجه الصغرى حتى انهيارها»، بحث ضمن كتاب: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مج1، تعريب: صالح سعداوي، (إسطنبول: إرسيكا، 1999م)، ص103.
(53) من تقرير للجنرال دي بوفور دوتبول -قائد الحملة العسكرية الفرنسية إلى سوريا سنة 1860م- إلى وزير الحربية في باريس، بعنوان: الحملة العسكرية على سوريا، الديوان، رقم4: « إفادة عن أحداث سوريا ووضع البلاد عند وصول الحملة العسكرية»، منشور ضمن كتاب «فرنسا والموارنة ولبنان: تقارير ومراسلات الحملة الفرنسية على سوريا (1860-1861م)»، تعريب: ياسين سويد، (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 1992م)، ص111.
(54) المصدر نفسه والصفحة نفسها.
(55) للمزيد حول الحملة الفرنسية على بلاد الشام سنة 1860م وأهدافها ومصيرها، انظر كتابنا: الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق (1855- 1883م)، (الجزائر: دار هومة، 2017م)، ص103 وما يليها.
(56) وجيه كوثراني، بلاد الشام في مطلع القرن العشرين، (الدوحة، بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013م)، ص192.
(57) انظر: مؤلف مجهول، حسر اللثام عن نكبات الشام (وفيه مجمل أخبار الحرب الأهلية المعروفة بحوادث سنة 1860م مع تمهيد في وصف البلاد الجغرافي والسياسي)، (مصر: د.ن، 1895م)، ص62-63.
(58) هناك اختلاف كبير حول أصل الطائفة المارونية، فهناك من يقول إن الموارنة بعد اعتناقهم المسيحية اتبعوا راهبًا اسمه مارون كان يسكن بالقرب من حماة في القرن السابع، وقد انضموا إلى الكنيسة الكاثوليكية وأقروا بصحَّة تعاليمها، ولكن الموارنة ظلوا لا يقرون بسيادة البابا في الأمور الدينية إلى سنة 1438م، وعارضوا القول بعصمة البابا، واشتهر الموارنة بمساعدة الإفرنج في حروبهم ضد سلاطين المسلمين. للتوسع انظر: مؤلف مجهول، حسر اللثام، مرجع سابق، ص62-63.
(59) حسين خطار أبو شقرا، «منتخبات من رواية درزية عن حوادث 1860م»، كتبها يوسف خطار أبو شقرا، ضمن كتاب: سهيل زكار، بلاد الشام في القرن التاسع عشر، (دمشق: دار حسان، 1982م)، ص319.
(60) بكديللي، مرجع سابق، ص103.
(61) بول دومون، مرجع سابق، ص121-122.
(62) حوراني، مرجع سابق، ص60.
(63) وبالتدريج ازدادت مطالبتها بالاستقلال. انظر: أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص215.
(64) تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام 1879م، ملحق منشور في: عبد العزيز محمد عوض، الإدارة العثمانية في ولاية سورية (1864-1914م)، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ص352.
(65) حوراني، مرجع سابق، ص73.
(66) كومنز، مرجع سابق، ص20.
(67) وهو محمد أبو السعود الحسيبي، من أعيان دمشق وأشرافها، كان شابًّا حين وقعت حوادث 1860م، شهد الأحداث وسمع بقية الوقائع، توفي سنة 1914م. انظر: سهيل زكار، بلاد الشام في القرن التاسع عشر، (دمشق: دار حسان، 1982م)، ص13-14.
(68) المرجع نفسه، ص286.
(69) فيليب شكري خوري، «طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق (1860-1908م)»، ترجمة: زهير السمهوري، المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام (1516-1939م)، ج1، (دمشق: جامعة دمشق، 1978م)، ص451؛ كومنز، مرجع سابق، ص21.
(70) «منتخبات من مذكرات محمد أبو السعود الحسيبي الدمشقي»، ضمن كتاب: سهيل زكار، بلاد الشام في القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص286.
(71) هاملتون جب وهارولد بوون، مرجع سابق، ص159-161.
(72) ديفيد دين كومنز، مرجع سابق، ص20-21.
(73) فيليب خوري، مرجع سابق، ص451.
(74) كومنز، مرجع سابق، ص19.
(75) وجيه كوثراني، «التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصًّا وتطبيقًا ومفهومًا»، مجلة تبيُّن، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مارس 2013م)، ص2.
(76) وجيه كوثراني، «التنظيمات العثمانية بين النظام القديم والجديد: أمثلة من ولايات بلاد الشام»، مجلة الاجتهاد، ع45-46، مج11، ( د.م: دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، ربيع سنة 2000م)، ص148.
(77) حوراني، المرجع السابق، ص59.
(78) لويس، مرجع سابق، ص140، 145.
(79) دومون، مرجع سابق، ص88-89.
(80) لويس، مرجع سابق، ص140، 145.
(81) وهو رأي دومون في مقالته: «فترة التنظيمات»، مرجع سبق ذكره، ص89.
(82) لويس، مرجع سابق، ص153.
(83) من تقرير أحمد جودت باشا إلى السلطان عبد الحميد الثاني باسم «معروضات»، مترجم إلى العربية ومنشور ضمن كتاب: ماجدة مخلوف، تحولات الفكر والسياسة في التاريخ العثماني، (القاهرة: دار الآفاق العربية، 2009م)، ص115.
(84) هو المؤرخ والعالم أحمد جودت باشا (1822-1895م)، تقلد عدَّة مناصب عالية، حيث كان أول مدير لدار المعلمين عند افتتاحها سنة 1848م، وهو الذي قام بإعداد اللائحة التنظيمية لها، ثم ترأس الهيئة التي أصدرت قانون الأراضي (أراضي قانون نامه سى) الصادر في سنة 1859م، وشارك في إعداد قانون الولايات الذي صدر في 7 نوفمبر 1864م، كما ترأس ديوان الأحكام العدلية عند افتتاحه سنة 1867م ليكون محكمة للنقض، وفي سنة 1873م تولى نظارة المعارف فقام بإعداد برنامج عصري للمدارس، وبعدها نظارة التجارة والزراعة في حوالي عام 1878م. وكان له دور مهم في إنجاز مجلة الأحكام العدلية، سواء في التعجيل بها وإتمامها أم في تحرير بنودها. للمزيد راجع المقالات التالية ضمن كتاب «الدولة العثمانية تاريخ وحضارة»: محمد ابشير لي، «التشكيلات المركزية»، مج1، ص203.إيلبر أورطايلي، «الهيكل الإداري في عهد التنظيمات»، مج1، ص348-349.محمد عاكف آيدين، «القوانين العثمانية بعد عهد التنظيمات»، مج1، ص516-517.أورخان أوقاي، «دراسة أولية عن الحياة الفكرية خلال عهد التغريب»، مج2، ص292. أكمل الدين إحسان أوغلو، «المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين»، مج2، ص550، 566.ليلى الصباغ، «معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني»، مج 2، ص384.
(85) من تقرير أحمد جودت باشا للسلطان عبد الحميد الثاني، مصدر سبق ذكره، ص114-115.
(86) التقرير نفسه، ص115.
(87) دومون، مرجع سابق، ص89؛ آيدين، مرجع سابق، ص517؛ الصباغ، مرجع سابق، ص384؛ أوقاي، مرجع سابق، ص292.
(88) آيدين، مرجع سابق، ص518.
(89) لويس، مرجع سابق، ص153.
(90) دومون، مرجع سابق، ص92.
(91) المرجع نفسه والصفحة نفسها.
(92) أكمل الدين إحسان أوغلو، «المؤسسات التعليمية والعلمية عند العثمانيين»، مرجع سابق، ص543-544.
(93) دومون، مرجع سابق، ص92.
(94) أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص211، 219.
(95) وهي الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم، علاوة على كلية القسطنطينية (1890م)، وعدد آخر من الكليات الأقل شهرة. انظر: نادية ياسين عبد، الاتحاديون: دراسة تأريخية في جذورهم الاجتماعية وطروحاتهم الفكرية (أواخر القرن التاسع عشر-1908م)، (بغداد: دار ومكتبة عدنان؛ دمشق: صفحات، 2014م)، ص68-69.
(96) رهبنة كاثوليكية، تأسَّست سنة 1625م في باريس على يد القديس فنسان دو بول، وأطلق اسم «اللعازاريون» على جمعية آباء وكهنة سكنوا دير القديس لعازار في باريس، وفي القرن التاسع عسر نشطت بعثاتها التبشيرية في بلاد الشام ومصر، وبخاصة في دمشق وبيروت والإسكندرية، حيث جعلت من التعليم أولى اهتماماتها.
(97) المرجع السابق، ص69-70.
(98) ليلى الصباغ، «معالم الحياة الفكرية في الولايات العربية في العصر العثماني»، مرجع سابق، ص398.
(99) المرجع نفسه، ص401.
(100) نادية عبد، مرجع سابق، ص56-57.
(101) وليد صبحي العريض، «إصلاح التعليم وفلسفته في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر: قراءة في قوانين التنظيمات من عهد محمود الثاني إلى عبد الحميد الثاني (1824- 1876م)، مجلة كلية التربية، ع146، ج2، (القاهرة: جامعة الأزهر،كلية التربية، 2011م)، ص436.
(102) انجلهارد، مرجع سابق، ص216.
(103) المرجع السابق، ص217.
(104) أكمل الدين أوغلو، مرجع سابق، ص547.
(105) لويس، مرجع سابق، ص152.
(106) دومون، مرجع سابق، ص93.
(107) لويس، مرجع سابق، ص152.
(108) انجلهارد، ص215.
(109) دومون، مرجع سابق ص95.
(110) مع أنهم كانوا يتحايلون لحيازة الأملاك والأراضي التي يشترونها بكتابة عقود حيازتها بينهم وبين زوجاتهم أو بقية أقاربهم من رعايا الدولة العثمانية. انظر: تقرير أحمد جودت إلى السلطان عبد الحميد الثاني، مصدر سبق ذكره، ص108.
(111) انجلهارد، مرجع سابق، ص174.
(112) نفسه.
(113) نفسه، ص201.
(114) نفسه، ص175.
(115) نفسه.
(116) نفسه، ص176.
(117) تقرير أحمد جودت باشا إلى السلطان عبد الحميد الثاني، مصدر سابق، ص110.
(118) نفسه.
(119) أحمد عبد الرحيم مصطفى، مرجع سابق، ص215.
(120) Öke , op.cit., p157.
(121) انجلهارد، مرجع سابق، ص423.
(122) نفسه، ص108.
(123) نفسه، ص196.
(124) انظر: دومون، مرجع سابق، ص64 وما بعدها.
(125) تاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص179-180. والجدير بالذكر أن فرنسا كانت تأمل أكثر من بريطانيا في حسم المسألة الشرقية خلال هذه الفترة، وتدخلت كثيرًا لتحقيق ذلك، لكنها كانت تُواجه بمعارضة شديدة من قِبَل الدول الأوروبية وعلى رأسها منافستها بريطانيا، وكانت التدخلات الروسية كثيرًا ما تجبرها على تقديم العون للعثمانيين -على مضض- لكي تقطع الطريق أمام روسيا وتحول دون تحقيق أهدافها في الدولة العثمانية. بينما كان رأي الانجليز أن أيَّ حسم للمسألة الشرقية لن يكون لصالحهم بأيِّ حال من الأحوال، وذلك لافتقارهم لجيش بريّ قويّ، ولذلك تبنوا -حتى هذا الوقت- مبدأ الحفاظ على تمامية أملاك الدولة العثمانية. على أن الدعم البريطاني والفرنسي المزعوم للدولة العثمانية -الذي لم يكن في حقيقته سوى خدمة لمصالحهما في الدولة العثمانية- لم يكن ليمرّ دون أن تقبضا ثمنه، وكان ثمنه هو الحصول في كل مرة على امتيازات جديدة والمزيد من النفوذ داخل الدولة، وهو أمر كان متسقًا مع مخططاتهما لإضعافها وتمزيقها أكثر من الداخل، ليسهل الإجهاز عليها وتقسيمها من الخارج بعد ذلك، حين يحين أوان حسم المسألة الشرقية.
(126) المرجع السابق، ص178.
(127) حوراني، مرجع سابق، ص59-60.
(128) نقلًا عن: المرجع السابق، ص60.
(129) انجلهارد، مرجع سابق، ص178.
(130) نفسه، ص179-180.
(131) لويس، مرجع سابق، ص154.
(132) Richard Tapper, Islam in Modern Turquey: Religion, politics and literature in a secular state, ( London, New york: IB Taurisand co, E.J Brill, 1966)., p5.
(133) للتوسع انظر الباب الأول من كتابنا: الخلافة وصراع المسألة الشرقية، (الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، 2021م).
(134) لويس، مرجع سابق، ص158.










