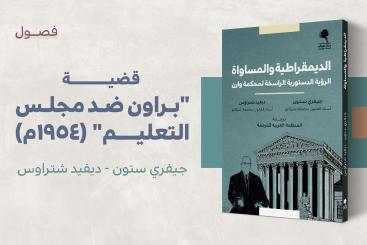القانون والحرية في المجتمعات بلا دولة: قراءة في أعمال بيار كلاستر في ضوء مقاربة مجهرية للقانون

مقدمة المترجم
تتصدَّى النظرية المجهرية للقانون التي طوَّرها المُنظِّر القانوني البلجيكي لوسيان فرانسوا Lucien François لتبديد الغموض الدلالي العُضال لكلمة «قانون»، وذلك بإعادة التفكير في الظاهرة القانونية في أدنى مظاهرها، وهو «الأقنون» (تصغير لفظ قانون). وتسمح لنا الأدوات التي قدَّمها بإلقاء نظرة جديدة على المجتمعات بلا دولة، أي المجتمعات التي وصفها عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي بيار كلاستر Pierre Clastres بأنها «مجتمعات ضد الدولة»، وإظهار أن غياب الدولة لا يعني أنها بلا قانون. فهذه المجتمعات لا تخلو من علاقات قانونية، غير أن تلك العلاقات تتخذ شكلًا مخصوصًا، وهو شكل «دائرة الإلزام المتبادل».
وهذا المفهوم، إلى جانب مفهوم «الهالة» الذي حدَّده لوسيان فرانسوا أيضًا، قد يجعل من الممكن إعادة النظر في فكرة الحرية في هذه المجتمعات ومن ورائها فكرة القانون وارتباطه بالدولة، وهي فكرة قد تبدو للوهلة الأولى متعارضة جذريًّا مع تصوّراتنا بشأنها، وهذا ما يحاول أن يفعله ماكسيم دي برونياز De Brogniez Maxime الباحث في الأنثروبولوجيا القانونية في جامعة لياج البلجيكيّة في هذه الدراسة التي يُبيِّن فيها أن الوقائع الأنثروبولوجية قد تقول خلاف ما رسخ في الأذهان حول مقولات القانون والدولة وما يُجاورها من مفاهيم تتعلَّق بالسلطة والتشريع وتدوين الأحكام والشرائع، سواء عند المجتمعات المسماة «بدائية» أو مجتمعاتنا المعاصرة، وآن الأوان لتجلية ما ران حولها من غموض.
مقدمة
جرت العادة أن يُعرَّف القانون بأنه منبثق عن الدولة. ومن ثَمَّ، يُشار إلى المجتمعات بلا دولة عمومًا بأنها مجتمعات بلا قانون. بيد أننا سنقوم اعتمادًا على أعمال عالم الأنثروبولوجيا الفرنسي بيار كلاستر Pierre Clastres، وأعمال المُنظِّر القانوني البلجيكي لوسيان فرانسوا Lucien François، بإظهار أن هذه المجتمعات بلا دولة ليست بلا قانون. وستسمح لنا الأدوات التي يُوفّرها فرانسوا في الجزء الأول بتحليل الشكل الفريد الذي تكتسيه العلاقات القانونية في المجتمعات بلا دولة. فمن خلال ضمان المساواة التامة بين أفراد «القبيلة»، فإن هذا الشكل يسمح -وفق كلاستر- بمنع ظهور الدولة، وإذا كانت هذه المجتمعات تُوجب المساواة الكاملة بين أعضائها، فما ذاك إلا حفاظًا على حريتها[1]. وسيقودنا هذا الطرح إلى النظر -في الجزء الثاني- في مفهوم الحرية عند ما يُسمّى بالمجتمعات البدائية. وقبل الختام، سنُعرِّج على أعمال مارشال سالينز Marshall Sahlins، وريموند فيرث Raymond Firth، ولوسيان فرانسوا لإغناء مقاربة بيار كلاستر والتساؤل عن الطابع السياقي -وحتى الثقافي- للحرية.
في مجال فلسفة القانون يجب على الخيال -بالطبع- أن يُفسح المجال سريعًا للصرامة.
وستسمح لنا المواجهة بين تخصّصيْن -ونقصد الأنثروبولوجيا ونظرية القانون (من حيث إن الأخيرة مهتمة بما هو قانون)[2]- بإلقاء أضواء جديدة على بعض المفاهيم الأساسية لفلسفة القانون. وهكذا، فإن تساؤلاتنا ستشمل العلاقة بين القانون والإكراه من جهة، وبين القانون والحرية والدولة من جهة أخرى. أما رجوعنا إلى بعض المؤلفين دون غيرهم، فيرتبط برغبتنا في إظهار أن التحليل الوضعاني لظاهرة معيارية راسخة أسطوريًّا ودينيًّا، يُمكنه أن ينحاز بسهولة كبيرة إلى جانب القانون الطبيعي، وهذا أمر مرغوب من حيث إنه يُبرز أسس الأنظمة القانونية للدولة ذاتها. وإذا كان صحيحًا -كما يقول إميل دوركايم Émile Durkheim- أنه: «لا يمكننا أن نُفسِّر إلا من خلال المقارنة»[3]، فإن الدراسة التالية تهدف في المقام الأول إلى الربط بين أشياء قد تبدو متنافرة للوهلة الأولى، لكن التفكير فيها معًا قد يُتيح فهمًا أفضل لرهانات كلّ منها. ومن ثَمَّ، فإن هدفنا ليس التشكيك في مدى صحة أو ملاءمة تحليلات كلاستر[4] أو فرنسوا في ذاتها، ولكن إنشاء روابط مثمرة بينها. وقد سبق لجورج ديدي-هوبرمان Georges Didi-Huberman أن كتب في مجال آخر مختلف يقول: «يقبل الخيال ما هو متعدد ويُجدِّده باستمرار لاكتشاف «علاقات حميمية وسرّية، وتطابقات وتماثلات» جديدة لا تنضب، مثلما لا ينضب كل تفكير حول العلاقات ينتج عن تركيبها بشكل مبتكر»[5]. وفي مجال فلسفة القانون، يجب على الخيال بالطبع أن يُفسح المجال سريعًا للصرامة، ومن ثَمَّ، يسمح برؤية أفضل «لما هو مُفيد في هذه المقارنات»[6].
مجتمعات مساواة تامّة؟
في عام 1974م، نشر بيار كلاستر كتابًا مثَّل -من وجهة نظر النظرية السياسية- علامة فارقة، وهو كتاب "المجتمع ضد الدولة" La Société contre l’État الذي خصّصه لدراسة «همج ما قبل الحضارة، وشعوب ما قبل الكتابة، ومجتمعات ما قبل التاريخ: هذه هي بالتأكيد المجتمعات المسماة مجتمعات بدائية، المجتمعات الأولى التي ظهرت وهي تجهل الانقسام، والتي وُجدت قبل اللقاء الحتمي المشؤوم[7]. إنها الموضوع المفضل، إن لم يكن الحصري لعلم الإثنولوجيا: إنها المجتمعات بلا دولة»[8]. وبتجاوزه مجرد ملاحظة غياب ظاهرة الدولة في هذه المجتمعات، توصّل كلاستر بناءً على تجاربه المتنوعة في هذا المجال -خاصة بين هنود الغاياكي (Guayaki) في الباراغواي، وأيضًا بين هنود الغواراني-شيريبا (Guarani-Chiripa) وقبائل الجافاي (Javae)- إلى أن: «المجتمع البدائي قد هيكل نفسه مجتمعًا ضد الدولة، وأنشأ نظامًا دفاعيًّا يجعل من المستحيل تشكيل سلطة قد تنفصل عن المجتمع بما يُتيح لها الانقلاب عليه، واستعباد أفراده من قبل زعيم»[9]. إنه يعارض الخطاب السائد الذي يرى أن «المجتمعات البدائية ينقصها شيء ما ضروري لها، أي الدولة، كما هو ضروري لكل مجتمع، على غرار مجتمعنا على سبيل المثال»[10]؛ بحيث تُعتبر تلك المجتمعات غير مكتملة؛ لأنها تعيش «تجربة نقص قد تكون مؤلمة -نقص الدولة- ستحاول دائمًا سدَّه دون أن يتحقّق أبدًا»[11]؛ وأنه «لا يمكننا التفكير في المجتمع دون الدولة، فالدولة هي قدر كلّ مجتمع»[12]. ومن هنا يسعى كلاستر لإثبات الطابع العرقي لهذا التصور الأحادي الاتجاه للتاريخ[13].
أ. مجتمعات بلا دولة ومن ثَمَّ بلا قانون
1. مجتمعات بلا دولة...
منذ البداية، وخلافًا لتيار التحليل الماركسي، يفترض كلاستر أولوية السياسي على الاقتصادي. فالانقسام الأول ليس ذاك الذي يحدث بين مستغِلّين ومستغَلّين، بل بين «آمرين ومطيعين، (...) بين من يملك السلطة ومن يخضع لها»[14]. ذلك أنه من المستحيل -وفق كلاستر- أن نرى انقسامًا بين أغنياء وفقراء ينشأ في مجتمع يعمل فيه كل شيء في سبيل منع الانقسام بشكل عام، «فالدولة هي التي تخلق الطبقات»[15]. لكن من أين تنبثق الدولة؟ وما هي شروط انبثاقها؟ الحق أننا لا نجد في أعمال كلاستر نظرية حول ولادة الدولة: «لئن بدا أن تحديد شروط ظهور الدولة ما يزال بعد مستحيلًا، فإنه يُمكننا بالمقابل تحديد شروط عدم ظهورها»[16]. ويُحدِّد كلاستر شرطيْن في أصل الضرورة العامة للمساواة، بوصفها ضمانة لعدم ظهور الدولة. الشرط الأول: هو غياب سلطان، أو عدم وجود زعيم، أو بشكل أدق، غياب زعيم يتمتّع بسلطة قهرية. وفي المقابل، فإن وجود زعيم دون سلطة أمر مطلوب. وبالطبع، فإن للمجتمعات بلا دولة زعيمًا، لكنه محروم من كلِّ سلطة فعلية[17]. ذلك أن وجود الزعامة، أي حيّز للسلطة، ضروري بطريقة ما لمنع ظهورها فعليًّا: «لمنع هذه السلطة من أن تصبح واقعية، فلا بُدَّ من تفخيخ ذاك الحيز، ووضع شخص فيه. وهذا الشخص هو الزعيم»[18]. بيد أن هذا الزعيم لا يملك أي سلطة ملزمة للمجتمع.

كتاب "مجتمع اللادولة" لبيار كلاستر
وفي مواجهة المطامع الخارجية، تسمح الزعامة بمعارضة حيز سلطة غير فعالة بالتأكيد، لكنه حيز مشغول. وتُشكِّل الحرب، أو بشكل أدق الحرب بوصفها أداة للحدِّ من عدد السكان، الشرط الثاني لعدم ظهور الدولة. وعلى عكس ما يُكتب في كثير من الأحيان من أن «التجزّؤ الكبير الذي يبدو عليه المجتمع البدائي في كل مكان هو السبب (...) في تواتر الحروب في هذا النمط من المجتمعات»[19]، فإن كلاستر يرى أن «الحرب ليست نتيجة التجزّؤ، بل التجزّؤ هو نتيجة الحرب. بل إنه ليس نتيجة الحرب فحسب، ولكنه هدفها أيضًا، فالحرب هي سبب ووسيلة لبلوغ نتيجة وتحقيق غاية مرجوة في آن، ألا وهي تجزّؤ المجتمع البدائي»[20]. وعلى عكس منطق الدولة الذي يدفع دائمًا نحو التكاثر البشري والتوسع الإقليمي[21]، يسعى المجتمع «البدائي» إلى الحد من نموّه السكاني. فالمجتمعات «الأولية» -في الواقع- «تعرف وتمارس وسائل متعددة للتحكم في نمو سكانها أو منعه، مثل الإجهاض، ووأد الأطفال، وإقرار المحرمات الجنسية، والفطام المتأخر، وما إلى ذلك»[22].
وسيكون من الخطأ -وفقًا لكلاستر- إرجاع هذه الرغبة في الضبط السكاني إلى اقتصاد الكفاف الذي لا يُلبِّي احتياجات عدد كبير من السكان. ذلك أن المجتمعات المسماة بدائية «تُظهر قُدرة على تلبية احتياجاتها مساوية على الأقل لتلك التي يفخر بها المجتمع الصناعي التقني»[23]. وهذه المجتمعات تكتفي بإنتاج ما تحتاج إليه في أقصر وقت ممكن، بحيث يُمكننا التحدث عن مجتمعات رفاه، وعن مجتمعات رفض العمل[24]. وهذا المنطق الغريب في نظر المراقب «المتحضّر» هو كذلك موقف صراع ضد ظهور الدولة: «عندما يختفي رفض العمل، يُستبدل الميل إلى التسلية بالرغبة في التراكم. وباختصار، عندما تظهر في الجسد الاجتماعي (...) تلك القوة التي دونها لن يتخلى الهمج عن أوقات التسلية التي تُدمِّر المجتمع من حيث هو مجتمع بدائي، فإن هذه القوة هي قوة الإكراه والقدرة على القهر، أي السلطة السياسية»[25]. وما يُفسّر بالفعل الرغبة في إبقاء التركيبة السكانية للمجتمع «البدائي» ضمن حدود ضيقة هو أن «الأمور لا يمكن أن تسير إلا وفقًا للنموذج البدائي إذا كان عدد الناس قليلًا. أو بعبارة أخرى، إن المجتمع لكي يكون بدائيًّا، فلا بُدَّ أن يكون صغيرًا عدديًّا»[26].
هذا ما يُبرِّر التجزئة بوصفها هدفًا لا بوصفها سببًا للحرب. ويخدم هذيْن الشرطيْن لعدم ظهور الدولة –التحكمُ البنيوي في السلطة والضبط السكاني- مبدأ أشد رسوخًا، وهو مبدأ المساواة بوصفه ضرورة مطلقة، أي «الحظر غير المعلن ولكنه قائم مع ذلك للتفاوت»[27]. وتهدف جميع العمليات الموصوفة بأنها تعمل على منع ظهور الدولة في نهاية المطاف إلى منع ظهور التفاوت. وهكذا، يكتب كلاستر: «سنعتبر كل آلة اجتماعية تعمل وفق مبدأ غياب التسلط مجتمعًا بدائيًّا. ومن ثَمَّ، سنعتبر كل مجتمع يعمل وفق مبدأ ممارسة السلطة -مهما بدا لنا ضئيلًا- مجتمع دولة»[28]. بيد أن هذا التطابق الصارم بين التفاوتات والمجتمع القائم على الدولة من ناحية، وبين المساواة والمجتمع بلا دولة من ناحية أخرى لا يخلو من تباينات. فلئن كانت ضرورة المساواة بلا شك مثالََا أعلى في المقام الأول، أي أفقًا يُوجّه حياة الهنود وقراراتهم بقطع النظر عن فعّاليته في الواقع، فهي لا تعدو كونها قاعدة قد تعرف بعض الانحرافات. وعلى الرغم من تأكيد علم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا أن ظهور التفاوتات في مجتمع ما يكون سابقًا زمنيًّا ومنطقيًّا لتشكُّله في هيئة دولة[29]، فإن ذلك لا يمنع أن تعرف هذه «القاعدة» بعض الاستثناءات، وأنه «قد يُوجد أحيانًا عالم آخر»[30].
تستند القواعد التي تحكم الهنود -وهي تشرح ضرورة المساواة- إلى أساطير قديمة جدًّا سبق أن قام المبشّرون بنسخها منذ القرن الخامس عشر، وهي الأساطير التي لا يتوانى الكاراي (الأنبياء) عن التذكير بها بانتظام. يكتب كلاستر: «إن جوهر مجتمع الغواراني هو عالمه الديني، وإذا ما فقد رسوخه في هذا العالم، فحينها سينهار المجتمع. إن علاقة الغواراني بآلهتهم هي ما يبقيهم ذاتًا جماعية، وهي التي تجمعهم معًا في أمة من المؤمنين، ولا حياة لهذه الأمة ولو للحظة إذا فقدت الإيمان. وهذا ما يعرفه الهنود حق المعرفة»[31].
يعيش البشر في أرض سوء وشر، وهذا النقص يأتي من حقيقة أن «الأشياء في كلّيتها واحدة». فالواحد كما يشرح كلاستر هو الناقص، إنه الشر.
ودون ادّعاء تقديم نظرة شاملة عن أساطير الغواراني[32]، من الضروري أن نتناول بإيجاز جدلية الواحد والمتعدد في تلك الأساطير لفهم أساس ضرورة المساواة بشكل أفضل. يقول الهنود: «الأشياء في كلِّيتها واحدة، وهي سيئة في نظرنا نحن الذين ما رغبنا في أن تكون كذلك»[33]. يعيش البشر في أرض سوء وشر، وهذا النقص يأتي من حقيقة أن «الأشياء في كلّيتها واحدة»[34]. فالواحد كما يشرح كلاستر هو الناقص، إنه الشر. لكن «ما هو هذا اللّاواحد الذي يرغب فيه الغواراني بعناد؟»[35]. يجب أن نحذر من استيعاب الواحد في الكل. فنمط وجود الواحد مؤقت عابر وزائل، وهو صفة الناقص غير الكامل. وفي الأرض الخالية من الشر التي يطمح إليها الهنود «لا يُوجد شيء يمكن أن يُسمّى واحدًا»[36].
ومن ثَمَّ، فإن سكّانها ليسوا بشرًا محضة، ولا آلهة محضة، بل هم هذا وذاك في الوقت نفسه. «إن الشر هو الواحد، لكن الخير ليس المتعدد، إنه الاثنان، الواحد وآخره في الوقت نفسه، وهذا «الاثنان» هو ما تتصف به الكائنات الكاملة حقًّا. إن ياوي مارا-آي Ywy mara-eÿ [الأرض الخالية من الشر]، مقصد آخر البشر، لم تعد تأوي بشرًا ولا آلهة، بل تأوي فقط متساوين، آلهة-بشر، أو بشر-آلهة، بحيث لا يُمكن لأحد منهم أن يُعبِّر عن نفسه باسم الواحد»[37]. وتُعاش هذه العلاقة الحميمية بين الهنود وجزئهم الإلهي بشكل جماعي. و«بين ذات الفرد وذات الآلهة، يُوجد مجتمع البشر، وتُوجد القبيلة»[38].
لقد تمّ اصطفاء الغواراني من قبل الآلهة «بوصفهم ينتمون إلى القبيلة التي تكتشف أساس اجتماعها في وعيها بذاتها على أنه مستقرّ للكلام المنبعث من الآلهة. فالوجود الاجتماعي للقبائل عند الغواراني قائم أساسًا على الأيفو (ayvu) [خطاب الآلهة-م]: إنه متجذّر في الإلهي»[39]. بيد أن كلاستر يكتشف وراء المعادلة الميتافيزيقيّة التي تُماثل بين الواحد والشر معادلةً أخرى «أكثر خفاءً، وذات طابع سياسي تقول إن الواحد هو الدولة»[40]. وبدل علاقة تستتبع فيها ثلاثة مصطلحات بعضها بعضًا (الهنود - الآلهة – القبيلة) حسب مقتضى التعدّد، فإن انتصار الواحد يُحل محلَّ ذلك سلطة مركزية ومنفصلة. فالواحد هو «جوهر الدولة الشمولي»[41]. فالتفاوت والهيمنة والسلطة السياسية، تحتوي على بذرة بنية الدولة. وظهورها سيعني بحكم الواقع اهتزاز التواصل الاجتماعي للهنود والأساس الأسطوري لفكرهم: «فإذا نجح الأمر [أي إذا استغل الزعيم المجتمع في تحقيق غايات شخصية]، فسنكون هنا أمام مولد السلطة السياسية بوصفها قهرًا وعنفًا، وسنكون إزاء أوّل تجسد للدولة في أدنى صورها»[42]. وحينها، لن يكون -حسب كلاستر- بين الزعيم الذي يُلزم رعاياه بأن يدفعوا له نصيبًا من محاصيلهم وبين إدارة الضرائب، سوى فرق في الدرجة لا النوع.
2. ومن ثَمَّ دون قانون؟
تقليديًّا، تُعرَّف هذه المجتمعات التي تتسم بأنها بلا دولة أو بلا تنظيم سياسي مركزي، بأنها مجتمعات بلا قانون[43]. وإذا كان البعض -على العكس من ذلك- لا يرى أن غياب سلطة مركزية يعني عدم وجود أيِّ ظاهرة قانونية مطلقًا، فإن ذلك يُدرَك في أغلب الأحيان من خلال مفاهيم بديلة، مثل النموذج والبنية والقاعدة والعُرْف والمعيار[44].

كارل ليويلين
ومع ذلك، فإن هذه الظواهر، وبسبب الافتقار إلى مشرِّع دولاني [نسبة إلى دولة] [45]، وغياب قوانين مكتوبة[46]، والافتقار إلى نظام قانوني[47]، تُخْتَزل في الأغلب الأعمّ في كونها «ما قبل قوانين» أو «شبه قوانين»[48]، وفي بعض الحالات «أنظمة قانونية أخرى»[49]. ويعكس تنوع المعايير المعتمدة في تحديد بلوغ درجة اكتساب صفة القانون، جموح الخيال أكثر من أيّ شيء آخر. ذلك أنه حتى في صورة إنشاء صلة بين القاعدة والقانون، فإنه يظل من الصعب تحديد معيار الربط بين الأمريْن، ومن ذلك مثلًا ما يراه الأمريكي كارل نيكرسون لويلين Karl Nickerson Llewellyn من أن «النكهة الإضافية للقانون، هي ما يُميِّزه عن عوامل الضبط الاجتماعي الأخرى»[50]. وإلى جانب صعوبة تحديد ما إذا كان أحد المعايير أو الأعراف قانونًا، تطرأ صعوبة أخرى حين يتعلّق الأمر بتعريف القانون نفسه. فهل هو القانون الموضوعي (كما في القانون الفرنسي)، أم القانون الذاتي (كما هو الحال في قوانين حقوق الإنسان)، أم اختصاص أكاديمي (كما هو الحال في دراسات القانون)...إلخ. فاستخدامات الكلمة متعددة وما تُغطّيه من حقائق مشوب بالغموض في غالب الأحيان.
ما كان لعلم اللسانيّات العامة أن يُولد إلَّا من خلال إنشاء مجموعة من المفاهيم الخاصة، التي كانت دقيقة ومرنة بما يكفي للتكيّف مع تحليل أي خطاب.
إن مسألة القانون في الأساس، فيما يُسمى بالمجتمعات البدائية، هي مشكلة تعريف. وفي هذا الإطار، يرى روبرت جاكوب Robert Jacob أن «العلوم القانونية في القرن العشرين كانت تفتقر إلى ما يُعادل الثورة السوسوريّة [نسبة إلى دوسوسور] في علوم اللغة. فقد كان لكلّ فقه لغة، يتمثل موضوعه الخاص في لغة معيّنة أو مجموعة من اللغات، ثم جاء علم اللسانيّات -أي العلم الشامل للتواصل من خلال الكلمة- لكي يخلفها جميعًا. فإذا كانت المعرفة اللغوية تتوافق مع تنوع المناخات الثقافية، فإن علم اللسانيات يميل إلى إعادة تكوين وحدة الإنسان. بيد أنّنا نعرف أنه ما كان لعلم اللسانيّات العامة أن يُولد إلَّا من خلال إنشاء مجموعة من المفاهيم الخاصة، التي كانت دقيقة ومرنة بما يكفي للتكيّف مع تحليل أي خطاب، ولذلك فُصِل علم اللسانيات جذريًّا عن الإطار الذي كانت تحبس فيه قواعدُ كلّ لغة فقهاءها. وبسبب عدم القيام بمثل هذا الجهد، فإن العلوم التاريخية والقانون المقارن ما تزال تتلمّس طريقها، كما لو أننا نستمرّ في فهم لغات الهنود الحمر أو قبائل البانتو الإفريقية فقط من خلال ما يُقرِّبها بشكل مرتبك من اللغات الهندو-أوروبيّة»[51]. ولذلك، فإن ما يفتقر إليه العلم القانوني هو أسلوب شامل حقيقي لإدراك موضوعه.
إن مصطلح القانون مشوّه وغائم لدرجة أن دراسة الظاهرة التي من المفترض أن يُغطّيها حتى في المجتمعات «البدائيّة»، لا يمكنها الاستغناء عن التفكير مسبقًا في تعريفه هو بالذات. ومن أجل فهم أفضل لما تُغطّيه الظاهرة القانونية، سوف نترك مؤقتًا -لغرض البرهنة- كلمة قانون وما يشوبها من غموض، وننظر فيما يُمكن أن يُفيدنا به المنهج المجهري الذي اقترحه منظِّر القانون البلجيكي لوسيان فرانسوا Lucien François [52]. وإذا ما تذكرنا -بالإضافة إلى الغموض الذي تعانيه الكلمة- أن «القانون (ius Recht, droit, law, diritto, pravo) هو مفهوم ليس له معادل دقيق في جميع الثقافات»[53]، فإن الحاجة إلى البحث عن إطار تحليلي آخر تبدو أكثر إلحاحًا، فهدفنا ليس تطبيق مقولاتنا بشكل مصطنع على ثقافات لا تعرف تلك المقولات على الوجه الذي نعرفها به، بل السعي إلى فهم ظاهرة محددة. وفي هذا المجال، يُقدِّم لوسيان فرانسوا منهجًا متدرّجًا، ينطلق من الوحدة الأساسية لظاهرة اجتماعية معينة (قد يميل القارئ الغربي إلى تصنيفها بسرعة على أنها «قانونية»، بما قد يحجب عنه أحد أهم إسهامات المنهج المجهري)، لتكون كونية بحق.
ومن هنا، فإن تطبيق الأدوات المفاهيمية التي ابتدعها لوسيان فرانسوا على المجتمعات التي درسها بيار كلاستر سيجعل من الممكن تقدير مدى ملاءمتها لموضوعنا، ومن ثَمَّ التساؤل مجدّدًا -كما نأمل- بشأن المفاهيم التطورية التي ما يزال حضورها غالبًا في مجال الأنثروبولوجيا القانونية، وهذا ليس من أجل إبراز ما يُفرِّقنا، بل التأكيد على ما يُوحّدنا[54]. وبما أنّ لوسيان فرانسوا يرى -على غرار بيار كلاستر- أن علاقة التسلّط الأولية هي التي شكَّلت الجنين الذي سيفرز ظاهرة الدولة، فإن هذا التقارب في وجهات النظر بين مؤلفيْن يبدو أن أعمالهما تتبع مبدئيًّا مسارات مختلفة، يجعل المقارنة بينهما ضرورية، أو على الأقل محفزة بشكل خاص.
وبعد أن نقوم -بفضل هذا المنهج- بعزل العنصر الأوّلي للظاهرة الموصوفة في الفكر الغربي بأنها «قانونية» (وهي ما سنسمّيها بشكل منهجي فيما يلي من بحثنا باسم «الظاهرة القانونية»، مع إلحاحنا على القارئ بأن يضع في اعتباره دومًا الطابع العرقي لهذه العبارة)، سنقوم بالبرهنة على أن المجتمعات بلا دولة ليست مع ذلك مجتمعات بلا قانون.
ب- المقاربة المجهرية للظاهرة القانونية
للتغلّب على غموض مفهوم القانون، يقترح لوسيان فرانسوا اللجوء إلى استحداث اصطلاحات جديدة، تكون محدَّدة بدقة وتُشير إلى مختلف مراحل تعقّد ظاهرة جنينيّة حين ظهورها (مثل الأمر الصادر عن قاطع الطريق إلى ضحيّة: «أعطني أموالك أو سآخذ حياتك!») وصولًا إلى البنية المعقَّدة لما يُسمّى في الخطاب الدارج «دولة». وفي هذه السبيل، قام فرانسوا بابتداع منهج وأدوات تحليل تسمح -كما يقول- بإدراك تعدّد مظاهر الظاهرة القانونيّة، دون الوقوع في تناقض دلالي، أي إنه يقوم -بمعنى من المعاني- بثورة في العلوم القانونية شبيهة بالثورة التي عرفتها علوم اللسانيات. وبغرض الإيجاز، سنكتفي بدراسة أهم عناصر نظريّته من أجل تحليل الأداء القانوني للمجتمعات التي درسها كلاستر.
1. الأقنون (jurème)
حُدِّد الشكل الأساسي للظاهرة التي درسها لوسيان فرانسوا بالمصطلح المستحدث «الأقنون» (jurème)[55]* وعرَّفه بأنه «كل إظهار لمطلب من قبل إنسان بقصد حصول سلوك بشري، ويكون مزوَّدًا بآلية تُثير ضغطًا معاكسًا في صورة مقاومة أحد المتلقين للمطلب، يتمثّل في التهديد بإيقاع عقوبة»[56]. وتبعًا لذلك، تُسهم خمسة عناصر في حدوث مثل هذا الوضعيّة:
(أ) القدرة على ممارسة الضغط عبر التهديد بالتضييق. ولا يهم أن تكون القدرة على إحداث التضييق حقيقية؛ إذ يكفي لذلك الإيهام بالقدرة على إنزال عقوبة أو التوعد بإيقاعها (يمكن على سبيل المثال استخدام مسدّس وهمي للتهديد، أو التوعد بإحلال غضب إله أو قوة شريرة في تهديد الإنسان الذي نطلب منه انتهاج سلوك محدد).
(ب) يجب أن يكون المتلقي مدركًا للعقوبة وحسّاسًا ومكشوفًا تجاهها. «لذلك من الضروري، من أجل إصدار أقنون، أن يكون أمامك كائنات قادرة على إدراك أنها مُهدَّدة وفي الوقت نفسه حسّاسة تجاه ما يُهددها»[57]. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري ألا يكون متلقّي الأقنون قادرًا على التهرب من السلطة التي تُهدِّده[58].
(ج) يجب أن تكون آلية التضييق قادرة على كسر كلِّ مقاومة تجاه المطلب. ومن ثَمَّ، فإن العنف المجاني لا يُسهم في تشكيل أقنون.
(د) يجب أن يُنظر إلى المطلب على أنه إلزامي[59] «بمعنى أنه مستقل عما يرغب فيه المتلقّي»[60].
(هـ) يجب أن يكون المطلب والتهديد واضحيْن، أو معلوميْن على الأقل.
ونحن نجد هذه العناصر الخمسة مجتمعة بالفعل في المواجهة القصيرة التي يأمر فيها قاطع طريق أحد المارّة بتسليم أمواله تحت تهديد السلاح. لكن من المرجح أنها تدخل في تركيبة أشكال أكثر تعقيدًا من علاقات السلطة وصولًا إلى أكثرها تطوّرًا (أي الدولة). وتتميّز الدولة في نظر لوسيان فرانسوا بأقنون خاص، هو أقنون السيادة، وهو الذي يتعلق بـ«حظر أي عنف مادي كبير غير مرخّص فيه في مكان محدد»[61].
2. تعقّد بنى السلطة: دائرة الإلزام المتبادل والتجانس العقدي
لا يكفي الأقنون البسيط لوصف عمل علاقات السلطة داخل مجتمع. ذلك أنه يمكن لفرد واحد إصدار عدة أقانين مرتبطة ببعضها بطريقة متماسكة، وتكون تمهيدية أحيانًا، وتعديليّة في أحايين أخرى، وتُنشأ بفضل «نفس» السلطة، ولها «نفس» القدرة على الضغط بالتهديد. وهذا النظام الصغير للسلطة الخاضع لنفس الفرد «السيّد» يُسمّى «أُحْكُومَة» (archème)[62][63]*.
وإذا ما توافق عدد من الأفراد لكلّ منهم أقنون على التعاون من أجل تشكيل بنية سلطة داخل مجتمع، فإن أُحكوماتهم تتضام، بحيث يُعلن كل فرد أنه «يتعاون مع الآخرين، وأن رسائلهم الأقنونية تُلزمه»[64]. وبعبارة أخرى، فإن كل فرد يتبنّى تلك الرسائل الأقنونية بشكل من الأشكال، وهذا ما يُنتج شيئًا يتجاوز مجرَّد الجمع البسيط بين أحكومات، فإذا تبنّى الشخص (أ) مطالب الشخص (ب)، فلا يمكن للشخص (ج) التمرّد على (ب) دون إثارة استياء (أ)، والعكس بالعكس. أي إن مطالب أحدهما تغدو مطالب الآخر نفسها. ويُشكِّل هذا التضامّ ما يُسمّيه لوسيان فرانسوا «المجاميع» (agrégats)[65]. ويمكن التمييز بين نوعيْن من المجاميع.
الأوَّل: هو المجاميع المتكوِّنة من تضامّ أحكومات متناظرة، أي أحكومات من المستوى نفسه وغير متراتبة فيما بينها، وهذه هي الحال مثلًا في صف الانتظار، حين يُعلن كلّ فرد من الأفراد المتّحدين الذين يُشكِّلون الصفَّ استهجانه لمحاولة أحدهم تجاوز آخر يقف أمامه. أمّا الثاني: فهو حين تكون المجاميع في علاقة هرمية؛ وعندها تغدو مستقطبة. وهذه هي مثلًا الحال داخل منظّمة إجرامية، حيث تتضام المجاميع التي يكون على رأسها أحكومة الزعيم. أما ضمان تماسك المجتمع، فيتم من خلال نوع من تجانس القناعات المعيارية، أي إن بعض المبادئ تُعتبر أساسية من قبل الجميع، بحيث يتوقَّع كلّ فرد من الآخرين احترامها، وهذا ما يُسمّى بـ«التجانس العقدي» homodoxie [66]. وبما أن كل واحد يتوقع من الآخرين احترام هذه الالتزامات، فإن العديد من المجاميع المتماثلة تتطابق، بحيث تتبادل الرسائل الأقنونية وتتّحد بشأنها بكلّ يُسر. وعلى عكس المجاميع الناتجة عن تضامّ أحكومات تُوجِّه فيها بنية السلطة (الآمرون) مطالبها نحو الخارج (من عليهم الطاعة)، فإن تطابق الأحكومات في حالة التجانس العقدي يُشكِّل دائرة من الإلزام المتبادل يتحكّم فيها الأعضاء ويخضعون لها في الوقت نفسه[67]، «فكل عضو في الجماعة هو في الوقت نفسه متلَقٍّ لواحدة من هذه المجاميع، وصاحب أحكومة داخلة في تشكيل جميع الأحكومات الأخرى»[68].
3. الهالة
تهدف «الهالة» nimbe إلى تعزيز فعالية الرسائل الأقنونية من خلال إكسائها طابعًا يُناسب الإعلان عن المطلب وعن التهديد بالعقوبة في حالة العصيان. وتهدف هذه الآلية التي يشير اسمها إلى هالة الضوء أو الدائرة المضيئة التي تُرسم في فن الأيقونات حول شخصيات يُراد تمجيدها- إما إلى إبراز مظهر التهديد المصاحب لمصدر الأقنون، أو إلى التخفيف من حدّة الإزعاج المرتبط بالإكراه، حيث يُقدَّم الأقنون أو مصدره في مظاهر مُغرية أو في صور من شأنها كسب تأييد المتقبّل. ويتجلّى هذا التجميل الكذوب للواقع -بشكل أساسي دون حصر- في استخدام أساليب لغوية معينة. وهكذا، فإن الأعمال التحضيرية للنصوص التشريعية، ودوافع الإجراءات الإدارية، والدعاية المصاحبة لبعض الإجراءات الحكومية وخطابات التبرير الأخرى، ينضوي جميعها تحت مقولة الهالة. فهي تهدف إلى تبرير إجراء يحتمل أن يكون مزعجًا، وتُقدِّمه في شكل جذَّاب. ومن هنا، فإن الاستخدام المتكرِّر للعبارات الملطّفة في النصوص القانونية يُمثّل أيضًا شكلًا من أشكال الهالة[69].
وفي المجتمعات «الغابرة» على وجه الخصوص، «يُوجد تعبير ملطّف آخر (...) يتمثّل في تسمية الهدايا التي يقتضي العُرف تقديمها في بعض المناسبات (الزواج...إلخ) خوفًا من سوء الذكر، باسم آخر مثل الهبات والعطايا، والحديث عنها كما لو أنها طوعية وبدافع الكرم الخالص»[70]. ووفقًا لكلاستر، فإن هذه الهبة الإلزامية وهذا الكرم المغلف، هو ما يُميّز علاقات الهنود بزعيمهم. فوراء هذه التبادلات تتوارى عقلانية أعمق تتدثر بهالة مزدوجة، يتمثّل وجهها الأوّل في أن الهبة هي تقنية تحكّم في السلطة، ويتمثّل وجهها الثاني في أن الزعيم مسؤول عن حفظ السلم. لكن الزعيم في الواقع له مصلحة في الحفاظ على السلم: «ليس للزعيم سلطة قرار، إنه غير متأكد أبدًا من أن «أوامره» ستنفّذ، وهذه الهشاشة الدائمة لسلطة متنازع عليها باستمرار تُضفي طبع الهشاشة كذلك على ممارسة الوظيفة: فسلطة الزعيم تعتمد على إرادة الجماعة. ومن هنا نفهم مصلحة الزعيم المباشرة في الحفاظ على السلم، فاندلاع أزمة قد تُدمِّر الانسجام الداخلي يستدعي تدخّل السلطة، ولكنها تُثير في الوقت نفسه الرغبة في النزاع، تلك الرغبة التي لا يملك الزعيم الوسائل اللازمة لمغالبتها»[71].
وتتصل بهذه المهمة الأساسية ثلاثة واجبات علينا أن ننظر إليها -بسبب غياب المعاملة بالمثل- على أنها هبات، غير أنها هبات في خدمة هدف سياسي أو إذا شئنا ذات هدف معادٍ للسياسة. وتتمثّل تلك الهبات في واجب الزعيم في أن يتكلّم، وفي أن يكون سخيًّا بالممتلكات، وواجب الجماعة في إعطاء نساء للزعيم الذي يتمتّع وحده بامتياز تعدّد الزوجات. إن تداول هذه العناصر الثلاثة (الكلمات والممتلكات والنساء) وتبادلها، هو ما يُميّز الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة، إذ إنّ الهنود من خلال حرصهم على هذا التبادل، إنّما يعملون على بناء الجماعة نفسها في قالب مجتمع. بيد أنه «من الواضح أنه بالنسبة للجماعة التي تخلت عن عدد كبير من أهم قيمها الأساسية (أي النساء) لصالح الزعيم، فإن الخُطَب اليومية والممتلكات الاقتصادية الضئيلة التي يمكن للزعيم التصرف فيها لا تُشكِّل تعويضًا مكافئًا»[72].
بيد أن ما يبدو أنه نابع من منطق تبادل، لا يعدو في الواقع كونه مجرّد هبة، وذلك نتيجة غياب المعاملة بالمثل. أضف إلى ذلك أن السلطة وراثية، فهي لا تُتداول، ولا تنتقل إلى الأغنى أو إلى أفضل خطيب. ومن هنا، فإن رفض التبادل، ومن ثَمَّ غياب المعاملة بالمثل، يعزل كلّ علامة في دائرتها الخاصة: «تحتفظ السلطة بعلاقة مميزة مع العناصر التي تُؤسس بحركتها التبادلية بنية المجتمع ذاته، لكن هذه العلاقة، من خلال إنكار الجماعة لقيمتها التبادليّة، لا تُؤسِّس المجال السياسي بوصفه يقع خارج بنية الجماعة فحسب، بل هي تتجاوز ذلك لتعتبره نفيًا للجماعة نفسها، فالسلطة مضادة للجماعة، ورفض المعاملة بالمثل بوصفها بعدًا وجوديًّا للمجتمع، هو رفض للمجتمع نفسه»[73].
ومن خلال موضعة الكلام خارج الجماعة وخارج دائرة التبادل، ومن ثَمَّ خارج مجال التواصل، يُتَجنَّب ظهور خطاب يدعي الإكراه؛ لأنه «ليس من الضروري أن يُستَمع إلى خطاب الزعيم ما دام أن الهنود لا يُعيرونه أي اهتمام في الغالب»[74]. وبما أنه ما من زعيم يُحاول جعل سلطته فعّالة إلا وتتخلّى عنه الجماعة، فإن النساء يصبحْن موضوع ابتزاز حيال الزعيم أكثر من كونهنّ امتيازًا حقيقيًّا له. وهكذا تتجلى ظاهرة الهالة المزدوجة في مؤسسة الزعامة، فمن جهة، تختبئ وراء التبادلات الظاهرة تدفّقات في اتجاه واحد. ومن جهة أخرى، تسمح هذه التدفقات المنعزلة للجماعة بالسيطرة على الزعيم وعلى تدفّقات السلع والكلمات والنساء، وهو ما يُؤدِّي -حسب كلاستر- إلى ولادة مجتمع (سياسي) لو أضحى التواصل بينها حرًّا.
ج- الأداء القانوني لما يُسمّى بالمجتمعات البدائية في ضوء المنهج المجهري
1. ضرورة المساواة والتلقين: منع ظهور سلطة مركزية فعالة
لقد سبق أن أشرنا في عدة مناسبات إلى ضرورة المساواة التي تُفرض على أعضاء المجتمعات «البدائية»، وركّزنا مع كلاستر على بنية هذه المجتمعات التي تمنع ظهور سلطة مركزية فعالة من خلال إرساء مساواة صارمة. ويُعبَّر عن هذا المطلب بشكل خاص من خلال طقوس التلقين[75]* التي لا يتردَّد كلاستر في وصفها بأنها طقوس تعذيب. وهنا، يتعلق الأمر مرة أخرى بمنع استيلاء فرد على السلطة. فمن خلال التأكد من أن المجتمع يُشكّل كيانًا متجانسًا تمام التجانس، تقل فرص ظهور تسلط مركزي. ومن ثَمَّ، ظهور علاقة هيمنة داخل الجماعة. وفي الواقع، فإنّه لا يوجد قانون إلا في علاقة بين ذوات[76]. ويبدو أن المجتمع البدائي يسعى إلى تشكيل نفسه بوصفه ذاتًا واحدة، بحيث لا يمكن أن تأتي محاولة الاستيلاء على السلطة إلا من خارجه. بيد أنه سرعان ما تُحيَّد؛ لأن ما يُسمّى بالمجتمعات البدائيّة تمتلك كما رأينا مكانًا للسّلطة، غير فعّال بالتأكيد، ولكنّه مع ذلك قابل للمعارضة. وبالمثل، فإن القانون الآتي من الخارج سيُحيَّد على الفور من خلال القانون الداخلي (قانون المجتمع).
ولنتأمّل المقتطف التالي:
«لنأخذ بعين الاعتبار أن التلقين هو -بلا شك- وضع الشجاعة الفردية على محك التجربة، وهي شجاعة تُعبِّر عن نفسه في الصمت الذي تُقابل به المعاناة إذا جاز التعبير. ولكن، بعد عمليّة التلقين ونسيان كلّ عذاب، يبقى شيء مكتسب لا رجعة فيه، هو تلك الآثار التي يتركها السكِّين أو الحجر على الجسد، وتلك الندوب الناتجة عن الجروح. فالرجل الملقّن هو رجل موشوم. والغرض من التلقين وما يصحبه من تعذيب، هو وضع علامات على الجسد، ففي طقوس التنشئة، يضع المجتمع بصمته على أجساد الشباب من خلال وضع تلك الندوب والعلامات التي لن تمحى، بل تظل منقوشة في عمق الجلد، لكي تشهد على الدّوام وإلى الأبد بأن الألم وإن كان مجرَّد ذكرى سيّئة، إلا أنه قد اختُبِر مع ذلك في جو من الخوف والرعب. إن الوشم يمنع النسيان؛ لأن الجسد نفسه يحمل آثار الذكرى المطبوعة عليه، فالجسد هو الذاكرة. (...) وطقوس التلقين هي طريقة تربويّة تنتقل من الجماعة إلى الفرد، ومن القبيلة إلى الشباب. إنها تربية عن طريق التأكيد لا الحوار؛ ولذلك يجب على الملقّنين التزام الصمت وهم تحت وطأة التعذيب، وما السكوت إلا علامة الرضا.
«لكن ما الذي يرتضيه الشبّان؟ إنهم يرضون بتقبل ما أضحوا عليه من الآن فصاعدًا، أعضاء كاملين في الجماعة، لا أكثر ولا أقل. لقد طُبعوا بميسم يجعلهم كذلك دون رجعة، وهذا هو السر الذي تكشفه الجماعة للشباب في عملية التلقين: «أنتم منّا. كل واحد منكم شبيه بنا، كلّ واحد منكم شبيه بالآخرين. أنتم تحملون الاسم نفسه ولن تغيّروه. كل واحد منكم يشغل بيننا المكان نفسه والمجال نفسه: حافظوا عليهما. لا أحد منكم أقلَّ منّا، ولا أحد منكم أكثر منّا. ولا يمكنكم نسيان هذا، فتلك العلامات التي تركناها على أجسادكم ستذكّركم دومًا بهذا».
إن المجتمع يُملي قانونه على أعضائه ويحفر نصّه على سطح الأجساد؛ لأن القانون الذي تقوم عليه الحياة الاجتماعية للقبيلة لا يُفترض أن ينساه أحد[77].
إن التلقين ينقش حرفيًّا قانون المجتمع على جسد أعضائه (الوشوم، الندوب، الخدوش، ...إلخ)، وهو قانون أساسي يُطبَع على أجساد جميع أعضاء القبيلة، ومفاده «أنك لا تُساوي أقل من غيرك، ولا تُساوي أكثر من غيرك»[78]. وهذا ما سيذكّر به الوشم الفرد باستمرار. إنها آلية ذكية بشكل مدهش بالنسبة لمجتمعات تُوصف بأنها «بدائية». فالمجتمع يبدو مدركًا للمصدر المزدوج لخطر الهيمنة: المجتمع نفسه من خلال الأفراد الذين يؤلّفونه من جهة، والعالم الخارجي من جهة أخرى. ومن أجل منع كلّ قانون قادم من الخارج، فلا بُدّ من وجود قانون من الداخل يُعَدُّ أكثر أصالة، يُعارض به المجتمع كل قاعدة سواه ويجعله فوقها جميعًا.
إن تجانس الجسم الاجتماعي من خلال وشم أجساد الأفراد في عملية التلقين يمنع -في نهاية المطاف- ظهور القانون في جانبه العلائقي المحض (يأمر إنسان إنسانًا آخر ملزمًا بطاعته).
كما لا ينبغي أيضًا أن يكون هذا القانون قابلًا للانقلاب عليه من الداخل من قبل فرد أو مجموعة أفراد طموحين يرغبون في احتكار السلطة داخل الجماعة. ولذلك، فإن ما يُراهن عليه المجتمع لا يتعلَّق بآلية القانون ذاتها، بل بمضمونه وطريقة إبلاغه. فإذا كان مضمون القانون هو منع التفاوت، أي منع كلّ تسلّط، فإن طريقة إبلاغ أفراد القبيلة بالقانون تمنعهم من نسيانه ومن نسيان الأقنون الأوّل: «النّدوب المرسومة على الجسد، هي نصّ القانون البدائي المدوَّن على الجسد، وهي بهذا المعنى كتابة على الجسد»[79]. أما المواضع الأخرى الوحيدة التي يمكن أن تنبثق عنها الظاهرة القانونية داخل الجسم الاجتماعي، فهي تبغض التفاوت، بل هي لا تتصوّر ذلك أو لا تطرحه على الأقل؛ لأن الأفراد ليسوا واحدًا، بل هم منخرطون بعمق في تعدديّة تجمعهم معًا. وإذا كان هذا القانون يهدف بالتأكيد إلى منع الظهور الداخلي للتفاوت، إلا أنه يهدف كذلك إلى درء القانون الخارجي، أي القانون المنفصل. ذلك أن «القانون البدائي يطرح نفسه في مواجهة قانون الدولة الذي يُؤسس التفاوت ويُشكِّل ضمانته من أجل تحاشيه»[80]. إن تجانس الجسم الاجتماعي من خلال وشم أجساد الأفراد في عملية التلقين يمنع -في نهاية المطاف- ظهور القانون في جانبه العلائقي المحض (يأمر إنسان إنسانًا آخر ملزمًا بطاعته). لا وجود لتسلّط، ولا وجود لوضعية أقنونية بالأخص، إلا بين شخصيْن على الأقل. فإذا كان الإنسان البدائي ملتحمًا بالآخرين وغير منفصل عنهم بل يُشكِّل معهم كلًّا غير قابل للتجزئة، وإذا كان التجانس كليًّا، فإنه لا سبيل لظهور التسلّط، ومن ثَمَّ لا سبيل لظهور الدولة وقانونها.
2. دائرة الإلزام المتبادل: ضمان سلطة منتشرة الكل فيها آمر والكل مطيع
ومع ذلك، فإن لهذا التلاحم إخفاقاته، فنحن نلاحظ مثلًا حدوث انتهاكات لقانون قبيلة الآشي (Aché)، وهي انتهاكات تعود حسب كلاستر إلى الاتصال بالبيض، أي بالعالم الخارجي. وللكشف عن بُعد أقنوني في تنظيم الجماعة، فمن الضروري وجود آلية عقوبات كما رأينا. ومع ذلك، فإن صورة دائرة الإلزام المتبادل تجعل من الممكن التوفيق بين ضرورة المساواة وبثِّ رسائل أقنونية. فالمجتمعات بلا دولة لا تقوم على تجانس كامل للذات الجماعية، بل على ترتيب معين للأوامر الأقنونية. ويُمارس الغاياكي التلقين الذي يُفتّت حياة الأفراد ويُهيكل المجتمع، ويُعيد إنتاج الأساطير الهندية بشكل طقوسي. «لا يمكن للمرء أن يكون طفلًا وبالغًا في آن، لا يُمكنه أن يكون معًا كيبوتشو [طفلًا] وفاتن نساء، فهو إما هذا أو ذاك، أحدهما تلو الآخر، فهو في الأول قضيب، ثمّ يغدو حَلْقَة شفة[81]*، لا يجب الخلط بين الأمور، الأحياء يعيشون هنا، والأموات هناك، الأطفال من جهة، والرجال من جهة أخرى»[82]. أما الفتيات، فتخضعن مباشرة بعد أول حيضة لهنّ لطقوس تلقين أليمة بغرض تطهيرهنّ. وقبل مرحلة الاتصال بالبيض، لم يكن الشباب الهنود يعترضون أبدًا على هذه الطقوس المؤلمة. لكن حدث أن اعترضت الفتاة شاشوجي Chachugi على ذلك صائحة: «لا للنّدوب! الفتاة تفتقر تمامًا إلى الشجاعة، وكانت تلك أوّل مرة لا يُحترم فيها قانون قبيلة الآشي. لقد كانت شاشوجي خائفة، ولم تكن تريد الخضوع لعلمية التلقين، فقد أرعبتها محنة الألم. كيف أضحى ذلك ممكنًا؟ لقد غضب الناس، لكن ماذا يُمكنهم أن يفعلوا؟ لقد كان الجميع يعرف أنه إذا كان «الدم قد نزل» قبيل بضعة أشهر، أي قبل الاتصال بالبيض، فإنه ما كان لشاشوجي أن تُفكِّر مطلقًا في الهروب مما كان واجبًا عند نساء الآشي على مرّ الأزمان.
(...) لقد كانت شاشوجي تخشى أن تصبح شخصًا راشدًا، وامرأة آشي حقيقية، وأرادت أن تظل «امرأة جديدة». فهل كان يمكن لمثل هذا الشيء أن يدوم؟ على أية حال، في صباح أحد أيام شهر يونيو الباردة، اكتشفوا جثة الفتاة الصغيرة. لقد ماتت في صمت أثناء الليل. ولم يُعلق أحد على ذلك، لكن أناس الآشي كانوا يعرفون»[83].
وفي حالة شاشوجي، ربما لم تكن العقوبة معروفة بشكل واضح مسبقًا. ومع ذلك، فقد كانت الفتاة تعرف أنها برفضها الخضوع لطقوس التلقين، فإنها تضع نفسها خارج المجتمع. ألم يكن قتلها من قبل الجماعة في نهاية المطاف أكبر دليل على هذا الإقصاء؟ إن الالتزام بالخضوع للتلقين، ومن ثَمَّ ضمان استمرار قوانين الأسلاف، يُمكن تحليله بسهولة بوصفه التزامًا أقنونيًّا، أوّلًا: سلطة ممارسة الضغط عن طريق التهديد بالتضييق موجودة عند جميع أفراد الجماعة باستثناء شاشوجي، وهي تتمثّل في التهديد بالإقصاء من الجماعة بأيّ وسيلة كانت. ثانيًا: كانت شاشوجي مدركة لهذا التهديد؛ فهي تعرف أنه لا يمكن لأحد أن ينتمي إلى الجماعة دون الخضوع لعملية التلقين. وبما أنها لم تهرب، فقد ظلت بذلك عرضة للتهديد. ثالثًا: كانت آلية الضغط تتّسم بالقدرة على كسر مقاومة المطلب التي أبدتها شاشوجي، فلم تكن شاشوجي لتُقتل لو وافقت على الخضوع لعملية التلقين. رابعًا: التلقين مفروض من قبل الجماعة على الفتاة الهندية دون أي اعتبار لرغبتها. وخامسًا: كان المطلب والتهديد واضحيْن لشاشوجي، حيث كانت عمليات التلقين العديدة التي حضرتها كافية لكي تفهم ما كان يُنتظر منها. وترتبط بعض القواعد التي يكون تجاوزها بالتأكيد أكثر حدوثًا بعقوبات أكثر دقّة. وعلى سبيل المثال، فإن عملية تلقين الفتيان كانت تتم على مرحلتيْن. المرحلة الأولى: هي الأمبي موتو (imbi mutu)، وهي تتمّ عندما يغدو الفتيان غير قادرين على كبح جماح رغباتهم الجنسية، وعندها يطلبون «ثقب الشفة، لكي يصبحوا صيادين حقيقيّين وقادرين على ارتداء حَلْقَة الشَّفَة[84]* التي تُشير إلى دخولهم مرحلة البلوغ، وتفتح أمامهم بلا قيد سُبُل الوصول إلى النساء اللواتي طالما رغبوا فيهنّ»[85]. وما دام الجرح لم يلتئم، ولم يسقط الخيط المعقود داخل الشفة لمنع انغلاق الثقب، فلا يمكن للشباب الملقّنين الانغماس في رغباتهم الجسدية. فإن حدث أن خالف أحد الشبّان ذلك، فستحل به «أعظم مصيبة يُمكن أن تصيب رجلًا، وهي سوء الحظّ في الصيد»[86].
ولا أهمية مطلقًا في كون العقوبة مبنيّة على خرافة، أو أنها جاءت من خارج الجماعة. إن هذه الأمثلة تُثبت وجود ظواهر أقنونيّة (أي قانونية) داخل المجتمعات بلا دولة، أي إنها تُنتج العديد من الأقانين. ومع ذلك، فإن ضرورة المساواة والضبط البنيوي للسلطة يمنعان انبعاث تلك الأقانين من أفراد منعزلين على حساب الآخرين. إن الظاهرة القانونية لا تُوجد إلا في صورة دائرة الإلزام المتبادل، التي يكون فيها كل فرد مُرسِلًا ومتلقيًا في آنٍ لإلزامات أقنونيّة، وضامنًا لاحترامها في الوقت نفسه. لم تُقتل شاشوجي على يد فرد من جماعتها ذي حماسة مفرطة، ولم يكن هناك من يدافع عنها. فكم هو بليغ هذا الصمت المجمع عليه عند الهنود!
د- توليف: ما يُسمّى بالمجتمع البدائي يهدف إلى منع الدولة
إن المجتمع البدائي مهيكل بطريقة تمنع ظهور علاقة هيمنة -خلاف هيمنة الجميع على كل فرد- ومن ثَمَّ تمنع ظهور القانون في شكله الجنيني، خاصة قانون الدولة. فمنع ولادة الدولة هو منع ولادة قانون الدولة، بيد أنّه منع بموجب قانون آخر، هو قانون المجتمع المتجانس، فمنع الدولة -على حدّ تعبير لوسيان فرانسوا- هو منع تشكّل أقانين خارج دائرة الإلزام المتبادل، فالمجتمع «البدائي» بفضل هذه الدائرة ليس مضادًّا للقانون، بل هو مهيكل من قبل مجموعة من القواعد المصحوبة بتهديد وعقوبة. وما هذه القواعد سوى تعبير عن قانون الأسلاف الذي يعرف الجميع محتواه، ويقوم بالتذكير به باستمرار زعيم لا يتمتّع بسلطة ومن واجبه الكلام. ذلك أن «موضع السلطة هو المجتمع»[87]. وتترجم هذه الصيغة ببساطة صورة دائرة الإلزام المتبادل، إذ يُرسل كل هندي صاحب أحكومة مجموعةً من المطالب من المحتوى نفسه إلى الآخرين. وتتضامّ هذه الأحكومات المتجانسة إلى بعضها، ممّا يُؤدي إلى تكوين مجاميع متناظرة. ومن حينها، فإن كل واحد يطلب من الجميع أن يحترموا قانون الأجداد، وكل واحد يعرف أن الجميع يتوقّعون منه أن يفعل الشيء نفسه. وتشكّل دائرة الإلزام المتبادل هذه، البنية التي يندرج فيها الشأن القانوني عند «البرّيين» وهي بنية يحول منع التفاوت داخل الجماعة دون تغيّرها. فلا يمكن للقانون أن يظهر فيما يُسمّى مجتمعات بدائية إلا ضمن تناظر تامّ. فكيف يمكن بالفعل إدخال أقنون صادر عن فرد في غياب كل تبادلية، ضمن دائرة إلزام متبادل؟ هذا مستحيل، وهو ما فهمه مجتمع الآشي جيدًا بطريقة لا شعورية، إن محتوى القاعدة الأساسية يمنع ظهور عدم تناظر في العلاقات الاجتماعية.
وبالعودة إلى كلمة قانون واللعب على غموضها، يُمكننا أن نقول إن ضرورة المساواة تمنع ولادة القانون[88] بموجب القانون[89]، وإن القانون[90] بمنعه ولادة القانون[91] فإنه يمنع ولادة الدولة.
3. مجتمعات بلا حرية؟
من الواضح في هذه المرحلة أن المساواة -أو على الأقل المساواة المفروضة عن طريق ضغوط متبادلة- هي الشرط الأساسي لعدم ظهور الدولة. فالقانون لا يُولد بالفعل فيما يُسمّى مجتمعات بدائية، إلا من خلال صورة دائرة الإلزام المتبادل. ويتضمّن هذا التكوين تناظرًا مثاليًّا بين العلاقات، وهو ما يجعل ضرورة المساواة، تمنع إذا ما احتُرِمَت ظهور أي تفاوت. أما إذا كُسرت المساواة فسينتج عن ذلك انهيار الدائرة أو بث رسائل أقنونية خارجها على الأقل، وهو ما يُتيح نشوء علاقة هيمنة تجعل من الممكن انبعاث أقانين جديدة، بما في ذلك أقنون علوية الدولة. وبما أنه لا يُمكن أن يُولد أقنون علويّة بالفعل داخل دائرة إلزام متبادل، فمن الأحرى ألا يُولد إذا كان يحمل طابع مجاميع متناظرة وميسم تماثل عقدي معيّن؛ لأنه يفترض أن المتلقي المحتمل سيكون أيّ شخص يُوجد ضمن إقليم محدد، سواء كان ذلك الشخص عضوًا في دائرة الإلزام المتبادل أم لا. وبعبارة أخرى، إن نطاق عمل دائرة الإلزام المتبادل شخصي، في حين أن نطاق عمل أقنون العلويّة إقليمي. ومن هنا، فإن السلطة السياسية القائمة على قانون الدولة، ومن ثَمَّ على سلطة إكراه، هي بطبيعتها غير مساواتيّة. وها نحن بتنا نعرف الآن أن إدراج القانون في الجسم الاجتماعي وفي جسد الأفراد يمنع ظهور قانون قادم من الخارج، وأن ذلك يضمن استقلال القبيلة، ومن ثَمَّ يضمن حرّيتها. ومن وجهة نظر المجتمع ككل، من المؤكّد أن المساواة هي أساس حرّيته. وبالمقابل، ومن وجهة نظر فردية، فإن المسألة تبدو أكثر حساسية.
إن نقش قانون القبيلة على الأجساد من خلال عملية التلقين عنيفٌ بشكل مهول[92]. فالمجتمع يفرض قانونه على أعضائه من خلال العنف. فكيف يمكن أن نتحدَّث إذن عن حرية لديهم؟ هل المساواة القسرية قادرة على ضمان الحرية؟ لا مجال لإنكار الطابع العنيف لعملية التلقين، بيد أن العنف مقصود؛ لأن المعاناة تُؤدّي وظيفة حقيقية: «يحرص القائمون على طقس التلقين إلى أن تكون المعاناة شديدة، ويعملون على أن تصل إلى ذروتها. وقد يكون سكّين من قصب الخيزران أكثر من كافٍ لقطع جلد الملقّنين عند الغاياكي، لكنه لن يكون مؤلمًا بدرجة كافية. ولذلك من الضروري استخدام حجر يكون حادًّا قليلًا، لكن دون أن يكون قاطعًا، حجر يُمزّق بدل أن يقطع. ولذلك يذهب رجل خبير إلى مجاري بعض الأنهار للإتيان بهذه الحجارة المخصصة للتعذيب. (...) التلقين بلا شك اختبار للشجاعة الفردية التي يُعبَّر عنها -إذا جاز التعبير- في الصمت الذي تُقابل به المعاناة»[93].
ألا يُعَدُّ هذا العنف بمثابة إعادة تشكيل حقيقي للأفراد، ومن ثَمَّ ارتهان حريتهم؟ من المؤكد أن الملقَّنين لا خيار لديهم، وأنه لا مجال أمامهم لرفض التلقين ورفض الامتثال لضرورة المساواة. هذا ما يشهد عليه ذاك المصير الذي لاقته شاشوجي. هل يكون رفض الدولة واستقلال «القبيلة» على حساب ضياع الحرية الفردية؟ هل يجب أن نرى في هذه الآلية تعزيزًا للحرية الجماعية (حرية القبيلة) على حساب الحرية الفردية (حرية أعضائها)؟ إن مسألة الحرية، باستثناء بعض التأملات الموجزة، لم تُتَناول إلا قليلًا في أعمال كلاستر. ففي تعامله مع المشكلة المعاصرة للنمو السكاني، يبدو كلاستر وكأنه يُقيم علاقة سببية بين غياب الارتهان والحرية: «إن الشرط الذي يكون المجتمع به بدائيًّا، أي بلا دولة، أن يوجد فيه في نهاية الأمر حدّ أدنى من الارتهان ومن ثَمَّ أقصى حد من الحرية»[94].
وبالفعل، فقد وضعت المجتمعات البدائية عدة آليات تهدف إلى منع ارتهان البشر لبعضهم، والتمكن من السلطة بصفة فردية. بيد أن دائرة الإلزام المتبادل تعني ارتهان الجميع للجميع، فإذا تمكّنت المجتمعات «البدائية» من منع ظهور سلطة منفصلة، فذلك لأن كلًّا منهم يطلب من الجميع احترام مبادئ معينة؛ ولأنه يعرف أن الآخرين يتوقّعون منه الأمر نفسه. أما المجتمعات القائمة على الدولة، فتفضّل الارتهان الطوعي للأفراد، ومن ثَمَّ، ارتهان جزء من الحرّية: «أصبحت آلة الدولة في جميع المجتمعات الغربية، في سبيلها لمزيد من التدولن، بمعنى تزايد سلطويّتها خلال فترة طويلة قادمة على الأقل، وذلك بموافقة عميقة من الأغلبية التي تُسمّى عادة الأغلبية الصامتة، وهي أغلبية من المؤكد أنها موزعة بالتساوي بين اليسار واليمين»[95].
أليست دائرة الإلزام المتبادل التي تُهيكل المجتمعات بلا دولة، هي -مع ذلك- الصورة الأكثر دلالة عن العبودية الطوعية؟ إذا ضعف التماثل العقدي، فإن الدائرة لا تلبث أن تنحل، وما محافظة الدائرة على نفسها إلا لأن أعضاء الدائرة يحافظون على مطالبهم مع علمهم بأن الآخرين يفعلون الشيء نفسه. فإذا عنّ لأحد أعضاء دائرة الإلزام المتبادل عدم الخضوع لها، فيكفيه قطع صلته بالجماعة ومغادرتها طوعًا. وفي إحدى حلقات «يوميات هندي الغاياكي» التي سنفصل فيها القول أدناه، يذكر كلاستر أيضًا حرية الهنود في قطع الصلة ومغادرة الجماعة: «إذا لم يضغطوا أكثر على الرفاق للعودة معهم، فما ذاك إلا احترام لحريتهم. لكن يبدو أن هؤلاء قرروا البقاء هناك، ولذلك يجب ألا نُبالغ في الإلحاح عليهم»[96].
إن هذه الحرية التي تتطلب -في سبيل منع ارتهان بعض البشر من قبل سلطة منفصلة- عزل كلٍّ منهم عن الآخرين قد تبدو شديدة الغرابة. ولعله من المدهش حقًّا ألا تُتَناول هذه المسألة إلا بطريقة عرضية. ومع ذلك، ومن خلال مراجعة مقولاتنا، والتشكيك في المعنى الفرداني جوهريًّا الذي نُعطيه للحرية، وإعادة قراءة «النحن» التقليدية المتجانسة في ضوء فكرة الهالة، يظهر مسار جديد: ألا تكون الحرية مجرد فكرة ظرفية أساسًا، إن لم تكن ثقافية؟
أ. «النحن» المتجانسة لما يُسمّى بالمجتمعات البدائية: الحرية الجماعية مقابل الحرية الفردية
بما أن «المجتمع البدائي يعمل بطريقة تمنع التفاوت والاستغلال والانقسام داخله (...)، فإن المجتمع البدائي هو كلية شاملة ووحدة في آن. إنه كلية شاملة من حيث إنه مجموع ناجز ومستقل وكامل، حريص بلا هوادة على حفظ استقلاليّته، أي مجتمع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهو وحدة بمعنى أن كيانه المتجانس يثابر على رفض الانقسام الاجتماعي، واستبعاد التفاوت، ومنع الارتهان. إن المجتمع البدائي هو كلية شاملة وواحدة، بمعنى أن مبدأ وحدته لا يُوجد خارجه، فهو لا يسمح لأي صورة من صور الواحد بأن تنفصل عن الجسم الاجتماعي كي تُمثِّل وحدته أو تُجسّدها.
وهذا هو السبب في كون قاعدة عدم الانقسام سياسية في الأساس، إذا كان الزعيم البرّي بلا سلطة، فذلك لأن المجتمع لا يقبل بأن تنفصل السلطة عن كيانه، وأن ينشأ انقسام بين آمر ومطيع. وهذا السبب أيضًا في أن الزعيم في المجتمع البدائي، هو المفوّض بالكلام باسم المجتمع، فهو لا ينطق على هواه أو تعبيرًا عن رغباته الفردية أو قانونه الخاص، بل عن رغبة المجتمع في أن يظل غير منقسم، وعن قانون لم يسنّه أحد لأنه لا يتعلق بقرار بشري. فالمشرِّع هو نفسه من سبق أن أسّس المجتمع، إنه الأسلاف الأسطوريّون والأبطال الحضاريّون والآلهة. وما الزعيم إلا مجرد ناطق باسم هذا القانون، وجوهر خطابه دائمًا العودة إلى قانون الأجداد الذي لا يمكن لأحد خرقه؛ لأنه يُمثِّل كينونة المجتمع ذاتها. ذلك أن انتهاك هذا القانون سيكون معناه إفساد الجسم الاجتماعي، وإحداث تجديد فيه وتغييره، وهذا ما يرفضه المجتمع رفضًا قاطعًا»[97].
ومن هنا، فإن الكلية الشاملة والوحدة، أي التجانس باختصار، هو ما يُميِّز ما يُسمّى بالمجتمعات البدائية التي تُشكِّل «نحن» ملتحمة ومتوحدة. ومن هنا يبدو التجانس التامّ للجسم الاجتماعي، وكأنّه عقبة أمام مفهوم الحرية الفردية كما تتصوّرها المجتمعات الليبرالية الغربية. غير أن المسألة لا تتعلق بممارسة حرية «تقف حيث تبدأ حرية الآخرين»[98]، بل بالأحرى بضمان الانسجام التام للجسم الاجتماعي. ويوضح أسلوب إنتاج المجتمعات «البدائية» هذا المبدأ. فإنه من الخطأ -كما رأينا- التحدّث عن اقتصاد كفاف؛ لأن المجتمعات بلا دولة هي مجتمعات وفرة ورفاه، فهي تُكرِّس أقل وقت ممكن لإنتاج الغذاء، وتسعى إلى تثمير الجهد بهدف تقليل وقت العمل.
فإذا حدث أن أنتج أحد «البرّيين» عن طريق الصدفة أكثر من اللازم، فإنه لن يحتفظ بهذا الفائض، بل سيتقاسمه مع الجماعة: «الرجل الذي يُصبح «ثريًّا» بمجهوده الخاص سيرى كيف تختفي ثروته في غمضة عين بين أيدي جيرانه أو في بطونهم»[99]. فلا مجال مطلقًا للإثراء الشخصي، وهذا ما نجده مثلاً عند الغاياكي، حيث يستحيل بنيويًّا حدوث أي إثراء شخصي. فبما أن «السلعة» الأساسية هي اللحوم، فإنه لا يمكن للصيّاد أن يستهلك طرائده وحده خشية أن يُصاب بلعنة سوء الحظ في الصيد، ومن ثَمَّ وضعه على هامش المجتمع. «إذا قتلتُ حيوانًا، فإن زوجتي تتولّى تقطيعه؛ لأن ذلك محظور عليّ. وتحتفظ هي لنفسها وللأطفال ببعض القطع، ثمّ تُوزِّع الباقي على الصحاب: أوّلًا على الأقارب من الأخوة والأصهار، ثم على الآخرين»[100]. و«في الجملة، فإن الصياد يقضي حياته في إطلاق السهام من أجل الآخرين وأكل طرائدهم. إن تبعيّته كاملة، مثلها مثل تبعية أصحابه له. ومن ثَمَّ، فإن الأشياء متساوية، فلا أحد يتضرّر أبدًا لأن جميع الرجال «ينتجون» كمّيات متساوية من اللحوم. وهذا ما يسمى بيبى (pepy) أي التبادل»[101].
إن مفهوم الفردية الذي يفترض مسبقًا وحدة الفرد، لا يبدو أنه موجود أصلًا.
إن التبادل هو ما يضمن أولوية الجماعة على الفرد، ويجعل الفرد معتمدًا على الجماعة من أجل بقائه، بحيث يغدو التفاوت أمرًا لا يمكن تصوره. فكيف يُمكننا التحدّث إذن عن حرية فردية؟ فالفرديّة، أو الذاتية، لا يمكن التفكير فيها إلا فيما يتعلّق بـ«النحن» المشتركة. بل إن مفهوم الفردية الذي يفترض مسبقًا وحدة الفرد، لا يبدو أنه موجود أصلًا[102]. ولعله من باب المفارقة أن نجد في «يوميات الهندي الغاياكي» بعض التلميح لمفهوم فرداني عن الحرية. فقد وصف كلاستر رحلة استكشافية للبحث عن مجموعة من الهنود كان غيابهم المطول قد بدأ يُثير القلق. وقد عثر المؤلِّف وبعض رجال الأتشي على المفقودين وهم ملقون على الأرض، ومصابون بالحمّى، ربما بسبب الأنفلونزا. وفي هذا الصدد، كتب كلاستر يقول: «ولدهشتي الكبيرة، ظل الرجال الذين رافقتهم هناك لمدة عشر دقائق على الأكثر. لم يتكلّفوا مطلقًا عناء جعل الآخرين يقفون على أقدامهم، لقد أخذوا أسلحتهم ثمّ عادوا أدراجهم، لقد أنجزوا المهمة، ووجدوا المفقودين وتحدّثوا إليهم؛ الصحاب لا يريدون العودة، فلنعد إذن إلى ديارنا. يمكن للمرء أن يُفكِّر في لا مبالاتهم العميقة وعدم حساسيّتهم تجاه مصير المرضى، إن لم يكن في مدى قسوتهم. لكن الأمر غير هذا. ففي الواقع، إذا لم يُلحّوا على الصحاب في الرجوع معهم، فهو من باب احترام حرّيتهم. وما داموا قد قرَّروا البقاء هناك على ما يبدو، فلا مجال لإزعاجهم. (...) وحين بدأنا العودة، استدار العجوز توكانغي Tokangi نحوهم صارخًا: «عندما تموتون، ستلتهمكم النسور!».
إنه لمصير بغيض عند الهنود ألا يُغادروا عالم الأحياء وفق المراسم الطقوسية، فما من شيء أبغض من أن تُهمل جثّة إنسان وتُترك نهبًا لضواري الطبيعة، وخاصة النسور. ولذلك سمعنا من يصرخ: «سوف نأتي معكم!»[103]. فكيف نُفسّر الحرّية الممنوحة للهنود حين يتعلَّق الأمر بتركهم يموتون بمفردهم من جهة، والإكراه القسري على تحمّل الجروح أثناء طقس التلقين من جهة أخرى؟ تعتمد فرضيّتنا على توازن دائرة الإلزام المتبادل، فبرفضها التلقين أخلّت شاشوجي بتناظر العلاقات بين الهنود، ووضعت نفسها خارج الدائرة، ومن ثَمَّ، خاطرت بأن تكون غير واعية أو غير مُستهدفة من قبل مختلف المجاميع. أما مجموعة الصيّادين، فإنهم من خلال البقاء على قيد الحياة، لم يخلّوا بأي حال من الأحوال بالتوازن الاجتماعي للقبيلة. لقد خرجوا بالتأكيد من دائرة الإلزام المتبادل، ولكنهم بطبيعة الحال، لم يتمادوا في البقاء خارجها. ولذلك، فإن الحرية الفردية لا تُوجد إلا حين تكون غير مخلّة بتوازن الجماعة. ومع ذلك، فإن بيار كلاستر لم يتناول هذا المفهوم بشكل كاف تاركًا المجال لفرضيات شتى.
ب- نسبيّة النحن المتجانسة: الهالة ودائرة الإلزام المتبادل
يبدو أن الالتحام القوي للجماعة إلى جانب الحرية التي تُترك للهنود حين يقومون بأفعال لا تُلزم غيرهم، يُؤديان إلى مفارقة مفادها أن الحرية الفردية مكفولة ما دامت الجماعة قد وافقت عليها. وهذا لعمري تصوّر عجيب في نظر العقل الغربي. بيد أن حل هذه المفارقة قد يكون ممكنًا بفضل مفهوم الهالة. فـ«النحن» ليست راسخة، وهي تتطلّب مناخًا ملائمًا. فإذا تدهور هذا المناخ بدرجة كافية، فإن الأنانية تطفو على السطح وتنهار أخيولة (fiction) الجماعة بوصفها «نحن» متجانسة. فـ«النحن» من حيث إنها تسهم في ضمان الأداء الأمثل لدائرة الإلزام المتبادل من خلال أخيولة هي هالة. فإذا تبدّدت هذه الهالة، فمن المهمّ ألا تغيب عن بالنا أن صورة دائرة الإلزام المتبادل مكوّنة من أجزاء متعددة. فإذا أصاب تجانس الجماعة ضعف، فإن الأوامر الصادرة عن أعضاء الجماعة لا تتلاشى وتظل موجودة. وما يُحرك المجتمعات «البدائية» هو نموذج الاكتفاء الذاتي، فهي تُنتج الحد الأدنى لكي تعيش، وليس لكي تظل على قيد الحياة، لا أكثر ولا أقل. «إن نموذج الاكتفاء الذاتي الاقتصادي هو في الواقع نموذج للاستقلال السياسي، وهو أمر مضمون ما دام لا يحتاج إلى الآخرين»[104].
«هذه الإرادة تعمل أيضًا بمعنى من المعاني داخل الجماعة، حيث تدفع الميول النابذة كلّ وحدة إنتاج، أي كل «بيت»، إلى الإعلان: كلّ يعمل لنفسه! وبالطّبع، فإنه نادرًا ما يُطبَّق هذا المبدأ الشرس في أنانيّته، إلا إذا حدث طارئ، ومن ذلك المجاعة التي عاين ريموند فيرث Raymond Firth آثارها على مجتمع جزيرة تيكوبيا (tikopia) إثر الأعاصير المدمرة التي ضربتها بين عامي (1953 و1954م)»[105]. وإذا ظهر في البداية أن أهالي توكوبيا «توحدوا في مواجهة الشدائد»، كما لاحظ فيرث، ليعقب ذلك «حركة ثانية من الانسحاب، والعودة إلى العزلة العائلية، بعد أن تحوّلت المحنة إلى كارثة»[106]. لقد كشفت الأزمة هشاشة «نحن التيكوبيا» مع انتهاء الظروف المثلى للحفاظ على الهالة. «فقد ظهر البيت على أنه الحصن الحصين لمصلحة الفرد وجماعة البيت، وأنه قلعة تعزل نفسها في حالة الأزمات عن العالم الخارجي، وتقطع جسورها الاجتماعية، إذا لم تنشغل بنهب حدائق الأقارب والجيران»[107].
وتتضح نسبية تجانس «النحن» عند ما يُسمّى بالمجتمعات البدائية، وبشكل خاصّ فيما تنضح به الأمثال الحِكمية عند قبائل الماوري في نيوزيلندا، وهي قبائل تستخدم الأمثال أكثر مما تفعل مجتمعاتنا المتحضّرة. فبدلًا من التعبير عن رأي شخصي، يستخدم الماوري في كثير من الأحيان صيغًا مسبقة، أي الأمثال. فقد كان الاستشهاد بصيغ موجزة مستقاة من التقاليد المنسوبة إلى أسلاف أمجاد (حتى لو كان الاستشهاد بغرض تعزيز سلطة المتكلّم فحسب) [108]، يسمح للرأي العام بالتعبير عن نفسه بصوت متجانس إلى حد ما. ولذلك كان الرأي العام هو الضامن للعقوبات في حالة انتهاك القاعدة المُصاغة في قالب مَثَل: «كانت قوة الرأي العام عاملًا شديد التأثير في حياة الماوري. فما من شخص كان يُمكنه تحدّي الجماعة بأسرها والمضي في طريقه الخاص دون اعتبار لآراء رفاقه وجيرانه وأقاربه وأقوالهم. سيكون وجوده غير محتمل على الإطلاق (...). فأيّ تحدٍّ حقيقي لرقابة الجماعة سيكون معناه قطعًا تلقائيًّا لكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتبادلة، التي يمكنها وحدها أن تجعل الحياة ممكنة»[109]. بيد أنه من الغريب حقًّا أن نجد عند الماوري أمثالاً متناقضة تُعبِّر عن سلوك واحد بالتمجيد مرة والتحقير مرة أخرى.
ومن ذلك مثلًا أن الجماعة تمتدح كرم الضيافة والعطاء «لا يغرنَّك صغر الهديّة، المهم أنها تُعطَى عن حب»، «أبناء طاورنغتيرا (Taorangatira) وطورنغابيكي (Turangapeke) [أسماء رمزية] يُقدِّمون الهدايا ولا ينتظرون مقابلًا»[110]، في حال أنّا نجد أمثالاً أخرى تدعو إلى الأنانية «يظلّ الطعام ملكك ما دام نيّئًا، فإذا طُبخ صار لغيرك»[111]، «ينفد طعامنا إذا تسارعت أقدام الزوّار»[112]. فكيف يُمكن تفسير التعايش بين هذه التوجهات المتعارضة؟ نرى أنه من الضروري التمييز بين السلوك المثالي والسلوك الحقيقي. فالسلوك المثالي هو سلوك السخاء الذي يُحبِّذه المجتمع وتُشجّع عليه أمثال المديح: «كثرة الأيدي تخفّف الأثقال»[113]، «لا أحسن من ذراع قوية تسحب الحجر الكبير الذي يشدّ الزورق»[114]. بيد أن السلوك الفعلي مخالف للأخلاق التي تنشدها الجماعة، فهو يدفع الأفراد إلى السعي وراء مصالحهم الخاصة ويغدو موضوع تعليقات من خلال أمثال تستهجنه: «هل الجلوس في البيت يجلب لك الطعام؟»[115]؛ «هذا الرجل مثيل كلب محترق الذيل»[116].
إن هذه السلوكيات الأنانية شائعة وفي حاجة دائمة إلى رأي عام لكي تُصلح من نفسها وتُواكب مصلحة الجماعة. ويكشف وجود هذه الأمثال ذات المعاني المتناقضة، التي لا يُؤيّد الرأي العام سوى وجهها الجمعي، مدى هشاشة «النحن» البدائية ما دام تجانسها لا يعتمد إلا قدرة الجماعة على ممارسة ضغط كافٍ على الأفراد. فلا وجود لميل طبيعي نحو الكرم، ولا لشعور جماعي مفرط، بل مجرَّد دائرة إلزام متبادل تتعزّز فعاليّتها بالأمثال، أي بصيغ يُفترض أنها تُعبِّر عن قانون موروث عن الأسلاف، وهذا ما يُضفي عليها طابع الشرعية. إنّها هالة. وها نحن بعيدون –لحسن الحظ بلا شك- عن أسطورة الهمجي الطيّب. وفي مضارب قبيلة الغاياكي، يجتمع الرجال ليلًا في الغابة للغناء، ويستخدم كلّ منهم اللغة لابتكار أسطورته الفردية الخاصة به، وبذلك يصلون للحظة إلى إدراك ذواتهم الفردية التي يجعلها المجتمع مستحيلة التحقّق بنيويًّا. فاللغة وحدها هي التي «يُمكنها أن تفي بالمهمة المزدوجة: تجميع البشر، وكسر الروابط التي تُوحدهم»[117].
وإذا كان الغرب قد جعل اللغة خارجة تمامًا عن الإنسان حين جعلها مجرّد وسيلة اتصال، فإنّ «الثقافات البدائية، على العكس من ذلك، تهتمّ بإعلاء شأن اللغة أكثر مما تهتم باستخدامها، وعرفت كيف تُحافظ معها على تلك العلاقة الداخلية التي تمثّل في حدِّ ذاتها حلفًا مع المقدّس»[118]. وبشكل لا شعوري، فإنّ أغاني الرجال، وهي الإمكانية الوحيدة للتعبير عن إنجاز فردي، «تتقاطع عن غير قصد، في حوار أرادوا نسيانه»[119]. ولعل هذه الجدليّة بين التجميع والكسر من شأنها إلقاء بعض الأضواء على الطريقة التي تُعاش بها الحرية في هذه المجتمعات: فللهنود مطلق الحرية في العلاقة الفريدة التي يرتبطون بها مع جزئهم الإلهي، وهذه الحرية هي التي تقودهم بالضرورة إلى الجماعة وإلى تقاليدها التي تسمح بدورها للجزء الإلهي لكل منهم بأن يُوجد. ومن وجهة نظر النظرية المجهريّة للقانون، إذا كان للهالة بالتأكيد أن تُفسِّر بعض الأمور، فإنه لا ينبغي أن يغيب عنا التوتر الذي يُميِّز كلّ دائرة إلزام متبادل. فهذه الأخيرة تربط بين الكل وأجزائه ربطًا هو هشّ بالضرورة. وإذا ما كان الضغط عبر التهديد بإيقاع عقوبة والصادر عن الأفراد الذين يشكّلون الجماعة، فعّالًا، فما ذاك إلا بفضل تجانس القوة الآمرة، وهو ما يُفسّره وجود تماثل عقدي معيّن.
وبشكل مماثل، فإنه إذا كان لكلّ فرد الانتظارات المعياريّة نفسها، فهذا بفضل الضغط الذي تمارسه الجماعة. ومن ثَمَّ، فإن حرية الفرد، في هذه الحالة، تغدو بالضرورة مرتهَنة لحرية الجماعة. ومع ذلك، فإنّ وجهة النظر الوضعانيّة التي نتبنّاها تُلزمنا برفض كل واقعية[120]، فالمعايير ليست ما هي عليه بطبيعتها، بل تجد أساسها في فعل بشري (حتى لو كان على البشر تبرير سلوكهم وتوقعاتهم استنادًا إلى مرجعيّات غيبيّة). ومن هنا، فإنّه لو ضعُفت قوة التماثل العقدي، فإن أعضاء دائرة الإلزام المتبادل سيتوقّفون عن إصدار الأقانين نفسها، ومن ثَمَّ يصبح تضامّ هذه الأقانين على مستوى الجماعة مستحيلًا. وبدل بنية جعلت من تولّي فرد منعزل السلطة أمرًا مستحيلًا، سنكون أمام عدد كبير من الأحكومات، أي عدد كبير من أماكن السلطة. فإذا كانت السلطة منبثقة عن الجماعة، فما ذاك في نهاية المطاف إلا بفضل الأفراد الذين يؤلّفونها. وفي هذا المقام، يتحدّث كلاستر عن مقابلة أجراها مع أحد زعماء الغواراني في عام 1965م: «هذا الهندي، كان حكيمًا، وزعيمًا روحيًّا معترفًا به من قبل شعبه»[121].
وبينما أضحى أعضاء الجماعة مجبرين على العمل في مواعيد محدّدة والدخول في علاقة مع العالم الأبيض، أحس هذا الرجل الحكيم بمدى الخطر الذي يُشكّله هذا الاتّصال على حياة «القبيلة». ولذلك دعا أفراد شعبه إلى احترام طقوسهم التي تضمن الاتصال بالآلهة، ومن ثَمَّ مع الجزء الإلهي للهنود الذي يضمن تماسك الجماعة. وبعبارة أخرى، فقد دعا الجماعة إلى التمركز حول الذات. إن المساواة بين مكونات دائرة الإلزام المتبادل (لاهوتها المشترك) واستقلال هذه الدائرة عن الخارج، هو الشرط الضروري لبقائها، ولحرّيتها في العيش وفق ثقافتها الخاصّة:
«العديد من الأمم تُراهن على الأرض. لا تفقدوا صبركم معها! يا رفاق استمرّوا في الرقص! هزّوا خشخشات[122]* رقصاتكم بقوّة. اطلبوا من أخواتكم مرافقتكم بعصا الرقص. دعوهنّ يعرفن كيف يرقصن بها! أخواتكم! غنّوا جيّدًا، ودون أن تُخطئوا، الأغاني التي ألهمكم إيّاها [الإله] توبان (Tupan). غنّوها لأخواتكم، عندها فقط سيعرفن تلك الأغاني. إذا لم تُنشدوا هذه الأغاني، إذا نفد صبركم، إذا لم تُثابروا، إذا لم تصبروا على أجسادكم، فلن تكتسبوا القوة. فلتستمر [نبتة] الأوروكو (urucu) المتألقة في رفع رأسها! ولتتزيّن النساء بزهور الأوروكو، لا بزينة الرجال البيض؛ لأنه يجب علينا أن نظلّ منفصلين. نحن لا نتحمل الرجال البيض على هذه الأرض القبيحة!»[123].
4. خاتمة: هل الارتهان الأكبر هو المجتمع أم الدولة؟
«العالم الأبيض بصفته تلك تستحيل فيه المساواة»[124]. العالم الأبيض هو عالم الدولة. أما المجتمعات التي درسها كلاستر، فهي تنتظم دون أن تكون مجتمعات بلا قانون، ضدّ القانون الدولاني. إن ظهور القانون خارج دائرة الإلزام المتبادل القائمة على قانون الأسلاف يفترض بالضرورة وجود علاقة هيمنة. ويعتمد الهنود في منع هذا الظهور على عدة عوامل، هي الزعامة التي تسمح بتوجيه السلطة، وتبادل الطرائد الذي يضمن تبعيّة الفرد للجماعة، ثم خاصة قانون الجماعة الذي يحظر التفاوت. ويُنظَر إلى هذه المساواة المفروضة على أنها حرية، فالمجتمع دون رأس يتميّز بتماثل عقدي قوي يجعل منه «نحن» متجانسة.
ومع ذلك، فإن هذه الحرية تغدو نسبيّة للغاية إذا أدّت ممارستها إلى تعطيل سير الجماعة، أو ضعُفت هالة التجانس، وعلى نطاق أوسع، لو اتصلت مكونات دائرة الإلزام المتبادل عند الجماعة بأشكال أخرى من السلطة. فالمجتمع القائم على قانون الأجداد، هو مجتمع ضد الدولة، وهو بالضرورة مجتمع ضدّ التغيير وضدّ البدع. أما الدولة من جهتها، فتتّسم بأقنون السيادة الذي لا يمكنه أن ينحصر في دائرة إلزام متبادل. ذلك أن مجال تطبيق هذا الأقنون لا يكون إلا إقليمًا لا مجرّد أشخاص. ومن هنا، فإن الهنود ما داموا محافظين على المجال القانوني ضمن دائرة إلزام متبادل، فهم في مأمن من خطر الدولة. ذلك أن التضحية بالحرية الفردية لصالح حرية الجماعة هي ما تسمح للهنود بالبقاء والحفاظ على أسلوب حياتهم، أي أن هذه التضحية بما نَعدّه حريتهم الفرديّة تسمح لهم بضمان بقاء الدائرة، ومن ثَمَّ ديمومة الحرية الجماعية. ولذلك، فإن كلا النموذجين -الدولاني وغير الدولاني– يستتبعان دائمًا ارتهانًا معيّنًا للحرية الفردية. لكن ما هو الجزء الذي نضحّي به؟ وما مقداره؟ لقد بدا اختيار الهنود واضحًا على الأقل حين لم يكونوا على علم بعد بإمكانية وجود نموذج آخر، خاصة أنّ الاتصال بالخارج كان سبب اختفاء الغاياكي. لكن هذا الأمر يتجاوز أفق تفكيرنا الراهن.
الدراسة الأصليّة:
Brogniez (Maxime De), « Droit et liberté dans les sociétés sans État : une relecture de Pierre Clastres à la lumière d’une approche microscopique du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2021/1, Volume 86, p. 5-36.
الهوامش
[1] P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », in Pierre Clastres, M. Abensour et A. Kupiec (dir.), Paris, Sens & Tonka, 2011, p. 37.
وانظر ترجمة نصّ هذه المقابلة ضمن كتابنا: محمد الحاج سالم، «مجتمع بلا دولة أم مجتمع ضد الدولة؟ حوار مع بيار كلاستر»، في السياسة والدين والمجتمع: حوارات إناسية، (تونس: الوسيطي للنشر، 2014م)، ص 8-54.
[2] «نظرية تقترح حصريًّا معرفة موضوع القانون، أي تحديد ماهيّته وكيفيّته». انظر:
H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962, p.1
[3] É. DURKHEIM, Le Suicide, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930, p. 1.
[4] للاطّلاع على نقد لطروحات كلاستر، انظر:
J.-W. LAPIERRE, Vivre sans État? Essai sur le pouvoir politique et l’innovation sociale, Paris, Seuil, 1977, p. 323 et s.
[5] G. DIDI-HUBERMAN, Atlas ou le gai savoir inquiet, Paris, Les éditions de Minuit, 2011, p. 14.
[6] É. DURKHEIM, op. cit., p. 7.
[7] «مصيبة: حادث مأساوي، نكبة غير مسبوقة لا تتوقف آثارها عن التضخم إلى حد إلغاء ذاكرة الماضي، إلى درجة أن حب العبودية حل محل الرغبة في الحرية». انظر:
P. CLASTRES, « Liberté, malencontre, innommable », postface à É. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, 1978, p. 231.
[8] السابق، ص233.
[9] Cl. LEFORT, « L’œuvre de Clastres », in L’esprit des lois sauvages, M. Abensour (dir.), Paris, Seuil, 1987, p. 191.
[10] P. CLASTRES, La Société contre l’État, Paris, Les éditions de Minuit, 1974, p. 161.
[11] السابق.
[12] السابق.
[13] حول التطوريّة في علم الأنثروبولوجيا، انظر:
N. ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 14 et s.
[14] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 161.
[15] السابق، ص15.
[16] السابق، ص175.
[17] انظر بالخصوص الفصل الثاني من كتاب كلاستر وهو بعنوان: «التبادل والسلطة: فلسفة الزعامة الهنديّة»، في:
P. CLASTRES, « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », in La Société contre l’État, op. cit., p. 25-42.
[18] P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 29.
[19] P. CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2013, p. 35.
[20] السابق.
[21] P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 38.
[22] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 69.
[23] السابق، ص163.
[24] حول هذا الموضوع، انظر أيضًا:
M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976.
[25] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 167-168.
[26] السابق، ص181.
[27] السابق، ص169.
[28] P. CLASTRES, « Liberté, malencontre, innommable », op. cit., p. 234.
[29] ظهرت أولى المجتمعات غير المتساوية خلال العصر الحجري الحديث، أي حوالي 4500 قبل الميلاد. «وتمامًا مثل العصر الحجري الحديث نفسه، نتجت التفاوتات عن عوامل متعددة، أسهمت فيها ظروف إمكان مادية (اقتصاد إنتاجي، نمو سكاني، تقسيمات إقليمية)، وظروف فكرية (ثقافية، إيديولوجية، وحتى نفسية اجتماعية). ومن هنا، أفضت جميع مجتمعات العصر الحجري الحديث إلى ولادة مجتمعات غير متكافئة، ومن ثَمَّ، وبسرعات متفاوتة، ولادة مجتمعات الدولة والمجتمعات الحضرية». انظر:
J.-P. DEMOULE, « Naissance des inégalités et prémisses de l’État », in La Révolution néolithique dans le monde, J.-P. Demoule (dir.), Paris, CNRS éditions, 2009, p. 424).
[30] السابق.
يستند موريس غودلييه Maurice Godelier إلى مثال قبائل البارويا (Baruya) الذي عاش بينها في بابوزيا غينيا الجديدة منذ عام 1967م. ومع أن البارويا لم يكن لديهم زعيم، إلا أنه «كان عندهم تسلسل هرمي مزدوج. الأول بين الرجال والنساء وجميع الأفراد حسب الأعمار». انظر:
M. GODELIER, « Tribus et États. Quelques hypothèses », in La Révolution néolithique dans le monde, op. cit., p. 428.
وينبع هذا التسلسل الهرمي -وهو نظير ما نجده أيضًا في المجتمعات التي درسها كلاستر- من طقوس التلقين: وعلى إثرها «يظهر التسلسل الهرمي الثاني، وهو بين العشائر التي تمتلك الأدوات الطقسية والصيغ السرية التي تسمح بتلقين الفتيان وتُحوّلهم إلى محاربين أو سحرة شامان، وبين العشائر الأخرى» (المصدر نفسه). لذلك كان لخطاب بعض الأفراد أهمية أكبر من خطابات بقية الناس الذين يجب عليهم أن يُقدِّموا لهم الهدايا من السلع والخدمات. ومع ذلك، فقد كان يتعيَّن على هؤلاء إنتاج أقواتهم بأنفسهم. وما كان للدولة أن تظهر إلا حين بدأت مجموعات معينة «في تكريس وجودها ووقتها بالكامل لأداء الوظائف [السياسية والدينية] التي أضفت الشرعية -في نظر الجماعات الأخرى التي تُؤلِّف معها المجتمع- على حقّها في عدم إنتاج أقواتها من جهة، والتحكّم في نفاذ أعضاء آخرين في المجتمع إلى شروط إنتاج الوسائل المادّية -نفسها- لوجودهم الاجتماعي. وأخيرًا حقّها في احتكار استخدام قوة عملهم، بالإضافة إلى جزء من السلع والخدمات التي ينتجها عملهم». (نفسه، ص435).
[31] P. CLASTRES, Le Grand parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, Paris, Seuil, 1974, p. 8.
[32] من أجل ذلك، راجع:
P. CLASTRES, Le Grand parler…, op. cit.
[33] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 146.
[34] السابق، ص147.
[35] السابق.
[36] السابق، ص149.
[37] السابق.
[38] P. CLASTRES, Le Grand parler, op. cit., p. 27.
[39] السابق.
هنا يُعلِق كلاستر على المقطع التالي: «بمعرفته أساس الكلام المستقبلي، وفي سابق علمه الإلهي بالأشياء والمغيّبات، فهو يعرف بنفسه مصدر ما هو مقدّر له أن يتجمّع. الأرض غير موجودة بعد، والظلمة الأصلية تسود، ولا معرفة بعد بالأشياء: فبالمعرفة تنكشف الأشياء، لكنّه كان عليمًا في ذاته بمصدر ما يُراد جمعه» (السابق، ص26).
[40] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 184.
[41] السابق.
[42] السابق، ص178.
[43] R. JACOB, « Le droit, l’anthropologue et le microscope », in Le Droit sans la justice. Actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, E. Delruelle et G. Brausch (dir.), Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2002, p. 43; N. ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 46 et s.
[44] السابق.
وفي توليف بين آخر الأعمال الفرنسية في الأنثروبولوجيا القانونية، يقترح رودولفو ساكو Rodolfo Sacco تعريفًا يُماثل فيه بين القانون والقاعدة: «لقد اقتُرِحَت تسمية القانون قاعدةً، بمعنى الحكم العام والدائم، واعتبار الصفة القانونية صفة محددة لا للقانون فحسب، بل كذلك لكلّ آلية رقابة تتولاها هيئة اجتماعية على سلوك أعضائها، حيث يلجأ القانون إلى العقوبات، بينما تهدف الآليات الأخرى إلى استعادة الانسجام الاجتماعي إذا كُسِر». انظر:
R. SACCO, Anthropologie juridique. Apport à une macro-histoire du droit, Paris, Dalloz, 2008, p. 9.
بيد أن هذا التعريف لا يتسع للعلاقة القائمة بين فرديْن، ولا للأمر الذي يستنفد آثاره حال تطبيقه. فهل يجب أن نعتبر أن فعلًا فرديًّا للإدارة لا يتضمن قاعدة قانونية؟ أضف إلى ذلك أن التمييز بين القانون والقانونية من جهة، وبين العقوبة والآليات الأخرى من جهة أخرى، يُثير أسئلة لا حصر لها ولا يسمح المقام هنا بدراستها بعمق. وعلى كلّ، فإنّ سوكو يُحيل بشكل خاص على:
C. EBERHARD et G. VERNICOS (éds.), La Quête anthropologique du droit. Autour de la démarche d’Étienne Le Roy, Paris, Karthala, 2006.
[45] L. ASSIER-ANDRIEU, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, p. 44-45.
[46] السابق، ص45-47. وانظر:
É. DURKHEIM, De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2e éd., 1991, p. 108-109.
[47] H.L.A. HART, Le concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 14; L. ASSIER-ANDRIEU, op. cit., p. 44-45.
[48] أما نوربرت رولاند، فيرى من جهته أنه «إذا أمكن للدولة والقانون أن يُشكّلا زوجًا، فلا يمكن فصلهما». ووفقًا له، فإن الدولة تنتج عن اختيار المجتمعات لـ«توسيع مجال القانون وصياغته في معايير، سواء كانت مكتوبة أو غيرها (...)». انظر:
N. ROULAND, L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990, p. 48.
ومن هنا فإن الدولة ستكون تعبيرًا عن المكانة الأوسع الممنوحة للقانون في المجتمع. ومع ذلك، يظل معيار التحوّل من مجتمع بلا دولة إلى مجتمع ذي دولة غامضًا، وكذلك الفرق بين المعيار والقانون.
[49] السابق، ص68.
[50] أضف إلى ذلك أن هذه النكهة الإضافية محددة: «أولاً: ما هو قانوني تحديدًا هو المعيار الذي يجب أن يسود من بين بقيّة المدوّنات المعياريّة الأخرى. وثانيًا: تستخلص الوظيفة القانونيّة من الخلافات أو الاضطرابات التي تستدعي تدخّلها، «طابعًا رسميًّا» ينحلّ بموجبه الخلاف». انظر:
L. ASSIERANDRIEU, présentation de K. N. LLEWELLYN et E. ADAMSON HOEBEL, La Voie Cheyenne. Conflit et jurisprudence dans la science primitive du droit, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 1999, p. XI.
[51] R. JACOB, « Le droit, l’anthropologue et le microscope », op. cit., p. 44.
[52] L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes. Essai de microscopie du droit, Bruxelles-Paris, Bruylant LGDJ, 2001, 2e éd., 2012.
[53] R. SACCO, op. cit., p. 8.
[54] وعلاوة على ذلك، فإن مسألة التعايش بين العديد من «الأنظمة القانونية» هي في أساس النظرية المجهرية للقانون. علمًا بأن لوسيان فرانسوا هو من ترجم إلى الفرنسية بمعية بيار غوطو Pierre GOTHOT كتاب "النظام القانوني" Ordinamento giuridico لسانتي رومانو (Santi Romano)، على أساس ما يُسمّى نظريّة «تعدّد الأنظمة القانونيّة». انظر:
S. ROMANO, L’Ordre juridique, Paris, Dalloz, 2002.
وفي مستهلّ كتابه "رأس العواصف" Le Cap des Tempêtes، أدلى لوسيان فرنسوا بالملاحظة التالية: «نقرأ بأقلام فقهاء قانون أو علماء اجتماع أنه يُوجد -داخل الطوائف الدينية والمؤسّسات والنقابات والأحزاب والحركات الثورية والجمعيات السرية والعصابات ودوائر الأعمال وحتى في دوائر «الإجرام»- عدد كبير من «القواعد الاجتماعية، إن لم يكن القانونية»، و«القواعد ما تحت قانونية»، و«قواعد شبيهة بقواعد القانون». بيد أنّ مثل هذه التعبيرات تتحدّث مرتيْن عن مفهوم القانون، إذ هي تُؤكّد اقتراب ظواهر معيّنة من القانون، ولكنّها تُشير ضمنًا إلى أنّها لا تُمثّل جزءًا منه. لذا، فهي هنا تتضمّن بدورها تلميحات غامضة إلى وجود حدٍّ مفترض بين القانون وما هو ليس كذلك، وهو حدّ يُمكننا بعده العثور على بعض القواعد، في حين أن القواعد التي تضعها الدولة والقواعد المعيارية (لأن عبارة «القانون المعياري» تظل شائعة الاستخدام) تكون ضمن القانون». انظر:
L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 8.
ولئن كان لوسيان فرانسوا يبحث عن أدوات صارمة قادرة على الاستجابة لخصوصية كلّ واحدة من هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني تحديد ما هو موجود وما هو غير موجود، بل على العكس، الانطلاق مما هو موجود وإدراك الطريقة التي تحدث بها هذه الظواهر معًا. وفي هذا الصدد، يمكن أن تكون لأدوات الفقيه البلجيكي قيمة خاصة في تفكّر مسألة التعددية القانونية، وهي المسألة التي حظيت بتناول واسع في مجال الأنثروبولوجيا القانونية. فعلاوة عن أعمال رودولفو ساكو، يُمكننا الإشارة إلى:
G. GURVITCH, L’Expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Paris, Pédone, 1935; J. GILISSEN (dir.), Le Pluralisme juridique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1972; J.-G. BELLEY, Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit, Thèse, Paris II, 1977; J. GRIFFITHS, « Anthropology of Law in the Netherlands in the 1970 », Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechtssociologen, Rechtsantropologen en Rechtspsychologen, 1983, p. 132; M. CHIBA (éd.), Asian Indegenous Law in Interaction with received Law, Londres, New York, KPI Publishers, 1986; F. VON BENDA-BECKMANN et F. STRIJBOSCH (éds.), Anthropology of Law in the Netherlands, Dordrecht, Foris, 1986; R. MACDONALD, « Normativité, pluralisme et sociétés démocratiques avancées », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2002, p. 133; R. MOTTA, « “Maîtres chez eux”. Sovranità domestica e diritti ancestrali delle prime nazioni in Nuova Francia e Canada », Materiali per una storia della cultura giuridica in Italia, 2001, n°1, p. 211; N. ROULAND, S. PIERRÉ-CAPS et J. POUMARÈDE, Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996; A. LAJOIE, R.A. MACDONALD, R. JANDA et G. ROCHER (éds.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination, effectivité, Montréal/Bruxelles, éd. Thémis, Bruylant, 1998; A. GAGNON et F. ROCHER (éds.), The Conditions of Diversity in Multinational Democracies, Montréal, Canada IRPP – Mc Gill University Press, 2003.
وانظر أيضًا الدوريات التالية:
Journal of Legal Pluralism; Law and Anthropology; Newsletters of the Commission on Folk-Law and Legal Pluralism.
[55]* jurème: لفظ فرنسي استحدثه لوسيان فرانسوا، وهو منحوت من مقطعيْن (juri) بمعنى قانون أو حكم، و لاحقة التصغير (ème). والمعنى هو قانون مصغّر، وقد اخترنا صيغة التصغير للفظ قانون (وهو لفظ دخيل) باعتماد صيغة أفعولة المسندة للمذكّر (أفعول)، وقد يشفع لنا ما يقوله أحد كبار اللغويّين العرب وهو أبو البقاء الكفوي، من أن الأفعولة «إنما تُطلق على مُحقّرات الأمور وغرائبها». انظر:
الكَفَوِي (أبو البقاء، أيّوب بن موسى الحسيني)، كتاب الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمّد المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998م)، ص1061. (المترجم)
[56] L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 42.
[57] السابق، ص53.
[58] السابق، ص53-54.
[59] «ولذلك، فإنّ الأقنون غالبًا ما يكون مجرّد رغبة مصحوبة بآلية ضغط خامدة وخاملة مؤقتًا، أي إن الضغط لا يكون إلا افتراضيًّا فحسب. ولكن حتى عندما لا تكون آلية الضغط بصدد الاشتغال، فإن صاحب الرغبة يجعلها حاضرة من خلال إظهار نيّته
في استخدام الإكراه في صورة تُعرّض رغبته إلى مقاومة. وسنُطلق على هذا الإظهار اسم «الإلزام»، وهو ضروري للأقنون» (المصدر نفسه، ص59).
[60] السابق.
[61] السابق، ص251.
[62] السابق، ص129 وما بعدها.
[63] *Archème= لفظ فرنسي استحدثه لوسيان فرانسوا، وهو منحوت من مقطعينْ (archi) بمعنى سلطة أو حكم، ولاحقة التصغير (ème)، والمعنى هو حُكم مصغَّر أو سلطة مصغَّرة، وقد اخترنا لفظًا عربيًّا مهجورًا على وزن أفعولة، رأينا أنه يُؤدِّي معنى التصغير للفظ حُكم وحكومة معًا، وهو: «أُحْكُومَة»، والنسبة «أُحْكومي».
وتأصيلًا لهذا اللفظ المستحدث في لغتنا، نُشير إلى ما جاء في لسان العرب: «حَكَّمْنا فُلَانًا فِيمَا بَيْنَنَا أَي أَجَزْنا حُكْمَهُ بَيْنَنَا. وحَكَّمَهُ فِي الأَمر فاحْتَكَمَ: جَازَ فِيهِ حُكْمُه... وَالِاسْمُ الأُحْكُومَةُ والحُكُومَةُ». انظر:
ابن منظور (أبو الفضل، جمال الدين، محمّد بن مكرم)، لسان العرب، مادة حكم، (بيروت: دار صادر، 1993م، ط3، ج12)، ص140.
وحول استخدام صيغة «أفعولة» في التصغير والتحقير في لفظ (أحكومة)، راجع ما سبق أن قلناه بشأن اشتقاق لفظ (أقنون) من لفظ (قانون)، والنسبة إليه «أُقْنوني». (المترجم)
[64] السابق، ص232.
[65] السابق، ص195-199.
[66] السابق، ص207-212؛ وحول التماثل العقدي للمجتمعات «البدائية»، انظر بالخصوص: السابق، ص211-212.
[67] السابق، ص199-202.
[68] السابق، ص200.
[69] السابق، ص91.
[70] السابق، ص91-92.
[71] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 34.
[72] السابق، ص35.
[73] السابق، ص38.
[74] السابق، ص41.
[75] *اخترنا لفظ تلقين مقابل اللفظ الفرنسي (initiation) واستبعدنا ألفاظًا أخرى جرى العرف بأنها تُقابل اللفظ الفرنسي، مثل التأهيل (المستخدم خاصة في تعليم المهن)، والتكريس (المستخدم في ترسيم الكهنة)، والمُسارّة (بمعنى تلقين الأسرار)، والتنشئة (بمعنى التربية)، والعبور (بمعنى الانتقال من وضعية اجتماعية إلى أخرى)، وذلك لأن جميعها تقريبًا لا تتضمّن أي معنى لعنف ممارس على الملقَّن، والحال أنه المعنى الذي أراد بيار كلاستر إبرازه بوصفه أداة غرس الأعراف في نفوس الشباب من خلال تعريضهم إلى عنف جسدي يرقى في كثير من الأحيان إلى درجة التعذيب، بما يجعل الأعراف محفورة على أجسادهم وكأنها قوانين مكتوبة، ثم لأن التلقين جامع تقريبًا لكلّ معاني بقية المفردات (التعليم، التكريس، تلقين الأسرار، التربية، العبور من المراهقة إلى البلوغ). (المترجم)
[76] L. FRANÇOIS, Le Cap des Tempêtes…, op. cit., p. 66.
[77] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 156-157.
[78] السابق، ص158.
[79] السابق، ص159.
[80] السابق.
[81] *لا يُمكن لشاب أن يُعَدَّ في عداد الرجال ما لم تُثقب شفته، وتُثبَّت فيها حَلْقَة من عظم أو قطعة خشب دليلاً على اجتيازه محنة التلقين ودخوله عالم الرجال الصيّادين. (المترجم)
[82] P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 173.
[83] السابق، ص 152-153.
[84] * حلقة الشفة: حلقة من المعدن أو قطعة من العظم تُوضع في ثقب تحت شفة الفتى عند بعض القبائل الهندية في غابات الأمازون، وبعض الشعوب الأخرى في مناطق عديدة من العالم، دلالة على تلقيه طقس التلقين. (المترجم)
[85] السابق، ص129.
[86] السابق، ص140.
[87] السابق، ص176.
[88] بمعنى الأقانين الصادرة عن باثّ واحد (أو أكثر) نحو متقبّل واحد (أو أكثر).
[89] بمعنى الأقانين المنتَجة ضمن دائرة الإلزام المتبادل.
[90] بمعنى الأقانين المنتَجة ضمن دائرة الإلزام المتبادل.
[91] بمعنى أن الأقانين الصادرة عن باثّ واحد (أو أكثر) نحو متقبّل واحد (أو أكثر).
[92] السابق، ص154.
[93] السابق، ص155-156.
[94] P. CLASTRES, « Entretien avec L’Anti-Mythes », op. cit., p. 37.
[95] السابق، ص 38-39.
[96] P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, Paris, Plon, 1988, p. 158.
[97] P. CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, op. cit., p. 41- 42.
[98] وقد كُرِّس هذا المفهوم في نصوص ذات أهمية قصوى في الأنظمة القانونية الغربية المعاصرة. فالمادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م تنص على ما يلي: «تتمثّل الحرية في القدرة على فعل كل ما لا يضر بالآخرين، ومن ثَمَّ، فإن ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا حدود لها إلا تلك التي تضمن لأفراد المجتمع الآخرين التمتّع بهذه الحقوق نفسها. ولا يمكن تحديد هذه الحدود إلا بموجب القانون». وبالمثل، ينصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1948م، في مادّته 29 (2) على ما يلي: «لا يُخضَع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلا للقيود التي يُقرِّرها القانون مستهدفًا منها -حصرًا- ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي» .
[99] CLASTRES, Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, op. cit., p. 40.
[100] P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 231.
[101] السابق.
[102] نُشدِّد هنا على عدم توافق هذه الوحدة مع التصور الذي يمتلكه الهنود حول أنفسهم: بشر وآلهة في آنٍ. ويتطلّب هذا الوجود المزدوج وساطة الجماعة، وهو ما يضمن وحدتها في الوقت نفسه. (انظر أعلاه).
[103] السابق، ص158.
[104] P. CLASTRES, préface à M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, op. cit., p. 17.
[105] السابق.
[106] M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, op. cit., p. 177.
[107] السابق، ص178.
[108] R. FIRTH, « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, II », Folklore, 1926, n° 3, p. 262.
[109] السابق، ص258.
[110] السابق، ص249.
[111] السابق، ص249.
[112] السابق.
[113] R. FIRTH, « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, I », Folklore, 1926, n° 2, p. 138.
[114] السابق، ص140.
[115] السابق، ص 141.
[116] السابق.
[117] P. CLASTRES, La Société contre l’État, op. cit., p. 109.
[118] السابق.
[119] السابق، ص88.
[120] بالمعنى الذي يكتسيه هذا المفهوم في سياق الخلاف حول الكليات الإنسانية، أي بقدر معارضته للاسمانيّة.
[121] P. CLASTRES, Le Grand parler…, op. cit., p. 123.
[122] *لُعْبَة تُحْدِث خشخشة عِنْد هَزِّها يُلْهَى بِهَا الرَّضِيع، وهي هنا آلة موسيقيّة تُستخدم في ضبط إيقاع الرقص. (المترجم)
[123] السابق، ص135.
[124] P. CLASTRES, Chronique des Indiens Guyaki, op. cit., p. 83.
المراجع
-
Assier-Andrieu (Louis), Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, p. 44-45.
-
Assier-Andrieu (Louis), présentation de Llewellyn (Karl) & Hoebel (Edward Adamson), La Voie Cheyenne. Conflit et jurisprudence dans la science primitive du droit, Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 1999.
-
Belley (Jean-Guy), Conflit social et pluralisme juridique en sociologie du droit, Thèse, Paris II, 1977.
-
Chiba (Masaji) (éd.), Asian Indegenous Law in Interaction with received Law, Londres, New York, KPI Publishers, 1986.
-
Clastres (Pierre), « Entretien avec L’Anti-Mythes », in Pierre Clastres, M. Abensour & A. Kupiec (dir.), Paris, Sens & Tonka, 2011.
-
Clastres (Pierre), « Liberté, malencontre, innommable », postface à É. DE LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, Paris, Payot, 1978.
-
Clastres (Pierre), Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2013.
-
Clastres (Pierre), Chronique des Indiens Guyaki, Paris, Plon, 1988.
-
Clastres (Pierre), La Société contre l’État, Paris, Les éditions de Minuit, 1974.
-
Clastres (Pierre), Le Grand parler. Mythes et chants sacrés des Indiens Guarani, Paris, Seuil, 1974.
-
Clastres (Pierre), préface à M. SAHLINS, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976.
-
Demoule (Jean-Paul), « Naissance des inégalités et prémisses de l’État », in La Révolution néolithique dans le monde, J.-P. Demoule (dir.), Paris, CNRS éditions, 2009.
-
Didi-Huberman (Georges), Atlas ou le gai savoir inquiet, Paris, Les éditions de Minuit, 2011.
-
Durkheim (Émile), De la division du travail social, Paris, Quadrige/PUF, 2e éd., 1991.
-
Durkheim (Émile), Le Suicide, Paris, Librairie Félix Alcan, 1930.
-
Eberhard (Christoph) & Vernicos (Geneviève) (éds.), La Quête anthropologique du droit. Autour de la démarche d’Étienne Le Roy, Paris, Karthala, 2006.
-
Firth (Raymond), « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, II », Folklore, n° 3, 1926.
-
Firth (Raymond), « Proverbs in the Native Life, with Special Reference to Those of the Maori, I », Folklore, n° 2, 1926.
-
François (Lucien), Le Cap des Tempêtes. Essai de microscopie du droit, Bruxelles-Paris, Bruylant LGDJ, 2001, 2e éd., 2012.
-
Gagnon (Alain-G.) & Rocher (François) (éds.), The Conditions of Diversity in Multinational Democracies, Montréal, Canada IRPP – Mc Gill University Press, 2003.
-
Gilissen (John) (dir.), Le Pluralisme juridique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1972.
-
Godelier (Maurice), « Tribus et États. Quelques hypothèses », in La Révolution néolithique dans le monde, op. cit., p. 428.
-
Griffiths (John), « Anthropology of Law in the Netherlands in the 1970 », Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechtssociologen, Rechtsantropologen en Rechtspsychologen, 1983.
-
Gurvitch (Georges), L’Expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit, Paris, Pédone, 1935.
-
Hart (Herbert Lionel Adolphus), Le concept de droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976.
-
Jacob (Robert), « Le droit, l’anthropologue et le microscope », in Le Droit sans la justice. Actes de la rencontre du 8 novembre 2002 autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, E. Delruelle & G. Brausch (dir.), Bruxelles, Paris, Bruylant, LGDJ, 2002.
-
Kelsen (Hans), Théorie pure du droit, trad. fr. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2e éd., 1962.
-
Lapierre (Jean- William), Vivre sans État? Essai sur le pouvoir politique et l’innovation sociale, Paris, Seuil, 1977.
-
Lefort (Claude), « L’œuvre de Clastres », in L’esprit des lois sauvages, M. Abensour (dir.), Paris, Seuil, 1987.
-
MacDonald (Roderick) , « Normativité, pluralisme et sociétés démocratiques avancées », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 2002.
-
Motta (Riccardo), « “Maîtres chez eux”. Sovranità domestica e diritti ancestrali delle prime nazioni in Nuova Francia e Canada », Materiali per una storia della cultura giuridica in Italia, n°1, 2001.
-
Rocher (Guy) & MacDonald (Roderick) & Lajoie (Andrée) & Janda (Richard) (éds.), Théories et émergence du droit: pluralisme, surdétermination, effectivité, Montréal/Bruxelles, éd. Thémis, Bruylant, 1998.
-
Romano (Santi), L’Ordre juridique, Paris, Dalloz, 2002.
-
Rouland (Norbert) & Pierre-Caps (Stéphane) & Poumarede (Jacques), Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996.
-
Rouland (Norbert), L’Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1990.
-
Sacco (Rodolfo), Anthropologie juridique. Apport à une macro-histoire du droit, Paris, Dalloz, 2008.
-
Sahlins (Marshal), Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976.
-
Von Benda-Beckmann (Keebet) & Strijbosch (Fons) (éds.), Anthropology of Law in the Netherlands, Dordrecht, Foris, 1986.
- ابن منظور (أبو الفضل، جمال الدين، محمّد بن مكرم)، لسان العرب، ط 3، دار صادر، بيروت، 1993م، 15 جزءًا.
- الحاج سالم (محمّد)، «مجتمع بلا دولة أم مجتمع ضدّ الدولة؟ حوار مع بيار كلاستر»، في السياسة والدين والمجتمع: حوارات إناسيّة، الوسيطي للنّشر، تونس، 2014م.
- الكَفَوِي (أبو البقاء، أيّوب بن موسى الحسيني)، كتاب الكلّيات، تحقيق: عدنان درويش ومحمّد المصري، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1998م.