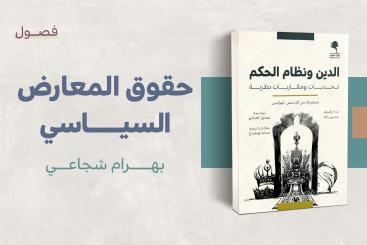المسؤول المتدين في الدولة العلمانية

انتهى الصراع في أوروبا بين رجال الدين ورجال السياسة حول السلطة، وبين رجال الدين والعلماء على الحقيقة إلى فصل السلطات وتوزيع الاختصاصات. ولم يقف الفصل والتوزيع عند حدود رسم مجالات النفوذ والعمل لكل طرفٍ في إطار ما يسميه طه عبد الرحمن – في كتابه "روح الدين" – بـ"العلمنة الخاصة"، ويسميه عبد الوهاب المسيري بـ"العلمانية الجزئية"، أي فصل الدين عن السلطة؛ بل تحوَّل إلى فصل الدين عن مختلف الأنشطة داخل المجتمع، رغبةً في تنقية مجالات الحياة من سابق آثار الفكر الديني. ونتج عن هذا ما سمَّاه طه عبد الرحمن – في كتابه "روح الدين" أيضًا – بـ"العلمنة العامة"، وما يسميه عبد الوهاب المسيري بـ"العلمانية الشاملة".
أما العمل السياسي، فهو "تجليات إرادة الإنسان في نطاق النهوض بشؤون الحياة قيامًا بواجب تدبيرها الذي هو الغاية من اجتماعه".
ويذهب كثيرٌ من العلمانيين إلى أن هذا الفصل هو حدودٌ حقيقية وثابتة، لا تتغيَّر ولا تتحوَّل بتحوُّل ظروف الحياة الاجتماعية وتغيُّرها، مع أن الواقع يكذب ذلك؛ ذلك أنها ليست حدودًا ثابتة بقدر ما هي إجراءات صناعية واصطلاحية ومنهجية لتدبير شؤون الحياة؛ إذ يصحُّ أن يتداخل المجالان، مجال الدين ومجال السياسة، وتبادل العناصر والمواقع. ولولا ذلك ما كانت عندنا في واقعنا اليوم: "العلمانية الأمريكية"، و"العلمانية الإنجليزية"، و"العلمانية الفرنسية".
وينطلق طه عبد الرحمن في معالجة حدود العمل الديني والعمل السياسي من تعريف العمل الديني بأنه "تجليات إرادة الإنسان في نطاق الامتثال لإرادة الله، قيامًا بواجب عبادته الذي هو الغاية من خلقه". وأما العمل السياسي، فهو "تجليات إرادة الإنسان في نطاق النهوض بشؤون الحياة قيامًا بواجب تدبيرها الذي هو الغاية من اجتماعه"(1). لذلك يرى أن رسم حدودٍ بين المجال الديني والمجال السياسي هو تضييقٌ لنطاق الدين ولنطاق السياسة معًا.
ويكون تضييق نطاق الدين بحصره في الدائرة الخاصَّة، وانحصاره في الإيمان الداخلي، وبالقول بحيادية الدين. ويكون تضييق نطاق السياسة بادعاء حصرها في الدائرة العامَّة، وتدخُّل الدولة العلمانية في معتقدات المواطنين، وتأثير معتقدات المسؤولين السياسيين في الدولة العلمانية. فحَصْر الدين في الدائرة الخاصَّة يعني (خوصصته)، أي لزومه لخاصَّة الروح؛ فيكون تعريفه هو: "جملة عبادات تصل المؤمن بربِّه في سرِّه". ويؤسِّس الفكر العلماني لهذا التعريف بناءً على أن الدين هو مجرَّد عمل طقوسيٍّ لا يؤثر في الحياة العامَّة. وهذا اختزالٌ للدين، وتضييقٌ لمجال نفوذ الفاعل الديني، والذي يعتبره ميرسيا الياد "إنسانًا كليًّا". فالممارسة الدينية – وَفْقَ هذا المنظور – تنفتح على الحياة بكل مستوياتها وأنشطتها وفعاليتها، والفاعل الديني في هذه الحالة – باصطلاح طه عبد الرحمن – يصبح "إنسانًا كلانيًّا غير جزءانيٍّ"، وتصبح عبادات الفاعل الديني مؤثرةً في حياته الفردية والجماعية؛ إذ من خلال الاستغراق في العبادة يُقبل بكليته على مختلف أعماله، وهو يرتاد مساجدَ وأمكنةً للعبادة عامَّة، ويقوم بطقوسٍ جماعية ومشتركة وغير مختصَّة، ويحضر الأعياد والمناسبات الدينية التي تشمل المجتمع كلَّه، بل تطالعنا في الشوارع والطرقات أسماء رجال دين، وعلاماتٌ كثيرة ذات إيحاءاتٍ دينية، كما نرى في الملاعب الرياضية اليوم.
إذن، فالاشتغال الديني لا يكون في الروحانيات فحسب، خارج منطق العبادات والاكتفاء بالتأملات؛ بل في إطار روحانية حيَّة يعيشها الفاعل الديني بوجدانه وسلوكه، وتنقله من النطاق الخاص للدين إلى النطاق العام للثقافة؛ إذ الروحانية تغشى كلَّ المجالات والأنشطة، ومنطلقها "الإيمان الديني". وقد ظهرت مقارباتٌ تأملية جديدة في الفكر الأوروبي، تحاول التصدي للتمدُّد الديني في الحياة العامَّة، هي أقرب إلى الخيال والتوهمات النفسية، بنظر طه عبد الرحمن، تتكلَّم عن: "روحانية بلا دين"، و"روحانية علمانية"، و"روحانية من غير الله"، و"الديني بعد الدين"، و"الإنسان الإله"… فاختزال الدين – إذن – في ما هو روحاني تضييقٌ لنطاقه وللوجود الإنساني. وقد اعتبر شلايرماخر أن من يقيم فرقًا بين الأخلاق والدين، إنما هو خادع لنفسه.
أما القول بحيادية الدين، فينطلق من أن الصلة بالله لا تتضمَّن الصلة بالإنسان، وأن المواطنين متساوون، مهما كانت اختياراتهم العقدية والروحية، وأن المساواة هي أساسُ المواطنة، مع أن الدين ما زالت له سلطةٌ في المجتمع الأوروبي، وما زال قادرًا على التدخُّل في السلطة بكل مستوياتها، بل نلحظ اليوم رجوعًا مدهشا إلى الدين؛ كأنها استعادة لخطاب الفيلسوف الألماني شلايرماخر في دفاعه عن التجربة الدينية، في كتابه "عن الدين: حوار مع محتقريه من المثقفين"، الذي ألَّفه سنة 1799م. وهو من الكتب الكلاسيكية القوية في اللاهوت، التي ترمي إلى إعادة هيبة الدين وكرامته، بوصفه نظامًا فكريًّا وأخلاقيًّا ليس محصورًا بفئة خاصَّة من الناس، وإنما هو لكل المجتمع، وأوله طبقة المتعلِّمين والنُّخب الثقافية والسياسية. وهذا ما يجسده أيضًا كتاب "قوة الدين في المجال العام"، وهو خلاصة نقاش متعمِّق حول الدين في السياسات العمومية اليوم، سنة 2009، بين الفيلسوف الألماني وعالم الاجتماع يورغن هابرماس، والفيلسوف الكندي وأستاذ الفلسفة السياسية تشالس تيلر. والكتاب تعميق لأفكار هابرماس التي وردت في كتبه عن الدين؛ مثل: كتاب "مستقبل الطبيعة البشرية"، وكتاب "الغرب المنقسم"، وكتاب "بين النزعة الطبيعية والدين.. مقالات فلسفية". كما عمَّق تيلر أفكاره التي وردت في كتبه؛ مثل: كتاب "تنويعات الدين اليوم.. إعادة نظر في وليم جيمس"، وكتاب "المتخيلات الاجتماعية الحديثة"، وكتاب "عصر العلمانية".
تحييد الدين سلوك سياسيٌّ تنافسيٌّ من العلمانيين، لنزع أسباب الفاعلية والإنتاجية من الفاعل الديني داخل المحيط الاجتماعي، وعزله عن معترك الحياة.
ونرى اليوم رجوعًا إلى الدين بدوافع برغماتية ووظيفية لدفع المخاطر التي تهدِّد الإنسان الغربي في البيئة والصناعة والصحَّة والأمن…إلخ. إذن، فتحييد الدين إنما هو سلوك سياسيٌّ تنافسيٌّ من العلمانيين، لنزع أسباب الفاعلية والإنتاجية من الفاعل الديني داخل المحيط الاجتماعي، وعزله عن معترك الحياة. فهو ليس "تحييدًا"، ولكنه بالأحرى – بتعبير طه عبد الرحمن – "تعقيم" للفاعل الديني، وتعطيلٌ لكل عناصر الخصوبة والإنتاجية فيه، وهي سِرُّ قوته وفاعليته. وعليه، يكون الفاعل الديني أَوْلَى بالوجود في الدائرة العامَّة، هذا الوجود الذي يعمل الفاعل العلماني على منعه منه، وتحصينه بأسوار مقدَّسة من النزعات/الاعتقادات العلمانية ذات الأهداف السياسية.
وأما تضييق نطاق العمل السياسي بحصره في الدائرة العامة، بدعوى أن العمل السياسي لا علاقة له بعقائد المواطنين، ولا يتدخَّل في حياتهم الروحية، حفظًا لحرية الاعتقاد واستقلال الأخلاق، فهذا ما يكذبه واقع الممارسة السياسية في الدولة العلمانية الحديثة؛ فالدولة العلمانية ذات خيار عقديٍّ، سواء كان ظاهرًا أو باطنًا، وسواء كان معتقدًا علمانيًّا أو قناعة سياسية. فـ"علمانية" الدولة هي اختيار قرار بقطع كل منازعة بشأنه. كما أن صفة "العلمانية"، وصفة "الدينية"، وصفة "اللادينية" – هي اختياراتٌ وقناعاتٌ بمثابة عقائد، وإيمان، ليس بالضرورة "إيمانًا بالله"، ولكنه اعتقاد بتجاوز ما هو غير مرئيٍّ، سواء كانت "علمانية حيادية"، وهي التي لا تعادي الدين ولا تواليه، أو "علمانية كفاحية" – بتعبير طه عبد الرحمن – وهي التي تعادي الدين بنسبة محدودة، وتُعرف بـ"النزعة المضادة للكهانة"، أو التي تعادي الدين بشدَّة وتجاهر بذلك، وهي ما يُسمَّى بـ"النزعة العلمانوية". فهذا المعتقد العلماني يضيِّق فسحة الوجود على المواطن، ويكرهه على معتقدٍ يعطِّل بصيرته، ويشلُّ بصره، ويُميت روحه، وينزع عنه كلَّ محفزات الفعل الإيجابي المنتج.
ولا تقف الدولة العلمانية عند هذا الحدِّ في اقتحام الحياة الشخصية للمواطنين، بل تتدخَّل في معتقداتهم، في إطار سحب الحياة الخاصَّة للمواطنين إلى المجال العام؛ مثل ما قامت به الدولة الفرنسية عند منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والأماكن العامَّة، وهي بذلك تخالف مبدأ "اختيار الاتجاه الوجودي" للمواطنين، بالاعتداء على حرية الاعتقاد للمواطنين، كما تخالف "مبدأ اختيار المنهج التدبيري"؛ إذ تلزم المواطنين بتدبير معتقداتهم بشكلٍ لا يرتضونه لأنفسهم، وتحرمهم من إضفاء المعنى على وجودهم وتحقيق الغاية من خلقهم، بما يعتقدون. وعليه، تمارس الدولة العلمانية على مواطنيها عنفًا روحيًّا بالتدخل في معتقداتهم الدينية، وجودًا وتدبيرًا. مما يضيق وجودهم الإنساني، فيفقدون الغاية والمعنى والمحفز الروحي للعمل والإنتاج والفاعلية، مما قد يدفعهم إلى سلوكاتٍ سلبية، قد تتطور إلى انتقاماتٍ من الدولة ومن مؤسساتها ومن رموزها، وربما من المجتمع ومن أنفسهم. ويزيد من هذا التضييق الوجودي تأثير معتقدات المسؤولين في الدولة العلمانية؛ إذ يحمل المسؤول في الدولة معتقداتٍ وقناعاتٍ – في قلبه – في أثناء أداء مهامه التدبيرية ومسؤوليته السياسية، مما يخلِّف آثارًا متفاوتةً في ممارسته التدبيرية والسياسية العامَّة، بوعي أو من دونه.
ويكون تأثير معتقد المسؤول في ممارسته السياسية العامَّة على شكلين: فإمَّا أن تكون اعتقاداته من جنس اعتقادات الدولة العلمانية، وإمَّا تكون مخالفةً لها. فإن كانت من جنسها، كانت إمَّا أقوى وإمَّا أضعف. وإن كانت أقوى من عقيدة الدولة العلمانية ومن جنسها، تزداد الدولة تسلطًا وطغيانًا حاملةً المواطنين على الخضوع لعقيدتها العلمانية. وأما إن كانت عقيدة المسؤول التدبيري والسياسي أضعفَ من عقيدة الدولة العلمانية، فإن ممارساته لا تزيد الوصف العلماني للدولة إلَّا رسوخًا، ويجتهد هو باستمرار في تمثيل عقيدة الدولة والتعبير عنها، عبر عملياتٍ تحويلية وتجميلية في شخصيته شكلًا أو مضمونًا.
وأما إن كانت عقيدة المسؤول السياسي العمومي ليست من جنس عقيدة الدولة العلمانية، من حيث اختيار الاتجاه الوجودي، فإن هذا المسؤول السياسي سيجد صعوبةً بالغةً في التأثير في الدولة، مما يحتاج "مقاومة روحية" لا تكفي فيها أشكال التدين السطحية، والتزود بالمواعظ الباردة؛ فالعلمانية على صعيد الدولة تمارس تغييبًا حقيقيًّا، يلتبس ويخفى على المسؤول السياسي المتدين، بل تستمدُّ أصولها وقيمها من الدين نفسه، كـ"العدل"، و"المساواة"، و"الحرية". لذلك يتوهم المسؤول المتدين أن لا فرق بين "التدين" و"العلمنة" إلَّا في الكمِّ والعرض، متوهمًا أنه حريصٌ على حفظ قيمة الإيمان، فيقع في ما يسميه طه عبد الرحمن بـ"العلمانية الغافلة"، فيظهر تيار واسع من المتدينين العلمانيين الغافلين، يأتون أفعالًا ظاهرها الدين وباطنها العلمنة، ظانين أن أفعالهم وتصرفاتهم لا تعلُّق لها بالدين.
فالمسؤول المتدين في الدولة العلمانية يحتاج إلى مقاومة نفسية مستمرة، وليس إلى حالاتٍ تدينية شكلية في الخطاب والمظهر؛ إذ من دون تحصيل مقتضيات المقاومة الروحية يضيق وجوده الإنساني. وما يفتأ يتعاطى هو بنفسه علمنةً في أعماله وتصرفاته، مع تزكية نفسه وتبرير سلوكه، ودفاع عن وجوده في منصبه، مدعيًا أنه تكليف غيبيٌّ، بتدبير إلهيٍّ، مغترًّا بحوله وبمن حوله، وهو يمكر بنفسه، وبحزبه، وبإخوانه، فيغرق في الرخص تلو الرخص، والشبه تلو الشبه، مضيقًا واسع وجوده، ظانًّا أنه يوسِّعه، حتى يصبح كائنًا علمانيًّا في ثوبٍ دينيٍّ، وتلك أشد العلمانيات وأقساها على النفس وعلى المجتمع.
الهوامش
(1) طه عبد الرحمن، "روح الدين – من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية"، المركز الثقافي العربي، بيروت – لبنان-، ط2، 2012م، ص203.