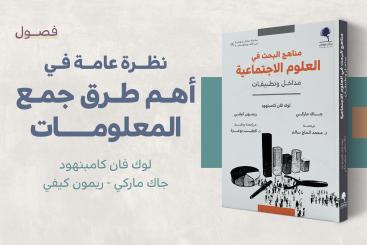ماذا لو تكلَّم أصول الفقه؟

لو استحال بشرًا وقُدِّر له أن يُعرِب بلسانٍ لقال: إنما أنا فن وطائفة من المقولات المنهجية قبل أن أكون جنسًا من العلوم. ولئن كان أصول الفقه كائنًا حيًّا وناميًا فلا يلزم في الترجمة له أو اختصار سيرته إحصاء ما كان من تَطوافه الجغرافي، أو ذكر ما وقع بين مصنفيه من تفاوت العبارات؛ إن كان ذلك مفضيًا بنا إلى تصنيف موسوعة لا مجرد سيرة، فإنما تُعْنى السيرة بالمعالم الكبرى.
ولقد يجدر بنا قبل الخوض في التاريخ أن نقف على «الغاية». ولما كان مدار سيرتي هذه على المذاهب السُّنية -وما كنت لأذهب إلى اعتداد مذهب الشيعة في الأصول والفروع قليل الغَناء أو حقيقًا بالإعراض- فسأستهل [هذه الورقة] برأي للعلامة [الشيعي] محمد تقي الفقيه الحاريصي[1] أورده في تمهيد كتابه «قواعد الفقه»[2] [وهو كتاب شرح فيه 64 قاعدة أصولية كبرى مع ذكر طرف من فروعها]. وخُلاصة رأيه أن تعرُّض العلماء المحققين لابتناء الأصول على الفروع [دون تفصيل] يورث الشك في كيفية ابتناء الأحكام، ويُفضي إلى شيوع التقليد. وبأثر من ذلك يصير تحصيل رتبة المجتهد متعذر النوال، وينشأ عقلٌ يجمع بين وصْفَي الاجتهاد والتقليد[3]. ويجزم الفقيه بأن غموض الصلة بين الأصول والاجتهاد في الفروع -وإن كان يسيرًا- يعقبه ولا بُدّ الانصراف عن العلوم الشرعية النظرية، والتماس العزاء في العكوف على الفروع أو الانصراف إلى الأدب ومماحكات اللغة، ثم يمضي إلى القول بأن ركون المرء إلى التقليد في استجلاء مباني الحكم شاهدٌ على نقصان ثقته في هذه المباني، يقول الفقيه:
«والمحقق من المدرسين قد يتعرض لهذه القواعد أثناء الدرس عند الحاجة إليها فيقول بِناءً على كذا يكون كذا… ولكن التعرض للبناء وإهمال تحقيق المبنى وكيفية الابتناء قد يترك الطالب النبيه عرضةً للشك أو للتقليد الأعمى، فيكون مجتهدًا مقلدًا من حيث لا يحتسب، وإذا لم يفهم المبنى والابتناء غمره اليأس واعتقد أن الاجتهاد بعيد المنال، وأصبح عدوًّا للاجتهاد والمجتهدين، وللتدريس والمدرسين، بل عدوًّا للكتب الدراسية، ثم لا يقف عند هذا الحد، بل قد يعلن الثورة على علم الأصول وعلم المعقول وعلى كل تحقيق وتدقيق.
إن إتقان هذه القواعد يحل المعقّدات العلمية، ويسهل الوصول إلى النتائج، ويجعل الاجتهاد قريب المسافة، لا سيما مع حسن العرض وبساطة البيان. وإن إهمال هذه القواعد هو الذي أوجب انقطاع كثير من الطلاب عن القافلة وانصرافهم إلى استقراء الأخبار والأقوال، أو انصرافهم عن الفقه والأصول إلى الأدب واللغة. وإن النظر في السلسلة التي تُبتنى عليها الأحكام، وإقامة البرهان على كل حلقة منها يضمن سلامة النتائج ويقلل النزاع، ويقرِّب المسافة بين المتخاصمين، ويكون صاحبها مجتهدًا معذورًا عند الله سبحانه؛ لأن خطأه يكون ناشئًا عن قصور لا عن تقصير، والقاصر عاجز، وعقاب العاجز قبيح عقلًا.
فطول النزاع والانتقال من مبنى إلى آخر، وتمسك كل منهما أو أحدهما بقول عالم من العلماء والمطالبة بنظائر المسألة دليل على العجز والضعف، وعلى أن أحد المتخاصمَيْن أو كلَيْهما لم يفرغ من مباني المسألة. ولو كان هؤلاء ممن أتقن مباني الصغريات والكبريات لكان لخلافهم حدّ، ولوقف النزاع عند أحد المبنيَيْن في المسألة»[4].
وإن شئت قل عن الأصول: إنه اختصاص يورث العقل دُربة على بيان ما يتخذه من المذاهب. أو هو نظرية المعرفة الشرعية، وجل اشتغاله عملي يتعلق بالاجتهاد الفقهي. على أننا سنقف على أن مسيرة هذا العلم، بالنظر إلى الزورتَيْن الطويلتَيْن لعلم الكلام -(وهو العلم الكلي المنتظم للتنظيرات العقدية المستمدة من الوحي والوجود) في القرنَيْن الرابع والخامس، ثم في القرنَيْن السابع والثامن- قد أحالت علم الأصول الذي تلقيناه إلى ما يدعوه الفارابي بالعلم الكلي (وهو العلم ذو الشواغل المنهجية، كالشأن في الميتافيزيقا وعلم الكلام نفسه). أو قل في وضوح وبساطة: صار علم الأصول نظرية للمعرفة.
إن الذخيرة الأصولية التي أُورثتموها جميعًا أثر عارض لخيارات اتخذها بشر أحياء وهم المصنفون. فقد حفَّزهم إلى التصنيف ما يقرؤون، ثم تشوُّفهم إلى التفاعل مع هذا المقروء والتفكير فيه علانية. وعلاوة على ذلك فإن لُبّ هذا الاختصاص وغاياته، وما يعرض له من التقاطع مع اختصاصات مجاورة، وما يعِد به من المنفعة والقيمة.. كل أولئك ينصهر فيثمر -في نظر هذا القارئ- طاقة (إيجابية) تجري في عروق التاريخ الإنساني، ولم تزل حية فيه. على أن السيرة المطروحة ثَمَّ تعكس مُكنة راويها، وما تبدو عليه من الوفاء أو خلافه موقوف على محصولك من القراءة وتكرارك له، وما قدّمت منه وما أخرت.
والآن يقص عليكم أصول الفقه خبره..
وُلدت فنًّا واحدًا في ختام القرن الثاني من الهجرة..
(أ)
شُغِل عيسى بن أبان (ت. 221هـ) ومحمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ) بالفن نفسه، وبالجواب عن المسائل الأساسية المتعلقة بحجية الأدلة من الإجماع والأقيسة، وما يدخلها من التعارض، وكذا بما رُكِّب في النصوص والأخبار من الظنية. وعلاوة على الأجزاء اليسيرة الباقية من تصانيف ابن أبان، فقد وثَّق الجصاص (ت. 370هـ) أقواله في الفصول. ولئن كان ابن أبان -ولا ريب- قاضيًا (للبصرة)، والشافعي فقيهًا على نحو ما، فلا يعني ذلك أنهما عاشا في عوالم منفصلة، فالحق أنهما خاضا في المسائل نفسها المتعلقة بأدلة الأحكام وعلة كونها أدلة[5].
عوَّل عبد العظيم الديب في مقدماته لـ«نهاية المطلب» على السيرة الجماعية ليدحض ابتناء التمييز بين الطريقتَيْن على تمسك العراقيين بأقوال الشافعي في المذهب القديم.
التصنيف نشاط يقع لكل قارئ باحث، وهو جزء لازم في البحث، وإن كان يعتريه الخروج عن جُدد الصواب. وقد انقسم الفقه الشافعي المبكر إلى طريقتَيْن في المذهب: طريقة الخراسانيين، وطريقة العراقيين، أو طائفتَيْن: إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب. فأما الشرقية/الخراسانية فاقترنت بالقفال المروزي (ت. 417هـ) المنسوب إلى مرو، وكذا كان شيوخه ومشايخهم من علماء مرو. وأما الغربية/العراقية ومركزها بغداد، فقد اقترنت باسم أبي حامد الإسفراييني (ت. 406هـ) (وهو من أصل شرقي لكنه ارتحل إلى بغداد في الحادية والعشرين من عمره). ويكفي لقب العراقيين باعثًا على الالتباس؛ إذ المعهود أنه علم على الحنفية، ورسالة الشافعي في اختلاف العراقيين إنما قُصد بها ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن (ت. 148هـ)، وأبو حنيفة (ت. 150هـ). وقد عوَّل عبد العظيم الديب (ت. 2010م) في مقدماته لـ«نهاية المطلب» على السيرة الجماعية (prosopography) ليدحض ابتناء التمييز بين الطريقتَيْن على تمسك العراقيين بأقوال الشافعي في المذهب القديم (ذاك الذي وضعه في العراق قبل أن يستوطن مصر) على حين أقرَّ الخراسانيون مذهبه «الجديد» الذي أنشأه بمصر[6].
صار من المألوف لدينا قسمة أصول الفقه إلى علمَيْن: أحدهما صنيعة الفقهاء، والآخر من وضع الفلاسفة أو المتكلمين، وهي قسمة تُعزى إلى ابن خلدون (ت. 808هـ)، وقد سار عنه كذلك تقسيم مذهب المالكية إلى ثلاث طرائق: تُنسب إحداها إلى شمال إفريقيا (القرويين)، والثانية إلى الأندلس (القرطبيين)، وأما الثالثة فمرجعها إلى العراقيين، وقد تبعتهم طريقة المصريين من بعدُ[7]، ومن الطريقة الأخيرة ظهرت في شروح المالكية المتأخرين طريقتان، عُرفت الأولى بطريقة المغاربة، والأخرى بطريقة المصاروة.
(ب)
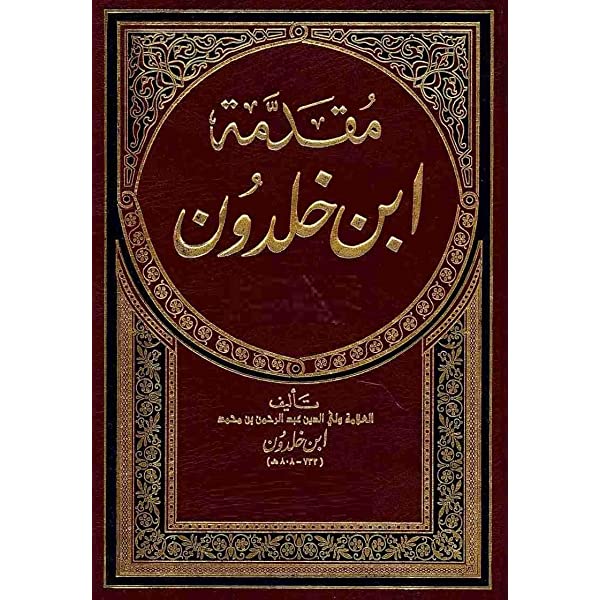
مقدمة ابن خلدون
لم يُرِد ابن خلدون [بقسمته هذه] أن أصول الفقه كان صناعتَيْن بحاجة إلى من يجمع بينهما (الجمع بين الطريقتَيْن) ليصيرا علمًا واحدًا، فإنما كانت غاية قوله التفهيم. ومن الحق أنه عرّض في الفصل السابع من المقدمة (حيث يحكي تاريخ الفقه) بالعراقيين أو الحنفية لقلة بضاعتهم في الحديث، لكنه ابتغى بذلك امتداحهم حيث اتخذوا من استعمال القياس وسيلة لتوسيع معاني ما حصّلوه من السنة وهو قليل، ومن سمته الإيجاز. وقد بدَّد في الفصل نفسه وهمًا شائعًا، وهو القول بأن تعويل مالك على عمل أهل المدينة احتجاجٌ بالإجماع. وإنما هو -كما يبيّن ابن خلدون- نمط خاص من العمل ببعض ضروب السنة، وهو السنة الحية [التي استمرت في الناس] دون الأخبار المقتطفة من حياة النبي ﷺ (وهو الشرف الذي لا يدعيه سوى أهل المدينة التي قضى بها النبي ﷺ العقد الأخير من عمره)[8]، ثم يأتي ابن خلدون على ذكر أصول الفقه في الفصل التاسع، فيقيم التمييز المعهود بين طريقتَيْن فيه.
وظاهر ذلك التفريق بين فنَّيْن: أحدهما مبناه على الحجج العقلية، وهي السمة المائزة للمتكلمين (وقد أسهب ابن خلدون في ضرب الأمثلة للمصنفين الذين اتبعوا هذه الطريقة، ومنهم المشاهير الأربعة مصنفو الكتب المعدودة أركانًا لهذا الفن: القاضي عبد الجبار (ت. 415هـ)، وأبو الحسين البصري (ت. 436هـ)، وإمام الحرمين الجويني (ت. 478هـ)، والغزالي (ت. 505هـ). وأما الآخر فيعوِّل على الفروع والطرائق العملية (ولم يضرب له ابن خلدون مثلًا سوى الدبوسي (ت. 430هـ)[9]، لا يرتاب المرء مع وقوفه على السيرة المفصلة للعلم في أن المراد بهذا التقسيم التفهيم، واصطناع السبيل لإحصاء الطرائق الفقهية والتصنيفية. وجملة القول أن أصول الفقه فن واحد، ومداره على سؤال السبيل التي يسلكها الفقيه أو الفقهاء في إنشاء الأحكام.
(ج)
لا جرم أن مصنفي الحنفية كانوا يبادرون إلى الفروع العملية كلما ذكروا أصلًا أو أوردوا قاعدة. ولربما كان التفريع على الأصل أو القاعدة في بعض الأمر بسطًا له؛ ذلك أن العقل يمتزج فيه ساعةَ الإنشاء الأصل وغيره من القضايا. أتبغي شاهدًا على ذلك؟ لقد نعلم أن المجتهد (أعني الفقيه المستنبط) قد تعرض له حالٌ تثقل عليه من تعارض الدليلَيْن وهما في القوة سواء، وربما أفضى ذلك إلى تساقطهما عنده. وقد سارع الشاشي (أعني نظام الدين المتوفى 344هـ) إلى إعمال ذلك الأصل، دون أن يتكلف فيه كبير تفكير، في عاميٍّ مضطر إلى الاختيار بين الوضوء والتيمم، ذلك أن معه إناءَيْن: أحدهما طاهر يجوز به الوضوء دون الآخر. ثم ينتقل من فوره إلى إيراد فروع مشابهة، ومنها ما لو كان للمرء ثوبان تجوز في أحدهما الصلاة دون الآخر (لتعلق النجاسة به)، ثم يمضي إلى أصول أخرى تتفرع عنها فروع مباينة[10].
***
بلغتُ أشدي في الخمسين بعد المئة الثانية من عمري، وحفزني إلى ذلك ما كان بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية من النزاعات الكلامية في حرية الإنسان وصلة العقل بالوحي وما إن كان يجب على الله تعالى شيء. واعلم أن أبا الحسين البصري قد رغب بنا عن خلط الأصول بالكلام (لا سيما دقيق الكلام، وما كان من النظرية المعرفية عويصًا وعن الأحكام الفقهية بمعزل)..
(أ)
ما يزال موضوع أصول الفقه أدلة الأحكام، وربما تكون الأدلة كلامًا (نزل به الوحي) وتبعث منزلته التاريخية على استجلاء طبيعته الفلسفية والتاريخية، وربما حسُن العكوف على اللغة وطرائق التفسير، غير أن مسألة «القطع»/«اليقين» قُدِّر لها أن تتبوَّأ موضع الصدارة: انتفاء القطع عن اللغة، والتباس العلاقة بين الإنسان والإله، وما رُكِّب من الظن في الإسناد الواصل بين الفقيه والنبي، الذي ما فتئ يطول. والحق أن أبا الحسين قد ذكر بطريق الاقتضاء أن الولع بالكلام وبالحدود والمفاهيم منه بخاصة، قد طغى على موضوع علم الأصول وأعاد صياغته. وهو يعلِّل لتصنيفه المعتمدَ باعتقاده أن سُهمته الأولى في الأصول، وهي شرحه لكتاب القاضي عبد الجبار، قد حملته على الإيغال في علم الكلام المجرد[11].
(ب)
فرَّق الزركشي (ت. 794هـ) من بعد ذلك بين نضج العلم وميلاده، فعنده أن كتب قاضي المعتزلة (عبد الجبار) وقاضي الأشاعرة (الباقلاني المتوفى 403هـ) كانت جمعًا وبناءً على ما كان، ولم تك خلقًا من عدم. ثم كاد الجمود والميل إلى الدعة -والقول للزركشي- يذهب بهذا الفن ويقصره على النزاع في طائفة قليلة من رؤوس المسائل[12].
(ج)

ميزان الأصول في نتائج العقول
نازع الغزالي دون لجج الدبوسيَّ لاستكثاره من الفروع (موفرًا الأساس العقلي لتقسيم ابن خلدون اللاحق)، وتمسك علاء الدين السمرقندي (ت. 539هـ) في «ميزان الأصول» بالميز بين الماتريدية من جهة والأشاعرة والمعتزلة من جهة أخرى. وربما كان لوقوف الغزالي على إمكان توسع أصول الفقه دون حد ليشبع نزعات مصنفيه ويترجم عن معارفهم الموسوعية[13] نصيب من بعد في كلام الزركشي الذي رام الجواب عن مسألة نفي الاستقلال عن الأصول؛ أن كان مركبًا من أبعاض مستعارة من فنون شتى، ولذا صح القول بأنه تأليف أو مزج لمباحث من علوم قائمة سلفًا هي علوم اللغة والكلام والفقه.
(د)
لم يكن ما سُمِّي بطريقة الحنفية أو الفقهاء في التصنيف الأصولي بمعزل عن نزاعات علم الكلام. ولئن كان «فصول» الجصاص (ت. 370هـ) بعض ما بقي من أمهات كتب هذه الطريقة، فإنه كذلك مصدر مهم يقف فيه القارئ على التفريق الحيوي بين ما يسوغ من «الاختلاف» وما لا يسوغ، ما كان من ذلك في المذاهب الفقهية وما كان بين الفرق الكلامية. ولقد يصح عدُّ الخلاف بين الفرق الكلامية خلافًا بين الأديان، ولذا نُسب قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري (ت. 168هـ) إلى الاختلاط، إذ ظن أن سواغ الخلاف يعم المسائل الكلامية والعقدية الخالصة، كتصور الذات الإلهية[14].
(هـ)
أخذتُ من «علوم اللغة» قبل أن تكون لي عناية بالغة بالمباحث الكلامية. وانتبه إلى أن الحدود بين الفنون ليست خبط عشواء، وإنما هي عارض ينشأ عن العادات المتصلة بالتأليف وتصنيف المادة، وقد كان القرن الثالث حاسمًا في إرساء استقلال أصول الفقه، وما كان ذلك إلا ثمرة للتوسع والاستطراد المستمر. كان أبو عبيد القاسم بن سلام (ت. 224هـ) من تلاميذ أبي يوسف (ت. 182هـ) ومحمد بن الحسن الشيباني (ت. 189هـ)[15]، وقد نازع أبا عبيد تلميذُه ابن قتيبة (ت. 276هـ) في أقواله في «غريب الحديث» (ما يتعلق بكيفية النظر في طائفة من الكلمات التي وردت على لسان النبي ﷺ، أو في الأخبار التي تروي أفعاله وتنتظم ألفاظًا غير شائعة)، ثم وقف ابن فارس (ت. 395هـ) في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» على كثير مما ينكره على ابن قتيبة، وقد جرت هذه النقاشات جميعًا على التخوم المحاذية لأصول الفقه.
***
لم أستوف الأجل في المئة السادسة من عمري، صار من الجلي -وقد أنفت على ستمائة عام- أن عنايتي مصروفة إلى طائفة من المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة الشرعية، ومدارها لم يزل السؤال عن ماهية الحكم الشرعي وإمكان تحصيله. انظر كيف استهل الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت. 476هـ) مختصره الأصولي «اللمع»: «ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه، وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما؛ لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما؛ لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نُبيّن الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل».
(أ)
شق عليّ أهل الحديث (أو من عدُّوا أنفسهم أنصارًا للحديث)، كتقي الدين السبكي (ت. 756هـ) وابن تيمية (ت. 728هـ) وابن حجر (ت. 852هـ)، لكنهم لم يبلغوا حد القضاء علي.
كان بناء الفقه على الحديث غاية قديمة، وقد نقل عبد العظيم الديب قول عبد الغافر الفارسي (ت. 529هـ) مصنف «السياق لتاريخ نيسابور»، في الجويني «ولولاه لصار أصحاب الحديث حديثًا [فيُذكرون، ولا يُرى لهم أثر]»[16] فمن هم أصحاب الحديث؟ لا مرية أنهم الشافعية.
لو أن شافعيًّا وقف على حديث يعارض بعض أحكام المذهب، فالأمر بين أن يكون الإمام الشافعي قد فاته الصواب، أو أنه رغم علمه بالحديث لم يره، خلافًا للظاهر من صحته، موجبًا للقول بمقتضاه.
روي عن الشافعي أنه قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». وقد ارتأى تقي الدين السبكي لزوم تصنيف رسالة لبيان السبيل التي أقام بها فقهاء الشافعية على التمسك بمذهب إمامهم، دون أن يفرِّطوا فيما التزمه من اتباع الحديث. إذ التزام الشافعي بالحديث الصحيح حاكمًا على مذهبه مناقضٌ -على نحو ما- لعمل الشافعي. فلو أن شافعيًّا وقف على حديث يعارض بعض أحكام المذهب، فالأمر بين أن يكون الإمام الشافعي قد فاته الصواب، أو أنه رغم علمه بالحديث لم يره، خلافًا للظاهر من صحته، موجبًا للقول بمقتضاه. كيف للمرء -والحال هذه- أن يُعيّن وقوع واحد من الأمرَيْن؟
الحق عند السبكي أن الأمر مظنة للزلل، وهو يسوق قول ابن الصلاح (ت. 643هـ) ليعْلمنا بالآتي:
«ممن حكي عنه منهم أنه أفتى بالحديث في مثل ذلك: أبو يعقوب البويطي (ت. 231هـ)، وأبو القاسم الداركي (ت. 375هـ)، وهو الذي قطع به أبو الحسن إلكيا الطبري (ت. 504هـ)، وليس هذا بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ممن صحب الشافعي».
إذن، ما السبيل والحال هذه؟ إن آنس الفقيه المتبع لمذهب الشافعي من نفسه القدرة على تمييز أسباب التعارض الظاهر بين ما قال الشافعي إنه سيفعله [من العمل بكل حديث صح]، وبين ما وقع من عمله فعلًا [من ترك العمل بالحديث]، فذاك من يسعه العمل بما أداه إليه اجتهاده، ولازم هذا أنه لا حرج عليه في اتباع الحديث والعدول عن قول إمامه الشافعي. فإن لم يبلغ الفقيه الرتبة التي تجعل له الاستقلال بالاجتهاد فليس له العمل بالحديث إلا في حال واحدة ولا مزيد، وتلك هي قول إمام مستقل بمقتضاه. وتلك حالة فريدة ومحدودة يسوغ لمقلد الشافعي فيها أن يتبع مذهبًا آخر، ومراده أن يتمذهب بمذهب إمام عمل بالحديث الذي عدل عنه الشافعي (وقد خفي عنا علة عدوله هذا).
ولئن عجبت من تلك النتيجة، فإنما سوَّغ لها أمران، أولهما: أن الإمام الشافعي دون سواه هو من افترع الأمر، فدعا مقلديه إلى اتباع النبي ﷺ وترك قوله إن هو فرط في العمل بما زعم أنه يعمل به من اتباع النبي ﷺ. وثانيهما: أن في احتجاج أحد من الأئمة المجتهدين بالحديث (خلافًا لمذهب الشافعي) رفعًا للحرج عن مقلد الشافعي الذي قَصُرت آلته الفقهية عن تحصيل المسألة دون الرجوع إلى أقوال الأئمة الآخرين.
تلك صور المسألة عند ابن الصلاح، أتُراه غفل عن شيء؟ أتُراه ذكر القول في شافعي وقف على حديث دون أن يجد إمامًا مستقلًّا احتج به؟ واقع الحال أن ابن الصلاح قد غفل عن معالجة هذه الصورة. وقد تنبه السبكي لهذا، ثم ترجح عنده أن علة امتناع ابن الصلاح عن إيراد هذا الاحتمال ظنه أن وجودها يعني وقوع مسألة أجمع الفقهاء فيها على الإعراض عن الحديث كليًّا.
على أن السبكي لم يقنع بهذا، فذكر حالة الاختلاف في أمر يكون فيه حديث يفضي إلى حكم معين وهو صحيح، غير أنه لا قائل به من الأئمة المجتهدين. تأمل قوله مرة أخرى: ربما يترك أئمة الفقه جميعًا حديثًا ظاهر الصحة، وليس هذا بدليل على امتناع العمل به، فماذا يصنع؟ يخلص السبكي إلى هذا الحكم: والأولى عندي اتباع الحديث! فهب أن النبي ﷺ ثَمَّ قائم أو قاعد يسألك اتباعه والإعراض عن قول غيره! وإنما كل أحد -والقول للسبكي- مكلَّف بحسب فهمه. على أن النووي (ت. 676هـ) يحذر من العجلة في القول بأن الشافعي أغفل العمل بالحديث، فالظاهر أن إعراض الشافعي عن القول بظاهر طائفة من الأحاديث إنما يكون لعلل أصولية متجهة.
تلك وجهة من اتباع الحديث اتصل العمل بها، وإن خال المرء أن وجاهتها تتفاوت بين باب وآخر. فلئن ورد الحديث في باب من أبواب العبادة، فقُصارى عمل الفقيه بيان ما تقع به العبادة مُجزِئَة؛ ذلك أن القياس -كما يرى أصوليو الحنفية- ممتنع في العبادات والكفارات والحدود. ولشراح الحديث مَهْيَع واسع إن هم عرضوا للأحاديث المتصلة بعبادة النبي (كصفة تهجده ﷺ) من الكلام عن رواة الخبر وما وقع في طرقه من اختلاف الألفاظ. وحديث البخاري [رقم 1120] خير شاهد على ذلك، فقد اتبع ابن حجر في شرحه له ما وصفنا وأجاد فيه. لكن مع النظر بدءُ العلة، وذاك حين نأتي على ذكر هذا الفعل النبوي وعمومه في حق المؤمنين (وترد ثَمَّ مسألة صومه ﷺ الوصال)، ولئن سلَّمنا بعموم هذه العبادات، فهل يلزم المرء المدوامة على التهجد حين يعتريه المرض أو نحوه. إن هذا الباب مداره على معرفة النبي ﷺ وعاداته، غير أن حبل زينب (ت. 8هـ) (ذاك الذي كانت تتعلق به خشية السقوط أثناء صلاتها الطويلة)[17] يلفتنا إلى القاعدة الكلية: القصد خير في الأمور كلها حتى في عبادة الله. وإنما صدرت تلك الأحكام عن وقائع التاريخ وغدت شرائع تعم العالمين، ومحلًّا لتأويلات الفقهاء.
أسرف علَّامة مصر أحمد بن علي بن حجر في الصبر على استقصاء الآراء المتصلة بالأحاديث المعدودة التي جمعها البخاري محمد بن إسماعيل المحدِّث الفارسي الأوزبكي (ت. 256هـ) في صحيحه. ومهما تكن غاية ابن حجر، فإنه بذلك قد قطع طريق الاجتهاد الفقهي، إذ مهد سبيل النظر إلى الفقه باعتداده صنيعة التاريخ/الحديث. وإنما تأتَّى له بلوغ تلك الغاية بكثرة هائلة من الأقوال المسندة المتعلقة بأحاديث البخاري وعدتها نحو 6000، تعمّ كل المسائل وجميع المذاهب وكافة ديار الإسلام.
كان نظام الدين الشاشي (ت. 344هـ) في طليعةٍ من الحنفية الذين صاغوا عبارات من قبيل: «الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى»، فما كان مراده بذلك؟ لا جرم أن مراده مباين بالكلية لكلام أهل الحديث من النووي والسبكي وحتى ابن حجر، فقد وقف على أن ما في القرآن من الفقه قليل، ووطَّن نفسه على التعامل مع هذه الحال. وثَمَّ شاهد يستبين به أن النصوص -في غالب الحال- لا تستقل وحدها بالأحكام. وفي هذا الشاهد يستعين المجتهد بالنص ليفرِّق بين واقعتَيْن يتوهم فيها الأب أو الابن حلّ وطء جارية الآخر. ومن ذلك يظهر أن النص يُقيِّد -بالنظر إلى منزلة الأبوة- اعتداد الملكية المشتركة ضربًا من شبهة الملك. ويظل المعنى العام لمبدأ درء الحد بالشبهة أوسع مجالًا من النص[18].
(ب)
في الجوامع التي تُعْنى باستقصاء الأقوال وبيان ما اندرس منها شاهد على سعة هذا الفن، وليست أمارة موته.
غالى أبو زهرة (ت. 1974م) في حكمه على الزركشي والسيوطي، فغاية أمرهم عنده أن يكونوا جامعين لا علماء. غير أن حكمه هذا يُثبت أن نمو أصول الفقه وتنوعه وسعة مادته شواهد على أن نضجه لم يبلغ حد الاحتراق [فمن العلوم ما لم ينضج، ومنها ما نضج ولم يحترق، ومنها ما نضج واحترق]. وعلاوة على ذلك، استبد بعلماء الفقه أصولًا وفروعًا، في القرنَيْن الثامن والتاسع الهجريَّيْن وما تلاهما، النزوع إلى التوثيق وتصنيف الموسوعات (وهو أمر ستخبره أوروبا بعد نحو ثلاثة قرون)، وبأثر من هذا ترسخ الاشتغال بالتراث المعرفي والخشية من فقدانه، ولم يك في ذلك دلالة على جموده وتوقفه.
(ج)
اتسعت مسائل الاجتهاد حتى امتدت عند البيضاوي (ت. 685هـ) وأبي الثناء الأصفهاني (ت. 749هـ) إلى الفلسفة والفيزياء. ولم يك ذاك إلا تسليمًا باتجاه عُرف سلفًا عند الرازي (ت. 606هـ) والآمدي (ت.631هـ)، ثم اتصل من بعدُ في مصنفات العضد الإيجي (ت.756هـ) وشرَّاحه.
أخذت شواغل الرازي تَسِمُني أنا أصول الفقه بمَيْسمها، وتخوض بالفن في مسائل أوليّة وأشد عمقًا، وهو ما سيتجلى لدى الذين أتوا من بعده (كالأرموي، وأبي الثناء الأصبهاني). ولا ريب أن هذه المسائل لم تكن بِدْعًا بلا سابقة. كما أن الاتصال بين المسائل اللغوية ومعقولية الأحكام، وحرية الإنسان ومعرفته، وما يجب على الله.. إلخ قائمٌ عند معاصرين للرازي، وإن لم يكن اشتغالهم بالفلسفة -بالضرورة- في رتبة اشتغال الرازي، ويمكن الوقوف على ذلك في «المغني» للخبازي (ت.691هـ).
ربما كان الخبازي نفسه بحاجة إلى أن يُكرِّر في مختصره الكلامي[19] «الهادي» انحصارَ العلم في مصادر ثلاثة: (الحواس السليمة، والخبر الصادق، ونظر العقل). وفي ذلك تأكيد على الدرس الأساسي لعلم الأصول، ومؤداه أننا لم نزل في ابتلاء بضرب من «مبدأ الظنية» داخل الإطار الذي أقام المتكلمون والفقهاء على العمل فيه، وهو مبدأ قائم في التفكير البشري، ومنه تصوره لماهية الوحي الإلهي أو ما يفيده. وإنما كان توفّر فلاسفة التشريع المسلمين على مقاصد الوحي، وإن كان ثبوته قطعيًّا لا شبهة فيه.
المعلوم بالسبب إن كان محسوسًا يُدرَك بالحس، وإن كان معقولًا يُدرَك بالعقل، وإن لم يكن محسوسًا ولا معقولًا فلا طريق لدركه إلا الخبر.
يقول الخبازي: «ثم الأسباب التي يحصل بها العمل ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل؛ لأن العلم الحاصل بالعقل إن كان من غيره فهو الخبر، وإن كان من نفسه فإن كان من أسباب ظاهرة فهو الحواس، وإن كان من باطنة فهو العقل. أو نقول: المعلوم بالسبب إن كان محسوسًا يُدرَك بالحس، وإن كان معقولًا يُدرَك بالعقل، وإن لم يكن محسوسًا ولا معقولًا فلا طريق لدركه إلا الخبر. أما الحواس فهي خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وبكل حاسة يعلم ما وضعت هي له. والخبر الصادق وهو نوعان: الخبر المتواتر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وخبر الرسول المؤيد بالمعجزة. فالعلم الحاصل بالحواس والخبر المتواتر ضروري، وبخبر الرسول قطعي لكن بواسطة الاستدلال، وأما نظر العقل فما ثَبُت منه بالبديهة ضروري».
على أن في هذا أيضًا بيانًا لقول ارتجله ابن رشد في «الكشف»، وخُلاصته أن النظر فيما حواه الوحي هو سبيل التثبت من صدقه أو فهمه ابتداء[20]. وحين نتجاوز الشك في تاريخية الوحي سنعكف على محتواه، ولم يبق لنا من بعد ذلك سوى أمر واحد مع السنة النبوية، وهو التصنيف المألوف الذي درج عليه الأصوليون.
يجدر بنا النظر فيما جدَّ من العناصر على المسائل القديمة. وفي هذا المقام ثَمَّ قول لأبي الثناء الأصبهاني (في شرحه على مختصر ابن الحاجب (ت. 646هـ)) يعرض فيه لمنزلة الخبر باعتداده أصلًا للأحكام الشرعية، وهي مسألة شُغِل بها الشافعي في حجاجه للمعتزلة وغيرهم ممن أنكروا إفادة الأخبار المتواترة أو المشهورة وأخبار الآحاد. على أن المتواتر لم يزل مقولة جوهرية في ذلك الجدل، مما أفضى إلى موقف معتدل من الفقهاء يُجعل فيه خبر الواحد أصلًا للأحكام، ويُعتدُّ من الناحية العملية مفيدًا للعلم (لغلبة الظن فيه)[21]. وفي السياق نفسه طرأ نسيج جديد على مسألة إمكان اتفاق المسلمين كافة على مذهب يناقض أصول الإسلام بالكلية (وذاك ما يترجم له بإجماع الأمة على الكفر)[22]، [ليست المسألة اليوم لدى الناس نظرية مجردة فيما أزعم، فعلى الرغم من أن الإحصاءات تبلغ بتعداد المسلمين -من وَرِث الإسلام منهم ومن دخل فيه- ما يناهز المليارَيْن، فإن إمكان العدول السريع والجسور عن العقائد غير مستبعد].
***
القواعد والفروق أبناء إخوتي..
(أ)
ليست المصنفات في فن القواعد (كالتي للقرافي وابن اللحام والتمرتاشي) بالأجنبية عن أصول الفقه، وقد تهيَّأ لها سبيل الذيوع على يد الكرخي (ت. 340هـ) والدبوسي (ت. 430هـ) وأبي محمد الجويني (ت. 438هـ) الذي صنَّف «الجمع والفرق» (وفيه ترسيخ القول بأن الفقه علم يقوم على إدراك ما بين المسائل المتشابهة ظاهرًا من جوامع وفروق، وذاك قولهم: الفقه جمع وفرق).
أفرد الكرابيسي (ت. 570هـ) في مرحلة مبكرة بالتصنيف طائفة من مسائل المذهب الحنفي قد بُنيت على فروق كتلك القائمة في مسائل القياس والاستحسان (وإن رأى المصنف أنها بمعزل عن القياس والاستحسان)، فهيَّأ بذلك السبيل لصياغة الفروق الفقهية[23]، ومن الخير ترك المسائل المتعلقة بالفروق الواردة في مصنفات شبيهة على حالها؛ ذلك أن مرجع محتوى الكتاب إلى مصنفه وحده. وغير بعيد من ذلك، فإن الطريقة التي يفهم بها القارئ جملة معينة من الفروق تجلو لنا طرفًا من تحيزاته في المسألة التي تصاغ منها الأصول. ودونك مثلًا لذلك، الفرق (رقم 328) بين شهادتَيْن: يشهد في أولاهما أربعة من الرجال على الزنا شهادة تتسم بالإجمال ويكسوها الإبهام، وإن كان يسعهم البسط والبيان (ولا شيء على المتهمَيْن بالزنا ثمة، وكذا الشهود. أعني أن حد الزنا وكذا القذف في المسألة ينتفيان). وأما الأخرى فشهادة على الزنا فيها كذلك إجمال وإبهام، لكن وقع فيها اختلاف الشهود[24].
ربما يؤول بنا الكلام في تحديد الرتبة بين علم الأصول وعلم الكلام -على غرار ما ذكره السمرقندي في «ميزان الأصول» (حيث جعل الأصول فرعًا للكلام وأصلًا للفقه)- إلى مسألة استعمالنا للألفاظ، فننتهي إلى خلاف لفظي لا حقيقي. ومن هذا القبيل كذلك القول بابتناء الفقه على الأصول، وابتناء القواعد على الفقه (وهو مذهب ارتضاه علي الندوي في كتابه «القواعد الفقهية»). على أننا نقف في «أشباه» تاج الدين السبكي (ت.771هـ) على مطلب وجيز عن القواعد الكلامية التي تتفرع عنها فروع فقهية[25]، وآخر عن القواعد الأصولية يتخرج عليها مسائل فقهية[26].
(ب)
على أنه لا سبيل إلى أن تحل هذه الصلة ما استحكم من رابطتي بعلم الكلام، أو -في هذا الصدد- بفن الخلاف وقواعده الكلية الحاكمة للجدل والخلاف الفقهي. وآية ذلك كتاب شمس الدين الأصبهاني: القواعد الكلية، فقد جمع فيه جملة من كليات المنطق والأصلَيْن (أصول الفقه وأصول الدين) والخلاف، استبان بسوقها ما بين هذه العلوم الأربعة من صلة راسخة، وكان -على اختصاره- تنبيهًا لنا إلى الرابطة التي لم تنفصم عراها بين هذه الفنون. لقد شُغل الأصفهاني بالرجوع إلى مادة من فلسفة القانون، والنظرية الأصولية، والمنطق الفقهي، والخلاف. ولم يكن ذلك مقتصرًا على أدوات الاستدلال من القياس وعناصره الأساسية من التلازم والدوران والنقض، بل انتظم الآليات الأساسية كالاستصحاب وتداخله مع الأخذ بأقل ما قيل، ناهيك بالمسائل المركبة (أعني التي اجتمع فيها الفقه والإلهيات) كالتكليف، وطبيعة النفس الناطقة، وذلك جلي باهر في الحجج التي سيقت على البعث بعد الموت[27].
(ج)
كان في ظهور مبحثَي المصلحة والعرف (والمقاصد إلى حد ما)، واضطرام أوار النقاش حولهما في العصر الحديث ومطلعه، ما رسَّخ الرابطة الجامعة بين الأصول وغيره من علوم الشرع النظرية، وذاك ظاهر غني عن البيان.
الزعم بانقضاء أجلي على يد الاستعمار وهمٌ كالزعم باحتراقي قبله..
مهَّد ابن عابدين بمذهبه في العرف وأثره في الفقه سبيلَ عبد الوهاب خلاف، فكان للأخير أن يبسط عمل أصول الفقه، فيعم القوانين الحديثة في الشرق الأوسط. وما كان تصور السنهوري للعرف باعتداده وسيلةً لإنشاء القوانين وتفسيرها بمعزل عن تلك التطورات. ولو خامرك الشك في وفاء بني القرن العشرين هؤلاء لتراثهم، فأولى بك الاسترابة في ابن عابدين الذي وضع ثلاثة شروط لاعتبار العرف في الأحكام. بل إنه نافح عن التوسع في مفهوم القياس وإعماله في الوقائع الناشئة عن قياس سابق (غير أنه تعسف فجعل غاية ذلك القرن الرابع، لبعد الشُّقة عن الأصل المقيس عليه). وليست تلك النزاعات سوى أثر لطول ما تصرَّم من الزمان على التراث مذ نشأ. على أن الدرس المستفاد من ابن عابدين يتمثل في أن الخوض في التراث هو السبيل الوحيد لسكون النفس إليه، لا القناعة بالإنكار على ذامِّيه.
سينزع مستقبلي -اتصالًا بماضيّ الممتد لألف ومئتَيْ عام- إلى توثيق صلته بالعقل ومبتكراته دون النص..
ما من فن أو نظام إلا ويدخله النقص ويعرض له القصور، حتى إن طائفة من مصنفاتي المعتمدة لم تخل من سُخف التحيز المذهبي (ومن ذلك ذهاب ابن السمعاني في «القواطع» إلى اعتداد قول النبي ﷺ: «الأئمة من قريش» حجةً لتفضيل الشافعي، الذي آل أمر المصنف إلى تقليده بعد عقود من انتسابه إلى الحنفية)[28]، وإن كان ذلك فيها نزرًا هينًا، لقد ورث العصر الحديث علوم الفقه النظرية غنيةً بالوضوح والسلامة، وهو أمر قل أن يُعهد في المعارف الأخرى، وسواء في ذلك قواعد اللغة والفلسفة والأدب والتاريخ.
عُني الفقهاء في مشارف العصر الحديث بالجانب العملي من الفقه (القانون الديني الأخلاقي)، بيد أنهم لم يصرفوا كبير عناية إلى العلوم الفقهية النظرية (كالأصول والقواعد والفروق). وقد عُهد إلى بعض هؤلاء بالتدريس في كليات الحقوق الحديثة (كخلاف وأبو زهرة في القاهرة)، فتساءلوا عن أمر سيغدو من بعدُ أشد إثمارًا: لأي أمر كان أصول الفقه؟ حريٌّ بالمجيب أن يُحيط بطرف من تاريخ هذا العلم، ولقد يجدر به البدء من العصر الحديث عودًا إلى ما قبله، فيحدوه ذلك إلى تلك النتيجة: لئن بدا من المحال تطبيقُ الجانب العملي من القانون الديني الأخلاقي (الفقه)، فإن لعلوم الفقه النظرية جوابًا آخر مؤداه إمكان ذلك، وتوقفه على استيعاب المشتغلين بالفقه لهذا الفن وملكاته.
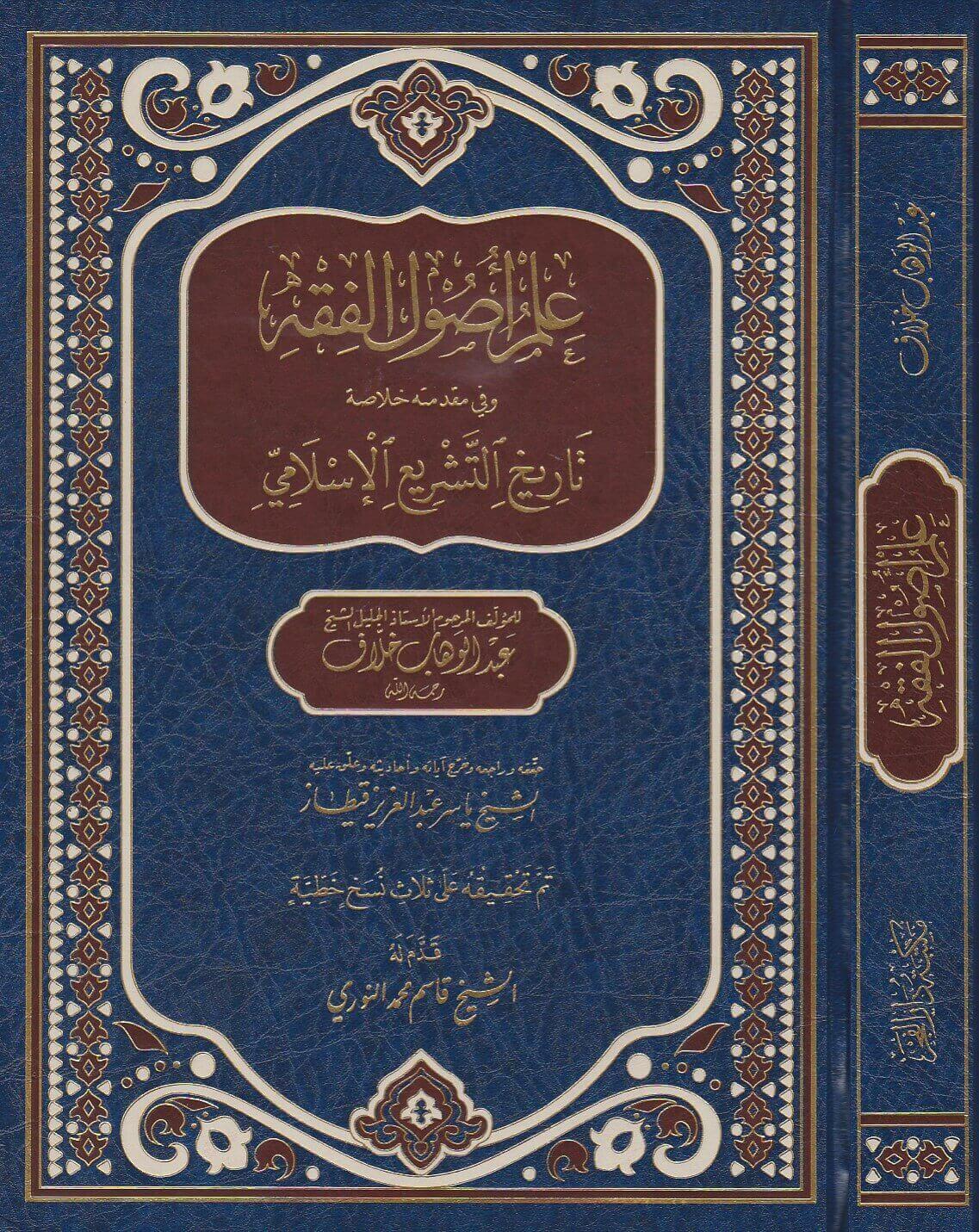
أصول الفقه- عبد الوهاب خلاف
يستمسك عبد الوهاب خلاف، في مقدمة كتابه: أصول الفقه عام 1942م، بأن أصول الفقه منهج، من أجل ذلك كانت مناهج التفكير الأصولية باقية على تغير الزمان، خلافًا عن الأحكام الفقهية التي قد لا تلائم من الزمان سوى ما استُنبِطت فيه. وهو يصرف طائفة من كتابه إلى تعليقات مركبة (تلك التي تشق عليك عادة إن كان أولُ نظرك في الكتاب غيرَ مسبوق بدراسة القانون الحديث)، يستبين بها بعض وجوه التلاقي الجذري بين قواعد التفكير التشريعي: الموروث منها والمستجد. وتلك سلسلة تمتد من المبدأ القائل بأن معرفة الحكم [التي يترتب عليها التكليف والجزاء] إنما تعني إمكان الوقوف عليه وتحصيله لأولئك الساعين لمعرفته، (وسواء في ذلك اطلاعك على نزاع الأشاعرة والمعتزلة في المسألة وإسراعك إلى الثمرة العملية المذكورة في المادة الثانية من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لعام 1883م) وحتى قواعد الاستنباط من النصوص التي تنزع إلى المبالغة في الاستقصاء والنظر في العام والخاص والحقيقة والمجاز والظاهر والخفي، وأشباه ذلك من المسائل[29].
ولقد يسع المرء أن يعوِّل على توظيف السنهوري للعرف، إذ اعتده قرين الشريعة الحية في المصدرية، فيخطو إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى الاستعانة بمفهوم الرضا الفردي أساسًا لحياة الأحكام الإسلامية في المستقبل، حتى تتأسس الأحكام على رضا الفرد، أكان ذلك في اتباع ملة من الملل، أو حكم من الأحكام، أو نظام في الأخلاق، أو إنشاء للعقود. فقد وسع المرء دومًا أن يُلْزِم نفسه (نذرًا أو يمينًا) فيكون من ثمرة ذلك اشتغال ذمته بالواجب. وربما أمكن التنظير لاجتماع هذه الأمور واحتشادها بوصفها بعض تطبيقات العرف الذي يُقرُّه الناس. ومن ثمرة ذلك عون المشتغلين بالتشريع على استنباط الصورة الحقيقية للموطن الذي نشأت فيه الشريعة الحية ونمت.
مضيتُ من بعد ذلك مستوثقًا من أني أفدت واحدًا من أهم الدروس الأساسية في تاريخ الفكر البشري، وذلكم أن الظن لا يحول دون العمل. إن حصري في حدود الدراسات الإسلامية الفقيرة يجعلني عرضة للتأثر بالدخيل من النقد والتاريخية السطحيَّيْن. (ربما لم تزل طائفة من الناس على جهل ببزوغ عصر ما بعد النقد وما بعد التاريخانية)، وفي إخضاعي لفرضيات أجنبية عني ما يؤذن بالقضاء عليّ، وذاك حين يُزعَم أن كل احتمال لما أردته مصيب، خلا ذاك الذي نشأ عن تصوري لذاتي.
كان مبدأ أصول الفقه عناصرَ أولية بسيطة تتمثل في مسائل تتعلق باللغة، والتاريخ، والمنطق التشريعي والعقدي، ثم كان من ثمرة ذلك أدوات فرعية لم تزل الحاجة إليها قائمة في عصرنا هذا. ومن جملة ما نتج من المقولات المنهجية مباحث الأهلية، أي للتكاليف الشرعية والأخلاقية، وفيها بيان إجمالي للمسائل الفقهية المهمة، ومنها يُسْتفَاد أن من عوارض الأهلية السفر (الذي يُبيحُ للمسافر أداء الصلوات المفروضة جمعًا وقصرًا)، ومنها كذلك النفاس (وفيه إسقاط التكاليف بالكلية)[30].
أثرى الرجوعُ إلى ما لدي من قواعد في تفسير النصوص الشرعية مباحثَ التفسير القانوني في التشريعات الحديثة، كما أن النقاشات الحديثة في الفلسفة التحليلية/اللغوية، وعلاقة اللغة بالوجود الخارجي، وحدود ما يمكن الدلالة عليه بالقول، إنما أغناها ووسَّع لها الآفاقَ اقترانُها بما يشبهها في التراث القديم، وهاك عبد الوهاب خلاف (ت. 1375هـ/1956م) مرة أخرى يقول:
«وعلى هذا فالقواعد والضوابط التي قررها علماء أصول الفقه الإسلامي في طرق دلالة الألفاظ على المعاني، وفيما يُفيد العموم والخصوص من الصيغ، وفيما يدل على العام والمطلق والمشترك، وفيما يحتمل التأويل وما لا يحتمل التأويل، وفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب، وغير ذلك من ضوابط فهم النصوص واستثمار الأحكام منها، كما تُراعى في فهم النصوص الشرعية فإنها تُراعى في فهم نصوص القانون المدني، والتجاري، وقانون المرافعات، والعقوبات، وغيرها من قوانين الدولة الموضوعة باللغة العربية، طبقًا للمادة 149 من الدستور: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية».
وختام ذلك أن أصول الفقه من الفقيه منزعُه العقلي، وأنه يورثه القدرة على سبر النص القرآني. في سورة الطلاق (الآية 4) نص لا إبهام فيه على أن الحامل إن فارقت زوجها حل لها النكاح بوضع الحمل. وربما يستبهم الأمر على من حملوا النص القاضي بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر للائي لا يحضن (ومن عجب أنه مذكور في الآية نفسها، وإن غلب على بعض القراء تجاهله)، على الزمن الذي تتربصه المرأة (العدة) عقيب الطلاق قبل النكاح مرة أخرى. وحينئذ فلا محل لسؤال بعض الناس: «ما بال رجل وامرأة وقع بينهما الطلاق في الثالثة عصرًا يسلكان من بعده سبلًا شتى، حتى كان للرجل أن يتزوج ولو بعد ساعات ثلاث (في السادسة)، على حين يلزم المرأة التربص لأشهر ثلاثة؟»، إذ كان للسائل أن يعود فيذكر أن فرضية السؤال بمعزل عن الصواب، فإنما قاعدة التكليف وعوارض الأهلية جانب واحد من أصول الفقه يمهد السبيل إلى النص.
ولقد ترى في هذا -إن أنت لم تُنعم النظر- خلاصة أو كلمة ختامية. والحق أنه بإنعام النظر فاتحة لإحسان الاتصال بعالم مفتوح لا ينبغي تقييده بمسائل الفن التراثية، وإذن فذاك تمهيد لدراسة علم أصول الفقه، على شاكلة تضع عنها إصر الاختلاط الفاحش في فهم تاريخ هذا العلم ومنزلته باعتداده سهمة في الفكر الإنساني.
تذييل
لو كنتُ طالبًا يدرس مجالا آخر ينتظم الكثير من السُّهم الفكرية للعقول قديمًا وحديثًا وفيما بين ذين، لكنت أهلًا (ولعل ذلك ما كان) ليأس يورثنيه الوعي بحال البحث العلمي فيما بعد الاستعمار، وفيه لا يعدو الباحث المعاصر في هذه المجالات خيارًا أو اثنين: الاحتفاء بأحوال العصر الحديث، أو التنكر لها. على أن أصول الفقه -إن فهمته على الوجه الذي طرحته- يحدونا إلى سبيل آخر من الثقة بقدرة طالب هذا المجال على الخوض دون نَصَب في الفلسفة الحديثة (ومنها المادية)، وتاريخ القانون والعلوم، وما شئت بعدُ في الفكر والبحث العلمي. ربما يسلِّم المرء بأن عالمنا مستمسك بأنه لا محل فيه للمعنى يبعثه العقل أو يزجيه الخيال، لكن ما أحراه أن يرجع -والحال هذه- فيجزم بأن أصول الفقه لم تزل مصدرًا لهذا المعنى (ذلك أن أصول الفقه بعض صنائع الواقع فتنبه). لقد ألَّف علم الأصول بين مباحث شتى، من النظر في اللغة والتاريخ إلى النزاع في طبيعة القطع والدليل، وهي لا تتنازع فيه موضع الصدارة، وإنما يرفد بعضها بعضًا. وليس ذلك بقائم في الفلسفة الحديثة، فقد مثَّل المنعطف اللغوي فيها -وليكن ذلك آخر ما نمثِّل به- تحولًا في محل العناية والتوفر، ووهّن -أو كاد- من سعي الميتافيزيقا (وفيها ميتافيزيقا الرياضيات) إلى الانتفاع بالتحليل اللغوي التقليدي. وسبيل تلك المسائل في أصول الفقه التعايش لا التصارع.
الهوامش
[1] نسبة إلى حاريص، وهي مدينة لبنانية، عاش بها الفقيه الشيعي بين عامَيْ (1911 و1999م).
[2] (بيروت: دار العَودة، 1987م)، ص7-8.
[3] يتردد صدى هذا القول الرائع في حديث ابن رشد (ت. 595هـ) عن منزلة علماء المالكية في موطنه الأندلس، وقد أوردته وعرضت له بالنقاش في الفصل الرابع من كتابي «فتور الشريعة».
[4] السابق، ص8.
[5] استعنت بقائمة المصادر الأصولية التي تضمها المكتبة الشاملة الحديثة متى أمكن، وذلك ابتغاء تسهيل الوصول إلى المصادر العربية الواردة هنا. وقمت بالإحالة فيما دون ذلك (مثال ذلك: شمس الدين الأصفهاني (ت. 688هـ))، القواعد الكلية، وعبد الوهاب خلاف (ت. 1956م)، كما قمت بإضافة مزيد من المعلومات لتيسير الرجوع إلى الموضع المقتبس، ففي المثال السابق اعتمدت على طبعة الدعوة، منشورات الأزهر، 1956م، التي قدَّم لها محمد أبو زهرة (ت. 1974م) صديق خلاف، وهي الطبعة التي تُعَدُّ أصلًا لما سواها من طبعات الكتاب، حتى طبعات القرن الحادي والعشرين التي يشيع تداولها.
جاء في تاريخ الإسلام للذهبي، 5/156، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب، 2003م، الطبقة الثالثة والعشرون:
«قال الطحاوي: حدثني أبو خازم القاضي قال: حدثني شعيب بن أيوب قال: لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التي أوردها على أصحابنا قال المأمون لإسماعيل بن حماد ولبشر ولابن سماعة: إن لم تبينوا الحجة وإلا منعتكم من الفتوى بهذا القول -يعني الذي يخالف هذه الأحاديث- وجمعت الناس على خلافه. ولم يكن عيسى بن أبان حضر، كان دونهم في السن، فوضع إسماعيل بن حماد كتابًا كان سبابًا كله، وتكلَّف يحيى بن أكثم فلم يعمل شيئًا، فوضع عيسى بن أبان كتابه الصغير فأُدخِل على المأمون، فلما قرأه قال:
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالناس أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجـهها ... حسدًا وبغيًا: إنه لذميم».
[6] عبد العظيم الديب، في مقدمة تحقيق نهاية المطلب1/147، في سبق العراقيين للخراسانيين من الشافعية وفي التزام العراقيين بقديم المذهب والخراسانيين بجديده:
«كما ننبه أيضًا لعبارة موهمة وردت في البحث الأصيل لأخينا النبيل الشيخ محمد إبراهيم علي «المذهب عند الشافعية»، فقد جاء عند الحديث عن الطريقتَيْن قوله: «وبقيت طريقة العراقيين وحيدة في الميدان الفقهي الشافعي، فقولها هو المعتمد، حتى نبغ القفال الصغير المروزي واشتهر بالتدوين في الفقه، وتبعه جماعة لا يُحْصَون عددًا...». فهذه العبارة توحي، بل تُصرِّح أن طريقة العراقيين تقدَّمت في النشأة عن طريقة الخراسانيين وظلَّت زمانًا لا يعرف الفقهُ الشافعي غيرَها، حتى ظهرت طريقة الخراسانيين متأخرة عنها بزمان طويل، هذا ما تقول به العبارة. والواقع أن تمايز الطريقتَيْن في رواية المذهب نشأ في وقت واحد، وما قبلهما لم يكن يوصف بأنه عراقي ولا خراساني. والذي يشهد بأن نشوء الطريقتَيْن كان متزامنًا وفي وقت واحد بصورة لا تقبل الشك هو النظر إلى ترجمة شَيْخي الطريقتَيْن، الشيخ أبي حامد الإسفراييني والقفال المروزي، فهما من طبقة زمنية واحدة، بل إن ميلاد القفال شيخ طريقة المراوزة قبل ميلاد أبي حامد شيخ طريقة العراقيين، فقد وُلِد القفال سنة 327هـ، على حين وُلِد أبو حامد سنة 344هـ، وإذا قيل لنا: إن القفال تأخر اشتغاله بالفقه إلى سن الثلاثين، فالجواب أننا لو قدَّرنا تأخر ميلاده سبع عشر سنة مثلًا (وهي فترة الطفولة والصبا) لوقع ميلاده في السنة نفسها التي ولد فيها شيخ طريقة العراق وهي سنة 344هـ، أو نقول: إن القفال اشتغل بالفقه سنة 357هـ بعدما بلغ سنّ الثلاثين، وأفتى بعد نحو عشر سنوات من اشتغاله بالفقه أي في سنة 367هـ، وقد ذكروا أن الشيخ أبا حامد كان مبكر النبوغ فأفتى وهو ابن سبع عشرة سنة، أي في سنة 361هـ. فهذا التدقيق في تواريخ الميلاد والاشتغال بالفقه يضع أمامك الدليل القاطع بأنهما متعاصران تمامًا، وإن تفاوتا بعض التفاوت ميلادًا ووفاة (القفال 327-417هـ) و(الشيخ أبو حامد 344-406هـ). وواضح أن هذا الوهم بسَبْق طريقة العراقيين مبنيٌّ على ما هو أكبر منه، وهو أن العراقيين كانوا يروون المذهب القديم فقط، والخراسانيون كانوا يروون المذهب الجديد فقط حتى مطلع القرن الخامس، حين جمع بينهما الشيخُ أبو علي السنجي المتوفى نحو سنة 430هـ، وهذا هو نص كلامه الذي أَفْهمَ ذلك: «وبظهور هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين الطريقتَيْن، بدأ الرافدان الأساسيان الناقلان لفقه الشافعي: قديمه وجديده يلتقيان في قولٍ موحَّد يمثل مذهبَ الشافعي والراجحَ من قوله». وهذا لا قائل به ولا هو بمعقول، فمنذ قرَّر الشافعي مذهبه الجديد ودُوّنت كتبه الجديدة وهي تُروى في العراق كما كانت تُروى في خراسان. وهذا الوهم جاء الباحثَ من عبارة الشيخ أحمد بك الحسيني التي هي مصدره، حيث قال بعد أن ذكر طريقة العراقيين: «وحتى جاء القفال الصغير، وتبعه جماعة...» فأوهم تعبيرُه بـ(حتى) وجودَ (غاية) زمنية ومدّةٍ بين ظهور الطريقتَيْن. والواقع أن (حتى) في عبارة الحسيني معطوفة على مثلها بالنسبة لطريقة العراقيين، ونص كلامه وهو يتكلم عن تطور المذهب: «... ثم جاء بعدهم بقية أصحاب الوجوه طبقة بعد طبقة، حتى جاء الشيخ أبو حامد الإسفراييني، وتبعه جماعة... وحتى جاء القفال المروزي وتبعه جماعة...» فعند التنبه لهذا (العطف) لا توحي العبارة بوجود سبق زمني بين الطريقتَيْن».
[7] المقدمة، الفصل السابع، 570/1، تحقيق: خليل شحادة:
٥٧٠- وتميَّزت للمذهب المالكي ثلاث طرق: للقرويين وكبيرهم سحنون الآخذ عن أبي القاسم، وللقرطبيين وكبيرهم ابن حبيب الآخذ عن مالك ومطرف وابن الماجشون وأصبغ، وللعراقيين وكبيرهم القاضي إسماعيل وأصحابه، وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين.
[8] المقدمة، الفصل السابع، 1/564-570، تحقيق: خليل شحادة:
٥٦٤- وكَمُل الفقه وأصبح صناعة وعلمًا فبدَّلوا باسم الفقهاء والعلماء القرَّاء، وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتَيْن: طريقة أهل الرَّأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز، وكان الحديث قليلًا في أهل العراق لما قدَّمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرَّأي، ومقدَّم جماعتهم الذي استقرَّ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعيّ من بعده…
٥٦٥- وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، واختصّ بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة؛ لأنه رأى أنهم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم الآخذين ذلك عنه. وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية. وظنَّ كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأن دليل الإجماع لا يخصّ أهل المدينة من سواهم بل هو شامل للأمة. واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد. ومالك رحمه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه…
[9] الفصل التاسع، أصول الفقه (والجدل والخلاف):
٥٧٥- وكان أوَّل من كتب فيه الشافعي ، أملى فيه رسالته المشهورة التي تكلَّم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحقَّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب المتكلِّمون أيضًا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه وأليقُ بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النّكت الفقهية. والمتكلِّمون يُجرِّدون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنّه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النُّكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمّم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكمُلَت صناعة أصول الفقه بكماله، وتهذَّبت مسائله وتمهَّدت قواعده وعني الناس بطريقة المتكلِّمين فيه. وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلِّمون «كتاب البرهان» لإمام الحرمين و«المستصفى» للغزالي وهما من الأشعرية، وكتاب «العمد» لعبد الجبّار وشرحه «المعتمد» لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه.
[10] أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص304-305:
بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد:
«ثم إذا تعارض الدليلان عند المجتهد، فإن كان التعارض بين الآيتَيْن يميل إلى السنة. وإن كان بين السنتَيْن يميل إلى آثار الصحابةوالقياس الصحيح. ثم إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما؛ لأنه ليس دون القياس دليل شرعي يُصار إليه، وعلى هذا قلنا: إذا كان مع المسافر إناءان: طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم. ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما؛ لأن للماء بدلًا وهو التراب وليس للثوب بدل يُصار إليه، فثبت بهذا أن العمل بالرأي إنما يكون عند انعدام دليل سواه شرعًا، ثم إذا تحرَّى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحري، وبيانه فيما إذا تحرى بين الثوبَيْن وصلى الظهر بأحدهما ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر؛ لأن الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحري، وهذا بخلاف ما إذا تحرى في القبلة ثم تبدَّل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه إليه؛ لأن القبلة مما يحتمل الانتقال فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص، وعلى هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأي العبد كما عرف».
[11] مقدمة المعتمد للبصري:
«ثم الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أصول الفقه بعد شرحي كتاب «العمد» واستقصاء القول فيه، أني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام، نحو القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده النظر إلى غير ذلك، فطال الكتاب بذلك وبذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثير منها، فأحببت أن أؤلف كتابًا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم، وإن يعلق به من وجه بعيد فإنه إذا لم يجز أن يُذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل وأصول الفقه مع كون الفقه مبنيًّا على ذلك مع شدة اتصاله به، فبأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصول الفقه على بُعد تعلقها بها، ومع أنه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى، وأيضًا فإن القارئ لهذه الأبواب في أصول الفقه إن كان عارفًا بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء، وليس يستفيد من هذه الأبواب شيئًا، وإن كان غير عارف بالكلام صَعُب عليه فهمها وإن شرحت له، فيعظم ضجره وملله إذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يَصعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه، فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه».
[12] مقدمة البحر المحيط للزركشي:
«أما بعد: فإن أولى ما صُرِفت الهمم إلى تمهيده، وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده وتشييده، العلم الذي هو قوام الدين، والمرقى إلى درجات المتقين. وكان علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق، وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق، فإنه قاعدة الشرع، وأصل يُرَد إليه كل فرع. وقد أشار المصطفى ﷺ في جوامع كَلِمه إليه، ونبَّه أرباب اللسان عليه، فصدر في الصدر الأول منه جملة سنية، ورموز خفية، حتى جاء الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي فاهتدى بمناره، ومشى إلى ضوء ناره، فشمَّر عن ساعد الاجتهاد، وجاهد في تحصيل هذا الغرض السني حق الجهاد، وأظهر دفائنه وكنوزه وأوضح إشاراته ورموزه، وأبرز مخبآته وكانت مستورة، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نوَّر بعلم الأصول دُجى الآفاق، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق. وجاء مَنْ بعده فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات، وفكَّا الإشارات، وبيَّنا الإجمال، ورفعا الإشكال. واقتفى الناس بآثارهم، وساروا على لاحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا، فجزاهم الله خير الجزاء ومنحهم بكل مسرة وهناء. ثم جاءت أخرى من المتأخرين فحجَّروا ما كان واسعًا، وأبعدوا ما كان شاسعًا، واقتصروا على بعض رءوس المسائل، وكثَّروا من الشبه والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق، وتركوا أقوال من لهذا الفن أصل، وإلى حقيقته وصل، فكاد يعود أمره إلى الأول، وتذهب عنه بهجة المعول، فيقولون: خلافًا لأبي هاشم، أو وفاقًا للجبائي، وتكون للشافعي منصوصة، وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة، وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة، وتقريرات فائقة، ونقول غريبة، ومباحث عجيبة».
[13] المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، 1993م، ص9:
«اعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم، فقالوا: إذا لم يكن بُدٌّ من معرفة الحكم حتى كانت معرفته أحد الأقطاب الأربعة فلا بُدَّ أيضًا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بُدَّ من معرفة النظر، فشرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر، وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملًا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد -رحمه الله- وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه، وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين؛ لأن الحد يُثبت في النفس صور هذه الأمور ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه».
[14] فصول الجصاص، 4/375:
«قال أبو بكر: زعم عبيد الله العنبري: أن اختلاف أهل الملة في العدل والجبر، وفي التوحيد والتشبيه، والإرجاء والوعيد، وفي الأسماء، والأحكام، وسائر ما اختلفوا فيه، كله حق وصواب. إذ كل قائل منهم فإنما اعتقد ما صار إليه من جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون؛ لأن كل واحد منهم كلّف أن يقول فيه بما غلب في ظنه، واستولى عليه رأيه، ولم يكلّف فيه علم المغيب عند الله تعالى، على حسب ما قلنا في حكم المجتهدين في أحكام حوادث الفُتيا. قال أبو بكر: وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال. والأصل فيه: أن التكليف من طريق الاجتهاد إنما يصح على الوجه الذي يصح ورود النص به، (وكل ما) أجزنا فيه الاجتهاد، وصوّبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه، فإنما أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة. فأما العدل والجبر، والتوحيد والتشبيه ونحو ذلك، فإنه غير جائز ورود النص فيه بجميع أقاويل المختلفين. والذي كلّف المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه على ما هو عليه، ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل، وآخرين القول بالجبر، وبتكليف بعضهم القول بالتوحيد، وآخر القول بالتشبيه».
[15] تُثير كتب الشيباني أسئلة حول دور ابن أبان في نشأة أصول الفقه، على نحو ما ذهبت إليه في ورقتي: «سبعة وخمسون كتابًا» (Fifty-Seven Tracts) وفي هذه الحالة وغيرها من الرجوع إلى أعمالي السابقة أجازف بالظهور مظهر المتبع للنمط الجديد من الرجوع إلى الأعمال الشخصية لغير سبب وجيه، وربما لغير سبب مطلقًا، على أن حرج إقرار الحجج التي لم أحققها هنا تُحدق بي من الطرف الآخر.
[16] يعوِّل المبحث القادم على محاضرة كتبتها لسيمنار عقده «معهد الدراسات الإبستمولوجية في أوروبا» في 3 إبريل 2021م، وهي بأكملها بين يدَيْ منظمي هذا المؤتمر.
[17] الحديث 1150، فتح الباري، (3/36).
[18] أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص300-301:
«فصل. الواجب على المجتهد طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى، ثم من سنة رسول الله ﷺ بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره؛ فإنه لا سبيل إلى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص؛ ولهذا إذا اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحري، ولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضؤ به بل يتيمم. وعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا: إن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الأول. ومثاله فيما إذا وطئ جارية ابنه لا يُحَد وإن قال علمت أنها عليّ حرام ويثبت نسب الولد منه؛ لأن شبهة الملك لا تثبت بالنص في مال الابن، قال عليه الصلاة والسلام: (أنت ومالك لأبيك) فسقط اعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك، ولو وطئ الابن جارية أبيه يُعتبر ظنه في الحل والحرمة حتى لو قال ظننت أنها عليّ حرام يجب الحد».
[19] الهادي، فيض الله، اللوحة رقم 2.
[20] أوردنا قول ابن رشد هذا، وفصَّلنا القول فيه في الفصل الرابع من «فتور الشريعة».
[ناقش ابن رشد قول المتكلمين بثبوت الرسالة بناء على تجويز العقل لها، وقولهم: إن من ظهرت المعجزة على يديه فهو رسول. ورأى أن ذلك لا يصح إلا أن يكون المعجز دالًّا على الرسالة نفسها وعلى المرسل. ثم إنه جعل الدليل على صدق نبوة محمد ﷺ القرآن، وذلك عنده قائم على أصلَيْن، الأول: أن وجود صنف من الناس (هم الرسل والأنبياء) يضعون الشرائع بوحي من الله معلوم بنفسه، ولا ينكره إلا من جحد المتواتر. والثاني: أن من وضع الشرائع بوحي فهو نبي. وذاك غير مشكوك فيه، ودلالة هذا الأمر على النبوة كدلالة الإبراء على الطب. وجعل يستدل لكل واحد من الأصلَيْن، ثم قال: «فإن قيل: فمن أين يدل القرآن على أنه خارق ومعجز من نوع الخارق الذي يدل دلالة قطعية على صفة النبوة؟... قلنا يوقف على ذلك من وجوه، أحدها: أن يعلم أن الشرائع التي تضمنها من العلم والعمل ليست مما يمكن أن يُكتَسب بتعلم بل بوحي. والثاني: ما تضمَّن من الإعلام بالغيوب. والثالث: من نظمه الذي هو خارج عن النظم الذي يكون بفكر وروية...». الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م، ص181. وانظر فتور الشريعة للمؤلف، ترجمة: طلعت فاروق، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2017م، ص109]. (المترجم)
[21] أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم. وخالفت السمنية -وهم قوم من الهند- في إفادة المتواتر العلم وهو بهت، أي باطل. فإن المتواتر يفيد العلم، سواء كان إخبارًا عن أمور موجودة في زماننا أو أمور ماضية؛ لأنّا نجد بالضرورة العلم بالبلاد النائية، كمكة وبغداد ومصر، والأمم الماضية والأنبياء والخلفاء. وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر.
[22] المحصول، 4/206-208:
«المسألة الرابعة: لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر وحُكِي عن قوم أنه يجوز أن ترتد الأمة لأنها إذا فعلت ذلك لم يكونوا مؤمنين ولا سبيلهم سبيل المؤمنين، وإذا كذبت الرسول خرجت من أن تكون من أمته، وجه القول الأول أن الله عز وجل أوجب اتباع سبيل المؤمنين واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، هذا إذا حملنا لفظ المؤمنين على الإيمان بالقلب أما إذا حملناه على التصديق باللسان ظهر أن الآية دالة على أن المصدقين في الظاهر لا يجوز إجماعهم على الخطأ ذلك يؤمننا من إجماعهم على الكفر.
المسألة الخامسة: يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به؛ لأن عدم العلم بذلك الشيء إذا كان صوابًا لم يلزم من إجماعهم عليه محذور، وللمخالف أن يقول لو أجمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلًا للمؤمنين، فكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل العلم به».
[23] الفروق، أسعد بن محمد بن الحسين، تحقيق: د. محمد طموم، مراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى، 1402هـ-1982م، جزأيَنْ:
«هذه المسائل التي التقطها من الكتب ليس فيها قياس واستحسان إلا خلاف مشهور بين أصحابنا وسمعت القاضي الإمام أبا العلا صاعد بن محمد -أنار الله برهانه وثقل بالخيرات ميزانه- أظهر الفرقان بينها فاستحسنتها، وأردت أن أفردها ليسهل حفظها...».
[24] 328- أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا نزيدك على هذا، لم تُقبَل شهادتهم ولا حدَّ عليهم، وكذلك لو وصفه بعضهم دون بعض، ولو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه وقال الرابع أشهد أنه زان، فسُئِل عن صفته فلم يصفه وجب الحد. والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه، ولا يجب عليهم ويجوز بخلاف ذلك، فالاتفاق على الشهادة بالزنا وجد، والخلاف ممكن فلا يبطل المتعين به بالممكن. وليس كذلك إذا شهد ثلاثة أولًا، ووصفوا ولم يصف الرابع؛ لأن الخلاف قد ظهر، ويجوز أن يُفسِّر الرابع ويجوز ألا يُفسِّر، فلا يبطل الظاهر بخلاف الممكن كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن.
[25] الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، 1991م، 2/3:
«أصل: قال الشيخ أبو الحسن : السعادة والشقاوة لا يتبدلان. ومعنى ذلك أن الاعتبار في الأعمال بالخواتيم، فلا ينفع من مات على الكفر تقدم قناطير من إيمان ولا يضر من مات على إيمان قناطير من كفران. وقال أبو حنيفة : يتبادلان، وتحرير المسألة في كتب الكلام وقد ذكرناها محررة في كتاب منع الموانع. وألفاظ الشافعي وفروعه تدل على القول، بما قاله أبو الحسن…
أصل: العلم: «الاعتقاد الجازم المطابق لموجب» فما لا مطابقة فيه من الاعتقادات الجازمة ليس بعلم، فلا علوم لأرباب الضلالات وذوي الجهالات. وهو بخلاف الظن؛ إذ لا تشترط المطابقة فيه2. فلو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا الإنسان -الذي في يدي- حر حكم بعتقه. بخلاف ما لو قال: أنت تظن. نقله الرافعي عن الروياني عن بعض الأئمة. ولو قيل [أطلَّقت] امرأتك؟ فقال: اعلم أن الأمر على ما تقوله. ففي كونه إقرار بالطلاق وجهان. حكاهما الرافعي في فروع الطلاق من حكاية الروياني عن جده أصحهما: ليس بإقرار؛ لأنه أمره أن يعلم ولم يُحصِّل هذا العلم. قلت: ويمكن تخريج هذا الفرع على أن الأمر لا يستلزم الإرادة، فإنه طلب منه أن يعلم هذا الأمر ولم يُرده؛ إذ لو أراده لأنشأ إيقاع الطلاق. ثم أقول: أمره أن يعلم ولم يُحصِّل هذا العلم. فيه نظر؛ لأنه لما أمره أن الأمر على ما يقول، ومراده بما يقول قوله: الآن طلَّقت امرأتك، لأن يقول: «فعل مضارع حقيقة في الحال» وأيضًا فلا قول له إلا ذلك؛ وإنما يكون الأمر [على] 4 ما قال الآن إذا كانت الآن طالقًا. فظاهر العبارة أن هذا إقرار. وقد يقال: ليس قوله إلا الاستفهام عن أنه هل طلَّق امرأته؟ فكأنه قال: اعلم أن الأمر على الاستفهام الذي نقوله على أنه لو قال: له علي ألف -فيما أعلم [أو أشهد]5 لزمه الألف، بخلاف ما لو قال: فيما أحسب أو أظن. ذكره أبو سعد الهروي وشريح الروياني في «أدب القضاء» قال أبو سعد: «لا انفصال للعلم عن الظن عند علماء الأصول». وذكر الرافعي مسألة الولي في آخر الباب الأول من الإقرار».
[26] الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية،1991م، 2/77:
[مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية]
«اعلم أنَّا لنا في أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبير من الفروع المخرَّجة على الأصول، من نظره عرف أنَّا لم نُسبق إليه، ومن أحاط بما في كتبنا الأربعة وهي: «شرح مختصر ابن الحاجب» و«شرح منهاج البيضاوي» و«المختصر المسمى» و«جمع الجوامع» والأجوبة على الأسئلة التي أوردت عليه المسمى «منع الموانع» من الفروع المخرَّجة على الأصول أحاط بسفر كامل «من ذلك»، ونحن نذكر هنا مشيرًا بما ينبغي أن يدخل في الأشباه والنظائر ومما بعضه غير مذكور في كتبنا المشار إليها ونورده على ترتيب جمع الجوامع مستعينين بالله متوكلين مصلين على نبيه محمد ﷺ.
أصل: التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة ومن ثم يختض بالواجب والمحرم، وقيل: طلبه، فيشمل معهما المندوب والمكروه وهذان القولان لأئمتنا وسلكت الحنفية طريق سبيل آخر فقالوا: التكليف ينقسم إلى وجوب أداء وهو المطالبة بالفعل إيجادًا أو إعدامًا سواء خصصنا تلك المطالبة بالحكمين أم قلنا بدخول الأربعة، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه، وعنوا بهذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب وإن لم يصلح صاحب الذمة للإلزام كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض ثم إنما يجب الأداء على الولي، وزعموا أن استدعاء التكليف الأول عقلًا وفهمًا للخطاب الأول، بخلاف الثاني. قالوا: والأول يتلقى من الخطاب والثاني من الأسباب».
[27] انظر الصفحات: 55، 89، 263، 303، 306، 364.
[28] انظر «القواطع» لابن السمعاني، بيروت، 1999م، (2/367-369).
[29] أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، الدعوة بالأزهر، ص129-141:
«وثانيها: أن يكون معلومًا أن التكليف به صادر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه لأنه بهذا العلم تتجه إرادته إلى امتثاله، وهذا هو السبب في أن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على المكلفين، أي إن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها. وهو السبب أيضًا في أن كل قانون وضعي يتوجب بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحاكم أصدر القانون بِناءً على عرض مجلس الوزراء وموافقة البرلمان، ليعلم المكلفون أن القانون صادر ممن لهم سلطان التشريع، وممن يجب عليهم امتثال تكاليفهم؛ فيتجهوا للتنفيذ.
ويلاحظ أن المراد بعلم المكلف بما كلف به إمكان علمه به، لا علمه به فعلًا، فمتى بلغ الإنسان عاقلًا قادرًا على أن يعرف الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر عنها، اعتُبِر عالمًا بما كلِّف به، ونُفِّذت عليه الأحكام وأُلزم بآثارها ولا يُقبل منه الاعتذار بجهلها. ولهذا قال الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام عذر الجهل بالحكم الشرعي؛ لأنه لو شرط لصحة التكلف علم المكلف فعلًا بما كلِّف به ما استقام التكليف، واتسع المجال للاعتذار بجهل الأحكام. وعلى هذا التقنين الوضعي، فالناس يعتبرون عالمين بالقانون بتيسير إمكان علمهم به، وذلك بنشره بالطريق القانوني بعد إصداره. ولا اعتبار لأن كل فرد من المكلفين علم به فعلًا أو لًا، ولذا جاء في مادة (22) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية: لا يُقبل من أحد أن يدعي بجهله القانون. وكذلك المراد بعلم المكلف بأن تكليفه بما كلِّف به صادر ممن يجب عليه امتثال أحكامه، وإمكان علمه بهذا لا علمه به فعلًا. فكل حكم شرعي يمكن للمكلف أن يعرف دليله، وأن يعرف أن دليله حجة شرعية، على المكلفين إتباع ما يستمد منه، سواء أكان هذا بنفسه أم بواسطة سؤال أهل الذكر عنه».
[30] التقرير والتحبير، ابن أمير حاج، دار الكتب العلمية، 1983م، 2/172:
«(وهذا فصل آخر اختصوا) أي الحنفية (به في بيان أحكام عوارض الأهلية أي أمور ليست ذاتية لها طرأت أولًا) أي خصال أو آفات لها تأثير في الأحكام بالتغيير أو الإعدام سُمِّيت بها لمنعها الأحكام المتعلقة بأهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت، إما لأنها مزيلة لأهلية الوجوب كالموت، أو لأهلية الأداء كالنوم والإغماء، أو مغيرة لبعض الأحكام مع بقاء أصل الأهلية للوجوب والأداء كالسفر، ولذا لم يذكر الكهولة والشيخوخة ونحوهما في جملتها؛ لأنها ليست بأحد هذه الأقسام (فدخل الصغر) لعدم اشتراط الطروء والحدوث بعد العدم فيها، أو كونه ليس من الأمور الذاتية للإنسان ومن ثمة كان الكبير إنسانًا كالصغير، وإن كان ثابتًا في أصل الخلقة لا يخلو عنه إلا نادرًا كآدم وحواء -عليهما السلام- وملخصها أحوال منافية لأهليته غير لازمة له (وهي) أي العوارض (نوعان: سماوية أي ليس للعبد فيها اختيار) فنُسِبت إلى السماء بمعنى أنها نازلة منها بغير اختياره وإرادته، وهي أحد عشر (الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت) قالوا وإنما لم يذكر الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء وإن تغير بها بعض الأحكام لدخولها في المرض وأورد الإغماء والجنون من المرض وقد أُفردا بالذكر وأجيب لاختصاصهما بأحكام كثيرة يحتاج إلى بيانها بخلاف تلك (ومكتسبة أي كسبها العبد أو ترك إزالتها)، وهي سبعة ستة منه، وهي الجهل والسفه والسكر والهزل والخطأ والسفر وواحد من غيره وهو الإكراه».