النقد الأخلاقي التواصلي والتعارفي في عصر ما بعد الأخلاق

ستتم مقاربة هذا الموضوع برؤية منهجية تبحث عن المؤتلف والمختلف في السؤال النقدي الأخلاقي، أولًا لدى النظرية الأخلاقية التواصلية عند هابرماس ومحاولته تجاوز النقد الأخلاقي الكانطي في التداولية الغربية، وثانيًا لدى النظرية الأخلاقية التعارفية المستمدة من المرجعية المعرفية القرآنية ونقدها للتصورات الأخلاقية الموضوعة من العقل الإنساني الأداتي المجرد. إنه بحث في الفكرة النقدية الأخلاقية التي تكشف صيرورة النهضة المعاصرة لعلم الأخلاق، والتي لها تعلُّقات بجهود عدد من المفكرين الذين نشطوا في منظور الفلسفة العملية، نحو ماكس شيلر مؤسس الشخصانية الحديثة وصاحب فلسفة القيم الحازمة والمستكشف لأنماط المشاركة الوجدانية وطبيعة أشكال التعاطف، ونحو مارتن بوبر الذي أوضح أن مسؤولية كل إنسان قائمة في التعامل بالمثل مع الآخر، ونحو حنة أرندت التي أثبتت أهمية الولادة باعتبارها ظهورًا لفرد إنساني حُر وسط تاريخ غير متوقع بطبيعته، ونحو مشروع أخلاقي عالمي لهانس كينغ وما يثير من قضايا أهمها التصادم بين القيم الكونية والقيم الخصوصية، وإشكالية تحديد الخصوصي والكوني بين الأخلاقية الدينية والأخلاقية العقلانية. [1]
إن من أفق هذا البحث الكشف أولًا أن النظرية الأخلاقية التواصلية الهبرماسية لها صلة بتطور فلسفة اللغة وإنجاز الأفعال كما قدَّمها فينغنشتاين وتوظيفها في الخروج من فلسفة الوعي الذاتي إلى فلسفة التواصل التي لا تبقى في حدود الصورية لتهتم بمصالح الأفراد ومنافعهم، ولتصل إلى أهمية الحوار في صنع السلام الدائم، وهو صنع أخلاقي لا يتعب المتتبع في كشف أزمته الفردية والمجتمعية والعالمية. والكشف ثانيًا عن أن نقد النظرية الأخلاقية التعارفية يتجه لجهتين: للعقل الأخلاقي التاريخي الذي برز في التراث الأخلاقي الإسلامي، وللنظرية الأخلاقية في اتجاهاتها العقلانية المعاصرة.
إنه أفق بحثيٌّ يقصد كشف الفكر النقدي الأخلاقي في ما بعد الأخلاقية، ليس في مستوى التحليل اللساني المنطقي للقضايا الأخلاقية، بل باعتباره سؤالًا ما بعد حداثي، يبحث في الأسس الأخلاقية التي تسمو على الواقع الأخلاقي الوضعي، لتتجاوزه نحو أفق الاعتراف بتكاملية الذات الفاعلة مع الآخر، في سبيل تجاوز أخلاق المنفعة الفردية واللذة والسعادة والرفاهية... إلى إنتاج كائن إنساني فاعل تواصلي تعارفي، مفكِّر في أخلاق التضحية والعدالة والعناية والكرامة. وفي منظور هذا الأفق سيتم تحليل ثلاثة محاور:
الأول: في أهمية السؤال النقدي الأخلاقي من كانط إلى مدرسة فرانكفورت ومآلاته الفكرية في إنضاج السؤال الما بعد أخلاقي.
الثاني: قراءة في نظرية التواصل الهبرماسية ونقد الإرث النقدي الأخلاقي الكانطي: من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل.
الثالث: نظرية التعارف الأخلاقي والتأسيس الائتماني لأخلاق الكائن الفاعل.
المحور الأول: في أهمية السؤال النقدي الأخلاقي من كانط إلى مدرسة فرانكفورت ومآلاته الفكرية في إنضاج السؤال الما بعد أخلاقي
فالإدراك بفاعلية الذات الاستعلائية يسهل على العلم عدم البقاء في وضع قوانين للمعرفة العلمية للظاهر، ليخرج من مجاله وإلقاء نظرة على حقائق الأشياء التي ليست في حدِّ ذاتها ظواهر، ولكن إذا كان الذهن المشدود إلى الظواهر لا يستطيع معرفة الأشياء في ذاتها، إلا أن بإمكان العقل التفكير فيها، وبهذا الإمكان يتم تعويض التأملات النظرية التي لا توصل إلى المعرفة النقدية، بالعقل العملي التجريبي الحسي المحدد للسلوك بداعي الواجب. وليس هذا العقل إلا "مَلَكة إدراك الحقيقة فيما يتعلق بما ينبغي أداؤه، أو بما لا بدَّ من عمله"[6]
لا يخرج السؤال النقدي الأخلاقي عن تطور الجدل العقلي الحاد، الذي عرفه السياق الفلسفي الغربي، بمنطق التجاوز للمفاهيم والتصورات المعرفية التي أنتجت في متوالية تاريخية، تمثِّل عصور النهضة والحداثة وما بعدها في أوروبا، فقد تأسست اتجاهات عقلانية اتخذت من المنهج النقدي آلية عقلانية للتأمُّل في مسارات التأسيس العلمي للفلسفة، وجعلت منه قاعدة معرفية، لمراجعة الأسس المعرفية والمبادئ المرجعية التي قام عليها فكر النهضة والحداثة وما بعدها.
ولعل التعريف الذي أعطاه إيمانويل كانط (1724-1804م) للفلسفة بمعناها الكوني، أي علم العلاقات بين كل المعارف والغايات الجوهرية للعقل البشري[2]، يكشف عن أبعاد أهمية السؤال النقدي الأخلاقي، بكونه مندرجًا في منزع نقدي من جهة أولى، للتجريبية التي جعلت من التجربة الحسيَّة المصدر الأساسي للمعرفة والقيم ولم تعط قيمة للذات العارفة، ومن جهة أخرى للعقلانية الدوغمائية التي اعتبرت أن مصدر المعرفة اليقينية هو العقل لا التجربة الحسيَّة. فاتجه المنزع النقدي في استكشاف الذات التي تجمع بين الإدراك العقلاني والتجريبي، ليصير بديلًا عن الميتافيزيقية التقليدية. ويتجلَّى هذا البديل في نقده لنظرية المعرفة، ونقد ميتافيزيقا الأخلاق، ونقد الحكم الجمالي، متأملًا فلسفيًّا بتحليل تركيبي لأربعة أسئلة هي: ماذا أستطيع أن أعرف؟ ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟ أي أمل أستطيع أن آمله؟ ما هو الإنسان؟
لا يقف كانط في تحديد شروط المعرفة من خلال الأحكام التحليلية للصفات المعروفة مسبقًا في الموضوع، أو من خلال الأحكام التركيبية؛ لأنها تضيف إلى الموضوع صفاتٍ لم تكن موجودة فيه، بل يكشف أهمية المكان والزمان في رسمهما الشكل القبلي لحساسية الذات، على الرغم من كونهما ليسا واقعًا موضوعيًّا. ويضيف أن هذا المعطى يتم توضيحه بوساطة مقولات "هي مفاهيم تفيد حصرًا في تنظيم التجربة وضبطها، وهذه المفاهيم بمفردها وبعيدًا عن كل ملء بمادة توفرها حساسيتنا (التي ربما تظل عمياء من دون هذه المفاهيم) هي فارغة ولا يمكن أن يكون لها إذن أي استخدام نظري"[3]، وبهذا فالإنسان هو الذي يبرز ضرورة المعرفة التجريبية. لكن هذه المقولات لما كانت شكلًا من أشكال الربط، "وجب أن يكون هناك أيضًا فعل للربط يكون واحدًا، يسبق هذا الفعل ولا ينجم عنه، إن ذاتًا واحدة يمكن أن تلبي هذا المطلب، ذاتًا لا تكون هي نفسها موضوع تجربة، بما أنها الشرط الأخير لها، وهي الذات الاستعلائية"[4]، التي لاحظ كانط أن ديكارت خلطها بالذات التجريبية في تجربة الكوجيتو "أنا أفكر". وهي في نظر كانط تقتضي الاستقلال في إثبات المعرفة، و"لما كان مستحيلًا غضّ النظر عن شروط المعرفة، فإنه لا يستطاع أن تعرف إلا الأشياء كما تظهر في الظاهر وليس الأشياء كما هي في ذاتها، إذن المعرفة النظرية مستحيلة"[5]. فالإدراك بفاعلية الذات الاستعلائية يسهل على العلم عدم البقاء في وضع قوانين للمعرفة العلمية للظاهر، ليخرج من مجاله وإلقاء نظرة على حقائق الأشياء التي ليست في حدِّ ذاتها ظواهر، ولكن إذا كان الذهن المشدود إلى الظواهر لا يستطيع معرفة الأشياء في ذاتها، إلا أن بإمكان العقل التفكير فيها، وبهذا الإمكان يتم تعويض التأملات النظرية التي لا توصل إلى المعرفة النقدية، بالعقل العملي التجريبي الحسي المحدد للسلوك بداعي الواجب. وليس هذا العقل إلا "مَلَكة إدراك الحقيقة فيما يتعلق بما ينبغي أداؤه، أو بما لا بدَّ من عمله"[6]، فالعقل العملي ينتشر في الدائرة المحددة للسلوك التي تجمع كل ما هو ممكن بوساطة الحرية، والسلوك له ارتباط بفكرة الواجب، فلا سلوك دون تمسُّك بالواجب أو بمبادئ الأمانة. إذ فكرة الواجب هي الأساس، وليس المنفعة أو الفائدة من العمل الأخلاقي. فإذا عمل الإنسان عملًا طيبًا كالإحسان، فيتوجب أن يكون بعيدًا عن المنفعة، فحيثما استطاع فعله فهو الواجب.
فكانت فكرة الواجب العقلي، أو نظرية الواجب، مدخلًا لنقد الأخلاق اليونانية والمسيحية، فأخذ بتجاوز الآراء الفلسفية التي ترد الأخلاق إلى الطبيعة أو الفطرة أو الدين المسيحي، فقد أوضح في كتابه "تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق"[7] أنه يوجِّه عنايته إلى حكمة الأخلاق، وإعداد فلسفة أخلاقية خالصة، نقية نقاءً تامًّا من كل ما يمكن أن يكون تجريبيًّا، ومن كل ما يتصل بعلم الإنسان بسبب، ومن الفكرة المعتادة عن الواجب وعن القوانين الأخلاقية وقاعدة الإلزام وقاعدة السلوك العملي، وهذه الفلسفة الأخلاقية الخالصة أو ميتافيزيقا الأخلاق ضرورة لا غنى عنها، لا عن دافع من دوافع التأمل المجرد فحسب يستهدف البحث في مصدر القواعد الأخلاقية الموجودة في عقلنا وجودًا قبليًّا، بل لأن الأخلاق نفسها لا تفتأ تتعرض لألوان من الفساد لا حصر لها، ما بقيت مفتقرة إلى ذلك المقياس والمعيار الأعلى الذي لا بدَّ له أن يكون خيرًا من الناحية الأخلاقية، لا يكفي فيه أن يكون مطابقًا للقانون الخلقي، بل لا بدَّ له كذلك أن يحدث من أجله، وإلا كان هذا التطابق من قبيل الصدفة وكان تطابقًا فاسدًا. ذلك لأن القاعدة غير الأخلاقية قد تتولد عنها من حين إلى آخر أفعال مطابقة للقانون، ولكنها لا تنتج في أغلب الأحيان غير أفعال منافية للقانون الخلقي. أما والقانون الخلقي في نقائه وأصالته (وعلى هذين يعول في السلوك العملي) لا يمكن البحث عنه في غير فلسفة نقية خالصة، فلا بدَّ لهذه الميتافيزيقا أن تسبقه وتتقدَّم عليه، وبغيرها لن يقوم لفلسفة أخلاقية وجود، بل إن الفلسفة لا تستحقُّ أن تُسمَّى فلسفة (ذلك أن الفلسفة تتميز من المعرفة العقلية الشائعة بأنها تعرض ما تتصوره هذه مختلطًا على هيئة علم مستقل بذاته) ولا تستحقُّ حتى أن تُسمَّى فلسفة أخلاقية؛ لأنها بهذا الخلط إنما تفسد نقاء الأخلاق وتتعارض مع الهدف الذي تريد هي نفسها تحقيقه[8]. فيتبيَّن أنه يقصد من تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق البحث عن المبدأ الأعلى للأخلاق، وتثبيت دعائمه، متوسلًا بمنهج تحليلي وتركيبي للمعرفة الفلسفية، وبنقدٍ للعقل العملي الخالص. فالبحث عن مبدأ الإلزام لا يكمُن في الطبيعة الإنسانية أو الملابسات التي تكتنفها في التاريخ، بل يبحث عنه أولًا في تصورات العقل الخالص ذاتها، وكل ما يؤسس على مبادئ من محض التجربة لا يمكن أن يُسمَّى قانونًا أخلاقيًّا. إذ مجال المبادئ الأخلاقية هو الفلسفة الخالصة التي بدونها لن تتأسس ميتافيزيقا فلسفة الأخلاق. فالميتافيزيقا أساس الفلسفة الأخلاقية، باعتبارها منبع التصورات الخالصة التي لا صلة لها بالتجربة، وهي وحدها الملائمة للفلسفة الأخلاقية، وهذا يبدو مخالفًا للعقل في المجال النظري أو العقل الخالص الذي لا يعرف إلا ظواهر الأشياء لا ذاتيتها. ولهذا فميتافيزيقا الأخلاق لا تستند على دعائم خارجية، بل تستند على مبادئ قبلية غير خاضعة للتجربة والحِس. بل هي كامنة في الذات الإنسانية بمنطق إرادة الواجب. إن الانتقال من ميتافيزيقا الأخلاق إلى العقل العملي الخالص يقوم على كون تصور الحرية مفتاحًا لتفسير الاستقلال الذاتي للإرادة.
ويشكِّل مفهوم الحرية "حجر الغلق في بناء منظومة العقل المحض بكاملها، حتى التأملي، وكافة المفاهيم الأخرى (مفهوم الله والخلود) التي تبقى فيها مجرد أفكار من دون قوام، أما الآن فهي تتصل به وتنال معه وبه قوامًا وحقيقة موضوعية، أي إن إمكانيتها قد حصلت على برهان بأن الحرية هي حقيقية لأن الفكرة تتجلَّى عبر القانون الأخلاقي. لكن الحرية هي أيضًا الوحيدة من بين جميع أفكار العقل التأملي التي نعرف قبليًّا بإمكانيتها، ولكن من دون أن ندركها؛ لأنها شرط القانون الأخلاقي الذي لنا معرفة به. في حين أن فكرة الله والخلود ليست شروطًا للقانون الأخلاقي، بل هي شرط للموضوع العملي لعقلنا المحض، ومن هنا نحن لا نستطيع أن نؤكِّد بخصوص هذه الأفكار أننا نعرف وندرك، لست لأقول حقيقتها فحسب، بل حتى إمكانيتها أيضًا. إلا أنها مع ذلك شروط لتطبيق الإرادة المعينة أخلاقيًّا على موضوعها المعطى لها قبليًّا (الخير الأسمى). وينتج عن ذلك أنه يمكن أن تقبل إمكانيتها من الناحية العملية هذه من دون أن نعرفها وندركها نظريًّا"[9].
إن ربط الحرية بالإرادة في المبادئ العملية لأنها "قضايا تحتوي على تعيين عام للإرادة، تنضوي تحتها قواعد علمية كثيرة هي ذاتية أو مُسلَّمات، إذا اعتبر أن الشرط الذي هو من جانب الذات يصلح بالنسبة إلى إرادتها فقط، إلا أنها تكون موضوعية أو قوانين عملية إذا تمت معرفة ذلك الشرط على أنه صالح لإرادة كل كائن عامل"[10]، ويحتوي العقل المحض في ذاته على مبدأ عملي، أي كافٍ لتعيين الإرادة، وعندئذ توجد قوانين أخلاقية عملية. وعليه، ينظر إلى القانون الأخلاقي أنه المبدأ الوحيد الذي يجعل الخير الأسمى وتحقيقه والإعلاء من شأنه موضوعًا للإرادة. وربط الحرية بالإرادة يستتبعه ربط الإرادة بفكرة الواجب أو الفعل الأخلاقي، فالإنسان حين ينجز الفعل الأخلاقي فهو ينجز الواجب لذاته، من حيث هو كائن إنساني يراعي الإنسانية في ذاته، فيكون الإلزام مطلقًا وضروريًّا وقائمًا على الحرية. وهذا هو السبب الذي يجعل المعاملة الإنسانية غاية ومقصدًا وليست وسيلة، فالإنسان قيمة قطعية في ذاته. ولما كان مبدأ الواجب يستبعد كل خضوع لمعيار خارجي، فإن النيَّة لا تخضع إلا لقانونها الخاص، إنها مستقلة، "ولما كانت كل الكائنات العاملة تتبع نفس القانون الذي يلزم بمعاملة الكائن كغاية، فهي مرتبطة فيما بينها بقوانين موضوعية مشتركة، مما يؤسس لعهد الغايات. إذن، إن فكرة نيَّة كل كائن عاقل تسنُّ تشريعًا عامًّا، إن مملكة الغايات هي المثل الأعلى الذي يجب تحقيقه بوساطة الحرية"[11].
إن السؤال النقدي لدى كانط في تأسيسه لنظرية المعرفة وتأسيسه لميتافيزيقا الأخلاق قد أبرز أن الجمع بينهما جمع بين الوسيلة والغاية بقصد إمكانية الكشف عن عالم يمكن أن تُطبَّق فيه المبادئ الأخلاقية والدينية أيضًا، هذه الإمكانية التي غلق بابها العلم بقوانين الطبيعة وما يحكمها من البحث في العِلية والحتمية، أو ميتافيزيقا الطبيعة التي تقوم على التجربة، فلم يترك لحرية الفعل البشري أو الإرادة الإلهية وقانونها الأخلاقي مكانًا. فكان النقد الكانطي العقلاني العملي مؤسسًا لنظرية في الأخلاق على أنقاض العقل الخالص المجرد، وموضحًا أن المشكلة الأخلاقية هي مشكلة البدهيات العقلية التي هي تركيبية وقبلية شأنها شأن النظريات الرياضية والفيزيائية، وبالوصل بينهما وصل الجمع بين المعرفي والأخلاقي مداه في التأمل الفلسفي الخالص.
لقد كان السؤال النقدي لدى كانط ملهمًا لبروز اتجاهات نقدية للتطورات الأخلاقية في مسار سياق حداثي استفحلت فيه أنسنة ذات بُعْد أناني، وعقلنة مادية خاضعة لقوانين طبيعية حتمية، وتقنية أبعدت الإنسان عن إنسانيته، سياق معقَّد عرف تجاوزات وصلت إلى حالة من النسبية المفرطة التي ذابت في ظلها المعاني، وانتعشت فيها العبثية، وتفكَّكت الروابط الاجتماعية، وتوحَّشت الرأسمالية والليبرالية، وتضخَّمت المركزية، وتحوَّل وعد الأمان والحرية التي قطعته الحداثة الصلبة -بتعبير زيغمونت باومان- على نفسها بعيد المنال، بل تحوَّل إلى أسطورة تخفي وراءها السيطرة والهيمنة، ولم تعد قادرة على تحرير الإنسان. ولقد كان اتجاه مدرسة فرانكفورت مؤسسًا لنظرية نقدية، نشأت ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأنتج إنتاجات نقدية عديدة لما اعتقد أنه استغلال وقمع واغتراب تنطوي عليه الحضارة الغربية، وإليه يرجع فساد القانون الأخلاقي الذي حمله مفهوم الحرية وفكرة التقدُّم في المشروع التنويري في القرنين السابع عشر والثامن عشر.
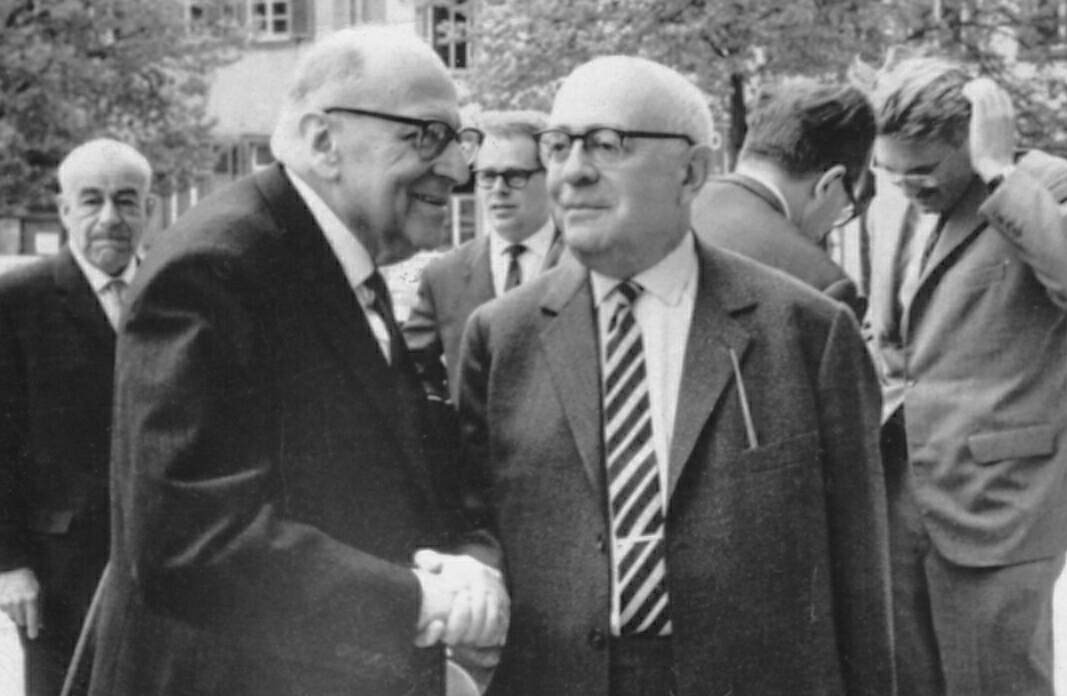
يمكن الحديث "حول بداية المشروع العلمي لمدرسة فرانكفورت مع نشأة معهد البحوث الاجتماعية الذي مارس نشاطه في بداية فبراير 1923م وافتتح رسميًّا في يونيو 1924م، وتكون حلقة فكرية أو حركة طلائعية عبر المنافسات الجماعية لمؤسسيه، ممن شكلوا إحدى فصائل الموجة الراديكالية، وعايشوا صعود اليسار الألماني وانتكاسته، وتشاركوا في همِّ رفض المشروع الثقافي الغربي، ورغبوا في القيام بنقد جذري لعصرهم"[12]. لقد جعلت تلك المنافسة من المدرسة ظاهرة مركَّبة، أخذت تسميات عديدة: "من مثل النظرية النقدية إشارة إلى مجموع أعضائها من المثقفين الألمان الذين اتخذوا من الفلسفة النقدية رؤية لهم، والماركسية الأوروبية تمييزًا لفكرها من التفسيرات التي قدمها منظرو الأممية الثانية والثالثة للماركسية، وفكرة الهجرة، ومدرسة فرانكفورت وهو الاسم الذي خلعوه عليها بعد عودتها من المهجر، إضافة إلى فندق الهاوية الكبير كما أطلق عليه جورج لوكاتش دلالة على تعدُّد الأُطر النظرية والمنهجية لدى مفكريها، ناهيك عن توالي أكثر من جيل بالمعنى الكرونولوجي، لممثليها، أهمهم من الجيل المؤسس: ماكس هوركايمر، وتيودور أدرنو، وفردريك بولوك، وهربرت ماركيوز، وإريك فروم، وفالتر بنيامين. ومن الجيل الثاني: ألفريد شميت، وكلاوس أوفي، ويورغان هابرماس، وأولبرخت فيلمر"[13]. وما قدَّمته المدرسة من أعمال تطرح اهتمامًا مشتركًا "تجسد في محاولة صوغ فلسفة نقدية بديلة، تقف بإزاء التيارات النظرية البورجوازية التي مارست ولم تزل صنوفًا من السلطة الفكرية، وهدفت إلى تقويض الفصل بين النظرية والممارسة"[14]. فارتسمت تلك الفلسفة النقدية نظرية نقدية غايتها التنظيم العقلاني للنشاط البشري الذي يتولى مهمة التنوير، واتجهت "إلى محاولة البرهنة على أن عقلانية المشروع الثقافي الغربي في جوانبه الثلاثة: كنتاج فلسفي نظري علمي، ونظم اجتماعية تاريخية، ونسق قيمي سلوكي، تؤلف جميعها أيديولوجيا شمولية متكاملة ومتماسكة تهدف إلى تبرير التسلُّط، وجعله عقيدة وحيدة تعطي أواليات القمع المتحققة كواقع مستمر يجمع مختلف فعاليات هذا المشروع"[15]. واقتضت مواجهة هذه الأيديولوجية منهجية حدَّدها المنظر الأول لمدرسة فرانكفورت هوركايمر من منطلق أن العقلانية كأيديولوجيا تستند إلى يقين معرفي محدَّد يجب التصدي له واكتشاف تهافته وتسلُّطه، وهو ما دعاه إلى اقتراح أربعة أسس للفلسفة النقدية: أولا: الكشف في كل نظرية عن المصلحة الاجتماعية التي ولدتها، عن طريق استخدام التحليل الناقد، من أجل النفاذ إلى أعماقها، في العلاقات الاجتماعية التي تتضمنها. وثانيًا: تأسيس فهم جدلي للذات الإنسانية. وثالثًا: أن تظل نظرية النقد على وعيٍ بكونها لا تمثِّل مذهبًا خارج التطور الاجتماعي التاريخي. ورابعًا: التصدي لمختلف الأشكال اللاعقلانية التي حاولت الطبقية السائدة أن تلبسها للعقل، وأن تؤسس اليقين على اعتبار أنها هي التي تجسده.
إن التحليل النقدي للعقل قد تأسَّس على أن العقل ذاته كان قد صاغ في ماضي قانونًا أخلاقيًّا، تمثَّل في نحو صياغة مفاهيم لها تجليات سلوكية في المجتمع، نحو العدالة والحرية والديمقراطية، لكن هذه المفاهيم في الفاعلية التاريخية الغربية، حلَّ بها الفساد في ظل هيمنة البورجوازية التي أدت إلى تحلُّل حقيقي للعقل. فكان ذلك التأسيس تعقلًا لاغتراب العقل بالذات، ونقدًا بليغًا للنزعة العلمية المغالية، نحو الوضعية التي أسَّسها أوغست كونت، وذهبت إلى أن "مهمة العلم هي الوصف الخالص للوقائع وليس تفسيرها، وادعاء الحياد وعدم التحيز، إضافة إلى وضع العلوم الاجتماعية على نفس مستوى العلوم الطبيعية في أساسها، واعتبارها تهدف إلى صوغ قوانين عليَّة عامَّة، وتقيم ادعاءاتها على المعرفة الصادقة، وعلى تحليل الواقع الإمبريقي، وليس على الحدس الفلسفي"[16]، فتوجَّه النقد لهذه التصورات الوضعية، حيث انتقدها أدورنو "لعجزها عن اكتشاف المصلحة الذاتية التي قد تُسهم في تحقيق تقدُّم موضوعي، بسبب القصور الكامن في أسسها المنهجية، وفشلها في إقامة صلة قوية بين المعرفة من ناحية والعمليات الاجتماعية الحقيقية من ناحية أخرى"[17]. ولعل الأهم في سؤال الأخلاق أن مهاجمة مفكري فرانكفورت كشفت "سعي الوضعية إلى تحقيق المعرفة العلمية وتكميم الحقائق، بما يؤدي إلى ضياع المعنى الجوهري للظواهر الاجتماعية، وأنه ارتباطًا بذلك فقد أدى تمثل الوضعية لنموذج العلم الطبيعي في علم الاجتماع إلى فصل المعرفة عن بعدها الأخلاقي، وهو ما يعني استبعاد الموقف الأخلاقي للباحث، عن طريق الادعاء بأن علم الاجتماع هو علم متحرر من القيمة، وهو ما يعني أيضًا أن هذا العلم يمكن أن يكون أداتيًّا بالنسبة للقوى الاجتماعية المتسلطة، أو هو وسيلة للتحكُّم والهيمنة كما حدث في الرأسمالية المتقدمة" [18].
إن معارضة مدرسة النظرية النقدية للاتجاه الوضعي الذي رسخ في الاجتماع الغربي الحداثي وما بعده نمطًا من التفكير العقلاني الأداتي المشتغل على الإيمان بالعلم نزعة نهائية، شكَّلت مسوغًا معرفيًّا لتأسيس سؤال النقد الأخلاقي من أجل الابتعاد عن الفكر المعياري الصوري الذي يختزل العقلية العلمية في معايير منطقية صمَّاء صارت بها الأخلاق مجرَّد علم من علوم الطبيعة أو الاجتماع. ولعل النقدية الأخلاقية عند مدرسة فرانكفورت لم تبقَ في حدود تحليل قصور الوضعية عن فهم العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ، انطلاقًا من أن علم الاجتماع الوضعي لا يأخذ في اعتباره التحولات التاريخية في تشكيل المجتمعات، بل ستعرف مع هابرماس منطلقات أخرى تبرز أهمية الفعل التواصلي باعتبار الإنسان كائنًا تاريخيًّا (سنتناوله في المحور القادم).
لقد كان الانطلاق من مقولة الكائن الظاهرة مقابل طغيان الوضعية التي آلت فيها الأخلاق إلى خاصية طبيعية، رؤية للاتجاه الظاهراتي الذي عرف مع إدموند هوسرل (1859-1938م) منهجًا جديدًا للفلسفة يدرس بنى الوعي والظواهر كما تتبدى للوعي، ويعود إلى الواقع لإدراك الظواهر كما هي في جوهرها، عودة إلى المباشر، لكنه مباشر مُتحرّر من مفاهيم ونظريات يعتقد أنها طبيعية. فكان التحليل النقدي الظاهراتي للوضعية منطلقًا لنهضة في علم الأخلاق فتحت أبعادًا جديدة أبان عنها من منظور الفلسفة العملية مفكرون أخلاقيون منهم:
ماكس شيلر (1874-1928م) مؤسس مذهب الشخصانية الحديثة وصاحب فلسفة القيم الحازمة وأنماط المشاركة الوجدانية. ومارتن بوبر (1878-1965م) الذي أوضح مسؤولية كل إنسان في التعامل مع الآخر. وحنة أرندت (1906-1975م) التي أثبتت أهمية الولادة بمثابة ظهور فردي إنساني حُر وسط تاريخ غير متوقع بطبيعته. وهانز جوناس (1903-1993م) الذي جعل من المسؤولية مبدأ، وطوَّر علم أخلاق المستقبل، ردًّا على البروميثيوسية الثائرة التي تمثل الشكل الأكثر تهديدًا لمذهب التحسينية (méliorisme) الذي يتلخص باستبدال الخير الأخلاقي بالأفضل من الخير مما يتطلب تغييرًا في الإنسان. وإيمانويل ليفانيس (1906-1995م) الذي انطلق من الكشف عمَّا اعتبره غموض قانون الأخلاق لدى كانط، فابتدأ بتفحص للأخلاقيات الصافية-الخالصة البدائية، المرتجلة، والخارجة عن النطاق، لم تلوثها المنتجات الاجتماعية المعاد تدويرها ولم تدنسها الخلطات غير الشرعية، غير المتجانسة العرضية، والتي يمكن التخلُّص منها، وكذلك للدلالة الصافية للأخلاق (القصدية كما لا بدَّ أن تكون كل الدلالات الصافية لدى هوسرل) التي تجعل كل الدلالات المنسوبة قابلة للتصور بينما تسائلها وتطالبها بالتبرير، هذه الرحلة الاستكشافية قادت لفيناس في تعارض صارخ مع هوسرل ليس إلى ذاتية متعالية، وإنما إلى الآخرية المتعالية للآخر، الآخرية التي لا يمكن قهرها أو اختراقها[19].
عمل ليفي بروهل (1857-1939م) على فصل الأخلاق عن الميتافيزيقا بردها إلى تجربة خليقة بإعطاء قواعد موضوعية للسلوك، فيرى أن الأخلاق لدى البدائيين والمتمدنين طبيعية، كما هي في الاتجاه الوضعي، وتخضع لفعل التطور بتغيُّر العوامل الاجتماعية، وفائدة علم الأخلاق أنه يسمح لنا بتكوين فن خُلقي، أي جملة من القواعد المتبعة التي ليس لها صفة الإلزام ودون أن يكون للفعل الإنساني قيمة ذاتية يعبّر عنها بالخير والشر. كما أن جزءًا من هذا الفن الخلقي يطلق عليه ليفي بروهل ما بعد الأخلاق (méta- éthique)[20]، ويتضمَّن البحث في كل متعالٍ عن الحقيقة الأخلاقية الواقعية، وفي كل ما هو ضروري لاتصاف هذه الحقيقة بالمعقولية. فما بعد الأخلاق جزء من علم الأخلاق يُعنى بالمُثُل والمبادئ العامة التي تسمو على الأفعال الأخلاقية الوضعية تشبيهًا لها بالميتافيزيقا.
إن ما بعد الأخلاقية لا ترتبط بالوضعية في شكلها المنطقي الصوري، بل بالوضعية المنطقية الجديدة التي تعتمد الفلسفة التحليلية، ومن مفكريها لودفيغ فيتجنشتاين (الرسالة المنطقية الفلسفية) وفلاسفة حلقة فيينا ومنهم ألفرد آير ورودولف كارناب وتشارلز موريس، فهي -أي ما بعد الأخلاقية- مندرجة ضمن الوضعية الجديدة، التي تعتمد التحليل اللغوي للغة الأخلاقية ومنطقية اللغة الأخلاقية، أو فهم الأخلاق الماورائي التحليلي من منطلق رفض القضايا الميتافيزيقية؛ لأنها خارج القضايا التحليلية القبلية (كقضايا العلوم الرياضية) والقضايا التركيبية (العلوم الطبيعية والتجريبية). وقد اتشرت في إنجلترا وأمريكا، متجاوزة البحث في الأخلاق المعيارية والأخلاق التطبيقية إلى الاهتمام باللغة الأخلاقية، أي من جهة الاهتمام مثلًا بمدلول كلمة الأحسن ولا تهتمُّ بما هو أحسن، وكذلك بالنسبة للخير والعدل والصدق... فهي تُعنى بتحليل المفردات الأخلاقية والعلاقة المنطقية بينها وبين الأخلاق المعيارية، لتقدِّم التحليل اللغوي على المضمون الأخلاقي المعياري، بقصد إظهار الفرق بين المعنى واللامعنى، المعاني بنية لغوية فارغة من القيمة الأخلاقية والسلوك الأخلاقي، ليتسنَّى نقد المعايير والمفاهيم الأخلاقية كما أبرزها عصر التنوير أو مشروع كانط فيما يخص مثلًا الواجب والحرية والإرادة. وهو ما يبدو تغليب الرؤية الوضعية التجريبية التي أسهمت في إدخال العقلانية إلى مآزق قيمية أبرزها نقد ما بعد الحداثة.
ويبرز هابرماس نموذج التفاهم بكونه اتجاهًا أدائيًّا يتبناه الذين "يشتركون في تعامل، الذين ينسقون مشاريعهم بالاتفاق فيما بينهم على أمر ما موجود في العالم. أنا Ego) ( بقيامي بالكلام، والآخر (Alter) -الذي يتخذ موقفًا إزاء هذا العمل الكلامي- يعقدان الواحد مع الآخر علاقة بين شخصية (relation interpersonnel) تستجيب هذه العلاقة لبنية تتعرف من خلال النظام الذي تشكله، في تلاقيهما المتبادل منظورات المتحدثين، والمستمعين والأشخاص الحاضرين الذين لم يشتركوا في عملية التبادل، يقابل هذا النظام، النظام القائم على قواعد ضمير الفاعل.
لقد كان في فلسفة النهضة والحداثة -كما يرى تودوروف- طموحٌ نحو العقلانية الكونية والكرم الإنساني والعطاء والوفاق بين الشعوب، وكان هذا الطموح أو هذه الرغبة شيئًا عظيمًا بالفعل، ولكنه للأسف لم يبلغ مداه ولم يدُم طويلًا؛ إذ سرعان ما انكشفت هذه العقلانية الكونية عن عرقية مركزية أوروبية، ثم بدت عمياء ولا مبالية إزاء انتقادات كثيرة جادة وقوية كانت قد صيغت في القرن التاسع عشر ضد أوهام عصر التنوير من قِبَل مفكرين كبار، هؤلاء المفكرون يُسمون ماركس ونيتشه....[21] يشير هذا إلى سؤال النقد عمومًا والنقد الأخلاقي الذي اتجه إلى تبيين ضرورة معالجة مشكلة العقلانية الغربية، وغياب معرفة التواصل في الأخلاقية الذاتية الاستعلائية، ولعل من أقوى نماذج البحث في هذه المعرفة التواصلية النقدية يورغان هابرماس.
المحور الثاني: قراءة في نظرية التواصل الهبرماسية ونقد الإرث النقدي الأخلاقي الكانطي: من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل
يتحدَّد سؤال النقد الأخلاقي عند هابرماس في خروجه من فلسفة الوعي، التي تهتمُّ بالفعل الغائي إلى العناية بقضايا الفعل التواصلي بين الذوات، فعمل على تأسيس نظرية الفعل التواصلي من أجل الانتقال من عقل متمركز على الذات، إلى عقل تواصلي يسهل عملية تجاوز فلسفة الذات التي لها صلة بالعقلانية الأداتية، إلى قيام مجتمع على مفهوم جديد للعقلانية التواصلية. والجدَّة تتوضح من إرادته تجاوز الفلسفة الكانطية ونقدها للعقل، الذي يراه قد أخذ شكل تحديد ذاتي بشكل صارم، ولذا يقول: "لا بدَّ من أجل منحه درجة تكاليف تكوين العقل الذي يضع بنفسه حدوده الخاصة وينفصل عن الميتافيزيقا، لا بدَّ من حيازة مفهوم عقل يتجاوز أفقه الحدود التي وضعها كانط، مفهوم يمكن للقول المتعالي الذي يزعم وضع هذه الدرجة الاعتزاز به. كيما يكون نقد العقل أكثر جذريةً عليه وضع مفهوم أوسع مفهوم شامل للعقل"[22].

ويقصد بالعقلانية "الاستعداد الذي تبرهن عليه ذوات قادرة على الكلام والعمل وعلى اكتساب وتطبيق معرفة قابلة للخطأ"[23]. وما دامت مقولات فلسفة الوعي تفرض المعرفة، بوصفها حصرًا معرفة تخصُّ أمرًا ما موجودًا في العالم الموضوعي، فإن العقلانية تقيس نفسها بأسلوب الذات المنعزلة، وهي تتوجه وفقًا لمضمون أفكارها وعباراتها، يعثر العقل المتمركز على الذات على معاييره العقلانية انطلاقًا من محكي الحقيقة والنجاح بوصفهما ينظمان العلاقات، التي تعقدها ذاتٌ عارفة وعاملة مع عالم أشياء ممكنة أو محتملة، أو أحوال شيء وفقًا لغاية ما. وفي المقابل، منذ اللحظة التي نتصور فيها المعرفة بوصفها معرفة يتوسطها التواصل، عندئذ نقيس المعرفة نفسها بملكة يمتلكها أشخاص يتصفون بالمسؤولية ويشاركون في تفاعل، توجههم وفقًا لمطالب مصداقية تستند إلى اعتراف متبادل بين الذوات. يحدِّد العقل التواصلي محكات العقلانية وفقًا لإجراءات قائمة على الحجة ترمي إلى تكريم مباشر أو غير مباشر، للتطلُّع إلى الحقيقة القائمة على الحكم، والدقة المعيارية، والصدق الذاتي وأخيرًا التماسك الجمالي[24]، ويستخلص أن مفهوم العقلانية التي يقدمها الحجاج التواصلي لا يقتصر على دمج البُعْد العلمي والأخلاقي، بل أيضًا على البُعْد الجمالي والتعبيري، وأنه أغنى من المفهوم الذي تقدمه العقلانية الغائية المفصلة على البعد الأداتي والمعرفي. مؤكدًا هذا الغنى بتناوله تحليل عقلانية الفعل والعقلانية الاجتماعية ثم نقد العقل الوظيفي[25]. فهي نظرية إلى بناء نموذج للتفاهم بين الفاعلين للتواصل بواسطة التحليل اللغوي الدلالي والتركيبي والتداولي، فاللغة محور العقلانية التواصلية التي تتشكَّل من ثلاث علاقات: علاقة الذات العارفة بعالم الأحداث والوقائع، وعلاقة الذات بعالم اجتماعي متميز بالفاعلية، وعلاقة الذات الفاعلة للتواصل مع الذوات الأخرى. فبهذه العلاقات يتأسس نموذج التفاهم الذي تعود الذات العارفة إلى أدائها كما تعود إلى الأشياء المادية الموجودة في العالم. ويبرز هابرماس نموذج التفاهم بكونه اتجاهًا أدائيًّا يتبناه الذين "يشتركون في تعامل، الذين ينسقون مشاريعهم بالاتفاق فيما بينهم على أمر ما موجود في العالم. أنا Ego) ( بقيامي بالكلام، والآخر (Alter) -الذي يتخذ موقفًا إزاء هذا العمل الكلامي- يعقدان الواحد مع الآخر علاقة بين شخصية (relation interpersonnel) تستجيب هذه العلاقة لبنية تتعرف من خلال النظام الذي تشكله، في تلاقيهما المتبادل منظورات المتحدثين، والمستمعين والأشخاص الحاضرين الذين لم يشتركوا في عملية التبادل، يقابل هذا النظام، النظام القائم على قواعد ضمير الفاعل. إن أي شخص يستعمل هذا النظام يعرف كيف يتبنى منظورات ضمير المتكلم وضمير المخاطب وكيف يحولها الواحدة ضمن الأخرى في اتجاه ذاتي"[26]. وهذا التبادل يتوسطه اللسان "فالتفكر الذي يتم انطلاقًا من منظور المشارك يفلت من نمط الموضعة الذي يمتنع تجنبه انطلاقًا من منظور الملاحظ المقلوب بالتفكُّر، وتحت نظرة الشخص الثالث، أكانت هذه النظرة متجهة إلى الخارج أو إلى الداخل، يتجمد كل شيء في موضوع، الشخص الأول في ضمير المتكلم الذي في موقف أدائي، يخضع لنظرته الخاصة باتخاذه مكان الشخص الثاني المخاطَب، يمكنه من جراء ذلك إعادة بناء زاوية أخرى لأسلوب أفعاله التي تم أداؤها بشكل مباشر، وهكذا نحصل مكان معرفة مموضعة بالتفكُّر -بتعبير آخر مكان وعي الذات- على بنيان يسمح بإعادة بناء معرفة ما برحت قيد الاستعمال من زوايا أخرى"[27]. وبهذا ما كان راجعًا إلى الفلسفة المتعالية أو إلى التحليل الحدسي لوعي الذات، يتم إدماجه في دائرة العلوم التي تعمل على إعادة بناء العلوم بتعبير آخر، مما يسمح بدمج إعادة البناء والنقد الذاتي بنظرية واحدة، وهي نظرية التواصل، والفاعلية التواصلية هي إتيقا المناقشة التي تصور الممارسة العقلانية بمثابة عقل صار عيانيًّا داخل التاريخ والمجتمع في البدن وفي اللسان. يقول هابرماس إنها "تقوم بشرح المضمون المعرفي الإدراكي لمنطوقاتنا الأخلاقية دون الرجوع إلى انتظام أخلاقي بديهي ومعروف مشكل من وقائع أخلاقية يمكنها أن تكون في متناول الوصف؛ لذا فإنه لا ينبغي الخلط بين المنطوقات الأخلاقية التي تبين لنا ما ينبغي علينا فعله، وبين المنطوقات الوصفية التي تنحصر مهمتها في تبيان الطريقة التي نرى بموجبها الأشياء كما تبدو في علاقتها المتشابكة، فالعقل العملي في النهاية هو مَلَكة للمعرفة الإدراكية الأخلاقية دون تمثلات. هكذا، وانطلاقًا من تصور مقالي للحقيقة، فقد كان من اليسر بمكان تأويل صحة المعايير والأحكام الأخلاقية وكأنها معرفة مماثلة لكن دون أدنى تبني للتدخلات الواقعية التي عادة ما تكون ملازمة للمعرفة الحقيقية هذا من جهة، من جهة أخرى أعتقد أن الانطلاق أيضًا من تصور إبستيمي للحقيقة شعاره لنكن على توافق دائم مع الوقائع، مع ذلك فإنه ومن منطلق مراجعتي للمفهوم المقالي للحقيقة، توصلت إلى ضرورة أن أهتم مرة أخرى بمشكلة الحقيقة الأخلاقية"[28]. وذلك من خلال تأكيده أن التداولية الكانطية تعود إلى واقعية دون تمثلات، وهو ما يبيِّن اللاتناسق بين مفهوم الصحة أو الصواب الأخلاقي الذي يفسره بالصيغة الإبيستيمية للتربية المثالية، وبين المفهوم غير الإبستيمي للحقيقة الذي بقي مرتبطًا بالافتراضات الأنطولوجية للعالم الموضوعي. ليستخلص أن المعايير الصالحة لا توجد أصلًا، وما يوجد فقط هو ذلك الشكل الذي يمكن من خلاله القول إنها تتميز بالصلاحية، من حيث إنها "معيار من المعايير الأخلاقية، يفيد بأن هذه الأخيرة تستحق اعترافًا شاملًا، وذلك لجهة قدرتها على ربط المشمولين بهذه المعايير بطريقة عقلية، فعالم الأخلاق الذي نسعى لتحقيقه تبعًا لصفتنا الأخلاقية يمتلك دلالة بنائية. لهذا السبب بالذات فإن أي إسقاط لعالم اجتماعي متضمن ومكون من علاقات بين شخصية منظمة تنظيمًا جيدًا، فاسمها المشترك الحرية والمساواة -ترجمة لمملكة الغايات كما تصورها كانط- يمكن استخدامه كبديل للمرجعية الأنطولوجية للعالم الموضوعي"[29]. وفي هذا إيضاح لضرورة التفاهم والتواصل في جانبه العملي الإجرائي التاريخي، لكي لا تعرف الأحكام الأخلاقية والمعايير الأخلاقية إخفاقًا أو اعتراضًا، فتصير إتيقا المناقشة متنفسًا للاعتراض، وبها يمكن "للأطراف المتنازعة الوصول إلى زحزحة ذواتهم الخاصة عن مراكزها -أو إلى آفاق خلاصتها تمركز إثني أو عرقي (ethnocentrique)- بطريقة تجعلهم ينضوون تباعًا في عملية بناء مشتركة لعالم موسع من العلاقات البين شخصية المشروعة، فإتيقا المناقشة تود بالفعل أن تثبت بأن الديناميكية المحصلة مبنية على أساس من البحث المتبادل الموجه لتبني رؤية الآخر، ومن ثمة إدماجها داخل الافتراضات التداولية للمناقشة العملية ذاتها"[30].
إن محور إتيقا المناقشة هو الأفعال التواصلية، التي تكون فيها مستويات الفعل بالنسبة إلى الفاعلين المشاركين في العملية التوصلية غير مرتبطة بحاجيات تخصُّ السلطة السياسية وحاجياتها، وغير متعلقة بالبحث عن الوسائل التي تمكِّن من التأثير في الغير، بل القصدية فيها متجهة للبحث عن كيفية التوصل إلى تفاهم وتوافق متبادل دونما إكراه، ولا تفاهم إلا بإدراك الوسيط وهو اللغة من أجل فهم العلاقات التواصلية، وهنا كان لدى هابرماس حضور التداولية في اللغة لفتنجشتين وأوستين، حضورًا حقق به إنجاز نظرية التواصل. وقد اتخذ ذلك الإدراك عناية فائقة بالرؤى التأويلية القائمة على الدراسات اللغوية التحليلية، القائمة على فهم عميق لفلسفة اللغة، وأفعال الكلام، وللأبعاد الاجتماعية والحضارية، وللقيم والأخلاق والمصالح التي لها صلة ببناء التاريخ للأعراف والثقافات. فهذه الرؤى التأويلية هي -في الواقع- سبب يجعل التفكير الذاتي مهما تكن ميزاته فكرًا متفتحًا على البدهيات المساعدة على تحقيق ما يسميه هابرماس مبدأ الإجماع، الذي في غيابه يفشل التفاهم ويتقوى سوء الفهم. فالإجماع العقلاني لا يتحقق إلا بتحاجج وتناظر موصل لفعل تواصلي كامل وقوي، وتفاهم عملي واقعي بين أفراد الجماعة التواصلية بخصوص قضايا معينة. ويشكِّل هذا أحد تجليات الفعل الكلامي.
لقد كانت إتيقا المناقشة سؤالًا نقديًّا في الأخلاق لا في بُعده الذاتي المعياري والميتافيزيقي، بل في بُعده التواصلي الذي يبحث في المناهج الإجرائية التي تمكِّن الذوات المتفاعلة فيما بينها من التواصل عبر صياغة معايير أخلاقية من أجل التفاهم في القضايا السياسية والاجتماعية، فليس المراد حصرها في تأسيس مجتمع مدني يستوعب التعدُّد، بل في مجتمع إجماعي كوني. وتكفل هذه المعايير الأخلاقية توليد توازن دولي يدعم تحقيق مصالح المجتمعات وتنميتها. فتتحدَّد أخلاقيات النقاش بكونها أخلاق المسؤولية التي في نظر هابرماس تكون بديلًا للأخلاقيات التقليدية، فإذا كان الفعل الكلامي التواصلي يحقق التواصل والتفاهم، فإن أخلاق المسؤولية تفتح أفق المشاركة للجميع ليتحمل مسؤوليته التاريخية في تجاوز تحديات العالم ومشكلات الإنسان المعاصر.
تبدو أخلاقيات التواصل في نظرية التواصل الهبرماسي مكتملة الأركان في مقاربة أزمة التداولية الكانطية وأزمة الوضعية القديمة والوضعية المنطقية الجديدة[31]، لكن التحليل العميق لها قد يجدها تصورًا مثاليًّا لمجتمع يسود فيه نظر لغوي سديد، يستبعد النقص المعتبر في أي عملية لإنتاج المعنى في التاريخ، كما يدفع التمايز الواقعي والمثالي في عملية التواصل. وهذا مدخل لنقد أخلاقيات التواصل، يمكن الإشارة فيه إلى الآتي:
انتقد فرنسوا ليوطار مفهوم الإجماع الذي جعله هابرماس مفهومًا أساسيًّا في النظرية التواصلية، بناءً على أن جوهر الأمور هو الاختلاف والنزاع، ولا إبداع دونهما، وملاحظًا أن هابرماس يدافع عن مشروع الحداثة الذي أسَّسه الفكر الحداثي وقبله فكر النهضة. ويرى ليوطار -باعتباره متكلمًا عما بعد الحداثة- أن الحداثة خطاب متجاوز؛ ولذا فإن كل محاولة لرد الاعتبار إليه محاولة غير موفقة، ومذكرًا بكون الاختلاف والتعدُّد محركًا للتطور والإبداع، وليس الإجماع الذي لا توجد شروط تحققه في السياسة والاجتماع.
كيف يشكل مبدأ الكونية معيارًا في أخلاقيات التواصل، دون تحقيق مرجعية موحدة تضمن استيفاء المعايير والقوانين شروط تحققها في الواقع التاريخي الزاخر بالتناقضات العقدية والمصلحية؟
لقد اجتهد هابرماس في بناء أصول معرفية لنظرية التواصل قائمة على فلسفة للغة، وعلى نقد فلسفة الوعي الذاتي لدى الاتجاهات الفلسفية في الحداثة، لكن ذلك البناء لم يصل إلى التكاملية المعرفية عندما وقف في إتيقا المناقشة على الحالة المثالية للكلام. وهذا ما يجعله في اعتقاد المعترضين بناءً مثاليًّا، باعتبار الإطار النظري متضمنًا لشروط بعيدة كل البُعْد عن التفاعل اللغوي بين الذوات. ولهذا فليس بوسع مبادئ إتيقا الأخلاق إيجاد تعليل منطقي لصلاحية المعايير عبر طريق البرهان، بحيث يتم العمل على فحص صحة فاعلية أخلاقيات المناقشة بإخضاع قدرتها على التعليل للتمحيص.
وعلى الرغم من الاعتراضات القوية على نظرية التواصل الهبرماسية، فإنها تبقى محافظة على قوة سؤال النقدي الأخلاقي -أولًا- في علاقة الوعي الأخلاقي بالفعل التواصلي والخطاب الفلسفي للحداثة والمعرفة والمصلحة، وثانيًا: في نقد النزعة الوضعانية العلموية ثم الفلسفة المطلقة والأخلاق المعيارية العقلانية، وأن هذه القوة النقدية التي تمتلكها نظرية التواصل تمكِّننا من البحث في تداخلات وتقاطعات منهجية وإجرائية مع ما نقصد بيانه في نظرية التعارف الأخلاقي والتأسيس المقاصدي الائتماني لها، في أفق مقاربة إنسانية لأخلاق كونية تفاعلية وتواصلية وتقصيدية لتحقيق السلام العالمي، القائم على مبدأ تحاور الحضارات وتفاعلها، لا على فلسفة الصراع وتصادم الحضارات ونهاية التاريخ، وعلى مبدأ منطق الأخلاق العملية المنشئ لثقافة التكامل المعرفي وتعايش الثقافات لإدارة التعارف العالمي والاعتراف الإنساني، وعلى مبدأ عقلانية تواصلية نقدية إجرائية مندمجة في العالم المعيش، تعمل على تحرير الإنسان وتحرير محيطه من كل تقنية غايتها تشييء الإنسان وإفراغه من المعنى الأخلاقي القويم.
فنجد الجابري قد عمل على تحليل المسألة الأخلاقية في التراث العربي معيدًا سؤال: أيهما أساس الأخلاق العقل أم النقل؟ ثم على تحليل نظم القيم في الثقافة العربية، فبيَّن نظام الموروث الفارسي وأخلاق الطاعة، ونظام الموروث اليوناني وأخلاق السعادة، ونظام الموروث الصوفي وأخلاق الفناء وفناء الأخلاق، ونظام الموروث الإسلامي من أجل أخلاق إسلامية، مثبتًا فرضية شبه فارغة في مجال التأريخ للفكر الأخلاقي في الإسلام[42]. بينما طه عبد الرحمن يحلل في كتبه -وخصوصًا "سؤال الأخلاق"- أن مجال علم الأخلاق ليس العلوم الإنسانية التي لم تنضبط مفاهيمها كما انضبطت مفاهيم العلوم الطبيعية[43]، بكونها مجالًا معنويًّا لا يمكن ضبطه بالملاحظة والتجريب، بل مجاله هو الدين الذي يؤطرها بالتكامل بين عناصر الإنسان والغيب والمعنى.
المحور الثالث: نظرية التعارف الأخلاقي والتأسيس الائتماني لأخلاق الكائن الفاعل
لعله من النظر العلمي أن يتحدَّد مفهوم النظرية قبل ربطها بالتعارف والأخلاق؛ ولهذا سيتم اعتماد كونها نسقًا فكريًّا استنباطيًّا متسقًا حول ظاهرة أو مجموعة من الظاهرات المتجانسة، ويضمُّ هذا النسق إطارًا تصوريًّا ومفهومات وقضايا نظرية، توضح العلاقات بين الوقائع وتنظيمها، بطريقة دالَّة وذات معنى، كما أنها ذات بُعْد إمبريقي، بمعنى اعتمادها على الواقع ومعطياته، وذات توجيه تنبؤي يساعد على تفهم مستقبل الظاهرة ولو من خلال تعميمات احتمالية[32]. ومن شأن اعتماد هذا التحديد أن يكشف هوية التعارفية الأخلاقية، ويساعد على تحديد أبعادها وعلاقاتها وتنظيم معطياتها وما يجمعها من ارتباطات وتداخلات.
إن قضية التأسيس للتعارفية الأخلاقية لا تقف عند حدود مرجعية الفلسفة المطلقة أو الوضعانية بكل تشكلاتها، التي مركزها وجوهرها العقلانية المجردة الأداتية، ووصف ما عدا ما اعتبرته علمًا بالميتافيزييقا غير القابلة للتحليل العلمي أو قطعية العلم التجريبي، وأسطرة كل التصورات التي تخالفها وخصوصًا الدينية، واعتبار هيمنة السببية والحتمية، وإلغاء كل مذهب للعقل ومنتج للفكر والمعرفة، يعتبر منطقيًّا في إمكان الوقوع والحدوث في العالم...، بل إن قضية التعارفية الأخلاقية ظاهرة متعدِّدة التشكُّل من عقل الدين ودين العقل، وعليه لا يمكن القول إن الدين لا عقل فيه والعقل لا وحي فيه[33]، وهذا ما نستكشفه في خطابية الوحي القرآني ونصيته، التي يحكمها التناسب البرهاني في متعلقات الكائن الإنساني الوجودية، باعتباره ظاهرة وجودية تستدعي الملاحظة والاستقراء والتحليل، وينتظمها الفعل الأخلاقي عبر مسارات مختلفة، ملؤها الروح والعقل والحس، بعيدًا عن مغالاة نزعات العقل والحس في انغلاقها الكلي على ذاتها من جهة، أو انفتاحها المشروط على الروح والغيب من جهة أخرى. وبعيدًا أيضًا عن المساءلة الإبستيمولوجية النقدية التي لم تعُد تكتفي من البحث في ماهية كل من العلم والمعرفة أو البحث في الأسس الاجتماعية أو الثقافية للعلوم، بل صارت تعتني بنظرية المعرفة والبحث الميثودولوجي والبنية المنطقية للعلوم[34].
وبتحديد الأخلاقية في المركَّب الإضافي التعارفية الأخلاقية، سيتشكَّل إطار معرفي للتعارفية أيضًا. وسيتم هذا التحديد من منظورين تأسيسيَّيْن: المنظور الفلسفي والمنظور القرآني.
ففي المنظور الأول، ارتبط الخلق بإيتوس الإغريقية ومعناه العادة، والعادة لها صلة بالطبع[35]، وعلى هذا جاء تعريف الخلق عند ابن مسكويه، فقال: "الخلق حال النفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًّا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب... ومنها ما يكون مستفادًا بالعادة والتدريب، وربما كان مبدؤه الفكر، ثم يستمر عليه أولًا فأولًا حتى يصير ملكة وخلقًا"[36]، ويستدل على هذا برأي الرواقيين وجالينوس وأرسطو[37]. وقد تابعه في هذا التعريف أبو حامد الغزالي، فقال: "هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويُسْر من غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعًا سُميت تلك الهيئة خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سُميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا"[38].
فالخلق بحسبهما ليس عبارة عن الفعل أو القدرة عليه أو المعرفة به، بل هو الهيئة التي بها تستعدُّ النفس لأن يصدر منها الخلق الحسن أو السيئ. وعلى الرغم من ربط الخلق بقوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل تحت إشارة العقل والشرع، ومن هذه القوى تستخلص أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل[39]، فإنه يظهر في التعريفين نقل معنى الخلق في الفلسفة اليونانية، باعتباره قضية طبع أو عادة تصدر عنها أفعال الخير أو الشر[40]. وهو معنى عقلاني مؤسَّس على الممارسة الاستدلالية عند اليونان، فيكون التعريف للخلق متعلقًا بطريقة الفلاسفة التي تتبع استنباط الأحكام من المقدمات إلى النتائج بمقتضى قواعد عقلية محضة، فالمنطلق هو العقل والنتيجة هي ذاتها، وهي طريقة إن اعتمدت في تحديد التعارفية فسيتم توجيهها نحو التعارفية العقلانية الاستدلالية في بُعدها الحسي المادي الذي سيعرف مع الفلسفة المطلقة الغربية تطورات مذهبية في إقصاء أي متعلق له صلة بالدين، الذي صار بدوره محددًا بالسوسيولوجيا الوضعية والإبستيمولوجيا المؤسسة عليها في النظر لمفهوم العلم والمعرفة[41]. وستؤول هذه التعارفية إلى أزمة أخلاق إنسان الداروينية الذي يجد أخلاقه في تطور التغيرات البيولوجية، وإنسان إرادة القوة الذي لا يعرف إلا القوة الطاغية وتمجيد الجسد والشكلانية الفنية، وإنسان الدوافع اللاواعية المترسبة في بنية عقلية منشطرة، وإنسان الثقافة السائلة الذي تشيأ فيها الإنسان وصار قيمة استهلاكية ومتعة نرجسية.
ولعل مجهود محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن يندرج ضمن المهتمين بالأخلاق من المنظور الفلسفي، لكن الأول بقي محافظًا على الاستشكال الفلسفي في بناء العقل الأخلاقي، بينما الثاني عمل على تصحيحه فجعل الجمع بين الأخلاق والدين أصل الأصول. فنجد الجابري قد عمل على تحليل المسألة الأخلاقية في التراث العربي معيدًا سؤال: أيهما أساس الأخلاق العقل أم النقل؟ ثم على تحليل نظم القيم في الثقافة العربية، فبيَّن نظام الموروث الفارسي وأخلاق الطاعة، ونظام الموروث اليوناني وأخلاق السعادة، ونظام الموروث الصوفي وأخلاق الفناء وفناء الأخلاق، ونظام الموروث الإسلامي من أجل أخلاق إسلامية، مثبتًا فرضية شبه فارغة في مجال التأريخ للفكر الأخلاقي في الإسلام[42]. بينما طه عبد الرحمن يحلل في كتبه -وخصوصًا "سؤال الأخلاق"- أن مجال علم الأخلاق ليس العلوم الإنسانية التي لم تنضبط مفاهيمها كما انضبطت مفاهيم العلوم الطبيعية[43]، بكونها مجالًا معنويًّا لا يمكن ضبطه بالملاحظة والتجريب، بل مجاله هو الدين الذي يؤطرها بالتكامل بين عناصر الإنسان والغيب والمعنى، فجعل الجمع بين الأخلاق والدين أصل الأصول لسؤال الأخلاق النقدي للحداثة الغربية وما بعدها، مبينًا حدود العقلانية المجردة، وكشف أهمية العقلانية المسدَّدة والمؤيدة في تحقيق المقاصد النافعة والوسائل الناجعة، وتحديد نمط المعرفة الحديث وكيفية معالجة أزماته الأخلاقية، وكيفية تقويم النظام العلمي التقني في انفصاله عن الأخلاق الدينية، ودعوته إلى العودة لأخلاق الإسلام من المنظور الاستئماني ومحوره الأساسي ماهية الإنسان الأخلاقية والقيمية، فلا إنسان بلا أخلاق، ولا أخلاق بغير دين[44]. وقد اجتهد في كشف علم الأخلاق انطلاقًا من التأسيس الائتماني للمقاصد باعتبارها قيمًا أخلاقية، وكاشفًا مقدمات التقريب الإسلامي للأخلاق النظرية اليونانية ومدى تأثيرها في تحديدات مفاهيم مقاصدية وأخلاقية أبعدتها عن الخطاب الميثاقي الائتماني. ولذا عمل على إثبات التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، كاشفًا -من جهة أولى- مقومات استقلال الفلسفة الإسلامية في البناء المقاصدي، ثم مؤسسًا -من جهة ثانية- مشروعية علم المقاصد وثلاثية التأسيس: تأسيس الفطرة على ميثاق الإشهاد، وتأسيس الإرادة على ميثاق الاستئمان، وتأسيس التزكية على ميثاق الإرسال[45]، يقول: "فكان لهذا العمل التأسيسي جانبان اثنان متكاملان: أحدهما جانب نقدي اقتضى أن نبيّن آثار نسيان حال المواثقة في المسائل والنتائج التي توصل إليها المقاصديون، والجانب الثاني جانب بنَّاء اقتضى أن نضع بعض المعالم لتقويم مسار علم المقاصد، وأن نقترح حلولًا لبعض الإشكالات التي أثارها هذا العلم"[46].
المنظور القرآني للأخلاق: وهو متعلق بالمواثيق الإلهية في جعل الإنسان كائنًا أخلاقيًّا منذ خلقه، وباعتباره كذلك فالخلق القرآني فوق التعقل الاستدلالي لإثبات الخلق في النفس كونها حالة أو طبعًا، وإنما الخلق صفة خِلقية بالجعل الإلهي تتجه بحسب إلهام النفس للتقوى أو الفجور، بتوضيح طرقهما، وفاعلية الكائن الإنساني في تمثُّل ذاتي للطريقين، اللذين يدلان على الواقعية التاريخية للكائن الإنساني، وبهذا فالتعارفية المؤسسة على ما تقدَّم ستتوجه اتجاهات عديدة لها ارتباط بالتعقل والتزكية والفعل التاريخي التعميري والاستخلافي. وهو أمر من شأنه تأسيس إبستيمولوجيا جديدة تقوم على استنباط نموذج معرفي من كونية القرآن وقرآنية الكون، وإنسانية القرآن والكون[47]، وهي مقدمات نظرية وواقعية، تقوي الفاعلية الذاتية الحية في تحقيق تعارفية إنسانية الإنسان المتجهة نحو الخير في سياق العلم بالشر وليس معرفته فقط.
إن المراد من التعارفية الميثاقية هو إرادة الله تعالى الجاعلة الصلة الرحيمية في روحية الإنسان، والرحيمية هي اشتقاق من الرحم التي شقَّ لها الله تعالى من اسمه الرحمن. وبهذا تكون الإرادة الإنسانية منوطةً بالحرية في معرفة المصالح والمفاسد المترتبة عن الحفاظ وعدمه لميثاق التعارف الإنساني، فيتأسس بهذا مرجع لنقد الأخلاق الإنسانية المتعلقة بالذات الإنسانية المفردة، أو بالذوات في ضرورة العيش الاجتماعي والتعاون على حاجياته وتحسينياته. وهو مرجع موثوق في كلياته وجزئياته، ليطمئن بحث الإنسان عن الحرية والكرامة والسعادة. فالميثاقية هنا ميثاقية مستمدَّة من النص القرآني، حيث فيه تظهر كل المواثيق الربانية، سواء كانت ائتمانية أم تبليغية أم تكريمية؛ إذ لا فرق بين النص والخطاب في الوحي القرآني، فلا معرفة للخطاب الميثاقي إلا بالنص التبليغي، ولا تبليغ دون خطاب[48]. فالميثاقية في هذا السياق ميثاقية تكاملية بين النص والخطاب.
فالتعارف ليس تعريفًا لغويًّا واصطلاحيًّا كما ورد في المعاجم اللغوية والاصطلاحية[49]، إنه روح يسري في الإنسان قبل الفطرة والنية والسلوك؛ لأنه ميثاق خطابي من الإرادة الربانية مندرج في نسق كلي من الجعليات الإلهية التي تتحقق بها تقويمية الخَلق الإنساني، فالجعل الإلهي هو الذي بيَّن كون الفطرة أكمل الاستعدادات الخلقية والقيمية التي خُلق بها الكائن الإنساني. وتلك التقويمية الخلقية تقابلها تقويمية خُلُقية. إذ لا يمكنه الحديث أن أحسن تقويم في الظاهر دون الباطن، وفي الشكل دون الجوهر. فلا مطمع للتأكُّد من جمالية الظاهر دون التحقُّق من جمالية الباطن والعكس منطق صحيح. وصفة الجمال في الظاهر والباطن لم تلغ في الضرورة التاريخية من حدوث ما يعكره من الفعل الإنساني، حيث دفاع الناس بعضهم ببعض، والدفاع يقتضي التنافس على المصالح، والبحث عن وسائل تحقيقها، وحيث لا توجد في الدنيا من جهة مواقع الوجود، المصالح المحضة أو المفاسد المحضة[50]، فيكون الجمال وما يثبته القبح من جانب العدم في السياسة العقلية من الظلم والطغيان والهيمنة وادعاء الأعظمية. ويظهر هذا التقابل بين الجمال والقبح في سورة الحجرات التي وردت فيها مفردة التعارف، فقال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير} [الحجرات: 13]، فهو خطاب جعليّ في سياق أخذ الإنسانية إلى أفق مستقبلي سامٍ ووضيء، من الآداب النفسية والاجتماعية، وإقامة السياجات الأخلاقية السلوكية القوية منهجًا مستقيمًا لإدراك مقصد الوحي من كرامة التقوى، وهو مقصد الحرية الذي يثير في روح النفس البشرية التطلُّع إلى معرفة الله وتقواه، ولا تُفقد هذه الحرية إلا بالخضوع الكلي لمنطق العقل واعتبار تحسيناته هي نهاية التعقل. فليس التعارف مقصدًا جزئيًّا أو قيمة مفردة، إنه نسق أخلاقي ومشترك في بناء مفهوم الذات الإنسانية والوقع الاجتماعي الموضوعي. وتبرز قيمة كونه مشتركًا في خطاب المختلفين أجناسًا وألوانًا والمتفرقين شعوبًا وقبائل، بألا يختلفوا فيما حقّه الردّ إلى أصل واحد وميزان واحد، تتحدد به القيم، ويُعرف به فضل الناس، فتسقط الفوارق وتتوارى أسباب النزاع والصراع.
ومن تلك السياجات الأخلاقية التي جاء في سياقها التعارف، خطاب المؤمنين بالتبيُّن في خبر الفاسق، والإصلاح بالعدل بين الطائفتين المتقاتلتين، والتأكيد على الأخوة بين المؤمنين، والنهي عن السخرية، والنهي عن التنابز بالألقاب، واجتناب كثرة الظن، واجتناب التجسُّس، واجتناب الغيبة. وهي كلها أخلاق عامَّة وليست أخلاقًا خاصَّة، يوجب الإسلام التحلي بها من أجل بناء مجتمع قادر على أداء أمانة الاستخلاف وأمانة التعمير. وروح العمل فيها يخرجها من التجريد العقلي إلى الفاعلية الذاتية التاريخية.
إن التعارفية الأخلاقية في المنظور القرآني قاعدة مقاصدية من المصالح الكلية، التي لا منهج لها إلا جماع من الأخلاق القرآنية الناظمة للميزان الموضوعي للفعل الإنساني في التاريخ، وهذه القاعدة هي التي يقوم عليها علم الاجتماع وقواعد الفهم السوسيولوجي والنقد المعرفي، فتدفع كل التخييلات العقلية التي تقصد شيئًا من تلك القاعدة المقاصدية فتخفق، فتحدد معالم الثقافات والحضارات في النجاح والإخفاق في جعل مقصد التعارف ميزانًا لتصحيح التفاعلات والتأثيرات وتجاوز ادعاءات الصراعات بينها. ومن هنا يمكن استنتاج:
أن التعارف بناء على القومية، تحاور عِرقي، والتعارف على مستوى إقصاء الدين الحق تحاور إقصائي، والتعارف على مستوى العقلانية والعلمية تحاور وضعاني يقصي الإنسان، والتعارف على مستوى المنظور القرآني تحاور أخلاقي جامع لاحترام القومية والدين، والحق والعقلانية والعلمية، في بوتقة النقد الإنساني المتجدد في الوصول إلى الاطمئنان وليس إلى السعادة أو اللذَّة ودفع الألم، بل البحث عن طمأنينة أكرمية التقوى.
وهكذا تتحقَّق هوية النظرية التعارفية الأخلاقية من خلال المفاهيم والأبعاد الآتية:
أما المفاهيم فقد وردت في خطابات ميثاقية متعدِّدة، نذكر منها: عهد الربوبية في عالم الأرواح، ووحدة الأصل والرحِم الإنسانية، والجعل الاستخلافي الذي يدفع سفك الدماء والإفساد، وعرض الأمانة بوضع قواعد تحملها من حيث الأصول المعرفية والإيمانية، والتعمير بالوسطية الأخلاقية والكلمة السواء، ووصف النبي الأمين بمفهوم الخلق العظيم. وهي مفاهيم تكشف أن مقاصد الوحي القرآني هي قيم وأخلاق للتخلُّق في السلوك الفعلي، لا تمثلات تجريدية وميتافيزيقا بعيدة عن تغيير الواقع للأنفع الإنساني. وبهذه المفاهيم وأمثالها يمكن مثلًا نقد النقدية الكانطية كما تقدَّم، في تمييزها بين مذهب الأخلاق الذي يقوم على الواجبات العامة، ومذهب السعادة الذي يقوم على النصائح الخاصة التي ترشد إلى الحياة المُثلى، وأن الأول أخلاقي والثاني قيمي[51]. وذلك بما يفتح ترابط مكونات النسق المقاصدي الأخلاقية والقيمية، بحيث لا ترى مقاصد الوحي إلا قيمًا أخلاقية لتزكية الإنسان في منتدي تفاعلية الذوات الاجتماعية نحو الصلاح والإصلاح والمصلحة الشرعية.
وأما أبعاد النظرية التعارفية الأخلاقية فتتكشف من سؤالها النقدي عن حقيقة الفعل الإنساني ومقاصده في الوجود، وأنه مهما تطور في عقلانيته سيبقى متصفًا بالهلع والجزع، قال تعالى: {إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا} [المعارج: 19-21]. ولذا تساءلت الاتجاهات الأخلاقية عن عدم وصول الإنسانية إلى مرحلة النضج المعرفي في التأسيس العلمي لعلم الأخلاق، وخصوصًا في العالم المعاصر، حيث يقف على حافة المخاطر والخوف من مآلات المخترعات الإنسانية في عدم المحافظة على صلاح الإنسان وصلاح المجال البيئي، فصارت ما بعد الأخلاقية في الزمن الما بعد حداثي عنوانًا لأزمة الأخلاق، وعلم الأخلاق، في السرديات الأخلاقية المعاصرة التي تبحث عن عودة الأخلاق الدينية ووجود معايير قيمية كونية. فصار النظر الأخلاقي متجهًا نحو تحليل القضايا الآتية:
- الفعل الأخلاقي وقضايا العدالة الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمعات ومنظومة الجيل الجديد من حقوق الإنسان المتعلقة بالأسرة والبيئة والمهن...
- القيم الكونية الجامعة لتنوع الثقافات واختلاف الحضارات، لتدخل مناهج التحاور والتواصل بدل التناحر والتصارع والتكالب.
- العناية بالأخلاق التطبيقية، لكن في غياب المرجعية المؤسسة الناظمة لرؤية العالم، تبقى خاضعة للمنظور الوضعاني، الذي لا يشفي غليل البحث في حقيقة الإنسان الوجودية.
- وفي هذا المقام السياقي يمكن تحديد أبعاد النظرية التعارفية الأخلاقية:
- بُعْد التأسيس الأخلاقي القائم على مقاصد الإرادة الربانية في تغيير الإنسان من إصابة الخسران إلى خلق الإيمان الناقل من عقلانية التيه والشكّ الهادم إلى عقلانية البحث المتجدد عن عمل الصالحات النافعة لعيال الله من منطلق السُّنن الاجتماعية التي تراعي المصلحة الإنسانية لا المصلحة الفردية، فهيمنة هذه الأخيرة أدت إلى فلسفة ذاتية في الأخلاق أنتجت ثقافة التحيز والتمركز المفتقرة للحس الأخلاقي، والبعيدة منهجيًّا عن تحقيق ثقافة التواصل والتعارف ومن معالمها:
- طغيان الهوس الاقتصادي بسبب الهوامش التي أتاحها التقدُّم التكنولوجي لهيمنة علاقات اقتصادية غير أخلاقية تبتدئ من المتاجرة في الأسلحة وإثارة الحروب والاتجار في إذلال البشرية.
- تسويغ تصنيف الإنسانية إلى مجموعات غنية وأخرى فقيرة، والأولى تستعلي على الثانية وتعاملها من خلال الضعف الاقتصادي لا من منظور التعارفية الأخلاقية التي تفرض تأسيس أخلاق التعاون والتراحم ودفع أخلاق الغاب.
- الاعتناء بالعلم بمفهومه الوضعي الذي لم يعطِ لعلم الأخلاق أيَّ مسلك في بناء العلاقات التواصلية، بحيث كانت الأيديولوجيات المعاصرة كالليبرالية والماركسية منطلقًا لزعزعة المفاهيم الأخلاقية المؤسسة لكرامة الإنسان، وفتح المسالك لانتشار اللامعنى والعدمية والفوضى وعدم الثقة بالعقل أصلًا.
- إن نظرية الأخلاق التعارفية تؤسِّس لمعالجة هذه المعالم، ووضعها أمام الدراسة العلمية على الوحدة الإنسانية ومقاصدها، في بناء اجتماعي يحقِّق الوظيفة التعميرية، ويكفل للبشرية تحقيق التواصل الأخلاقي عبر التواصل اللساني، والتعارف الروحي لا الشكلي، وذلك لتجاوز ما يفرضه الواقع من قواعد يفرضها قانون التصارع.
- بُعْد التواصل الأخلاقي، فالتواصل في نظرية التعارف لا يقف عند نظرية التواصل لهابرماس، ولا نظرية الاعتراف لبول ريكور، ولا نظرية العدالة والإنصاف لجون رولز، ولا مذهب الرغبة والسعادة لجيل دولوز، ولا أخلاق المسؤولية لهانز يوناس...؛ وإنما تواصلية تعتقد في علم الإيمان وإيمان العلم، وهذا ما يجعلها تتجاوز المرجعيات الفلسفية التي جعلت الإيمان مسألة إنتاج سوسيولوجي وليس قضية وجودية متعلقة بالإنسان في علاقته بالبحث عن الله باعتباره الخالق الهادي للعلم في مفهومه المادي والروحي، الحسي والغيبي، وليس مفهومًا مقدسًا[52] سحريًّا أو مثاليًّا لا علاقة له بالواقع. فالتواصلية التعارفية أداة منهجية برهانية للنظر في الصلاح البشري من منطلق أخلاق دينية موضوعية غير متأثرة بالنظريات العقلانية المادية المتحيزة لإنسانية متعبة.
- بُعْد التحاور الأخلاقي بين الحضارات والثقافات والأديان، فنظرية التعارفية الأخلاقية من الناحية القيمية تجمع بين الثقافة والحضارة باعتبارهما مكوَّنًا ومكوِّنًا في الزمن الأخلاقي الإنساني، فتنوع الثقافات والحضارات في العالم ليس مدعاةً للتصارع، وإنما يكون كذلك حين تغلب نظرة الصراع والمواجهة، وهو ما تدفعه الأخلاق القرآنية. فمنطق التعارف منطق تواصليّ، يرفض منطق نهاية التاريخ لفوكوياما[53]، كما يرفض منطق صراع الحضارات أو الثقافات، كما ذهب إلى ذلك هنتنجتون، حينما تحدَّث في كتابه "صدام الحضارات"[54] عن الحدود الدامية للإسلام، وعن تهويل سيناريو الرعب تجاه التحالف الإسلامي الكونفوشيوسي، دون تمييز بين التعاون الاقتصادي وبين التباعد في العقائد الدينية والمنظورات الثقافية. وقد حدَّد الحضارة بكونها نُظُم القيم فجعل الدين معيارًا حاسمًا دون أن يوظفه في التقارب بين آسيا واليابان والغرب، لكن وظفه في مقاربة علاقة المسلمين بالغرب. وبهذا قد يستخلص الباحث أن الكتاب لم يستحضر مفهوم الأخلاقية وما يقتضيه من تحليل ضرورة التعايش بين الثقافات والحضارات[55]، وضرورة حوار الحضارات كما في أطروحة روجيه جارودي[56]، ورفض نظرية التعارف لمنطق التصارع وتقديم التواصل؛ لأنها ترتكز على تفاعلية الكلمة السواء واعتماد المشترك الإنساني القائم على إرادات تحقيق حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، فهي قيم مشتركة للحفاظ على الوجود الإنساني والصلاح البيئي، سواء كانت الكلمة السواء هي المشترك الإنساني، أم هي أصلية الوحدة الإلهية، التي تؤسِّس القيم الموضوعية الراشدة إلى البحث عن المنفعة واللذَّة في أفق مراعاة الكينونة الإنسانية، وعدم اعتماد التفكيك اللانهائي للثوابت الجوهرية. فإن من شأن اتباع النقد من أجل النقد ترسيخ منطق الفلسفة الوضعية، وتغييب المعنى وتحقير المشترك الإنساني الحافظ للبشرية من الجنوح نحو هدمها. فنظرية التعارف بناء متواصل يقرُّ بأن الثقافات لا تعرف الركود والجمود، بل هي في حالة تدفُّق مستمر، وهي تتغيَّر وتتطوَّر بشكل تدريجي، وأحيانًا على شكل قفزات، وما يطبعها بعلامتها الفارقة هو إمكان فهمها بصفتها بنية وبصفتها عملية. وانطلاقًا من هذا الأساس ترى نظرية التعارف أنه لا شرعية ولا مشروعية أخلاقية وقيمية أن تقف الحضارات ضد بعضها البعض في مواجهة متصلبة، حيث إن المطلوب هو جعل الأخلاق محور التحول الثقافي والمعرفي، لإنتاج التواصلية التقاربية التي تدفع الشكوك المعارضة للتكامل والتعايش، والاندماج في بوتقة عالم أفضل يراعي حقَّ الله وحقَّ العباد. وهنا تبرز القيمة العلمية في تأسيس التعارفية الأخلاقية على المقاصدية القرآنية، التي تُحدّد بمعايير روحية وعلمية المصلحة الموضوعية أساسًا لتحقيق خلق التكريم الممزوج بخلق التقوى والتعقُّل والتذكُّر.
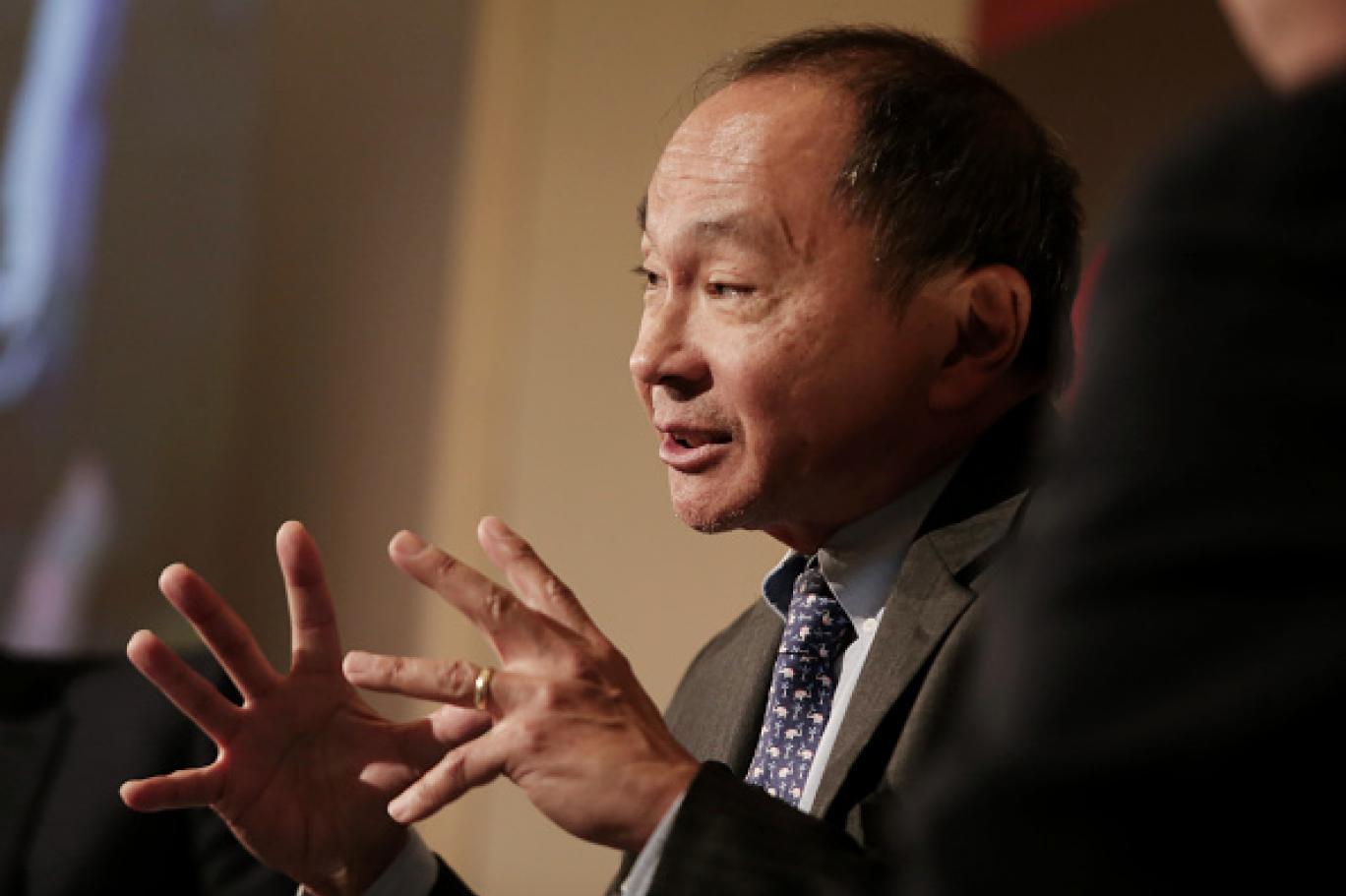
لعل الأبعاد الثلاثة تظهر ترابطها العميق مع هوية نظرية التعارف الأخلاقية، حيث إن من أهم وظائف هذه النظرية أن تكشف الهوية الأخلاقية في النص القرآني، وتكون مرجعية للسياق العلمي للبحث في التعارفية الأخلاقية، ولامتلاك القدرة على السؤال النقدي لتأويل الواقع الأخلاقي لدى جميع الاتجاهات العقلية قصد يناء أخلاق التغيُّر في جميع الأفعال السياسية والاجتماعية والعلمية للمحافظة على إنسانية الإنسان وعدم الذهاب بها إلى مسالك إنتاج اللاإنسان.
إن نظرية التعارف الأخلاقية بارتباطها بفلسفة الدين، من حيثُ إن الدين ليس قضية تفسير مادي وإنما قضية إيمان برهاني، من شأنها إخراج التنظيرات الفلسفية من الرؤية التجزيئية للإنسان الأخلاقي، بإقصاء الإنسان، والتنظير لأفعاله، إلى التنظير للإنسان في ذاته باعتباره كائنًا أخلاقيًّا قبل وَسْمِه بالعقلانية، فسوف يكون التنظير من خلال الأفعال دون المرجعية النظرية استمرارًا متجددًا في ألوان نظريات عقلية لأزمة الأخلاق، المتميزة بالخواء والفراغ، من المعنى الأصيل في المرجعية الكلية التي تبحث في حقيقة الإنسان الوجودية. وبهذا فنظرية التعارف الأخلاقية لها أسس معرفية وعلمية، تعمل على تعميق النظر في مفهوم الأخلاق العالمية، الذي صاغه هانز كونغ في مشروعه عن الأخلاق العالمية والقيم المشتركة بين أديان العالم والتحديات التي تواجهها، ومن معالمه: أنه لن يكون هناك سلام عالمي دون سلام بين الأديان، وأنه لا يمكن للإنسانية العيش دون أخلاق عالمية، وأنه لن يكون هناك سلام بين الأديان دون حوار بينها[57].
وتظهر فائدة النظرية التعارفية الأخلاقية هنا في الارتكاز على أهمية التعارف الذي يقوي تفهم الاختلاف والتنوع، فالوعي المعرفي بأبعاد المختلف فيه في الشرائع الدينية والقوانين من شأنه الدفع نحو الابتكار والإبداع في احترام المختلفات والعمل بالمتفقات. وبهذا تدفع النظرية إلى التفهم المعرفي لمقومات التعارفية ومقاصدها المصلحية الكلية: الحرية، والكرامة، والعدل، والعمل على دفع الظلم، باعتباره قاعدة مخربة للعمران الخاص والعام. ومن تلك المقومات سؤال الإيمان والعمل[58]، وهما شرطان أساسيان لتحقيق إنسانية الصالحات والمصالح والصلاح، فمن شأنهما صياغة قصدية للتسامح تؤسِّس قواعد للتعامل لإزالة الصور النمطية والاستعلائية والعِرقية بين أطراف التعارف، وهم الآخر الفرد أو المجتمعات أو الدول أو الحضارات أو الثقافات.
فسؤال أخلاق التعارف يجعل العقل في صلب أخلاق الدين من أجل إنضاج المقاصد المصلحية المحافظة على الدين الحق والإنسان الإنسان، من أجل ترشيد علوم الوحي والإنسان والكون لتجنُّب مآزق الوضعية القديمة والجديدة التي لا ترى إلا الحس والشكل، فيأخذ العلم مفهومه الكلي لا التجزيئي.
خاتمة
من خلال المحاور الثلاثة، يظهر أن سؤال النقد الأخلاقي التواصلي والتعارفي في عصر ما بعد الأخلاق قد كشف بعض آفات العقل المجرد، وهي التجزيئية لظاهرة الكائن، أو الظاهرة الإنسانية، وأن ملامح الخروج من العقلانية المجردة التي أوصلت الإنسان الغربي إلى أزمة أخلاق في التنظير والعمل في زمن الحداثة وما بعدها، ملمح النظر العلمي الجاد لنظرية الأخلاق التعارفية المؤسسة على الميثاقية التكاملية، الإشهادية والاستئمانية والإرسالية. وذلك بكونها أخلاقًا كونية توجه الإنسانية نحو مستقبل عالمي أفضل، محوره التعارف والتحاور وأفضلية التقوى التكريمية الجامعة لسنن تغليب أخلاق الخير والحرية والحق والعدل والجمال في سياق الواقع الموضوعي المتحول، الذي لا يختفي فيه وجود قيم الطغيان والاستبداد والظلم. فسؤال أخلاق التعارف يجعل العقل في صلب أخلاق الدين من أجل إنضاج المقاصد المصلحية المحافظة على الدين الحق والإنسان الإنسان، من أجل ترشيد علوم الوحي والإنسان والكون لتجنُّب مآزق الوضعية القديمة والجديدة التي لا ترى إلا الحس والشكل، فيأخذ العلم مفهومه الكلي لا التجزيئي.
لقد توصل هابرماس من تعميق بحثه الفلسفي في نظرية كانط الأخلاقية إلى أنها ذات أفق غائي وذاتي متأصل في فلسفة الوعي، وحصرت رؤيتها في التمركز على العقل واستخلاصه للحكم الأخلاقي النظري الكلي، دون النظر إلى الواقع السوسيولوجي لإقامة أخلاق الحياة، والانتصار للنظرية الاجتماعية في مقابل فلسفة الوعي. فسعى إلى الخروج من هذا الحصر إلى تأسيس وعي أخلاقي يعتمد -من جهة أولى- على العقل التواصلي والفعل التواصلي وعلى صلة المعرفة بالمصلحة، من منطلق أن كل شيء خاضع للنقد والتداول، ومن جهة ثانية أن تكون أخلاقًا منخرطة في سياق الحياة السوسيولوجية من خلال فاعلية الحوار وإتيقا المناقشة والحوار، من منظور الفاعل للتواصل، فالحداثة لا يمكن أن تخرج من أزمتها العلموية والأخلاقية إلا بالتفكير في فاعلية التواصل الأخلاقي، بوصفها إنتاج عملية تبادل لأفعال الكلام القائمة على تقديم البراهين والحجج لتجاوز المشكلات الاجتماعية والسياسية والحضارية. لكن هذا المسعى الهبرماسي بقي محافظًا على المنزع الكانطي في النظر لأحكام الوجوب وأحكام الواقع وأحكام الوجود، لبناء شرعية كونية تشكِّل معيارًا أساسيًّا لأي قانون أخلاقي. والشرعية الكونية لا تتحقَّق بالإلزام التواصلي، وخصوصًا بين الحضارات والثقافات، فكان لا بدَّ من التفكير في أن مشروعية الأخلاق الكونية لا تحتاج للتأسيس فقط على مبدأ التواصل، بل هي تفتقر للتأسيس على مرجعية مبدأ التعارفية. ولهذا كان محور السؤال النقدي في هذه الدراسة البحث عن التواصلية التعارفية في عصر ما بعد الأخلاق، حيث إنه لا المكان ولا الزمان استطاعا توسيع المخيلة الإنسانية للاتفاق على أخلاق قائمة على المشترك الإنسان تتقدَّم في التنظير والفعل للحدِّ من آفات الأخلاقية الحداثية على العالم، فقد صار الحديث عن أخلاق العقلانية والتقنية معاني إخفاقية ثقيلة على العيش الإنساني ومساره التعميري المستقبلي.
ولن ينتهي سؤال النقد لأخلاق الحداثة وقيمها، ولأخلاق وقيم ما بعد الحداثة، وللتحولات المعولمة وآثارها المستقبلية؛ إذ يبقى السؤال النقدي التعارفي لإشكالية الأخلاق والقيم في الفكر الفلسفي والديني العالمي الراهن مطلبًا استراتيجيًّا، وفكرًا حيًّا من أجل الإبداع والاجتهاد في الواقع التاريخي الإنساني الحديث والمتجدد. فليست الأخلاق والقيم هي ما يعوز عالمنا، بل إن الفاعلين هم الذين تعوزهم الأخلاق والقيم، ومن هنا حُقَّ لنظرية التعارف الأخلاقية أن تعرف مزيدًا من تعميق النظر الفلسفي والمقاصدي من لدن العقلاء والنُّخَب العلمية.
- الهوامش
-
[1] المقصود من عرض هذه النماذج بيان تعدُّد الرؤى في تطور الفكر النقدي الأخلاقي، التي من شأنها أن تكشف السياق العام الذي يتم فيه تحليل عنوان هذه الدراسة في موضوع: النقد الأخلاقي التواصلي والتعارفي في عصر ما بعد الأخلاق.
[2] إمانويل كانط، نقد العقل العملي، ترجمة: غانم هنا، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2008م)، مقدمة المترجم، ص19.
[3] دومينيك فولشيد، المذاهب الفلسفية الكبرى، ترجمة: مروان بطش، (المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 2011م)، ص90.
[4] المرجع نفسه، ص91.
[5] المرجع نفسه، ص91.
[6] زكريا إبراهيم، المشكلة الخلقية، (القاهرة: دار مصر للطباعة)، ص180.
[7] ترجمة وتقديم: عبد الغفار مكاوي، (بيروت: منشورات الجمل، 1963م).
[8] تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ص28.
[9] نقد العقل العملي، ص44.
[10] المرجع نفسه، ص66.
[11] المرجع نفسه، ص94.
[12] توم بوتومور، مدرسة فرانكفورت، ترجمة: سعد هجرس، (ليبيا: دار الكتب الوطنية، الطبعة الثانية، 2004م)، ص16.
[13] المرجع نفسه، ص14.
[14] المرجع نفسه، ص17.
[15] المرجع نفسه، ص20.
[16] المرجع نفسه، ص212.
[17] المرجع نفسه، ص212.
[18] المرجع نفسه، ص212.
[19] زيغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، ترجمة: سعد البازعي وبثينة الإبراهيم، (أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، كلمة، 2016م)، ص64.
[20] ما بعد الأخلاق لها صله من حيث المفهوم بـ(post éthique) و(méta éthique)، فمعنى ما بعد الأخلاق وما وراء الأخلاق قد يأخذ المدلول نفسه الذي يتجه نحو مرحلة زمنية جديدة متميزة عن العناية بالأخلاق المعيارية، ويتضمَّن دراسة المصطلحات الأخلاقية واللغة الأخلاقية، وقد يرجح (post éthique) بكونه متعلقًا بثقافة ما بعد الأخلاق من حيث التجليات التي تجلَّت في هيمنة الحقوق الذاتية والفردانية والاستهلاك المادي المفرط، والاستغلال السياسي البشع دون إلزام أخلاقي. انظر كتاب بيتر باوفو (beyond ethics to post- ethics).
[21] تودروف يراجع تودوروف، مجلة الفكر العربي المعاصر، لقاء خاص أجراه هاشم صالح، العدد 40، 1986م، ص26.
[22] يورغان هابرماس، المرجع القول الفلسفي للحداثة، ترجمة: فاطمة الجيوشي، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، 1995م)، ص463.
[23] المرجع نفسه، ص451.
[24] المرجع نفسه، ص482.
[25] صدر كتاب "نظرية الفعل التواصلي" عن سلسلة ترجمان في المركز العربي ودراسة السياسات، من ترجمة فتحي المسكيني، في مجلدين، الأول بعنوان: عقلانية الفعل والعقلانية الاجتماعية، والثاني بعنوان: في نقد العقل الوظيفي.
[26] القول الفلسفي للحداثة، ص455.
[27] المرجع نفسه، ص456.
[28] يورغان هابرماس، إتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، ترجمة: عمر مهيبل، (الجزائر: منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، 2010م)، ص62.
[29] المرجع نفسه، ص64.
[30] المرجع نفسه، ص64.
[31] نقد هربرت ماركوز الوضعية القديمة في كتابه "العقل والثورة"، وخصَّص كتاب "الإنسان ذو البعد الواحد" لنقد التقنية والعلمويين.
[32] عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 44، 1981م)، ص13.
[33] طه عبد الرحمن، التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، (الكويت: مركز نهوض للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى، 2022م)، ص160-164.
[34] وذلك بناءً على أنه ليس من مهام العلوم الاجتماعية تعيين القيم والمبادئ المُثلى للناس التي هي من اختصاص علم الأخلاق، بل الكشف عن سُبل تحرر الباحثين في العلوم الإنسانية من عبء الأيديولوجيات والتحيزات الثقافية والحضارية. لكن العناية بالبحث المنطقي للعلوم دون ملاحظة علم اجتماع المعرفة من شأنها أن تدفع نحو غلبة منطق النمذجة والمعيارية التي ستفضي إلى حصر العلم في أبعاد ضيقة وعضينية.
[35] يقول طه عبد الرحمن: "لقد استعمل فلاسفة الغرب المتقدمون لفظ الأخلاق والقيم باعتبارهما مترادفين، وإن كنا نجد بينهم من يؤثر استعمال هذا اللفظ أو ذاك، أما المعاصرون منهم فأبوا إلا أن يفرقوا بينهما... لكن لا يبدو أن الأخلاقيين المعاصرين استوفوا شروط الوضوح الاصطلاحي في لجوئهم إلى التفريق بين (Morals) أو (Morale) وبين (Ethics) أو (Ethique) ليس ذلك لأن الوجه الذي فرق به الواحد منهم بين المصطلحين المذكورين يختلف عن الوجه الذي فرق به الآخر بينهما فقط، بل أيضا لأنه يجوز أن يتردد هذا الواحد بين وجهين فأكثر من وجوه التفرقة أو ينساق إلى استعمال أحد اللفظين في معنى الآخر أو يورده في المواضع التي ينبغي أن يورد فيها هذا اللفظ الثاني". انظر: سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2000م)، ص17.
[36] تهذيب الأخلاق، دراسة وتحقيق: عماد الهلالي، (بيروت: منشورات الجمل، الطبعة الأولى، 2011م)، ص256.
[37] المرجع نفسه، ص257.
[38] أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج3، ص57.
[39] المرجع نفسه، ج3، ص58. قال الغزالي: "ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه"، ص60.
[40] وهذا لا يفيد ما ذهب إليه البعض بأن حظَّ مجال الأخلاق من اهتمام علماء الإسلام ومفكريه ضئيل إذا ما قورن بغيره من مجالات المعرفة العلمية والفلسفية. إذ إن استمداد نظرية التعرف الأخلاقية من المنظور القرآني كفيلٌ بأن يثبت أن المقصد الكلي في حفظ الإنسان يكمُن في حفظ الكليات الأخلاقية التي قرر الوحي الالتزام بها وجوبًا من أجل الصلاح الإنساني. فدعوى ضآلة الأخلاق الإسلامية إيذان بعدم الاطلاع على الرؤية الأخلاقية في الوحي القرآني، وكيف أسهمت في بناء العلوم العقلية والنقلية على أساسها قلة وكثرة. فابن مسكويه والغزالي، وإن استفادا من المنهج الفلسفي اليوناني، فإنهما أبرزا الخاصية الإسلامية في كشف معاني الأخلاق الإسلامية. انظر: محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن: دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985م).
[41] دان بول ويليام، الأديان في علم الاجتماع، ترجمة: بسمة بدران، ص173.
[42] محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2001م)، ص17.
[43] سؤال الأخلاق، ص24.
[44] المرجع نفسه، ص14.
[45] يبدو أن المشروع الائتماني لدى طه عبد الرحمن مشروع كُليّ غير منحصر في علم المقاصد، بل هو روح كلية تبرز في كل مؤلفاته نحو "دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني"، وكتابه "شرود ما بعد الدهرانية: النقد الائتماني للخروج من الأخلاق"، وكتابه "روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية.
[46] التأسيس الائتماني لعلم المقاصد، ص504-505.
[47] عبد الرحمن العضراوي، آليات التداخل المعرفي وتجديد البراديغم في العلوم الإسلامية، (الجزائر: مكتبة الجامعة، تلمسان، 2016م).
[48] وهذه ملحوظة على أستاذنا طه عبد الرحمن في تمييزه بين الخطاب القرآني والنص القرآني، وذلك أن التمييز بين الخطاب والنص إشكالية معرفية قد تصل لإلغاء النص، واعتبار أن التواصل مع الله قد يتم دون تبليغ. ولذا فالمشروعية المستمدة من الوحي الإلهي المتصف بصفات الكمال والإحسان والحق والعدل، ليست مصادرة على المطلوب، بل تأكيد على تكاملية الوحي نصًّا وخطابًا، وباعث قوي على الإخلاص في النيَّة والعزم على نظر تدبُّري للوحي، لا تتناهى دلالاته المعنوية والمادية. وفي إقرار الاعتماد على الخطاب وحده، فتح ذريعة لما يعتقده البعض إمكانية الوصول إلى سِر العلم وسِر الإخلاص، الذي يفوق ما جاء به التبليغ النبوي، من مصالح كفيلة بتدبير الوجود الإنساني. وفي اعتبار أن النص قضية تاريخية متعلقة بواقع معين، وهو ما يؤسس لتناهي معانيه. ومعلوم أن معاني الوحي لا متناهية في الربط بين الثوابت والمتغيرات وبين القطعيات والظنيات. ولهذا فالنص القرآني خطاب، وخطابه نص، وهما مفهومان يحكمهما قانون الوحدة البنائية وقانون التكامل. وهذان القانونان لا يوجدان فيما حصل في الدرس اللساني والبلاغي، من التمييز بينهما، باعتبار أن الخطاب كل ملفوظ يندرج تحته نظام اللغة وقوانينها، فهو نصّ. وإذا ما خرج ليندرج تحت السياقات الاجتماعية سُمي خطابًا، فالخطاب إذن يضطلع بمهمة توصيل رسالة. فهناك الخطاب في ذاته، ومنتج الخطاب؛ ولذا تعدَّدت المداخل إلى الخطاب من جهة جدلية النص والمبدع والمتلقي، وهي ثلاثية ينفذ من خلالها لتأويل الخطاب.
[49] جاء في "مقاييس اللغة" لابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدها على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض والآخر على السكينة والطمأنينة، وفي "لسان العرب" لابن منظور: عرفه يعرفه عرفة وعرفانًا ومعرفة، ورجل عروف عارف: يعرف الأمور ولا ينكر أحدًا رآه مرة، والعريف والعارف بمعنى، مثل عليم وعالم...
[50] الشاطبي، الموافقات، (بيروت: دار المعرفة)، ج2، ص25.
[51] سؤال الأخلاق، ص17.
[52] المقدَّس الحقيقي المثبت صحَّة لله تعالى لا علاقة له بالعنف ولا بالتطرف؛ لأنه كشف عن الميثاق الذي عاهد عليه الإنسان روحًا في التزكية الباطنية، وعملًا في التزكية الظاهرية. وإنما ارتبط المفهوم السلبي للمقدَّس البعيد عن العلم، من خلال التجربة الدينية في الغرب الحداثي، فتم البحث في إخضاع المقدَّس للعقلنة، بدل خضوع العقل له.
[53] نهاية التاريخ والإنسان الأخير، أشرف على ترجمته: مطاع صفدي، (بيروت: مركز الإنماء العربي، 1993م).
[54] صمويل هنتنجتون، صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، ص69، وانظر أيضًا ص88.
[55] انظر: هارالد موللر، تعايش الثقافات: مشروع مضاد لهنتنجتون، ترجمة: إبراهيم أبو هشهش، (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2004م).
[56] في كتابه "من أجل حوار بين الحضارات" الصادر عام 1997م، وقد بيَّن فيه كيف أن الغرب في حاجة إلى تقويم مساراته، بعد أن وصل إلى وضعية مأزومة، لا يمكن تجاوزها إلا بحواره مع الثقافات والحضارات الإنسانية، وذلك لاستكشاف النقائص الأخلاقية التي أصابته في زمن الحداثة، ومنها طغيان النزعة العقلانية وتضخم فلسفة الكمّ، ورجحان نزعة العمل على نزعة النظر، وهو ما أنتج تشييئية الإنسان والإفراط في الاستهلاكية.
[57] انظر على سبيل النموذج كتابه "القيم الأخلاقية المشتركة للأديان: الإسلام رمز الأمل".
[58] انظر: طه عبد الرحمن، سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم، (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2012م).











