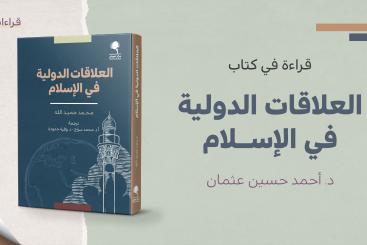محمد أسد: المفكر المجهول

وُلِدَ ليوپولد ڤايس (Leopold Weiss) لأبوَيْن يهوديَّيْن عامَ 1900م، في الإمبراطورية النمساوية-المجرية (Austro-Hungarian Empire)، واعتنَق الإسلامَ في عام 1926م، فغيَّر اسمَه إلى «محمد أسَد»، ليُصبحَ بعدئذٍ أحدَ مشاهير المسلمين في القرن العشرين. ويُعرَف أسد بسيرته الذاتية الشهيرة «الطريق إلى مكة»[1] (The Road to Mecca)، التي تحكي القصة الأخَّاذة لشابٍّ يهوديٍّ من أوروبا الوسطى يترك ديانته التي وُلِدَ بها ليعتنقَ الإسلامَ قبل أن يتوجَّه إلى العيش سنواتٍ عدَّة في قلب صحارى شبه الجزيرة العربية. ثم انتقَل أسد في سنواتٍ لاحقةٍ إلى الهند التي كانت مستعمرةً بريطانية، فشهِد عَيانًا مولِدَ باكستان التي صار أول ممثّلٍ لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة (United Nations General Assembly). وحين وافته المنيَّة في جنوب إسبانيا عام 1992م، كان أسد قد عاش فيما يربو على عشر دولٍ شرقًا وغربًا. بَيد أن أسدًا لم يكن مجرَّد رحَّالةٍ أو مُهتدٍ إلى الإسلام؛ بل كان مثقفًا، أولًا وآخِرًا.
ويمتدُّ مسارُه الطويل على مدى القرن العشرين بأكمله تقريبًا، ويتيح نافذةً للاطلاع على كثيرٍ من التيارات الإسلامية الحديثة، اجتماعيًّا وسياسيًّا وفكريًّا. وتغطّي كتاباتُ أسد العديدَ من مجالات الفكر الإسلامي في العصر الحديث، ومنها علوم القرآن وعلوم الحديث والنظرية السياسية وأصول الفقه الإسلامي. وهناك نزعة مهمَّة -وإن كانت ضئيلة- لدى بعض معتنقي الإسلام الغربيين للحديث عن دور أسد في رحلاتهم إلى الإيمان، ومن هؤلاء مراد هوفمان (Murad Hofmann)، ومحمد نوت برنستروم (Muhammad Knut Bernström)، ومريم جميلة (Maryam Jameelah)، وجوناثان براون (Jonathan Brown).
ما يزال مصدرنا الرئيس حول حياة أسد هو أسد نفسه، حتى وإن كان هذا الأمر قد بدأ يتغيَّر ببطء. لكن التجاهل الذي ينال الرجل يظل أكبرَ في الدوائر الإسلامية.
غير أن أسدًا ما يزال شخصية هامشية إلى حدٍّ ما، وما زالت [الأكاديميا الغربية] في انتظار دراسة جادة عن الرجل باللغة الإنجليزية. إذ لا نكاد نسمع اسمه عند حديثنا عن بعض المفكرين المسلمين الكبار في القرن الماضي. وقليلون هم الذين يعرفون سيرته الذاتية الثانية «عودة القلب» (Homecoming of the Heart)، التي تغطي سنوات حياته بعد رحيله عن شبه الجزيرة العربية في عام 1932م. وفي الواقع، ما يزال مصدرنا الرئيس حول حياة أسد هو أسد نفسه، حتى وإن كان هذا الأمر قد بدأ يتغيَّر ببطء. لكن التجاهل الذي ينال الرجل يظل أكبرَ في الدوائر الإسلامية، فمن الصعب العثور على طلاب دكتوراه أو أكاديميين مسلمين يشتبكون مع أفكاره، أو معاهد إسلامية تحمل اسمه. وبالكاد يمكن للمرء أن يسمع اسمَ أسد في خطبة جمعة، إن حدَث هذا أصلًا.

محمد أسد
لكن محمد أسد مفكِّر إسلامي أكثر ثراءً وإبداعًا وتعقيدًا مما يدركه كثيرون عمومًا، ولديه الكثير لنتعلَّمه منه اليوم، بعد مُضِيّ ثلاثة عقود على وفاته. وفي حين أن الخطوط العريضة لحياة أسد معروفةٌ لدينا، يظل هناك الكثير مما لم نزل لا نعرفه. وفي الوقت ذاته، فإن كثيرًا مما نعتقد أننا نعرفه عن أسد لا يصمد أمام البحث والتمحيص. وفوق كل ذلك، فإن أسدًا وثيق الصلة [بعصرنا]؛ إذ تُثير حياتُه وفكرُه موضوعاتٍ من قبيل الهوية والانتماء والإصلاح ومستقبل الإسلام، وهي الأمور التي لا تقلُّ أهميتُها في عصرنا عمَّا كانت عليه في زمانه.
دعونا هنا نبدأ بتصحيح فهم شائع مغلوط. فحيثما يجري الحديث عن أسد في الدراسات والبحوث، يُنظَر إليه باعتباره حلقةَ وصلٍ أو وسيطًا بين الإسلام والغرب. ويَرُوجُ الحديثُ عنه بوصفه «هديةَ أوروبا إلى الإسلام»[2]. وقد سُمّيت الساحةُ أمام مبنى الأمم المتحدة في ڤيينا باسم «ساحة محمد أسد» (Muhammad Asad Platz). بَيْدَ أن الحقيقة أعقَد من هذا بكثير. فقد وضَع أسد اعتناقَه الإسلامَ في إطار الثورة ضد تيار النسبية والنزوع الاستهلاكي والحَيرة التي ضربت أوروبا في حقبة ما بعد الحرب العُظمى [الحرب العالمية الأولى]. فسُرعان ما غادرَ أوروبا، ليحطَّ رحالَه في شبه الجزيرة العربية، ويكرِّسَ حياتَه لقضية التجديد والإصلاح الإسلامي.
حذّر أسدُ المسلمين الذين كانوا على وشك الاستقلال عن الحكم الاستعماري من اتّباعِ المسار العلماني الأوروبي. إذ يرى أسد في هذا العمل والأعمال اللاحقة أن الحداثة العلمانية هي عصر أزماتٍ وانحطاط.
وللقيام بذلك، استند أسد إلى توجهات متباينة من الإرث الفكري الإسلامي، ومن ذلك التيار الإصلاحي التحديثي بقيادة محمد عبده، وتيار الإحياء المناهض للتصوف بقيادة ابن تيمية، وأصول الفقه وَفْقَ ما جاء به ابن حزم. وقد كان أسد أيضًا ناقدًا قاسيًا للعلمانية الأوروبية طوالَ مسارِه [الفكري]. ففي أحد أعماله الأولى، بعنوان «الإسلام على مفترَق الطرق» (Islam at the Crossroads) (صدر عام 1934م)، حذّر أسدُ المسلمين الذين كانوا على وشك الاستقلال عن الحكم الاستعماري من اتّباعِ المسار العلماني الأوروبي. إذ يرى أسد في هذا العمل والأعمال اللاحقة أن الحداثة العلمانية هي عصر أزماتٍ وانحطاط؛ فقد كتب قائلًا إن إقصاءَ الحقيقة الدينية من المجال السياسي يكْمُن وراء كثيرٍ من الأزمات في العالَم الحديث. وليست الصراعات الاجتماعية والسياسية والعسكرية سوى عرَض لهذا الاضطراب الأعمق. ولذا فليس من المستغرَب أنه حين انتقل أسد إلى الهند تحت الحكم البريطاني في ثلاثينيات القرن العشرين، ومع تأسيس باكستان في عام 1947م، قد دعَا إلى إقامة دولة إسلامية حقيقية تطبِّق الشريعة:
"لا يكتفي الإسلام بمجرَّدِ المطالَبة باتخاذ «موقفٍ روحاني» ما… بل يؤكد على إذعان معتنقيه برؤيته الخاصة للحياة العملية أيضًا. إذ لدى الإسلام -في إطار هذه الرؤية التي تُسمَّى الشريعة- رؤاه الخاصة للتقدُّم، وتعريفه الخاص للصالح الاجتماعي، ونمطه الخاص في العلاقات الاجتماعية… و[نظامُ] الإسلام في صعودٍ وانحدار تبعًا لقدرته على تشكيل مجتمعنا."
نجد في قصة اعتناق أسد للإسلام العديد من الاستعارات التي كانت سائدةً في بواكير الخطاب الصهيوني، ومن ذلك التَّوق إلى الجذور وتشكيل جماعة [إنسانية]، وخيبة الأمل في أوروبا، وإضفاء الطابع الرومانسي على الشرق باعتباره مكمَنَ النقاء والأصالة. لكنَّ أسدًا وجده ضالَّته في الإسلام، لا في إسرائيل. ومثلُ هذا التقارُب مع ما طرحَته الصهيونية يُعطي فكرةً خاطئةً عن سياساته المناهضة للصهيونية. ففي باكورة أعمال أسد، «الشرق غير الرومانسي» (Unromantisches Morgenland) (صدر عام 1924م) [بالألمانية]، يعبّر عن تعاطفه مع سكان فلسطين العرب، ويطرح تعبيرَ «الاستعمار الصهيوني» (Zionist colonialism)، قبل عقودٍ من ذيوعه في الدوائر التقدُّمية. لكن المسيحية لم تكن بديلًا أفضل؛ إذ يصفها أسد بأنها «قوة مُستهلَكة»، غايتُها توفير «نغمة مزاجية» روحانية، بدلًا من القيام بدورٍ نشِطٍ في تشكيل المجال السياسي. وقد تنبَّأ أسد أيضًا بما جاء لاحقًا في حقبة ما بعد الاستعمار من نقدٍ للمركزية الأوروبية (Eurocentrism)، متهمًا الأوروبيين بالخَلط بين رفضهم المسيحية وبين رفض الدين في حدِّ ذاته. ففي مقالةٍ نُشِرت في عام 1947م، نجده يكتب:
"نظرًا لأن المسيحية كانت هي التجربة الدينية الوحيدة للغرب على مدى عدَّة قرون، فقد اعتاد الغربيون أن يُساووا بينها وبين مفهوم «الدين» عمومًا؛ ومن ثَمَّ فإن خيبةَ أملهم الواضحة في المسيحية، في هذا العصر الحديث، قد جعلتهم يفترضون أن تغمر خيبةُ الأمل كلَّ تجربةٍ مع المبدأ الديني في حدِّ ذاته. لكنهم -في الواقع- أُصيبوا بخيبةِ أملٍ من الشكل الديني الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق."
من الصعب التوفيق بين هذا وبين الصورة الرائجة لأسد باعتباره جسرًا بين الشرق والغرب. لقد كان أسد -في الواقع- مفكرًا مسلمًا جاء اعتناقه الإسلام راسخًا إلى حدٍّ كبير، نتيجةَ رفضه للكثير من [قِيَم] أوروبا في عصره. واستمرار الصورة الشعبية درسٌ للمسلمين، مفاده أن هذا هو ما يجري حين نُهمِل علماءنا ونتجاهلهم؛ إذ يُشكِّل الآخرون معنى حياتِهم وفكرِهم وإرثِهم.
استدعى تركيزُ أسد على دور العقل في الإسلام -على سبيل المثال- [إلى الأذهان] إرثَ المتكلِّمين المعتزلة.
إلا أن علاقات أسد مع إخوانه من المسلمين لم تكن سهلةً ومباشرةً. فقد خيَّم على أسد شعورٌ بوجود انفصالٍ ومسافة حاجزة بينه وبينهم طوال مسيرته. فلم ينضمّ يومًا إلى حركة جماهيرية أو تنظيم، مثل «الإخوان المسلمين» أو «الجماعة الإسلامية» [في باكستان]، بما كان من شأنه أن ينشر أفكاره على نطاقٍ أوسع. وقد كان أيضًا مفكرًا مستقلًّا، استنَد [في أفكاره] إلى توجُّهاتٍ متنوِّعة. وقد استدعى تركيزُه على دور العقل في الإسلام -على سبيل المثال- [إلى الأذهان] إرثَ المتكلِّمين المعتزلة. بَيد أن أسدًا كان يقف أيضًا على أرضية مشتركة فسيحة مع الإسلاميين، وقد امتدَح كلٌّ من سيد قطب وأبي الأعلى المودودي نقدَ أسد اللاذعَ للعلمانية.
ولأن أسدًا قدَّم نقدًا من الداخل، بصفته مُهتدِيًا أوروبيًّا، فقد أدّى هذا إلى زيادة مكانته في دوائر الإسلاميين في أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته. ومع ذلك، وعلى نحوٍ شديد التميُّز، كان ما يعنيه أسد بـ«الشريعة» شيئًا فريدًا من نوعه. فالقراءة الدقيقة لأفكار أسد حول الشريعة الإسلامية تكشف لنا أنه كان تلميذًا لابن حزم والمذهب الظاهري، وهو مذهبٌ منقرضٌ الآن، وقد استُبعِد -منذ القرن الرابع عشر الميلادي على الأقلّ- من الإجماع الفقهي السُّني.
"على القارئ ألَّا ينظر إلى ما أطرحه من آراء على أنها بدعةٌ غير مسبوقة في الفكر الإسلامي… فقد كانت هذه الآراء لدى صحابة النبي (ﷺ) أنفسهم وتابعيهم، ثم كانت أيضًا لدى بعض أعظم علماء الإسلام، لا سيما ذلك الرجل الذي يُعَدُّ -بحقٍّ- من بين ألمَعِ ثلاثة عقول أو أربعة أنجبها العالم الإسلامي، أعني أبا محمد ابن حزم القرطبي."

منهاج الإسلام في الحكم
كان أسد أيضًا ذا توجُّهٍ ليبراليٍّ في المسائل الاجتماعية، وكان يسخر من التوجُّه المحافِظ تجاه تلك المسائل لدى «المُلّالي». وفي عملٍ موجَز لأسد بعنوان «مبادئ الدولة والحكم في الإسلام» (Principles of State and Governance in Islam) (صدر عام 1956م)[3]، يرسم معالمَ رؤيته لدولة إسلامية حقيقية، بناءً على مبادئ المذهب الظاهري. ومن الواضح في تلك الرؤية ذلك الشَّبه [بين تلك الدولة وبين] الديمقراطية الغربية الليبرالية، من حيث الاقتراع العام وحرية الفكر والمساواة بين الجنسين.
والمقصد هنا أن أسدًا شخصية يصعب تصنيفها. فهو يندُّ عن تلك التصنيفات الدقيقة وعن مَيلنا إلى تصنيف العلماء وتأطيرهم بصورة حادَّة: هل هو ليبرالي أو إسلامي؟ تقدُّمي أم رجعي؟ مبتدعٌ أم متّبِع؟ فنحن نرى في أسد التزامًا بالليبرالية الاجتماعية إلى جانب مناهضةٍ حادةٍ للعلمانية، واعتزالًا في الجانب العقدي مع تمذهبٍ بالمذهب الظاهري من الناحية الفقهية. والنتيجة أنه لا يمكن لمدرسة فكرية إسلامية في العصر الحديث أن تزعم أن أسدًا ينتمي إليها. غير أن الذنبَ ليس ذنبَ أسد، بل هو في رغبتنا الجامحة في اختزال هذا الإرث الإسلامي الغني والمعقَّد في مثل هذه الثنائيات التبسيطية. ويمثِّل أسد تحدّيًا لهذه الحدود، مما يجبرنا على التساؤل حول معنى أن يكون المفكر المسلم «ليبراليًّا» أو «إسلاميًّا» أو -في الواقع- أيَّ نمط آخر من التصنيفات.
ربما هناك أسباب أعمق لهذا الانفصال بين أسد وإخوانه المسلمين. فعلى مدى التاريخ الإسلامي، كان المهتدون يجلبون معهم معتقداتٍ وممارساتٍ متجذّرة فيهم إلى الإسلام. فلا أحدَ [يسلم] برأسٍ فارغ. وقد كان أسد ذلك المهتدي الذي رحل عن أوروبا ووَجَد في الإسلام زادَه الروحي؛ ولكنه الإسلام كما فهمه أسد بفهمِه وشروطِه هو، ويبدو أن تصوُّره عن «الدين» و«العقل» و«الإصلاح» قد تشكَّل -بدرجة كبيرة- من خلال تربيته في أوروبا ومصادر التأثير فيه في مرحلته التكوينية هنالك. ولنتذكَّر هنا إنكارَه لقصص المعجزات في القرآن؛ فهو يرى أن هذه القصص أساطيرُ تمثيلية تؤدّي غرضًا تعليميًّا لا غير، ولا تُشير إلى أحداثٍ تاريخية فعلية. فقصّةُ كلامِ المسيح في المهد (سورة آل عمران، الآية 46، وسورة مريم) هي «إشارةٌ مجازية إلى الحكمة النبوية التي كان ستصبح مصدرَ إلهامٍ للسيد المسيح منذ بواكير حياته». أما فيما يتعلَّق بأن المسيح يخلقُ {مِن الطينِ كهَيْئةِ الطَّير} (سورة آل عمران، الآية 49)، فيعتمد أسد على براعته في اللغة العربية؛ إذ يقول إن كلمة «طَيْر» في اللغة العربية في عهد ما قبل الإسلام تعني في الشِّعر أيضًا «النصيبَ» أو «القدَر»:
"وهكذا، تبعًا للأسلوب التمثيلي الذي يرُوقُ المسيحَ كثيرًا، ألمحَ إلى بني إسرائيل أن من طِينِ حَيَواتِهم الحقيرِ سيُشكِّل لهم رؤيةً لمصيرٍ يُحلّقُ عاليًا، وأن هذه الرؤيةَ -التي ستدبُّ فيها الحياة بما وهبَه اللهُ من نفحَات- ستُصبِح مصيرَهم الحقيقي بإذنِ الله وبقوّة إيمانِهم."
يكشف أسد هنا عن تصوُّر «تنويري» عن «العقل» يسعى إلى التوفيق بين الدين والنصوص المقدَّسة وبين العلوم التجريبية؛ وهي مسألة كان لها أثرٌ حاسمٌ في تشكيل الخطاب اليهودي والمسيحي في القرن العشرين، بصورةٍ أبعَد كثيرًا عمَّا شغَل المفكرين المسلمين. وفي الواقع، هناك تعارُض بين التشكيك في المعجزات وبين كثيرٍ من ميراث التقوى في التصوُّر الإسلامي. وكما يؤكد شيخُ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري أفندي، فالتراث الإسلامي يرى في المعجزات إحدى دلائل النبوّة. ومن ثَمَّ فليس من المستغرَب أنْ كان أسد شخصيةً جدليةً في بعض الدوائر الإسلامية. فقد أوقفَ الراعي الأوَّلي لمشروعه في ترجمة القرآن -أعني «رابطة العالَم الإسلامي» ومقرّها مكة- دعمَ المشروع في عام 1964م، ثم حظرَت الترجمةَ/التفسيرَ تمامًا في عام 1974م، حتى قبل النشر. كان هذا الرفضُ صدمةً بالنسبة إلى أسد. وقد شكَا بمرارةٍ في رسالة خاصة كتبها في فبراير 1969م، وجاء فيها:
"لو علمتَ على أيِّ أساسٍ هشٍّ، غيرِ ذي اعتبارٍ تقريبًا، اعترَضَ العديدُ من «علمائهم» على بعض تفسيراتي، فستندهش من معرفة إلى أيِّ مدًى قد انحدرَ النشاط الفكري في أوساط مَن يُسمّون «علماء» بيننا، ممَّن يخشون من كلِّ ذرّةٍ في الهواء النقي. وعلى ما يبدو، فهم يعتبرون الإسلامَ هشًّا لدرجةٍ تَحُولُ بينه وبين توظيف العقل."
وقد زعم أسد في مقابلةٍ أُجرِيَت معه في السنوات الأخيرة من حياته أنه لو كان الإسلام في عشرينيات القرن العشرين كما هو عليه الحال اليوم[4]، فمن المرجَّح أنه ما كان ليُسلِمَ أبدًا. فقد دعا أسد إلى «إسلام عقلاني»، كان يقف آنذاك في الجهة المقابلة لكثيرٍ من أتباعه الأصليين. وبإيجاز، كان إسلامًا مفرَّغًا من [عادات] المسلمين. وكان أسد مُدرِكًا لهذا الانفصال؛ فقد تساءل في ملاحظة واعية، في كتابه «الطريق إلى مكة»، قائلًا:
"لماذا، حتى بعد أن وجدت مكاني بين الناسِ الذين يؤمنون بالأمورِ نفسِها التي أصبحتُ أؤمن بها، لَم أستقرّ بعدُ؟"
والجواب أن تصوُّر أسد عن الإسلام والعقل والإصلاح لا يمكن استيعابه تمامًا إلَّا من خلال الثقافة الفكرية التي خلَّفَها -ظاهريًّا- وراءَه. فقد كان سهلًا على أسد تَرْك أوروبا، ولكن كان من الصعب أن تتركه أوروبا.
وهكذا، يكشف أسد عن «عجز الأصالة» الذي ما يزال يضرب المثقف الغربي: هل يخدم التراث أم يخونه؟ هل يُجدّد الدين ويُوطّنه في تخومٍ غربية جديدة، أم بالأحرى يستعمر الإسلام فكريًّا ويلعب -دونما وعيٍ منه- دورَ «المُخلِّص الأبيض» الذي يعلِّم السكان الأصليين [في العالَم الإسلامي] أمورَ دينهم؟ لو عاش أسد عقدًا أو نحوَ ذلك، فيبدو أنه كان في نهاية المطاف سيوجِّه نداءً مباشرًا وصريحًا للمسلمين الغربيين لقيادة الإحياء الإسلامي؛ لأن هذا يبدو هو الاتجاه الذي كان يُبحِر فيه خلالَ سنواته الأخيرة، وهو موضوعٌ ظهَرَ في آخر أعماله البارزة، وأعني ترجمتَه وتفسيرَه للقرآن، بعنوان «رسالة القرآن» (The Message of the Qur’an).
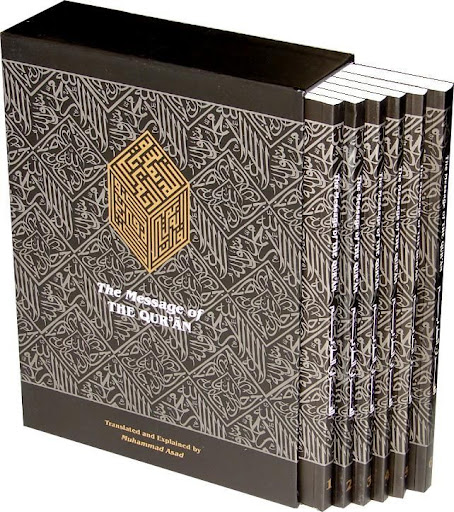
رسالة القرآن
جاءت هذه الترجمة، التي كُتِبت بين عامَي 1958-1980م، لتضم مقدمةً مفصَّلة وأربعةَ ملاحق وما لا يقلّ عن 5371 حاشية. وفي المقدمة، يتحدَّث أسد عن سعيه إلى تقريب القرآن من قلوب الناس وعقولهم في الغرب، ويُهدي عملَه «لقومٍ يتفكَّرون». ولا شكَّ أن هذه إشارة إلى توجُّهه الإصلاحي التحديثي؛ بَيدَ أن أسدًا يعي بالتأكيد أن هذه الدعوة إلى «التفكُّر» ستلقى رواجًا في أوساط الجماهير الغربية. ويعقد أسد أيضًا سلسلةً من الخيارات المعجمية التي يبدو أنها صُمّمت ليكون لها صدًى لدى القرَّاء الغربيين المطّلعين على الكتاب المقدَّس والتعاليم المسيحية. فعلى سبيل المثال، نجده يختار لفظة God ولا يكتب Allah، مُستبِقًا مترجِمين لاحقين مثل محمد عبد الحليم. وكذا يستخدم ضمائرَ Thee وThy وThou، وأفعالَ shalt أو dost، في أسلوبٍ يذكرنا بنسخة الملك جيمس من الكتاب المقدَّس (King James Bible). فيما لم يترجم أسد كلمتَي «رسول» و«نبي» إلى Prophet أو Messenger، وإنما إلى Apostle، وهو مصطلحٌ ذو نبرةٍ كتابية/تَوراتية قوية. أما مصطلح «خليفة»، الذي غالبًا ما يُترجَم في الإنجليزية إلى vicegerent أو successor، فترجَمه أسد إلى جملة (one who shall inherit the Earth)، في إشارةٍ إلى الآية الخامسة من الإصحاح الخامس في إنجيل مَتَّى [«يرِثون الأرضَ»]. وهذا قد يشير إلى خلْفية أسد الخاصة؛ إذ نرى هنا بقيةً من أثرِ نشأة أسد في أوروبا، أو ربما هي محاولةٌ متعمَّدة لتقديم القرآن بأسلوب يسهل به إقناع الغربيين. لكن على الأرجح أن الأمر مزيجٌ من الاحتمالَيْن.
وهذا من شأنه أن يُفسّر لنا نظرةَ أسد إلى المعجزات؛ فهو يدرك أن قصص المعجزات تواجه تحدّياتٍ في عصره، ومن غير الراجح أن تروق للجمهور الغربي. ويفسّر لنا أيضًا وتيرةَ استدعاء أسد لرفض الإسلام المعتقداتِ المسيحيةَ الرئيسة، مثل «الخطيئة الأصلية» و«الكفَّارة البديلة»؛ إذ يستحضر أسد هذا الأمرَ في حواشيه كلَّ حينٍ وآخَر، حتى عند تفسير آياتٍ قرآنية لا يبدو أن لها علاقةً بهذه المعتقدات. ولننظر إلى تناوُلِه الآيةَ رقم 18 من سورة فاطر: {ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أخرَى وإنْ تَدعُ مُثقَلَةٌ إلى حِمْلِها لا يُحمَلْ مِنهُ شَيْءٌ ولو كانَ ذا قُربَى…}.
يقول أسد إن النصف الأول من الآية فيه رفضٌ لفكرة «الخطيئة الأصلية»، فيما يُنكِر الجزء الثاني «الكفارةَ البديلة». لكننا لا نجد مترجِمًا إنجليزيًّا آخر -من يوسف علي وبكثال وأربري، إلى مترجِمي The Study Qur’an- يشير إلى هذه المعتقدات المسيحية. ويُدرِك أسد أن هذه المعتقدات لم تعُد تلقى قبولًا لدى الغربيين؛ ولذا فإن هدفه هنا هو إثبات ما يراه العقلانية الحقَّة والمعقولية والمساواة في التعاليم الإسلامية.
إذا صحَّت قراءتنا للرجل، فمن الممكن أن ندرك في عمله الأخير لمحاتٍ عن حجَّة اكتسبَت زخمًا من ذلك الحين؛ وهي أن المسلمين الغربيين هم الأمل لمستقبل الأُمَّة، وأنهم وحدَهم مَن لديهم الحريات والملَكَة النقدية الضرورية لتحقيق النهضة الإسلامية.
وينطوي هذا على فكرة أن الغربيين على وفاقٍ تامٍّ مع الإسلام، ومن ثَمَّ يمكن أن يُقنِع الإسلامُ ذلك الغربَ الذي سئمَ المسيحية. وفي الوقت ذاته، فإن الجماهير الغربية تمثِّل تربةً أخصَب يمكن فيها غرس بذور الإحياء الإسلامي. إذا صحَّت قراءتنا للرجل، فمن الممكن أن ندرك في عمله الأخير لمحاتٍ عن قولٍ اكتسبَ زخمًا من ذلك الحين؛ وهو أن المسلمين الغربيين هم الأمل لمستقبل الأُمَّة، وأنهم وحدَهم مَن لديهم الحريات والملَكَة النقدية الضرورية لتحقيق النهضة الإسلامية. وهذا قولٌ نسمعه اليوم من أمثال خالد أبو الفضل ومراد هوفمان. وهذا الأمر قد يعني أيضًا أن أسدًا قد عاد -بصورةٍ ما- إلى جذوره الأوروبية. فالأسباب التي دفعته إلى اعتناق الإسلام وتَرْكِ أوروبا أعادته في نهاية المطاف إليها، وإن كان ذلك بطريقة لم يتخيلها أسد على الإطلاق ولم يعبِّر عنها بصورة تامَّة.
نمرُّ اليوم بلحظة ثقافية مهمَّة، يجري فيها التركيز على قضايا العِرق والهُوية كما لم يحدث من قبل على الإطلاق. فمفاهيم مثل «العنصرية المنهجية» (systematic racism) أو «الامتياز الأبيض» (white privilege) قد انتقلت من الدوائر الأكاديمية ودائرة النشطاء إلى التيار السائد. لكنَّ أسدًا عاش ورحَل عن عالمنا قبل هذا بكثير. ولكن بوصفه أحد أبرز وقُدامى المهتدين البِيض إلى الإسلام، فربما ما زالت تجاربه وخبراته تُسهِم في النقاشات المعاصرة.
فمن ناحية، كان أسد -بلا شك- من المستفيدين من «الامتياز الأبيض» طوال مساره المهني. فلا يمكننا أن نتغافَل عن إدراك تغلغله بيُسْر في دوائر النخبة أينما ذهب؛ فقد التقى [شيخَ الجامع الأزهر] مصطفى المراغي في مصر، و[الملكَ] عبد العزيز آل سعود في شبه الجزيرة العربية، و[الشاعرَ والفيلسوف البارز] محمد إقبال في الهند. لا شكَّ أن لعقله وذكائه دورًا في هذا؛ ولكنَّ المهتدين الأوروبيين كانوا شيئًا جديدًا [جاذبًا] في ذلك الوقت، وقد استفاد أسد من هذا الأمر إلى أبعد حدّ. بل إننا لا نرى في أعمالِه أيَّ أثرٍ للشعور بالحرَج بسبب ما حظيَ به من امتيازات من قِبَل المسلمين غير البِيض. ولكن من ناحية أخرى، فإن نظرةً عن كثب على حياة أسد تعزّز أيضًا شعورًا بأن البَياض يُبطِل الإسلام، بطريقة أو أخرى، وأن المسلمين البِيض والمهتدين لا يمكن أن يكونوا مسلمين «حقًّا». ففي [سيرته الثانية]، «عودة القلب»، يتحدَّث أسد عن التمييز الذي واجهه خلال عمله مع الحكومة الباكستانية بين عامَي 1947-1951م؛ لأنه لم يكن من أبناء البلد. لكن الأكثر إشكالًا كانت التعبيرات المعادية للسامية، التي لحقت بأسد طوال مساره في العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال، لا يكاد يُعرَف أن أسدًا تعرّض حين كان يكتب «الطريق إلى مكة» -في نيويورك في خمسينيات القرن العشرين- لحملةِ اغتيالٍ للشخصية في الصحافة الباكستانية. وكان عليه أن ينفيَ -مرارًا وتكرارًا- الادعاءات التي تتهمه بأنه جاسوسٌ إسرائيليٌّ أو أنه عاد إلى اليهودية. وإليكم مقتطَفًا من رسالة خاصة أرسلَها أسد إلى وزير الخارجية الباكستاني آنذاك، [محمد] ظفر الله خان، بتاريخ 6 يوليو 1953م:
"سيدي وصديقي العزيز،
يُحزنني أنني في كل مرةٍ أكتب إليك يتعلَّق الأمر بشيءٍ مؤلِم لا يسُرّ، ولكني حقًّا لا أرى في الموقف الحرِج الذي أمرّ به مفرًّا من وضع الحقائق أمامك عمَّا أتعرّض له من سَبّ وقذف وتشهير. فمنذ استقالتي من وزارة الخارجية، يجري تداوُل موجة من الشائعات المغرِضة، شفاهةً وصحافةً على حدٍّ سواء، ومفادُها ما يَلي:
1) أني هجرتُ الإسلامَ وقطعتُ علائقي به، وعدتُ إلى اليهودية.
2) أني وظَّفتُ نفوذي في وزارة الخارجية الباكستانية لنَفْع اليهود، وأني ما فتِئتُ أدعو إلى أن يُقيم العرب علاقاتٍ وُدّيةً مع إسرائيل.
3) أني زرتُ إسرائيل سرًّا خلال جولاتي الأخيرة في الشرق الأوسط.
4) أني تزوّجتُ يهوديةً في الولايات المتحدة…"
ويمكننا أن نشعر بما مرَّ به أسد من ألمٍ وأذًى ومرارةٍ مع مواصلة قراءة خطابه، حيث يقول:
"هذه النقاط القلائل التي أشرتُ إليها آنفًا تضُرُّ بسُمعةٍ بنَيتُها لنفسي على مدار خمسٍ وعشرين سنةً من العمل للإسلام ولفكرة باكستان. ولك أن تتصوّر حجمَ الألم الذي أشعرُ به إذ يتهمني بعدمِ الولاء ذلك المجتمعُ الذي كرَّستُ له حياتي كلَّها…"
كان الدافع الظاهري لهذا الأمر هو قرار أسد طلاقَ زوجته الثانية العربية ليتزوّجها كاثوليكي أمريكي اعتنَقَ الإسلام. وهي مفارَقة مُحزِنة حقًّا أن أسدًا كان مضطرًّا للدفاع عن التزامه بالإسلام في أثناء تدوينه كتابًا سعى فيه إلى شرح كلّ ما وجده جميلًا في عقيدته للجمهور الغربي. ولكن عند النظر من زاوية أخرى، فإن كثيرًا من هذا لم يقتصر على أسدٍ وحده. فحتى يوم الناس هذا، ما زال المسلمون والمهتدون البِيض يتحدَّثون عن شعورٍ بالاغتراب عن الفضاءات الإسلامية الأوسَع. فإلى جانب الاحتفاء بالمهتدين (البِيض)، هنالك واقعٌ أكثر كآبةً وقَتامَة؛ إذ يجري استجوابُهم عند دخول المساجد، أو يُعزلون في الأعياد الدينية، أو يُتهمون بالتجسُّس على الجماعة الدينية. ولا يزال المسلمون البِيض إما مُصنَّمين أو مُهمَّشين، ولكن نادرًا ما يُعامَلون على قدم المساواة. ويدلُّنا مسارُ محمد أسد على هذا الواقع. فمن المفيد أن نفكِّر في مسألة أنه عند وفاة أسد في عام 1992م، كان مسلمًا لمدَّة 66 عامًا من حياته التي امتدَّت 92 عامًا. ومع ذلك، كان -وسيظلّ- يُنظَر إليه على أنه -أولًا وقبل كلّ شيء- متحوِّلًا [إلى الإسلام].
وليست حملة التشهير هذه سوى جانب واحد من العديد من الجوانب غير المعروفة إلى حدٍّ كبيرٍ عن «الطريق إلى مكة». ويزعم الكتابُ، الذي نُشِر في عام 1954م ليحظى بإشادةٍ واسعة، أنه يروي كيف ترَك أسد إرثَه اليهودي-الأوروبي واعتنَق الإسلام، منغمسًا فيما بين عامَي 1926-1932م في حياة البدو في قلب شبه الجزيرة العربية، ليصبح من أقرب المقرَّبين من [الملك] عبد العزيز آل سعود، مؤسِّس المملكة العربية السعودية. ويأتي الكتاب موزّعًا بين أدب الرحلات وأدب الذكريات، ويُعَدُّ اليوم واحدًا من السِّيَر الروحية العظيمة في القرن العشرين، وربما لا تنافسه سوى «سيرة مالكوم إكس»[5] (Autobiography of Malcolm X).
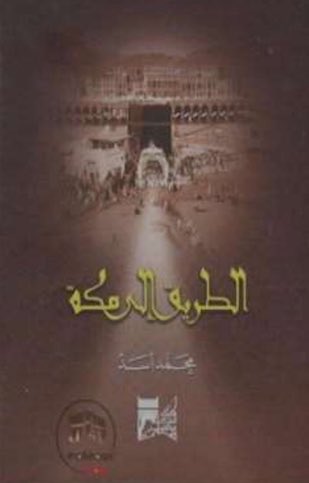
الطريق إلى مكة
غير أن مكانةَ العمل الأيقونية لم تنعكس بعدُ بشكلٍ كاملٍ في بحوث نقدية. ولكن ما لدينا مُعبِّر وذو دلالة. إذ لم يعُد من الممكن قراءة «الطريق إلى مكة» باعتباره سردًا دقيقًا -من الناحية التاريخية- وموثوقًا لحياة مؤلِّفه. فالدراسة النقدية البارزة للنص التي أجراها (بالألمانية) غونتر فيندهاغر (Günther Windhager) تبذل جهدًا كبيرًا للفصل بين الحقائق التاريخية والسرد القصصي. فعلى سبيل المثال، يُقدَّم زَيد -رفيقُ أسد البدويُّ الرحَّالةُ [الذي يظهر] في الفصول الأولى من الكتاب- على أنه شخصية أدبية بحتة [لا واقعية]. ولنضع في الاعتبار أيضًا تلك الإغفالات الملحوظة في النص. ففي مراجَعة نقدية باكرة، اتهَم جود تيللر (Judd L. Teller) أسدًا بالتقليل عَمدًا من أهمية المكوِّن اليهودي في قصّته:
"من اللافت للنظر أن [أسدًا] لا يناقش معاداة السامية في أوروبا، كما لو أن هذا لم يكن له تأثيرٌ فيه. لكنه وُلِد في غاليسيا (Galicia)، حيث أُخِذ اليهودُ كبشَ فداءٍ في الصراعات التي دارت على السلطة والنفوذ بين الأوكرانيين والبولنديين المُعادِين للسامية وبين الحكومةِ النمساوية المتسامحة مع بعض التذبذب. ثم نشأ في ڤيينا التي كانت حينها عاصمةَ معاداة السامية في أوروبا… فهل كلّ هذا لم يمسّه بسوء؟"
كما لا يقدِّم أسد تفاصيلَ عن [انخراطه في] أي دراسة رسمية طوال تلك السنوات في شبه الجزيرة العربية. وإلى يومنا هذا لا نعرف أيَّ متونٍ درَس، أو مع مَن، أو ما الذي كان له أثرٌ في أفكاره حول التراث الفكري الإسلامي؛ وهي ثَغرةٌ ملحوظة [عند الحديث] عن شخصٍ يسعى إلى تجديد هذا التراث نفسه. أما الأكثر دلالةً فهو إخفاقُنا في الكشف عن الأسباب الحقيقية لرحيله عن شبه الجزيرة العربية في نهاية المطاف عام 1932م. فتلك الإشارة المقتضَبة إلى أرَقِ الروح، و«القلَقِ والتبرُّم»، والرغبةِ في استكشاف البلدان الإسلامية الأخرى لا تكاد تقنع القارئ، الذي لا بدَّ أن يعتقد أن ما لَم يُقَل هو أكثر من هذا بكثير. وبالإضافة إلى ذلك، تدفعنا رسائل أسد الخاصة إلى التشكُّك في نيَّته المعلَنة من كتابة النص. ففي مقدمته يزعم أسد أن دافعه هو الرغبة في نقل جمال الإسلام إلى الجمهور الغربي، غير أن رسائل خاصة من تلك الحقبة تُشير إلى شيءٍ دنيويّ، وهو ضائقة مادية وعقد مُغْرٍ من دار نشر سيمون وشوستر (Simon & Schuster).
ولا ينفرد أسد بهذا. فلا يمكن لأي سيرةٍ ذاتيةٍ أن تكون موضوعيةً تمامًا في سرد قصة صاحبها. غير أن التركيز على «الحقيقة» التاريخية ربما أعمانا عن رؤية «الحقائق» الأعمق التي سعى أسد إلى نقلِها [إلينا]. ولكن تظل مهمة الباحثين في المستقبل أن يستكشفوا إلى أي مدًى اتسع نطاق عمل أسد التحريري، ولا بدَّ لهذا أن يشملَ قراءةً متقاطِعةً للطبعات الأربع المختلفة من كتابه «الطريق إلى مكة»، التي نُشرَت بين عامَي 1954-1980م. فلا يعرف كثيرون أن أسدًا أجرى سلسلةً من التعديلات التحريرية في كلّ طبعة [من هذه الطبعات]؛ لكن حتى المقارنة الخاطِفة للنصوص تكشف عن هذا. ولنأخذ انتقاداته للملك عبد العزيز آل سعود في الطبعة الأولى من «الطريق إلى مكة»، الصادرة في عام 1954م:
"لقد ملَأ وصولُ ابن سعودٍ إلى هذه المرتبة -بصورةٍ لم يسبقْ لها مثيلٌ، في وقتٍ كان معظمُ أقطار الشرق الأوسط يستسلمُ فيه لتوغُّلِ النفوذِ الغربي- العالَمَ العربي بالأملِ في أنه قد جاء أخيرًا زعيمٌ وقائدٌ عربيٌّ يخلِّصُ الأمةَ العربيةَ كلَّها من عبوديتها. وتطلَّعت إليه جماعاتٌ إسلامية عديدة من غير العرب لإحياء الفكرةِ الإسلامية بأكملِ معانيها، وذلك بإقامةِ دولةٍ تكونُ فيها الكلمةُ العُليا لروحِ القرآنِ وحده. ولكن هذه الآمال ظلَّت غيرَ منجَزة. ومع زيادةِ سلطتِه وتوطيدِها، صار من الواضحِ أن ابنَ سعودٍ لم يكن أكثرَ من ملِكٍ، لا يسعى إلى أسمى من كثيرٍ من الحكَّام الشرقيين المستبدّين الآخرين مِن قَبله.
لقد كان كريمًا وعادلًا في حياته الشخصية، وفيًّا لأصدقائه ومؤيديه، وكان كريمًا إزاءَ أعدائه؛ وَهَبه اللهُ ذكاءً فطريًّا فاقَ كثيرًا ذكاءَ أقرانِه وأتباعِه. ولكنه -مع ذلك- لم يكن ذا رؤية واسعة وقيادة مُلهَمة كما كان متوقّعًا منه. لقد حقَّق بالفعل الأمنَ لكلّ شعبه في الأرجاء الشاسعة لبلادِه، لم يتحقَّق مثلُه في أي بلدٍ عربيٍّ منذ عصر الخلفاء الراشدين الأوائل من ألف عام مضَت. ولكنه على عكس هؤلاء الخلفاء الأوائل، حقَّق ذلك عبرَ القوانين الصارمة والتدابير العقابية، لا عن طريق غرس الشعور بالمسؤولية المدنية في نفوس شعبه. وقد أرسل عددًا من الشباب إلى خارج البلاد لدراسة الطب والاتصالات اللاسلكية؛ ولكنه لم يفعل شيئًا ليبثّ في شعبه ككلّ الرغبةَ في التعليم، ومن ثَمَّ إخراجهم من الجهل الذي انغمسوا فيه على مدى قرون. وقد اعتادَ أيضًا أن يتحدَّث -بكلّ ما يدلّ على إيمانِه بذلك- عن عظمةِ الحياةِ الإسلامية؛ لكنه لم يفعل شيئًا لبناء مجتمعٍ عادلٍ وتقدُّمي، يمكن لهذه الحياةِ أن تجد فيه تعبيرًا ثقافيًّا عنها."
والآن، قارِن هذا بالثناء المُفرط الذي نشاهده في المقطع ذاته في طبعة الكتاب الصادرة في عام 1973م:
"لقد ملأ وصولُ ابن سعود إلى هذه المرتبة -بصورةٍ لم يسبق لها مثيلٌ في وقتٍ كان معظمُ أقطار الشرق الأوسط يستسلمُ فيه لتوغُّلِ النفوذِ الغربي- العالَمَ العربي بالأملِ في أنه قد جاء أخيرًا زعيمٌ وقائدٌ عربيٌّ يخلِّصُ الأمةَ العربيةَ كلَّها من عبوديتها. وتطلَّعت إليه جماعاتٌ إسلامية عديدة من غير العرب لإحياء الفكرةِ الإسلامية بأكملِ معانيها، وذلك بإقامةِ دولةٍ تكونُ فيها الكلمةُ العُليا لروحِ القرآنِ وحده.
لقد كان كريمًا وعادلًا في حياته الشخصية، وفيًّا لأصدقائه ومؤيديه، وكان كريمًا إزاءَ أعدائه [في نُبلٍ وشهامة]، ولا يعرفُ المداهنةَ مع المنافقين، وَهَبه اللهُ ذكاءً فطريًّا فاقَ كثيرًا ذكاءَ أقرانِه وأتباعِه. لقد حقَّق ابن سعود الأمنَ لكلّ شعبه في الأرجاء الشاسعة لبلادِه، لم يتحقَّق مثلُه في أي بلدٍ عربيٍّ منذ عصر الخلفاء الراشدين الأوائل من ألف عام مضَت. إن سلطتَه الشخصية هائلةٌ، ولكنها لا ترتكزُ على وسائلِ القوّة بقدرِ ما ترتكزُ على قوّةِ شخصيته. وهو معتدلٌ في كلامِه وسلوكِه، كما أن روحَه الديمقراطيةَ -بحقٍّ- تُمكّنُه من أن يتكلم مع البدو الذين يأتون إليه بثيابهم الرثَّة القذرة كأنما هو واحدٌ منهم."
ربما دفعَ مرورُ عقدين من الزمن أسدًا إلى التفكير بمحبَّة أكبر للملك عبد العزيز آل سعود بحلول عام 1973م. لكن هذا يبدو غيرَ محتمَل. إذ يبقى الشعور بأن الطبعة الأولى في عام 1954م هي الأقرب إلى مشاعر أسد الحقيقية. وهذا قد يفسّر لنا رحيل أسد عن شبه الجزيرة العربية في عام 1932م بعد أن زادت خيبة أمله في توجُّهات القيادة لدى الملك. غير أن هذا بدوره يثير سؤالًا حول سبب تلك النقلة التقديسية في عام 1973م. وقد أشار العديد من الباحثين إلى ذلك الجدل الذي دار حول ترجمته وتفسيره للقرآن خلال الفترة نفسها، وربما كانت تلك التعديلات محاولةً لاستعادة الرعاية السعودية للمشروع.
«الطريق إلى مكة» ليس نصًّا ثابتًا، وإنما هو سردٌ ديناميٌّ لحياة مؤلِّفه، أعاد أسد صياغته في مراحل مختلفة وفي ضوء الظروف المتغيرة.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن طبعة عام 1973م من «الطريق إلى مكة» -وهو العام ذاته الذي شهد الطفرة النفطية- يُمكن أن تُقرأ على أنها شاهدٌ مبكرٌ على مدى انتشار السطوة السعودية وتأثيرها في مجال التمويل والنشر في العالم الإسلامي الحديث.
ويتضح لنا من هذه الاستراتيجيات التحريرية أن «الطريق إلى مكة» ليس نصًّا ثابتًا، وإنما هو سردٌ ديناميٌّ لحياة مؤلِّفه، أعاد أسد صياغته في مراحل مختلفة وفي ضوء الظروف المتغيرة. ومن المؤكد أن إجراءَ دراسة مقارِنة شاملة لكلّ طبعة [من الطبعات الأربع] سيكشف عن مدى عمق هذه الاستراتيجية واتساعها، وسيُتيح أيضًا فهمًا ثاقبًا وغنيًّا للطرق المتعدِّدة التي تغيرت عبرها مواقف أسد على مدى مساره الطويل.
إذن، لماذا ما زلنا في انتظار دراسة شاملة باللغة الإنجليزية لهذا المفكر الإسلامي الهائل؟ ربما يرجع هذا فقط إلى عِظَم حجم المهمَّة. فدراسةٌ لائقةٌ بأسد تتطلَّب إلمامًا بما لا يقلُّ عن أربع لغات (الإنجليزية والألمانية والعربية والأُردية)، وعلى الباحث أن يتعقَّب إنتاجَه الفكري الذي يضمُّ سبعة أعمالٍ منشورة (بالإضافة إلى طبعاتٍ مختلفة من «الإسلام على مفترَق الطرق» و«الطريق إلى مكة»)، وستة أعدادٍ حرَّرها من مجلة «الثقافة الإسلامية» (Islamic Culture) (بين يناير 1937 و1938م)، وعشرة أعدادٍ من مجلته «عرفات» (Arafat) (بين عامَي 1946-1947م)، وعددًا هائلًا من اللقاءات الإذاعية، ومقالاتٍ وخطاباتٍ عامةً ورسائلَ شخصيةً ومقابَلاتٍ مع أصدقاء أحياء وأفرادٍ من الأسرة. وستتطلَّب هذه الدراسة بحثًا مستفيضًا لإلقاء الضوء على مختلِف مراحل حياة أسد: من المجتمع اليهودي الأوروبي في بواكير القرن العشرين إلى سنوات التشكيل في فجر الدولتَيْن السعودية والباكستانية. ولا بدَّ من قراءة سردية أسد نفسِه بالتقاطُع مع الأصوات المنافِسة. وباختصار، فهي مهمَّة شاقَّة.
بَيد أن هناك جانبًا آخرَ يجب مراعاتُه. فقد تكْمُن الإجابة أيضًا في الجمود الفكري لدى المسلمين في العصر الحديث، وإخفاقهم في ضمِّ أسد إليهم واعتبارِه أحدَ مثقفيهم. وربما يُعزَى هذا -على سبيل المثال- إلى حاجة المسلم الحديث إلى أجوبةٍ سهلة ويقينياتٍ عاجلة، فيما لا يطرَح أسد سوى أسئلة. وبالنسبة إلى بيئة الصراع «الصوفي-السلفي»، الأشبه بالصراع القَبَلي، فإن أسدًا عصيٌّ على التصنيف الدقيق. أما لمَن يفضّلون الحفظَ والتلقين، فإن أسدًا يدعو إلى التفكير النقدي. ومن ثَمَّ فقد استمرَّ الانفصال الذي لاحَقَ أسدًا في حياته إلى وقتٍ طويلٍ بعد وفاته.
اعتنَق الإسلامَ عقلٌ كبيرٌ من عقول القرن العشرين، وكرَّسَ حياتَه لعقيدته ودينه، فأنتَجَ كثيرًا من طريقِ الفكر والحِجاج.
ويبقى هناك شعورٌ بأن أسدًا لو خدَم الصهيونية أو المسيحية كما خدَم الإسلام، لَكان هناك العديد من الدراسات التي تبجّلُ حياتَه وفكرَه وإسهامَه. وربما مما له دلالةٌ في هذا الصدد أن أفضل الدراسات اليوم عن أسد نجدها في حقل «الدراسات اليهودية» (Jewish Studies)، بينما يغيب عن بال المسلمين إلى حدٍّ كبير، سواء على الصعيد العلمي أو الشعبي. وهكذا اعتنَق الإسلامَ عقلٌ كبيرٌ من عقول القرن العشرين، وكرَّسَ حياتَه لعقيدته ودينه، فأنتَجَ كثيرًا من طريقِ الفكر والحِجاج. ولكنه تراجَع وانحسَر في خلفية المشهد بعد وفاته. وليست هناك جهودٌ ملحوظة من المجتمع الذي كان جزءًا منه للحفاظ على أفكاره أو نشرِها أو الاشتباكِ معها أو تطويرها. وحيثما يظهر أسد اليوم أو يُشار إليه، فإنما هي نسخة معدَّلة و«جسرٌ» بين الطوائف، بعد تفريغه من كثيرٍ من فكره الحقيقي.
فالحاصلُ أن لدينا نصفَ الحقيقة وحالةً من الاختزال والجهل. ويُعاني أسد من التجاهُل والتحريف بالقدر نفسِه. وأيًّا كان مستوى معرفتِنا به، فالآخرون هم مَن يشكّلونها ويحدّدونها. فلَم تُروَ بعدُ الحكايةُ الأكثر تعقيدًا وإثارةً عن حياة محمد أسد وما يمكن أن نتعلَّمه منه. ومهما يكن ما سنستفيدُه من أسد، فإن تقديرًا أعمق لحياتِه وفكرِه وإرثِه أمرٌ مطلوبٌ ومستحَقٌّ منذ أمَد.
مصدر المقال الأصلي: مجلة «المسلم الناقد» (Critical Muslim) [اللندنية]، العدد 40، خريف عام 2021م.
الهوامش
[1] نُقِلَت إلى العربية في ترجمةٍ رائقةٍ بعنوان «الطريق إلى الإسلام»، أنجزها عفيف البعلبكي، ونشرتها «دار العلم للملايين» في بيروت، وقدَّم لها الدبلوماسي والأديب المصري عبد الوهاب عزام. ثم صدرَت لها ترجمةٌ أخرى -عن «مكتبة الملك عبد العزيز» في الرياض- بعنوان «الطريق إلى مكة»، وفيها فصل جديد ليس في الترجمة الأولى، وقد صدرَت لاحقًا عن «منشورات الجمَل». (المترجم)
[2] نُشِرت مقالة بالعربية تحت هذا العنوان في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عدد 8 يوليو 2011م، وجاء فيها أن هذا مما وصفه به الدبلوماسي والمفكر الألماني المسلم مراد هوفمان. يمكن مطالعتها عبر هذا الرابط: https://tinyurl.com/asad-sharq-awsat. (المترجم)
[3] صدَرت الترجمة العربية لكتاب «مبادئ الدولة والحُكم في الإسلام» عن دار العلم للملايين في بيروت عام 1957م، بعنوان «منهاج الإسلام في الحكم»، وأشرف المؤلف على الترجمة التي أنجزها منصور محمد ماضي. (المترجم)
[4] يعني وقتَ إجراء المقابلة، لا يومنا الحالي! (المترجم)
[5] يمكن مطالعة الترجمة العربية في: مالكوم إكس، سيرة ذاتية، تحرير: أليكس هاليي، ترجمة: ليلى أبو زيد، (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 1996م). (المترجم)